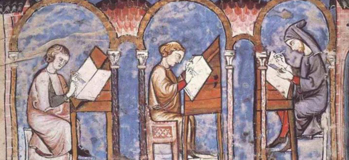حوار مع محمد التركي: مهام الفلسفة في الزمن المعاصر
فئة : حوارات

الأستاذ محمـد التركي، من مواليد 1945 بقابس في الجنوب التونسي، أستاذ جامعي متقاعد، مختصّ في الفلسفة الغربية المعاصرة في مجالات الفينومينولوجيا والفلسفة الظاهراتية والفلسفة الوجودية والمدرسة النقدية وفلسفة اليوتوبيا، وكذلك الفلسفة العربية الإسلامية.
درس الفلسفة وعلم الاجتماع والعلوم الإسلامية بجامعة مونستر في ألمانيا خلال السبعينيات من القرن الماضي وختمها بأطروحة دكتوراه في الفلسفة حول "الحرّية والتحرّر في فلسفة جان بول سارتر".
قام بالتدريس الجامعي في عدد من مدن ألمانيا ثمّ في موريتانيا وتونس إلى حد التقاعد عام 2007.
نشر العديد من المقالات باللغات الثلاث: الألمانية والفرنسية والعربية. من بين المؤلفات بالألمانية: "الحرّية والتحرّر، جدلية البراكسيس الفلسفي لدى جان بول سارتر" (1985)، "الإنسانوية والتثاقف" (2010)، "مدخل إلى الفلسفة العربية الإسلامية" (بصدد الإنجاز). أمّا بالفرنسية فقد دارت أبحاثه حول سارتر ومرلو بونتي، هيغل وهيدغر، بلوخ وريكور. وبالنسبة إلى الأبحاث العربية، فقد نشر المفكّر أوّلاً دراسات حول القراءات الألمانية للتراث العربي الإسلامي، خصوصا حول الفارابي وابن سينا وابن رشد وابن خلدون، ثمّ اهتمّ فيما بعد بفلسفة الهوية والتثاقف. كما قام الباحث بترجمة عدد من المؤلفات من الألمانية إلى العربية مثل دراسة إرنست بلوخ حول "ابن سينا واليسار الأرسطوطاليسي" التي صدرت عن "بيت الحكمة" بقرطاج (2012) وكتاب ماكس فيبر حول "السيادة" عن المنظمة العربية للترجمة (2015).
التقينا الأستاذ محمد التركي بمناسبة مشاركتنا معًا في ندوة بمدينة فرنكفورت انعقدت خلال شهر سبتمبر 2014 وكان لنا معه الحوار التالي:
حمادي ذويب: ما هي منزلة الفلسفة في العصر الحديث وماهي الوظيفة التي ترى أنّها ينبغي أن تضطلع بها؟
محمد التركي: لا شكّ أن كل حضارة عالمية على مدى التاريخ البشري خلّفت أثرًا معرفيًّا أصبح مرجعية يقتدى بها قد كان للفلسفة نصيب فيها. فعندما نعود إلى الحضارة الصينية القديمة أو الحضارة الهندية أو اليونانية فسنجد الفكر الفلسفي متجذّرًا فيها. وقد أشار الفيلسوف الألماني كارل ياسبير في القرن الماضي إلى المحور المشترك بين كونفوشيوس وبوذا وسقراط في القرن الخامس قبل الميلاد والذي جمع بين هؤلاء العباقرة بحيث ظهرت معهم الفلسفة وحدّدت بذلك معالم هذه الحضارات الثلاث. كذا الأمر بالنسبة إلى الحضارة الرومانية فيما بعد والحضارة الأوربية الحديثة التي تلتها بعد قرون. فهذه الأخيرة برزت مع تحرّر الفكر من هيمنة الكنيسة وظهور المقولة الديكارتية الشهيرة: "أنا أفكّر، إذن أنا موجود" التي فتحت المجال للفكر الحرّ المتعطّش إلى المعرفة، حيث أصبح الإنسان سيّد الموقف وفرض على الطبيعة القوانين التي بموجبها يمكن التحكّم فيها حسب عبارة الفيلسوف الشهير إمانويل كانط. من هذا المنطلق نستجلي أنّ الفلسفة كان ومازال لها دور أساسي وتأسيسي لكلّ حضارة ولا يمكن التخلّي عنها.
أمّا عن الوظيفة التي ينبغي أن تضطلع بها اليوم، فهذه تعود إلى الأهداف والغايات التي ترسمها الشعوب لتكريس حضارتها وبناء مستقبلها. فالعصر الحديث مثلاً عرف العديد من الأفكار والتيارات الفلسفية مثل العقلانية التي بادر بها ديكارت وتفرّعت عنها الثورتان العلمية والصناعية أو الأنوار التي تمخّضت عنها "الحرّيات وحقوق الإنسان" والثورتان الأميركية والفرنسية في القرن الثامن عشر، أو الماركسية التي حلّلت الظواهر الاجتماعية والاقتصادية بعد تطوّر الرأسمالية وتفاقم الفقر والاستغلال في المجتمعات التابعة لها، أو الوجودية التي أعادت النظر في مكانة الإنسان وخصوصًا الفرد في العالم، إلى جانب التيارات الأخرى، مثل الفينومينولوجيا التي لولاها لما ظهرت الوجودية أو المدرسة النقدية التي رفعت القناع عن الأطر الإيديولوجية الفاشية وحلّلت ظواهر الاغتراب في العالم الرأسمالي، وصولاً إلى الحركات الفلسفية الحديثة العهد مثل البنيوية والتفكيكية والتحليلية التي تعكس بدورها صورًا من المجتمعات التي نشأت فيها وتسعى إلى فهمها وتجاوز سلبياتها. فلكلّ هذه التيارات الفلسفية وظائف أفرزها الواقع المعيش وحدّدتها الحاجة بحيث تبلورت مفهوميًّا فعملت على تحقيق أهدافها وفتح آفاق جديدة لبناء مستقبل أفضل.
حمادي ذويب: كيف تبدو لكم منزلة الفلسفة الألمانية حاليًّا؟
محمد التركي: احتلّت الفلسفة الألمانية منذ القرن الثامن عشر المكانة القصوى في الفكر الغربي الحديث، وهو ما دفعني إلى تعلّمها في لغتها حين قرّرت السفر إلى ألمانيا للدراسة. ففلسفة الأنوار مثلاً بدأت مع المفكّرين الفرنسيين أمثال مونتسكيو وفولتير وروسّو، ولكنها تبلورت مع إمانويل كانط الذي ذكرته سابقًا ومشروعه النقدي الكامل الذي ضمّ أيضًا إلى جانب مؤلّفاته الكبرى نصّه الشهير "ما هي الأنوار؟" حيث حدّد فيه هذا المفهوم بالقول: "الأنوار هي خروج الإنسان من القصور الذي هو مسؤول عنه، والذي يعني عجزه عن استعمال عقله دون إرشاد الغير". ثمّ ظهرت فيما بعد الأنساق الفلسفية المختلفة مثل "المثالية" و"الماركسية" و"التاريخانية" في خضمّ التحوّلات الاجتماعية والسياسية التي عاشتها ألمانيا خلال القرنين الأخيرين ومن بعدها الفينومينولوجيا وفلسفة الوجود والمدرسة النقدية. كلّ هذه الحركات الفلسفية جاءت إمّا ردًّا على التغيّرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أو تنظيرًا لما يمكن فعله بالمعنى اليوتوبي للكلمة. وهو ما يمكن تلخيصه في كلّ من جملة هيغل التي تقول بأنّ "الفلسفة هي بمثابة بومة مينرفا التي تبدأ تحليقها في المساء بعد انتهاء العمل الذي أنجز في النهار"، وقول أرنست بلوخ، فيلسوف اليوتوبيا ومبدأ الأمل في القرن الماضي: "على الفلسفة أن تكون ضمير الغد وانحيازًا للمستقبل، كما يتحتّم عليها معرفة الأمل وإلاّ فستفقد كلّ معرفة". فبين هذين القطبين تتحرّك الفلسفة ساعية إلى تشخيص الواقع وتجاوزه نحو مستقبل أفضل متبنّية في ذلك تحديد مفاهيمه وسبر أغواره، وهو العمل الذي كانت ومازالت الفلسفة تقوم به في ألمانيا، خاصّة الآن من خلال المدرسة النقدية التواصلية بفرانكفورت التي يقودها المفكّر الكبير يورغن هابرماس. فهذا الأخير واصل المشروع النقدي الكانطي وذكّاه بما استلهمه من أدوات وأفكار من المدرسة التحليلية الأنغلوسكسونية، سواء في مستوى فلسفة اللغة أو من وجهة نظر البراغماتية الأميركية، ليؤسّس من جديد مشروعًا يتماشى والعقل التواصلي المابعد حداثي الذي يمكن أن يلبّي طلبات العصر ومشاغله. هكذا بقيت الفلسفة الألمانية حيّة، مواكبة للواقع ومحافظة على بعدها النقدي ومستشرفة للمستقبل.
حمادي ذويب: ما موقفك من الفلسفة الإسلامية قديمًا وحديثًا؟
محمد التركي: مثلما كان الحديث عن الفلسفات الأخرى فإنّ الفلسفة العربية الإسلامية نشأت في وضع تاريخي معيّن وعبّرت عن مسائل خاصّة بالأمّة الإسلامية في حال تطوّر حضارتها وانفتاحها على شعوب أخرى كما ورد في الآية القرآنية "يا أيّها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم". وقد عبّر الفيلسوف المغربي محمّد عابد الجابري عن دور الفلسفة الإسلامية في مرحلة نشأتها وتكوينها أحسن تعبير حين بيّن في كتابه "نحن والتراث" كيف نقرأ التراث الفلسفي العربي الإسلامي ونتعامل معه معرفيًّا وأيديولوجيًّا. فمن واجبنا أن نهتمّ به كتراث فكري تاريخي تشكّل في إطار السّجال الذي دار آنذاك حول "علاقة العقل بالنقل" وكيفية الانفتاح على الثقافات الأخرى كالفلسفة اليونانية والتراث الشرقي الفارسي والهندي. فكانت النتيجة أن استوعبت هذه الفلسفة الكثير من عناصر التراث الفلسفي اليوناني ووظّفته لأغراضها المعرفية والأيديولوجية وقامت بتأسيس أنساق تنسجم مع الوضع السياسي والاجتماعي القائم حينئذ، خاصّة بعد قيام الخلافة العبّاسية وهيمنة الفكر الاعتزالي على المشرفين على السّلطة. ففلسفة الفارابي مثلاً ومشروعه الفلسفي الجامع بين رأيي الحكيمين أفلاطون وأرسطو والتفكير في تشييد "المدينة الفاضلة" إنّما يدلّان على الهاجس الذي كان ينتاب هذا المفكّر البارع في كيفية الربط على أحسن وجه بين النظام الكوسمولوجي المتماسك والنظام السياسي الرشيد.
من خلال قراءتنا للتراث يمكننا حقًّا أن نستخلص العبرة في فهم واقعنا الحالي، لكن ليس لإعادة الماضي كما يرغب السلفيّون، وإنّما لاستشراف المستقبل من منطلق معرفي جديد يدخل هو الآخر في حوار تثاقفي مع الحضارات المواكبة لنا كما فعل فلاسفتنا القدامى مع الثقافات السابقة لهم. وهذا العمل النظري يفترض تجاوز الثنائيات التي تحاصر حاليًّا فكرنا مثل ثنائية "الهوية والاختلاف"، "الأنا والآخر"، "التقليد والحداثة"، "الأصالة والمعاصرة"، "المقدّس والمدنّس"، "الاستشراق والاستغراب" إلخ، ثمّ السعي لتأسيس مفاهيم بديلة تستقطب المشاريع والأفكار الأخرى وتدمجها في عملية الخلق والإبداع بعد أن تستوفيها تفكيكًا ونظرًا وتمحيصًا ونقدًا.
فمنذ النهضة العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وإلى حدّ الآن ما زال الفكر الفلسفي العربي الإسلامي يخوض الصراع الذي حاول ابن رشد في العصر الوسيط أن يبتّ فيه بوصفه فقيهًا وفيلسوفًا في كتابه "فصل المقال"، حيث حدّد فيه لكلّ من الحكمة والشريعة مجال بحثهما وفصل بينهما منهجيًّا ومرجعيًّا. غير أنّ السجال الرشدي أعيد ترويجه وقراءته من دون أن يقع نقده وتجاوزه، وكأنّنا ما زلنا نعيش في العصر الوسيط، بل أخذ منذ عودة المقدّس بقوّة ثوبًا أيديولوجيًّا جديدًا يتمثّل في الصّراع بين النزعتين الدينية والعلمانية. ألم يحن الوقت لتخطّي كلّ أنواع السلفيات المعرفية والأيديولوجية والنظر إلى الواقع الاجتماعي والسياسي بأعين القرن الواحد والعشرين، قرن المعلوماتية والعولمة والتواصل المعرفي وحقوق الإنسان، عوض التنازع الديني والقبلي وحتى العشائري؟ كيف يمكن للفلسفة أن تضطلع بمهمّتها وهي غائبة كليًّا في المدارس والجامعات في العديد من الدول العربية؟
يمكن القول إنّ حضور الفلسفة منذ أكثر من قرن في بعض الدّول العربية قد ساهم بالتأكيد في إعادة قراءة التراث الفلسفي العربي الإسلامي. وهنا لا بدّ من التنويه بما قام به المستشرقون الألمان من جهد في عملية تحقيق للمخطوطات الفلسفية ونشرها كـ"فصل المقال" لابن رشد أو "آراء أهل المدينة الفاضلة" و"السياسة المدنية" للفارابي وغيرها من المؤلّفات الثمينة التي اختفت لقرون من السّاحة الفكرية العربية والإسلامية ولم تظهر من جديد إلاّ في غضون القرن التاسع عشر على أيدي المستشرقين. هذه القراءة اتخذت توجّهات عدّة، سلفية كانت أم ليبرالية أو تقدّمية، وكان لها أثر كبير في القرّاء عامّة. إلى جانب ذلك حظيت التيارات الفلسفية الغربية بجانب لا بأس به من الاهتمام بعد انتشار العديد من المؤلفات المترجمة إلى العربية أو استيعابها مباشرة من الأصل، خاصّة من اللغتين الفرنسية والانجليزية. فأفرزت في الجامعات العربية ما يشابهها من مذاهب كالمثالية والماركسية والوضعية والظاهراتية والبنيوية. غير أنّ الحركة الفلسفية في العالم العربي ما زالت تتدحرج بين القطبين: "الأصيل والحديث" أو "الموروث والوافد" فتتماهى مع هذا أو ذاك حسب التأثير العام والأيديولوجيا السياسية ولم تصل إلى حدّ الإبداع وتأسيس النسق الفلسفي الذي يعكس الواقع المعيش ويلبّي الطلب للإجابة على مشاكل الشعوب وتطلعاتها. لذلك ما زالت هذه الحركة تعيش أزمة تموقعها في العالم وتموضعها معرفيًّا ولم تنته مرحلة المخاض التي تمرّ بها. وعسى أن تكون النتيجة نقلة نوعيّة في مسار البحث الفلسفي.
حمادي ذويب: كيف ترى صلة الدين بالفلسفة وبالمجتمع؟
محمد التركي: إذا ما عدنا إلى الفيلسوف النابغة إمانويل كانط وكتابه "الدين في حدود العقل" فإنّنا سنجد ردًّا واضحًا ومقنعًا على طبيعة هذه العلاقة بين الدين والفلسفة، إذ حاول هو أن يبيّن أنّ البراهين العقلية التي تقدّم عادة من طرف اللاهوت لإثبات وجود الله كالبرهان الكوسمولوجي أو البرهان الوجودي (الأنطولوجي) أو غيرها يمكن دحضها من وجهة نظر نقدية بما أنّ العكس هو أيضًا ممكن. فالبحث في وجود الله وخلود النفس والحرّية يتجاوز حدود الظواهر، ولذلك لا تصمد الأدلّة المقدّمة من وجهة العقل المحض لإثباتها أو نفيها، وهو ما دفع كانط لوضع هذه المسائل في مجال العقل العملي وميتافيزيقا الأخلاق حيث يمكن الخوض فيها من منظور الفعل الأخلاقي النابع عن الواجب في الذات والخير الأسمى. ومثل هذه الأعمال الفلسفية التي حاولت أن تحدّد طبيعة العلاقة بين الدين والفلسفة والتي تلتها دراسات أخرى كالتي عرضها لودفيغ فويرباخ حول "ماهية المسيحية" في القرن التاسع عشر ساهمت كلّها في توضيح الصورة بين الدين والمجتمع وكذلك بين الدين والدولة، وهو ما أدّى في آخر المطاف إلى الفصل بين المجال الرّوحي والمجال المدني، مع العلم أنّه لم يحصل بصفة قطعية كما يروّج له عادة.
أمّا من وجهة الفكر الفلسفي العربي الإسلامي، فإنّ ابن رشد قد تعرّض لهذه العلاقة في "فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال" وأصدر حكمه فيها كما سبق أن ذكرت. وقد سعت الرشدية العربية منذ أكثر من قرن إلى العودة إلى ابن رشد، ليس فقط لإحياء تراثه، وإنّما للاقتداء به أيضًا في تأسيس مشروع العقلانية الحديث. وما السجال الذي حصل في بداية القرن الماضي بين الفقيه محمّد عبده وفرح أنطون حول كيفية قراءة ابن رشد إلاّ دليل على التمزق الفكري الذي كان سائدًا آنذاك، ولكنّه أيضا شاهد على الحركية الفكرية وعلى الجوّ المتسامح الذي كان مهيمنًا في ذلك العهد بحيث لم تحصل عملية تنديد أو تكفير كما جرى سابقًا مع الغزالي إزاء الفلاسفة، وهو ما دفع ابن رشد للردّ عليه، أو كما يجري الآن من أعلى بعض المنابر. فإشكالية العلاقة بين الفلسفة والدين ما زالت في قلب السجال الفكري في الوطن العربي والعالم الإسلامي على الرغم من ظهور مسائل أخرى قد أفرزها تأثير الفلسفة الغربية في أقطاب الفكر الفلسفي في هذه الربوع، بل عادت بقوّة في العقود الأخيرة مع قراءة التراث الفلسفي العربي الإسلامي والتأثر بفلسفة "الهوية والاختلاف" التي أنتجها خطاب ما بعد الحداثة. وما حدث بعد "الربيع العربي" زاد الطين بلّة حيث أصبحت هذه الإشكالية في مقدّمة المسائل وهيمنت على السجال الفلسفي عامّة.
حمادي ذويب: هل تعتبر أنّ تجديد الفكر الإسلامي مرتبط بإحياء مقاصد الشريعة أم إنّ البديل في نظرك هو القيم والحقوق الحديثة؟
محمد التركي: يبدو لي أنّ السؤال يبقى محصورًا في دائرة الثنائيات التي تحدّثت عنها سابقًا والمتمثلة في أنّ الحلّ هو "إمّا... وإمّا"، والذي يكرّس عملية إقصاء النقيض وليس تجاوز التناقضات نحو تركيبة خلّاقة تجمع بين العديد من الإمكانيات المحتملة. أعود إلى الجواب بما قاله الفيلسوف العربي "الكندي" في بداية نشأة الفلسفة الإسلامية وما أعاده ابن رشد فيما بعد على مسامع القرّاء آنذاك: "يجب علينا أن نستعين على ما نحن بسبيله بما قاله من تقدّمنا في ذلك، سواء كان ذلك الغير مشاركًا لنا أو غير مشارك في الملّة". هذا يعني أنّه يستوجب علينا النظر في القضايا الفلسفية التي تهمّنا بالاعتماد على مفاهيم متعدّدة وربّما أيضا متداخلة ثقافيًّا وليس الاستناد إلى مقاصد الشريعة أو القيم الحديثة فحسب. لننظر مثلاً إلى الفكر الفلسفي الياباني المعاصر الذي تأثر بالفكر الغربي، وخصوصًا بالأنطولوجيا الهيدغرية. هل فقد من أصالته شيئًا؟ كلّا. إنّه استفاد من الرافد الفلسفي الغربي وطوّره حسب مقولاته واحتياجاته. لماذا لا نقوم نحن أيضا بمثل هذه التجربة التثاقفية الإبداعية التي سبق أن تناولناها في المرحلة الأولى من الفكر الفلسفي العربي الإسلامي، ونجحنا من خلالها في إرساء خطاب معرفي يستجيب لحاجاتنا؟ علينا اليوم أن نعمل على ترسيخ القيم الكونية وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان بتبنّي الاجتهاد ومراجعة الأصول الفقهية التي لا تلبّي مقتضيات المعاصرة. وابن رشد كان من بين الذين كرّسوا التأويل الفقهي والفلسفي. وقد طالبتم أنتم أيضًا في أحد مؤلفاتكم بمراجعة لمفهوم الإجماع، وناديتم بـ"تجديد أصول الفقه الإسلامي" حتّى تستجيب لقضايا اجتماعية وسياسية راهنة، وهو ما يستوجب القيام به في العديد من المجالات المعرفية. فمشروع الجابري النقدي الذي استعان هو الآخر بالمنهجين البنيوي والتفكيكي لنقد "العقل العربي" سار في الاتجاه الصحيح على الرغم من الانزلاق الأيديولوجي. وكذلك الحال بالنسبة إلى محمّد أركون. ولكن بعد ثورات "الربيع العربي" تغيّرت الأوضاع، ولا بدّ من إعادة النظر فلسفيًّا في الواقع الجديد وما يتضمّنه من تحديات. ربّما نحن اليوم في حاجة أكيدة إلى "أورغنون عربي" جديد نستشرف به المستقبل كما يذهب إلى ذلك المفكّر المصري مصطفى النشار!
حمادي ذويب: كيف تقيّم ما حصل في تونس وهل يمكن مقارنة التجربة السياسية التونسية في مرحلة ما بعد الثورة بتجارب الدول العربية الأخرى؟
محمد التركي: بعد مرور أربع سنوات عسيرة، ختمت تونس أخيرًا المرحلة االانتقالية ودخلت في مستهلّ هذه السنة فترة تاريخية جديدة لقّبت بمرحلة "الجمهورية الثانية". وبهذا التخطّي نجحت تونس حقًّا في وضع دستور جديد تبنّى الفصل بين السلط والتداول السلمي على السلطة بصفة شفّافة وديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان. من هذا المنظور انفردت تونس بفضل مؤسّساتها وجمعياتها وأحزابها وكذلك بفضل حركات المجتمع المدني في تحقيق المسار الديمقراطي والخروج من الأزمة السياسية التي عاشتها منذ ثورة 14 جانفي 2011 والتي كادت تدفع بها إلى المجهول. فلا شكّ أنّ تونس أصبحت اليوم البلد الرمز لتكريس مبادئ الديمقراطية في الوطن العربي ومثالاً يقتدى به في الألفية الثانية. لكن المخاطر التي تهدّد هذه الولادة الجديدة عديدة ولا بدّ من مراصدتها والتغلّب عليها. هذه المخاطر ليست داخلية ووليدة الثورة فحسب، بل إنّ جذورها عميقة تعود في جزء منها إلى السياسة الاقتصادية وما انجرّ عنها من تفاقم البطالة، خاصّة لدى الشباب، والفوارق التنمويّة بين الجهات والفساد داخل عدد من المؤسّسات، وفي الجزء الآخر إلى العوامل الخارجية بعد اندلاع الثورات في الدّول العربية المجاورة وانتشار التطرّف الديني والإرهاب اللذين وجدا أرضيّة خصبة لتقبلهما.
إنّ الجهود الأمنية الحالية للتصدّي إلى الإرهاب ضرورية لإعادة الأمن والاستقرار في البلاد، لكنّها غير كافية لأنّ التحديات الاقتصادية جسيمة وتفترض حلولاً سريعة لتحريك عجلة الاقتصاد واستقطاب الشباب العاطل عن العمل حتّى لا يفقد الأمل وينزلق في ثنايا التطرّف الديني والإرهاب.
فالتجربة التونسية بقيت إلى حدّ الآن فريدة، ولا يمكن مقارنتها بالتجارب الأخرى التي حصلت في الدّول العربية بعد الثورة لأنّ الظروف التي أفرزتها مغايرة تمامًا وكذلك القوى الداخلية والخارجية التي تقف وراءها. وربّما ساعد الحظ التجربة التونسية لأنّها باغتت العالم ولم يكن لها أثر مباشر في المصالح والموازنات الإقليمية والعالمية. فربّ ضارّة نافعة، وهو ما حدث مع الثورة التونسية.