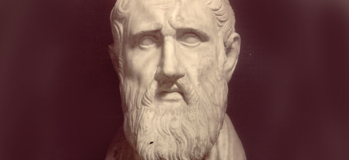محدّدات القراءة العلميّة للوجود
فئة : مقالات

محدّدات القراءة العلميّة للوجود
ما هي المسلّمة الفلسفية التي تقوم عليها الممارسة العلميّة؟ يُحدّد الفلاسفة المدلول الغائي للعلم في كونه نشاطاً عقلياً يستهدف فهم الطبيعة. وبتحديدهم هذا يتضح أنّ التفكير العلمي يرتكز ابتداء على فكرة مبدئية مسبقة تتمثل في الاعتقاد بقابلية الطبيعة للفهم والعقلنة، وإلا ما جعلها العلم موضوعاً لعملية الفهم والتعقيل. وهذا ما يصطلح عليه فلسفياً بمسلّمة "محايثة العقل للوجود"؛ أي أنّ الوجود الطبيعي منتظم على نحو معقول وقابل من ثمّ للتفسير .
إنّ هذه المسلّمة الثاوية داخل العقل العلمي هي منطلق مبدئي للممارسة العلميّة؛ وبذلك يستوي العلم مع غيره من أنماط التفكير في احتوائه على مسلّمات غير مبرهنة، حيث تتخذ منطلقات للبرهنة على غيرها لا على ذاتها. وهذا ما نجد توكيده في النظرية المنطقية، مع كورت غودل، حين بيانه استحالة أن يبرهن نسق معرفي على جميع قضاياه؛ أي لا بُدّ للأنساق المعرفية من أن تحتوي على مسلّمات ابتدائية غير مبرهنة، تكون منطلقاً لها.
كيف يقارب العلم الوجود الطبيعي هذا الذي كان لا بُدّ له حتماً من التسليم بمعقوليته؟ وما هي المحدّدات التي اشتغل بها في مقاربة الوجود؟
إنّ الطبيعة مجموعة أشياء وظواهر محكومة بالصيرورة والحركة، وللإمساك عقلياً بهذا الوجود الطبيعي، كان لا بُدّ للعلم من أن يصطنع أداوت ووسائل لتمكينه من إدراك الكون. ومن بين أهم هذه الوسائل المفاهيم: فامتداد الأشياء والظواهر يقاربه العلم بمفهوم المكان؛ وصيرورة الوجود؛ أي حراكه، يقاربه بمفهوم الزمان... ثم إنّ تتالي الظواهر واحدة تلو أخرى جعل العلم يصطنع مفهوم العلاقة السببية/الحتمية لعقلنة هذه الصيرورة. وعندما يضع علاقة سببية يحرص العلم على صياغتها رياضياً، حيث ينزع العلم الحديث نحو تكميم الظواهر، بناء على اعتقاده بأنّ "الكون مكتوب بلغة رياضية" كما يقول جاليليو .
إنّ العلم الغربي، منذ بدء انطلاقته الفعلية في القرن السابع عشر مستفيداً من الرصيد الثقافي العربي، قام على هذا التصور السابق إيضاحه؛ أي انتظام الطبيعة وقابليتها للصياغة والتكميم الرياضيين؛ لأنها خاضعة لقوانين حتمية. لكنّ المستجدات التي انبجست في بداية القرن العشرين خفّفت من غلواء هذا التصور الحتمي للوجود الطبيعي، وأدخلت معطى جديداً لا ينتظم وفق علاقة الحتمية، إذ تبيّن أنّ الوجود غير قابل للاستدخال بكل ظواهره ومجالاته ضمن هذه الأطر والمقولات الذهنية التي يعتمدها الوعي العلمي.
فالمجال ما تحت الذّري مثلاً ليس مجال سببية وحتمية، كما هو الشأن في المجال الفيزيائي المرئي، لذا نجد هيزنبرغ يقترح قانون "اللاتحديد"، أو "عدم التعيين"، كمدخل منهجي ضروري لفهم البنية الداخلية للذرّة. وهذا ما فرض من ناحية أخرى اعتماد المقاربة الإحصائية الاحتمالية .
والواقع أنه قبل هيزنبرغ؛ أي بدءاً من أبحاث ماكس بلانك، لم يعد يكفي لدراسة الظاهرة الكونية الاعتماد على نيوتن وماكسويل، بل اتضحت ضرورة الانتقال إلى نموذج معرفي جديد يجاوز مفاهيم السببية و الحتمية.
وبالنظر إلى الأبحاث الدارسة لإشكالية فيزياء الكم، نرى أنّ بعض التأويلات المتفلسفة التي أطلقها الفيزيائيون تنزع نحو القول بأنّ الصدفة هي وجودية وليست معرفية؛ بمعنى أنّ الوجود ما تحت الذرّي وجود خارق للانتظام السببي، وعدم كشف أسباب وأشكال انتظامه ليس نتاج ضعف وسائلنا في المعرفة، بل نتاج طبيعة الوجود ما تحت الذرّي ذاته.
لكني أميل إلى الاعتقاد بأنّ هذا التصور الذي يرجع الصدفة إلى الوجود يفتقر إلى الاستدلال؛ فهو مجرد افتراض. وهنا أستحضر جاك هارتونك J.Harthong أحد كبار المتخصصين في حساب الاحتمال، حيث يميّز بين ما يسميه بالصدفة الموضوعية الهشة، والصدفة الموضوعية الصلبة؛ فالأولى تتحصّل بسبب ضعف أدوات المعرفة، أمّا الثانية فهي صدفة أنطلوجية حاصلة بسبب طبيعة الوجود ذاته الذي تنتفي منه السببية. وفي سياق بحثه في هذين النوعين من المداخل المنهجية الدارسة لإشكالية الصدفة في الوجود الطبيعي، ينتهي إلى أنّ الأمر غير قابل قطعاً للبتّ والتوكيد. فلا يستطيع العلم أن يجزم بأنّ الصدفة ما هي إلا نتاج ضعف أدوات المعرفة، كما لا يستطيع الجزم بأنها راجعة إلى طبيعة الوجود ذاته، بل كلّ ما هو ممكن هو اعتبار أحد الفرضين كمُسَلَّمة عقليّة.
وفي هذا توكيد لنسبيّة القدرة المعرفيّة البشريّة، ومحدوديّة إدراكها للوجود.