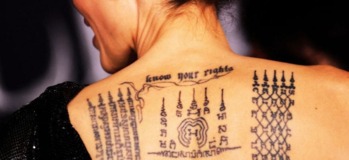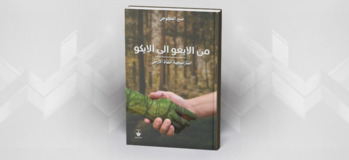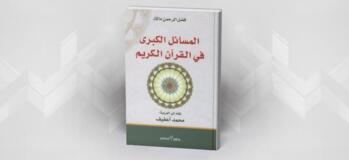التفكير في الثقافة براغماتيا
فئة : أبحاث محكمة

التفكير في الثقافة براغماتيا
"الثقافة فكرة تتعرض للشبهات بعمق ...غير أن المرء لا يستطيع العمل من دونها"
جيمس كليفورد
تقديم:
أضحت لفظة "ثقافة" إحدى الكلمات الأكثر رواجًا خلال القرنين الأخيرين، يستعملها الإنسان العادي في لغته اليومية البسيطة، كما يستعملها الباحث في أبحاثه ومقالاته، وكذلك تبرز لنا عند المتخصصين والأكاديميين في خطاباتهم العلمية والأكاديمية؛ إذ نجدها متداولة في حقول معرفية مختلفة كالأنثربولوجيا وعلم الاجتماع وغيرهما...، بل وفي سياقات متباينة، ما جعلها تكتسب حمولات دلالية عديدة شأنها في ذلك شأن جميع المصطلحات والمفاهيم التي تهاجر من حقل معرفي إلى آخر أو أكثر. وهذا ما يمكن أن يفسر تعدد وكذلك اختلاف التعريفات التي أعطيت للفظة «ثقافة»، والتي فاقت مائة وستين تعريفا حسب ما أحصاه كل من «كروبير وكلوكهون» سنة1952م.
من المدهش فعلا أن نجد لفظة تقبل كل هذه التعريفات، وسبب الدهشة يزداد حين نعلم أن لفظة "ثقافة" حديثة الاستعمال نسبيًّا -وفق المفهوم الذي أصبحت تكتسيه اليوم-، إذ لم تستخدم بهذا الشكل إلا في القرن الثامن عشر. فما المعاني التي كانت تنطوي عليها هذه اللفظة؟ وهل هذه المدة الزمنية تعد كافية حتى تطور لفظة "الثقافة" نفسها تاريخيا على هذا النحو المفرط؟ أم إننا أمام كلمة حربائية تلبس لكل حال لبوسا مختلفا؟ ما جعل «إدجار موران» يعتبر أن "الثقافة بداهة خاطئة، كلمة تبدو وكأنها كلمة ثابتة، جازمة، والحال أنها كلمة فخ، خاوية، منومة، ملغمة، خائنة... الواقع أن مفهوم الثقافة ليس أقل غموضا وتشككا وتعددا في علوم الإنسان منه في التعبير اليومي".[1]
1. في مفهوم الثقافة:
يرى «ريموند ويليامز» أن كلمة ثقافة هي إحدى الكلمات الأكثر تعقيدًا في اللغة الإنجليزية للدرجة التي جعلته يقول: "لا أعرف كم مرة تمنيت لو أنني لم أسمع بهذه الكلمة اللعينة"[2]، وهذا يؤكد أن تحديد مدلول لفظة ثقافة ليس سهلا كما قد نتوهم، إذ يفرض علينا إعادة النظر في المناهج المتبعة في تحليلها وتأويلها، كما يحتم علينا العودة إلى الوراء، قصد تتبع نشأة وتطور المفهوم، لعلنا نستطيع الاقتراب من معناه، أو على الأقل تفسير سبب الاختلاف حوله وتعدد التعريفات المقدمة له.
أ. الثقافة مقابل الطبيعة
يضع «كلود ليفي شتراوس» الثقافة كمقابل للطبيعة، هذا الرأي الذي ينم عن الفكرة الأساسية التي قد تشكل جوهر الثقافة؛ بمعنى أن الثقافة لا علاقة لها بما تصنعه الطبيعة من تلقاء نفسها وفق القوانين التي تسيرها من جهة أولى. أما من جهة ثانية، فالثقافة تقف كمقابل للفطرة والغريزة الإنسانيتين، وفي السياق نفسه يرى «كانط» أن تعارض الثقافة والطبيعة يتيح لنا دراسة ما تفعله الطبيعة بالإنسان، ويجب أن يدرس فسيولوجيا، في حين أن ما يفعله الإنسان ككائن يمتلك حرية وإرادة فينبغي أن يدرس براغماتيا[3]. فإذا ما أخذنا برأي كانط، فإن دراستنا للثقافة يجب أن ترتكز على نقطتين أساسيتين: أولا أنه لا وجود لحقيقة ابتدائية تفرض نفسها على الواقع، وثانيا لا بد من التركيز على الجانب النفعي أو الوظيفي للثقافة.
تحيل الثقافة على كل ما يكتسبه الإنسان داخل مجتمعه بهدف السيطرة على نفسه والتغلب على الطبيعة، "فليس هناك ثقافة إلا بتجاوز الطبيعة"[4]. وهذا المعنى الذي يبرز لنا هنا للثقافة هو ما نجده في معنى الجذر (ث. ق. ف)، الذي يحمل في طياته معنى الظفر بالشيء، [5] فالإنسان عندما يثقف الطبيعة، فإنما يغلبها ويظفر بها مسيطرًا عليها، ونلاحظ ذات المعنى ينطوي عليه الجذر (ح. ر. ث) أيضا؛ إذ يرد بمعنى أن يهزل الشيء كما في قول الأنصار ردًّا عن سؤال معاوية: فما فعلت نواضحكم؟ فأجابوا: حرثناها يوم بدر؛ أي أنهكناها وأضعفناها.
يسعى الإنسان إلى حرث الطبيعة بمعنى إضعافها وبالتالي كسبها، وهنا تحديدًا يلوح لنا معنى الكسب المتضمن في الجذر (ح. ر. ث). [6] هذا المعنى الذي ينسجم مع طرح «دونيس كوش» حين ذهب إلى أن لفظة ثقافة ظهرت أواخر القرن الثالث عشر "للإشارة إلى قسمة الأرض المحروثة"[7]، والحقيقة أن معنى ثقافة المراد هنا هو قسمة مكسب وغلة الأرض، لا قسمة الأرض نفسها.
وفق هذا الطرح، يمكن القول إن الثقافة هي ظاهرة إنسانية واعية ومكتسبة؛ أي إنها غير محكومة بالعوامل الوراثية الجينية والبيولوجية، ولا بالغرائز الفطرية، كما في عالم الحيوان؛ لأن كل سلوكيات الحيوانات مدفوعة بغرائزها الفطرية فلذلك لا ثقافة لها، بل إن الثقافة هي المسؤولة عن ضبط هذه الغرائز الفطرية وتقويمها، وهو ما نلاحظه أيضا في معنى الجذر (ث. ق. ف) الذي يتضمن معنى تقويم ودرء اعوجاج الشيء ومنه الثقاف، وهو الآلة المستخدمة لإصلاح اعوجاج الرماح وغيرها حسب ما أورده ابن فارس في مقاييس اللغة.
إذا كانت "لفظة ثقافة تغطي التعارض طبيعة/ثقافة المشترك للعلوم الإنسانية خلال القرن التاسع عشر"[8]، فإن هذا يفصح عن طبيعتها المكتسبة بالتلقين والتعلم الذي تم على مراحل رافقت تطور المجتمعات الإنسانية من مرحلة الثقافات البسيطة إلى الأكثر تعقيدًا، مهد له طبعا تطور العقل الإنساني ومعه المعرفة البشرية التي أضحت أكثر تجريدا ورمزية على ما كانت عليه في بداياتها. فاعتمادًا على هذه المكتسبات المتراكمة استطاع الإنسان تسخير محيطه الطبيعي والبيئي تبعًا لمصالحه ضمانا لبقائه أولا، وبحثا عن سعادته وتحسين ظروف عيشه ثانيا.
إن وضع الثقافة كمقابل للطبيعة يعني في المقام الأول أن السبب الرئيس لخروج الإنسان من الحالة الطبيعية أو البدائية كان هو تحصنه بالثقافة؛ إذ بفضلها تمكن من السيطرة على نفسه أولا، ثم استطاع التغلب على الطبيعة من حوله، بل وتسخيرها لمصالحه، ووفق احتياجاته. وما حرص الإنسان على تناقل الثقافة من جيل لآخر، مع ضرورة تنميتها وتطويرها إلا اعتراف وإقرار ضمني منه بأهميتها، بل وضرورتها في الحياة، فهي الحصن والملاذ من شر نفسه، ومن أخطار الطبيعة الغامضة بخباياها وأسرارها.
ب. اكتساب الثقافة
كانت الثقافة غالبًا ما توصف بأنها "كيفية التميز لرجل أو لإنسان أو مجتمع"[9]، إذن فلفظة «الثقافة» كما نفهمها ونعيشها اليوم ليست سوى تلك الثقافات التي ننعتها بالبدائية بعد أن خضعت لعدد من التراكمات والتطورات بعدد المجتمعات التي عرفتها الإنسانية، أو لنقل أنها ذلك التراكم الثقافي الذي عرفته الإنسانية، والذي يشمل إلى جانب الرواسب الثقافية المختزنة في الوجدان العميق للجماعات والأفراد، جانبا آخر مازال يؤدي وظيفته بين الأفراد والجماعات، ويحرصون على تناقله بينهم؛ وذلك لأن "الثقافة هي بمثابة إطارات مرجعية تكون منظومات من المعاني والاعتقادات والقيم والنظرات للعالم، وأشكال الحس وأساليب التفكير التي على أساسها تبني المجموعات البشرية، كل واحدة بخصوصيتها، حياتها ووجودها (ومعنى وجودها بالحياة)".[10]
إن الثقافة بهذا المعنى، وكما جاءت عليه أيضا في بعض تعريفاتها هي "ذلك الكل المركب الذي يتألف من كل ما نفكر فيه، أو نقوم بعمله أو نتملكه كأعضاء في مجتمع".[11] هذا التعريف الذي ينم عن كون الثقافة معطيات قد تبقى مختزنة في أعماق الوجدان الانساني، كما أنها قابلة للظهور في السلوك اليومي، لتتحول بذلك إلى نوع من الاتصال عن طريق الرموز التي هي في حقيقتها رسائل ثقافية على حد تعبير «هال».
تأسيسًا على كل ما تقدم، فإن اكتساب الأفراد والجماعات للثقافة جاء على مرحلتين:
- في المرحلة الأولى كان يأتي اكتساب الثقافة عن طريق التعلم المباشر كما في حالة الدفن التي شاهدها الإنسان مشخصة أمامه من طرف الغرابين. أو يأتي نتيجة التعلم عن طريق التجربة والمحاولة كما حدث عندما اكتشف النار أولا، ثم القدرة على ايقادها بعد ذلك والتحكم فيها من خلال وصوله لقانون الاحتكاك. ويأتي كذلك تعلم الإنسان واكتسابه عن طريق المحاكاة، كمحاكاة الحيوانات التي واجهها؛ وذلك من خلال محاولته الحصول على مثيل أو مقابل لوسائلها الدفاعية أو الهجومية، فقامت بذلك محاولاته الأولى بتجسيد أدوات بسيطة من الحجر والخشب والعظام على شكل أنياب ومخالب وقرون...
- أما في المرحلة الثانية، فقد أصبح الإنسان مستعدًّا للتعلم المجرد الخالص؛ إذ بات بمقدوره تلقي واستيعاب المفاهيم المجردة كالقيم والأخلاق مثلا، هذه الاخيرة التي كانت تأتيه عن طريق النذر من السماء قبل مرحلة إرسال الرسل، أو حتى مع بعض الرسل والأنبياء لاحقًا، وربما هذا ما يفسر لنا إلى حد ما طبيعة تلك العلاقة الغريبة التي نجدها بين بعض الثقافات التي نسميها بدائية والسماء، والتي غالبا ما عبروا عنها بالقوى العليا أو الروح العظمى، هاته العلاقة التي وصلتنا اليوم بعد تشوهها على شكل أساطير وخرافات. لتتراكم بعد ذلك المعتقدات والقيم التي اكتسبها الإنسان في مرحلة الرسل والأنبياء.
ج. تطور دلالات الثقافة
يعود أصل كلمة ثقافة إلى اللفظ اللاتيني culte الذي يعني العبادة والتمجيد والإجلال، وهي بذلك تهتم بالتهذيب والتقويم الروحي، أو بعبارة أخرى التهذيب والتقويم العقدي والديني، وهي ظاهرة تبدو جلية في الفكر الإغريقي كما في العصور الوسطى التي سادت فيها الكنيسة بأفكارها ومعتقداتها. أما ما يقابل لفظة culte في الفكر العربي الإسلامي، فهي لفظة فقه التي التصقت واقتصرت على حذق وفهم الأمور الدينية، حتى خيّل إلينا أن ذلك هو الأصل في استخدامها، وأنها تنقل إلى غير ذلك من باب المجاز والاستعارة، ليتم الانتقال بعد ذلك إلى لفظة culture التي تعني "رعاية النباتات والحيوانات حتى نهاية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر"[12]، ثم شملت بعد ذلك عملية التطور البشري. سواء من الناحية المعرفية أو النفسية أو الحس حركية؛ بمعنى أنها تلك العملية العامة من التطور العقلي والروحي والجمالي عند الإنسان.
واضح إذن، أن الثقافة هي لفظة تضم في طياتها مدلولات متعددة، راكمتها عبر رحلتها الطويلة من الاستعمال الديني إلى الاستعمال في الزراعة والمختبرات وارتباطها بنمو النبات والحشرات والفطريات، وصولا إلى عملية التطور والنمو الإنساني، هذا التعدد في الاستعمال هو ما يفسر لنا اختلاف التعريفات التي أعطيت لها، كما يوضح لنا أيضا سر تعدد مكوناتها؛ إذ نجدها تضم المعتقدات والدين والعادات والقيم والأخلاق والفنون والأنظمة المختلفة التي تحكم الفرد داخل جماعته لتصبح بذلك تعني نمط وأسلوب الحياة، وهذا على عكس ما ذهب إليه كل من «كروبر وكلاكهون» اللذين يريان أن "تاريخ مفهوم الثقافة على النحو المستخدم اليوم هو قصة بزوغ فكرة صفيت تدريجيا من جميع مدلولات الكلمة فعلا"[13].
د. الثقافة في الفكر العربي الإسلامي
لا شك أن هذا البعد التراكمي للثقافة يشي بسمة أساسية أخرى تميزها. إنها سمة التطور والتغير عبر الزمان والمكان من مجتمع لآخر، بل وأحيانًا داخل المجتمع نفسه من جيل لآخر. فإذا كان هذا البعد التراكمي والتطوري للثقافة يفسر لنا كيف أن الثقافة الإنسانية ما هي إلا محصلة أو مجموع الثقافات التي عرفتها المجتمعات الإنسانية، لكل مجتمع فيها نصيب، بما أن لكل مجتمع ثقافة خاصة به قد تتشابه أو تتقاطع مع ثقافة غيره، أو قد تختلف كليا عنها. فيحق لنا أن نتساءل إذن عن دور العرب ومدى مساهمتهم في بناء هذا المفهوم المقدم ل "الثقافة"؟
لا أقصد هنا تلك المساهمات الفكرية والفنية والعلمية والأدبية وغيرها من المساهمات التي أثرت المشهد الثقافي الإنساني، فذلك موضوع لا جدال فيه، فلا أحد يستطيع أن ينكر دور العرب والمسلمين في الحفاظ على الفكر العالمي الإنساني وتطويره حين كان المسلمون يسيطرون على جزء كبير من العالم، وحين كانت أوروبا تعيش لقرون عديدة في ظلامها خلال العصور الوسطى. ولكن المقصود هو تلك المساهمة في بناء المفهوم وتشكيله، وهل عرف العرب المسلمون لفظة ومفهوم ثقافة قبل نظرائهم الغربيين؟ أم إنهم انتظروا حتى تصلهم لفظة culture اللاتينية، واقتصر جهدهم على ايجاد مقابل له باللغة العربية، كما يرى ذلك بعض الباحثين الذين يرون أن «سلامة موسى» هو من اقترح هذه الترجمة العربية لتلك اللفظة اللاتينية؟ وهل كانت هذه الترجمة صائبة؟
بالرجوع إلى المعاجم اللغوية العربية، نجد أن ثقافة هي من الجذر (ث ق ف)، وهو كما رأينا سابقا يحيل على معنى تقويم ودرء اعوجاج الشيء، كما تقويم الإنسان، وهو ما يتأكد لنا من خلال البيت الشعري المنسوب لكثير عزة، والذي قال فيه:
ألا إنما يكفي الفتي بعد زيغه من الأود البادي ثقاف المقوم[14]
ويحيل كذلك الجذر "ث ق ف" على معنى الظفر بالشيء، كما في قوله تعالى في الآية 57 من سورة الأنفال: ﴿فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون﴾، والمعنى المراد هنا هو التشريد بهم، إذا غلبتهم في الحرب.
تأتي لفظة ثقافة على وزن فَعالة كشجاعة ونباهة، وهو من الأوزان العربية الصرفة، وقد وردت عند «ابن سلام الجمحي» في كتاب طبقات فحول الشعراء "وللشعر صَناعة وثقافة"[15]، فنلاحظ هنا أن كلمتي صناعة وثقافة جاءتا بفتح الصاد وفتح الثاء على التوالي للدلالة على المعاني والمجردات، كما يشير إلى ذلك «محمود محمد شاكر» شارح كتاب ابن سلام الجمحي؛ إذ يوضح أن كلمة صناعة بالكسر تدل على المحسوسات لا على المعاني، وكذلك هو الحال عموما بالنسبة إلى المصادر على وزن فعالة بكسر الفاء التي تدل على الحرف. وهي بالتالي؛ أي الثقافة، جاءت عند ابن سلام بذلك المعنى الذي نجده في المعاجم اللغوية العربية.
ترد لفظة "ثقافة" عند «ابن خلدون» بمعنى قريب من ذلك المعنى الذي نعرفها به اليوم "فلا تفرق بينهم وبين السوقة من الحضر إلا في الثقافة والشارة"؛[16] لأن ابن خلدون كان يعرض في مقدمته علما جديدا، وصفه قائلا: "وكأن هذا علم مستقل بنفسه. فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماعي الإنساني، وذو مسائل، وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى. وهذا شأن كل علم من العلوم وصفيا كان أو عقليا."[17] إن هذا العلم الجديد الذي يقترحه ابن خلدون، والذي موضوعه العمران البشري والاجتماع الإنساني، هو ما يمكن تسميته اليوم ب علم الثقافة على حد قول «محمد بدوي»، في مقدمة كتاب "تأويل الثقافات". فحين نتمعن عنوان مؤلَّف ابن خلدون نجده (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)، يتضح أنه يتحدث عن علم أوسع وأكبر من علم الاجتماع. إنه علم الأنثروبولوجيا.
كان استعمال العرب المسلمين للفظة ثقافة مطابقا إلى حد ما استعمالنا لها اليوم، وإن كنا نصادف بعض التشويش في المفهوم عند ابن خلدون الذي يستعمل بدرجة أكبر مصطلح العمران البشري والاجتماعي الإنساني للدلالة على مفهوم الثقافة بمعناها الواسع. هذا التشويش الذي سرعان ما يزول حين نرى استخدام ابن خلدون للفظة "الثقافة" في مكان آخر، حيث يقول: "والسبب في ذلك أن العرب كانوا لبداوتهم لم يكونوا أول الأمر مهرة في ثقافته وركوبه، والروم والإفرنجة لممارستهم أحواله ومرباهم في التقلب على أعواده مرنوا عليه وأحكموا الدراية بثقافته"[18]، كما نلاحظ أيضا استخدام ابن خلدون لفظة "ثقافة" مقترنة بلفظين آخرين هما الدراية والممارسة. وسيتضح معنا المغزى من ذلك في الفقرة التي عنوانها بالثقافة ككفاية ممتدة.
2. بين الثقافة والحضارة
إذا كنا قد سجلنا بعض التشويش في مفهوم الثقافة عند «ابن خلدون»، فإننا نلاحظ في المقابل وضوحا تاما في تناوله لمفهوم الحضارة الذي كان مخالفا ومغايرا لمفهوم الثقافة على كل حال؛ إذ يرى "الحضارة إنما هي تفنن في الترف واحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من الطبخ والملابس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل وأحواله"[19]، وهو تعريف يقترب من مفهوم الثقافتين كما عند «تشارلس بيرسي سنو» مثلا، وهي وجهة نظر وإن كانت تشير إلى الثقافة الأدبية والثقافة العلمية، إلا أنها تتغذى من الفكرة التي تميز بين الثقافة المادية التي تضم كل الابتكارات والإبداعات الإنسانية في الفن والأدب والأدوات والآلات والتكنولوجيا، في مقابل الثقافة الروحية التي تضم الدين العقائد والعادات والأخلاق والقيم، وهو ما عبر عنه «توماس مان» قائلا: "الثقافة تعني النواحي الروحية الحقيقية بينما الحضارة تعني سيادة الآلة والتصنيع"[20].
إلى جانب هذا التقسيم للثقافة إلى جزأين؛ أحدهما روحي والثاني مادي، نجد بعض الباحثين الغربيين يصرون على أن الحضارة والثقافة وجهان مختلفان لنفس العملة، أو لنقل بعبارة أخرى أنهما دالان مختلفان ومتمايزان لنفس المدلول، ولعل الباعث وراء ذلك هو كون "الثقافة هي الفكرة العامة في كل تعريف للحضارة تقريبا."[21] فنجدهم بذلك يستعملون لفظة ثقافة للتعبير عن الحضارة، كما يجيزون استعمال لفظة حضارة للدلالة على مفهوم الثقافة، فالثقافة والحضارة عندهم تحيل على المفهوم نفسه، ولا اختلاف بينهما.
لكن برجوعنا إلى المعاجم اللغوية، يتأكد لنا أن معنى المتضمن في الجذر (ح. ض. ر) هو إيراد الشيء ووروده ومشاهدته[22]؛ بمعنى أن الحضارة هي كل ما أنتجه الإنسان وأمكن معاينته ومشاهدته حتى لو لم يكن شيئا ماديا ملموسا كالفنون والأفكار المدونة في الكتب، أو التي ما تزال حاضرة ومتداولة حتى مشافهة، فمفهوم الحضور الآني يمكن أن نلمسه في معنى لفظة الحاضر الذي هو من الجذر (ح. ض. ر)، ولعل ما وصلنا مكتوبا من قانون حمو رابي خير دليل على قيام حضارة في تلك البقعة من العالم ذات يوم.
لا ريب في أن هذا الجانب اللامادي الذي ينصرف إليه المصدر الذي يأتي على وزن فَعالة بفتح الفاء (حَضارة) كما رأينا سلفا يؤكد أن الحضارة ليست فقط تلك الثقافة المادية المحضة، وإنما هي مجموع ما ينتجه الإنسان انطلاقا من ثقافته، فإذا كانت الثقافة مكتسبة فإن الحضارة منتجَة؛ لأن الإنسان ليس كائنا مستهلكا فقط، لكنه أيضا كائن منتج. فالحضارة كما يقول «شبنجلر»: "هي المصير الحتمي للثقافة... نتيجة."[23] إذا كانت الثقافة هي ما يتلقاه ويكتسبه الفرد داخل مجتمعه دون أن يكون له دخل في اختياره، فإن الحضارة هي كل ما ينتجه هذا الفرد داخل هذا المجتمع، وهذا ينسجم إلى حد كبير مع تلك النظرة التي تعتبر أن الحضارة هي كل ما يتم إضافته إلى ثقافة الجماعة.
وبالتالي تؤكد الحضارة على طابعها الاجتماعي الإنساني شأنها شأن الثقافة، لكن الفرق بينهما بالنسبة إلى الفرد والمجتمع هي أن الثقافة تحيل على الماضي والتراث المشترك للجماعة، الذي يكتسب ويلقن، في حين تنصرف الحضارة إلى الأمور الحالية والمستقبلية، التي ينتجها الفرد والمجتمع معا. وعلى هذا الأساس، يمكن أن نقبل الفكرة القائلة إن "الحضارة هي الوجه التقدمي للثقافة."[24] فالحضارة وفق هذا الطرح هي نتاج الثقافة ومحركها وباعثها التطوري في الوقت ذاته؛ وذلك ما حاول «توماس مان» أن يعبر عنه حين قرر أن "الثقافة هي الروح الحقيقية، بينما الحضارة فهي الآلية نفسها."[25] وربما خير مثال نقدمه لتوضيح العلاقة الثلاثية بين الإنسان والثقافة والحضارة هي تمثيل الإنسان بالنحلة التي تتغذى على الرحيق وتنتج العسل. فكذلك الإنسان يستهلك ثقافة مجتمعه ليبدع ويبتكر إنتاجات حضارية مختلفة حسب ما تتيحه له ثقافته وبيئته، بل ووفق ما تتطلبه حاجاته وحاجات مجتمعه.
يرى «داوسن» أن الحضارة نتاج "عملية أصيلة خاصة من الإبداع الثقافي، والتي هي من صنع شعب ما"[26]. وفي المقابل يمكن أن تصبح تلك الحضارة بدورها جزء من ثقافة متطورة يستهلكها جيل جديد على أنها ثقافة بالنسبة إليه لإنتاج حضارة أخرى جديدة، وهكذا دواليك. وهذا ما يؤكده «آيكة» حين يذهب إلى أن "الحضارة درجة من ثقافة متقدمة نوعا ما". [27]
إن مثل الثقافة والحضارة، كما يرى ذلك «رالف لنتون» في كتابه شجرة الحضارة، هو كمثل شجرة البانيان التي تمتد بعض فروعها إلى الأرض لتصبح بدورها جذورا تتفرع عنها فروع أخرى. كما أن القواميس العربية تؤكد على أن الحضر هو خلاف البدو؛ أي إن التحضر يعني وجود الإنتاجات والشواهد التي تؤكد وجود علاقات جديدة نتيجة الحياة الجديدة التي تفرزها الحواضر، فالبدو لا شك لهم ثقافاتهم، لكنهم لم ينتجوا ذلك القدر الكافي من الإنتاجات التي قد تؤثر في ثقافاتهم اللاحقة التي تبقى ساكنة وثابتة، ولعل هذا ما جعل «توينبي» يقول: إن سكان افريقيا لا حضارة لهم.
يظهر جليا إذن، أن الثقافة أو الثقافات التي لا تستطيع تطوير نفسها، ولا يتمكن أصحابها من إنتاج حضارتهم الخاصة، ستكون ثقافة تعيد إنتاج نفسها بالدرجة الأولى، وهي بذلك ثقافة محدودة الفاعلية ومعرضة للزوال لا محالة؛ "لأن فعالية الثقافة تتحدد في مدى امتلاكها –أو قل: امتلاكنا- القدرة على مقاومة القصور الذاتي والاجترار والاستهلاك."[28] وربما في اعتقادنا هذا هو السبب الرئيسي في اندثار بعض الثقافات وانقراضها، لأن الثبات هو صفة يختصها بالله سبحانه دون غيره من الكائنات والمخلوقات، فبالقليل من إمعان النظر في الكون والمخلوقات، سنرى أنه لا شيء أو أحد يبقى على حال واحدة، فالكل متغير متحرك، بما في ذلك الأجرام والنجوم والكواكب.
3. لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة؟
إن الناظر المتمعن في حقيقة الثقافة، بتنوع مظاهرها، وتعدد مكوناتها، يدرك يقينا أن الثقافة نسق متكامل يتشكل من عدة مكونات تأتي التربية والفن في مقدمتها؛ لأنهما يعتبران كذلك مظهرين أو إفرازين من إفرازاتها وإنتاجها، بما أنهما سمتان من سمات الحضارة. فإذا صار بمقدورنا اليوم "تقسيم الثقافة إلى عدد من المظاهر: التربية ومراقبة اجتماعية واقتصاد ونظام معرفي ومعتقدات وأخلاق وطرائق التعبير والإبداع الفني"[29]، فينبغي أن نضع نصب أعيننا أن هذا التقسيم، إنما هو تقسيم إجرائي أو منهجي يساعدنا على تفكيك الثقافة إلى أجزاء صغرى قصد التعامل مع كل جزء على حدة بشكل أفضل.
إن تفتيت الثقافة وتقسيمها يحجب علينا طبيعة العلاقة الجدلية بين مكوناتها، وخصوصا تلك العلاقة المتداخلة بين الفن والثقافة والتربية. فإذا كانت التربية هي ما يسمح بنقل الثقافة من جيل لآخر، فإن عملية النقل هذه لا يمكن أن تتم دون فن ومخيلة تساعد الإنسان على تجريد مكونات الثقافة بشكل سليم. وعليه تظهر عمليات التعلم والتعليم والتربية والتنشئة الاجتماعية والتنشئة الثقافية على أنها عمليات تهدف إلى امتصاص الفرد للثقافة واكتسابها، حيث تبدو هنا كل هذه العمليات وعلى اختلاف مستوياتها ودرجاتها مجرد وسائل لبلوغ هدف وغاية محددة وهي عملية «التثقيف»، التي تميز الإنسان عن غيره من الكائنات، طالما أن الإنسان هو الكائن الوحيد في هذا العالم الذي يمكن وصفه بالكائن الثقافي.
تأسيسًا على ما سبق، يتضح أن التربية والفن هما مفهومان لا يمكن إغفالهما أثناء الحديث عن الثقافة، فهما معا ما يمكن أن يفسر لنا سر تفرد الإنسان بالثقافة، انطلاقا من عملية الاكتساب إلى عملية التنمية والتطوير مرورا بعملية النقل الثقافي؛ ذلك أن الإنسان يسعى ويجتهد في نقل هذه الثقافة عن طريق التربية والتنشئة الاجتماعية اللتين يعد الفن أحد اهم وسائلهما.
أ. الفن مفتاح اكتساب الثقافة
يرى كل من «كروبر وكلوكهون» أن "الثقافة تجريد".[30] يبدو هذا الرأي سديدا وفق الزاوية التي ينظر من خلالها الأنثربولوجي للسلوك في علاقته بالثقافة، لكن الزاوية التي ينظر من خلالها الإنسان العادي، فإن السلوك هو محاكاة للثقافة وتجسيد لها؛ بمعنى أن سلوك الإنسان هو تعبير عن ثقافته، وعندما نقول محاكاة فهذا يُظهر بشكل واضح ضرورة وأهمية الفن في بناء الثقافات واكتسابها كما في تنميتها وتطويرها انطلاقا من المعنى الواسع الذي تحيل عليه لفظة فن، حيث يمكن النظر إليه على أنه:
- مفهوم مجرد بطبيعته؛ لأننا لا نصادف شيئا على أرض الواقع اسمه فن. فالفن إذن ملكة إنسانية توجد عند عمرو كما عند زيد. أما الفنون أو الاعمال الفنية فهي الإنجازات والأداءات التي يتم عرضها على أرض الواقع عن طريق المحاكاة، فالفنون بذلك تجسيد لما يقع داخل مملكة الخيال، وهي بهذا الشكل تقابل التجريد.
- ملكة تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات والكائنات، فالفن هو ما يجعل من الإنسان إنسانا كاملا، فإذا كان الإنسان كائنا ميتافيزيقيا، فذلك يرجع بالأساس إلى امتلاكه هذه الملكة التي تمكنه من التجريد والمحاكاة على حد سواء. وهي الملكة ذاتها التي تجعل منه كائنا ثقافيا.
إن وضع الثقافة كمقابل للطبيعة يعني دون شك جعلها مقابلا للتوحش والغرائز الفطرية، مما يدل على طابع الإبداع والابتكار في الحياة اليومية الإنسانية؛ فالإنسان البدائي مثلا كان يتغذى على ما يصطاده، أو توفره له الطبيعة دون أن يتصرف فيه، لكنه بعد ذلك أصبح يطهو طعامه كما أضاف عليه البهارات والتوابل وغيرها، ولم يكتف بذلك، بل اجتهد في صنع الأطباق والكؤوس وغيرها من أدوات المطبخ حتى أصبح الطبخ فنا كما نعلم، وما يقال عن الطبخ يقال كذلك عن الأفرشة والأثاث المنزلي الذي أصبح يطلق عليه اليوم فن الديكور، بل وينصرف كذلك إلى مجال اللباس وفن الأزياء، وغير ذلك من الأنشطة اليومية التي يمارسها الإنسان في حياته العادية
يسعى الإنسان إلى الكمال عبر اكتساب الثقافة، وفي سعيه هذا لا مناص له عن الفن بوصفه ما يجعل الإنسان كاملا وفق وجهة نظر «غوته» الذي يقول: "إن من لا يحب الموسيقى لا يستأهل اسم الإنسان، ومن أحبها كان نصف إنسان. أما من يمارسها، فهو الإنسان الكامل"[31] فإذا كانت الثقافة هي ما يحدد رؤية الفرد ومعه المجتمع لذاته وللوجود بأسره، فإن السبيل المثالي المتاح أمامه هو الفن؛ ذلك "أن أيسر سبل الوجود كامنة في الفن"[32]. وكمثال على ذلك فإن الإنسان لم يستطع الوصول إلى تاريخ الأمم السابقة وتبين معالم ثقافاتها إلا من خلال الفن وما خلفته تلك الأمم الغابرة من آثار فنية متمثلة في الرسوم التي وجدت على جدران الكهوف، أو البناءات التي بقيت شاهدة على قيام حضارات عظيمة، إضافة إلى اللقى التي وجدت في أماكن متعددة.
ب. التربية جسر لنقل الثقافة
تتأثر التربية بالثقافة وتتحدد من خلالها، ثم تعود لتؤثر فيها من جديد. "والحقيقة أيضا أننا لسنا نتاج وراثتنا فحسب، ولا محصلة ما نكتسبه فحسب، وإنما نتكون من تلك العلاقة الدينامية بين ما نرثه وما نكتسبه"[33]. فالتربية هي الوسيلة أو الأداة التي تنقل الثقافة مع إتاحة الفرصة لتغييرها لتوافق روح العصر؛ ذلك أن الإنسان يتحصن بثقافته، ويسعى قدما إلى تحسينها وتغييرها لتجاوز النقائص التي تعتريها، ولضمان مواكبة متطلبات عصره، وحلّ المشاكل التي تعترضه من حين لآخر. ما يعني اتسام التربية بالإبداع والابتكار والقدرة على النقد.
لا تتحدد هنا التربية على أنها "الفعل الذي يمارسه الأجيال الراشدة على الأجيال التي لم ترشد بعد من أجل الحياة الاجتماعية"؛[34] لأن التربية عندما ترتبط بالثقافة فهي تحيل على التنشئة الثقافية التي تنسحب أيضا على إدماج غير القاصرين في المجتمعات، لاسيما هؤلاء الذين يعانون من اضطرابات أو اختلالات معينة، أو حتى أولئك الذين ينتمون لثقافات مختلفة كالمهاجرين واللاجئين مثلا. لهذا، نجد أن التنشئة الاجتماعية هي عملية ترافق الفرد منذ ولادته إلى وفاته، مغطية بذلك مختلف المراحل العمرية للإنسان.، ما يفيد أن "خبرة التنشئة الثقافية لا تنتهي بانتهاء مرحلة الطفولة ولكن يمكن القول إنها لا تنتهي في الحقيقة إلا بموت الفرد."[35].
على هذا الأساس، يجب النظر للتربية كعملية مصاحبة دائمة مستفيدة من المعنى الذي بنيت عليه البيداغوجيا كمفهوم. وعندما نتحدث عن البيداغوجيا، فلا بد من استحضار الأقطاب الثلاثة المكونة لرؤوس المثلث البيداغوجي، وكذلك هو الشأن عندما نتحدث عن الحياة الإنسانية في كنف جماعة ما، أي ما يميز الجماعات الإنسانية عن غيرها من الجماعات غير العاقلة، فلا مناص من استحضار ثلاثة أقطاب هي الفن والثقافة والتربية.
ج. الثقافة والفن والتربية
لا غرو أن نجاح التربية يظل رهينًا بمدى قدرة الفرد على إظهار ما تلقاه واكتسبه على شكل سلوكيات قابلة للملاحظة والقياس استحسانا أو استهجانا من طرف الجماعة، لكن هل يستطيع الفرد إبراز كل ما تعلمه وتلقاه في شكل سلوكيات ملحوظة؟ هنا تظهر أهمية الفن الذي يضم في معناه "التعنية والاطراد الشديد"[36]، مما يفيد أن الفن ما هو إلا إظهار وإخفاء في الوقت ذاته لتلك القيم الجمالية والفنية التي تشربها الفنان داخل مجتمعه، طالما أنه يقوم بالأساس على اللغة الرمزية. لذلك، نجد أن الفن كثيرًا ما كان يوصف بأنه مرآة المجتمع. هذه العبارة التي لا ينبغي أن نفهم منها على أن عمل الفنان يقتصر على تصوير مجتمعه وفق ترجمة حرفية، وإنما هي بالأساس انعكاس لثقافة المجتمع إما تعزيزا وتأكيدا لها، وإما نقضا أو إبرازا لبعض عيوبها وبالتالي تمردا عليها.
تُعَد علاقة التربية بالفن علاقة وطيدة وقديمة جدا، فلا يخفى علينا ذلك الدور التعليمي الذي لعبته الدراما في حياة الإنسان منذ بدء الخليقة، ويظهر هذا جليًّا في عهد الإغريق، وكذلك في عهد الرومان حين لجأت الكنيسة للدراما لنشر تعاليمها، بل ويتجلى أيضا دور الفن في التربية وتكاملهما من خلال عدد الكتب التي اهتمت بالموضوع، وهنا نشير إلى كتاب التربية عن طريق الفن ل «هربرت ريد»، أو الفن خبرة ل «جون ديوي»، أو كتاب ضرورة الفن ل «أرنست فيتشر» أيضا. حيث نجد على سبيل المثال «هربرت ريد» في كتابه هذا يجعل للفن والتربية نفس الأهداف والغايات، فإذا كانت التربية تسعى لجعل الفرد مندمجا داخل جماعته، قادرا على التواصل معهم، فإن الفن هو خير وسيلة اهتدى إليها الإنسان للتعبير عن أفكاره وآرائه ومشاعره، وبالتالي التواصل مع الآخرين، طالما أن اللغة بشكل عام لا تقتصر فقط على اللغة المنطوقة أو المكتوبة فقط، بل تتعداها إلى اللغة في معناها العام الواسع.
إن الكتب التي اهتمت بتاريخ الفن والفنون منذ القديم تنقل لنا كيف كانت الفنون وسيلة لنقل الثقافة، وأداة لنشر التعاليم الدينية وترسيخ القيم السائدة في مجتمعات بعينها. فكان الهدف الأسمى للفن ومن خلاله الأعمال الفنية هو التربية العامة للأفراد. وكمثال على ذلك "يعتبر المسرح المدرسي من التجهيزات المهمة في المدارس اليسوعية. فإلى جانب التمرين على اللغة والتعبير، تساعد القطع المسرحية المؤلفة، وإن جزئيًّا، على نشر التعاليم الأخلاقية والدينية"[37].
إن العلاقة الجدلية بين الثقافة والفن والتربية هي ما يمكن أن يفسر لنا السبب الذي يجعل من الإنسان الكائن الوحيد الذي يمكن أن ننعته بالثقافي، فإذا كان بعض الباحثين يرون أن السبب الرئيس لانفراد الإنسان بالثقافة يكمن في أنه كائن اجتماعي، فيمكننا الجزم بأن الشرط الاجتماعي على أهميته، إلا أنه غير كاف لوصف الإنسان بالكائن الثقافي؛ ذلك أنه لا يمكننا أن نصف الكائنات غير العاقلة بصفة الثقافة، رغم أننا ننعتها بالكائنات الاجتماعية طالما أنها تعيش داخل جماعات، بل تحرص هذه الكائنات غير العاقلة على رعاية صغارها. وهنا يظهر أن صفة الثقافة التي تميز الإنسان تتطلب إضافة إلى الشرط الاجتماعي شرطا آخر هو الوعي والفن.
الإنسان يا له من كائن محظوظ! نعم محظوظ لكونه الكائن الوحيد الذي يتمتع بقدرة وحس فنيين، طالما أن "الجنس البشري يعيش من الفن والعقل".[38] ومحظوظ كذلك؛ لأن التربية والثقافة مكتسبتان وليستا بالوراثة، وإلا كنا فقط صورا مستنسخة لأسلافنا، وما كنا ما نحن عليه الآن. هذا إن لم نكن قد هلكنا.
4. الثقافة كفاية ممتدة أو عامة
تحيل الثقافة بمعناها الواسع على كل ما يكتسبه الإنسان داخل مجتمعه بهدف السيطرة على الطبيعة وعلى نفسه، وهي بذلك تشير إلى كل ما يصدر عنه بشكل واع، فاعتمادا على هذه المكتسبات يستطيع الإنسان تسخير محيطه الطبيعي والبيئي وفق مصالحه ضمانا لبقائه أولا، وبحثا عن سعادته وتحسين ظروف عيشه ثانيا. فعلى هذا الأساس، فإن "كل الترقيات في الحضارة التي يستكمل بها الانسان تهذيب نفسه، إنما غرضه أن يطبق هذه المعارف وهذه المهارات المكتسبة قصد استخدامها في دنياه".[39]
إن جدلية العلاقة بين الثقافة والتربية تجعلنا نقف مباشرة أمام السؤال الجوهري أو المحوري لهذه العلاقة، والذي يمكن أن نصوغه على الشكل الآتي: ما الذي يكتسبه الفرد داخل مجتمعه حتى يصبح مثقفا؟ وهل يكفي هذا الاكتساب وحده لإضفاء صفة مثقف على الأفراد، دون العمل على ترجمة تلك المكتسبات إلى سلوكيات؟ إن محاولة الإجابة عن مثل هذين السؤالين تفرض علينا لا محالة تحديد جوهر الثقافة في البدء، أو لنقل تلك المحددات التي تشكل السمات المميزة لما هو ثقافي عن غيره، هنا نرجع لتعريف جوهر الثقافة الذي يأتي على أنه "تلك الاتجاهات العامة، والنظرة إلى الحياة والمظاهر الحضارية الخاصة التي تمنح شعبا من الشعوب مركزه المتميز في العالم."[40]
يبدو هذا التعريف فضفاضا واسعا، لا نستطيع من خلاله تحديد تلك الجينات التي تختزنها الثقافة في أعماقها، وهي الجينات التي يصطلح عليها بالميمات كما يبرز ذلك «روبرت أونجر» في كتابه (الثقافة منظور دارويني، وضع مبحث الميمات كعلم). ويحاول «ريتشارد دوكنز» تحديد طبيعة هذه الميمات بقوله: "ومن ثم، فإن الميمة هي وحدة معلومات ثقافية منقولة تماثل الجينة."[41]
إن جوهر الثقافة أو الجينات الثقافية يجب أن يبحث:
✔ أولا في ضوء المقاربات التي تناولت الثقافة، وهنا نجد المقاربات النفسية والاجتماعية والأنثروبولوجية والتربوية وغيرها...
✔ ثانيا من خلال العلاقة التي توحد عناصر الثقافة ومكوناتها المتعددة والمتنوعة كاللغة والدين والمعتقدات والقيم والأخلاق والفنون والآداب وغيرها...
جوابا عن سؤال ما الذي يكتسبه الإنسان داخل جماعته حتى ينال صفة مثقف؟ ينبغي أولا الإشارة إلى أن الثقافة سواء عند الفرد أو الجماعة ليست هي تلك المعطيات المتنوعة والمتعددة التي تنقل من السلف إلى الخلف فقط، فهي تختلف عن «الهابيتوس» الذي "يشتغل بوصفه تجسيدا ماديا للذاكرة الجماعية، معيدا في الخلف إنتاج ما اكتشفه السلف"[42]؛ لأن الثقافة هي كذلك ما يبنيه الفرد بنفسه داخل جماعته، أو ما تطوره وتسنّه الجماعة نفسها من قوانين وأنظمة وأعراف ومعتقدات...، حيث يتداخل فيها ما هو نفسي مع ما هو اجتماعي ومعرفي ومهاري وحس حركي… ويتفاعل فيها ما هو موروث مع ما هو جديد مبنى ذاتيا، لنصبح بذلك أمام ثقافة تحيل على مفهوم الكفاية، فإذا كانت هذه الأخيرة تمكننا في مجال التربية والتعليم من إضفاء المعنى على التعلمات، "فإن من مهمات الثقافة أن تمنح للحياة الهدف والمعنى."[43]
إن تنوع وتعدد المقاربات التي اهتمت بالثقافة، إضافة لتنوع وتعدد مكوناتها يجعل جوهر الثقافة أو تلك الجينات الثقافية المراد نقلها للأفراد داخل المجتمع هي اتحاد أو إدماج ذلك كله في عنصر واحد مركب، الذي يصفه بعض الباحثين ك «جوهان هيردر» بمثابة الدماء التي تجري في عروق جماعة أو شعب ما، أو ينعته آخرون ك «ليفي بروهل» بالروح أو الذهنية".[44] فإذا كنا نتحدث عن ثقافة دينية، وثقافة لغوية والأخلاق والقيم كثقافة، وكذلك نتحدث عن ثقافة فنية وأدبية، ثم نجمع كل هذه الثقافات في ثقافة واحدة مركبة هي الثقافة العامة. فإن هذا يعني أن هذه الأخيرة ليست سوى كفاية ممتدة يكتسبها الفرد داخل مجتمعه انطلاقا من دمج وتوليف عدد من الكفايات الفرعية التي تتعدد وتتنوع حسب عناصر الثقافة نفسها، ولا ينبغي أن تفهم الثقافة ككفاية ممتدة أو عامة على أنها مجموع كفايات فرعية، بل هي كفايات فرعية تشتغل بشكل ديناميكي ضمن نسق معين.
يعد كل عنصر من عناصر الثقافة ثقافة فرعية أو جزئية مستقلة في حد ذاتها، يستوجب امتلاك كفاية فرعية خاصة بها، لتأتي بعد ذلك الكفاية العامة او الممتدة كدمج لمختلف تلك الكفايات الفرعية. إن الثقافة ككفاية عامة/ممتدة تضم في طياتها كفايات فرعية هي ما يفسر لنا تعدد وتنوع الثقافات؛ لأن قدرات واستعدادات الأفراد تختلف وهذا يجعل كفاية فرعية بعينها تهيمن أو تسود على الأخريات، وهو ما يكون له تأثيره طبعا على نوعية تلك الكفاية الممتدة التي يكتسبها كل فرد، إذ في الغالب ما يكتسب الافراد تلك الكفايات الفرعية بشكل متفاوت، لتفاوت قدراتهم واستعداداتهم وكذلك لاختلاف اهتماماتهم وميولاتهم، وربما هذا ما يفسر لنا ليس فقط اختلاف الثقافات الفردية، بل يتجاوزها إلى فهم تعدد الثقافات واختلافها من جماعة إلى أخرى.
لا يتصرف الأفراد كلهم بنفس الطريقة أمام الوضعية الواحدة، وهذا راجع بالأساس إلى تلك الكفاية العامة/الممتدة التي يمتلكها كل واحد منهم، بل لعل نفس الفرد سيتصرف بطريقتين مختلفتين أمام نفس الوضعية لو اختلفت كفايته الممتدة في كل مرة، وهذا دليل على أن مرد الاختلاف هو مبلغ الفرد من العلم ومكتسباته القبلية.
أما جوابا عن سؤال هل يكفي اكتساب الفرد لكفاية ممتدة داخل جماعة ما لنعته بالمثقف؟ لا بد من التذكير هنا أن مفهوم الكفاية لا يشير إلى الاكتساب فقط، بل يشير كذلك وبالأساس إلى التجسيد والتطبيق العملي على أرض الواقع من خلال وضعيات محددة. وعليه فإن اعتبار الثقافة بمثابة كفاية ممتدة هو ما يمكن أن يفسر لنا مفهوم المثقف العضوي الذي طرحه «غرامشي»، فإذا كان المثقف هو كل فرد يكتسب ثقافته/كفايته من جماعته، فمن هو المثقف العضوي إذن؟
للجواب عن هذا السؤال يمكن الرجوع إلى «أليكس ميكشيللي» حين يقر بوجود أوجه الشبه بين الثقافة واللغة، فيقول: "حال الثقافة كما يقول «بينديكت» كحال اللغة".[45] ونحن نعلم أن اللغة كما جاء بذلك «تشومسكي» هي كفاءة وإنجاز؛ أي إنها عملية اكتساب لغوي أولا، ثم التواصل بها أو استخدامها فعليا في مواقف مختلفة، وكذلك الثقافة مثلها تماما فالمثقف هو من يكتسب تلك المعارف والخبرات والسلوك من محيطه، أما الكفاية، فهي أن تتجسد هذه الثقافة أداء وسلوكا فعليا ملحوظا من قبل مثقفين عضويين؛ لأننا نستطيع ملاحظة أفراد ينتمون لثقافات معينة، أو يمتلكون معارف وخبرات وسلوكيات معلومة، لكنهم لا يتصرفون وفقها، وبالتالي فهؤلاء هم أفراد مثقفون طالما أنهم اكتسبوا تلك الثقافة/كفاية، لكنهم بالتأكيد ليسوا مثقفين عضويين. وهذا ما يجعلنا نخلص إلى أن الثقافة كفعل اجتماعي، لا بد أن يكون من خلالها هذا الفاعل عضويا، أي يتصرف وفق سلوكيات تعكس هذه الثقافة المكتسبة لديه والموجهة بذلك النموذج المثالي/ المواطن الصالح، وهو في هذه الحالة المثقف العضوي نفسه، لا المثقف السلبي. بمعنى أن الثقافة تصبح كفاية؛ لأنها وعي وممارسة فعلية، أما في غياب الممارسة والتجسد الفعلي على أرض الواقع فلا تتعدى كونها خبرات ومعارف، فلنقل إنها تصبح أقرب ما يمكن إلى مفهوم الملكة. فهي ثقافة مع وقف التنفيذ أو ثقافة سلبية إن صح التعبير.
إن المثقف السلبي هنا ليس من يتصرف عكس ما تمليه وتقتضيه ثقافته التي اكتسبها فحسب، لكنه أيضا هو من يمتنع عن تطبيق أو العمل وفق ثقافته؛ لأن تصرفهما معا يأتي منافيا لإحدى أهم وظائف الثقافة الأساسية المتمثلة في الانضباط والالتزام اتجاه الأفراد والجماعة. هذا دون أن ننسى أن صفة المثقف السلبي تنطبق أيضا على من يمتلك ثقافة فرعية منحرفة وهي ظاهرة أطلق عليها «دوركايهم، 1951» اسم "أنومي".[46]
لا شك أن الثقافة بوصفها كفاية عامة/ممتدة هي ما يمكّن الفرد من التصرف بفعالية إزاء الوضعيات والمواقف التي يصادفها كل يوم في حياته، إذ عليه دمج كل ما اكتسبه سابقا داخل مجتمعه لتجاوز الوضعيات الحياتية، سواء كانت مألوفة لديه أو جديدة كليا (إن عليه أو على مجتمعه ككل). ما يشجع روح الابتكار لدى الفرد والجماعة معا. مع التذكير هنا بأن روح الاختراع والابتكار لدى الإنسان لا يعني فقط استخدام وسائل جديدة لأداء مهام ووظائف قديمة، لكنه يعني كذلك إنتاج وسائل وتقنيات جديدة لإنجاز مهام ووظائف جديدة ومستحدثة غير مسبوقة، تأتي نتيجة احتياجات جديدة للمجتمع. وبهذا يتجسد ذلك التحقق الفعلي للثقافة ككفاية عامة/ممتدة قادرة على تأدية وظيفتها من خلال معالجة وضعيات وإبداء سلوكيات قابلة للملاحظة، كما أنها قابلة للقياس من خلال استحسان أو استهجان المجتمع لها. طالما أن "الثقافة هي مجموعة من العناصر لها علاقة بطرائق التفكير والشعور والفعل."[47] فالثقافة معتبرة ككفاية عامة، لا شك أنها تحتفظ بخاصيتها النمائية والتطورية، فنجدها بذلك مرافقة للفرد طيلة حياته، حيث يمكنه تعديلها وتطويرها وإنماؤها متى دعته الضرورة إلى ذلك.
إذا كان الأفراد يكتسبون كفايات عامة/ممتدة داخل جماعاتهم، وهي التي تمكنهم من التصرف والاندماج داخل هذه الجماعات، فإن ما نصطلح عليه ب "ثقافة الجماعة" لا يفترض بالضرورة أن تكون هي مجموع هذه الكفايات التي يكتسبها الأفراد باعتبار أن الجماعة ليست إلا نسيج لتلك المجموعة من الأفراد الذين تتكون منهم. وإنما ثقافة الجماعة هي بالأساس ثقافة متعاقد عليها وفق عقد اجتماعي صريح أو ضمني، وهذا يصدق أيضا على ثقافة المجتمع/الثقافة الوطنية التي تكون من خلال عقد ضمني أو صريح يوضع من طرف الدولة أو الطبقة الحاكمة. وهنا تحديدا يصبح معنى الثقافة معادلا إلى درجة كبيرة لمعناها اللغوي الذي هو التهذيب وإصلاح الاعوجاج، حيث يتمكن كل فرد من اكتساب وبناء كفايته الكبرى الخاصة به التي تدل على حذقه وفطنته، وهذا يؤشر بالتأكيد على قدرة ثقافة المجتمع في أداء وظيفتها، وبالتالي ضمان اندماج الأفراد في الروح والذهنية ليس فقط المقبولة من طرف المجتمع، وإنما كذلك المميزة له عن غيره من المجتمعات.
تبقى الإشارة إلى أن حديثنا عن الثقافة ككفاية ممتدة/عامة نخص به الأفراد، طالما أن الكفاية هي مكتسبة وتبنى فرديا بشكل مستقل عن الآخرين. أما ثقافة الجماعة، فهي ما يبنيه المجتمع أو الجماعة بما أنها ظاهرة اجتماعية في المقام الأول، ولا يجوز لنا الحديث عنها إلا في ظل وجود وتحقق فعلي للجماعات أو المجتمعات. فهل يمكن القول إن الثقافة الجماعية أو ثقافة المجتمع هي كفاية؟ فانسجامًا مع رؤية «كارل كوستاف يونغ» الذي يميز بين الوعي الفردي والوعي الجمعي، وفي الوقت ذاته تماشيا مع الطرح الذي يرى أن الثقافة هي في الأساس "وعي وممارسة"، وهو طرح يذكرنا باستعمال «ابن خلدون» للفظة ثقافة مقترنة بالدراية والممارسة. وهذا ما ينتقده بشدة «هانز ألبرت شتيغر» حين يدعو إلى "أن الثقافة التجميعية لا يجوز اطلاقا أن تعتبر على أنها ثقافة وعي وممارسة".[48]
كان من الضروري أن نفصل حدود هذا الوعي والممارسة عند الأفراد عن حدودهما عند الجماعات، وبالتالي عند كل مجتمع. واعتبارا كذلك لكون الثقافة الجمعية التي تتبناها الجماعات ليست بالضرورة هي مجموع ثقافات (كفايات) أفرادها؛ بمعنى أنها ثقافة واحدة تأتي نتيجة عقد أو عرف بين أفراد الجماعة، أو بوصاية الجهات الحاكمة أو المسؤولة، فإن الثقافة الجمعية أو ثقافة الجماعة تغدو إذا كفاية قصوى إن صح التعبير (فهي أشبه بالغاية). وهكذا تصبح الثقافة ككفاية ممتدة مرتبطة بالأفراد، في حين الثقافة الجمعية أو الجماعية كفاية قصوى أو غائية خاصة بالجماعات. هذه الكفاية القصوى أو الغائية هي ما تمثله أيضا الثقافة الوطنية باعتبارها ثقافة موحدة تخضع لها كل الجماعات التي تقع تحت سلطة الدولة وداخل نفوذها الترابي، لتصبح الثقافة الوطنية بمثابة كفاية وطنية تمثل غاية في حد ذاتها، وهي ما تنشد الدولة إرساءه وتعزيزه من خلال مؤسساتها.
إن جميع خصائص ومميزات الثقافة كالاكتساب والنمائية والانتقائية والتغير والأدائية... تجعلها ترتفع لمستوى الكفاية العامة أو الممتدة القابلة للملاحظة على شكل سلوكيات في وضعيات مختلفة، فمثلا، لم يكن بمقدورنا القول إن المغاربة يتمتعون بثقافة التضامن، إلا انطلاقا من مواقفهم وسلوكياتهم الفعلية على أرض الواقع، التي جسدوا من خلالها تضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المغرب في 8شتنبر 2023. ما يؤكد أن الثقافة هي في المقام الأول كفاية تربط الوعي بالممارسة والتطبيق.
خاتمة:
تظهر مكانة «كانط» العلمية وأهمية أعماله في أنه انتبه إلى أن الإنسان استعمل العقل من غير أن يفهمه بشكل كامل، وعليه فإننا نعتقد أن أصالة هذا العمل تقوم كذلك على نفس المبدأ، وهو أننا نستعمل بعض الألفاظ دون أن نفهمها بشكل كامل، ومن بينها: الفن والثقافة والتنمية والتربية، وبالتالي فإن كل ما تم تقديمه في هذه الورقة البحثية هو محاولة لفهم دلالات لفظة الثقافة من وجهة نظر براغماتية ترمي إلى ربط الفهم بمعطيات الواقع التي تؤكد صدقيتها، انطلاقا من أن الواقع يفرض على البشر معنى الحقيقة، وليس هناك حقيقة ابتدائية تفرض نفسها على الواقع. كما تنظر للثقافة من حيث تطبيقاتها واستخداماتها العملية في الحياة العامة.
إن قصة الثقافة تبدو لي شبيهة جدا بقصة «ستة نسور وطفل» لـ «غسان كنفاني»، حيث يستمع فيها البطل لست حكايات مختلفة عن نسر واحد، كل حكاية تأتي وفق ما سمعه الراوي الذي يختلف في المرات الست، عن ذلك النسر الذي يراه الناس من بعيد واقفا على صخرة معزولة، أو من خلال مشاهدتهم له واجتهاداتهم الشخصية في تأويل وتبرير سبب وقوف النسر هناك فوق تلك الصخرة دون غيرها، ثم يستمع في نهاية الأمر إلى حكاية الطفل الذي يؤكد له أن النسر المزعوم ليس في الحقيقة إلا شجرة توت صغيرة، كان يذهب إليها رفقة أصدقائه لجمع التوت.
يتم تقديم الثقافة كذلك في كل مرة وفق نظرة الباحث إليها، وكتركيب لما جمعه عنها من معلومات، كل باحث حسب تخصصه ومجال اشتغاله، لهذا تتعدد وتتباين التعريفات المقدمة بخصوصها، وستستمر التأويلات المطروحة حولها؛ لأن الطفل في هذه الحالة لن يأتي ليساعدنا، لكن في المقابل علينا أن نعتمد على أنفسنا ونجد التأويل الذي يمكن أن يجيب لنا عن أهم التساؤلات المطروحة في شأن الثقافة، وينير لنا الطريق لتقديم تأويل منطقي ومقنع.
المصادر والمراجع
*- القرآن الكريم
- أبو الحسن أحمد ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1979
- أجنر فوج، الانتخاب الثقافي، ترجمة شوقي جلال، (الإصدار 1)، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2005
- ادم كوبر، الثقافة التفسير الانثربولوجي، ترجمة تراجي فتحي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2008
- أرثر ايزابرجر، النقد الثقافي، تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترجمة وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسي، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 2003
- أليكس ميكشيللي، الهوية، ترجمة علي وطفة، (الإصدار 1)، دار الوسيم للخدمات والطباعة، دمشق، 1993
- إميل دوركهايم، التربية والمجتمع، ترجمة علي أسعد وطفة، دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 1994.
- أيكة هولتكراس، قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفلكلور ترجمة محمد الجوهري، وحسن الشامي، (الإصدار 2)، دار المعارف، مصر، 1972
- إيمانويل كانط، الانثربولوجيا من وجهة نظر براغماتية، ترجمة فتحي انقزو، (الإصدار 1). صوفيا، الكويت، 2021
- باولو فريري، تربية الحرية: الأخلاق. الديمقراططية. الشجاعة المدنية، ترجمة أحمد عطية أحمد، الدار المصرية اللبنانبة، القاهرة، 2004
- برتولت برشت، أوراق من الرزنامة، ترجمة بوعلي ياسين، مكتبة عين الزهور. اللاذقية، 1992
- توما دوكونانك، الجهل الجديد ومشكلة الثقافة، ترجمة منصور القاضي، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، (الإصدار1)، بيروت، 2004
- جلال مدبولي، الاجتماع الثقافي، (الإصدار 1)، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1979
- دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، منير السعيداني، (الإصدار 1)، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2007
- ديوان كثير عزة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 1971
- رالف لنتون، شجرة الحضارة، ترجمة أحمد زكريا الشلق، المشروع القومي للترجمة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2010
- روبير داوسن، وآخرون، التربية والتعليم، ترجمة اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، 1966
- السيد حنفي عوض، فجر الثقافة في تاريخ الشعوب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2015.
- شارلوت سيمور، وسميث، موسوعة علم الإنسان، المفاهيم والمصطلحات الأنثربولوجية. ترجمة محمد الجوهري، المشروع القومي للترجمة، (الإصدار 2)، 2009
- صامويل هنتجتون، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ترجمة طلعت الشايب، (الإصدار 2) كتاب سطور، 1998
- الطاهر لبيب، سوسيولوجيا الثقافة، (الإصدار 2)، دار قرطبة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، 1986.
- طوني بينيت، ميغات موريس، ولورانس غروسبيرغ، مفاتيح اصطلاحية جديدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ترجمة سعيد الغانمي، (الإصدار 1)، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2010
- عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، (الإصدار 1)، دار الكتب العلمية، بيروت، 1993
- عبد الغني عماد، سوسيولوجيا الثقافة المفاهيم والاشكاليات...من الحداثة إلى العولمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2006
- عبد الله حمودي، المسافة والتحليل في صياغة أنثربولوجية عربية، (الإصدار 1)، دار توبقال للنشر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019
- غسان كنفاني، موت سرير رقم 12، (الإصدار 4)، لبنان: مؤسسة الأبحاث العربية، لبنان، 1987
- فرانز بيتر بوكارد، وأكسل فيس، أطلس علم التربية، ترجمة جورج كتورة، (الإصدار 1) مكتبة الشرقية، بيروت، 2013
- كيلفورد غيرتز، تأويل الثقافات، ترجمة محمد بدوي، المنظمة العربية للترجمة، (الإصدار 1)، بيروت، 2009
- محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، 2004.
محمد حسن عبد الحافظ، في مدنية الثقافة ومرجعياتها الشعبية، (الإصدار 1)، إصدارات معهد الشارقة للتراث، الشارقة، 2016
- هارلمبس، وهولبون، سوشيولوجيا الثقافة والهوية، ترجمة حاتم حميد محسن، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2010
- هانز ألبرت شتيغر، الثقافة جسر عبر الحدود. صفحة 166/ 176، ترجمة سليم سالم، مجلة الثقافة العالمية، المجلد 1، العدد2، الكويت، 1982
- هربرت ريد، الفن والمجتمع، ترجمة فارس متري ضاهر، دار القلم، بيروت، 1975
- هيربرت ريد، التربية عن طريق الفن. ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصر، 1996
- وليامز، ريموند، الكلمات المفاتيح، معجم ثقافي ومجتمعي، ترجمة ونعيمان عثمان، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2005
- Bronislaw Malinovski. une théorie scientifique de la culture, et autres essais. (P. Clinquart, Trad). francois maspero. paris.(1968).
- Joseh Sumpf et Michel Hugues. dictionnaire de sociologie. librairie larousse. Paris. (1973).
[1] الطاهر لبيب، سوسيولوجيا الثقافة، 1986، ص6
[2] طوني بينيت وآخرون، مفاتيح اصطلاحية جديدة (معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع)، ترجمة سعيد الغانمي، 2010، ص255
[3] إيمانويل كانط، الأنثروبولوجيا من وجهة نظر براغماتية، ترجمة فتحي إنقزو، 2021
[4] الطاهر لبيب، سوسيولوجيا الثقافة، مرجع سابق، صفحة 13
[5] ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، 1979، ج1 ص383
[6] ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، 1979، ج2، ص49
[7] دونيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ترجمة منير السعيداني، 2007، ص 17
[8] Joseh Sumpf et Michel Hugues , dictionnaire de sociologie. 1973, p74
[9]Joseh Sumpf et Michel Hugues , dictionnaire de sociologie. 1973, p74
[10] عبدالله حمودي، المسافة والتحليل في صياغة أتثربولوجية عربية، 2019، ص131
[11] عبد الغني عماد، سوسيولوجيا الثقافة المفاهيم والاشكاليات...من الحداثة إلى العولمة. 2006، ص ص31و32
[12] ريموند وليامز، الكلمات المفاتيح، معجم ثقافي ومجتمعي، ترجمة نعيمان عثمان، 2007، ص95
[13] أيكة هولتكراس، قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفلكلور، ترجمة محمد الجوهري وحسن الشامي، 1972، ص144
[14] ديوان كثير عزة، تحقيق إحسان عباس، 1971، ص 335
[15] ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، شرح محمود محمد شاكر، 2004 ص 5
[16] ابن خلدون، مقدمة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 1337، ص 134
[17] ابن خلدون، المرجع نفسه، ص 29
[18] ابن خلدون، المرجع نفسه، ص 198
[19] ابن خلدون، مرجع سابق، ص، 135
[20] السيد حنفي عوض، فجر الثقافة في تاريخ الشعوب. 2015، ص 131
[21] صامويل هنتجتون، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ترجمة طلعت الشايب، 1998، ص69
[22] ابن فارس، مقاييس اللغة، ج2، مرجع سابق، ص 75
[23] صامويل هنتجتون، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، مرجع سابق، ص69
[24] السيد حنفي عوض، فجر الثقافة في تاريخ الشعوب، 2015، ص 118
[25] جلال مدبولي، الانتخاب الثقافي، 1979، ص12
[26] صامويل هنتجتون، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ترجمة طلعت الشايب، 1998، ص69
[27] السيد حنفي عوض، فجر الثقافة في تاريخ الشعوب، مرجع سابق، ص 118
[28] محمد حسن عبد الحافظ، في مدنية الثقافة ومرجعياتها الشعبية، 2016، ص27
[29] Bronislaw Malinovski,1944, tr Pierre Clinquart, 1968,p128
[30] عبد الغني عماد، سوسيولوجيا الثقافة المفاهيم والاشكاليات...من الحداثة إلى العولمة، مرجع سابق، صفحة 45
[31]. داوسن، وآخرون، التربية والتعليم، 1966، صفحة 324
[32] أرنست فيشر، ضرورة الفن، ترجمة ميشال سليمان، صفحة 12
[33] باولو فريري، تربية الحرية: الأخلاق. الديمقراطية. الشجاعة المدنية، ترجمة أحمد عطية أحمد، 2004، صفحة 147
[34] إميل دوركهايم، التربية والمجتمع، ترجمة علي أسعد وطفة، 1994، صفحة 67
[35] أيكة هولتكراس، قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفلكلور، ترجمة محمد الجوهري وحسن الشامي، 1972، ص 137
[36] ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، 1979، ج4، ص 435
[37] فرانز بيتر بوكارد، وأكسل فيس، أطلس علم التربية، ترجمة جورج كتورة، 2013، صفحة 55
[38] توما دوكونانك، الجهل الجديد ومشكلة الثقافة، ترجمة منصور القاضي، 2004، ص 122
[39] كانط، الانثربولوجيا من وجهة نظر براغماتية، مرجع سابق، صفحة 91.
[40] أيكة هولتكراس، قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفلكلور، مرجع سابق، ص 173
[41] اجنر فوج، الانتخاب الثقافي، ترجمة شوقي جلال، 2005، ص54
[42] دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، مرجع سابق، ص 143
[43] آدم كوبر، مرجع سابق، ص52
[44] دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، مرجع سابق، ص49.
[45] أليكس ميكشيللي، الهوية، ترجمة علي وطفة، 1993، ص27
[46] ارثر أيزابرجر، النقد الثقافي، تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترجمة وفاء ابراهيم ورمضان بسطاويسي، 2003، ص203
[47] عبد الغني عماد، مرجع سابق، 2006، ص32
[48] هانز ألبرت شتيغر، مقالة: الثقافة جسر عبر الحدود، ترجمة سليم سالم، مجلة الثقافة العالمية، المجلد1، العدد2، ص170