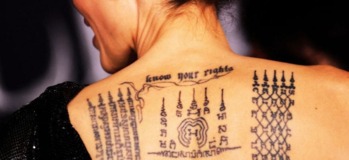القيم المغربية الناظمة للحياة اليومية: الشرف – البركة – العرف نحو مقاربة سوسيو-أنثروبولوجية
فئة : أبحاث محكمة

القيم المغربية الناظمة للحياة اليومية:
الشرف – البركة – العرف
نحو مقاربة سوسيو-أنثروبولوجية
ملخص:
يتناول هذا البحث موضوع: القيم المغربية الناظمة للحياة اليومية؛ وذلك من خلال تسليط الضوء على ثلاثة نماذج، وهي "قيمة الشرف"، و"قيمة البركة"، و"قيمة العرف"، من خلال سعينا إلى محاول فهم الأبعاد الاجتماعية والرمزية التي تحتلها في المجتمع المغربي، على اعتبار أن البحث في هذه القيم هو في حقيقته بحث عن ملامح الثقافة المغربية بوصفها ثقافة ضاربة في جذور التاريخ، فكرًا وحضارة وممارسة، ولعل هذا ما يمكن ملامسته من خلال العادات والممارسات والطقوس وأنماط الفنون والآداب المنبعثة من إبداع اللهجات واللغات المحلية، الشيء الذي يجعل من الثقافة المغربية ثقافة غنية ومختلفة ومتنوعة لها خصوصياتها ومميزاتها، وقد تساءلنا عن بعض خصوصيات الثقافة والقيم المغربية بتنوعها وتعددها، وبالتالي عن فهم فكر الإنسان المغربي ونظرته إلى الكون والحياة والناس، وتدبيره لحياته اليومية، أملا في الفهم والتفسير والتأويل، باعتماد الملاحظة والرواية الشفوية.
مقدمة:
إن حقيقة الاجتماعي تظهر من خلال تتبع الحياة اليومية للأفراد في أبسط معانيها؛ فالسياقات الاجتماعية المختلفة تنتج سياقات فكرية وثقافية متمايزة، تجعل من الفرد حاملا لها ومسؤولا عن إعادة إنتاجها، سواء بوعي أو من دون وعي، كحتمية أوجبتها استمرارية المجتمع ككيان وكوظيفة.
ويعد المجتمع المغربي من أبرز المجتمعات الذي يشكل أبرز المجتمعات إنتاجا وإعادة إنتاج للقيم الناظمة لحياته اليومية، بأشكال وبصيغ متعددة من خلال الثقافة المغربية بتعددها وتنوعها وطقوسها. فالمتأمل في الثقافة والقيم المغربية سيدرك أن هناك عمقا ونسيجا مغربيا متلاحما عبر العصور ومنذ قرون، ذابت فيه كل الفوارق وتعايشت كل مكوناته العربية والإسلامية والمورسكية والأندلسية والأمازيغية والحسانية، ولكن بالرغم من هذا التنوع الثقافي هناك بعض الخصوصيات الثقافية التي تجعل من المجتمع المغربي بلد التعدد والتنوع، ولعل هذا يمكن ملامسته من خلال العادات والممارسات وأنماط الفنون والآداب المنبعثة من إبداع اللهجات واللغات المحلية، وكل هذا أعطى خلاسية ثقافية ميزت المغرب والمغاربة.
والحديث عن الثقافة المغربية في أصولها لا يعني في نظرنا استعراض تاريخ هذه الثقافة، بقدر ما يعني محاولة النفاذ إلى عمقها ودلالتها وخصائصها ومميزاتها، لإدراك مدى تجذرها وحركيتها والدعائم المرتكزة عليها، ومن ثم يمكن القول إن الثقافة عموما، والمغربية على وجه الخصوص بتنوعها وتعددها تتضمن مجموع العناصر الإنسانية التي تشكل فكر الإنسان المغربي، وتضبط سلوكه وعلاقاته مع غيره؛ أي مع الكون والحياة والناس، وهي عناصر تكتسب بالتعلم والممارسة، إلى جانب ما يتوارثه جيل عن جيل وقابلية للتواصل والاحتكاك، وتبادل التأثير والتأثر وقدرة على صنع هذه العناصر وإخضاعها تلقائيا للحاجات بالتكييف والتطوير والتغيير.
ولا ندعي في هذا المقام أن هذا البحث يفي بالغرض أو قادر على الإحاطة بمجموع الثقافة والقيم المغربية، وإنما هي محاولة على سبيل الاستشكال وعلى درب الفهم، وهذا له ما يبرره، فدراسة الثقافة المغربية تحتاج إلى التوسل بمناهج متعددة، وتناولها من مختلف حقول معرفية تاريخية وإثنولوجية ولغوية ونفسية وأنثروبولوجية، خاصة منهج الأنثربولوجيا الثقافية التي تدرس الظاهرة الثقافية من حيث مكوناتها وخصائصها وعلاقتها بغيرها، وما عرفته من تطور وتبدل عبر الأزمان. وتجدر الإشارة هنا إلى أن البحث عن هذه الأصول الثقافية والقيم الناظمة للحياة المغربية لا يعني ارتماء في أحضان الماضي والتغني به، ولكنه يعني إدراكا واعيا للحاضر وتطلعا ملحا لاستشراف المستقبل، على أساس استخلاص هذه الأصول الثقافية وأبعاده الرمزية، بوصفها مصدر الذات المغربية ومرجعها، ثم باعتبارها أسسا ودعائم يمكن الارتكاز عليها لمواصلة البناء الثقافي المغربي وتجديده وتقويته، بعيدا عن كل أشكال الطمس للهوية المغربية وما قد يمسها من شوائب بفعل التغيرات والانفتاح الثقافي.
أولا- القيم: المفهوم والدلالات:
يعد موضوع القيم من المواضيع التي تثير اهتمام الباحثين والمفكرين من مختلف القارات المعرفية كالفلسفة وعلم الاجتماع والتربية وعلم النفس، وتمثل القيم جانبا رئيسا من ثقافة أي مجتمع من المجتمعات، بل يمكن القول إنها تمثل لب الثقافة وجوهرها، وقد ازدادت في عصرنا الحالي الاهتمام بدراسة القيم وتحليل طبيعتها؛ لأنها تتصل بكل مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية للأفراد والجماعات، بهذا المعنى وفي ظل الأزمة الكبيرة التي يعرفها العالم بفعل جائحة كورونا تسود قيم جديدة في المجتمع المغربي، ولعل من أبرز هذه الإشكالات التي تنطرح وبشكل ملح هو ما يتعلق بتحديد مفهوم القيم؛ فهي من المفاهيم الأكثر استعمالا في حياتنا اليومية لكنها الأكثر التباسا وغموضا. فالقيم نستعملها استعمالات مختلفة ومتباينة على مستوى الدلالة، فعندما نعود إلى المتن اللغوي نجد أن القيم les valeurs هي جمع قيمة، وقد عرفها ابن منظور بأنها ثمن الشيء بالتقويم، وأطلق على ثمن الشيء قيمة؛ لأنه يقوم مقام الشيء؛ إذ تقول العرب: كم قامت ناقتك؟ أي كم بلغت[1].
وفي علم الاجتماع قدم الباحثون والمفكرون العديد من التعاريف للقيم، ومن أقدم التعاريف هو تعريف توماس وزناينكي Thomas and Znaniecki في مؤلفهما الشهير الفلاح البولندي: "القيمة الاجتماعية تعني أي معنى ينطوي على مضمون واقعي وتقبله جماعة اجتماعية معينة كما أن لها معنى محدد، حيث تصبح في ضوئه موضوعا معينا أو نشاطا خاصا"[2].
ومن جهة أخرى يعرف بارسونز T. Parsons في كتابه "النسق الاجتماعي" القيمة بأنها: "عنصر في نسق رمزي مشترك يعد معيارا أو مستوى للاختبار بين بدائل التوجيه التي توجد في موقف معين"[3]، نجد أيضا تعريف كليد كلاكوهن G. khnkhohn الذي عرف القيمة على أنها: "تصور واضح أو مضمر يميز الفرد أو الجماعة ويحدد ما هو مرغوب فيه، حيث يسمح لنا بالاختيار بين الأساليب المتغيرة للسلوك والوسائل والأهداف الخاصة بالفعل"[4]، كما عرف حليم بركات القيم بأنها: "المعتقدات حول الأمور والغايات، وأشكال السلوك المفضلة لدى الناس توجه مشاعرهم وتفكيرهم، ومواقفهم وتصرفاتهم واختياراتهم، وتنظم علاقاتهم بالواقع والمؤسسات والآخرين أنفسهم والمكان والزمان، وتسوغ مواقفهم، وتحدد هوياتهم ومعنى وجودهم؛ أي تتصل بنوع السلوك المفضل وبمعنى الوجود وغاياته"[5]. كما نجد أيضا تعريف جميل لحسن رشيق، حيث يعتبر القيم: "عبارة عن تفضيلات جماعية، وتعتبر بمثابة قواعد للسلوك أو الكينونة ترتبط بمشاعر قوية، كما أن القيم لا تحيل على مثل نتطلع إليها، بل لها بالأساس وظائف عملية، إنها تقود وتلهم وتوجه وتنص على أحكام وآراء وخيارات وأعمال فردية وجماعية"[6].
نستنتج إذن، من كل هذه التعاريف أن القيم منظومة ونسق متكامل يحيل على أحكام معيارية يحملها الفرد نحو موضوعات وأوجه النشاط المختلفة، وتشكل محك ومختبرا يحدد على أساسه ما هو مرغوب فيه أو مفضل في موقف توجد فيه عدة بدائل وما هو غير مرغوب فيه، خاصة إذا ما اعتبرنا سوسيولوجيا أن القيم ليست ثابتة، بل هي متغيرة باستمرار مع تغيرات المجتمع، فإن خصوصية تطور القيم تكمن في حقيقة أن هذا التطور لا يحدث بوتيرة نفسها لباقي الوقائع الاجتماعية، من منطلق أن القيم تستبطن في الوعي والعقليات، كما تخضع لزمنية خاصة تتصف بالبطء والعودة إلى القيم القديمة في أشكال حديثة وبصيغ جديدة.
ثانيا - قيمة /قدسية "الشرف" في مخيال الإنسان المغربي
1 - مفهوم الشرف:
يعد مفهوم الشرفL’honneur من المفاهيم التي كانت ولاتزال من أكثر المواضيع أهمية في الدراسات السوسيولوجية والأنثروبولوجية؛ وذلك بالنظر إلى مكانته وما يحتله باعتباره عنصرا سوسيو-ثقافيا ميز المجتمعات العربية والإسلامية منذ القدم. فهو من المواضيع الجدلية التي أثار الكثير من النقاش والجدال، خصوصا أمام التغيرات والتحولات القيمية التي تشهدها المجتمعات والمجتمع المغربي على وجه الخصوص. فما مفهوم "الشرف"؟ وكيف يمكن مقاربته من الناحية السوسيو-أنثربولوجية؟ ما محددته في الثقافة المغربية؟ وهل من مبرر موضوعي للخوض في هذا المفهوم في ظل التحولات الثقافية والاجتماعية الحديثة؟
تعدّ قيمة الشرف نمط حياة يختلف من مجتمع لآخر، رغم الاشتراك في ذات القيمة؛ فالشرف كقيمة اجتماعية "تشترك فيها جميع الشعوب المتوسطية بغض النظر عن الخصوصيات التي تميز كل منطقة عن الأخرى في كيفية فهم وتمثل هذه القيمة"[7]، وهو ما جعل منها موضوعا أثيرا للبحث والدراسة. وعندما نعود إلى المتن اللغوي سنجد أن كلمة "الشرف" تعني العلو، فيقال ذو الشرف أي ذو العلا والرفعة، والاعتداء على الشرف يكون مفهوما في اللغة بوصفه مساسا بأي صفة في الفرد لها اعتبار في رفع قدره وقيمته، ومن معاني الشرف أيضا صيانة العرض واحترام الكلمة وهو حالة وجود إنسانية وقيمة اجتماعية وأخلاقية قد تمنح الإنسان الرفعة والمكانة والكعب داخل مجتمعه، أو قد توصمه بالعار والذل والمهانة فيصير منبوذا اجتماعيا ومنحط الكرامة.
إن مفهوم الشرف (Honneur) في العربية الكلاسيكية كما في مختلف اللهجات، كأن نقول مثلا "اللي راسو مرفود أو مرفوع" ومعناه "رأسه شامخ" من الشموخ والعزة، أو "بوجه أحمر" في إشارة إلى أن ماء الوجه يحيل على الشرف، فالذي فقد ماء وجهه، فقد شرفه ومكانته داخل المجتمع، كما يحضر مفهوم "الشرف" في الكثير من المعاني والتعابير المترادفة من قبيل: "يشرفني القيام بشيء أو التعامل مع شخص ما"؛ أي يعزني ويكرمني، أو أن يكون حدث ما "على شرف فلان"؛ أي إنه ضيف رفيع المستوى والمكانة، يضيف بوجوده للحدث، أو "القتال بشرف" في المعارك أو المواجهات؛ أي أن تكون المعركة متكافئة ومن دون ألاعيب خادعة، أو "الموت بشرف"؛ أي أن يموت الإنسان مدافعا عن دينه أو وطنه أو عرضه أو عن قضية يؤمن بها، أو حتى عن نفسه دون أن يهرب أو يجبن.
2 - الشرف كرأسمال رمزي واجتماعي:
ينطرح "الشرف" في المجتمع المغربي كمؤشّر دال وحامل لمكانة الذكر من خلال قوته في إثبات شرفه بين الجماعة؛ وذلك بالقدرة على السيطرة على مجموعة من النساء اللائي أوكلن إليه بحكم التصرف زوجة أو أما أو أختا أو حتى قريبة، كما يحمل مكانة المرأة وأنوثتها وحنانها وعطفها تجاه الرجل ذكرا، سواء أكان زوجا أو أبا أو أخا أو قريبا؛ فالمرأة بأنوثتها ظلت إشكالية الذهنية العربية مع الزمن، كما يقول الباحث Manicke[8]: "ليس من السهل أن تكون امرأة بين الحب والمهنة والوقاحة ثم الفتنة، بين الحنان والحرية"
من خلال هذا يمكن القول إن أهم ما عبرت عنه المجتمعات العربية، انطلاقا من رصيدها الثقافي وممارساتها اليومية هي مسألة "الشرف"؛ فقد بقي هذا المفهوم في المجتمعات العربية ينسج لنا فكر أجدادنا مع حامليه، رافضًا في غالب الأحيان النزاعات المادية والوضعية التي ظهرت مع مرحلة التصنيع في أوروبا. في كل هذا، جعلت المرأة معيار الشرف منذ العصر الجاهلي مثلا مسألة "الوأد"، وأيضا حتى في العصر الإسلامي وإلى يوم هذا، حيث تباينت الآراء والمواقف، وزاد الحديث عن "الشرف" من وجهات نظر فكرية مختلفة.
ومن أبرز ما كتب حول "الشرف" في المجتمعات العربية نجد:
- Julian Pitt-Rivers, « Anthropologie de l’honneur »[9] .
- أبحاث "بيير بورديو" الميدانية التي قام بها في منطقة القبائل (la grande Kabylie)، نجد كتابيه:
- « Esquisse d’une théorie de la pratique »[10].
- « La domination masculine »[11].
ومحاولات أخرى، انطلقت من أبحاث P. Bourdieu في تقريب الفضاء بمفهوم "الشرف" عرضت في كتاب: « Femme, culture et société au Maghreb »[12].
وقد قاربوا مفهوم وقيمة "الشرف" في المجتمعات التي تأسست بنياتها على القوة المجتمعية فيها (الذكورية)، من جهة أخرى يرتبط "الشرف" سوسيولوجيا بالأخلاق، الدين، العرف، القيم...إلخ، وقد تختلف طبيعة الشرف من مجتمع لآخر، وبالتالي من ثقافة إلى أخرى ترسم حدودها المعتقدات والأعراف والتقاليد الاجتماعية والامتداد التاريخي. في هذا السياق يطرح السؤال: إلى أي حد يمكننا رسم حدود ومعالم هذا المفهوم في المجتمع المغربي؟ الحدود التي تربط الشرف بمجموعة من الصفات والرموز التي نعت بها- أي الشرف- كالأنفة، الرجولة، الفحولة، العرض، الحشمة، العار، وغيرها.
3 - قيمة "الشرف" في المجتمع المغربي:
كيف تحضر قيمة الشرف في المجتمع المغربي؟ كيف يتمثل المغاربة الشرف كقيمة إنسانية؟ وهل اختلفت محددات الشرف كقيمة اجتماعية في الثقافة المغربية أمام تحديات العولمة الثقافية؟
يحضر الشرف في مخيال المجتمع المغربي كرمز وجود اجتماعي، ويعبر عنه في الكثير من التعبيرات الشعبية في الممارسات اليومية منذ القدم، فعندما نتأمل العبارات من قبيل:
"واش معندك عراض"، "نمشي نجيب طرف دالخبز بدراعي" "تيغراد"، "واللي معندو دراع ماشي راجل"، "واللي معندها شرف تتبقى بلا زواج" و"يا وين اللي خانوا دراعوا" "الله انجينا وانجيكم من اللي معندو عراض" اللي فيه قلة الحيا معندو عراض "حمرات وجه باها" في تأشير على عفة المرأة وشرفها وأنوثتها.
هذا التعبير الشعبي وغيره كثير، نجده في المجتمع المغربي بشكل كبير جدًّا، خصوصا وأن المجتمع المغربي مجتمع محافظ، ويقدس عاداته وتقاليده، ويرتبط بها في كل أحواله وعوائده، لهذا سنجد أن "الشرف" يعدّ عنصرًا مقدسًا لدى المغاربة، فقد يحضر مرادفًا "للعرض" أو مرادفًا "للكرامة" أو "الجنس" أو "الجسد"؛ وهذه التيمات كلها تشترك بشكل أو بآخر في بعض العناصر.
لقد ارتبط الشرف في المغرب بالصلحاء من أولياء الله والفقهاء والعلماء والطلبة، بسبب حبّهم لكتاب الله وحمله، وتفقههم في الشريعة الإسلامية السمحة، ونظرًا إلى حبهم للعلم وتسليمهم لبعضهم البعض طرح الله عز وجل بركته عليهم، وكان من بين هؤلاء رجالات الله الصالحين وأولياؤه، ولم يخرج عن هؤلاء النساء الصالحات اللواتي كان لهن دورًا كبيرًا في إنجاب الفقهاء والعلماء، وكذلك الشريفات من أهل البيت والمتصوفة والزهاد، أمثال ربعة العدوية وغيرها من النساء. لهذا سنجد أن رحال بوبريك الباحث المغربي يقدم لنا بحثا مهمًّا حول بركة النساء، حيث يقول في هذا الصدد: "لقد رفعت كرامات النساء الصالحات والمجذوبات والعابدات والولهات والمجنونات بما حملته من تجربة روحية لدرجة أكابر الأولياء، بل منهن من سمت المقام الفردانية، وهو مقام القرب الذي يعتبره ابن عربي الدرجة العليا من الولاية"[13].
وتمثلت مكانة المرأة في الإسلام في شخصية البنت التي بلغت سمو المكانة القدسية التي حملته عن طريق إرث أبيها البيولوجي والوحي الديني والرمزي؛ لأنها الوحيدة التي خلفت ذريته بما يعنيه ذلك من استمرارية للإرث البيولوجي للنبي صلى الله عليه وسلم.
لذا، سيظل المجتمع يرى في ذريته أشخاصًا ليس فقط يحملون نسبًا عاديًا بيولوجيا، بل عبر هذا الأخير يستمر البعد الروحي ليس في شكل نبوة، وإنما في شكل جسد مقدس وروح يتم تبجيله وتكريمه من منطلق الانتساب إلى شخصية مقدسة[14]؛ بمعنى من يحمل البركة المؤسسة على العلم والصلاح والكرامات والأصل الشريف من الطبيعي أن يكون متميزًا عمن لا يحوز أي رأسمال"[15]. في هذا الصدد يقول نور الدين الزاهي، يشترط في الفقيه[16] توفره على ميراث يؤهله ليكون تعبيرا بشريا للثقلين؛ كتاب الله وسنة نبيه، ميراث يتشكل من متغيرة الانتماء لآل البيت والقرابة معهم، لكن هذه القرابة ليست نسلية أو بيولوجية بل قرابة روحية. إن الميراث الروحي يحقق الانتساب الكامل للرسول صلى الله عليه وسلم؛ ذلك الميراث الذي يتميز به الصوفية أولياء الله المرشدون[17]، وهذا ما يحيلنا إلى فكرة أنه ليس كل من ينتسب إلى الأصل الشريف فقط هو شريف، وإنما حتى وضيع النسب هو شريف، شرفه من شرف العلم؛ بمعنى أننا نقيس قيمة الشرف بميزان العلم؛ أي شرف المرء يقاس بقيمة العلم الذي يحمله في صدره (القرآن، العلم). ومن خلال هذا المبدأ يعد حملة القرآن الكريم شرفاء بشرف القرآن الكريم، وهذا ما كان ولايزال إلى يومنا هذا في الكثير من المناطق بالمغرب ممثلا في الفقيه المغربي الأصيل، والمريد الحر النقي الشريف الذي لا يزيد ولا ينقص عن أصالة وشرف الفقيه، رغم عدم ارتباط جلّ فقهاء المغرب وإفريقيا بالنسب القرابي الدموي بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت، إلا أنهم أثبتوا جدارتهم وأحقيتهم في الانتساب إلى زمرة العلماء التي بدورها تخول لهم الارتباط الوثيق بالنبي؛ لأن المحبة الإلهية أشرف من نسبة الأبوة الظاهرية.
يرد الكاتب دييكودي طوريس في كتابه تاريخ الشرفاء أنه كان في نوميديا فقيه عادي يعيش في تكمادارت إحدى قرى إقليم درعة، يسمى محمد بن عبد الرحمن الزيداني، الذي نسب نفسه إلى سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، كان فقيهًا ومقرئًا، وبسبب إدراكه سر علم الحدثان، عرف أنه سيكون لأبنائه شأن عظيم في إمارة المغرب، وانطلاقا من هذه الفكرة قرر في سنة 1502 أن يرسل أبناءه إلى الحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن المغاربة الذين يذهبون إلى الحج ويعودون منه يعدّون صلحاء، ولما رجعا أكرمهما البربر وعظموهما، وحيثما حلّا كان الرجال والنساء يهرولون إليهما للثم أطراف ثيابهم[18]، بهذا الفعل طغت ميزة الشرف على الحياة الاجتماعية والسياسية لما لها من أهمية في حياة العامة.
ولعل مفهوم "الشرف" قد يتخذ أنواعًا وأشكالاً وصيغا متعددة، فقد يحضر الشرف ارتباطا بالثروة وهو شرف مرتبط بإيديولوجية الدفاع عن الإرث وامتلاك أكبر قدر من الرساميل المادية والرمزية، والذي يعدّه "بيير بورديو" أحد عوامل التراتبية الاجتماعية[19]، وهو كذلك مرتبط بالميراث العائلي أو التركة أو الأرض، التي تخلق نوعًا من التراتبية في قضية النصاب؛ أي إن هناك نظاما معينا في هذا المجال الذي يحدد تلك التراتبية في الأسرة بصفة خاصة، والمجتمع على وجه العموم، والعرض مرتبط أحيانا بالأرض، فهناك عبارات شعبية مشهورة تقول: "اللي باع أرضه باع عرضه" وهذا ما يوضح أن هناك ارتباطا وثيقا بين ملكية الأرض والشرف؛ بمعنى أن النبيل أو السيد أو المولى هو صاحب الجاه والمال والمالك للأراضي والبساتين.
كما قد يرتبط الشرف بالجسد خاصة في المجتمعات المحافظة والتقليدية، فكلا الجنسين يصر على احترام التقاليد، ويسهر الرجال على احترام الحشمة الجنسية للنساء من أجل أن لا تفسد طهارة نسبهم، وفقدان الشرف يولد "العار[20] الاجتماعي"، والشرف العذري هو شرط وجودي ومهم في المجتمعات الإسلامية والعربية على وجه الخصوص، ولعل المجتمع المغربي واحد من هذه المجتمعات.
فالمجتمع المغربي في الكثير من طقوسه وعاداته الاجتماعية، يقدس ويتشبث بالكثير من الممارسات التي تكون مقدسة في المخيال الجمعي، وإذا ما تأملنا مسألة الشرف في الكثير من الطقوس والعادات الاجتماعية في المجتمع المغربي، سنجد أن هناك طقسًا ما يزال حاضرًا إلى يومنا هذا في العرس المغربي أثناء لقاء العروس بالعريس، وهو طقس مقدس يسمى بـ "ليلة الدخلة"؛ فأم الفتاة تحديدا و"الوزير" أو "الوزيرة" اللذان يكونان مرافقين للعروسين، فإنهما ينتظران نتيجة هذا اللقاء، حيث يتم فض البكارة فإنه يتم حمل جزء من الدم في قطعة من الثوب، ويخرج بها إلى أم العريس، وحينها تقوم بالزغاريد والغناء فرحا بشرف ابنتها، وأيضا يقوم آل العريس بنفس الشيء فرحا بفحولة العريس حسب ما ترويه الرواية الشفهية، فإذا تم ذلك يعنى أن البنت بكر، وحافظت على عذريتها وشرفها وسط القبيلة. أما إذا حدث أمر أو تأخر الإعلان والطواف بالثوب وسط العائلة؛ فمعناه أن هناك مشكلًا، إما في العروس التي ربما قد تكون قد فقدت بكارتها لسبب من الأسباب، أو في العريس الذي لم يستطع أن يكون فحلًا أمام زوجته، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الطقس ما يزال إلى يومنا هذا، وإن بصيغ مختلفة، صحيح أن هناك الكثير من الشباب الصاعد الذي يحاول الإعراض عن هذه الطقوس والممارسات، والتي ينعتها أحيانا بالبدع والخرافة، إلا أن للوالدين كلمة الفصل في ذلك، لدرجة أن هناك من يتحايل على هذه الطقوس بوضع دم مستعار في الثوب، حتى يقنع الآخرين من العائلة ومن حولها أنه خاضع لطقوسهم وممارساتهم.
وبغض النظر عن صوابية هذه الممارسات أو خطئها في المعتقد الشعبي المغربي، فإن ما نستنتجه من كل هذا كباحثين، هو أن هذه الظاهرة تعد من مؤشرات القيمة والثقل الاجتماعي الذي توليه المجتمعات العربية بما فيها المجتمع المغربي لقيمة "الشرف"، وكيف أن البكارة على حد تعبير "مالك شبل": "فرضت نفسها على منظومة التمثلات الجماعية بوصفها مقولة ترمز إلى كائن قائم بذاته"[21].
ولعل الكثير من الممارسات في المجتمع المغربي تجعل البحث فيها أمر ملحًّا، وعلى سبيل المثال: فالرجل لا يحتمل في المخيال المغربي أن يثار اسم أخته أمام الرجال أو زوجته، على اعتبار أن هذا يمس خصوصياته ويمس شرفه، فلا يجب مناداة الزوجة باسمها الحقيقي أمام الغرباء، وهي ظاهرة لاتزال سارية إلى يومنا هذا، وفي الكثير من القرى المغربية، فمثلا إذا دخل الرجل إلى المنزل ومعه ضيف، لا ينادي زوجته مطلقًا، ولكنه يلفت انتباه الضيف بوجودها كالسعال مثلا، أو قول كلام غير مفهوم "تأتأة" أو "أحح" تدل على وجودها، أو يقول عند الدخول "ديرو الطريق" (ouvrez la voie)، (أفسحوا الطريق)[22]، أو إذا أراد أن يناديها باسمها، فإنه يقول عبارة ولا ينطق باسمها مثل "والمرا" أو و"مولات الدار" أو يعمد إلى إرسال ابنه أو بنته ليناديها ويقول له "قول لأمك"، أو في أحايين كثير يناديها بنسبها وينسبها إلى أبيها مثل "وبنت فلان"، ومنه يمكن أن نستشف من خلال هذه الممارسات التمثلات التي يتمثل بها الرجل مكانته وشرفه، فما يحيل على القوة دائمًا يكون في صالح ملك الرجل، وما يحيل على العطف والضعف يحيل على المرأة.
حتى كلمة "الراجل" تعني الرجولة والشرف، ولكنها أحيانا تكون بحاجة إلى مميزات إضافية للتأكيد على ذلك، من بين هذه المميزات، الجانب الفيزيقي للرجل الشارب (La moustache)، وهي علامة ورمز يحيل على الرجولة الإيجابية (La virilité positive)، وهي علامة على شرف الرجل خارجا، وعندما نقول "راجل بشلاغمو"، أو "راجل بدراعو"، أو "راجل بتغرادو"، فكلها عبارات تدل على شرف الرجل وأنه شريف (une homme d’honneur)، دلالة على القوة والشرف والقدرة على العمل لتلبية حاجيات أسرته[23]، وهنا نجد أنه في المجتمع المغربي يتمثل "الرجل" الذي لا يعمل أنه ليس برجل من خلال عبارات دالة من قبيل "كايف"، أو "معندو تغراد"، أو "هذا ماشي راجل"، فهو سبة في حقه؛ لأن "عيب الرجل هو خدمتو وجيبو"؛ بمعنى أن الرجل الذي لا يعمل يفقد شرفه وكرامته، ويصير عيبًا أن يظل طيلة النهار بلا عمل أو شغل، أو أن يمكث بالمنزل اليوم كله، فهذا يعدّ في المخيال المجتمع "عارًا" و"عيبًا".
ومن هنا، برزت إذن كلمة "الرجولة" في معناها عند (Bourdieu)، حيث نراها، وهي مفهوم بارز وعلائقي مبني للرجال الآخرين، أمامهم ولهم وضد الأنوثة في إطار الخوف من الأنوثة وقبل كل شيء من الذات نفسها[24]؛ وذلك سعيا وراء كسب المكانة بين الجماعة في المجتمع المتمثل في "الشرف"، فالشرف يقوي من المكانة الاجتماعية والنجاح الاجتماعي، ويكون هذا النجاح بتراكم مجموعة من الخصائص، التي ترفع مكانة الفرد داخل المجتمع، وتجعله رجلا محترمًا، لكي يكون الرجل رجلا يجب أن يمتلك الشجاعة والقدرة للدفاع عن الشرف. فهذا الأخير إذن "مرآة لشخص صاحبه يعكس بعد الإيمان الديني بقدر ما يعكس منزلة المرء، خلقه وأخلاقه منشأه حسن سمعته أو سوء معاملته"[25]، والشرف هنا إذن، عبارة عن قيمة أخلاقية تتمثل في الشهامة، الرجولة، الصدق، الشجاعة، الكلمة؛ فالرجل الشريف هو الذي يوفي بوعده (العهد) وكل رجل يخرج عن هذه الصفات، فهو غير شريف مثل القاتل، الخائن...أي إنسان بلا كرامة، والشريف هو رجل استثنائي ورمز للجهاد والشجاعة والصدق[26]، تظهر نعمة الشرف على الإنسان المتخلق بالخلق الحسن من خلال سلوكياته وأفعاله وأقواله، إذا عاهد وفى، وإذا تكلم نطق حكمة وصوابا.
في مستوى آخر، إن الرجل في مخيال المجتمع المغربي شرفه في عفة زوجته وإخوته وبناته، وأن سمعته ترتبط بسلوك النساء اللواتي هن تحت وصايته ومسؤوليته، إلى درجة أن جريمة القتل تعدّ أمرًا مبررًا، إذا لطخ هذا الشرف، والمرأة بالمقابل ملزمة بحماية شرفها الذي لا يعدّ مسألة شخصية بقدر ما يمس العائلة وكرامتها وعرضها. ولهذا توضع أمامها العديد من الضوابط والقوانين في علاقتها بالجنس الآخر، ويخضع سلوكها لرقابة اجتماعية صارمة، وأي موقف مقلق منها أو مشكوك فيه على حد تعبير "[27]Boucebci" يسقط هيبة السلطة الذكورية، ويهدد الأمان الداخلي والخارجي للعائلة، وبالتالي تتعلم أن تحافظ على نفسها من أجل رجل هو زوجها، والذي يرى العذرية حقًّا من حقوقه.
المرأة إذن في المجتمع المغربي وكل المجتمعات العربية الإسلامية عمومًا، لا ينظر إليها ككيان مستقل بذاته، بل إن مقاربة قضاياها متعلقة بمقابلتها وربطها بالجنس الآخر "الرجل"، وحتى بعض التسميات العامية التي يستعملها المغاربة في حياتهم اليومية تحيل على "شرف البنت"، ويربطونه بـ "شرف الأب" و"العائلة" ككل، فمثلا عبارة: "بنت الفاميلا" أو "بنت العائلات" "بنت الأصل" أو "بنت الناس" هو لقب اجتماعي أسس وفق عدة معايير وقواعد أخلاقية وسلوكية متعلقة بالمرأة بوصفها رمزًا للشرف، فهو يحمل دلالات رمزية منها ما هو متعلق بالأخلاق، ومنها ما هو متعلق بالسلطة الرمزية للعائلة، وهو توصيف يمكن اعتباره صفة تنعت بها "المرأة الشريفة" التي يسعى ويتنافس الشباب لخطبتها، فهو يحمل ضمنيًّا معاني رمزية أخلاقية ومحددات قيمية وسلوكية تحيل على الشرف والحياء والحشمة، وكلها تعدّ "مجموعة من الإجراءات الوقائية الهادفة للحفاظ على الشرف، ومن ذلك فصل الرجال عن النساء فيزيقيا ومكانيا، وفرض مواصفات خاصة لزي وسلوك المرأة في اللحظات التي يستحيل فيها الفصل[28]، على اعتبار أن "الحشمة" بالنسبة إلى الفتاة أو المرأة هي الوسيلة التي تعبر بها تلقائيًّا عن استيعابها للدروس الخاصة بما هو عيب و"حشومة" وحرام.
وعليه، يمكن أن نستنتج من كل ما تقدم أن "العذرية" كانت وما تزال الدليل الملموس على شرف المرأة، مما يجعل الخوف عليها ومنها الهاجس الأكبر لدى المرأة ذاتها والأسرة بأكملها، الأمر الذي خلق لديها العديد من الميكانيزمات الدفاعية ضد الإقصاء المجتمعي، حيث يعكس كل ميكانيزمات ذهنية خاصة حسب ثقافة المجتمع.
- قدسية/رمزية "البركة" في تمثل المغاربة
1 - مفهوم البركة:
يعرف المعجم العربي لفظة "البركة" بـ "الخير والنماء والأمن والسلام، ويقال بارك الله فيك؛ أي أحفظ باليمن والخير، وتبرّك بالشيء أي التمس بركته، وتبارك أي تقدس، واستبرك بالشيء؛ أي تفاءل به خيرا والتمس نعماءه[29]. وفي لسان العرب لابن منظور تعني البركة "الزيادة والنماء، وبارك الله الشيء وبارك فيه وعليه أي وضع فيه البركة"[30]، وقال الفراء في تفسير الآية: "رحمة الله وبركاته عليكم" إن البركات هي السعادة، وفي حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعني "بارك على محمد"؛ أي أثبت له وأدام ما أعطيت من التشريف والكرامة، وأصل المعنى من برك البعير إذا أناخ في موضعه فلزمه، وعن ابن عباس فلفظة "البركة" تفيد الكثرة في كل خير، وتعني عبارة "تبارك الله"؛ أي تعالى وتعاظم وتقدس وتنزه وتطهر، كما تقصد عبارة تبارك بالشيء تفاءل به، والمبارك ما يأتي من قبله الخير الكثير.
ويقول الأستاذ فوزي الصقلي في كتابه "أولياء وأضرحة فاس" إن البركة حسب قاموس العادات لأحمد أمين تعني سر الله والرسول والأولياء في الأشياء، وهي بذلك ميزة لدنية من عند الله، يلهمها ما شاء من مخلوقاته أكانت نعما (الماء والمأكولات وباقي الأرزاق) أو بشرا (الرسل وباقي الأولياء) والأماكن (البقاع المقدسة)، والأزمنة والشهور (كليلة القدر، والأشهر الحرم، وبعض ساعات وأطراف النهار)[31].
نستنتج من هذا التعريف، أن مفهوم "البركة" يستمد روحه من القداسة النابعة من الدين، وبالتالي فمصدرها إلهي، كما أن تاريخ المغرب الثقافي الشعبي حافل بمؤسسات وممارسات سياسية واجتماعية وعقدية مثل الزوايا واستجداء الأولياء توفر مناخًا خصبًا لتجذر مفهوم "البركة" في النسق الثقافي المغربي، ومن ثمة في التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية؛ ذلك أن الربكة لا تخترق جل أنساق الاعتقاد وأنواع الممارسات الشعبية فحسب، بل تؤثر أيضا في التجارة والخدمات والدراسة واكتساب المهارات الحرفية والفنية، وبالتالي أصبحت تتخلل أنواع السلوك والمعاملات بين الأفراد والجماعات من خلال المعتقدات والعادات والطقوس السائدة في الثقافة المغربية والمتجذر في المخيال الجمعي المغربي.
2 - رمزية البركة في المتخيل الشعبي للمغاربة:
لقد خصص "إدوارد فستر مارك"[32] في الجزء الأول من الكتاب المذكور حيزًا لا يستهان به من الكتاب لمفهوم البركة كركن من أركان الاعتقاد الشعبي لدى المغاربة، فأخصها بحجم 226 صفحة من أصل 608 صفحة، قسمها إلى ثلاثة أقسام هي: انتشار البركة، وأثرها وتجلياتها، ثم قابليتها للتأثر. فحسب المفكر "فستر مارك"، الاعتقاد السائد في المغرب حول البركة هو أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يمتلك نصيبًا من البركة لم يمتلكها غيره أحد من قبله، وانتقلت هذه البركة إلى الشرفاء[33] من نسل ابنته فاطمة، خاصة منهم الذكور، غير أنه لم يمتلك منها القدر الموجب لدرجة الولاية إلا القليل، كما أن البركة تقل عند أبناء من أبٍ من أصل "شريف"، وأمٍّ من ذلك الأصل. ومن دون هؤلاء الشرفاء أو "الشرفة" وهم كل من استطاع أن يثبت نسبه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأي شكل من الأشكال، تمتلك البركة أيضا من قبل أولئك الذين ينتمون إلى عائلات "المرابطين"، وينحدر أصل هذه العائلات من نسل شخص على درجة معينة من القداسة والولاية، لكن ليس من نسل "شريف"، ويستمد "المرابطين البركة عبر الوراثة".
ولعل التعريف المغربي لـ "المرابطين" هو أنهم "خدام الشرفة"، ويعتقد المغاربة أيضًا أن المرء يصبح "مرابطا" بعد أن يتلقى البركة من "شريف" ولي، أو بالصدفة من ولي كان يخدمه، وهذه البركة قابلة للتوارث داخل نسل "المرابط". وفي السياق نفسه، هناك من بين سكان الجبال في شمال المغرب من يمتلكون البركة ويدعون "لمعمرين"[34]، ويعرفون بأنهم نسل من شخص أصبح وليًّا صالحًا بعد أن مُلئ بالبركة من لدن آخرين.
ويكتسب المرء البركة عن طريق "الملء" إذا كان خادمًا لولي صالح؛ وذلك بطرائق شتى إحداها أن يبصق الولي الصالح في فم خادمه، فتمر عندئذ البركة لتستقر في الخادم. وأيضا أن يتناول الولي الصالح، في آخر عشرته مع خادمه، طعاما ويأمره بأكل ما تبقى، وعند انتهاء الخادم أو "لخديم" يقول له الولي: "نتا لي ديتي لخبزة"؛ أي "لقد حزت بركتي". ومن بين أشكال انتقال البركة من شخص إلى آخر لدى "فستر مارك" ما يدعو إلى الاستغراب[35]، حيث تنتقل البركة عن طريق الجماع بين الولي الصالح وامرأة، وإن كانت هذه المرأة متزوجة، فلن يعتبر ذلك حرجًا لأهلها وخاصة لبعلها، بل مبعث فخر وتفاؤل، كما أن ذلك يكون موضوع تهاني الجيران.
وفي بعض الأحيان، قد تنتقل البركة ضد رغبة حائزها. ويمثل فسترمارك لذلك بحقيقة أن بركة سلطان ما تنتقل إلى سلطان جديد بواسطة السلطان نفسه الذي عادة ما يعين خلفه بنفسه، هذا الخلف الذي عادة ما يكون أحد أولاده، غير أن هذه البركة قد تنتقل إلى راغب آخر في الحكم يطمع حيازتها في حياة السلطان، مثلما حدث لبوحمارة الذي حاز بركة السلطان، فمررها إلى أخ شقيق لهذا الأخير "مولاي امحمد"، والذي كان آنذاك سجينا فامتلكها لسنتين، وكمثل آخر يضيف فسترمارك أن شرفاء وزان لا يتورعون من سرقة بركة زائريهم من الشرفاء، إذا ما حدث أن ترك هؤلاء في متناول مستضيفيهم ما تبقى من طعامهم، حتى ولو كان عظما[36].
لذلك، يتحرز بعض الشرفاء من مصافحة شرفاء وزان، كما يتفادى بعض أهالي فاس الذين يحجون إلى ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش لدى قبيلة بني عروس، الرجوع عبر وزان، ويختارون لذات السبب طريقا أطول مخافة أن يسلبهم شرفاء وزان البركة التي استجلبوها لأنفسهم بزيارتهم الضريح المذكور، وللغرض نفسه أيضا، يدأب شرفاء وزان ألا يقدموا لضيوفهم الخبز إلا وقد أكلوا منه وقطعوه أجزاء متعددة تفاديا لضياع البركة منهم[37]. ومن موجبات البركة أيضا، الورع الشديد وكثرة تلاوة القرآن وقضاء الوقت في الصلاة والاستمرار في الصيام، وإطعام "الطلبة"؛ أي حفظة القرآن، وإيتاء الزكاة للفقراء وترك المحرمات. ولعل من أيسر الطرائق لإحراز البركة كذلك، الاختلاء في جبل مبارك من طينة "جبل لخضر" في دكالة، أو السكن لدى ضريح ولي صالح معروف.
في مستوى آخر، يمكن الحديث عن علاقة البركة بالأشخاص والمناسبات، إن البركة في الثقافة المغربية ترتبط بمراحل حياة الإنسان، فيعد الصبي والشيخ المشتعل رأسه شيبا ذوي بركة، لذلك من جمالية القيم المغربية عند المغاربة، أنهم يحترمون كبار السن ويقدسونهم ويحسنون إليه ويساعدونهم، وينادونهم بـ "عمي الحاج" أو "خالي الحاج" وهذا تعبير عن بركته وقدسيته واحترامه"، كما يتصف بها أيضا الوالدان وعابرو السبيل وتلامذة "المسيد"، كما تشكل الطقوس مصدرًا للبركة، فالختان يضفي بركة على الطفل، ويبارك الزواج في حديثي العهد به. ولم ترتبط البركة بالإنسان فقط، بل امتدت حتى إلى الأمكنة، نظرا إلى أهميتها وميزتها الخاصة في نظام القداسة والتقديس في الثقافة الشعبية المغربية، وتأتي في أول لائحة الأماكن المقدسة أضرحة الأولياء، [38] سواء أكانوا معروفين أم غير معروفين؛ لأن المكان يستمد البركة من جثمان الولي الصالح، كما تستمدها النباتات والأشجار المحيطة بقبره، بعد ذلك يأتي "الكركور" وهو ركام من الأحجار مجاور لضريح ما، نشأ بفعل الأحجار التي يرمي بها عابري السبيل عندما يمرون بضريح ولي صالح دون أن يقوموا بشكليات زيارته، لكن أحيانًا يكون "الكركور" علامة على مكان مواراة ولي، أو خلوته أو إقامته، إلى غير ذلك.
ويقدم فسترمارك مثالا على "الكركور" بذلك الموجود بمركز حفرة تدعى "حفرة مولاي إدريس" التي تشكلت وتكونت؛ لأن الناس ذات زمان تمادوا في جلب التراب من المكان الذي أقام فيه مولاي إدريس الأب لأجل بركته، حتى أضحى المكان عبارة عن حفرة. وفي أماكن مختلفة من المغرب يسمى المكان الذي اعتقد أن وليا صالحا معينا قد أقام فيه ب"لمقام"، وغالبا ما يكون مكان كهذا محاطا بالأحجار لتتبين حدوده، كما لا تستثنى من هذه الأمكنة الكهوف وعيون الماء[39]، والجبال والصخور الضخمة. ومن بين الأمكنة كذلك، يحظى البحر في الثقافة المغربية بقدر وافر من التبجيل بالنظر إلى بركته، لذلك يعول عليه كثيرًا في الاستشفاء والحماية واكتساب الرزق، وإنهاء العقم وإبطال مفعول السحر. كما يستجدى البحر في طلب الأزواج، فتقدم له القرابين كالخبز والتيس الأسود والنقود الفضية. وكما أن للمكان بركته، فللزمان أيضا نصيبه منها، ذلك أن بعض الشهور والأيام والمناسبات تعتبر ذات بركة ومن الأجدر التعامل معها كما يجب ويليق[40].
لم تبخس الثقافة الشعبية المغربية الحيوانات[41] حسب مارك فسترمارك نصيبها من البركة، فتكتسب القطط والحمير بركتها لمصاحبتها للأولياء الصالحين أو استقرارها بأضرحتهم. أما القطط، فتنال حظها من الهدايا المقدمة عند الزيارة. وأما الحمير، فمنها ما نفق وبني عليه، فصار ينال من التبجيل ما لا يناله البشر، وتبجل أيضا الغنم والجمال، كما أن هناك بعض الأسمال المقدسة التي تحظى لبركتها باحترام خاص فلا تصطاد[42]، بل إن هناك من يخرجها من الماء ليقبلها ويرجعها إلى الماء ثانية، وهناك من يناولها من الكسكس قبل أن يتناوله هو ليحوز بركتها، ولعل أجدر حيوان باستحقاق البركة والقداسة هو الحصان، فهو يضفي البركة على صاحبه وأهله، فبركته تعدل بركة أربعين حامل قرآن في المسجد[43]، كما تنفر الشياطين والأرواح الشريرة من حوله؛ ذلك أن هذه الأخيرة تطير حينما يقوم بالصهيل.
وهناك أمثلة كثيرة على مفهوم البركة وتجلياتها، فالثقافة المغربية أضفت البركة على الكثير من الأشخاص والأشياء والحيوانات، سواء في الحشرات والطيور أو الأمكنة أو الحبوب والخضر أو الأسماء والأرقام والكواكب، وهذا يوضح تمثلات المجتمع المغربي ونظرته إلى الكون بكل مكوناته، وأن مفهوم البركة ركن أساسي في الثقافة الشعبية المغربية، فهو مجتمع يقدس البركة ويراها مصدرًا للصلاح والفلاح والخير والنماء، ومهمتنا كما يقول الدكتور عبد الرحيم العطري لا تنحصر في البحث عن عقلنة ممكنة لهذه الممارسات التي تتم في رحاب الأضرحة، ولا التأكد من وجاهتها أو محدوديتها، وأساسا في جوانب الكرامة وما يتصل بها من انخراق وعادة وإبراء وتيسير ومباركة، بل المهم هو فهم حقل الإنتاج والتدبير الرمزي لحياة المجتمع، والسؤال عن الكيفيات التي يعاش بها المقدس ويستثمر ويستنزل، يعد ضروريًّا لإدراك وتمثل مفهومه، فالتجربة التي تختبر فيها العلاقة بين المقدس والدنيوي، تصير مدخلا لفهم الأبعاد الاجتماعية لتدبير علاقات القوة والمعنى[44]، وبالتالي البحث في مفهوم البركة في حقيقته هو بحث في الأبعاد الخفية والكشف عن ممكنات التأويل للطقوس والممارسات والتمثلات للمجتمع، أملا في الفهم والتفسير.
- العرف "أزرف" كمعيار اجتماعي لتدبير اليومي
1 - مفهوم العرف:
إن أهم ما أنتجته ثقافة المجتمع المغربي ما يعرف بـ "العرف"/ أو "أزرف" باللهجة الأمازيغية أو "العادة" أو "القاعدة" بوصفها تسميات لمعايير اجتماعية كمحددات لسلوك الأفراد، حيث يعيش الإنسان المغربي في مجتمع يتلقى من خلاله تصورات عديدة وأفكار وسلوكيات يكتسبها من الثقافة في إطار ما يسمى بعملية التثقيف، ومن خلال عملية التنشئة الاجتماعية حيث يتلقن الإنسان المغربي قواعد مجتمعه/ قبيلته أو المعايير الاجتماعية التي من خلالها يتصرف ويراقب ويتفاعل، فهي إذن تلعب دورًا مهمًّا في تنظيم المجتمع بصفة عقلية، في إطار ما الظروف والسياقات التي يعيشها المجتمع. فالعادات والتقاليد الشعبية تقدم صورة متكاملة عن حياة أي مجتمع؛ ذلك لأن من خلالها يمكن فهم ثقافة المجتمع المغربي، كما تمثل ظاهرة تاريخية ومعاصرة معا؛ لأنها تعبر عن مجموع السلوكيات التي يكتسبها الإنسان ويتوارثها من جيل لآخر. فما دلالة "العرف"؟ ماذا يشكل العرف بالنسبة إلى المجتمع المغربي؟ وما رمزيته في المجتمع المغربي؟
لقد استُعمل مصطلحا Mores وCoutumes كثيرا للدلالة على العرف، ولقد تعددت تعاريف العرف، ولكن تتفق كلها في كون أن العرف يطلق على العادات التي تمتاز بشدة الإلزام؛ أي العادة التي يلزم المجتمع الفرد القيام بها بغرض الحفاظ على كيان الجماعة. ويقصد بالعرف ما اتفق عليه الناس من سلوك معين يتعلق بجانب من جوانب حياتهم الاجتماعية لفترة زمنية طويلة مع إلزامية تطبيق هذه القواعد داخل القبيلة مخافة التعرض لأشد العقوبات المادية والمعنوية لكل من مخالف. وبهذا، فهو كل ما اعتاده الناس في تسيير شؤون حياتهم[45]. كما يطلق العرف على القواعد القانونية المستمدة منه، بوصفه المصدر في المجتمعات الإنسانية الأولى، فكانت القواعد القانونية تنبع من الجماعة ذاتها بطرائق مباشرة من غير تدخل الحاكم، فكان الناس يسيرون وفقا لعادات وتقاليد يتوارثونها جيلا بعد جيل ويحافظون عليها[46]. والعرف بضم العين، هو في أصل اللغة بمعنى المعرفة، ثم استعمل في اصطلاح الفقهاء "ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول"[47]، ثم زيد له في الأخير "بشرط أن لا يخالف نصا شرعيا"[48].
وإذا كان المفهوم اللغوي "لأزرف" بمعنى الطريق المستقيم "أغراس" أو "أبريد" لا يشكل أدنى صعوبة، فإن نقطة اختلاف الباحثين تكمن في التعريف القانوني لأزرف وفي إيجاد مرادف لهذا المفهوم في اللغات التي يكتبون بها، فهو عند البعض قانون وعرف[49]، وعند البعض كلية الحقوق ثم القضاء الجماعي[50] أو الحق[51]، ليصطلح عند البعض الآخر، إما بالعدالة الأمازيغية[52] أو بالقانون الأمازيغي[53]. لكن يبقى التعريف شاملا لهذه المنظومة من التعاريف التي أعطيت له بوصفه كتلة من المفاهيم المرتبطة بينها، العرف، العدالة، القضاء، والقانون والحق... والتي تنتمي إلى حقل واحد هو الحقل القانوني بمختلف تشعباته. ونشير هنا، أنه نادرًا ما نصادف نصوص "أزرف" مدونة، الشيء الذي يجعلها تتسم بصبغة المرونة والتشعب تبعا للحيز الزمكاني الذي تطبق فيه.
غير أن فلسفة "أزرف" وروح مبادئه قارة وموحدة في العمق في جميع القبائل، كما تجدر الإشارة إلى أن المجتمع المغربي يضم نوعين من "أزرف" حسب جورج سوردان[54]: أحدهما مكتوب وهو القانون الجنائي أو العقابي، ويختص بكل أنواع الجرائم والغرامات المخصصة لها، والثاني شفوي وهو القانون المدني. وقد تتسم الأعراف بنوع من الصرامة عندما تصير "تعقيدت/ تعقيدين" السائدة لدى قبائل المغرب الشرقي، وهي "تجميع مرن للأعراف والتقاليد والأخلاق المتعارف عليها عبر القرون، ويتم التجميع بإملائها على فقيه القبيلة لعدة أيام غالبا، حيث تنضاف البنود واحدة تلو الأخرى حسب تذكرها، الأمر الذي يعطيها طابع التلقائية، ويجعلها غير مبوبة وغير مصنفة وغير تابعة لأي معيار تصنيفي، كما يمكن إغناؤها حسب وقائع جديدة أو من طرف "أمغار"[55]. بينما قبائل الريف تطلق عليه اسم "القانون" وغالبا ما يطلق عليه في سوس أسماء مختلفة مثال "لوح" و"آمقون" و"ديوان" في حين أن قبائل الصحراء تسميه قانون "اجماعة" أو "آيت ربعين".
وهكذا إذن، يتضح أن العرف يعدّ أفضل القواعد القانونية؛ لأنه نشأ تدريجيًّا من طرف أفراد المجتمع وبرضاهم ويلتزمون به في حلّ مشاكلهم اليومية، ولأنه يتماشى مع العادات والتقاليد، فهو تعبير عن إرادة المجتمع؛ أي الجماعة وليس إرادة السلطة المركزية. وهو درس تاريخي يعبر عن العمق الأنثروبولوجي والسوسيولوجي للمجتمع المغربي؛ لأنه وببساطة تعبير ملائم ومطابق للحياة اليومية برهاناتها الفعلية، وليس المتخيلة أو المنتظرة أو النظرية أو المقتبسة. لذا، فإن أي مجتمع إنساني لا يخلو من مثل هذه القواعد والضوابط التي تعارف عليها أفراده في علاقاتهم وعاداتهم، وما شابهها من معاملات وأعراف وقوانين لضبط سلوكياتهم الاجتماعية وتنظيم حياتهم ومستوى عيشهم[56]. ومن هنا، نستنتج أن نشوء العرف رهين بنشوء المجتمع الذي يسعى إلى المحافظة على استقرار واستمرار الحياة الاجتماعية وفق قواعد وضوابط ومعايير اجتماعية منظمة.
2 - قيمة العرف في المجتمع المغربي
من بين الأعراف والتقاليد التي تنتشر واعتاد المغاربة على فعلها بطريقة طقوسية، ما ذكره "الونشريسي" في كتابه: "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب"، فالعديد من العادات والتقاليد في المغرب التي تخص الأعياد والاحتفالات، لا يخرج عنها المغاربة، ومن أمثلة ذلك الاحتفال بالمولد النبوي، حيث اعتاد الناس على إيقاد الشمع، وإمتاع البصر، وتنزه السمع والنظر، وتزيين بما حسن من الثياب، وركوب فاره الدواب[57].
كما اعتاد أهل المغرب الأوسط والأقصى أن يعطوا لمعلميهم شمعًا في المولد النبوي[58]، لذا ما كان يفعله المعلمون من وقد الشمع في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، واجتماع الأولاد للصلاة عليه، ويقرأ ممن هو حسن الصوت من القرآن، ونشيد القصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، ويجتمع الرجال والنساء[59]، واستكثار الصدقة وأعمال البر، وإغاثة الملهوف، ونصر المظلوم[60]. وقد ذكر لنا أيضا "التنسي" في "نظم الدر" عن هذه الليلة بقوله: "كانوا يحتفلون بليلة مولده، بأعظم الاحتفال، ونسجه ونسج أبيه على المنوال، ويرفع إليه من الممادح الغر الحجال ما يزرى بالأمداح...ويثيب عليها من عظم المنوال بما تم السمع بمثله في سالف الأحوال"[61].
أما عن هلال شوال، فكان لا يثبت إلا بشهادة عدلين فأكثر. أما في القرى، فكانوا يقومون بإضرام النار من قرية إلى أخرى إعلامًا برؤيته مع ثقة بعضهم ببعض[62]، ثم بعدها يذكر كيف كانت تقام ليلة القدر عن طريقة الفقراء، فيجتمعون ويذكرون الله عز وجل، فيأخذون في الغناء والرقص ثم يأكلون[63]. وعن عيد الأضحى، كان أهل المغرب يقدمون من الأضحية للمعلم والقريب والفقير والجار ونحوهم، وأن يطعموا منها الضيف؛ أي يصنع منها طعاما لكل مسلم بخلاف اليهودي وأجير الخدمة[64]. واهتم أهل المغرب أيضا، بالولائم والاحتفالات في أعراسهم، فقد اعتاد الناس في الأعراس حضور الملاهي، وصفة العرس هي أحضار المزامير ويذبح ثورا أو ثورين أو أكثر[65]، ومن الولائم التي كانت عند أهل المغرب، أنهم كانوا يحتفلون "بختان الطفل" فيقيمون بهذه المناسبة مأدبة يدعى إليها الأهل والأقارب، كما وجد ما يسمى "بالصنيع" وجدت فيها مجالس اللهو والطرب التي كان يصحبها غالبا النفخ بالبوق والضرب على العود[66]، وعن "وليمة النكاح" فهي تشمل الملاهي وأصوات النساء[67].
3 - نماذج من الأعراف بالمجتمع المغربي
يجمع مختلف الباحثين والدراسين على أن الأعراف هي مجموعة من القوانين والضوابط الأخلاقية والإجرائية، اعتمدت عليها القبيلة لتنظيم جوانب الحياة العامة والخاصة بها، وقد تأصلت في هذه الأوساط منذ القدم وتوارثتها الأجيال أبا عن جد، غير أن الأعراف نسبية في المجال والزمان؛ إذ تختلف من منطقة إلى أخرى، كما تتغير وتتجدد بمرور الزمن، والذي يهمنا هنا ليس دراسة القوانين العرفية من الناحية الدينية أو الأخلاقية، بل دراستها كسمة أساسية طبعت المجتمعات الأمازيغية.
وعلى الرغم من انتشار الإسلام بشكل واسع في المغرب، ظلت المجموعات القبلية تحبذ التعامل بترسانة من الأعراف المتوارثة إلى حدود القرن 19م، وإن لم نقل إلى حدود اليوم كانت ولاتزال هناك مؤسسة "الأمغار" التي تسعى إلى فرض احترام وتطبيق الأعراف المتعارف عليها لدى كل مجموعة قبلية. وعلى الرغم من تغلغل الشرع إلى الأوساط القبلية مع الصلحاء والمرابطين "إكرامن" الذين حاولوا تأسيس جملة من الزوايا والرباطات، فإن العرف ظل يقتسم الحياة التنظيمية والاجتماعية مع الشرع، بينما في مناطق أخرى على أعرافها المخالف للنص؛ وذلك لأسباب موضوعية[68]، والتي ربما تكمن في انطواء الشرع على عقوبات زاجرة نوعا ما في نظر هذه المجموعات البشرية التي لم يتمكن الإسلام من اختراقها.
دور العرف في التنظيم الاقتصادي
الأرض: يعطي القانون العرفي أهمية كبيرة للأرض نظرًا إلى كون عملية استغلالها تلبّي الحاجيات الضرورية من المواد الغذائية للساكنة، كما يبجلها؛ لأنها تكتسي أهمية كبرى على المستوى القانوني، حيث تستغل كل الاستراتيجيات للحفاظ عليها، ويكون العرف نفسه أهم استراتيجية للحفاظ على وحدة الأرض؛ لأن وحدتها من أهم الأسس المادية التي يقوم عليه إلتحام الجماعة العائلية، كأدنى وحدة دفاعية داخل القبيلة. لذلك، نجد أن الأرض كانت تشكل أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تماسك وتضامن القبيلة، كما أحيطت بكل القيود العرفية لكي لا تخرج عن القبيلة بشكل عام، هذا الوضع هو الذي رفعها إلى مستوى القداسة[69].
الماء: يخضع الماء في تسيير وتنظيم الاستفادة منه لضوابط عرفية صارمة، حيث تعمل "تاجماعت من نتقبيلت" على توزيع الحصص في السقي بين أفراد القبيلة، ففي كثير من المناطق والقرى المغربية نجد أن الماء يتم تقسيمه عبر حصص في اليوم الواحد أو الأسبوع، حيث إن كل أفراد القبيلة ومكوناتها الإثنية تستفيد من حصتها بشكل أو بآخر بطريقة عرفية، وهنا نلاحظ كيف أن المجتمع المغربي يدبر حياته اليومية باعتماد العرف كدعامة أساسية في تنظيم القبيلة والمجتمع. فالعرف يقوم بتأطير حقل الممارسات الطقوسية التي تتخذ من الماء قيمة اجتماعية وظاهرة قدسية تستقطب اهتمام الجميع، فهو من جهة يحدد شكل الاحتفال وعناصره وهوية المتدخلين في إحيائه حسب قيمه الثقافية وأبعاده الاجتماعية، وموقع وجنس كل فاعل داخل النسيج الاجتماعي، ومن جهة أخرى، تقوم هيئة "الجماعة" والتضامن والعصبة القبلية والإلتحام بالمساهمة في إنتاج أعراف متعددة الوظائف، تنتمي إلى حقول معرفية مرتبطة بطبيعة الاهتمامات وانشغالات الساكنة مثل الماء وأشكال توزيعه بينهم، وطرق الزراعة وشكل الموسم الفلاحي...إلخ[70]، لهذا فالماء يظل مرادفا للحياة والوجود وضده الموت والفناء، وعليه يصبح هذا المورد بؤرة كل التنظيمات والعلاقات الاجتماعية التي ينتجها المجتمع على شكل شبكة من التفاعلات والعلاقات المنصهرة فيما بينها.
في تنظيم العمل وطرائق الإنتاج
المغارسة: تكون بتعاقد صاحب الأرض مع المستفيد الذي يأخذ على عاتقه مسؤولية غراسة الأرض ورعايتها لمدة معينة قد تصل إلى خمس سنوات؛ وذلك مقابل الربع أو الخمس أو الثلث من الغلة حسب الاتفاق، وبعد انتهاء المدة المحددة يأخذ المغارس الحصة المتفق عليها من الأشجار والأرض معا.
المزارعة: ترتبط بالخصوص بالحبوب، حيث يلجأ مالك الأرض إلى استغلالها عن طريق شخص آخر يستفيد من ربع أو خمس الإنتاج حسب الاتفاق، وحسب مساهمة الأطراف بوسائل الإنتاج والبذور، غير أن هذا النوع من العمل يدور حول شخصية الخماس التي تتجاوز مهمته أعمال الزراعة والحرث والحصاد والدراس، إلى مهام النساء من جلب الماء والحطب وتنقية الحقل وتقديم الكلأ للماشية فضلا عن أعمال التسخير والحراسة وتنظيف الحظيرة وغيرها، فلا يتعاطى لهذه المهنة إلا المستضعفون من القوم وكذلك الوافدين.
ويرجع أساس هذا الاستغلال إلى قاعدة عرفية تقول إن "الخمّاس" لا يساهم إلا بقوته العملية، في حين يساهم المالك بأربعة أسهم، وهي: الأرض، الزوجة ووسائل الإنتاج، الحبوب، الأكل والشرب، وتجدر الإشارة إلى أن صاحب الأرض يساهم أيضا بالعمال في أوقات الحصاد والدراس إلى جانب الخماس[71]، وهناك شكل آخر من المزارعة يتعلق بالمزارعة بالنصف في الوقت الذي يساهم فيه المستفيد بالنصف من الحبوب ووسائل الإنتاج المتنقلة وقوته العملية. أما النوع الثالث، فهو المزارعة بالثلثين، حيث يأخذ المزارع الثلثين، ثلث الصائر وثلث الربح، مقابل المنتوج لصاحب الأرض، وتنتج هذه الوضعية عندما يساهم المالك بالأرض فقط، ويتكلف المستفيد بوسائل الإنتاج والحبوب والعمل.
في تنظيم المراعي
نظرًا إلى كون أعداد رؤوس الماشية محدد للثروة والمكانة الاجتماعية، تزايد اهتمام سكان القبائل بالماشية، مما خلف الرغبة في مراعٍ تستوعب الأعداد الكبيرة للقطعان، وتزامنت هذه الوضعية مع التقلبات المناخية وانتشار الزراعة على حساب الغاية بشكل متزايد، دفع بالقبائل إلى تأسيس ما يسمى ب"أكدال" بمعنى المراعي الجماعية.
ويتم تنظيم هذه المراعي الجماعية من طرف "أمغار" الذي تعينه القبيلة، ويتم تحديد المجال المحدد لـ "أكدال" الذي يمنع فيه الرعي منذ الانتهاء من الحرث (15 يناير إلى 21 أبريل)، ويعلن عن افتتاح هذا المجال "أكدال" أمام كل سكان القبيلة من طرف "أبراح/البراح"، وكل من يخالف الأعراف بالرعي في "أكدال" قبل إعلان فتحه يتعرض لعقاب تحدده القبيلة مثل ما يعرف بـ"النصاف"، والذي يعرض فيه على "اجماعة" إما غذاء أو عشاء أو دفع غرامة مالية.
في تنظيم العلاقات الاجتماعية
تشير الرواية الشفوية إلى أن الزواج بمقتضى العرف، وأنه يتوافق مع الشرع في بعض الشروط، حيث يكون حضور والي الطرفين إلزاميًّا، كما كان الحال لمختلف التعاقدات، وكما يكتفي بالإشهاد عند "الطالب" الذي يقوم بتوثيق العقد، هذا بالإضافة إل تقديم صداق يكون رمزيا من (سكر وتمر وحناء ومبلغ مالي)، أما الطلاق، فقد كان يتم هو الآخر بالإشهاد دون التزام الزوج المطلق بتعويضات ونفقات العدة. أما وضعية الأبناء، فكانوا مخيرين بين الأب في النسب والإرث، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر مع إمكانية المراجعة بين الزوجين طبقا لمقررات الشرع، كما هو الحال في كل القبائل الأمازيغية، حيث كانت المرأة تحصل على نفقات أيام العدة.
السرقة: في حالة ثبوت السرقة، فإن السارق يطالب بإعادة ما سرق أو معاقبته بمصادرة مثل ما سرقه من أملاكه الخاصة لصالح المسروق، كما يتم طرده من القبيلة، وفي حالة ثبوت الجريمة يؤدي المتهم اليمين بعد استدعاء "أمغار" وبحضور ما يزيد عن 25 شخصًا.
في الطقوس والعوائد
تمارس عادات وطقوس عديدة ذات ارتباط بالحياة الاقتصادية والاجتماعية من زواج ووفاة وختان وعقيقة وزراعة وتجارة وغيرها. ومن الأمثلة على ذلك "تلغنجا أو تاغنجا[72]".
وعمومًا، من خلال هذا الوصف لبعض الأعراف المنظمة للحياة الاجتماعية بالمجتمع المغربي، يتأكد أن العرف كان ينطوي على أشكال استغلالية خاصة في العلاقات الإنتاجية في المجال الاقتصادي، وبالضبط في استغلال الأرض والمياه، لكنه كان يسعى باستمرار إلى تنظيم المجال والحد من التعارض خاصة ما يبرز من خلال الأشكال التكافلية التضامنية، والتي تعبر عن روح التعاون والانصهار داخل مستوى القبيلة ورفض كل النعوت الانقسامية.
مجمل القول وبناء على ما سبق، نخلص إلى أن العرف شكل الدعامة الأولى المحورية في تنظيم الحياة الاجتماعية داخل المجتمع المغربي، وما يزال كذلك على الرغم من التحولات التي عرفها المجتمع، وذلك في مختلف مناحي الحياة ومجالاتها، من التنظيم والتسيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقضائي، بل ويمتد ليحكم حتى العوائد والطقوس، دون الحاجة إلى تشريعات مكتوبة، داخل المؤسسات التي تضمنه وتحميه، والمتمثلة في "اجماعة"، وتجسد الفكر الجماعي الديمقراطي والاتحادي، ويعكس التضامن داخل نسيج القبيلة.
كما تجدر الإشارة إلى أن تطور سيرورة العمل بالعرف، سجلت تراجعا يوازيه تراجع في الإطار أو المؤسسة التي كانت تحميه- وهي القبيلة- من خلال "اجماعة" مقابل هيمنة التشريع المكتوب، والذي تتحكم فيه الدولة لعدة أسباب، وبالتالي يبقى العمل به محصورا في بعض المجالات ولو بشكل ضئيل، وفي مناطق محدودة، والذي لم يعد بدوره قادرا على الصمود أمام تيار العولمة.
على سبيل الختم
على ضوء ما تقدم عرضه، نستخلص أن هذه القيم المغربية تحتاج إلى الكثير من البحث والدراسة من حقول معرفية مختلفة سوسيولوجية وأنثروبولوجية وتاريخية؛ فالبحث في القيم الثقافية المغربية هو محاولة في فهم الذهنيات ورصد الممارسات وكشف المخفي منها ومساءلة التفاصيل، وإن بدت صغيرة أو جزئية، والبحث في دلالتها وتفكيك صورها ورموزها وتحديد وظائفها المختلفة ورصد التحولات والتغيرات التي طرأت عليها. لهذا فقد آن الأوان - في ظل هذا التمزق والضياع الهوياتي والتنميط العولمي الذي يهدد القيم والثقافة المغربية-أن نعود إلى جذورنا الثقافية ونلملم هويتنا الحضارية كمغاربة عرب وأمازيغ، ونعمل على تطويرها والتصدي لكل أشكال الطمس والنسيان لبناء حضاري وهوية ثقافية مغربية.
وعليه، فضدًّا على ثقافة الطمس، وبحثا عن المعاني والدلالات، كما بين ذلك رولان بارت، الذي كتب يوما بأن "اللامعنى هو مكان الدلالة الحق"، فتوليد المعاني يمكن رصده من خلال الوقوف عند ما يدعوه "الفلسفة العمومية"، التي تغذي طقوسنا اليومية، وعاداتنا وتقاليدنا وتحدد لباسنا وحلاقة شعرنا وتنظيم مطبخنا وحفلاتنا وتدبير شؤوننا اليومية، وبالتالي لا يتعلق الأمر بما اعتدنا تسميته بالثقافة الشعبية في مقابل الثقافة العالمة، كما أنه لا يتعلق الأمر إلى المقابلة بين "الوضيع" و"الراقي" بالمعنى القيمي للكلمتين، وإنما الهدف هو فهم ومقاربة القيم والثقافة المغربية أملا في فهم المجتمع وفهم السلوكيات والممارسات من خلال نظرة شمولية تركيبية تسائل واقع الثقافة المغربية في ماضيها وحاضرها واستشراف مستقبلها.
المتن البيبليوغرافي:
- أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، الجزء الرابع دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى.
- المعجم العربي الأساسي، لاروس، بيروت 1991
- نخبة من أساتذة علم الاجتماع، المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية لطلاب قسم علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية.
- الزيود ماجد، الشباب والقيم في عالم متغير، دار الشروق، الأردن سنة 2006
- أنجلز ماريا، أنثروبولوجية الحياة اليومية في المتوسط، موسوعة البحر الأبيض المتوسط، ترجمة حسن بن منصور، سلسلة الوقت الحاضر، الجزائر، 2005
- الونشريسي أحمد بن يحيى، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، تحقيق محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، ودار المغرب الإسلامي، رباط، بيروت 1401هـ/ 1901م، الجزء 11، 7، 2، 3، 12، 8
- رحال بوبريك، بركة النساء، الدين بصيغة المؤنث، إفريقيا الشرق.
- عبد الرحيم، تحولات المغرب القروي، أسئلة التنمية المؤجلة، تقديم مصطفى محسن، دفاتر الحرف والسؤال، سلا 2009، المغرب.
- عبد الرحيم العطري، بركة الأولياء: بحث في المقدس الضرائحي، دار النشر والتوزيع المدارس، بالدار البيضاء، 2014
- نور الدين الزاهي، المقدس والمجتمع، إفريقيا الشرق، المغرب 2011
- أبو الأجفان محمد، كتاب رحلة "القلصادي"، الشركة التونسية لتوزيع تونس، 1978
- قسطاني بن محمد، التنظيم العرفي للعلاقات الاجتماعية "تعقيدين" واحة غريس نموذجا- القانون والمجتمع بالمغرب، سلسلة الندوات والمناظرات- رقم 7 – منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية- مطبعة المعارف الجديدة- الرباط 2005
- إبراهيم رحالي، إشكالية العرف والشرع بالجنوب الشرقي (قبيلة آيت أومرابط نموذجا)، بحث لنيل الإجازة في التاريخ- كلية الآداب بأكادير- 2003-2004
- حنان حمودا، العرف وإعادة إنتاج علاقات التضامن والالتحام حول الموارد المائية بواحة سكورة جنوب المغرب، مجلة ليكسوس الإلكترونية، دورية محكمة متخصصة في التاريخ والعلوم الإنسانية، العدد 36 دجنبر 2020م
- إدريس كمون (2015)، "مفهوم البركة في الثقافة الشعبية المغربية عند إدوارد فستر مارك"، الثقافة الشعبية، البحرين، المنظمة الدولية للفن الشعبي.
- الخياط عبد العزيز، نظرية العرف، مكتبة الأقصى- عمان الأردن 1977
- احدى محمد، الأعراف المحلية بالجنوب المغربي، مجلة المغرب الإفريقي، تصدرها جامعة محمد الخامس-السويسي-الرباط عدد 4 2003
- عمر بن عبد الكريم الجيدي، العرف والعمل في المذهب المالكي، مطبعة فضالة- المحمدية 1982
- أعزي الحسين، "أمود" دورية ثقافية من منشورات الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي 1990 عدد1
- أحمد بن الحاج العياشي سكيرج، الرحلة الحبيبة الوهرانية، تحقيق بن عمر حمدادو، العربي بوعمامة، دار قرطبة للنشر والتوزيع، 2011، الجزائر.
- بيار بونت، ميشال ايزار، معجم الاثنولوجيا والانثروبولوجيا، ترجمة مصباح الصمد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2006
- مالك شبل، "الجنس والحريم روح السراري، ترجمة عبد الله زارو، إفريقيا الشرق، 2010 المغرب.
- أحمد بن الحاج العياشي سكيرج، الرحلة الحبيبة الوهرانية، تحقيق بن عمر حمدادو، العربي بوعمامة، دار قرطبة للنشر والتوزيع، 2011، الجزائر.
- بيار بونت، ميشال ايزار، معجم الاثنولوجيا والانثروبولوجيا، ترجمة مصباح الصمد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2006
- مالك شبل، "الجنس والحريم روح السراري، ترجمة عبد الله زارو، إفريقيا الشرق، 2010 المغرب.
- شبل مالك، الجنس والحريم روح السراري: السلوكات الجنسية المهمشة في المغرب الكبير، ترجمة عبد الله زارو، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب 2010
- الخوري فؤاد إسحاق، إيديولوجيا الجسد: رموزية الطهارة والنجاسة، دار الساقي، بيروت لبنان.
- دييكودي طوريس، تاريخ الشرفاء، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، شركة النشر والتوزيع، الدا البيضاء، المغرب 1988.
- التركي ثريا وزريق هدى، تغير القيم في العائلة العربية، سلسلة دراسات عن المرأة العربية والتنمية، رقم واحد وعشرون، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، عمان الأردن، 1995
- شفيق محمد، لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغ، مجلة نيفاوت 1993 عدد 1.
- ادبلقاسم حسن، الترجمة الأمازيغية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منشورات الجمعية الجديدة للثقافة والفنون الشعبية بالرباط.
- تريكي حسان، ملامح التحول في قيم العمل في المجتمع الجزائيري: دراسة تحليلية، المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية، المجلد 10، العدد 2 سنة 2017
- [1] - محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي ت899هـ/1493م، نظم الدر والعقبان في بيان شرف بني زيان، تحرير وتعليق محمود بوعياد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1985 ص: 186
- [1] - أحمد التوفيق، المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر اينولتان (1850-1912)، الطبعة الثانية، منشورات كلية الآداب الرباط، النجاح الجديدة 1983
- رحمة بورقية، الدولة والمجتمع، ص: 171
- TALCOTT PARSONS. Social system, and Printing, Glencoe Illinois Thefree Press, New York 1958
- Bruno, Bulletin économique et social du Maroc le droit et le fait dans la société composite.
- Westermarck Edward, Ritual and Belief in Morocco.
- Bourqia. R. Charrad.M. Gallagher. N, « Femme, culture et société au Maghreb, Casablanca, ed Afrique orient, tom 01, 1996
- Hassan Rachik et Autres, Islam au quotidien, Enquête sur les valeurs et les pratiques religieuses au Maroc, Editions Prologues, (Collection: Religion et Société), Casablanca, 2007
- Julien Pitt-Rivers: « Anthropologie de l’honneur, la mésaventure de Sichem » Paris ed le sycomore, 1983
- Bourdieu Pierre: « La domination masculine », ed Seuil, Paris, 1998.
- Bourdieu Pierre, « Esquisse d’une théorie de la pratique » Genève, ed Dlroz, 1972
- Boucebci Mahfoud, Psychiatre société et développement en Algérie, ENAL, Alger, 1987
- Skali Faouzi, Saints et Sanctuaires de Fès, Marsam, Rabat 2007
[1] - أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، الجزء الرابع دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى.
[2] - نخبة من أساتذة علم الاجتماع، المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية لطلاب قسم علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 1985 ص 505
[3] - Talcott Parsons. Social system, and Printing, Glencoe Illinois Thefree Press, New York 1958 p 12
[4] - تريكي حسان، ملامح التحول في قيم العمل في المجتمع الجزائيري: دراسة تحليلية، المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية، المجلد 10، العدد 2 سنة 2017 ص: 208
[5] - الزيود ماجد، الشباب والقيم في عالم متغير، دار الشروق، الأردن سنة 2006 ص 505
[6] - Hassan Rachik et Autres, Islam au quotidien, Enquête sur les valeurs et les pratiques religieuses au Maroc, Editions Prologues, (Collection: Religion et Société), Casablanca, 2007
[7] - أنجلز ماريا، أنثروبولوجية الحياة اليومية في المتوسط، موسوعة البحر الأبيض المتوسط، ترجمة حسن بن منصور، سلسلة الوقت الحاضر، الجزائر، 2005
[8]- Les trois couplets de la chanson cités à différents moments du texte sont pris à la chanson de Manicke « je m’en vais, je m’en vais » dans son disque paroles de femme cité au livre «d’Algérie et femme ». Préface Fatima-Mernissi, édité par l’association Aicha 1994 Alger, page 39
[9] - Julien Pitt-Rivers: « Anthropologie de l’honneur, la mésaventure de Sichem » Paris ed le sycomore, 1983
[10] - Bourdieu Pierre, « Esquisse d’une théorie de la pratique » Genève, ed Dlroz, 1972
[11] - Bourdieu Pierre, «La domination masculine », Paris, ed Seuil, collection liber, 1998
[12] - Bourqia. R. Charrad. M. Gallagher. N: « Femme culture et société au Maghreb, culture femme et famille », ed Afrique-orient 1996, P 09
[13] - رحال بوبريك، بركة النساء، الدين بصيغة المؤنث، إفريقيا الشرق ص: 15
[14] - عبد الرحيم، تحولات المغرب القروي، أسئلة التنمية المؤجلة، تقديم مصطفى محسن، دفاتر الحرف والسؤال، سلا 2009، المغرب، ص: 108
[15] - نور الدين الزاهي، المقدس والمجتمع، إفريقيا الشرق، المغرب 2011 ص: 110
[16] - الفقيه: كلمة يتداولها المغاربة تعبيرًا عن ذلك الطالب "معلم العلم" في المدارس العلمية العتيقة والمثقف، الذي بلغ درجة من العلم القادر على تفسير القرآن الكريم ومتمكن من العلوم الشرعية؛ أي من أتقن العلم وعلمه، فهو فقيه وحاصل على الإجازة من مشايخه الذين درس على يديهم.
[17] - أبو الأجفان محمد، كتاب رحلة القلصادي"، الشركة التونسية لتوزيع تونس، 1978 ص: 110
[18] - أحمد بن الحاج العياشي سكيرج، الرحلة الحبيبة الوهرانية، تحقيق بن عمر حمدادو، العربي بوعمامة، دار قرطبة للنشر والتوزيع، 2011، الجزائر ص: 227
[19] - بيار بونت، ميشال ايزار، معجم الاثنولوجيا والانثروبولوجيا، ترجمة مصباح الصمد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2006 ص: 583
[20] - مالك شبل، "الجنس والحريم روح السراري، ترجمة عبد الله زارو، إفريقيا الشرق، 2010 المغرب ص: 10
[21] - شبل مالك، الجنس والحريم روح السراري: السلوكات الجنسية المهمشة في المغرب الكبير، ترجمة عبد الله زارو، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب 2010، ص: 77
[22]- Bourqia. R. Charrad.M. Gallagher. N, « Femme, culture et société au Maghreb, Casablanca, ed Afrique orient, tom 01, 1996, page 28
[23] - Ibid, p: 27
[24] - Bourdieu Pierre: « La domination masculine », ed Seuil, Paris, 1998 ? p59
[25] - الخوري فؤاد إسحاق، إيديولوجيا الجسد: رموزية الطهارة والنجاسة، دار الساقي، بيروت لبنان، ص: 1
[26] - دييكودي طوريس، تاريخ الشرفاء، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، شركة النشر والتوزيع، الدا البيضاء، المغرب 1988 ص ص: 13-14
[27] - Boucebci Mahfoud, Psychiatre société et développement en Algérie, ENAL, Alger, 1987, P 44
[28] - التركي ثريا وزريق هدى، تغير القيم في العائلة العربية، سلسلة دراسات عن المرأة العربية والتنمية، رقم واحد وعشرون، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، عمان الأردن، 1995 ص: 28
[29] - المعجم العربي الأساسي، لاروس، بيروت 1991
[30] - ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، القاهرة 2003
[31] - Skali Faouzi, Saints et Sanctuaires de Fès, Marsam, Rabat 2007 P4
[32] - إدريس كمون (2015)، "مفهوم البركة في الثقافة الشعبية المغربية عند إدوارد فستر مارك"، الثقافة الشعبية، البحرين، المنظمة الدولية للفن الشعبي، ص: 3
[33] - Westermarck Edward, Ritual and Belief in Morocco. Op Cit, P: 36
[34] - Ibid, P: 41
[35] - Ibid, P: 198
[36] - إدريس كمون (2015)، "مفهوم البركة في الثقافة الشعبية المغربية عند إدوارد فستر مارك"، الثقافة الشعبية، البحرين، المنظمة الدولية للفن الشعبي، ص: 4
[37] - إدريس كمون (2015)، "مفهوم البركة في الثقافة الشعبية المغربية عند إدوارد فستر مارك"، الثقافة الشعبية، البحرين، المنظمة الدولية للفن الشعبي، ص ص: 4-5
[38] - يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى كتاب الدكتور عبد الرحيم العطري، بركة الأولياء: بحث في المقدس الضرائحي، والذي يعرض لهذا الموضوع بالتفصيل من خلال دراسة ميدانية سوسيو-أنثربولوجية مهمة.
[39] - تجدر الإشارة هنا إلى أن الكثير من العيون ومنابع المياه في المجتمع المغربي يتم تقديسها والحفاظ عليها لما لها من بركة في مائها ومن الأمثلة على ذلك: حامات مولاي يعقوب بفاس، وسيدي حرازم، وعين الله، وعيون تدوغى بتنغير وغيرها كثير.
[40] - إدريس كمون (2015)، "مفهوم البركة في الثقافة الشعبية المغربية عند إدوارد فستر مارك"، الثقافة الشعبية، البحرين، المنظمة الدولية للفن الشعبي، ص: 5
[41] - Westrmarck Edward, Ritual and Belief in Marocco, p: 96-97
[42] - نشير هنا إلى أن بعض العيون المائية كانت تحتوي على أسماك ذهبية نواحي تنغير، ولكي يحافظ المجتمع على الماء عمل على تقديس هذه الأسماء وتم إصدار عرف اجتماعي أنه ممنوع على أي شخص أن يصطاد هذه الأسماك لأنها تتوفر على بركة معينة، وهذا له ارتباط بالمقدس.
[43] - إدريس كمون، مرجع سابق.
[44] - عبد الرحيم العطري، بركة الأولياء: بحث في المقدس الضرائحي، دار النشر والتوزيع المدارس بالدار البيضاء، سنة 2014
[45] - الخياط عبد العزيز، نظرية العرف، مكتبة الأقصى- عمان الأردن 1977 ص: 24
[46] - احدى محمد، الأعراف المحلية بالجنوب المغربي، مجلة المغرب الإفريقي، تصدرها جامعة محمد الخامس-السويسي-الرباط عدد 4 2003 ص 179
[47] - عمر بن عبد الكريم الجيدي، العرف والعمل في المذهب المالكي، مطبعة فضالة- المحمدية 1982، ص: 31
[48] - نفس لمرجع ص: 34
[49] - أعزي الحسين، "أمود" دورية ثقافية من منشورات الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي 1990 عدد 1 ص: 22
[50] - شفيق محمد، لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغ، مجلة نيفاوت 1993 عدد 1 ص: 54
[51] - ادبلقاسم حسن، الترجمة الأمازيغية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منشورات الجمعية الجديدة للثقافة والفنون الشعبية بالرباط.
[52] -Bruno, Bulletin économique et social du Maroc le droit et le fait dans la société composite.
[53]- عند أغلبية الباحثين الأجانب مثل: J.Berques. H.lafond _ D. J. Munie.
[54] - G. Surdon: Esquisse Du Droit coutumier, Paris p: 41
[55] - قسطاني بن محمد، التنظيم العرفي للعلاقات الاجتماعية "تعقيدين" واحة غريس نموذجا- القانون والمجتمع بالمغرب، سلسلة الندوات والمناظرات- رقم 7 – منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية- مطبعة المعارف الجديدة- الرباط 2005 ص: 168
[56] - إبراهيم رحالي، إشكالية العرف والشرع بالجنوب الشرقي (قبيلة آيت أومرابط نموذجا)، بحث لنيل الإجازة في التاريخ- كلية الآداب بأكادير- 2003-2004 ص: 6
[57] - الونشريسي أحمد بن يحيى، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، تحقيق محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، ودار المغرب الإسلامي، رباط، بيروت 1401هـ/ 1901م، الجزء 11، ص: 278
[58] - نفسه، ج 8، ص: 259
[59] - نفسه، ج 12 ص: 49
[60] - نفسه، ج 11
[61] - محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي ت899هـ/1493م، نظم الدر والعقبان في بيان شرف بني زيان، تحرير وتعليق محمود بوعياد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1985 ص: 186
[62] - الونشريسي، مرجع سابق ج1، 411-412
[63] - نفسه ج7، ص: 114
[64] - نفسه ج2، ص: 31-32-37
[65] - الونشريسي، السابق ج3، ص: 251
[66] - نفسه ج 6 ص 417.
[67] - نفسه ج3 ص: 181
[68] - أحمد التوفيق، المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر اينولتان (1850-1912)، الطبعة الثانية، منشورات كلية الآداب الرباط، النجاح الجديدة 1983
[69] - رحمة بورقية، الدولة والمجتمع، ص: 171
[70] - حنان حمودا، العرف وإعادة إنتاج علاقات التضامن والالتحام حول الموارد المائية بواحة سكورة جنوب المغرب، مجلة ليكسوس الإلكترونية، دورية محكمة متخصصة في التاريخ والعلوم الإنسانية، العدد 36 دجنبر 2020م ص: 48
[71] - مقابلة شفوية مع أحد المسنين بواحة افركلة بتاريخ 03/08/2023
[72] - ترتبط هذه العادة "تلغنجا" بحالات من الجفاف التي تؤدي إلى نضوب الينابيع، والسواقي، والخطارات وبذلك تلجأ الساكنة إلى هذا الطقس، ويطلق عليها أيضا اسم "تسليت ن انزار" أي عروس المطر، و"تلغنجا" مشتقة من "أغنجا" الذي يعني الملعقة الخشبية الكبيرة المستعملة في تحريك الطعام أثناء الطهي وإفراغه في الصحون، و"أغنجا" الذي هو أداة من أدوات المطبخ، يعتبر رمزا للخصوبة، وسميت عروس المطر ب"تلغنجا" نظرا لكون "أغنجا" يغطى بالملابس حتى يبدو كهيئة العروس، وبعد إلباس المجسم بزي محلي للعروس، وتزيينه بقلادات تحمله إحدى فتيات القبيلة، وتتبعها باقي المشاركات في الطواف لجمع التبرعات، بهدف إقامة مأدبة، وتظل النسوة يرددن بعض الأغاني وهن يجبن الأزقة والقصور.