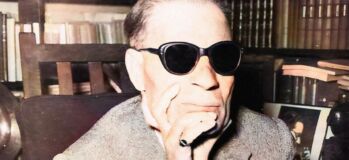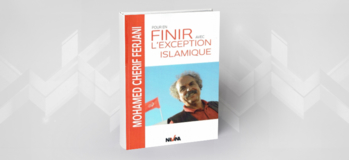نقد الأيديولوجيّة الغيبيّة
فئة : مقالات

نقد الأيديولوجيّة الغيبيّة
توجد الكثير من الكتابات التي تنتقد فكرنا الاجتماعي نظراً إلى تمسكّه بأفكار تقليديّة راديكاليّة ساهمت بلا ريب في تخلفنا، وفي زيادة توسيع الفارق بين عالمنا الثالث والعالم الغربي الذي يشهد يومياً طفرات معرفيّة وفلسفيّة وتكنولوجيّة، ورغم مطالبة أصحاب هذه الأعمال بضرورة الاعتماد على المناهج العقليّة والأساليب العلميّة لمعالجة مشاكلنا السياسيّة والاقتصاديّة والصحيّة والاجتماعيّة واللغويّة والثقافيّة مع تنديدهم بمظاهر التطّرف الديني من جهة، ونقدهم لمفاهيم تلبس لبوس الدين أدّت إلى تجهيل المجتمع كانتشار الدروشة والبدع والخرافات، وثقافة التبرّك بالقبب ومقابر الأموات لحّل المشاكل، والعقائد التواكليّة وانتظار الحلول من السّماء بالأدعية والتراتيل من جهة أخرى، إلاّ أنّ الظاهر في نقدهم التعميم الواسع، والتركيز على العنف المقدّس والأصوليات الإرهابية دون الخوض في نقد مباشر للخلفيّة العقديّة مع علمهم أنّ العقيدة الدينيّة هي المحرّك الرئيس لأفعال وسلوكيّات المجتمعات المتديّنة، ولعّل سبب تجنبّهم لهذا النوع من النقد واعتمادهم على الأسلوب الضمني يعود إلى إقامة محاكم التفتيش في بلداننا، وأيضاً إلى وجود تداخل بين مفهومي الغيب والإيديولوجية إلى درجة اللبس ما قد يُعرّضهم إلى سوء الفهم وربّما إلى التكفير، وانطلاقاً من هذه الإشكالية، سيكون هذا المقال محاولة لمعالجة كيفيّة تحوّل الأفكار الإيمانيّة إلى إيديولوجيات خطيرة؟
الغيب هو عالم ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا) إذ لا يمكن إدراكه بالحواس ولا تعريضه للتجربة بل محلّه التسليم والتصديق (الإيمان)، ونحن جوهر ديننا وروحه كمسلمين مبني على الإيمان بالغيب كوجود الله سبحانه وتعالى، واليوم الآخر، والملائكة، والجنة والنار وغيرها من المسائل الإيمانية. أما الإيديولوجية، فهي مجموعة الأفكار المرتبطة بالسياسة وبالسلوك الجمعي، ومن ثم لما يتّم نقل الإيمان من وظيفته الروحية (العلاقة بين العبد وربّه) إلى أداة سلطويّة، فنحن أمام أيديولوجية ارتدت ثوب القداسة، أو بتعبير آخر فقد تمّ رسكلة المُعتقد الديني وتحويله إلى ذهنية دينيّة جامدة، ذات منهاج شمولي دوغمائي لا تقبل النقاش، ولا تعترف بوجود الآخر المختلف، وقوتها في اعتقادها الجازم على امتلاك الحقيقة المطلقة.
إذا كان الإيمان هو ذلك التسليم الروحي الشخصي بهدف نيل رضى الله، فإنّ الأيديولوجية الغيبيّة هي توظيف استراتيجي بهدف تحقيق مكاسب سياسية أو شعبية (توجيه الرأي العام والتأثير عليه)، يقول نصر حامد أبو زيد: "تحوّل الدين إلى إيديولوجيا هو ما يجعل منه سلطة قمعية، لا علاقة لها بحقيقة الإيمان أو مقاصده الإنسانية"، فما تشهده مجتمعاتنا من عداء لمفاهيم معاصرة كالمواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية والفنون المختلفة والنظريات العلمية الحديثة ما هو سوى ردة فعل لتشبّعها بإيديولوجية دينيّة ترفض الآخر والتعدد وتراهما تهديداً لوجودها، كما تُصوّر كل ما لا يتوافق مع الموروث بالمؤامرة، وتتهّم كل أنصار العقلنة والعلم والتجديد باللائيكية والانحلال وحتى بالإلحاد، ولهذا لا غرابة أن تسود عندنا ثقافة الكراهية، وخطابات التحريض، واستخدام العنف بشكله المادي أو الرمزي ضد المعارضين، فالدين حين يتحوّل إلى إيديولوجيا، من الأكيد سيفقد الإنسان حريته كما أشار إيريك فروم في كتابه "الخوف من الحرية"، ومنه صار عقلنا الجمعي كما رأى الجابري سجين التراث إذ يتعامل مع الألفاظ دون المفاهيم انطلاقاً من أصل وانتهاء إليه هو سلطة السلف، مما يؤدي كتحصيل حاصل إلى تحديد قدرات هذا العقل على التجديد.
وجب القول أيضاً إلى أنّ بعض أنظمتنا السياسيّة وجدت في الدين بنسخته الراديكالية الوسيلة المثالية ليس فقط لتهدئة وامتصاص غضب شعوبها، بل حتى لتبرير فشلها وعجزها عن حلّ القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها؛ وذلك بفتح المجال للأصوليين والدراويش لنشر تفسيراتهم الدينية حتى صار المُعارض السياسي يُصنّف من الخوارج، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة عقاب رباني بسبب معاصينا، وقلّة تساقط الأمطار وجفاف المحاصيل الزراعية سببه سراويل البنات والحلّ بصلاة الاستسقاء والحجاب والصلاة في وقتها، إغراق المجتمع في مواضيع الشعوذة والجن والمس والرقية والبخور والبحث عن السحر في المقابر مع تغطية إعلامية سمعية بصرية واسعة، وما حدث في زمن الكورونا ليس عنا ببعيد إذ تمّ صبغ الفيروس صبغة ميتافيزيقية بداية من اعتباره جندا من جند الله نزل للانتقام من الصين لاضطهادها الإيغور، إلى خروج الحشود في الشوارع للصلاة والدعاء، رغم تحذير الأطباء من العدوى ما أدى إلى السرعة في تفشي الوباء، إلى الاحتجاج على قرار غلق المساجد تطبيقاً لتعاليم الحجر الصحي واعتبار هذا من الحرب العلمانية على بيوت الرحمن، إلى الزعم أن الوضوء أسلوب فعّال للوقاية من العدوى وهذا من الإعجاز، إلى تحذير بعض رجال الدين من اللقاح، وغيرها من الأفكار القروسطية التي أضحت تعزيّة للجماهير التعيسة، يقول محمد أركون محذراً من الجهل المقدّس: "لا بدّ من إخراج الفكر الديني من القرون الوسطى، وإعادة إدخاله في التاريخ، في العقل، وفي النقد، لكي يصبح قادراً على التفاعل مع أسئلة العصر"، وهكذا صار الدين وحتى بشقه اللاهوتي وسيلة ديماغوجية بيد السلطة، وقد صدق كارل ماركس حين قال: "الدين أفيون الشعوب"، وهو لا يُكِّن العداء للدين ولا يهاجمه كما يتوهّم الكثير، بل ينتقد توظيفه الانتهازي من طرف السلطتين السياسيّة والدينيّة. أما عبد الله العروي، فقال: "الأيديولوجيّة الغيبيّة لا تخدم إلاّ سلطة جامدة؛ لأنّ العقل وحده هو ما يهددها"، وحتى المفكر طه عبد الرحمان ورغم خلافه الشديد مع الحداثيّين، إلاّ أنّه في كتابه "روح الحداثة" انتقد التوظيف السياسي للدين ورأى في هذا مفسدة له، خاصة وإن كانت السلطة الحاكمة ماكرة.
ولعّل أخطر تجليّات هذه الظاهرة تكمن في بروز تيارات أصوليّة، سواء سنيّة أو شيعيّة ترى من واجبها الإيماني تغيير المجتمعات الإسلامية المعاصرة بإقامة حكم الله فيها، وهنا نضجت فكرة الطليعة المؤمنة والمقصود بها جماعة قليلة العدد، شديدة الإيمان وتقوى الله تعالى، هي من تتحمل مسؤولية إعادة مجتمعاتنا إلى الإسلام الصحيح بالجهاد، يقول عنها سيد قطب: "الطليعة المؤمنة التي تحمل رسالة الله في هذه الأرض هي أقلية في البداية، ولكنها أساس التغيير وبذرة النصر". أما الخميني ونظراً إلى أنّ الإمامة من أصول الدين عند الشيعة، فقد جعل هذه الطليعة من الفقهاء أصحاب العلم الشرعي والولاية السياسية وعلى رأسهم وليّ الفقيه (نائب الإمام الغائب)؛ أي طبقة من الفقهاء الذين يمارسون الحكم الديني والسياسي عبر ولاية الفقيه، يقول: "الطليعة المؤمنة هي أولئك الفقهاء الذين يحملون راية الإسلام، والذين من خلالهم تتحقق ولاية الفقيه، وبدونهم لا يمكن إقامة نظام إسلامي عادل"، وهكذا ظهرت جماعات دوغمائية تحمل عقيدة العودة بمجتمعاتنا إلى زمن السلف الصالح انطلاقاً من قناعة أنّ زمانهم هو فقط النموذج التطبيقي الصحيح للإسلام (المُتخيّل في العصر المؤسِّس)، وأضحت هذه الجماعات تُصادر معاني النصوص القرآنية من خلال أولاً المُصادرة على الانغلاق المعرفي، باعتبار أنّ الحقيقة الوحيدة والشاملة لا توجد سوى في القرآن والأحاديث الصحيحة (عند الشيعة يتّم زيادة أحاديث أئمة آل البيت)، وثانياً المُصادرة على الأسبقية الفقهية، حيث كلّ المسائل يمكن تفسيرها داخل هذه المنظومة التراثية، وبالنسبة إليهم فإن تخلّف البلدان الإسلامية راجع إلى ابتعاد المسلمين وانحرافهم عن الإسلام الحقيقي ومنابعه ولا حلّ سوى بالرجوع إليه من خلال المُصادرتين أعلاه، وقد تجسّدت هذه الإسلاموية في أربعة أشكال تختلف فيما بينها فكريًّا وعقديًّا، وهي:
- السلفية النجدية: هذا التيار يعتمد أكثر على التبليغ والدعوة وهدفه إصلاح المجتمع دينيًّا بإصلاح أخلاق وآداب الفرد حسب الشريعة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، يهتم بمحاربة التصوّف الفلسفي والبدعي، وهو ضد التكفير والخروج على الحاكم.
- الإخوان المسلمون: حركة في أصلها سلفي دعوي، بدأت في مصر أواخر العشرينات بهدف إصلاح المجتمع دينيا مع حسن البنا، ثم مع أبي الأعلى المودودي الباكستاني وسيد القطب المصري تغيّرت سردياتها واتجهت نحو العنف وصار الإصلاح عندها من الأعلى نحو الأسفل، وبالتالي وجوب جهاد الأنظمة الحاكمة وإسقاطها.
- السلفية الحركية الجهادية: تُعرف أيضاً بالقطبية نظرا إلى تأثرها بأفكار سيد قطب ومحمد عمارة وخاصة عقيدة الفريضة الغائبة، وقد جعلت من الجهاد واجباً فردياً وليس جماعياً، كما تدمج بالكفر الأنظمة الحاكمة والمجتمعات (كل من يخالفهم)، أغلب التنظيمات الإرهابية العنيفة تنتمي لهذا التيار المتطّرف.
- الأصولية الخمينية: تمكّن الخميني من تأسيس مذهباً راديكالياً لقيادة إيران دينياً وسياسياً بالمزج بين العقيدة الشيعية الإثني عشرية وفكرة ولاية الفقيه (الحاكمية الدينيّة)، وقد نجح في تأسيس حكومته الإسلامية وتحويل إيران إلى دولة ثيوقراطية، بل وسعى إلى تصدير ثورته إلى الدول الإسلامية.
وجب التنبيه أنّ الإسلاموية لها توجهات عالمية عابرة للحدود والقارات، وليست محليّة ما جعل منها إيديولوجية مدمّرة تستغلها مكاتب المخابرات الأجنبيّة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، بعد نهاية حرب الخليج وبالتحديد خلال شهر أبريل سنة 1991، اجتمعت عدة جماعات وشخصيات أصولية جاءت من بلدان آسيوية وإفريقية وحتى أوروبية بالخرطوم عاصمة السودان تلبيّة لدعوة حسن الترابي لمناقشة كيفية إقامة دولة إسلامية ذات بعد عالمي، هذا الملتقى الذي ضمّ الكثير من الأفغانيين والباكستانيين والماليزيين والسعوديين والمصريين وغيرهم من باقي الدول (من الجزائر حضره عباسي مدني وصاحبه علي بلحاج)، وقد غدت هذه المنظمة مركزاً تقريرياً رئيساً لهذه الحركات الجهادية والداعمة لها مادياً وإعلامياً، وبالتالي لا يمكن حصر الجذور الفكرية للتطّرف في السياسة أو الظروف الاجتماعية الصعبة، بل هناك معضلة الفهم التقليدي للنصوص الدينيّة وما ينتجه من عقائد عنيفة تجعل من صاحبها يلعب دور الحاكم بأمر الله في الأرض، يقول محمد شحرور: "التكفير هو اغتصاب لحق الله في الحكم على الناس"، ويقول أيضاً موضحاً خطأ الخلط بين الدين والدولة: "لا يجوز أن تُبنى الدولة على أساس ديني تكفيري؛ لأنّ ذلك يعني بالضرورة استبعاد فئات واسعة من الشعب".
يشهد التاريخ أنّ الأمم إما تتقدم أو تتأخر، ومن أجل تحقيق التقدم المنشود عندنا فلا تكفي الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية؛ لأنّ نظرتنا إلى الحياة والذات لن تتغيّر، بل لا بدّ من إصلاح فكري وثقافي بالتوازي مع الجهد المبذول على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فمن غير المعقول ونحن نعيش عصر غزو الفضاء والذكاء الاصطناعي لا نزال نتحاشى عرض الفكر الديني على مجهر التحليل الإبستيمولوجي لفضح ذلك الاستلاب الذي تمارسه الإيديولوجية الدينيّة على العقل، فبالإضافة إلى ضرورة تحسين الأوضاع المادية لمجتمعاتنا، وجب أيضاً نقد الذهنية البالية التي تعود إلى عصر البداوة والقرون الوسطى، وإعادة النظر إلى الإنسان عندنا وعلاقته بالآخر عن طريق تجديد بنائه الثقافي، كما يجب نزع هالة القداسة عن الكثير من الأفكار والنظرات الحياتية الميتافيزيقية مع توسيع مجال النقد العلمي لمختلف الظواهر؛ لأنّ الاعتماد على الغيب لتفسير ما لا نفهمه هو تعطيل للعقل وملكة التفكير وتوقف عن البحث.
المراجع:
- محمد أركون، "نحو نقد العقل الإسلامي"، دار الطليعة، بيروت. سنة 2009
- محمد عابد الجابري. "الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحليلية نقدية"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان. سنة 2001
- محمد شحرور، "الكتاب والقران"، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق.
- محمد شحرور، "الدولة والمجتمع"، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق.
- نصر حامد أبو زيد، "التفكير في زمن التكفير"، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر. سنة 1995
- صادق جلال العظم، "نقد الفكر الديني"، دار الطليعة، بيروت، لبنان. سنة 1970
- عبد الله العروي، "الأيديولوجية العربية المعاصرة"، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب. سنة 1995
- طه عبد الرحمن، "روح الحداثة، المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية"، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب. سنة 2006
- لياس بوكراع، الجزائر الرعب المقدس، فافر للنشر، لوزان، 2002
- الإمام روح الله الموسوي الخميني، "الحكومة الإسلامية"، دار الولاء، بيروت، لبنان. سنة 2011
- مركز المعارف للتأليف والتحقيق، "ولاية الفقيه في فكر الإمام الخميني"، دار المعارف الإسلامية للنشر.
- سيد قطب، "معالم في الطريق"، دار الشروق للنشر، بيروت، لبنان. سنة 1979
- إريك فروم، "الخوف من الحرية"، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دمشق، سوريا. سنة 1972