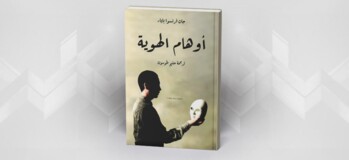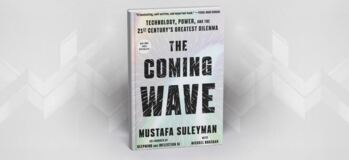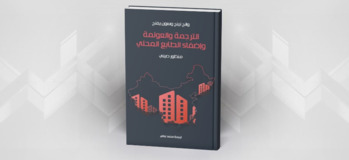تشكل النظام العالمي الجديد: تحولات القوة وآفاق المستقبل
فئة : مقالات

تشكل النظام العالمي الجديد: تحولات القوة وآفاق المستقبل
الملخص
يتناول هذا المقال التحولات الجذرية التي يشهدها النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين، مع التركيز على صعود قوى عالمية جديدة، تراجع الهيمنة الغربية، التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وأثرها على مفاهيم السيادة والأمن. كما يناقش البحث مستقبل النظام العالمي من خلال ثلاثة سيناريوهات محتملة: استمرار الهيمنة الأمريكية، نظام متعدد الأقطاب، أو الفوضى العالمية.
ويولي الموضوع اهتمامًا خاصًّا بدور العالم العربي والإسلامي في ظل هذه التغيرات، بين التحديات والفرص، مشددًا على أهمية التكيف الاستراتيجي لبناء مستقبل أفضل.
مقدمة
يشهد العالم المعاصر تحولات عميقة في بنية النظام العالمي وتوازنات القوى الدولية، تتجاوز في تأثيرها وعمقها التغيرات التي شهدها العالم منذ نهاية الحرب الباردة. وكما يشير هنري كيسنجر (2014) في كتابه “النظام العالمي”: “نحن نعيش في فترة تاريخية يتم فيها إعادة تشكيل جذرية للنظام العالمي، حيث تتزامن أزمة في مفهوم النظام ذاته مع تحولات في موازين القوى العالمية” (ص. 8). هذه التحولات تتجلى في صعود قوى عالمية جديدة، وتراجع نسبي للهيمنة الغربية، وتغيرات جذرية في طبيعة القوة ومصادرها، وتحديات غير مسبوقة تواجه المؤسسات الدولية التقليدية.
يؤكد زكريا (2008) أن “العالم يشهد ليس فقط توزيعاً جديداً للقوة، بل تحولاً في طبيعة القوة ذاتها، من القوة العسكرية التقليدية إلى أشكال أكثر تعقيداً من القوة الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية” (ص. 13). يطرح هذا التحول تساؤلات جوهرية حول مستقبل النظام العالمي وآليات إدارته وقواعده وقيمه الأساسية.
ومن ثمة، نحاول تحليل التحولات الجارية في النظام العالمي وتداعياتها المستقبلية، من خلال استكشاف التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية والقيمية التي تعيد تشكيل العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، مع تقديم رؤية استشرافية للسيناريوهات المحتملة لمستقبل النظام العالمي.
أولاً: الإطار المفاهيمي للنظام العالمي
يُعرّف النظام العالمي بأنه “مجموعة المبادئ والقواعد والمؤسسات التي تنظم العلاقات بين الفاعلين الدوليين، وتحدد أنماط توزيع القوة وآليات إدارة الصراعات وتحقيق الاستقرار على المستوى العالمي” (بول، 2010، ص. 77). ويشير إيكنبيري (2018) إلى أن “النظام العالمي يتشكل من ثلاثة عناصر أساسية: هيكل توزيع القوة، المؤسسات والقواعد المنظمة للعلاقات الدولية، والقيم والمبادئ التي تضفي الشرعية على هذا النظام” (ص. 42).
وقد مر النظام العالمي بمراحل تاريخية متعددة، من نظام وستفاليا (1648) الذي أرسى مبدأ سيادة الدولة، إلى نظام توازن القوى الأوروبي (1815-1914)، ثم نظام الحرب الباردة الثنائي القطبية (1945-1991)، وصولاً إلى “اللحظة الأحادية” الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وكما يلاحظ كراوثامر (1990): “شهد العالم بعد انهيار الاتحاد السوفييتي لحظة أحادية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، تميزت بهيمنة قوة عظمى واحدة على النظام العالمي” (ص. 24).
لكن هذه “اللحظة الأحادية” بدأت في التآكل تدريجياً مع مطلع القرن الحادي والعشرين، حيث يشير ميرشايمر (2019) إلى أن “النظام الليبرالي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة كان يحمل بذور أزمته في داخله، من خلال سعيه لفرض نموذج عالمي موحد لا يراعي التنوع الثقافي والحضاري والسياسي للمجتمعات المختلفة” (ص. 89).
ثانياً: التحولات الجيوسياسية المعاصرة
1- صعود القوى العالمية الجديدة
يشهد النظام العالمي المعاصر صعوداً متسارعاً لقوى عالمية جديدة، وعلى رأسها الصين التي تمثل التحدي الأكبر للهيمنة الأمريكية. يحذر أليسون (2017) من أن “العلاقة بين الولايات المتحدة والصين قد تقع في ‘فخ ثوسيديديس’، حيث تؤدي مخاوف القوة المهيمنة من صعود قوة منافسة إلى صراع حتمي بينهما” (ص. 29). ويضيف: “في 12 من أصل 16 حالة تاريخية شهدت صعود قوة جديدة تتحدى قوة مهيمنة، انتهت العلاقة بينهما بحرب” (ص. 30).
إلى جانب الصين، تبرز روسيا كقوة عالمية تسعى لاستعادة نفوذها، حيث يشير كابلان (2019) إلى أن “روسيا تحت قيادة بوتين تسعى لإعادة تأكيد مكانتها كقوة عظمى من خلال استراتيجية متعددة الأبعاد تجمع بين القوة العسكرية والدبلوماسية النشطة والتأثير الإعلامي” (ص. 112). كما تبرز الهند كقوة صاعدة بثقل ديموغرافي واقتصادي متزايد، إضافة إلى قوى إقليمية مؤثرة مثل البرازيل وتركيا وإيران وجنوب أفريقيا.
2- تحول مراكز صناعة القرار العالمي
يشهد النظام العالمي تحولاً في مراكز صناعة القرار من الغرب إلى الشرق، ومن المؤسسات التقليدية إلى منتديات وتكتلات جديدة. يلاحظ هاس (2023) أن “مجموعة العشرين أصبحت تدريجياً أكثر أهمية من مجموعة السبع في إدارة الاقتصاد العالمي، مما يعكس تحولاً في موازين القوى الاقتصادية العالمية” (ص. 156). كما برزت منتديات جديدة مثل مجموعة بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا) ومنظمة شنغهاي للتعاون كمنصات بديلة للتنسيق الدولي خارج الإطار الغربي التقليدي.
وفي هذا السياق، يشير ميد (2021) إلى أن “النظام العالمي يتجه نحو تعددية قطبية مرنة، حيث تتشكل تحالفات متغيرة حول قضايا محددة، بدلاً من الانقسام الثابت بين معسكرين متنافسين كما كان الحال خلال الحرب الباردة” (ص. 27).
3- النزعة القومية الشعبوية وتأثيرها على النظام العالمي
شهد العقد الماضي صعوداً متزايداً للنزعات القومية والشعبوية في مختلف أنحاء العالم، مما أثر بشكل عميق على النظام العالمي. يرى ناي (2020) أن “صعود القومية والشعبوية في الغرب يمثل تحدياً داخلياً للنظام الليبرالي الذي قادته الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية” (ص. 201). ويضيف: “للمرة الأولى منذ عقود، أصبحت الديمقراطيات الليبرالية الغربية مصدراً للتحدي للنظام العالمي الذي ساهمت في تأسيسه، وليس فقط داعمة له” (ص. 202).
ثالثاً: التحولات الاقتصادية والتكنولوجية
1- تحول موازين القوة الاقتصادية العالمية
يشهد الاقتصاد العالمي تحولاً جذرياً في موازين القوى، مع انتقال مركز الثقل الاقتصادي تدريجياً من الغرب إلى آسيا. وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2024): “من المتوقع أن تمثل آسيا أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2050، مقارنة بنحو 35% حالياً” (ص. 42). هذا التحول يعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وقواعده ومؤسساته. يشير رودريك (2022) إلى أن “العولمة تدخل مرحلة جديدة تتسم بتفكك سلاسل القيمة العالمية وإعادة توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعة بمخاوف الأمن القومي والمرونة الاقتصادية أكثر من اعتبارات الكفاءة الاقتصادية البحتة” (ص. 8). ويضيف: “نشهد انتقالاً من عولمة مفرطة إلى عولمة أكثر حذراً وانتقائية، تراعي الاعتبارات الجيوسياسية والأمنية” (ص. 9).
2- الموارد الاستراتيجية كسلاح جيوسياسي
أصبحت الموارد الاستراتيجية أداة رئيسة في الصراع الجيوسياسي العالمي، سواء كانت طاقة تقليدية أو معادن نادرة أو موارد مائية. يشير تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (2024) إلى أن “سيطرة الصين على أكثر من 80% من إنتاج المعادن النادرة عالمياً تمنحها نفوذاً استراتيجياً في الصناعات المتقدمة، من الإلكترونيات إلى الدفاع” (ص. 87).
وفي هذا السياق، يلاحظ الحسيني (2022) أن “المنافسة على الموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أصبحت محركاً رئيسياً للسياسات الخارجية للقوى الكبرى، مما يعيد تشكيل التحالفات الإقليمية والعالمية” (ص. 52).
3-الثورة التكنولوجية وتأثيرها على النظام العالمي
تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في إعادة تشكيل النظام العالمي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني والتكنولوجيا الحيوية. يحذر شوارتز (2023) من أن “السباق العالمي على الذكاء الاصطناعي يمثل منافسة استراتيجية تفوق في أهميتها سباق التسلح النووي خلال الحرب الباردة؛ لأنه سيحدد القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية في القرن الحادي والعشرين” (ص. 215).
وتشير سلوتر (2017) إلى أن “العالم يتحول من نموذج ‘رقعة الشطرنج’ التقليدي في العلاقات الدولية، القائم على تفاعل وحدات منفصلة (الدول)، إلى نموذج ‘الشبكة’ القائم على الترابط المعقد والمتعدد المستويات” (ص. 18). وتضيف: “في عالم الشبكات، تصبح القدرة على بناء الروابط وإدارتها مصدراً أساسياً للقوة، يضاهي في أهميته القوة العسكرية والاقتصادية التقليدية” (ص. 19).
رابعاً: تحولات مفهوم السيادة والأمن في النظام العالمي الجديد
1- تآكل مفهوم السيادة التقليدية
يشهد مفهوم السيادة الوطنية تحولات عميقة في ظل العولمة والتحديات العابرة للحدود. يرى كيوهين (2012) أن “السيادة المطلقة أصبحت وهماً في عالم متشابك، حيث تتطلب معظم التحديات المعاصرة تعاوناً دولياً وتنازلاً طوعياً عن بعض صلاحيات الدولة لصالح آليات الحوكمة العالمية” (ص. 130).
ويضيف إيكنبيري (2018): “نشهد تحولاً من مفهوم السيادة كسيطرة مطلقة إلى مفهوم السيادة كمسؤولية، حيث تُقاس سيادة الدولة بقدرتها على حماية مواطنيها وتلبية احتياجاتهم، وليس فقط بسيطرتها على إقليمها” (ص. 156).
2- توسع مفهوم الأمن وتعدد أبعاده
لم يعد مفهوم الأمن مقتصراً على البعد العسكري التقليدي، بل اتسع ليشمل أبعاداً متعددة. يشير تقرير مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي (2021) إلى أن “التهديدات الأمنية الأكثر إلحاحاً في العقود القادمة ستكون غير تقليدية، من التغير المناخي إلى الأوبئة العالمية والهجمات السيبرانية والإرهاب العابر للحدود” (ص. 34).
ويؤكد والتز (2000) أن “النظريات التقليدية للأمن الدولي، القائمة على مركزية الدولة والقوة العسكرية، لم تعد كافية لفهم التحديات الأمنية المعاصرة التي تتطلب مقاربات أكثر شمولية وتعاونية” (ص. 25).
3- تحديات الحوكمة العالمية في ظل تعدد الفاعلين
تواجه مؤسسات الحوكمة العالمية تحديات غير مسبوقة في ظل تعدد الفاعلين وتضارب المصالح. يرى هاس (2023) أن “النظام المتعدد الأطراف الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية يعاني من أزمة شرعية وفعالية، نتيجة عدم قدرته على التكيف مع التحولات في موازين القوى العالمية” (ص. 201).
ويضيف: “المؤسسات الدولية التقليدية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تواجه منافسة متزايدة من مؤسسات بديلة أنشأتها القوى الصاعدة، مما يهدد بتفتيت نظام الحوكمة العالمية” (ص. 202).
خامساً: السيناريوهات المستقبلية للنظام العالمي
1- استمرار الهيمنة الأمريكية مع تعديلات
يرى بعض المحللين أن النظام العالمي سيستمر تحت قيادة أمريكية، مع تعديلات تستوعب صعود القوى الجديدة. يشير إيكنبيري (2018) إلى أن “النظام الليبرالي بقيادة الولايات المتحدة يمتلك قدرة كبيرة على التكيف والاستيعاب، من خلال توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار العالمي مع الحفاظ على القواعد والمبادئ الأساسية” (ص. 245).
ويضيف: “التحدي الأكبر للنظام الليبرالي ليس خارجياً من القوى الصاعدة، بل داخلياً من تراجع التزام الولايات المتحدة ذاتها بالمؤسسات والقواعد التي ساهمت في تأسيسها” (ص. 246).
2- نظام متعدد الأقطاب متوازن
السيناريو الثاني هو التحول نحو نظام متعدد الأقطاب أكثر توازناً. يتوقع ليفي (2018) أن “العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب يضم الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وروسيا والهند كقوى رئيسة، مع تأثير متزايد لقوى إقليمية مثل البرازيل وتركيا وإيران” (ص. 320).
ويحذر من أن “الأنظمة متعددة الأقطاب تاريخياً كانت أكثر عرضة لعدم الاستقرار من الأنظمة الثنائية أو الأحادية القطبية، مما يتطلب آليات جديدة لإدارة العلاقات بين القوى الكبرى” (ص. 321).
3- الفوضى وتفكك النظام العالمي
السيناريو الثالث والأكثر قتامة هو تفكك النظام العالمي وانزلاقه نحو الفوضى. يحذر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (2023) من أن “تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى، مع ضعف المؤسسات الدولية وتزايد التحديات العابرة للحدود، قد يؤدي إلى تفكك النظام العالمي وظهور مناطق نفوذ متنافسة مع حد أدنى من التعاون العالمي” (ص. 45).
ويضيف التقرير: “هذا السيناريو سيكون الأكثر خطورة في مواجهة التحديات العالمية المشتركة مثل التغير المناخي والأوبئة والإرهاب العابر للحدود، التي تتطلب تعاوناً دولياً غير مسبوق” (ص. 46).
سادساً: التحولات القيمية والأخلاقية في النظام العالمي الجديد
1- صراع القيم والنماذج الحضارية
يشهد النظام العالمي صراعاً متزايداً بين نماذج قيمية وحضارية متنافسة. يرى هنتنغتون (1999) أن “الصراعات الرئيسة في السياسة العالمية ستكون بين أمم ومجموعات من حضارات مختلفة، وأن صدام الحضارات سيهيمن على السياسة العالمية” (ص. 28).
ويضيف: “الغرب في الواقع يستخدم المؤسسات الدولية والقوة العسكرية والاقتصادية للحفاظ على هيمنته وتعزيز قيمه السياسية والاقتصادية، مما يثير مقاومة متزايدة من الحضارات الأخرى” (ص. 29).
في المقابل، يرى ويندت (2005) أن “الهويات والقيم ليست ثابتة بل متغيرة، وتتشكل من خلال التفاعل الاجتماعي، مما يفتح المجال لبناء هويات مشتركة وقيم عالمية عبر الحوار والتعاون” (ص. 410).
2- تحديات العولمة الثقافية والهوية
تطرح العولمة الثقافية تحديات عميقة للهويات الوطنية والمحلية. يشير الحسيني (2022) إلى أن “العالم العربي والإسلامي يواجه تحدياً مزدوجاً: الحفاظ على هويته الثقافية والحضارية من جهة، والانخراط الإيجابي في النظام العالمي من جهة أخرى” (ص. 60).
ويضيف: “الاستجابة الناجحة لهذا التحدي تتطلب تجديداً فكرياً وثقافياً داخلياً، يسمح بالتفاعل الإيجابي مع العالم مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية” (ص. 61).
3- أزمة الأخلاق في السياسة الدولية
يرى ناي (2020) أن “السياسة الدولية تواجه أزمة أخلاقية عميقة، تتمثل في التوتر بين المصالح الوطنية الضيقة والمسؤولية الأخلاقية تجاه القضايا العالمية المشتركة” (ص. 175). ويتساءل: “هل يمكن للقادة السياسيين الموازنة بين مسؤولياتهم تجاه مواطنيهم ومسؤولياتهم تجاه الإنسانية جمعاء؟” (ص. 176).
ويخلص إلى أن “الأخلاق تهم في السياسة الخارجية، ليس فقط من منظور مثالي، بل أيضاً من منظور واقعي، لأن السياسات الأخلاقية تعزز الشرعية والنفوذ الناعم للدول على المدى الطويل” (ص. 177).
سابعاً: دور العالم العربي والإسلامي في النظام العالمي الجديد
1- التحديات الجيوسياسية
يواجه العالم العربي والإسلامي تحديات جيوسياسية غير مسبوقة في ظل التحولات العالمية. يشير الحسيني (2022) إلى أن “المنطقة العربية تحولت من موقع الفاعل إلى موقع المفعول به في النظام العالمي، نتيجة الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية وضعف مؤسسات الدولة الوطنية” (ص. 48).
ويضيف: “التنافس بين القوى العالمية والإقليمية على النفوذ في المنطقة العربية يحول دون تبلور مشروع نهضوي عربي مستقل، ويكرس حالة التبعية والتجزئة” (ص. 49).
2- الفرص الاستراتيجية المتاحة
على الرغم من التحديات، يمتلك العالم العربي والإسلامي فرصاً استراتيجية مهمة. يرى الحسيني (2022) أن “الموقع الجيواستراتيجي للعالم العربي، وموارده الطبيعية، وثقله الديموغرافي، وعمقه الحضاري، تمثل أصولاً استراتيجية يمكن توظيفها لتعزيز مكانته في النظام العالمي” (ص. 55).
ويضيف: “التحول الديموغرافي في العالم العربي، مع ارتفاع نسبة الشباب وتزايد مستويات التعليم، يمثل فرصة للانتقال نحو اقتصاد المعرفة والابتكار، شرط توفير البيئة السياسية والاقتصادية المناسبة” (ص. 56).
ثامناً: سيناريوهات مستقبل العالم العربي والإسلامي في النظام العالمي
يطرح الحسيني (2022) ثلاثة سيناريوهات لمستقبل العالم العربي والإسلامي في النظام العالمي:
- السيناريو الأول هو “استمرار التفكك والتهميش”، حيث “تستمر الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية، مما يعمق حالة التجزئة ويضعف الدور العربي والإسلامي في النظام العالمي” (ص. 62).
- السيناريو الثاني هو “التكامل الإقليمي والنهوض التنموي”، حيث “تنجح الدول العربية والإسلامية في تجاوز خلافاتها وبناء تكتلات إقليمية فاعلة، وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار” (ص. 63).
- السيناريو الثالث هو “التكيف الاستراتيجي مع النظام متعدد الأقطاب”، حيث “تتبنى الدول العربية والإسلامية استراتيجيات براغماتية للتعامل مع القوى العالمية المختلفة، وتوظيف التنافس بينها لخدمة مصالحها الوطنية والإقليمية” (ص. 64).
خاتمة
يشهد النظام العالمي تحولات عميقة وغير مسبوقة في هياكل القوة وآليات الحوكمة والقيم والمبادئ الأساسية. هذه التحولات تطرح تحديات وفرصاً للمجتمع الدولي بأسره، وتتطلب إعادة تفكير جذرية في قواعد وآليات إدارة العلاقات الدولية.
كما يشير كيسنجر (2014): “التحدي الأكبر للنظام العالمي في القرن الحادي والعشرين هو التوفيق بين تعددية الرؤى والمصالح من جهة، والحاجة إلى قواعد ومبادئ مشتركة للتعايش والتعاون من جهة أخرى” (ص. 371).
تخلص الدراسة إلى أن مستقبل النظام العالمي سيتحدد من خلال التفاعل المعقد بين ثلاثة عوامل رئيسة: تطور العلاقات بين القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة والصين، قدرة المؤسسات الدولية على التكيف مع التحولات في موازين القوى العالمية، ونجاح المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة مثل التغير المناخي والأوبئة والإرهاب.
وفي هذا السياق، يصبح بناء نظام عالمي أكثر عدالة وشمولية واستدامة ضرورة وجودية للبشرية جمعاء، وليس مجرد خيار سياسي أو أكاديمي.
المراجع المعتمدة
- أليسون، غراهام. (2017). محكومون بالحرب: هل تستطيع أمريكا والصين الهروب من فخ ثوسيديديس؟ ترجمة محمد محمود التوبة. الرياض: العبيكان للنشر.
- بول، هيدلي. (2010). المجتمع الفوضوي بعد ستين عاماً. مجلة العلاقات الدولية، 94(1)، 75-87
- الحسيني، محمد. (2022). العالم العربي في النظام العالمي المتغير: تحديات وفرص. المجلة العربية للعلوم السياسية، 74(3)، 45-67
- زكريا، فريد. (2008). عالم ما بعد أمريكا. ترجمة محمد محمود التوبة. الرياض: مكتبة العبيكان.
- سلوتر، آن-ماري. (2017). رقعة الشطرنج والشبكة: استراتيجيات الاتصال في عالم مترابط. ترجمة سامي الكعكي. أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
- شوارتز، هيرمان. (2023). الذكاء الاصطناعي والنظام العالمي: تحديات الحوكمة والأمن. مجلة السياسة الدولية، 75(2)، 211-232
- كابلان، روبرت. (2019). عودة عالم ماركو بولو: الحرب والاستراتيجية والمصالح الأمريكية في القرن الحادي والعشرين. ترجمة أحمد مغربي. الرياض: العبيكان للنشر.
- كراوثامر، تشارلز. (1990). اللحظة الأحادية. مجلة الشؤون الخارجية، 70(1)، 23-33
- كيسنجر، هنري. (2014). النظام العالمي: تأملات حول طلائع الأمم ومسار التاريخ. ترجمة فاضل جتكر. بيروت: دار الكتاب العربي.
- كيوهين، روبرت. (2012). المؤسسات الدولية: هل يمكنها المساهمة في السلام العالمي؟ مجلة السياسة الدولية، 45(3)، 325-355
- ليفي، جاك. (2018). قطبية النظام واستقراره الدولي: تحليل تجريبي. مجلة تسوية النزاعات، 38(2)، 303-334
- مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي. (2021). الاتجاهات العالمية 2040: عالم أكثر تنازعاً. واشنطن: مكتب مدير الاستخبارات الوطنية.
- المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. (2024). التوازن العسكري 2024. لندن: المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
- المنتدى الاقتصادي العالمي. (2024). تقرير المخاطر العالمية 2024. جنيف: المنتدى الاقتصادي العالمي.
- مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. (2023). مستقبل النظام العالمي: سيناريوهات 2035. واشنطن: مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
- ميد، والتر راسل. (2021). نهاية النظام الليبرالي؟ مجلة الشؤون الخارجية، 100(1)، 25-32
- ميرشايمر، جون. (2019). الوهم العظيم: الأحلام الليبرالية والواقع الدولي. ترجمة عمرو عثمان. القاهرة: المركز القومي للترجمة.
- ناي، جوزيف. (2020). هل للأخلاق أهمية؟ الرؤساء والسياسة الخارجية من روزفلت إلى ترامب. ترجمة محمد إبراهيم. بيروت: دار الساقي.
- هاس، ريتشارد. (2023). العالم في اضطراب: السياسة الخارجية الأمريكية وأزمة النظام القديم. ترجمة مصطفى قاسم. القاهرة: دار الشروق.
- هنتنغتون، صامويل. (1999). صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي. ترجمة طلعت الشايب. القاهرة: سطور
- والتز، كينيث. (2000). قطبية النظام الدولي واستقراره: تحليل تجريبي. المجلة الأمريكية للعلوم السياسية، 32(4)، 881-909
- ويندت، ألكسندر. (2005). الفوضى هي ما تصنعه الدول منها: البناء الاجتماعي لسياسة القوة. المجلة الدولية للدراسات الأمنية، 46(2)، 391-425
- إيكنبيري، جون. (2018). الليفياثان الليبرالي: أصول وأزمة وتحول النظام العالمي الأمريكي. ترجمة أحمد عبد الحميد. القاهرة: المركز القومي للترجمة.
- رودريك، دني. (2022). مستقبل العولمة في عالم متعدد الأقطاب. مجلة الاقتصاد السياسي العالمي، 29(1)، 1-18