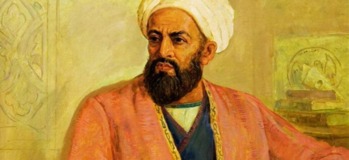قِيْل وقَالوا
فئة : مقالات

قِيْل وقَالوا
ما أكثر ما أنجبت الحضارة الإسلامية من رجالات العلم والفكر والفلسفة والسياسة والأدب والشعر والتصوف. ومن أبرزهم الإمام الكبير أبو حامد الغزالي؛ صاحب كتاب «إحياء علوم الدين» وكتب غيره كثيرة في الفقه والأصول وعلم الكلام والفلسفة والتصوف.
وكتابه «المنقذ من الضلال»، على صغر حجمه، فيه علمٌ جم، وخلاصة تجربة شخص نذر نفسه بحثًا عن الحقيقة في وسط كان يمور بكثير من التباينات والاختلافات في عاصمة الدولة العباسية بغداد.
تحدث الغزالي عن تجربة الشك التي مر بها، وكيف فقد الثقة في كل المعارف التي كان ينتحلها ويعول عليها؛ وذلك بعد قراءته للفلسفة قراءة شخصية خصص لها وقتًا، فوقف على حقيقتها، وشرع بالرد على رموزها، ثم التفت للتصوف فقرأه، وتحدث عن الصراع النفسي الذي عانى منه؛ لأنه بحسب قوله: فكر في أفضل عمل كان يؤديه؛ وهو التدريس، فرأى أنه غير خالص لوجه الله؛ وإنما لنيل الجاه، وغلبة الأقران، والتفرد بالرياسة.
وظل يصارع نفسه بين الاستمرار على عوائده القديمة، أو التضحية بكل ذلك والتخلي عنه بالمغامرة والذهاب للمجهول، حتى أقعد وأصيب بعدم القدرة على الكلام، وتأثر طلبته ورجال الدولة بما جرى له، وجاء الطبيب وعرف أنَّ لديه مشكلة نفسية وهمًا داخليًّا أورثه هذه العقلة في لسانه.
حسم الغزالي أمره - في آخر الأمة، وترك كل ذلك الجاه والصيت الذي كان يحظى به كعالم له مكانة في عاصمة الخلافة؛ وذلك لقربه من مركز الحكم فيها، فأوهم كل من يتصل به بتوجهه للحج، لكنه مضى إلى بلاد الشام معتكفًا في صومعة الجامع الأموي الساعات الطوال قضاها في التأمل، ومزاولة أعمال النظافة للمسجد، دون أن يعرف أحد أنه الغزالي الذي ملأ الدنيا علومًا وشهرة.
وللغزالي قصة يذكرها أصحاب الطبقات والتواريخ عن بدايته لطلب للعلم مع أخيه أحمد؛ فقد كان أباهما رجلاً محبًّا للعلم وأهله، وكان متى انتهى من عمله البسيط يحضر مجالس العلم والذكر، داعيًا الله أن يرزقه ابنًا كهؤلاء العلماء الذين أحبهم.
وحين دنا أجله أوصى بولديه محمد وأحمد إلى صديق له صوفي، وزوده بشيء من المال ادّخره لهما. ولمَّا انتهت نفقتهما لم يعد بمقدور هذا الشخص النفقة عليهما، فأودعهما في أحد المدارس لينالا حظهما من السكن والتغذية والعلم. ولذلك كان الغزالي كثيرًا ما يردد قائلاً: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله.
أمَّا أخوه أحمد، فقد ذكر ابن أبي الحديد أنه كان قاصًّا لطيفًا، وواعظًا مفوهًا، وأنه سلك في وعظه مسلكًا منكرًا في تعصبه لإبليس، وقوله عنه: إنه سيد الموحدين، وقوله يومًا على المنبر: من لم يتعلم التوحيد من إبليس فهو زنديق؛ أُمِرَ أنْ يسجدَ لغير سيده فأبى:
ولستُ بضارعٍ إلا إليكم
وأمَّا غيركم حاشا وكلا
وقال متحدثًا عن موسى: لمَّا قال له موسى: (أرني)، فقال: (لن). قال: هذا شغلك! تصطفي آدم، ثم تسود وجهه، وتخرجه من الجنة. وتدعوني إلى الطور، ثُمَّ تشمت بي الأعداء. هذا عملك بالأحباب، فكيف تصنع بالأعداء؟!
وذكر إبليس على المنبر، فقال: لم يدرِ ذلك المسكين أنَّ أظافير القضاء إذا حَكَّتْ أدمت، وأنَّ قِسِّي القَدَر إذا رَمَتْ أصْمَتْ، ثم قال: لسان حال آدم ينشد في قصته وقصة إبليس:
وَكُنتُ وليلى في صعودٍ من الهوى
فلمَّا توافينا ثبتُّ وَزّلتِ
وقال مرةً أخرى: التقى موسى وإبليس عند عقبة الطور، فقال موسى: يا إبليس لِمَ لَمْ تسجد لآدم؟
فقال: كلا ما كنت لأسجد لبشر. كيف أوحده، ثم ألتفت إلى غيره؟! ولكنك أنت يا موسى سألت رؤيته، ثم نظرت إلى الجبل؛ فأنا أصدق منك في التوحيد.
وأنه قال على المنبر: معاشر الناس إني كنت دائمًا أدعوكم إلى الله، وأنا اليوم أحذركم منه. والله ما شدت الزنانير إلا في حبّه، ولا أديت الجزية إلا في عشقه.
وقال أيضًا: إنَّ رجلاً يهوديًّا أُدخِلَ عليه، ليسلم على يده، فقال له: لا تسلم! فقال له الناس: كيف تمنعه من الإسلام، فقال احملوه إلى أبي حامد -يعني أخاه-: ليعلمه «لا» «لا» المنافقين.
ثم قال: ويحكم أتظنون أنَّ قوله: لا إله إلا الله منشور ولايته؟! ذا منشور عزله.
ويقول ابن أبي الحديد معلقًا: وهذا نوع تعرفه الصوفية بالغلو والشطح. ويُروَى عن أبي يزيد البسطامي منه كثير. ومِمَّا يتعلق بما نحن فيه ما رووه عنه من قوله:
فَمَنْ آدمُ في البينِ
ومَنْ إبليسُ لولاكا؟
فَتنتَ الكُلَّ والكُلُّ
مع الفتنةِ يهواكا
أقول: كُلُّ ما ذكره ابن أبي الحديد فقد أحال به على ابن الجوزي في تاريخه المنتظم. وابن الجوزي خصم لدود للصوفية. فكلامه فيهم غير مقبول فيهم، وقد انتقد ابن الجوزي أخاه الشيخ أبي حامد والشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهما من المتصوفة في تاريخه، ودافع عنه المناوي في طبقاته منتقدًا ابن الجوزي بالتحامل.
وذكر المناوي في طبقاته عن الحافظ السلفي متحدثا عن أبي الفتوح أحمد الغزالي: إنه كان أذكى الخلق، وأقدرهم على الكلام".
وأنه كان يقول عن الفقهاء إنهم أعداء أرباب المعاني.
وذكر أنَّ قارئَا قرأ عنده (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم)، فقال: شرفهم بياء الإضافة إلى نفسه. وأنشد:
وَهَانَ عَليَّ اللومُ في جَنبِ حُبِّها
وَقَولُ الأعادي: إنَّهُ لَخَليعُ
أصَمُّ إذا نوديتُ باسمي، وإنني
إذا قيل: يا عبدِهَا لَسمِيعُ
وسئل عن قول علي -رضي الله عنه-: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينًا، والخليل يقول: (أرني كيف تحيي الموتى) [البقرة: 206]، فقال: اليقين يُتَصور عليه الجحود، والطمأنينة لا يتصور عليها الجحود.
أما قوله: عن إبليس بأنه سيد الموحدين؛ لأنه رفض السجود لآدم، وقوله: «فمن آدم في البين...» إلخ- فأصله في أبيات للحلاج، مع اختلاف في السياق وتقديم وتأخير، وفي المعنى أيضًا. فالشيخ أحمد الغزالي جعل آدم في البين، فيما الحلاج جعله لإبليس، وهو بهذا الوصف أولى من آدم. هذا إذا قلنا إنَّ الواو في أبيات الحلاج استئنافية، وليست عاطفة على قوله: «وما آدمُ إلاكا».
الأمر الثاني: أنَّ أبيات الغزالي متعلقة بالقدر ومشيئة الخالق فيما يخلق، وأنَّ خطيئة آدم وخلق إبليس مرجعها للإرادة والتقدير الإلهي. ومن المعروف أنَّ أبا الفتوح الغزالي أشعري العقيدة.
أمَّا أبيات الحلاج، فهي أقرب إلى وحدة الوجود، وإن كانت الدكتورة سعاد الحكيم تنفي أن يكون الحلاج من أهل الوحدة، وإنَّما من القائلين بالحلول والاتحاد، وهذه الأبيات قد ترد عليها.
وأبيات الحلاج هي:
جحودي لَكَ تَقْدِيسُ
وَظَنِّي فِيكَ تَهوِيسُ
وقَدْ حَيرَّنِي حِبٌّ
وَطَرفٌ فِيهِ تَقويسُ
وقد دَلَّ دَليلُ الحُبَّ
أنَّ القُربَ تَلبِيسُ
وما آدمُ إلاكَ
ومَنْ في البَيْنِ إِبْليسُ
وقوله إنَّ: «لا» «لا» المنافقين، وأنها منشور عزله وليست منشور ولايته، يقصد بها كلمة الشهادة «لا إله إلا الله». فلا الأولى تنفي الإله مطلقًا، ثم إنه يثبت بلفظ الاستثناء «إلا». ولذلك، يفضل بعض الصوفية الذكر بالاسم العلم مجردًا، وهو: الله، الله، الله- مكرّرًا.
أمَّا فخر الرازي، فهو أحد عظماء المتكلمين على طريقة الإمام أبي الحسن الأشعري، له كتب كثيرة ذبَّ فيها عن هذا المذهب، وناضل عنه، وهو خصم المعتزلة العنيد؛ حتى إنَّ العلامة ابن أبي الحديد نجده في أحد أبياته يفخر أنه ممن رد ضلالات ابن الخطيب، ويقصد به الرازي؛ لأنَّ أباه كان خطيبًا في الري، وكان يقال لابنه ابن خطيب الري.
وكان للرازي جاه عظيم ومنزلة كبيرة حتى إنَّ التتار لما اكتسحوا العالم الإسلامي، جعلوا لأبنائه أمانًا مراعاة لحرمة أبيهم، فهرع الناس الخائفين من القتل يلوذون ببيته، لينجوا بأنفسهم من القتل.
فسر الرازي القرآن بتفسير لم يتمه سماه «مفاتيح الغيب»، وفسر الفاتحة بمجلد، وشرح نهج البلاغة، ولا أدري إن كان طبع أم لا.
وكنت قرأت قديمًا أنَّ الرازي في مرض موته جاءه أحد أصدقائه أو مريديه ليزوره، فرآه يبكي، فسأله عن سبب ذلك، فقال له:
مسألة كنت أجادل عنها منذ عشرين سنة أو ثلاثين سنة -الشك مني- تبين لي خطئي فيها، فكيف آمن على نفسي بأنَّ ما أعتقده الآن هو أيضًا من هذا الصنف.
ولمَّا زرت مصر عام 2014 كنت كثير التردد على مكاتبها في العتبة. وفي أحد أكشاكها التي تبيع الكتب، جاء زبون يبحث عن كتاب في تفسير الأحلام، للرازي، فقلت له: ليس من المعروف أنَّ للرازي كتابًا في تفسير الأحلام، ثم تحدثت معه عن الرازي وأنشدته أبياتًا له يقول فيها:
نهايةُ إقدامُ العُقُولِ عِقَالُ
وغايةُ سعي العالمينَ ضَلالُ
وأرواحُنَا في وحشةٍ مِنْ جُسُومِنا
وغايةُ دُنيَانا أذىً وَوَبَالُ
وَكَمْ مِنْ جِبالٍ قَدْ عَلتْ شُرفاتِها
رجالٌ فَزالتْ، والجِبالُ جِبَالُ
ولمْ نستفدْ من بحثنا طولَ عمرِنا
سوى ما جمعنا فيه قيل وقالوا
فــأبدى الأخ المصري أسفه، وهو يقلب يديه، مردّدًا: قيل وقالوا! قيل وقالوا!