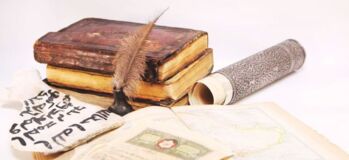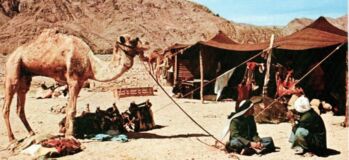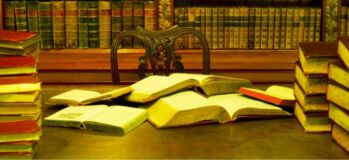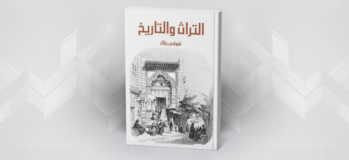أسئلة قراءة التراث عند الغذامي: المشاكلة والاختلاف أنموذجا دراسة تفكيكية
فئة : مقالات
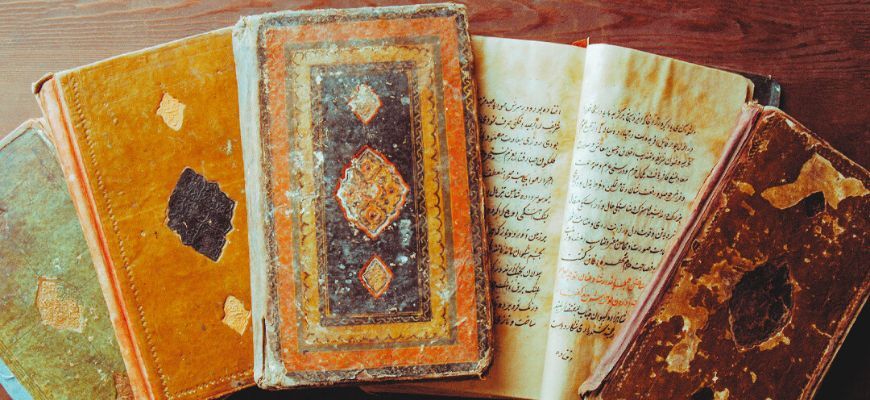
أسئلة قراءة التراث عند الغذامي: المشاكلة والاختلاف أنموذجا
دراسة تفكيكية
مقدمة
يتناول هذا البحث كتاب عبد الله الغذامي «المشاكلة والاختلاف: قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه المشترك» بوصفه قراءة حديثة للتراث العربي القديم، وقد رمنا رصد ما أسميناه «أسئلة القراءة» عند الغذامي؛ وذلك من خلال سؤال ماهية التراث ورؤية الناقد لهذا التراث، وسؤال الغاية من قراءته، ثم أخيرا سؤال الكيفية التي تمت بها القراءة. وقد جعلنا المقدمة المنهجية لدراسة جابر عصفور «قراءة التراث النقدي» منطلقا أعاننا في تحديد زاوية رؤيتنا إلى هذه القراءة.
وقد استفدنا خلال إعدادنا هذا البحث من دراستين تشتركان في موضوع واحد، وهو بحثُ تحيزات المناهج الغربية وكيفية تلقي النقاد العرب المعاصرين لها، وهما:
- إشكالية التحيز في النقد العربي المعاصر، لعلي صديقي والتي أعانتنا في فهم كثير من التناقضات التي وقعت فيها قراءة عبد الله الغذامي.
- هجرة التفكيك إلى النقد العربي، لأحمد الجرطي والتي أتاحت لنا مادة يمكن استعمالها وتوظيفها في كشف تحيزات منهج الغذامي وتناقضاته.
إلا أن الدراستين اقتصرتا على جوانب محددة من كتاب «المشاكلة والاختلاف»، وانحصرت في جانب تحيز مقولات التفكيك وتناقضات الغذامي في تعامله مع التراث النقدي، ومن ثم كان لابد من تجاوزها للإحاطة بالتراث الإبداعي الذي خصص له الغذامي القسم الثاني من الكتاب، ومن هنا تبرز أهمية البحث من خلال جدته، على حد علمنا، في التعرض للجانب الإبداعي في التراث عند الغذامي.
وقصد تحقيق هذا الغرض، وظفنا منهجا يقوم على تصورين نظريين؛ أما التصورُ الأول، فهو ما تتيحه لنا استراتيجية التفكيك من تفكيك للنص والوقوف على تناقضاته، وقد استعنا بمقولتين خاصة: الاختلاف ونقد التمركز، فجعلنا ننظر إلى قراءة الغذامي لا بالعودة إلى نموذج للقراءة يكون بمثابة الأصل، ولكن باختلافها مع قراءة عبد العزيز حمودة خاصة. يضاف إلى هذين المقولتين، مقولة قراءة الإساءة والتي تمثلت في تجاوزنا للقراءتين السابقتين. في حين أن التصور الثاني، هو التصور الذي جعله جابر عصفور أساس كل قراءة حديثة للتراث من خلال الأسئلة الثلاثة التي سقناها في بداية المقدمة، يضاف إليها رؤيا الغذامي إلى التراث.
ويتشكل هذا البحث من مقدمة، ومدخل منهجي تطرقنا فيه إلى منطلقات الدراسة، ثم محور واحد عنوناه بـ«أسئلة القراءة عند عبد الله الغذامي» وضم ثلاثة عناصر هي كالآتي: سؤال الماهية والرؤيا، وسؤال الغاية، ثم سؤال الكيفية. وختمنا بحثنا بخاتمة جمعنا فيها نتائج وخلاصات البحث، وأتبعناها بلائحة المصادر والمراجع.
مدخل منهجي: إشكالية قراءة التراث في النقد العربي المعاصر
قبل الخوض في قراءة عبد الله الغذامي للتراث من خلال كتابه «المشاكلة والاختلاف: قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه المشترك»، كان لا بد أن نتوقف عند إشكالية مركزية تعددت حولها الآراء والتصورات، ونتجت عنها خلافات وسجالات، ألا وهي إشكالية القراءة نفسها التي خص بها النقاد العرب المعاصرون التراث.
قراءة التراث تجعل منه عنصرا ثابتا في العملية النقدية، في حين تتغير أنماط القراءة بحسب الغايات المرجوة، والطرائق المسلوكة. والحالة هذه، فإن ما يهمنا في هذا البحث، ليس التراث الثابت، وإنما الأهداف التي يفترض أن تحققها هذه القراءة والتي، هي نفسها، تتغير بتغير منهجية التعامل مع النص التراثي.
لا جرم أن قراءة عبد الغذامي تحقق مقولة الاختلاف مع غيرها من القراءات، اختلاف يتنازعه مدلولان؛ أولٌ متصل بالمكان، وهو مغايرة قراءة الغذامي لغيرها من القراءات واختلافها عنها؛ إذ لا يمكن أن ندرج هذه القراءة في أي خانة مشتركة بين القراءات الأخرى. وثانٍ متصل بالزمان، ونعني به انتفاء قراءةٍ أصل تعود إليها كل القراءات وإنما ينظر إلى كل قراءة في اختلافها عن نظيراتها. وعلى هذا الأساس قمنا باستعراض نموذجين للقراءة، وهما: محاولة عبد العزيز حمودة في تأسيس نظرية نقدية عربية بديلة، وجهود جابر عصفور لإرساء معالم منهج عام لقراءة التراث.
ينطلق عبد الحمودة من مفهوم الشرخ أو «ثقافة الشرخ»[1] ليحدد أسباب تأزم النقد العربي المعاصر في انبهار العقل العربي بمنجاز العقل الغربي، واحتقاره التراث، ويؤكد على «ضرورة البحث عن هويتنا الثقافية ثم تأكيدها في مواجهة سيطرة غربية قادمة لا بل هي قائمة بالفعل»[2]، وهو إذ ينادي بالالتفات إلى التراث للحد من السيطرة الغربية، ينبه على أن الحماس الزائد للتراث يجعلنا نُقوّله ما لم يقله، ونبحث فيه عما يمكن أن يكون صدى للنظريات الغربية، ومن ثمة فإن البحث عن الهوية الثقافية العربية «ليس مبررا كافيا لحماسنا للتراث النقدي العربي؛ لأن الاعتماد على الحماس وحده يعني فرض رؤية وهمية لا وجود لها على النصوص النقدية التراثية أو استنطاقها بما ليس فيها»[3]، وفي المقابل، يرى أن أي قراءة للتراث يجب أن تنطلق من داخل هذا التراث لا من خارجه، فـ«النصوص التراثية العربية هي التي تؤسس شرعيتها في قراءتنا الحالية لها»[4].
ومن هذه النقطة؛ أي من انتقاده للمناهج الغربية ومنجزات العقل الغربي ثم محاولته إعادة الاعتبار للتراث، راح حمودة يؤسس لنظرية نقدية عربية بديلة وجد جذورها في التراث النقدي والبلاغي عامة، وعند عبد القاهر الجرجاني خاصة، إلا أنه هو الآخر «لم يسلم من شرك المركزية الغربية وسطوة مناهجها ومفاهيمها، حيث ساهم بدوره، بغير وعي منه، في تأسيس شرعية الحاضر الأجنبي»[5]، و«اتخذ من نظرية سوسير مؤطرا في بديله النظري»[6].
أما جابر عصفور، فيحدد ثلاثة أسئلة مركزية هي مدار كل قراءة للتراث، فـ«ما التراث النقدي؟ [و] لماذا نقرؤه؟ [و] كيف نقرؤه؟ أسئلة متكررة الطرح متغيرة الإجابة، ذلك لأنها أسئلة متضمَّنة بالضرورة، وإن اختلف ترتيبها، في كل اتجاه نقدي»[7]، ومن ثمة فهو يشترط في كل قراءة للتراث أن تجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة، ولو تغير ترتيبها؛ فتحديد ماهية التراث، من أين يبدأ وأين ينتهي؟ ثم تحديد الغاية من القراءة، ألاستخراج نظرية، مثلا، أم للبحث فيه عن طيف نظرية غربية؟ فاختيار الكيفية التي بها تتم عملية القراءة، أننطلق منه أم نصل إليه؟ أنقتصر على كل التراث أم جزء منه؟ وغيرها من الأسئلة المتفرعة عن سؤال الماهية، وسؤال الغاية، وسؤال الكيفية.
يرتب عصفور أنماط القراءة وَفق ترتيبها الأسئلة المطروحة وإجاباتها المقدمة؛ فهو يجعل التيار الإحيائي أول الأنماط التي حاولت قراءة التراث من خلال الإجابة المتميزة التي أعطى من خلالها أهميةً لسؤال الغاية والمتمثلة في استرجاع الماضي، وعلى أساسها حدد الإحيائيون كيفية قراءة التراث وماهيته. ومثل ذلك، يرتب الأنماط الأخرى كالرومنسية، والتاريخية، والبنيوية، وغيرها.[8]
يقوم منهج قراءة التراث النقدي عند عصفور على النظرة الشمولية للتراث، «فكل نص من نصوص التراث النقدي لا يمكن أن نقرأه في عزلة عن غيره من النصوص، فالتراث النقدي وحدة سياقية واحدة، داخل وحدة سياقية أوسع هي التراث كله»[9]، وعلى هذه النظرة الشمولية أن تراعي حضوره في تاريخه وتاريخنا، وتحدد علاقتنا به التي تنفصل باختلاف العصور وتتصل بثبات قيمة النص المقروء، ثم الحدود القصوى لعملية القراءة.
كما أن تبني جابر عصفور البنيوية التكوينية جعله يحدد منطلق القراءة في استخلاص (رؤيا العالم) التي يعبر عنها التراث ووضعها في مقابل (رؤيا عالم) عند القارئ المعاصر.
إن إيراد عصفور للرؤيتين، يؤكد ما ذهبنا إليه بكون التراث عنصرا ثابتا في عملية القراءة؛ فجعل رؤيا العالم التي يعبر عنها التراث معرفة في إشارة إلى أنها رؤيا واحدة لا تقبل التعدد، في حين جعل رؤيا عالم القارئ المعاصر نكرة دليلا على تعدد الرؤى بتعدد القراء؛ ومن ثمة، فكل قارئ معاصر يتعرض للتراث بالقراءة يضع رؤياه الخاصة في مقابل رؤيا التراث، «وقد تتقارب الرؤيتان، القديمة والمعاصرة. وقد تتباعدان. وقد تتصف العلاقة بينهما بصفات متعددة. ولكن المهم أن العلاقة بينهما دائما تؤدي إلى تحديد قيمة النص المقروء من ناحية، واتجاهات عملية القراءة من ناحية ثانية»[10].
وذهب عصفور أبعدَ من هذا، حينما جعل عملية قراءة التراث النقدي عملية تنهض على التفسير والتأويل، مما يجعل منها عملية ذاتية في المقام الأول، وهي على مستويين اثنين: المستوى النظري، والمستوى التطبيقي؛ إذ لا يمكن أن نقرأ التراث النقدي قراءة تطبيقية إذا لم نمتلك نظرية للقراءة، ولا معنى للتنظير دون تطبيق. وكلا المستويين تربطهما علاقة جدلية تقتضي التأثير والتأثر.[11]
ومن هنا، جعلنا نظرتنا إلى قراءة عبد الله الغذامي التراث تتركز في تحديد ماهيته واستخلاص رؤياه إلى هذا التراث، فالغاية من وراء قراءته، وأخيرا محاولة الكشف عن المنهجية أو الكيفية التي اعتمدها في هذه القراءة.
I. أسئلة القراءة عند عبد الله الغذامي
نحاول في هذا المحور استخلاص أجوبة الغذامي عن الأسئلة التي قررناها أساس كل قراءة حديثة للتراث، في مدخل هذا البحث، ولكن القارئ لكتاب «المشاكلة والاختلاف» لن يصادف حديثا صريحا حول ماهية التراث عند الغذامي، ولا الغاية من قراءته، ولا منهج هذه القراءة. والحالة هذه، فقد حاولنا استخلاص ما يمكن أن يكون أجوبة عن تلك الأسئلة عن طريق تحليل بعض نصوصه وتفكيكها وتأويلها، وأحيانا أدخلنا منهجه في التأليف بوصفه عنصرا متحكما في هذه العملية التأويلية ساعدنا في تقديم صورة ممكنة من صور أخرى يمكن أن تتشكل عليها قراءة الغذامي.
- سؤال الماهية والرؤيا
يحضر التراث عند عبد الله الغذامي بوصفه «كمّا معرفيا مهولا تراكم على مرّ الزمن»[12]، ويظهر هذا جليا من خلال منهجه في تأليف الكتاب وتقسيمه إلى قسمين اثنين: قسم خاص بالتراث النقدي، وقسم خاص بالتراث الإبداعي، إن جاز لنا أن نطلق عليهما هذين الاسمين.
إن التراث، في عينَي الغذامي، هو ذلك الجزء من الفكر الإنساني الذي يعود إليه الناقد المتأخر زمانا ليفتش فيه عن التمثلات العديدة لما يمكن أن يستجد عند الآخر، ومن ثمة ساعد هذا الكم المعرفي المتراكم عبر الزمن على «مقارعة الرأي بالآراء والفكرة بالأفكار، مما جعل الأفكار تتعرض لمزيد من الفحص والمقارنة والاختبار. ثم إن ذلك أعطى كل فكرة جديدة رصيدا معرفيا من الموروث الثقافي يساعدها على احتلال موقع مأمون في النسيج المعرفي الإنساني، وصارت كل نظرية - مهما بدت جديدة- تملك سلسلة من النسب والانتساب يمنحها صدقا لدى أهلها ومكانا لدى تاريخها»[13]، وبهذا لا يضع الغذامي التراث العربي القديم في موضع مقارنة مع منجزات الغرب، وإنما يذهب أبعد من هذا بكثير حينما يُسلّم بوجود الفكرة الغربية المفردة في صور متعددة في التراث، بل إن كل نظرية مستجدة لابد من وجود جذور لها في هذا التراث العربي المتراكم على مر الزمان.
يضاف إلى هذا، أن الغذامي لا يقرأ التراث النقدي بمعزل عن التراث الإبداعي، ومن هذه الزاوية ينظر إلى التراث نظرة فيها الكثير من التجديد؛ إذ لم يكتف بقراءة التراث النقدي وحده، وإنما حاول استثمار خلاصاته حول التراث النقدي لدراسة نصوص إبداعية تراثية ليؤكد هذه الخلاصات؛ فبعد أن راح يبحث للاختلاف الدريدي عن جذور عند عبد القاهر الجرجاني، ويجعلها في مقابل المشاكلة التي سار نحوها عدد كبير من النقاد، ومنهم على سبيل التمثيل، الآمدي والمرزوقي، عاد في القسم الثاني من الكتاب ليقف عند نصين أحدهما للبحتري والثاني للمتنبي عن معركة إنسان وأسد، «يضاف إليهما نص ثالث ورد في المقامة البشرية لبديع الزمان الهمذاني»[14].
ليس هذا فقط، فالغذامي تحكمه، في رؤيته إلى التراث، ثنائيات متناقضة ساهمت في توجيه قراءته، ولعل أهم هذه الثنائيات، تمييزه بين تيارين أحدهما كلاسِيّ مقلّد وهو تيار المشاكلة والعمودية، والآخر مجدد مغير في أساليبه، وهو تيار الاختلاف والنصوصية.
يتزعم تيار المشاكلة في التراث النقدي الآمدي والمرزوقي؛ فالآمدي يعد أول من اعتمد عمود الشعر في موازنته بين أبي تمام والبحتري، وعلى يديه تكون مصطلح المشاكلة، وتأسست «الرابطة بينها وبين الطبع، ثم وصف ذلك كله بأنه (المعروف) مما يعني حكر هذه الصفة داخل هذا التصور ونفيها عن كل شعر لا تتمثل فيه شروط العمود والطبع المعروف»[15]. أما المرزوقي، فقد نُسِبَ إليه الفضل في تحديد العناصر السبعة لعمود الشعر والتي لا يقوم الشعر إلا بها، وقد استفاد في ذلك من جهود سابقيه، فجاء تصوره لعمود الشعر «خلاصة نظرية صاغها الكاتب من الأعمال النقدية السابقة عليه في القرنين الثالث والرابع إلى الخامس الهجري، وبالتالي [ومن ثمة] فهي تمثل صياغة نهائية لمفهوم العمودية تم استخلاصها من كتب النقد العربي، وهي خلاصة تركز على مبدأ (المشاكلة) وتتمحور حوله»[16]. وبهذا تكون غاية المرزوقي في تبين عمود الشعر المعروف تتلخص في تمييز «تليد الصنعة من الطريف، وقديم نظام القريض من الحديث [...] ويعلم أيضا فرقُ ما بين المطبوع والمصنوع، وفضيلةُ الأتي السمح على الأبي الصعب»[17].
أما تيار الاختلاف في التراث النقدي، فتزعمه عبد القاهر الجرجاني الذي اتجه اتجاها مختلفا عما أقره الآمدي ومن بعده المرزوقي؛ فقد سعى عبد الله الغذامي إلى بيان تفرد الجرجاني من خلال مفهوم الاختلاف الذي مثّل جوهر «الغاية التي تسعى إليها (العمودية) وهي تتمثل في النص الأتي السمح، بينما غاية (النصوصية) تتجه نحو النص الأبي الصعب، الذي لا يقبل النزول إلى حالة التأتي أو السماح، وهذا يقودنا إلى تلمس صفات الأتي السمح مما يقوم على مبدأ (المشاكلة)، ويؤسس للمفهوم العمودي، وفي مقابله نضع صفات الأبي الصعب، الذي يقوم على مبدأ (الاختلاف) ويؤسس للتصور النصوصي»[18].
وبالنسبة إلى التراث الإبداعي، فإن تيار المشاكلة يتزعمه البحتري، الذي جاءت قصيدته «المتضمنة لنص الأسد، على نموذج نمطي (تقليدي) لم يفارق (عمود الشعر المعروف)، من حيث تكوينها الإنشائي»[19]، ومن ثمة فإن البحتري في قصيدة المدح التي خص بها الفتح بن خاقان لم يخرج عن البناء التقليدي للقصيدة العربية، أي شاكل النموذج وبقي حبيسَ النمطية والائتلاف؛ «فهي تبدأ بالغزل، ثم تتخلص منه بواسطة ما سماه البلاغيون بالتخلص [...] وتأخذ بعد ذلك بالمديح الذي يدخل إلى وصف المعركة بين الممدوح والأسد»[20].
في حين أن تيار الاختلاف، يمثله، من جهة الشعر، المتنبي الذي «تجنب التماثل الشكلي مع البحتري، فهو يتجنب تماثلات الوزن والروي. وبذا يخرج عن مصطلح (المعارضة) ويخرج عن سلطة الوزن وصوت الروي، فينطلق حرا في إيقاع مستقل وفي روي مختلف»[21]. فهو على عكس البحتري الذي جاء أسده «فاترا باردا»[22] وقُتل «قتلة رخيصة»[23] لا تخدم النص ولا تعطي شرعية للقتل، يقدم «لنا نصا ينطوي على نصوصية تسبب الأحداث وتولدها وتفضي إليها»[24].
أما من جهة النثر، فإن الغذامي يجعل من بديع الزمان الهمذاني زعيم تيار الاختلاف بلا منازع، ولا يتحرج في إعلان إعجابه بالمقامة البشرية، فهي «فريدة ومثيرة. فيها خصائص تميزها عن سواها من المقامات»[25]، وتَوقفُ الغذامي عند هذه المقامة بالضبط لم يكن توقفا اعتباطيا، وإنما لكونها تحقق لب مفهوم الاختلاف، وذلك عبر مستويين اثنين؛ الأول، هو اختلاف أسلوب السرد فيها عن باقي مقامات الهمذاني، فـ«تراجع السجع فيها، حتى لكأنها غير مسجوعة»[26]، وبهذا تكون المقامة البشرية قد «خرجت عن عرف كان بمثابة الأصل لها، فكأنما هي نص منبتّ انفصل عن أصله وخالف عرفه»[27]. والثاني، هو اختلاف الجملة الاستهلالية عن بقية المقامات الأخرى التي جرى العرف أن يستهلها الراوي عيسى بن هشام، فجاءت فعلا ناقصا: (كان بشر بن عوانة صعلوكا)، «وهذه المرة الوحيدة التي يرد فيها هذا الفعل الناسخ (كان) مسندا إلى غير الراوي»[28].
لقد تمثلت رؤيا الغذامي إلى التراث العربي بوصفه مزيجا بين جانبيه، النقدي والإبداعي، وربما هنا تكمن جدته واختلافه عن غيره من النقاد الذين صوبوا نظرهم نحو التراث النقدي وحده، وراهن في التمييز بين النقاد والمبدعين على مفهومي المشاكلة أو العمودية، والاختلاف أو النصوصية، ما أفضى إلى عدّه الجرجاني نموذجا متفردا للاختلاف في التراث النقدي، والمتنبي والهمذاني رمزين للاختلاف في التراث الإبداعي.
وقد قاد الغذامي في نظرته إلى هذا التراث مرجعيته التفكيكية الخالصة المتمثلة في توظيفه مقولتي الاختلاف ونقد التمركز عند جاك دريدا. فاستند إلى الاختلاف في تصنيفه لتيارات النقد والإبداع في التراث، فجعل الاختلاف عند الجرجاني والمتنبي مردّه الخروج عن عمود الشعر المعروف، ومحاولتهما تقويض فكرة الأصل أو المركزية التي اكتسبتها العمودية لزمن طويل، في حين أن الاختلاف عند الهمذاني حاصل في المقامة البشرية، دون غيرها، لاختلافها عن باقي المقامات، ومغايرتها الأصل الذي عُرفت به مقامات الهمذاني. هذا، باختصار، ما يمكن أن نقوله عن التراث عند الغذامي وسيأتي معنا في المحور الثالث الخاص بكيفية قراءة التراث ذكرُ وتفصيلُ القول في مرتكزات الناقد للحكم على التراث، ومساءلةُ توظيفِه مقولات التفكيك في تسويغ هذه الأحكام.
- سؤال الغاية
ينطلق عبد الغذامي من سؤال «كيف يكون النص الأدبي نصا أدبيا؟»[29] وللبحث عن أدبية الأدب تسلح بمقولة الاختلاف، وغيرها من المقولات، عند جاك دريدا وراح يبحث عن جذور لها في التراث العربي القديم (التأصيل)، نقدا وإبداعا، ثم جعل هذا التراث يتنازعه تياران، كما سبق القول، تيار المشاكلة أو العمودية، وتيار الاختلاف أو النصوصية. يغيب الاختلاف عند التيار الأول، بل يتناقض معه تناقضا تاما، في حين يحضر وبقوة عند التيار الثاني.
نظرة الغذامي إلى التراث القديم بوصفه كما معرفيا تراكم على مرّ الزمن جعلته يقرر أنه وعاء يمكن أن يستوعب كل ما يستجد في النظريات الغربية ومفاهيمها، مما يجعلها، في رأيه كونية، وإنسانية غير خاضعة لأنساق اجتماعية وثقافية وفلسفية، وعلى هذا الأساس راح يجوب «سراديب الماضي باحثا للنصوصية عن شجرة تنتسب إليها، وكان هذا المبحث يدعو لنفسه ويفتح أبوابه دون حاجة إلى طَرق كثير»[30]، وهو ما جعله يتوقف عند نماذج بعينها رأى أنها تمثل هذا الاختلاف، وميّزها عن غيرها، فجعل الجرجاني مثلا، نظيرا لدريدا في مقابل الآمدي والمرزوقي اللذين لم يختلفا عن عمود الشعر المعروف.
وفي السياق نفسه، ذهب أحمد الجرطي إلى أن الغاية من قراءة عبد الله الغذامي التراث تكمن في «محاولته تأصيل التفكيك في الموروث النقدي العربي القديم عن طريق رصد أوجه التقاطع والتواشج بين بعض مقولاته، وبعض المفاهيم والتصورات التي اكتنز بها النقد العربي القديم»[31]، وإذا كنا نتفق معه في الغاية، فإننا لا نسلم له بموضوع هذه الغاية؛ فالغذامي لم يتوقف عند التراث النقدي العربي فحسب، وإنما جاوزه، كما سبق بيان ذلك، إلى التراث الإبداعي العربي. ومن هنا، تكون إجابة السؤال الذي افتتح به الغذامي كتابه تكمن في النصوصية والاختلاف شرطا لتحقيق أدبية النص الأدبي.
ألزم الغذامي نفسه، في سعيه تحقيق هذه الغاية، بالالتزام بمصطلحات عربية تدل على ما يهدف إليه من مفهومات.[32] فجعل الاختلاف مرادفا لـ«Différance»[33] عند دريدا؛ إذ إن النص يتأسس عنده على قاعدة الاختلاف والتي هي «مبدأ نصوصي يجد بذرته لدى الجرجاني»[34]، وعن الفرق بين الاختلاف عند الجرجاني وعند دريدا، يقول الغذامي: «وعلى الرغم من أن اختلاف الجرجاني سابق على دريدا وبين الاثنين فروق جوهرية إلا أنني قد وضعت الأخير في كامل اعتباري، وتركت دريدا يحضر ويغيب بحرية تامة أثناء تفكيري في المصطلح وأثناء كتابتي عنه»[35].
والملاحظ أن الغذامي، في محاولته تأصيل مقولة الاختلاف في التراث، وقع في خلط كبير مردّه سوء فهم لهذه المقولة عند دريدا، جعلته يغفل «تحيزات هذا المفهوم، والاكتفاء بترجمته ترجمة لغوية حرفية، أي ضد الائتلاف»[36]. والغذامي نفسه يقر بتعسفه على دريدا، ومحاولة تقريبه قدر الإمكان من الجرجاني، لا لشيء إلا لأن الجرجاني سابق زمانا على دريدا رغم أن الاختلاف نشأ أول ما نشأ مع دريدا، وهذا من بين التناقضات الكثيرة التي وقع فيها الناقد أثناء محاولته تأصيل التفكيكية في التراث العربي القديم؛ فبعد أن أقر بأنه سيبحث عن جذور النصوصية في التراث، هذه النصوصية التي تتأسس على قاعدة الاختلاف، وجعل الاختلاف الجرجاني مرادفا لاختلاف دريدا، ثم ألزم نفسه بالانطلاق من دريدا ليصل إلى الجرجاني، نجده بعد فقرات قليلة يناقض نفسه ويحاول القيام بعكس ما صرح به، فراح يؤصل للاختلاف الجرجاني عند دريدا، وأثناء ذلك تعسف تعسفا لا يمكن إغفاله على نصوص جاك دريدا، يقول الغذامي: «ولعل الفصل الأول قد أخذ باعتبارات الاتفاق بين الاثنين من أجل استكشاف أبعاد الاصطلاح ومراميه القصية، ولكن الأمر ينتهي بنا إلى القول بمفهوم الاختلاف الجرجاني، بوصفه أساسا للنظر وللتفسير، أكثر من مجاراتنا دريدا في ذلك. بل إنني ربما ملت في أكثر من موضع إلى تفسير دريدا تفسيرا يقربه من الجرجاني، وبذا يكون (الاختلاف) في هذا الكتاب مصطلحا جرجانيا خالصا، وإن لم يغفل ولم يهمل دريدا»[37]. وهذا يجر إلى الذهن التعسف الذي مارسه عبد العزيز حمودة على الجرجاني، حينما تساءل: «هل حمّلنا عبد القاهر أكثر مما يحتمل؟»[38].
- سؤال الكيفية
تمثلت نظرة عبد الله الغذامي إلى التراث في كونه يضم النقد العربي القديم والنصوص الإبداعية على حد سواء، وجعل ينظر إلى كل قسم من هذين القسمين على أنه صراع بين تيارين؛ أحدهما مشاكل، والآخر مختلف. ثم أخذ على عاتقه قراءة هذا التراث من زاوية تأصيل مقولات التفكيك عامة، ومقولة الاختلاف خاصة، ولتحقيق هذه الغاية المتمثلة في رصد تقاطعات استراتيجية التفكيك مع مفاهيم التراث، اتبع منهجا يقوم على مجموعة من المنطلقات النقدية، سنحاول استخلاص بعضها في هذا المحور.
يرجع الغذامي أولى مشكلات النصوصية في «ثنائية اللفظ والمعنى، وأيهما أحق في الأفضلية الجمالية»[39] وهي المشكلة التي حاول الجرجاني حلّها بالنظم الذي تمركز حول المعنى، فجعله أولا ثم يأتي اللفظ «تابعا للمعنى»[40]. وبما أن الكلمة المفردة، في نظرية النظم، لا قيمة لها في ذاتها إلا حينما يُنظر إليها داخل التركيب، فقد «تم رفضها وصار مجموع الكلام هو مجال المقارنة والتشريح، وهذا يساوي (البنية)»[41].
وعلى الرغم من أن الغذامي ينتقد تمركز نظرية النظم عند الجرجاني حول المعنى، إلا أنه يعود ويستدرك تحرر عبد القاهر من سلطة المعنى حينما «هجس إلى فكرة سماها (معنى المعنى) تتفق مع مفهوم (الائتلاف عند الاختلاف) من حيث ارتكازها على (الأثر) الناتج عن النص وما يتولد عنه من دلالات»[42]. فمدار الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل، وعليه تكون الجملة «من حيث إنها تشير وتدل إلى غير ما في ظاهرها، أي إلى (الغياب) كما في مصطلح دريدا»[43].
وبالنسبة إلى قراءة الغذامي التراث الإبداعي، فينظر إلى قصيدة المتنبي التي يمدح فيها بدر بن عمار، على أنها أكثر من مبارزة بين رجل وأسد، ولكنها «-أيضا- بين شاعر وشاعر»[44] أحدهما سابق والآخر لاحق عليه، وهو يقتبس مقولة التداخل النصوصي من أحد رواد الجناح الأمريكي للتفكيكية، أو ما يعرف بحلقة جامعة ييل، هارولد بلوم، ليفكك التفاعل بين النص اللاحق والسابق، وقد حصرها في ستة مستويات[45]، فأول ما يفعله المتنبي هو «تجنب التماثل الشكلي مع البحتري»[46].
ثم إن نص المتنبي، يقوم على «التشابه المختلف مع نص البحتري، فهو يشبهه في كونه نصا عن المبارزة، وفي أنه جاء في سياق المديح»[47]، إلا أن المتنبي ما أن تشابه، في غرض القصيدة ومطلعها، مع البحتري حتى بادر إلى «مخالفته، ومن ثم تجاوزه»[48]. ولعلّ العنوان الذي اختاره الغذامي لهذا الفصل ب«ما ترك الآخِر للأول شيئا»[49] يحمل هو الآخر شيئا من المقولات التفكيكية، وهي ما يسميه هارولد بلوم «القراءة الضالة»[50] أو قلق التأثر، القائم على مقولة التناص، حيث إن الشعراء «يسكنهم الوعي بأنهم متأخرون في الزمن، وأن أسلافهم من عظماء الشعراء قد استنفذوا جميع المعاني مما يركب بداخلهم عقدة أوديبية [تجاه] هؤلاء الأسلاف لا سبيل للتغلب عليها من منظور بلوم إلا عن طريق إساءة قراءة المنجز الشعري لأسلافهم»[51]. ولهذا جاء العنوان «ما ترك الآخِر للأول شيئا» وليس «ما ترك الأول للآخِر شيئا».
في حين جعل الغذامي من الغياب شبه الكامل للسجع في المقامة البشرية للهمذاني على خلاف باقي المقامات انتصارا للكتابة على الصوت، حيث إن السجع من المظاهر الصوتية التي شاع استحواذها على هذا الفن الجديد المعروف بكثرة ملطفاتها اللغوية. وبهذا، يقوض الغذامي مركزية الصوت في المقامة، ويعيد الاعتبار للكتابة. ليس هذا فحسب، وإنما يعيد الاعتبار للبطولة الهامشية على حساب البطولة المركزية؛ فكانت بطولة الذكورية تنتقل من بشر إلى عمه إلى ابنه الأمرد، وسرعان ما اختفت هذه البطولة لتضطلع المرأة الجميلة بالبطولة.
على الرغم من جدة قراءة عبد الله الغذامي التراث العربي القديم، وأثناء محاولته تأصيل استراتيجية التفكيك وقع في مجموعة من التناقضات معضمها متعلق بسوء فهمه لما يحاول أن يؤصله أصلا، وبعضها مرتبط بسوء فهم نصوص الجرجاني. أما البعض الآخر، فيتلخص في ما يمكن أن نسميه خطأ المنطلقات.
جعل الغذاميُّ الجرجانيَّ متمركزا حول المعنى وقوّض من نظريته في النظم؛ لأنه ظهر بنيويا من خلال دعوته إلى النظر إلى اللفظة في مجموع التركيب لا في كونها مفردة، ثم سرعان ما استدرك هذا الأمر بمحاولته البحث عما يسوغ له تفكيكية الجرجاني، وتأتى له ذلك من خلال فكرة معنى المعنى عند الجرجاني، والحق أن الغذامي لم يفهم لا الجرجاني ولا فكرة النظم، فليس النظم عند عبد القاهر في المعنى، ولا في اللفظ، بل في تلاؤم معاني الألفاظ وتعلقها باللفظة التي تليها، يقول الجرجاني: «فقد اتضح الآن إذن اتضاحا لا يدع للشك مجالا، أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلم مفردة، وأن الفضيلة وخلافها، في ملائمة [ملاءمة] معنى اللفظة لمعنى التي تليها، وما أشبه ذلك، مما لا تعلق له بصريح اللفظ»[52].
كما أنه حين توظيفه مقولات التفكيك، انزاح عن دلالتها الحقيقية عند التفكيكيين، فمقولة الأثر التي قابلها الغذامي لفكرة معنى المعنى عند الجرجاني في النظم وتأويل الدلالة، لا علاقة لها بالمعنى التفكيكي المرتبط باللعب الحر للدوال وتأجيل الدلالة.[53] ويضاف إلى هذا، كما ذكرنا سالفا، فهمه الخاطئ لمقولة الاختلاف وترجمتها ترجمة لغوية حرفية.
ثم إن محاولة الغذامي تأصيل مقولات التفكيك في التراث العربي القديم من خلال إحداث مقارنة بينهما، تجعله يلغي تحيزات هذه الاستراتيجية الغربية، ويلغي الخصوصية الثقافية والتاريخية للتراث، ومن ثمة سقوطه في «القراءة الانتقائية»، كما يسميها جابر عصفور، والتي تحاول التوفيق بين أصالة الماضي ومعاصرة الحاضر، وما يتطلبه ذلك من نفي للعناصر السالبة والإبقاء على العناصر الموجبة.[54] ومن ثمة فـ«لا مجال للمقارنة بين ما أسماه الغذامي تيار النصوصية عند الجرجاني وبين الاختلاف الدريدي بصيغته الاجرائية المقوضة لمظاهر الانسجام والثبات في النصوص»[55]، ثم إن الحرص الذي أولاه الغذامي لتأصيل مقولات التفكيك في التراث العربي القديم أسقطه في «القراءة الانتقائية الإسقاطية التي جرد من خلالها التراث العربي من تاريخيته ليطابق مفاهيم وإبدالات معاصرة لا تنسجم مع حقيقة وخصوصية منجزه النقدي»[56]
ولعل أهم ما يمكن أن نسجل على قراءة الغذامي، تمركزه، في الجانب النقدي من التراث، حول الجرجاني، وكأن الجرجاني ظهر فجأة من العدم، «في حين أن نظريته في النظم امتداد لجهود علماء وبلاغيين سبقوه، وهو يصرح بذلك في مواضع كثيرة في كتابه دلائل الإعجاز». أما في ما يخص الجانب الإبداعي من التراث، فقد تمركز حول المتنبي في الإبداعي الشعري، وحول الهمذاني في الإبداع النثري.
خاتمـــــــة
سنحاول في نهاية هذا البحث التذكير بأهم القضايا التي تطرقنا إليها، وأهم النتائج المتوصل إليها، مع ما نسجله من ملاحظات لفتح آفاق جديدة للبحث، ونجمل كل ذلك في الآتي:
- التراث عند عبد الله الغذامي مزيج بين التراث النقدي والتراث الإبداعي، يتنازعهما تياريان كبيران؛ تيار المشاكلة أو العمودية، يمثله في النقد الآمدي والمرزوقي، ويمثله في الإبداع البحتري. وتيار النصوصية أو الاختلاف، يمثله في النقد الجرجاني، ويمثله في الإبداع المتنبي والهمذاني.
- تغيا عبد الله الغذامي من خلال قراءته التراث الإجابة عن سؤال: «كيف يكون النص الأدبي نصا أدبيا؟»، فكانت النتيجة التي توصل إليها، بعد محاولته تأصيل مقولات التفكيك في التراث العربي القديم، أن الاختلاف والنصوصية هي ما يحقق أدبية النص الأدبي.
- أثناء السعي وراء تحقيق غايته، راح الغذامي يؤصل ويوظف مقولات التفكيك، مقولة الاختلاف خاصة، على النصوص النقدية والإبداعية، وقاده ذلك إلى الوقوع في مجموعة من التناقضات منها، تمثيلا لا حصرا، سوء فهم نصوص الجرجاني، وسوء فهم وتوظيف مقولات التفكيك، بالإضافة إلى اختزاله التراث النقدي في الجرجاني، واختزاله التراث الإبداعي في المتنبي والهمذاني.
- إن قراءة الغذامي للتراث العربي القديم قراءة واحدة توضع موضع اختلاف مع غيرها من القراءات، شأنها في ذلك شأن هذا البحث، ومن ثمة فإن عملنا لا يعدو أن يكون مجرد «قراءة في قراءة» من مجموعة لانهائية من القراءات الممكنة.
- ساعدنا المنهج الذي وظفناه في هذا البحث، والذي محوره استراتيجية التفكيك من الوقوف على تناقضات قراءة الغذامي التراث، وتبيان اختلافها مع قراءتين أخريين، هما قراءة عبد العزيز حمودة، وقراءة جابر عصفور، كما يختلف هذا البحث نفسه مع بحثين آخرين، هما «هجرة التفكيك» لأحمد الجرطي، و«إشكالية التحيز» لعلي صديقي.
- أطر رؤيتنا في هذا البحث، بالإضافة إلى منهج الدراسة، المقدمة المنهجية التي ساقها جابر عصفور في «قراءة التراث النقدي»، وإذ نوجه اهتمام الباحثين في هذا الموضوع إلى مشاريع أخرى يمكنها أن تكون عونا في تجاوز نقائص هذا البحث، نذكر منها، على سبيل التمثيل، «تجديد المنهج في تقويم التراث» لطه عبد الرحمان.
لائحة المصادر والمراجع
- إشكالية التحيز في النقد العربي المعاصر، علي صديقي، كنوز المعرفة، الأردن، ط1، 2016.
- تشريح المرايا في نقد مشروع عبد العزيز حمودة، نبيل محمد صغير، دار الأمان، الرباط، ط1، 2015
- خريطة للقراءة الضالة، هارولد بلوم، تر: عابد اسماعيل، دار الكنوز الأدبية، بيروت، ط1، 2000
- دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمود شاكر، القدس للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2022
- شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، دار الجبل، بيروت، ط1، 1991
- قراءة التراث النقدي، جاير عصفور، منشورات عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مصر، ط1، 1994
- المرايا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربية، عبد العزيز حمودة، عالم المعرفة، الكويت، عدد 272، 2001
- المشاكلة والاختلاف: قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه المختلف، عبد الله الغذامي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، 1994
- هجرة التفكيك إلى النقد العربي: بين الكونية والتحيز، أحمد الجرطي، فضاءات للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2022
[1] المرايا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربية، عبد العزيز حمودة، عالم المعرفة، الكويت، عدد 272، 2001، ص: 17 وما بعدها.
[2] نفسه، ص: 221
[3] نفسه.
[4] نفسه.
[5] إشكالية التحيز في النقد العربي المعاصر، علي صديقي، كنوز المعرفة، الأردن، ط1، 2016، ص: 378
[6] تشريح المرايا في نقد مشروع عبد العزيز حمودة، نبيل محمد صغير، دار الأمان، الرباط، ط1، 2015، ص: 174
[7] قراءة التراث النقدي، جاير عصفور، منشورات عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مصر، ط1، 1994، ص: 26
[8] ينظر: نفسه، ص: 27 وما بعدها.
[9] نفسه، ص: 10
[10] نفسه.
[11] نفسه، ص: 17 وما بعدها.
[12] المشاكلة والاختلاف: قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه المختلف، عبد الله الغذامي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، 1994، ص: 5
[13] نفسه.
[14] نفسه، ص: 107
[15] نفسه، ص: 49
[16] نفسه، ص: 55
[17] شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، دار الجبل، بيروت، ط1، 1991، ص-ص: 8-9. (تنبهت إلى هذا في: المشاكلة والاختلاف، م س، ص: 56)
[18] المشاكلة والاختلاف، م س، ص: 58
[19] نفسه، ص: 110
[20] نفسه.
[21] نفسه، ص: 119
[22] نفسه، ص: 120
[23] نفسه.
[24] نفسه.
[25] نفسه، ص: 147
[26] نفسه، ص-ص: 152-153
[27] نفسه، ص: 154
[28] نفسه، ص: 155
[29] نفسه، ص: 5
[30] نفسه.
[31] هجرة التفكيك إلى النقد العربي: بين الكونية والتحيز، أحمد الجرطي، فضاءات للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2022، ص: 346
[32] ينظر: المشاكلة والاختلاف، م س، ص: 7
[33] استعمل جاك دريدا كلمة «Différance» بدل «Différence» للدلالة على الاختلاف، وهو بهذا يحقق أمرين اثنين؛ الأول، قابلية هذه الكلمة للإحالة على معنيين مختلفين أحدهما الاختلاف، والآخر الإرجاء أو التأجيل. والثاني، انتصاره للكتابة على حساب الصوت، فكلا الكلمتين تنطقان بالطريقة الفونيتيكية نفسها. ويتنازع الاختلاف عند دريدا عدة مدلولات متصلة بالمكان والزمان، فاتصالها بالمكان يشرع خاصية الانتشار والتشتت والتفرق التي تعرف بها الكتابة بفعل شساعة فضاءاتها التخييلية والتناصية المؤدية إلى لانهائية المعنى، أما اتصالها بالزمان فيشرع خاصية تأجيل وإرجاء المعنى. هذا بالإضافة إلى أن الغذامي يجعل من الاختلاف مفهوما، في حين أن دريدا ينفي أن يكون كذلك. (انظر: إشكالية التحيز في النقد العربي المعاصر، م س، ص: 109 وما بعدها، وهجرة التفكيك إلى النقد العربي: بين الكونية والتحيز، م س، ص: 68-70.)
[34] المشاكلة والاختلاف، م س، ص: 6
[35] نفسه، ص: 8
[36] إشكالية التحيز في النقد العربي المعاصر، م س، ص: 363
[37] المشاكلة والاختلاف، م س، ص: 8
[38] المرايا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربية، م س، ص: 413
[39] المشاكلة والاختلاف، م س، ص: 20
[40] نفسه.
[41] نفسه، ص: 40
[42] نفسه، ص: 24
[43] نفسه، ص: 38
[44] نفسه، ص: 117
[45] لمزيد من التفصيل حول التداخل النصوصي، أو التناص بين شاعرين عند هارولد بلوم، انظر: (هجرة التفكيك إلى النقد العربي: بين الكونية والتحيز، م س، صص: 96-103، أما تطبيق هذا المفهوم عند الغذامي، فينظر: المشاكلة والاختلاف، م س، ص-ص: 119-120.)
[46] المشاكلة والاختلاف، م س، ص: 120
[47] نفسه، ص: 125
[48] نفسه.
[49] نفسه، ص: 107
[50] ينظر: خريطة للقراءة الضالة، هارولد بلوم، تر: عابد اسماعيل، دار الكنوز الأدبية، بيروت، ط1، 2000، ص: 228 يقول بلوم: «الشعراء الأقوياء يصبحون أقوياء عبر مواجهتهم لقلق التأثر، وليس عبر تجاهلهم له. [...] ما من شاعر يستطيع أن يكتب قصيدة دون أن يتذكر». (تنبهت إلى هذا في: هجرة التفكيك إلى النقد العربي: بين الكونية والتحيز، م س، ص: 97.)
[51] هجرة التفكيك إلى النقد العربي: بين الكونية والتحيز، م س، ص: 98
[52] دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمود شاكر، القدس للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2022، ص: 46
[53] هجرة التفكيك إلى النقد العربي: بين الكونية والتحيز، م س، ص: 348
[54] ينظر: قراءة التراث النقدي، م س، ص: 52
[55] هجرة التفكيك إلى النقد العربي: بين الكونية والتحيز، م س، ص: 353
[56] نفسه.