الإبستمولوجيا: قراءة تاريخية وتحليل علاقتها بالميادين المتصلة بها
فئة : أبحاث محكمة
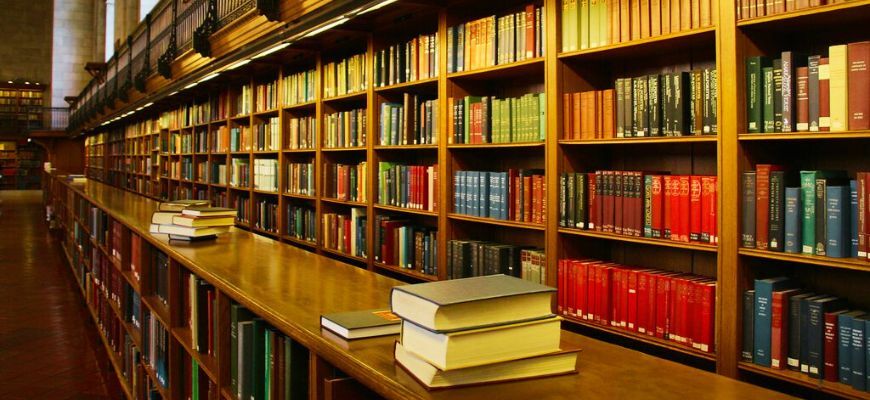
الإبستمولوجيا:
قراءة تاريخية وتحليل علاقتها بالميادين المتصلة بها
إنّ مفهوم الأبستمولوجيا الذي نجده متردّدًا في كثير من الدراسات الغربية والعربية، قد اتخذ دلالات متعدّدة، وهو ما يضعنا أمام صعوبة في تحديده ورسم ملامحه بدقّة. ولهذا الغرض تحديدًا، سيكون علينا، من خلال هذه الورقة البحثية، النظر في مفهوم الأبستمولوجيا وتبيّن المفاهيم التي تتقاطع معه، نظرًا إلى أنّه يُعَدّ إحدى الأزمات الإبستمولوجية حين تتداخل المعاني إلى درجة قد نقع معها في الخلط بين مفهوم الأبستمولوجيا وفلسفة العلوم، عندما نعتقد أنّهما وجهان لمعنى واحد.
وعليه، فإنّ مطلبنا الأوّل في هذا المبحث يتحدد في دراسة مفهوم الأبستمولوجيا لغةً واصطلاحًا، وطرح السؤال: كيف تطوّر هذا المفهوم عبر الفكر التاريخي؟ وما علاقاته بالميادين المتصلة به؟
المقدمة
إنّ التطوّرات العلمية التي حدثت منذ أواخر القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر، في ميادين مختلفة كالرياضيات والفيزياء، قد ساهمت في بروز الدراسات الإبستمولوجية المعاصرة. فقد نشطت هذه الدراسات عقب الثورة العلمية الحديثة التي أحدثت فجوة وأزمة بين الفيزياء الكلاسيكية التي دشّنها غاليليو وشيد صرحها نيوتن، وبين الرياضيات كما صاغها اليونان وطوّرها كلّ من ديكارت وليبنتز من جهة، وبين الفيزياء الحديثة التي أرسى دعائمها بلانك وأينشتاين وغيرهما من علماء الفيزياء الذرية، وبين الرياضيات الحديثة والمعاصرة من جهة أخرى.
ولما كان مفهوم الأبستمولوجيا يُعدّ من المصطلحات المعاصرة، فإنّه أصبح من أكثر المفاهيم تداولاً لدى المفكّرين الغربيين والعرب على حد سواء، إذ حظي باهتمام كبير لدى الفلاسفة والعلماء. وفي هذا السياق يقول محمد عابد الجابري: «تكتسي الدراسات الإبستمولوجية التي تتناول قضايا المعرفة عامة، والفكر العلمي خاصة، أهمية بالغة في الوقت الحاضر، بل يمكن القول إنّها الميدان الرئيسي الذي يستقطب الأبحاث الفلسفية في القرن العشرين». ويرجع اهتمام البحث الفلسفي بها إلى أهميتها القائمة، من جهة، على نقد المعارف العلمية بغية الكشف عن أسس هذه المعارف والعلوم ونظرياتها، والبحث في تفسيراتها للظواهر من أجل مواكبة التطور العلمي، ومن جهة ثانية على نشر المعرفة العلمية وأساليب التفكير العلمي على أوسع نطاق.
الإبستمولوجيا لفظٌ أجنبي مشتقّ من المقطعين اليونانيين épistèmè بمعنى «معرفة»، وlogos بمعنى «علم». ومن ثمّ، فإن المقابل الألماني لمصطلح الإبستمولوجيا هو Erkenntnistheorie، وقد استخدمه الفيلسوف الكانطي رينولد (K. L. Reinhold) في كتابه Versuch einer neuen Theorie des Vorstellungsvermögens.[1].
تُعَدّ الإبستمولوجيا فرعًا من فروع الفلسفة يدرس أصل المعرفة وبنيتها ومناهجها ومصداقيتها. ويبدو أنّ الفيلسوف فريير (James Frederick Ferrier) هو أوّل من استخدم هذا المصطلح في كتابه Institutes of Metaphysic، حيث ميّز بين فرعين أساسيين من فروع الفلسفة، هما: الإبستمولوجيا والأنطولوجيا.[2]. ويظهر ذلك في قوله: «إن معرفتنا بالمعرفة والتفكير تُعَدّ موضوع الفرع العلمي الذي يُسمّى بالإبستمولوجيا، أي علم المعرفة... تمامًا كما أنّ دراسة الوجود تُعرَف بنظرية الوجود». وتجيب الإبستمولوجيا عن السؤال الجوهري: ما هي المعرفة؟ وما طبيعة الشيء المعروف؟ أو بصياغة أكثر إيجازًا: ما هي المعرفة؟[3]
إن لفظ الإبستمولوجيا، الذي يعني حرفيًا "نظرية العلم" بحسب روبير بلانشي، يُعد اختراعًا حديثًا. والدليل على ذلك أنه لا يوجد في قاموس Littré ولا في المعجم الجديد لاروس. وعليه، يؤكد معجم روبير أن ظهور هذا اللفظ في المعاجم الفرنسية يعود إلى ملحق معجم لاروس الصادر عام 1906. وفي نفس الفترة ظهر أيضًا المعجم الفلسفي لالاند. ومن ثم، فإن كلمة الإبستمولوجيا تُعد لفظًا مستحدثًا غير موفق من حيث التسمية والتداول[4].
وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح "الإبستمولوجيا"، الذي ظهر في القرن التاسع عشر، كان ولا يزال استخدامه غير موحّد وغير متجانس في الفكر الفلسفي، باعتباره مصطلحًا واسعًا له معانٍ مختلفة. ففي هذا السياق، يميّز الأنجلوساكسونيون بين الإبستمولوجيا، باعتبارها دراسة طبيعة المعرفة ومصادرها وحدودها، وبين فلسفة العلوم التي تهتم بدراسة الأساليب والمناهج والنتائج العلمية.[5]
ولعل هذا التمييز يساعدنا على فهم العلاقة بين المعرفة والعلوم، من حيث أن المعرفة هي أساس العلوم، أما فلسفة العلوم فتدرس كيفية اكتساب المعرفة. ويمكن القول إن الإبستمولوجيا وفلسفة العلوم يُعدّان فرعين من فروع الفلسفة، رغم الإشكالية التي يحيط بهما، خصوصًا مصطلح "الإبستمولوجيا" الذي يثير التساؤل حول ما إذا كان حقًا فرعًا من فروع الفلسفة. وسنتطرق لاحقًا إلى معالجة هذه المسألة، متساءلين مع برونشفيك، الذي أشار بدقة إلى هذه القضية، عما إذا كانت الإبستمولوجيا في حد ذاتها طريقة علمية أم فلسفية.
وتجدر الإشارة إلى أن لفظ "الإبستمولوجيا" مصطلح غامض بعض الشيء، يصعب فهمه بدقة، نظرًا لاختلاف استخدامه في لغات متعددة، سواء في الرسم أو النطق. فهو مستعمل في كل من الإنجليزية والفرنسية، كما يستخدمه العرب المحدثون، خاصة في المغرب العربي. ومن هنا يظهر الإشكال حول هذا المفهوم نتيجة اختلاف المعاني عبر هذه اللغات. فالفرنسيون عمومًا يفصلون بين الإبستمولوجيا ونظرية المعرفة، مع بعض الاستثناءات لمفكرين مثل بياجيه وبوهي وغيرهما، بينما يقصد الأنجلوساكسون بهذا المصطلح نظرية المعرفة بوصفها دراسة لحدود المعرفة وشروطها[6].
ومن ثم، فإن تنوع الممارسات الإبستمولوجية يجعل من الصعب تحديدها ووضع تعريف دقيق له.
2. مفهوم الإبستمولوجيا اصطلاحا:
عندما نتساءل عن ماهية الإبستمولوجيا ونحاول تحديد معناها اصطلاحًا، فمن المفيد أن نبدأ بتعريف أندريه لالاند. ويعود ذلك إلى أن العديد من المفكرين الذين اهتموا بالإبستمولوجيا، سواء كانوا غربيين مثل روبير برنشي أو عربًا مثل محمد الوقيدي ومحمد بن ساسي ومحمد عابد الجابري، يستندون في أغلب الأحيان إلى معجمه الفلسفي الفرنسي المشهور.
ومن هنا، يصبح من الضروري النظر في تعريف لالاند لفهم التأثير الذي تركه هذا التعريف على المفكرين، ومستويات النقد التي خضع لها، والعلاقة القائمة بين أجزاء التعريف المختلفة.
في معجم لالاند، وتحت عنوان "معلومية... إبستمولوجيا (Epistémologie)"، نجد أن الإبستمولوجيا كانت تشير إلى فلسفة العلوم.[7]
لكن يجب أن نلاحظ أن هذا المصطلح قد اختلف في معناه عن التعريفات الواردة في القواميس الفرنسية. ففي قاموس أكسفورد، نجد أنه يعني "نظرية المنهج" أو "علم المنهج" أو "أسس المعرفة". ومنذ عام 1856، اتخذ هذا المصطلح معنىً خاصًا؛ إذ أصبحت الإبستمولوجيا منذ ذلك الوقت تشير إلى الإجابة عن السؤال: "ماذا تعرف؟" أو بعبارة أخرى: "ما هي المعرفة؟". وقد اعتاد الكتاب منذ عام 1883 على إدراج الأقسام التالية تحت عنوان الإبستمولوجيا: الإبستمولوجيا نفسها، الأنثروبولوجيا، والأخلاق.
وفي الموسوعة البريطانية، يُعرَّف مصطلح الإبستمولوجيا بأنه دراسة طبيعة المعرفة وصحتها، ويمنح الإبستمولوجيون درجات اليقين والاحتمال، كما يبحثون في الفروق بين المعرفة والاعتقاد".[8]
بالنسبة إلى ديكارت وهيوم وكانط، ترتبط الإبستمولوجيا بالمعرفة وحدودها، وتُعتبر مدخلاً ضروريًا لفهم الميتافيزيقا. أما عند سبينوزا وهيجل وهيوم، فتُعد الميتافيزيقا هي الأساس الذي تبنى عليه نظرية المعرفة.[9]
وعند ميشال فوكو، "تكتفي الإبستمولوجيا بوصف العلوم التي استطاعت أن تتكون انطلاقًا من فروع معرفية قائمة وعلى أنقاضها"[10].
في المقابل، يعرّف جان بياجيه الإبستمولوجيا بأنها محاولة "تسعى إلى توضيح المعرفة العلمية بصفة خاصة، استنادًا إلى تاريخها، وإلى تكوينها الاجتماعي، وإلى الأصول السيكولوجية للأفكار والعمليات التي تعتمد عليها بصفة خاصة".[11]
ولهذا، نجد أن بياجيه يتناول مفهوم الإبستمولوجيا التكوينية، الذي يدرس كيفية تطور المعرفة العلمية، على عكس الفلاسفة التقليديين الذين يدرسون المعرفة في لحظتها الراهنة فقط، إذ يرونها تحليلًا للمعرفة كما هي، دون النظر في كيفية تطورها.[12]
في هذا السياق، يتقارب رأي بياجيه إلى حد ما مع رأي كارل بوبر، حيث يركز كلاهما على أهمية تطور المعرفة العلمية وتقدمها. ومع ذلك، يختلف منهجهما. فجان بياجيه يعتمد على المنهاج التكويني في الإبستمولوجيا، الذي أسسه على علم النفس، وخصوصًا علم نفس الطفل، لدراسة كيفية نمو المفاهيم العقلية. كما يستعين بالمنطق لدراسة هذا النمو في مراحله المختلفة، ما يجعله يتبنى منهجًا مزدوجًا يجمع بين التحليل المنطقي والتحليل التاريخي النقدي أو التكويني، مع الالتزام بالنظر إلى المعرفة من زاوية تطورها عبر الزمن.[13]
يمكننا فهم تعريف بوبر للإبستمولوجيا من خلال دراساته في منطق البحث العلمي، حيث يتضح أنها تمثل امتدادًا للمنهج العلمي ونظرية للمعرفة في آن واحد. لذلك، ترتبط نظرية بوبر المنهجية ارتباطًا وثيقًا بنظريته في المعرفة، إذ يرى أن المعرفة الإنسانية تتكون من الفرضيات والنظريات والافتراضات الحدسية. في المقابل، ينظر معظم الفلاسفة إلى المعرفة على أنها حقائق ثابتة ومؤسسة.[14]
إذن، يظهر أن مفهوم الإبستمولوجيا يشهد اختلافًا في تحديد معناه ومصطلحه، بمعنى أنه مهما توضحت المعاني وتكثفت الدراسات، يبقى المصطلح خاضعًا للاختلاف في المنطلقات ودرجات الوضوح، وهذا ما نلاحظه بشكل خاص بين الفهم الأنجلوساكسوني والفهم الفرنسي. وعليه، فإن هذا الاختلاف قد انعكس أيضًا على الفكر العربي.
لا يفوتنا هنا ذكر المجهودات العربية ومحاولاتهم لتعريف مفهوم الإبستمولوجيا؛ إذ يعرّف عبد السلام بن عبد العالي وسالم يفوت الإبستمولوجيا في كتابهما درس الإبستمولوجيا بأنها: "نظرية الإنتاج النوعي للتصورات العلمية".[15]. يتبين لنا من خلال هذا التعريف أن الإبستمولوجيا تبحث في العلم، وهو ما يؤيد الاتجاه الفرنسي العام الذي يعتبر العلم الصحيح موضوعًا للإبستمولوجيا. فنتحدث هنا عن إبستمولوجيا الرياضيات، وإبستمولوجيا العلوم الطبيعية، وكذلك العلوم الإنسانية. وفي هذا السياق، يُعد المفكر التونسي عبد القادر بَشته من أبرز المؤيدين لهذا الاتجاه، حين يقول: "إن موضوع الإبستمولوجيا هو العلم الصحيح".[16] إلا أنه يضيف أن الإبستمولوجيا من الناحية المنهجية هي لوغوس.[17]
بالإضافة إلى ذلك، يعرف المفكر محمد عابد الجابري الإبستمولوجيا بأنها "أصبحت تفرض نفسها كعلم قائم بذاته في العصر الحاضر، يختلف من عدة وجوه. فهي تختلف، مثلاً، عن نظرية المعرفة التي تهتم بمشاكلها التقليدية في معناها الفلسفي العام، باعتبارها من مشاغل الفلاسفة ودارسي الفلسفة، في حين أن الإبستمولوجيا من اختصاص العلماء. ولهذا، فهي تُعد بدورها أوسع حتى من المنهجية (الميثودولوجيا)، لأنها تتناول مناهج العلوم."
وقد يُستنتج من ذلك أن الجابري يقطع الصلة بين الإبستمولوجيا وبقية الأبحاث المعرفية الأخرى، مثل نظرية المعرفة، والمنهجية، وفلسفة العلوم، وتاريخ العلوم. إلا أنه في الوقت نفسه يعتبر أن هذا القطع نسبي، يتميز بجدلية الاتصال والانفصال، بحيث يرى أنه من الصعب جدًا إقامة حدود نهائية. فإذا سألنا: "ما هي الإبستمولوجيا بالضبط؟"، فإنها بحسب الجابري تعني: "كل الأبحاث المعرفية منظورة إليها من زاوية معاصرة؛ أي من خلال المرحلة الراهنة لتطور الفكر العلمي والفلسفي".[18]
أما بالنسبة إلى المفكر محمد وقيدي، فإنه يرى أن الإبستمولوجيا هي دراسة نقدية لموضوع المعرفة العلمية، من حيث المبادئ التي تستند إليها، والفرضيات التي تنطلق منها، والنتائج التي تصل إليها. وتهدف هذه الدراسات إلى البحث في الأصول المنطقية لهذه المبادئ والفرضيات من جهة، وبيان قيمتها من جهة أخرى. وعليه، عندما تساءل الوقيدي في عنوان كتابه: "ما هي الإبستمولوجيا؟"، لم يكن هدفه تقديم تعريف معجمي للمفهوم، بل مناقشة التعريف الذي وضعه لالاند في القاموس الفلسفي الفرنسي، وإبراز التحديدات السلبية والإيجابية لهذا التعريف.[19]
من وجهة نظر أخرى، إذا طرحنا السؤال: "ما هي الإبستمولوجيا؟"، فإن ظاهر هذا السؤال، بحسب محمد بن ساسي، يتعلق بماهية هذا المفهوم، أي بحده أو تعريفه (sa définition). والحد هنا ليس مجرد تعريف الشيء بواحدة من خصائصه، بل هو ما تقوم به ذات الشيء، أي جوهره. بالتالي، يطرح السؤال نفسه: هل يمكننا تحديد الإبستمولوجيا من خلال ما تتقوم به ذاتها؟[20]
في هذا السياق، يحاول محمد بن ساسي محاورة هذا المفهوم من خلال الاستناد إلى بعض أفكار الفارابي الواردة في كتاب الحروف. فهو يقوم بتحليل السؤال إلى مكوناته الأساسية. يتبين لنا أن حرف السؤال "ما" هو الحرف الذي يقودنا إلى البحث عن علم يتعلق بالشيء، ويختلف هذا العلم في مراتبِه بحسب المواضع التي يُستعمل فيها هذا الحرف للسؤال. وفي تصور مفكرنا، يفترض السؤال قدراً من المعرفة المسبقة، ويتطلب الاستزادة والتدقيق؛ أي محاولة التوقف عند هذا الحد دون الوقوع في مغالطة الآراء الشائعة أو الاكتفاء بمعرفة سطحية، حتى وإن كانت لدينا معرفة مسبقة بالاسم محل السؤال.[21]
يخلص بن ساسي إلى أن حرف "ما" قد يُقرن بسؤال عن نوع من الأنواع. فإذا كانت الإبستمولوجيا تُعرَّف بانتمائها إلى الفلسفة، وبأن لها علاقة بالعلم أو بالعلوم، فإن السؤال "ما هي الإبستمولوجيا؟" يشبه السؤال "ما هو الإنسان؟" أو "ما هي النخلة؟". فقد يُقال عن الإنسان إنه حيوان أو حيوان ناطق، وعن النخلة إنها "شجرة تحمل الرطب"، وعن الإبستمولوجيا أنها فلسفة تهتم بالعلم. بهذا المعنى، إذا اعتبرنا الإبستمولوجيا نوعاً وحددناها بجنسها (الفلسفة)، وخصصناها بما يميزها (الاهتمام بالعلم)، فإننا نكون قد قدمنا تعريفاً لها.[22]
لكن هنا يبرز السؤال: إذا اعتبرنا الإبستمولوجيا جنساً أو نوعاً ينتمي إلى الفلسفة ويُعنى بالعلم، ألا يوقعنا هذا في خلط بين هذه المفاهيم؟
من هذه الناحية، يعترف بن ساسي في قوله: "ليس لدينا أي ضمانة في ذلك، ويزداد الأمر تعقيداً عندما تختلط الإبستمولوجيا، بما هي ضرب مخصوص من القول، مع ضروب أو أجناس أخرى تنافسها على موضوعها، مثل فلسفة العلم، وتاريخ العلم، والمنطق، والمناهج (الميثودولوجيا).)[23].
وفي هذا السياق، يطرح الجابري تساؤلاً حول ماهية هذا العلم، أي الإبستمولوجيا. ويشير إلى أننا نواجه عدة مشاكل إبستمولوجية عند دراسة هذا المجال الجديد من الدراسات والأبحاث التي تتخذ المعرفة موضوعًا لها. وتشمل هذه المشاكل: تعريف الإبستمولوجيا، وتحديد ميدان البحث الخاص بها، وبيان غاياتها، وكشف طبيعة العلاقات القائمة بينها وبين العلوم القريبة أو المتداخلة معها. ومن جهة أخرى، لا بد من التنبيه إلى أن الدراسات الإبستمولوجية تتناول بالتحليل والنقد نتائج العلوم، سواء كانت طبيعية أو إنسانية، ولذلك فهي، من هذه الناحية، نوع من فلسفة العلوم. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تتأثر التأويلات الفلسفية للكشوف العلمية التي تتم في هذا الميدان أو ذاك بالصبغة الإيديولوجية، مما يصعّب تحديد حدود هذه العلوم وبيان غاياتها وآفاقها وكفاءتها الموضوعية.[24].
وبهذا الاعتبار، فإننا نسأل كيف يمكن لنا أن نميز هذا العلم، الإبستمولوجيا، عن الدراسات المتداخلة معه؟
من هذا المنظور، كان لالاند حريصًا في معجمه الفلسفي على التمييز بين الإبستمولوجيا والأبحاث المرتبطة بها، مثل الميثودولوجيا وفلسفة العلوم ونظرية المعرفة، نظرًا لوجود احتمال كبير لحدوث خلط بين هذه الدراسات. في هذا السياق، سنتساءل عن الأثر الذي تركه هذا التعريف اللالاندي في تناول المفكرين، وما هي مستويات النقد التي خضع لها، وما هي العلاقة القائمة بين أجزائه.
ثانيا - الإبستمولوجيا وعلاقاتها بالدراسات المعرفية الأخرى:
1. الإبستمولوجيا وفلسفة العلوم
بالعودة إلى تعريف لالاند للإبستمولوجيا، يمكننا تحديد علاقة الإبستمولوجيا بفلسفة العلوم من خلال قوله:
"تعني هذه الكلمة فلسفة العلوم، ولكن بمعنى أكثر دقة. فهي ليست دراسات خاصة بمناهج العلوم؛ لأن هذه الدراسة موضوع للميثودولوجيا وهي جزء من المنطق، كما أنها ليست تركيبًا أو توقعًا حدسيًا للقوانين العلمية (على طريقة الوضعية). إنها، بصفة جوهرية، الدراسة النقدية للمبادئ والفرضيات والنتائج العلمية؛ دراسة تهدف إلى بيان أصلها (المنطقي لا النفسي) وقيمتها الموضوعية. وينبغي أن نميز الإبستمولوجيا عن نظرية المعرفة، على الرغم من أنها تمهيد لها وعمل مساعد لا غنى عنه، فهي تدرس المعرفة بتفصيل وبكيفية بعدية في تنوع العلوم، لا في وحدة الفكر."[25].
يشير تعريف لالاند في الجزء الأول إلى التقارب بين الإبستمولوجيا وفلسفة العلوم، بحيث يكاد يُطابق بينهما. ومن بين المفكرين العرب الذين اعتمدوا هذا التصور، نجد جميل صليبا، الذي يقول: "نقول فلسفة العلوم، أي الدراسات النقدية وأصولها العامة، وهي الإبستمولوجيا."[26].
ولكن ألا يُفهم من هذا أن الإبستمولوجيا وفلسفة العلوم اسمان لمعنى واحد؟
هنا نجد أنفسنا أمام إشكالية إبستمولوجية تتطلب فهمًا للتداخل الذي يحدث بين الإبستمولوجيا وفلسفة العلوم. وفي هذا السياق، يرى روبير بلانشي أن: "التمييز الدقيق بين الإبستمولوجيا وفلسفة العلم يعد تحديًا صعبًا." وقد يعود ذلك، كما يوضح محمد عابد الجابري، إلى أن مصطلح فلسفة العلوم غامض وعائم، فكل تفكير في العلم، أو في جانب من جوانبه—سواء في مبادئه أو فروضه أو قوانينه، وفي نتائجه الفلسفية أو قيمته الأخلاقية—يُعد، بشكل أو بآخر، فلسفة العلم".[27]
ثم يتبين أن هناك أربع طرائق يمكن من خلالها التفلسف في العلم أو ممارسة فلسفة العلم، وهي: أولًا، دراسة علاقات العلم بكل من العالم والمجتمع، أي النظر إلى العلم من حيث هو ظاهرة اجتماعية؛ ثانيًا، محاولة وضع العلم في مكانه الخاص ضمن مجموع القيم الإنسانية؛ ثالثًا، الرغبة في تشييد فلسفة للطبيعة انطلاقًا من نتائج العلم؛ أما رابعًا، فهو التحليل المنطقي للغة العلمية. وعليه، تعتبر الطريقة الأخيرة هي الوحيدة التي تتلاءم مع ما يعنيه لفظ الإبستمولوجيا، وفق ما يذكر روبير بلانشي".[28]
2. الإبستمولوجيا ونظرية المعرفة:
لقد تنوعت واختلفت القراءات حول مسألة العلاقة بين الإبستمولوجيا ونظرية المعرفة. فهناك من يربط بينهما كمصطلحين، بحيث يمكن تحديد علاقتهما مبدئيًا بنفس العلاقة الموجودة بين النوع والجنس. بمعنى أن الإبستمولوجيا تُعدُّ صورة من صور المعرفة، وهي المعرفة العلمية بالأساس. هذه الوجهة يعبر عنها أصحاب الوضعية الجديدة، بشرط أن تكون المعرفة العلمية هي وحدها التي يُطلق عليها لفظ "المعرفة".
وهذا ما ينتهي إليه بعض المفكرين الذين يعتبرون المعارف الأخرى، التي لا تعبر عن المعرفة العلمية، مجرد ألفاظ بلا أهمية معرفية. ومن أبرز أنصار هذا الرأي جماعة فيينا، مثل ريتشارد كارناب، الذي لا يعترف بقيمة المعرفة إلا إذا فُهمت على أنها التحليل المنطقي لقضايا العلم. ويتفق روجييه مع هذا المنحى التجريبي المنطقي، بعد أن أعطى إحدى مؤلفاته عنوانًا هو "مبحث المعرفة"، ثم عاد ليؤكد أن الإبستمولوجيا تشكّل هيكلًا للمعرفة العلمية.
من ذلك نستنتج أنه مع الوضعيين الجدد، فإن الإبستمولوجيا تهتم بالمعرفة العلمية وحدها، بمعنى أن كل نظرية في المعرفة هي بالأساس نظرية في العلم، وإلا فلا معنى لها. ذلك أن المعرفة العلمية تعتمد على القياس والتجربة، ويجب تمييزها وفصلها عن نظرية المعرفة التي تهتم بالمعرفة العامية الحسية، التي يمكن الحصول عليها بواسطة الخبرة والحواس.
وعليه، نجد أن جان بياجيه ربط بين مصطلحي الإبستمولوجيا ونظرية المعرفة، ويعود السبب في ذلك إلى أن أي نظرية إبستمولوجية ارتقائية، سواء كان ميدانها تاريخ العلم أو علم نفس الطفل، لا بد أن تتسع في نهاية المطاف لتتحول إلى نظرية في المعرفة.[29]
يؤكد كارل بوبر في تعريفه للإبستمولوجيا وعلاقتها بنظرية المعرفة أن البناء المستمر للمعرفة ونموها يمثلان الركيزة الأساسية لبحث الإبستمولوجيا، حيث يقول:
"إن كل مشكلات الإبستمولوجيا التقليدية تقريبًا مرتبطة بمشكلة نمو المعرفة. ويمكنني القول أكثر من ذلك: من أفلاطون إلى ديكارت ولايبنتز وكانط ودوهيم وبوانكريه، ومن بيكون إلى هوبز ولوك، وصولًا إلى هيوم ومل ورسل، لم يكن أمل نظرية المعرفة يقتصر على تمكيننا من معرفة المزيد فحسب، بل كان أيضًا في المساهمة في تقدم المعرفة، وخاصة المعرفة العلمية".[30]
في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن لالاند لم يذكر نظرية المعرفة كمصطلح مرادف للإبستمولوجيا، بل دعا إلى ضرورة التمييز بين المفهومين، رغم أن نظرية المعرفة ساهمت في ظهور الإبستمولوجيا. وقد أكد ذلك بقوله: "ينبغي أن نميز بين الإبستمولوجيا ونظرية المعرفة، بالرغم من أنها تمهيد لها." ويشير هذا إلى وجود اختلاف بين المفهومين، لكنه لا يعني الفصل التام بينهما، إذ يرى لالاند أن نظرية المعرفة تُعد "عملًا مساعدًا لا غنى عنه" للإبستمولوجيا.
ويرجع موقف لالاند حول ضرورة التفرقة إلى ما يراه الفرنسيون عمومًا، حيث يعتبرون الإبستمولوجيا فلسفة العلم. ومع ذلك، يشير عبد الرحمن البدوي إلى أن هذا الرأي يقتصر على بعض الفرنسيين فقط، قائلاً: "صارت كلمة الإبستمولوجيا الفرنسية تدل على نظرية المعرفة بوجه عام، وليس على فلسفة العلوم وحدها، رغم أن بعض الكتاب الفرنسيين يصرون على المحافظة على تلك التفرقة."[31]
يبرز هذا صعوبة الفصل بين هذين المجالين، مما يشكل إحدى المشكلات الإبستمولوجية، ويطرح أمامنا موقفين متمايزين: الأول يربط بين المفهومين رغم عدم تطابقهما، كما يتضح من تعريف لالاند الذي يشير إلى الصلة بين الجانبين مع التأكيد على ضرورة التمييز بينهما دون مطابقة تامة. أما الموقف الثاني، فيفصل بين المفهومين بشكل واضح، إذ لا يرى أن مهمة الإبستمولوجيا تتمثل في تقديم المعرفة، وهو ما يؤكده الوقيدي، موضحًا أن فهم هذا الموقف يستلزم الرجوع إلى علاقة الفلسفة الكلاسيكية بفلسفة كانط والعلم المعاصر.[32].
بناءً على ما سبق، تستدعي صعوبة تحديد العلاقة بين المفهومين، سواء أكانت اتصالًا أم انفصالًا، ضرورة مقارنة الإبستمولوجيا بنظرية المعرفة من حيث المجال والمنهج، لفهم ما إذا كانت العلاقة بينهما تقوم على الاختلاف أم التطابق.
3. الابستمولوجيا ومناهج العلوم:
من الثنائيات التي جرى مناقشتها لتحديد الممارسة الإبستمولوجية، نذكر علاقة الإبستمولوجيا بعلم المناهج أو الميثودولوجيا. فبينما لا يرى لالاند أي علاقة مؤكدة بين الطرفين، هناك مفكرون آخرون يرون العكس، حيث يشير العديد من النقاد إلى أن هذه المسألة نوقشت في الدراسات الغربية وامتدت كذلك إلى الفكر العربي. وهنا يطرح سؤال: هل ينبغي اعتبار الإبستمولوجيا وعلم مناهج البحث ميدانين متميزين، وإن كانا متجاورين؟
بناءً على ذلك، ما نلاحظه من تعريف لالاند هو أنه ينقسم إلى قسمين: في القسم الأول، يعرّف الإبستمولوجيا بأنها ليست علم مناهج البحث، كما أنها ليست الفلسفة الوضعية في نظرتها إلى العلم عمومًا. أما في القسم الثاني، فيحدد لالاند معنى الإبستمولوجيا بما هي عليه، أي بمكوناتها. فالإبستمولوجيا، بمعناها الضيق للغاية، هي فلسفة العلوم، وتعتمد على المنطق وحده في نقد مبادئ العلوم ونتائجها، وتحديد قيمتها ودرجة موضوعيتها.[33]
من بين المفكرين الغربيين، نجد بلانشي الذي يناقش مسألة العلاقة بين الإبستمولوجيا والمنهجية في مستهل كتابه، حيث يؤكد أن هذا التفريق يعود إلى القرن التاسع عشر في فرنسا، نظرًا لأن المنهجية كانت آنذاك جزءًا لا يتجزأ من المنطق [34]؛ إذ كان المنطق مقسمًا إلى قسمين: الأول هو المنطق العام، الذي يتجاوز مادة المعرفة، وأهم جزء فيه هو المنطق الصوري؛ والثاني هو المنطق الخاص أو التطبيقي، الذي يتناول المناهج الخاصة بكل علم. كما يتضمن القسم الثاني أيضًا علم المناهج المرتبط بالمنطق.[35]، وهذا الفهم قد يوقعنا في الخلط بين هذين المفهومين عندما نطابق بينهما.
هذا الجانب أدركه بعض المفكرين العرب الذين يتفقون مع هذا الرأي. ففي هذا السياق، يوضح محمد عابد الجابري أن سبب وقوع لالاند في هذا النوع من الخلط بين هذه الدراسات يعود إلى اتباعه للتقليد المدرسي الفرنسي السائد في عصره. فقد كان المنطق يُصنف آنذاك إلى نوعين: المنطق العام، المقصود به المنطق الصوري الذي لا يهتم بمادة المعرفة بل بصورة المعرفة فقط، والمنطق الخاص أو التطبيقي، الذي يدرس المناهج الخاصة بكل علم. وكان هذا التصنيف متعارفًا عليه في عهد لالاند. أما في الوقت الحاضر، فقد أصبحت المنهجية تشكل علمًا قائمًا بذاته، وهو علم المناهج، بينما أصبح المنطق واحدًا، وهو المنطق الصوري بالشكل الحديث.[36]
في الواقع، يتضح أن تعريف لالاند يحتوي على جانب سلبي وجانب إيجابي. ويشير المفكر العربي محمد الوقيدي إلى أن الجانب السلبي في تعريف لالاند يكمن في الشق الأول منه: فالإبستمولوجيا ليست دراسة لمناهج العلوم، إذ تُعد هذه الدراسة جزءًا من المنطق. ومن ثم، يمكننا قبول هذا التعريف، بحسب الوقيدي، دون أن نصل بالضرورة إلى نفس الاستنتاج النهائي. بمعنى أن المبدأ المقبول هو التمييز بين دراسة مناهج العلوم كدراسة وصفية، والإبستمولوجيا كدراسة نقدية تبحث، إلى جانب المناهج، في الأسس والنتائج. إلا أن هذا التمييز لا يعني الفصل التام بين هذين المجالين، إذ يظل ترابطهما ضروريًا؛ فلا يمكن للإبستمولوجي في دراسته النقدية الاستغناء عن دراسة مناهج العلوم، فهو بحاجة، قبل النقد، إلى معرفة صيغة المناهج التي يدرسها. أما النتيجة التي لا يقبلها الوقيدي، فهي اعتبار دراسة مناهج العلوم جزءًا من المنطق.[37]
بمعنى آخر، يهدف هذا النقد لتعريف لالاند إلى التمييز بين الدراسات الإبستمولوجية والدراسات المنهجية (الميثودولوجية) والمنطقية، غير أن هذا التمايز لا يعني الاستقلال التام لأي من هذه المجالات، كما أنه لا يؤدي إلى إرجاع الإبستمولوجيا إلى أي منها.
ثم نصل أخيرًا إلى التمييز الإيجابي الذي يقيمه تعريف لالاند للإبستمولوجيا في قسمه الثاني، وهو: أنها، بصفة جوهرية، الدراسة النقدية التي يكون موضوعها المعرفة العلمية من حيث المبادئ التي ترتكز عليها، والفرضيات التي تنطلق منها، والنتائج العلمية التي تنتهي إليها. أما هدف هذه الدراسة فهو البحث في الأصول المنطقية لهذه الفرضيات والمبادئ والنتائج من جهة، وبيان قيمتها من جهة أخرى.
ومن ثم، يتساءل الوقيدي هنا: ما معنى أن تكون الإبستمولوجيا دراسة نقدية وليست وصفية، وهي المهمة التي تعود إلى نوع آخر من المنهجية (الميثودولوجيا)؟ فهل يمكننا قبول هذا المعنى النقدي؟[38]
4. الابستمولوجيا وتاريخ العلوم:
"تبدو العلاقة بين الإبستمولوجيا وتاريخ العلوم متشابكة ومتداخلة، إذ إن كلاهما يدرسان المعرفة العلمية. ولا يمكن الفصل بينهما كميدانين متميزين إلا وفق وجهة النظر التي يُنظر بها إلى هذا الموضوع الواحد. من جهة أخرى، يبرز محمد الوقيدي أن هذه العلاقة تبدو أكثر تعقيدًا، حيث يصعب، أثناء الممارسة، الفصل الكامل بينهما. فمؤرخ العلوم، الذي يؤدي مهمته بأمانة ويحرص على تميز موضوع علمه، يجد نفسه في كثير من الأحيان يمارس، إلى جانب تخصصه، مهمة الإبستمولوجي. فتاريخ العلوم يُمارَس دائمًا وفق تصور إبستمولوجي معين، سواء كان هذا التصور صريحًا أو ضمنيًا. وهنا يثار السؤال: هل يمكن للإبستمولوجي أن ينجز مهامه على أكمل وجه دون أن يمارس، بشكل صريح أو ضمني، مهمة مؤرخ العلوم؟
ويشير الوقيدي إلى أنه لا وجود لمعرفة علمية منفصلة عن تاريخها يمكن أن تكون موضوعًا متميزًا للإبستمولوجيا. فالمادة التي تُشكل موضوعًا للعمل الإبستمولوجي، والتي يتم من خلالها استخلاص بعض التصورات العامة، هي نفسها التي يمد بها مؤرخ العلوم الإبستمولوجي، أو قد يعمل الإبستمولوجي بنفسه على تحصيلها عندما يضطر للقيام بدور المؤرخ.[39]
بحسب روبير بلانشيه، يمكن فهم العلاقة بين الإبستمولوجيا وتاريخ العلوم بطريقتين مختلفتين. في المعنى الأول، يبدو أن تاريخ العلم ليس مجرد ذاكرة تسجل بدقة المراحل الأساسية وغير الأساسية التي مر بها العلم في تطوره، بل يُنظر إليه على أنه 'المعمل' الذي يولد فيه التفكير الإبستمولوجي. بمعنى آخر، تاريخ العلم هو الذي يضع العقل الإنساني قيد التجربة، أو الذي يحول العقل الإنساني إلى نظرية تجريبية[40]، حيث إن هذا الموقف يؤيد وجهة نظر ديكتارويس، الذي يرى أن تاريخ العلوم ليس مجرد ذاكرة للعلم، بل هو مختبر للإبستمولوجيا. ووفقاً لما يذكره جورج كانغلام، فقد لاقت هذه الفكرة قبولاً واسعاً بين المتخصصين[41].
أما المعنى الثاني لعلاقة تاريخ العلوم بالإبستمولوجيا، فيشير إلى الاتجاه الفكري الذي يجد فيه الإنسان نفسه مضطراً للحكم على معارف الماضي. في هذا السياق، تلعب الإبستمولوجيا دور القاضي الذي يصدر الأحكام على المعرفة التاريخية. فهي مدعوة لتقديم المبادئ التي يستند إليها تاريخ العلم في إصدار أحكامه، كما تقدم له لغة العلم في آخر مراحل تطورها[42].
بناءً على هذا المعنى، يمكن استنتاج أن العلاقة بين الإبستيمولوجيا وتاريخ العلوم تسهم في توضيح أسس التفكير العلمي والتحليل الدقيق للمعرفة العلمية؛ إذ إن الفصل بين هذين المجالين سيؤدي إلى نقص في كلٍّ منهما، وسيمنع الفكر الإنساني من النظر إلى المعرفة العلمية من زاويتين مختلفتين. ومع ذلك، فإن هذا لا يلغي ضرورة التمييز بين هذين الميدانين، إلا أن الانفصال التام بينهما غير موجود.[43]
كما يظهر، وفقًا لما يبرزه الجابري، أن ما يهم الإبستيمولوجيا وتاريخ العلوم هو تطور المفاهيم وطرائق التفكير العلمية، وما ينشأ عن ذلك من قيام نظريات معرفية جديدة. وهذا ما يجعلنا نواجه مشكلة إبستمولوجية تعزز وعينا بمدى التشابك بين الإبستيمولوجيا وتاريخ العلوم[44].
وعلى الرغم من أن لالاند حرص على التمييز بين هذا النوع من الدراسات، فإنه استثنى تاريخ العلوم من نقاشاته، حيث لم يذكره صراحة. غير أن تعريفه كان نقطة انطلاق للمفكرين الغربيين مثل روبير بلانشي، وكذلك للمفكرين العرب مثل محمد عابد الجابري ومحمد الوقيدي ومحمد بن ساسي، في محاولاتهم للإجابة عن سؤال: "ما هي الإبستمولوجيا؟"
إذن، بناءً على ما سبق، نستنتج أن تعريف لالاند، رغم وضوحه النسبي، لا يكفي لتحديد مجال الإبستمولوجيا بدقة. قد نصل إلى هذا الهدف عبر عرض ومناقشة علاقة الإبستمولوجيا بفروع العلم والفلسفة الأخرى، سواء كانت لها علاقة مباشرة بها أم لا. وتشمل فروع المعرفة التي تربطها علاقات معينة بالإبستمولوجيا: الفلسفة الوضعية، نظرية المعرفة، فلسفة العلوم، تاريخ العلوم، علم مناهج البحث، والعلوم الإنسانية.[45]
كما نستنتج صعوبة تحديد ملامح الإبستمولوجيا بدقة بسبب اختلاف طرائق تناولها. ربما يعود هذا التعقيد إلى جذور نشأة الإبستمولوجيا؛ إذ ساهمت هذه الميادين المختلفة في ظهورها. ومن هنا، تعدّ القراءة التاريخية ضرورية لفهم هذه الاختلافات في القراءات الإبستمولوجية بشكل أعمق.
بناءً على ذلك، يتوجب علينا أن ننظر في المسار التاريخي الذي ساهم في ظهور الإبستمولوجيا. فمن خلال هذا المسار، نسأل عن أصل نشأتها قبل أن تصاغ كمصطلح. فالإبستمولوجيا، كعلم غامض يصعب تحديده، فإنه لا يعقل ان هذا العلم قد نشأ من العدم؛ لذا ينبغي أن نتساءل كيف نشأت، ومن أين استمدت قواعدها وأسسها.
تتجلى الإبستمولوجيا كمنظومة فكرية ذات جذور تاريخية متأصلة في الثورات الفلسفية والعلمية التي شكلت معالمها. فهي ليست مجرد تطور في أساليب التفكير، بل تمثل انعطافا جوهريا في مسار الفعل العلمي، حيث ينطلق من البناء المنهجي والفحص النقدي العميق لإعادة تشكيل المعارف وتنظيمها.
إن الإبستمولوجيا، في جوهرها، تجسد تلك الجرأة الفكرية التي دفعت فلاسفة وعلماء، في لحظات تاريخية محددة، إلى تبني مواقف ثورية لم يكن يدركون حينها أن ممارساتهم تغدو أن تصبح ممارسة إبستمولوجية بامتياز. هؤلاء الرواد سعوا لقطع الصلة مع أنماط المعارف السائدة التي كانت تقيد الفكر وتحول دون تقدمه، وبذلك كانوا يسهمون في إحداث قطيعة معرفية تمهد الطريق لانبثاق تصورات جديدة تُنقذ الفكر من جمود طال أمده.
I. قراءة تاريخية للإبستمولوجيا:
أ) الإبستمولوجيا في الفلسفة اليونانية: أفلاطون وأرسطو
يعد افلاطون الفيلسوف الأول الذي اهتم بمسألة المعرفة؛ فقد وجد نفسه بين رأيين متعارضين: رأي بروتاغوراس وإقريطوس وأمثالهما من الهرقليطيين، الذين يردون المعرفة إلى الإحساس ويرونها جزئية ومتغيرة مثل الإحساس ذاته[46] بهذا يمكن القول إن فلسفة أفلاطون تعدّ رائدة في تأسيس الإبستمولوجيا الكلاسيكية. فقد خاض في جميع مجالات العلم والمعرفة، وقسّمها، وقدم لها تعريفات جدلية وبراهين عقلية. كان هدفه الأساسي هو البحث عن الحقيقة والإيمان بها والالتزام بها، تلك التي تقود الإنسان إلى معرفة نفسه. كتب أفلاطون ثماني وعشرين محاورة تُعدّ أصل الفكر العالمي الصائب، والمصباح الذي أضاء طريق العقل البشري[47].
لقد كان لأفلاطون تصور مخالف تجاه من يسلمون بأن المعرفة تجريبية تعتمد على الإدراك الحسي ومستمَدة منه. فقد اعتبر أن المعرفة الحقيقية الوحيدة هي التي تتصل بالمدركات العقلية، وأنه لا يوجد ما يستحق المعرفة يمكن استخلاصه من الحواس. ويمكن رد أصول هذه النظرة إلى بارميندس. وقد تجلى نقد أفلاطون للرأي القائل إن المعرفة هي ذاتها الإدراك الحسي في النصف الأول من محاورته تياتيتوس[48].
بناءً على ذلك، فإن كل من الحدس، والذاكرة، والجمال، والخيال، والمنطق، والرياضيات، والرصد التجريبي كان لها دور محدد في نظرية المعرفة لدى أفلاطون. ومع ذلك، فقد تعرضت التجربة لقدر كبير من الانتقادات[49] بسبب التوجه الإبستمولوجي لأفلاطون الذي كان معادياً للمادية. وهذا يعكس محاولة لقطيعة معرفية من خلال إنكار دور التجربة في المعرفة.
فحين نجد أرسطو، على نحو مغاير، يدافع عن دور التجربة الحسية في المعرفة، نرى أنه ذهب إلى أن وسائل اكتساب المعرفة لدى الإنسان والحيوان تعتمد بداية على عالم الحواس. فالإدراك الحسي هو أول خطوات المعرفة، ومن تكراره تتولد الذاكرة ثم الخبرة، وهذه كلها مشتركة بين الإنسان وبعض أنواع الحيوان.[50]
ينحصر إبداع أرسطو الإبستمولوجي في طرحه لمشكلة المعرفة في إطار ارتباطها بنظريته للعلم؛ فهي على حد تعبير جان ديمون تعد كمشكلة اتحاد المادة والصورة. وهذا ما مكّنه من التخلص من هذا التناقض الخاص بصراع هذين العنصرين. فالواقع عند أرسطو ليس هو المادة ولا الصورة، بل هو المركب من الاثنين. مشكلة المعرفة عند أرسطو ترتبط بالنظر إلى مشكلة العلم؛ فالحواس والعقل والاستدلال والحدس تؤدي أدواراً واضحة للعلم في معرفتنا بالعالم الخارجي بمختلف موضوعاته، مادية وصورية وروحانية[51].
بناء عما سبق، وفقًا لما يذكره ريتشارد تارناس في كتابه آلام العقل الغربي: إن الفكر الكلاسيكي اليوناني قد زوّد أوروبا بالأدوات اللازمة لإحداث الثورة العلمية لاحقًا. ومن أهم هذه الأدوات نذكر: الحدس الأولي للإغريق بنظام عقلاني في الكون (الكوزموس)، الرياضيات الفيثاغورية، مشكلة الكواكب التي حددها أفلاطون، الهندسة الإقليدية، الفلك البطلمي، سلسلة بدائل النظريات الكوزمولوجية القديمة القائمة على فكرة أرض متحركة، التمجيد الأفلاطوني الجديد للشمس، المادية الذرية الميكانيكية، الباطنية الهرمسية، والقاعدة العميقة لمجموعة النزعات التجريبية والطبيعية والعقلانية الأرسطية وما قبل السقراطية[52].
يمكن القول إن الفلسفة الإسلامية قد تأثرت بالفلسفة اليونانية في بناء المعرفة مثل فلسفة الكندي وابن سينا وابن رشد. إلا أننا نجد أن الغزالي وابن خلدون يبتعدان تمامًا عن أصول الفلسفة اليونانية[53].
ب) الإبستمولوجيا الكلاسيكية وعلاقتها بالفلسفة الإسلامية:
عندما راجت الفلسفة في الإسلام، نقل حنين بن إسحاق وغيرهم من المترجمين الفلسفة اليونانية، مما أتاح للكندي والفارابي وابن سينا تطوير مجالاتهم الفكرية. وكانت هذه الترجمة من إيجابيات التواصل الحضاري، إلا أن هناك من النقاد العرب من حاولوا إحداث قطيعة مع العالم اليوناني، وهذا يعد أشبه بقطيعة إبستمولوجية مع الفلسفة الإسلامية التي سعت للدمج مع الفلسفة اليونانية.
ومن يقرأ أعمال الغزالي، مثل "معيار العلم" و"المنقذ من الضلال" و"تهافت الفلاسفة"، يتبين له أن نقده لآراء الفارابي وابن سينا في مسائل مثل قدم العالم والعلم لم يكن مدفوعًا بشعوره الديني فقط، بل اتخذ موقفًا حذرًا من علوم الأوائل بشكل عام.[54]
بذلك تحرر الغزالي من كل قيد فكري ويقيني، وانطلق في التفكير بشكل مستقل، غير مثقل بميراث يقيده. وبهذا الإبداع الإبستمولوجي، أصبح الغزالي أستاذًا بارعًا متعمقًا في البحث والمجادلة. لم يترك مذهبًا من دون أن يناقشه وينقده. وقد آمن الغزالي بالشك واعتنقه كمنهج، مما دفعه إلى عدم الرهبة من الخرافات المقدسة والتزييفات الدينية التي كانت محاطة بجلال وهمي في أذهان العامة. بهذه الطريقة، نجا الغزالي من التقليد والخضوع لفلسفة الإغريق.[55]
إذن تشمل الإبستمولوجيا الفلسفية الكلاسيكية القديمة مجموعة من المعارف التي نشأت عبر تاريخ الفلسفة اليونانية، بحيث اعمد اسلوب النقد العقلي كاءدات لمجابهة التفكير الأسطوري وإعادة بناء المعرفة العلمية.
2. الإبستمولوجيا الحديثة: (إبستمولوجيا العلم الحديث والفلسفة الحديثة)
في مطلع العصر الحديث شهد العالم تحولا مهمًّا تمثل في الثورة العلمية على مستوى العلم والمنهج التي انطلقت في القرن السادس عشر. كانت من أبرز ملامح هذه الثورة اكتشافات نيكولاس كوبرنيكوس، الذي قدم نموذجًا جديدًا للنظام الشمسي يعنى بمركزية الشمس، مخالفًا بذلك النموذج التقليدي الذي كان سائدًا منذ زمن أرسطو، والذي كان يعتبر أن الأرض هي مركز الكون[56]
تجدر الملاحظة في أن نموذج كوبرنيكوس لم يغير فقط الطريقة التي نفهم بها الكون، بل أثار أيضًا نقاشات فلسفية ودينية عميقة حول موقع الإنسان في الكون. اكتشافاته كانت مستوحاة جزئيًّا من النظريات الفيثاغورية القديمة[57].
هذه الثورة العلمية أسست لمرحلة جديدة في تاريخ البشرية، حيث بدأ الفكر العلمي يتجاوز الحدود التي فرضتها الفلسفة القديمة والسلطة الدينية، مما مهد الطريق لنهضة علمية وفكرية شاملة في أوروبا، ثم إن هذه الثورة العلمية قد تزامنت وتواصلت مع العالم الإنجليزي جلبرت Gilbert الذي اكتشف على يده علم المغناطيس، وقد شهد عام 1608 اختراعات التلسكوب فانكشفت أسرار الكون للعين المجردة، وظهرت الكواكب على حقيقتها بوصفها أجراما مادية فيها الجبال والسهول والأودية، بل وانكشفت أقمار المشتري الأربعة، فغدت الأفلاك أو الكواكب أحد عشر، وليست سبعة كما كان يعتقد في عالم أرسطو القائم على سماوات سبع يحيط بها الفلك المحيط[58]
مع بروز اكتشافات كبلر وغاليلا ونيوتن وغيرهم من العلماء الآخرين بدء العلم يظهر كجملة من الإبداعات يدفع بالمعرفة نحو التقدم نتيجة لفصل الدين عن العلم.
نذكر على سبيل المثال، اكتشاف قوانين حركة الكواكب الإهليلجية بواسطة كبلر، وقوانين حركة الأجسام بواسطة غاليليو، وقوانين نيوتن الكونية حول الجاذبية[59]. إلى جانب هذه الاكتشافات، كان هناك العديد من الإنجازات الأخرى التي ساهمت في تهيئة الظروف العلمية والاجتماعية والسياسية لتحقيق إنجازات علمية جديدة. نضجت الظروف العلمية بفضل هذه الاكتشافات النظرية والعملية التي تحققت في تلك الفترة.
في ظل هذه الأحداث، تأثر الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون بالاكتشافات المنهجية العلمية الجديدة التي ظهرت منذ بداية ثورة كوبرنيكوس. وكان بيكون سعيدًا بدراسة خطوات كبلر ونيوتن وغيرهم؛ لأنها كانت متوافقة مع منهجه في الاستقراء. بناءً على ذلك، يُعدّ بيكون أول من أرسى قواعد العلم الحديث في مطلع القرن السابع عشر، بوضعه أسس منهج الاستقراء القائم على الملاحظة والتجربة الممنهجة. ويُعد بيكون من رواد حركة التنوير والدعوة للفصل بين العلم واللاهوت، حيث تُوجت فلسفته بفصل العلم عن الدين، والفلسفة عن اللاهوت[60].
إذن تظهر لنا الإبستمولوجيا الحديثة أنها تشمل مجموعة من الثورات العلمية التي ساهمت في نشأة قيم إبستمولوجية جديدة. فقد كان العصر الحديث بمثابة تمهيد للحديث عن التحول في المنهج البيكوني والمنهج العلمي بشكل عام، مقارنةً بالمنهج الأرسطي. وقد دمر العلم الحديث المنظومة الفكرية لأرسطو بصورة تدريجية، مما أدى إلى ظهور تيارين في القرن السابع عشر: تيار عقلي وآخر تجريبي.
وعليه، فإن إبستمولوجيا العلم الحديث التي أسسها كوبرنيكوس وكيبلر وجاليليو ونيوتن وغيرهم من علماء العصر الحديث تلخصها وتبلورها فكرة الحتمية المطلقة[61]. لم تكن الحتمية آنذاك مجرد مبدأ من مبادئ العلم، بل كانت ركيزة أساسية يرتكز عليها وهدفًا منشودًا يسعى للوصول إليه. وهذا ما عبر عنه كلود برنار بقوله: "لابد للعقل من نقطة ارتكاز أولى، وهذه النقطة هي مبدأ الحتمية المطلقة. ولولاها، لكان الإنسان قد قُضي عليه بأن يدور في دائرة مفرغة ولا يتعلم شيئًا قط."[62] وهكذا، آمن العلماء بأن الحتمية ليست الأساس فقط، بل سلموا أيضًا بأن الهدف الأول من كل دراسة علمية تجريبية هو تعيين حتمية موضوعها، وصولًا إلى الحتمية الشاملة التي تمثل الحقيقة المطلقة. [63]
بناءً على ما سبق، كان للثورات العلمية الحديثة دور كبير في ظهور الإبستيمولوجيا، وقد كانت هذه الثورات نتيجة لقطيعة إبستمولوجية. ويُعدّ مفهوم القطيعة الإبستمولوجية، كما يراه باشلار، تفسيرًا لنشوء الثورات العلمية التي تحدث داخل العلم. ويُعدّ جاليليو هو أول من قطع الصلة بالفكر العلمي القديم.
وتبعا لذلك، يرتبط مفهوم الثورة العلمية بالنهضة التي شهدها القرن السادس عشر، والتي تعبر عن التغيير والإصلاح في مختلف الميادين. فعلى المستوى الديني، ظهرت حركة الإصلاح الديني مع لوثر وكالفن المناهضة للكاثوليكية. وعلى المستوى الاجتماعي، بدأت أرستقراطية تجارية جديدة تنافس أرستقراطيات الكنيسة. وهذا يعني أن الجو العام أصبح مهيأً لتقبل كل جديد.
ثم لا يفوتنا أن نذكر دور الفلسفة الحديثة ومساهمتها في بزوغ الإبستمولوجيا. من أهم هذه الفلسفات نذكر فلسفة كانط النقدية، التي قامت على نقد المذهب العقلي (ديكارت) ودحضه، بالإضافة إلى المذهب التجريبي الحسي (لوك وهيوم)[64]. تجدر الملاحظة أن مصطلح الإبستمولوجيا ظهر بعد الفلسفة الكانطية في القرن التاسع عشر، حيث استعارت الإبستمولوجيا الكثير من أفكار كانط، مثل النقد. للإبستمولوجيا طرفان أساسيان: الطرف النقدي، والطرف التاريخي. بمعنى آخر، يتناول الطرف النقدي تحليل النظريات وتقييمها، بينما يهتم الطرف التاريخي بكيفية نشوء وتطور وتفرع النظريات وتغيرها عبر الزمن، ونقد الوثوقية العلمية في النظريات والقوانين الفيزيائية والمعادلات الرياضية[65]
وبالتالي، فإن القطيعات الإبستمولوجية ستستمر، حيث ساهمت التطورات العلمية التي حدثت من أواخر القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين في مجالات متنوعة، مثل الرياضيات والفيزياء في ظهور الدراسات الإبستمولوجية المعاصرة. ازدهرت هذه الدراسات بعد الثورة العلمية الحديثة، التي أحدثت فجوة وأزمة بين الفيزياء الكلاسيكية التي أسسها غاليليو ونيوتن، والرياضيات التي نظمها اليونانيون وأعاد إحياؤها ديكارت وليبنتز من جهة، وبين الفيزياء الحديثة التي وضع أسسها بلانك وأينشتاين وغيرهم من علماء الفيزياء الذرية، والرياضيات الحديثة والمعاصرة من جهة أخرى[66].
3. الإبستمولوجيا المعاصرة: (إبستمولوجيا العلم المعاصر والفلسفة المعاصرة)
أحدثت الثورات العلمية المعاصرة، لا سيما في مجالي الفيزياء والرياضيات، تغييرًا جذريًّا تمثل في تطور الميكانيكا النيوتنية والهندسات اللاإقليدية. هذا التحول الكبير دفع العلماء إلى إعادة تقييم المبادئ والمفاهيم التي كانت تشكل أساس العلم الكلاسيكي. كما أن هذه الثورات فرضت على الفلاسفة والمهتمين بالفكر النقدي إعادة النظر في تصوراتهم ومفاهيمهم. فكانت هذه الثورات بمثابة نقطة تحول حاسمة أثرت على الفكر بشكل عام، الذي كان يعتمد سابقًا على النظريات العلمية الكلاسيكية، مما أدى إلى محاولة تجاوز نظرية التراكم العلمي التقليدية[67].
تتميز الابستمولوجيا العلم المعاصرة بتحول جذري تمثل في مبدأ اللاحتمية الذي جاء ليحل محل الحتمية التقليدية. فمع نهاية القرن التاسع عشر، واجهت الميكانيكا النيوتونية أزمة كبيرة، وأصبحت غير قادرة على تفسير العديد من الظواهر الطبيعية. في هذا السياق، ظهرت ميكانيكا الكم ونظرية النسبية في القرن العشرين كمخرج من هذه الأزمة، مما أدى إلى انهيار الحتمية الميكانيكية.
تُعتبر نظرية الكوانتم واحدة من أعظم الإنجازات العلمية التي غيرت مجرى العلم. وبالمثل، أسهمت نظرية النسبية في تحقيق نتائج إبستيمولوجية ذات قيمة كبيرة؛ إذ جعلت العلماء يدركون للمرة الأولى ضرورة إعادة النظر في المبادئ الأساسية للفيزياء.[68]وهاتان النظريتان ليستا فقط من أعظم الثورات العلمية التي شهدتها البشرية، بل تمثلان أيضًا خطوة جريئة نحو التقدم الفكري والعلمي. ومن خلالهما، برزت أزمة الفيزياء الكلاسيكية، مما أدى إلى إعادة صياغة الفهم العلمي للعالم.
أحدثت نظرية الكم ثورة مذهلة في ميدان الفيزياء المعاصرة، لدرجة أنه يمكننا القول إنها قلبت مفاهيمنا العلمية بشكل جذري. فقد شكلت قطيعة إبستيمولوجية عميقة بين الفيزياء الكلاسيكية والفيزياء الحديثة، مغيرةً ليس فقط فهمنا لطبيعة الذرة، بل أيضاً لرؤيتنا للكون برمته. بينما لعبت النظرية النسبية الخاصة والعامة دورًا مهمًّا في الفيزياء المعاصرة، فقد تم الاعتراف لأول مرة بضرورة تعديل المبادئ والمفاهيم الأساسية للفيزياء بفضل هذا التطبيق. ولعل هذا ما دفع بباشلار إلى تأسيس ملف كامل للنظرية النسبية، موضحاً قيمتها الاستقرائية العلمية[69].
هكذا نجد أن ثورة الكوانتم والنسبية، التي تعززت بتطور الرياضيات، قد أسست العلوم على أسس جديدة ومنطلقات مختلفة، قلبت رأسًا على عقب مبادئ إبستمولوجية راسخة كانت تعتبر حتى وقت قريب غير قابلة للجدل. مفاهيم مثل الحتمية والميكانيكية والعلية واطراد الطبيعة وثبات قوانينها ويقينها، كانت تشكل جوهر الفكر العلمي الكلاسيكي. ولكن مع هذه الثورة العلمية، تغيرت تلك المفاهيم جذريًّا، مما أدى إلى نشوء حد فاصل بين إبستمولوجيا العلم الكلاسيكي وإبستمولوجيا العلم في القرن العشرين. لم يعد من الممكن النظر إلى الطبيعة وقوانينها بنفس الطريقة، فقد تحولت إلى مفاهيم أكثر تعقيدًا وأقل يقينًا، وهو ما لم يكن أحد يتخيل في السابق[70].
من ثم، أسهم التطور العلمي في العصر الحاضر في تغيير كبير في مفهوم الإبستمولوجيا، فبعد أن كان بحثها يقتصر على إثارة أسئلة تقليدية حول إمكانية المعرفة؛ فقد أصبحت الإبستمولوجيا في الفلسفة المعاصرة، يتركز الاهتمام فيها بشكل أساسي على مشكلات المعرفة ونموها، بدلاً من تبريرها فقط، ويشمل ذلك العلم وتطوره. لهذا، نجد تشابهًا في هذا التركيز بين فلسفة كل من باشلار وبول ريكور وتوماس وألكسندر كويري، رغم أن هناك اختلافات واضحة في الاتجاهات التي اتبعوها في مساراتهم الإبستمولوجية وفلسفتهم العلمية. على الرغم من هذه الاختلافات، فإن ما يجمع بينهم هو محاولة تقديم إجابات على إشكالية كيفية تجسيد التقدم العلمي.
من أبرز المفاهيم التي تميز إبستمولوجيا الفلسفة المعاصرة هو مفهوم "القطيعة" كما عرضه غاستون باشلار. هذا المبدأ يكتسي أهمية بالغة في دراسته الإبستمولوجية، حيث يرى باشلار أن نقطة التحول الرئيسة في نمو المعرفة العلمية هي ما يسميه القطيعة[71]. ويعني هذا الانتقال من فكر علمي إلى تفسير أشمل للظواهر. القطيعة الإبستمولوجية لا تعني إلغاء الفكر العلمي السابق، بل تعني أن الفكر الجديد ينفصل عنه عندما تعجز المفاهيم العلمية الحالية عن تفسير وقائع جديدة، لم يسبق لها أن عرضت للتفكير العلمي. كما يُنظر باشلار إلى مفهوم القطيعة الإبستمولوجية la rupture épistémologique على أنه تفسير لنشأة الثورات العلمية التي تحدث داخل العلم، ويُعد جاليليو أول من قطع الصلة بالفكر العلمي القديم[72].
ساهمت أعمال باشلار حول الموضوعية العلمية في النتائج التي توصل إليها مفكرون بارزون مثل كارل بوبر وتوماس كون، حتى وإن لم يكن هناك ما يؤكد تأثير باشلار المباشر على هؤلاء المفكرين وبناء على ذلك استلهم كارل بوبر من مفهوم التطور الذي طرحه غاستون باشلار المعتمد على فكرة القطيعة ليصوغ مفهومًا أكثر جذرية هو قابلية التكذيب، حيث يعتبر هذا المفهوم، بحسب جاك مونو، جوهر فلسفة بوبر المعرفية[73].
طرح بوبر مبدأ التكذيب كبديل لمبدأ التحقق الذي تبنته الوضعية المنطقية؛ وذلك بهدف التمييز بشكل واضح بين المعرفة العلمية والمعرفة الميتافيزيقية. وقد دفعته انتقادات لفتجنشتاين وكارناب، ممثلي الوضعية المنطقية، إلى هذا الموقف. من حيث يرى هذا الفيلسوف المنهجي أن الميتافيزيقا، رغم أنها لا تخضع للاختبار العلمي، تلعب دورًا حيويًّا في تقدم العلم. فهي تحفز الخيال العلمي وتولد فرضيات جديدة، مما يدفع البحث العلمي إلى آفاق أوسع.[74]
وأخيراً، نذكر فكرة النموذج (Paradigm)عند توماس كون، الذي يعد من أهم المفاهيم التي تضمنها كتابه بنية الثورات العلمية في ميدان الابستمولوجيا المعاصرة؛ إذ يتصور كون أن العلم في مرحلة معينة يحتوي على مجموعة مترابطة النظريات والقوانين التي تشكل إطارًا عملًا موحدًا، حيث تؤلف هذه النظريات كلاًّ متماسكا يُطلق عليه مصطلح "النموذج". في هذه الفترة، يسير العلماء في أبحاثهم العلمية وفق هذا النموذج. إلا أنه قد يحدث أن يأتي أحد العلماء بفكرة تخالف الآراء السائدة في النموذج العلمي المعمول به، مما يؤدي إلى تغير نظرة العلماء ويحل مكانها نظريات جديدة نتيجة الكشف الجديد[75].
بمعنى أوضح، بحسب توماس قد تظهر الأزمات علمية عندما تتراكم الأدلة التي تتناقض مع النموذج السائد، وفي مثل هذه اللحظات الفاصلة، قد يطرح العلماء نماذج جديدة، لينشب صراع بين تلك النماذج حتى ينتصر أحدها ويصبح النموذج السائد الجديد، بحيث أن هذه العملية يصفها توماس كون بأنها "ثورة علمية من حيث إن حدوثها يقلب الأوضاع العلمية الموجودة"[76]، فهي تمثل تحولًا جذريًّا في فهمنا للعالم؛ إذ تفتح آفاقًا جديدة للفكر البشري وتعيد صياغة علاقتنا بالكون.
في المحصلة، كان لظهور الدراسات الإبستمولوجيا المعاصرة تأثير بالغ في إعادة تشكيل الفكر العلمي والفلسفي، فقد جاءت بوصفها استجابة فلسفية لتحولات جذرية أحدثتها الثورة العلمية الحديثة، التي أعادت تشكيل أسس الفهم الإنساني، حيث سعت إلى إعادة صياغة الأسس الفلسفية التي تقوم عليها العلوم في ضوء الاكتشافات الجديدة.
في الختام يمكن القول إن محاولة إدراك مفهوم الإبستمولوجيا وفهمه يتجاوز مجرد الاطلاع على تعريفاته. فهو يتطلب دراسة نقدية عميقة لتاريخ تطوره، حيث يُظهر التحليل التاريخي أن الإبستمولوجيا لم تكن يومًا مجالًا منفصلًا، بل كانت دائمًا في حوار مستمر مع الفلسفة والعلوم، مما أضفى عليها ثراءً وتنوعًا في التفسيرات والمدارس الإبستمولوجية.
وعليه، تظهر التحديات التي يواجهها الباحثون في دراسة الإبستمولوجيا الصعوبة في تحديد ملامح الإبستمولوجيا نتيجة لاختلاف طرق تناولها.
على الرغم من صعوبة تعريف الابستمولوجيا إلا أنه يبقى دوما في ضرورة الحاجة إلى تعزيز دراساتها ومواصلة الاهتمام بها نظرا لكونها تتجلى كمنارة فكرية تضيء مسار المعرفة العلمية؛ إذ تسهم في إعادة تشكيل أدوات البحث العلمي والفلسفي، مما يفضي إلى ديناميكية معرفية متجددة تسعى نحو الابداع عوض الثبات الفكري، حيث تبرز الإبستمولوجيا بوصفها أفقًا نقديًّا يمكّن الفكر من إعادة مساءلة المفاهيم السائدة، وفحصها وإعادة تأطيرها في ضوء فرضيات تكون أكثر ملائمة من أجل تحقيق التقدم والنمو بالمعرفة.
بيبليوغرافيا
المراجع باللسان الأعجمي:
James F.Ferrier, Institutes of Methaphysic, Black Wood
المراجع باللغة العربية:
- أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية: تاريخها ومشكلاتها، دار قباء، القاهرة، 1998
- أيوب أبو ديّة، العلم والفلسفة الأوروبية الحديثة من كوبرنيق إلى هيوم ط1، 2009
- أفلاطون، جمهورية أفلاطون، ترجمة فؤاد زكريا، مؤسسة الهنداوي، 2023
- توماس كون، فلسفة العلوم: تركيب الثورات العلمية، ترجمة ماهر عبد القادر محمد علي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1988
- جميل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، 1989
- جان بياجيه، الابستمولوجيا التكوينية، ترجمة السيد نفادي، بيروت، 2004
- جورج كانغيلام، دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتها، ترجمة د. محمد بن ساسي، د. مراجعة محمد محجوب، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بيروت، 2007
- الحبيب الحباشي، النظرية النسبية والأبستمولوجيا في القراءة الإبستيمولوجية الاعتقادية السندية، الجزء الأول، بيروت، دار التنوير، ط1، 2013
- حسن حسين صديق، دور الميتافيزيقيا في بناء النظرية العلمية: كارل بوبر أنموذجا، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، 2014
- ريتشارد تارناس، آلام العقل الغربي، ترجمة فاضل جتكر، العبيكان، 2010
- السيد شعبان حسن، برونشفيك وباشلار بين الفلاسفة والعلم: دراسة نقدية مقارنة، التنوير، بيروت، ط1، 1993
- عبد القادر بشته، الابستمولوجيا: مثال فلسفة الفيزياء النيوتونية، بيروت، ط1، 1995
- عبد السلام بنعبد العالي وسالم يفوت، درس الابستيمولوجيا، الدار البيضاء، 1986
- عبد الله ثاني محمد النذير، إبستمولوجيا علوم الإعلام والاتصال، منشورات دار الاديب، 2017
- غاستون باشلار، العقلانية التطبيقية، ترجمة بسام الهاشم، بيروت، المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع، ط1، 1984
- فيرنر هايزنبرج، الفيزياء والفلسفة: ثورة في العلم الحديث، ترجمة خالد قطب، المركز القومي لترجمة، ط1، 2014
- كامل محمد محمد عويضة، كارل بوبر فيلسوف العقلانية النقدبة، بيروت، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1، 1995
- ميشال فوكو، حفريات المعرفة، ترجمة سالم يفوت، بيروت، ط2، 1987
- محمد الوقيدي، ماهي الابستيمولوجيا، الرباط، مكتبة المعارف، ط2، 1987
- محمد وقيدي، بناء النظرية الفلسفية: دراسات في الفلسفة العربية المعاصرة، بيروت، دار الطليعة، ط1، 1991
- مصطفى نشار، نظرية المعرفة عند أرسطو، دار المعارف، القاهرة، ط3، 1995
- محمد وقيدي، جرأة الموقف الفلسفي، بيروت، أفريقيا الشرق، 1999
- محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم: العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، بيروت، مركز الدراسات الوحدة العربية، ط5، 2002
- ماهر عبد القادر محمد علي، فلسفة العلوم: قراءة عربية، الإسكندرية، أورينتال، 2006
- محمد بن ساسي، دارسات في الابستيمولوجيا، نيرفانا للنشر، 2021
- نعيمة ولد يوسف، مشكلة الاستقراء في إبستمولوحيا كارل بوبر، ابن النديم لنشر والتوزيع- دار الروافد الثقافية، وهران-بيروت، ط1، 2015
- يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين: الأصول- الحصاد- الآفاق- المستقبلية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2014
- يمنى طريف الخولي، مشكلة العلوم الإنسانية: تقنينها وإمكانية حلها، مؤسسة الهنداوي، 2014
المعاجم والموسوعات باللسان الأعجمي:
- Sylvain Auroux, Les Notion Philosophiques Dictionnaire, tome2, Presses Universaires De France.
المعاجم والموسوعات باللغة العربية:
- اندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب خليل احمد خليل، المجلد الأول، بيروت، منشورات عويدات ط 2، 2001
- مراد وهبة، المعجم الفلسفي، القاهرة، دار القباء الحديثة، 2007
مقالات ومجلات على مواقع إلكترونية:
حشلافي امحمد، دور البعد التاريخي وعلاقته بالنقد في نشأة الإبستيمولوجيا، مقال على الموقع الإلكتروني: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/76455#
حسين بن عبد الله، مدخل إلى إبستيمولوجيا باشلار، مجلة منيرفا، مجلد5، العدد1
[1] مراد وهبة، المعجم الفلسفي، القاهرة، دار القباء الحديثة، 2007، ص 12
[2] مراد وهبة، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص12
[3] James F.Ferrier, Institutes of Methaphysic, Black Wood, 1854, p46
[4] روبير بلانشيه، نظرية المعرفة العلمية (الإبستمواوجيا)، ترجمة د. حسن عبد الحميد، جامعة الكويت، 1987، ص35
[5] Sylvain Auroux, Les Notion Philosophiques Dictionnaire, tome2, Presses Universaires De France, p813
[6] عبد القادر بشته، الابستمولوجيا: مثال فلسفة الفيزياء النيوتونية، بيروت، ص5-6.
[7] اندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب خليل احمد خليل، المجلد الأول، بيروت، منشورات عويدات، ط 2، 2001، ص 356 -357
[8] ماهر عبد القادر محمد علي، فلسفة العلوم: قراءة عربية، مرجع سابق، ص23.
[9] مراد وهبة، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص12.
[10] ميشال فوكو، حفريات المعرفة، ترجمة سالم يفوت، بيروت، ط2،.198، ص 164.
[11] جان بياجيه، الابستمولوجيا التكوينية، ترجمة السيد نفادي، بيروت، 2004، ص35
[12] يجان باجيه، الابستمولوجيا التكوينية، مرجع سابق، ص35
[13] محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم: العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، مرجع سابق، ص38
[14] كامل محمد محمد عويضة، كارل بوبر فيلسوف العقلانية النقدبة، بيروت، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1، 1995، ص87
[15] عبد السلام بنعبد العالي وسالم يفوت، درس الابستيمولوجيا، الدار البيضاء، 1986، ص7
[16] عبد القادر بشته، الابستمولوجيا: مثال فلسفة الفيزياء النيوتونية، مرجع سابق، ص12
[17] المرجع نفسه، ص21
[18] محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم: العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، بيروت، ص ص 22-19-47.
[19] محمد وقيدي، جرأة الموقف الفلسفي، بيروت، مرجع سابق، ص ص8-15.
[20] محمد بن ساسي، دارسات في الابستيمولوجيا، نيرفانا للنشر، 2021، ص19.
[21] المرجع نفسه، ص ص 19-22
[22]المرجع نفسه، ص20-21.
[23] محمد بن ساسي، دارسات في الابستيمولوجيا، مرجع سابق، ص19.
[24] محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم: العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، مرجع سابق، ص 18.
[25] محمد الوقيدي، ماهي الابستيمولوجيا، الرباط، مكتبة المعارف، ط2، 1987، ص8.
[26] جميل صليبا، المعجم الفلسفي، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص162.
[27] محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم: العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، بيروت، ص24.
[28] روبير بلانشيه، نظرية المعرفة العلمية (الإبستمولوجيا)، مرجع سابق، ص49.
[29] روبير بلانشيه، نظرية المعرفة العلمية (الإبستمواوجيا)، مرجع سابق، ص49.
[30] عبد الكريم صالح، كليات في الفكر المعاصر: ضمن الإبستمولوجيا ونظرية المعرفة، مرجع سابق، ص29.
[31] عبد الكريم صالح، كليات في الفكر المعاصر: ضمن الابستمولوجيا ونظرية المعرفة، ص31.
[32] محمد الوقيدي، ماهي الابستيمولوجيا، مرجع سابق، ص14.
[33] روبير بلانشيه، نظرية المعرفة العلمية (الإبستمواوجيا)، مرجع سابق، ص9.
[34] عبد القادر بشته، الابستمولوجيا: مثال فلسفة الفيزياء النيوتونية، مرجع سابق، ص57.
[35] روبير بلانشيه، نظرية المعرفة العلمية (الإبستمواوجيا)، ترجمة د. حسن عبد الحميد، ص53.
[36] محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم: العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، مرجع سابق، ص19.
[37] محمد الوقيدي، ماهي الابستيمولوجيا، الرباط، مرجع سابق، ص9.
[38] محمد الوقيدي، ماهي الابستيمولوجيا، مرجع سابق، ص ص15-16
[39] المرجع نفسه، ص ص 252-253
[40] روبير بلانشيه، نظرية المعرفة العلمية (الإبستمواوجيا)، ترجمة د. حسن عبد الحميد، جامعة الكويت، 1987، مرجع سابق، ص20
[41] جورج كانغيلام، دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتها، ترجمة د. محمد بن ساسي، د.مراجعة محمد محجوب، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بيروت، 2007، ص 41
[42] روبير بلانشيه، نظرية المعرفة العلمية (الإبستمولوجيا)، مرجع سابق، ص21
[43] محمد الوقيدي، ماهي الابستمولوجيا، الرباط، مكتبة المعارف، ط2، 1987، مرجع سابق، ص235
[44] الجابري محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم: العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، مرجع سابق، ص42
[45] روبير بلانشيه، نظرية المعرفة العلمية (الإبستمواوجيا)، مرجع سابق، ص8
[46] يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، وكالة الصحافة العربية ناشرون، الجيزة، 2019، ص111
[47] أفلاطون، جمهورية أفلاطون، ترجمة فؤاد زكريا، مؤسسة الهنداوي، 2023، ص11
[48] برترناد راسل، تاريخ الفلسفة الغربية (الكتاب الأول) الفلسفة القديمة، ترجمة زكي نجيب محمود، مؤسسة هنداوي، 2023، ص 207
[49] ريتشارد تارناس، آلام العقل الغربي: فهم الأفكار التي قامت بصياغة نظرتنا للعالم، ترجمة فاضل جتكر، العبيكان-، 2010، ص84
[50] د.أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية: تاريخها ومشكلاتها، دار قباء، القاهرة، 1998، ص231
[51] مصطفى نشار، نظرية المعرفة عند أرسطو، دار المعارف، القاهرة، ط3، 1995، ص110
[52] ريتشارد تارناس، آلام العقل الغربي، مرجع سابق، ص347
[53] جميل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، ص23
[54] جميل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، مرجع سابق، ص114
[55] المرجع نفسه، ص ص12-13-25-26
[56] د. أيوب أبو ديّة، العلم والفلسفة الأوروبية الحديثة من كوبرنيق إلى هيوم، بيروت، دار الفرابي، ط1، 2009، ص95
[57] المرجع نفسه، ص95
[58] أيوب أبو ديّة، العلم والفلسفة الأوروبية الحديثة من كوبرنيق إلى هيوم، مرجع سابق، ص ص 108-110
[59] المرجع نفسه، ص ص 114-127-137
[60] المرجع نفسه، ص ص 148-143
[61] يمنى طريف الخولي، مشكلة العلوم الإنسانية: تقنينها وإمكانية حلها، مؤسسة الهنداوي، 2014، ص113
[62] يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين: الأصول-الحصاد-الآفاق-المستقبلية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2014، ص 101
[63] المرجع نفسه، ص 101
[64] عبد الله ثاني محمد النذير، إبستمولوجيا علوم الإعلام والاتصال، منشورات دار الاديب، 2017، ص21
[65] أحشلافي أمحمد، دور البعد التاريخي وعلاقته بالنقد في نشأة الإبستيمولوجيا، مقال على الموقع الإلكتروني:
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/76455#
[66] د.محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم: العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، بيروت، مركز الدراسات الوحدة العربية، ط5، 2002، ص11
[67] حسين بن عبد الله، مدخل إلى إبستيمولوجيا باشلار، مجلة منيرفا، مجلد5، العدد1، ص ص50-51
[68] فيرنر هايزنبرج، الفيزياء والفلسفة: ثورة في العلم الحديث، ترجمة خالد قطب، المركز القومي لترجمة، ط1، ص 111
[69] السيد شعبان حسن، برونشفيك وباشلار بين الفلاسفة والعلم: دراسة نقدية مقارنة، التنوير، بيروت، ط1، 1993، ص86-101
[70] د. يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين: الأصول- الحصاد- الآفاق- المستقبلية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2014، ص217
[71] د.عبد العزيز بو الشعير، مقالات في الدرس الإبستمولوجي: مساءلات فلسفية في العالمين الصغري والكبري، منشورات ضفاف، 2016، ص131
[72] د.السيد شعبان حسن، برونشفيك وباشلار بين الفلاسفة والعلم: دراسة نقدية مقارنة، مرجع سابق، ص ص149-156-161-162
[73] نعيمة ولد يوسف، مشكلة الاستقراء في إبستمولوحيا كارل بوبر، ابن النديم لنشر والتوزيع- دار الروافد الثقافية، وهران-بيروت، ط1، 2015، ص116.
[74] د.حسن حسين صديق، دور الميتافيزيقيا في بناء النظرية العلمية: كارل بوبر أنموذجا، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، 2014، ص ص 129-119
[75] المرجع نفسه، ص ص 78-79
[76] توماس كون، فلسفة العلوم: تركيب الثورات العلمية، ترجمة ماهر عبد القادر محمد علي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1988، ص 181






