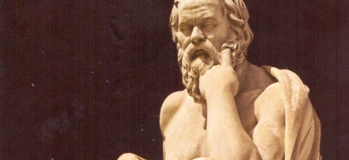الرهان القديم لعالمنا الجديد
فئة : مقالات

الرهان القديم لعالمنا الجديد
كلّ اختيار عملي هو اختيار متورط، من جهة ما، في تصور نظري قبلي معين، حتى وإن أعلن هذا الاختيار، كما يحصل في عالمنا اليوم، قيامه أصلاً على مناهضة ما هو نظري ومجرد. هكذا يمكن الجزم بالقول، إنّ كل الاختيارات التي يتبناها زمن عالمنا، في السياسة كما في المعرفة والقيم، تتأسس على أصل فلسفي عميق هو الذي يجعل وجودها ممكناً، والملفت بل والمثير أكثر هو أنّ هذا الأصل "قديم" قدم التجربة الفكرية الإنسانية. هكذا يصير كلّ رهان عالمنا العملي "الجديد" منبنياً في العمق على أساس نظري "قديم" قدم الفلسفة اليونانية كما سنتبيّن.
يُؤثر عن الحكيم اليوناني القديم هيراقليط قوله "كل شيء يصير" Ta Panta ReiΤα Πάντα ῥεῖ، وقد نقل أفلاطون وأرسطو ومؤرخو المذاهب بعده، وعلى رأسهم ديوجين ليرتيوس، هذا القول وجادلوه، فكان أن رفضه أفلاطون وزكّى عليه القول النقيض الذي ينسب إلى بارمنيدس، والذي مفاده "إنّ الوجود موجود واللاوجود غير موجود"، وهي العبارة التي اشتق منها، أنطولوجياً، تصور ساكن عن العالم، واشتق منها معرفياً تمثل ثابت للعلاقة بين الموجودات؛ فالعالم نظام بديع متراتب ساكن (كوسموس) تعمّره جواهر تلحق بها أعراض، ودراسة أشكال الإلحاق هذه هي ما اطلع ببيانه المنطق الأرسطي. إذن كُتب لقول بارمينيدس أن ينتصر ويخلد على حساب قول هيراقليط، فصار القول البارمينيدي عنواناً على الفكر الذي ينتصر "للحقيقة"، وصار قول خصمه هيراقليط قولاً منعوتاً. تزكّى هذا الأمر مع تغلب المسيحية ورسوخ الكوسمولوجيا القديمة مع الحساب الفلكي البطليمي، حيث استقر الأمر على أنّ العالم دائرة واحدة ثابتة متراتبة يقابلها نظام اجتماعي ثابت ومتراتب يكون الناس فيه متمايزين أنطولوجياً، وهذا ما يبرّر عدم تساوي الناس في مملكة البشر، فبما أنّ أنحاء العالم متراتبة قيمياً، فإنّ المجتمع سيكون متمايزاً قيمياً، ففي العالم القديم الفضيلة كانت هي أن تحتل الموقع الأنسب لك في مملكة الأرض التي هي مجرد صورة عن مملكة السماء ونظام الكوسموس الكامل البديع الجميل.
بطبيعة الأمر وكما يحصل دائماً في تاريخ الفكر، ظلّ القول الهيراقليطي المضاد حاضراً وإن بشكل خفي، هكذا فقد حضر شيء منه مع المدارس التالية على المعلم الأول، ومع بعض الرومان وعلى رأسهم لوكريس في نصه الباذخ "في طبيعة الأشياء"، ولكن بشكل عام سيبقى هذا التصور منبوذاً، خصوصاً، كما تقدم، وأنّ العقيدة المسيحية قد رفعته، في تأويله الأفلاطوني، إلى مستوى القداسة.
التغيير سيأتي مع القرنين السادس عشر والسابع عشر، ومن الفلك تحديداً مع الهزات التي أحدثها الفلكيون الكبار في نظام العالم القديم، تيكوبراهي ببرهانه على حركة الأفلاك وكيبلر ببرهانه الرياضي على مركزية الشمس وغاليلي في إلحاقه للفيزياء بهذا الحساب الرياضي. ستأخذ أوروبا مدة طويلة، حتى تستوعب الصدع الذي لحق بالكوسمولوجيا البطليمية المستندة على أنطولوجيا الثبات هذه، وسيكون القرن السابع عشر والثامن عشر مسرحاً لهذا الاستيعاب، مع ما عرفه من صراع بين العقلانيين (الأفلاطونيين) والهيراقليطيين الذين ستكون لهم حينها أسماء أخرى، مثل "إيتيقا" سبينوزا، حيث العالم جوهر واحد كلي يقال على ما يتحول ويصير، فلا تكون الموجودات فيه إلا أحوالاً، ومثل التجريبية الإنجليزية مع ذروتها هيوم، هذا الفيلسوف التفكيكي قبل الأوان الذي هدم الصرح الأفلاطوني على عروشه وأيقظ العجوز كانط من سباته العقدي الأفلاطوني مضطراً إياه لإعادة النظر الجذرية في كل شيء، احترازاً، كما أقرّ كانط نفسه، من شبح الأبيقورية والشكية التي كانت واحدة من الأسماء القديمة للهيراقليطية.
سيكون "للغارة" التجريبية على صرح بارمينيدس الأفلاطوني آثار وامتدادات. أمّا عن الآثار، فتتعلق بما سيلحق بالمفاهيم التقليدية من انكسارات، وعلى رأسها مفهوم الهوية، حيث سيصير الكوجيطو الديكارتي مثلاً محض وهم أصله العادة والتكرار؛ فالأنا ينحلّ إلى آلاف الحدوس الحسية التي تتقاسمه، إذ هو ليس جوهراً ثابثاً، بل فعل على الحقيقة؛ فعل التكون الدائم و"التحول" الذائب الذي لا ينقطع، وأمّا عن الامتدادات، فهي ما سيتحقق مع فلسفات أخرى، مثل المادية الفرنسية والجينيالوجية الألمانية والبرجماتية الأمريكية خصوصاً؛ فالبرجماتية هي الفلسفة التي ستدفع بالحدس الهيراقليطي إلى أقصاه، إذ أنها لن تحاول أن تحسم بين قول بوجود يصير أو صيرورة توجد، بل سترفض حتى طرح الأمر وفق هذه الثنائية.
بين البراجماتية والهيراكليطية أصول مشتركة كثيرة يصعب بسطها كاملة، فنهر هيراقليط الذي لا يمكن أن تستحم فيه مرتين هو النهر عينه الذي تحدث عنه جيمس، باعتباره الواقع المتحرك الذي يفيض فيفجّر كل أطر إدراكنا، إذ الواقع نهر والأطر دلاء، ولا يمكن أن تحسب حركة النهر أو تفهم دفقه بالدّلاء التي تستقيها منه، فالدلو عاجز عن أن ينبئ بماهية النهر. ونحن نحيا اليوم، في السياسة كما في الاقتصاد والقيم، عصر مجد البرجماتية، فكلنا مأخوذون في لجة النهر الهيراقليطي البراجماتي، كلنا نشيح بالوجه عن الأصل نحو الآتي، عن النظام الثابت نحو الصيرورة المتحولة، ولعل هذا ما يفسّر في جزء منه النفور المبدئي الذي تحسه ثقافتنا الأفلاطونية الساكنة من البرجماتية، فتستعملها على سبيل المنقصة، في حين تستعمل في مجالات العالم الجديد، باعتبارها مزية. نحن في العصر البراجماتي نحيا وفق منطق هيراقليطي خالص، فالحركة أولى من الثبات، والأفعال أهم من الحقائق، سواء في السياسة، حيث النجاعة أولى من الموقف أو المبدأ، أو في الاقتصاد حيث البرنامج العملي أولى من البيان الأيديولوجي، أو في الفكر، حيث تغيير الواقع أولى من تأمله و فهمه؛ كلّ هذا في إطار اختيار ثقافي حركي ترحالي تكون فيه الهُجنة أولى من الصفاء في العرق كما في القيم، فلا ثقافة بصافية ولا جنس بثابت، سواء قصدنا بالجنس استعماله المجازي، كما في الأدب والفن حيث لم يعد هناك فرق بين الشعر والنثر ولا بين الفن والتقنية في زمن "الفيزيون" fusion و"الديزاين" design، أو قصدنا معناه الأولي، حيث الذكورة والأنوثة صارت حركة وفق تصورات "الجندر" الجديدة، والحدود بين الحياة والموت والإنسان والآلة ما تفتأ تتغير كما يخبرنا العلم والتقنية كل صباح، لهذا فكلنا ينتظر ما سيُعلن عنه في الصباح الموالي، كلنا في انتظار هذا الذي سيصير إليه الأمر في الأيام القادمة، كلنا مشرئبون نحو الآتي، كلنا ننتظر وعد المستقبل، إذ في نهر هيراقليط الذي يأخذنا في لجّته الأهم هو المصب وليس النبع، المستقبل وليس الماضي.
قد تبدو هذه الخلفية الأنطولوجية بعيدة غابرة كما قلنا، وقد يبدو هذا الرهان قديماً واستحضاره لفهم شؤون عالمنا الحي غريباً، بيد أنّ الأمر ليس كذلك على الحقيقة؛ فالأسئلة في تاريخ الفكر واحدة، وإن كانت تعود في كل مرة من جديد، وكأن هذا العود لا يتحقق إلا باختلاف كما قال نيتشه مرة، وعنصر الاختلاف هنا هو المفاتيح التي يبدعها الناس في كل مرة لفك شفرات هذه الأسئلة الثابتة، وهي المفاتيح- الشفرات التي ما تفتأ تُنسى وتضيع مع كل جيل، لينتج الجيل التالي مفاتيح جديدة مختلفة، وهذا ما يجعلنا كائنات تاريخية أصلاً، كما يقرّر بعض مؤرخي الفكر الكبار.