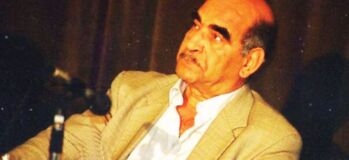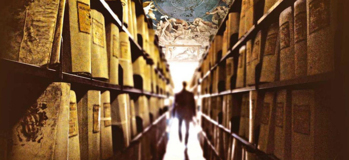المنهج في مشروع التراث والتجديد يمنى طريف الخولي
فئة : قراءات في كتب
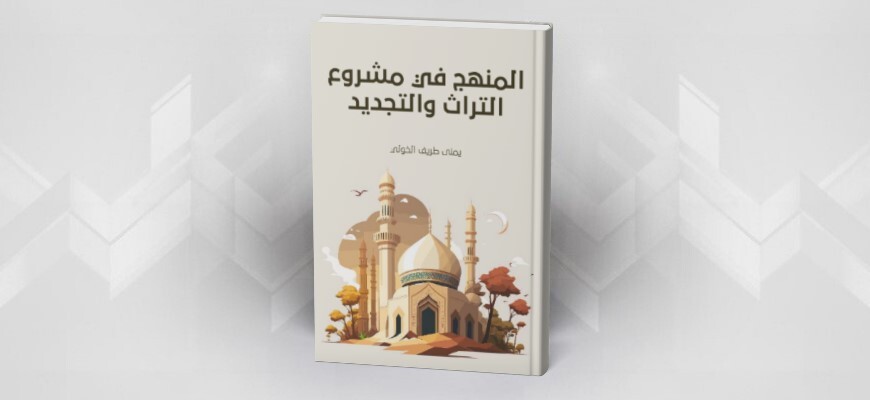
المنهج في مشروع التراث والتجديد
يمنى طريف الخولي
فكرة الكتاب
شغل المفكر المصري حسن حنفي (-2021م) جمهورا واسعا من القراء بأسئلة التجديد والتنوير، وبجهده الجهيد طول حياته؛ أثمر مشروعا علميا؛ انصب حول بناء المنهج في مشروع التراث والتجديد، إلى جانب عشرات المشاريع التي اهتمت بسؤال المنهج في التعامل مع التراث، والتي كتبها عشرات المفكرين من أبناء جيله. تميزت شخصية حسن حنفي بالهدوء والحكمة وبعد النظر؛ وقد ظل وفيا لصوت العقل والحكمة؛ لا تؤثر فيه شعارات الجماهير وعواطفها المتدفقة وهي تسفق وترفع أصواتها عاليا في نوادي وساحات الخطابة الفارغة باسم الزعيم؛ الزعيم هنا باسم السياسة أو باسم الدين أو باسم القوم؛ فحسن حنفي لا يرغب في أن يكون زعيما، بقدر ما سعى ليكون منارة لصوت العقل والفكر في العالم وقد تحقق له ذلك؛ فالرجل كان من بين أهم أعمدة الدرس الفلسفي في العالم العربي وقد ملأت كتبه كل المكتبات في العالم، وأثارت جدلا فكريا كبيرا. فعلى مدار نصف قرن أو يزيد اتسع مشروع حسن حنفي في قراءته للتراث، وعلى طول هذه الفترة استقطب المشروع بأسئلته وإشكالاته الفكرية، اهتمام مراكز بحثية وجهات أكاديمية شتى في شرق العالم وغربه، من طوكيو وجامعات في اليابان حتى هاواي وجامعات في الولايات المتحدة، مرورًا بدول عربية وأوروبية، وبضع عواصم آسيوية أفريقية.[1]
كثيرة هي الدراسات والأبحاث ورسائل الدكتوراه التي انصبت على نقد وتحليل مشروع حسن حنفي، فالكتاب الذي نحن بين يديه من بين الحزمة الكبيرة من الأبحاث التي شغلت نفسها بما كتبه حسن حنفي، وهو مقاربة تحليلية ونقدية لمعالم المنهج والمنهجية في مشروع «التراث والتجديد»؛ متخذا مثالًا عينيًّا تطبيقيًّا في الاقتراب من طبيعة تشييد علم كلام جديد عند حسن حنفي، من خلال كتابه «من العقيدة إلى الثورة» 1988م، بمجلداته الخمسة الضخمة. ونظرًا لأولوية ومركزية علم الكلام الجديد، وهي مسألة راهن فيها حسن حنفي على تفريغ الأطر التراثية من مضامينها وإعادة ملئها بمضمون معاصر، وهذه مسألة منهجية تلقي الضوء عن معالم المنهجية في مشروع «التراث والتجديد» بأَسره، والأبعاد المشكِّلة إياه.[2]
أما عن صاحبة هذا العمل، فهي الدكتورة يمنى طريف الخولي: أستاذ فلسفة العلوم ومناهج البحث، والرئيس الأسبق لقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة. ساهمت في إثراء الحركة الفكرية العربية بجهدها المتميز لنشر الثقافة العلمية ومنطق التفكير العلمي، وتفعيلِهما وتوطينهما في الثقافة العربية.
موضوعات الكتاب
يضعنا الكتاب أمام مقاربة تحليلية ونقدية لمعالم المنهج والمنهجية لجزء كبير من كتابات حسن حنفي، وترى المؤلفة بأن المرتكَز المنهجي لمشروع حنفي هو الوحي القرآني كفِعل توحيدٍ فذٍّ مثَّل نقطة تحوُّل متفردة، تجعل العلاقة مع الوحي محور التقابل بين الأنا والآخر الغربي. وهو مشروع يعتمد على فينومينولوجيا التفاعل بين الوحي والواقع، ليصل إلى هدف استراتيجي هو أنسنة علم الكلام الجديد. ولبلوغ هذا الهدف، حضر المنهج الجدلي مصحوبًا بقيم اليسار، والاستفادة القصوى من مناهج التأويل الخصبة الكامنة في هيرمنيوطيقا النصوص. الكتاب غطى مجموعة من المواضيع نذكر منها: الوحي والواقع. أنسَنة الكلام. اغتراب أم تغرُّب. الدين: الظاهرة والشعور. فلسفة التأويل. علم الكلام لاهوت التحرير. صراع الفينومينولوجيا والإبستمولوجيا. بتمعننا في مجمل هذه الموضوعات التي توقف عندها الكتاب، سنجدها كلها مستلة من مجمل المصطلحات التي اعتمدها حسن حنفي النقد التحليل والتركيب.
المحاور السبعة في فكر حسن حنفي
ترى يمنى طريف الخولي، أن المشروع الفكري لحسن حنفي يتلخص عبر بناء تراثنا القديم بهدف تحويل العلوم العقلية القديمة إلى علوم إنسانية بدايتها الوحي وغايتها الأيديولوجيا. فالأيديولوجيا عند حنفي علمٌ عملي ونظري على السواء. والوحي علم المبادئ العامة التي يمكنها تأسيس العلم ذاته، والتي هي في الوقت نفسه قوانين التاريخ وحركة المجتمعات، فالوحي هو منطق الوجود المميز لحضارتنا، ومهمتنا تحويله إلى علم شامل/أيديولوجية شاملة، فيتحول إلى حضارة لها بناؤها الإنساني المطابق لحاجات العصر. أوَلمْ يتحول الوحي منذ هبوطه إلى حضارة ارتدت إلى علوم مثالية، نقلية ونقليةٍ عقلية وعقلية؟
لم تكن الحضارة الإسلامية إلا محاولة لمَنْهجة وعَقْلنة الوحي، لكن في ظروف تاريخية مختلفة، علينا إذن مَنْهجته، وعَقْلنته مجددًا؛ أي إعادة بناء تراثنا طبقًا لظروف واقعنا، كالآتي: (1) علم الكلام، بالانتقال «من العقيدة إلى الثورة»، وصياغة لاهوت الثورة. (2) الفلسفة أو علوم الحكمة، إعادة بنائها للوقوف على شروط الإبداع، والانتقال من «النقل إلى الإبداع». (3) التصوف، للانتقال «من الفناء إلى البقاء»، أو من إنكار الذات إلى تأكيدها؛ وذلك بتحويل قِيَمه السلبية، كالرضا والزهد والصبر والتوكل والقناعة، إلى قيم إيجابية فعالة، كالرفض والثورة والتمرد والاعتراض. (4) إعادة بناء علم أصول الفقه بإعطاء الأولوية للواقع على النص، وللمصلحة على الحرف؛ وذلك بالانتقال من «النص إلى الواقع». (5) إعادة بناء العلوم النقلية، وهي القرآن والحديث والتفسير والسيرة، هذه العلوم هي التي تتوغَّل في أعماق الجماهير، وبإعادة بنائها تنتقل «من النقل إلى العقل». (6) العلوم العقلية؛ أي العلوم الرياضية والطبيعية، مطلوب إعادة بنائها لتبيان كيفية خروجها من الوحي، تأكيدًا على وحدة الوحي والعقل والطبيعة؛ وذلك في «العقل والطبيعة». (7) محاولة إعادة بناء العلوم الإنسانية كاللغة والأدب والتاريخ والجغرافيا للوقوف على «الإنسان والتاريخ».[3]
إعادة بناء التراث بخطوطه السبعة يصب في دائرة بناء الذات وبناء الوعي بالماضي بشكل معرفي ونقدي يحضر معه النقد والتحليل بدل الاتباع والتقليد، وهو وضع تجد فيه الذات نفسها قادرة من تحديد الموقف من الغرب في «علم الاستغراب» الذي يهدف إلى فهم الآخر/الغرب في إطاره وتطوره التاريخي، ليغدو مجرد موضوع دراسة، وليس نقطة إحالة … رد مشروعه الثقافي إلى حدوده التاريخية والجغرافية، تمهيدًا للقضاء على خرافة الثقافة العالمية، التي جعل الغرب نفسه مركزًا لها، وفي هذا السياق يأتي موضوع النهضة العربية.
انتقادات
من البديهي أن كل المشروعات لا تعلو فوق النقد، ومن غير العلمي أن يدعي شخص ما بأن كل كتاباته مكتملة، ومنتهية إلى درجة أعلى؛ من جهة القيمة العلمية، ووفق هذه القاعدة نجد جل المؤلفين في حياتهم يدركون أن كل ما كتبوا ما هو إلا مساهمة في حلقة كبيرة من التفكير، وعيًا منهم بكون أفكارهم وطروحاتهم محكومة بالزمن والمحيط الثقافي الذي عاشوه، وقد يبادر الكثير منهم إلى نقد وتحليل كل ما كتب، أو يدعو المهتمين ليقموا بذلك. لكن أحيانا نجد فئة من التلاميذ والأتباع والمعجبين بهذا المفكر أو ذاك، يطرحون مسألة النقد جانبا ويتعاملوا مع نصوص مفكريهم بنوع من الإعجاب الذي يفقد النقد والوعي الذي يقتضي المراجعة، حينها تتحول مشروعات وكتابات المفكرين الذي تجمعوا حولهم إلى أيديولوجية مغلقة لا تقبل النقد.
من بين ما ينتقد في مشروع حسن نفي:
- التناقضات الطاغية في كتاباته، وهي تناقضات حاول أن يستوعبها ويؤطرها في سياق جدلي، المشكلة هنا أن هذا الإطار الجدلي يحتاج استكشافه إلى معايشة عميقة ومثابرة دؤوبة مرهقة لكنها مثمرة حقًّا.
- لإطناب الشديد في كتابات حنفي يُحدث في ذهن القارئ شيئًا من التشتت وعدم وضوح المعنى، فالإطناب يبدو متعمدا ومقصودا أحيانا، فبسببه تتداخل الخطوط وتتضارب ويكون الابتعاد عن الغاية المنشودة. لا سيما وأن حنفي يبدو كأنه لا يفكر فيما يكتب بقدر ما يكتب فيما يفكر، وهو يسابق الزمن من أجل إنجاز أو تنفيذ مشروعه الضخم.
- الإسقاطات الإيديولوجية واضحة في مختلف كتابات حنفي، فهو يجمع ما بين إيديولوجية اليسار وأيديولوجية الإسلاميين والعروبيين والعلمانيين...إلى درجة أن هناك من رأى في حنفي رائد مشروع اليسار الإسلامي. فالتعدد الأيديولوجي جعل من مشروع حنفي غير واضح المنهج، وغير حاسم في الرؤى المعرفية في التعاطي مع فهم الذات والآخر.
[1] يمنى طريف الخولي، المنهج في مشروع التراث والتجديد، مؤسسة هنداوي، 2024م، ص.8
[2] نفسه، ص.8
[3] نفسه، ص. 12