زيف العلوم
فئة : مقالات
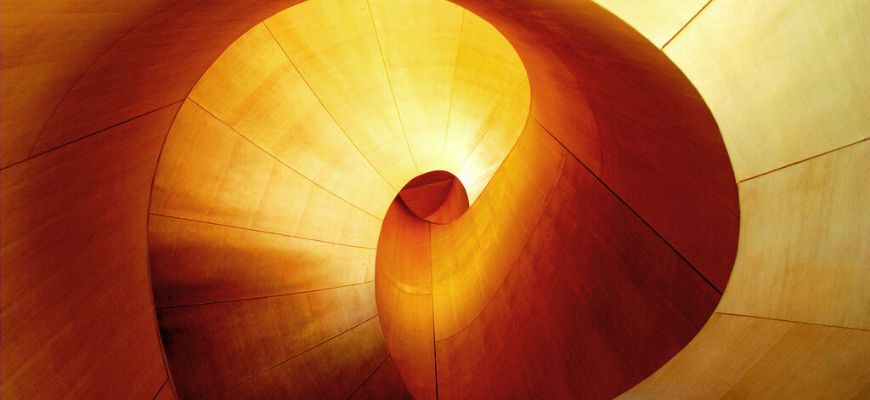
زيف العلوم
من مواصفات العقل النقدي أنّه يمتلك القدرة على النظر إلى القضايا والأشياء كما هي، لا كما يتخيّلها ويتصوّرها الناس، فضلًا عن الاقتراب أكثر من المحيط والسياق الذي يحيط بمختلف تلك القضايا والأشياء. وهي مسألة تمكّنه، في أغلب الأحيان، من التمييز بين ما يُعدّ معرفة واقعية وحقيقة، وبين مختلف التصوّرات والآراء الزائفة؛ إما لأنها تصوّرات وآراء ترتبط بالتاريخ وبمرحلة معينة من فكر الإنسان ومعرفته قد تمّ تجاوزها، وإما لأنها تتعارض كليًّا مع الواقع الموضوعي. فالمقابل للعلم الزائف هو العلم الحقيقي، وليس بالضرورة أن يبقى العلم الذي نراه حقيقيًّا ثابتًا، فقد يلحق بعضَ معارفه نوعٌ من الزيف والتجاوز.
نقول: أعطاه نقودًا زائفة؛ بمعنى أنها غير قابلة للتداول؛ فوجودها لا يفيد في شراء مختلف الضروريات والكماليات؛ لأن طبيعتها الزائفة جعلت وجودها وعدمه على درجة واحدة.
يرتبط زيف العملات والنقود، في جزء كبير منه، بطبيعة الاعتراف بها وجدواها وفائدتها. وللزمن دور مهم في تحديد هذا الأمر؛ إذ لا يُعقَل أن يقبل أحدٌ عملة ضُرِبَت في زمن بعيد لا أحد يعرف عنه اليوم شيئًا. وحتى إن حدث ذلك، فهو يحدث من زاوية وقيمة العملة المتداولة والمعترف بها.
فما يجري على العملة ينطبق، بدرجة معينة، على العلم؛ فالعلم يتحوّل ويتطوّر من زمن إلى آخر، كما هي العملات. فلا يُعقَل أن نتعاطى اليوم مع مجال الطب وفق ما كان عليه علم الطب في القرن العاشر الميلادي، رغم أهمية ما كان عليه علم الطب حينها. فمن يملك المعرفة الطبية لذلك الزمن لا يملك "العلم"، بل يملك "تاريخ ذلك العلم"، ولا يحق له أن يفتح عيادة بناءً على ما يملك من معارف تعود إلى القرن العاشر. وإن رغب في ذلك، عليه أن يقيس ما بحوزته من تلك المعارف على مقياس ما عليه المعرفة المعاصرة اليوم.
ماذا يعني هذا؟
يعني أن العلم، مع صيرورة الزمن، في بعض جوانبه، قد تَصدُق عليه صفة الزيف. فالزمن يخلف وراءه ما يمكن أن نسمّيه اليوم "العلوم الزائفة" غير القابلة للتداول من جهة الثقة في نتائجها والعمل بها.
في هذا السياق، نستحضر مقولة غاستون باشلار: "تاريخ العلم هو تاريخ أخطاء العلم."
فالعلم لا يُخطئ ولا يُصيب؛ هو طريق الإنسان للفهم، والطريق الطويل لا يُعرَف منتهاه من أوله. فعادةً، ما يُصنِّف الناس نظريةً معيّنة كعلمٍ زائف، لا بناءً على ماهيتها، بل استنادًا إلى الحقبة الزمنية التي ارتبطت بها.
المعرفة العلمية ليست مخزنًا ثابتًا من المعلومات، كما لو كانت مجموعةً من الكتب علاها التراب، تملأ حائطًا من أرفف الكتب في مكتبة مدينتك المحليّة.
على النقيض من ذلك، فإنّ واحدة من أبرز خصائص العلم هي ديناميّته الهائلة، ويُوَجَّه جزءٌ كبير من هذه الطاقة إلى دحض أو مراجعة المعارف السابقة، وهذه السِّمة هي ما ألهم كارل بوبر لوضع معيار التمييز. لا يوجد فَهم منطقي للعلم لا يعترف بهذه الخاصية التطورية، بل الثورية، لما يُعَد معرفة علمية.
يعني التطوّر العلمي أن الأمور التي كنّا نعتقد في الماضي أنها صحيحة، يتبيَّن بعد ذلك أنها مبسّطة للغاية، أو غير متطوّرة بما يكفي، أو خاطئة تمامًا، بعدما يجمع الباحثون اللاحقون أدلّة جديدة ويُعمّقون من تحليلاتهم.
وينطبق الأمر نفسه على أبحاث العصر الحالي: لقد نُشر الكثير منها على أنها أحدث ما توصّل إليه العلم، ولكن سيتبيَّن في المستقبل غير البعيد جدًّا أنها غير ذات صلة أو خاطئة.
نمثل لذلك بمثالين:
كان بلوتو يُصنَّف على أنه كوكب عندما اكتُشف في عام 1930، ولكن في الرابع والعشرين من أغسطس عام 2006، أعاد الاتحاد الفلكي الدولي تصنيفه على أنه «كوكب قزم»، الأمر الذي أدّى إلى انتهاء كواكب المجموعة الشمسية الرسمية بكوكب نبتون.
وكان علماء الحفريات يعتقدون أن الديناصورات زواحف تكسوها حراشف، ولكن كشفت تقنيات جديدة أن كثيرًا من هذه المخلوقات المنقرضة كانت أجسادها مكسوّة بالريش، وهو ما كان ينبئ عن تطورها لتصبح طيور العصر الحالي.
كلتا الفكرتين الجديدتين صدمتا أولئك الذين نشأوا على أنّ بلوتو كوكب، وأن الديناصورات عارية الأجساد، فكان هذا ما تعلّموه في حصص العلوم في المرحلة الابتدائية.
ألم تكن هذه المعرفة موثوقة إذن؟
لكن من الخطأ أن ننظر إلى العلوم على أنها ثابتة؛ فلا يمثّل التغيّر الدائم مشكلة فيما يتعلّق بكيفية عمل العلوم، فهذه هي الطريقة الطبيعية لعمل العلوم"[1]
لكن هل المسألة هنا تتعلق بالقطيعة الكاملة بمختلف العلوم التي لم تعد صالحة للاستعمال من جانب ما يترتب عنها من نتائج؟ إذ حلت محلها علوم أخرى توفي بالغرض وتتوافق مع طبيعة الوضع الحضاري الذي نحن فيه اليوم الجواب لا يتعلق بالقطيعة بقدر ما يرتبط بالتصنيف المنهجي لموضوع التمييز ما بين العلوم الزائفة المتجاوزة اليوم، ومختلف العلوم المفيدة في الزمن الحاضر، والتي سيدخل بعض منها، أو بعض من نتائجها فيما هو قادم إلى دائرة ما هو زائف، فما هو زائف علميا ليس بالضرورة أنه خاطئ وغير صحيح، بقدر ما هو جزء من تاريخ العلم.
في هذا السياق، يقول مايكل دي جوردين: "في واقع الأمر، لطالما جابهتنا مشكلة التمييز منذ أن بدأت المجالات المعرفية عن العالم الطبيعي تدَّعي الموثوقية. من بين أقدم النصوص الطبية في التراث الغربي النص الأبُقراطي، الذي يعود للقرن الخامس قبل الميلاد بعنوان «حول المرض المقدس»، والذي يُعد في الأساس وثيقةَ تمييز تتحدث عن كيفية فَهم وعلاج ما نُطلق عليه حاليًّا مرض الصرع. في هذا النص، يهاجم المؤلف - الذي يُطلق عليه عادة اسم «أبقراط»، رغم أنه من المرجح أن النص قد ألَّفه العديد من المؤلفين على مدى فترة زمنية طويلة - «نوعية الناس الذين نطلق عليهم الآن اسم المعالجين بالسحر، والمعالجين بالإيمان، وممارسي الدجل الطبي، والمشعوذين». ويطرح أبقراط نظريته الخاصة عن مسبِّبات الصرع، ويشرح سبب عدم أحقية أي معالج بالإيمان لقبَ طبيب. يتطلب ضمنيًّا انتزاع السلطة العلمية في كل مرة إقصاء الخصوم عنها. الصيغة الأساسية لمشكلة التمييز هي: كيف يمكن التفرقة بين العلم والعلم الزائف؟ ولكن، في واقع الأمر، ثمة الكثير من مشكلات التمييز. السؤال الأساسي للأبستمولوجيا هو: كيف يمكن تنقية المعرفة الصحيحة من المزاعم الخاطئة؟ بالإضافة إلى ذلك، قد ترغب أيضًا في تمييز العلوم على كل هذه المجالات (تاريخ الفن، وعلم اللاهوت، والبستنة) «اللاعلمية»، أو تلك المجالات التي قد تشبه العلوم كثيرًا، ولكنها لسببٍ ما لا ترقى إلى مرتبة العلوم. تلك المجموعة الأخيرة، المدَّعون، هي التي تُصنَّف على أنها «علوم زائفة». يجب أن يكون أي معيار تمييز يستحق هذه التسمية قادرًا على تمييز العلوم عنها."[2] ومصطلح «مشكلة التمييز» تعود صياغته إلى الفيلسوف كارل بوبر، ولا يزال معيار التمييز الذي ابتكره هو المعيار الأكثر شيوعًا بين العلماء، والفلاسفة، والطلبة الجامعيين الذين يملكون آراءً حول هذا الموضوع.[3]
في الحقيقة هناك مفهوم شائك وملتبس لمفهوم العلم الزائف والمقابل للعلم الزائف هو العلم الحقيقي؛ إذ يبقى التحدي هو رسم الخطوط الفاصلة بين العلم الزائف والعلم الحقيقي؛ لأن كثيرًا من المعارف والعلوم أحيانا قد تتحول إلى علوم زائفة نتيجة تطور العلم، ومن الصعب أن نصف علما من العلوم بكونه علما زائفا نتيجة تجاوز مضامينه، لماذا؟ لأن العلوم يصب بعضها في بعض، ولا حدود بينها، فضلا عن أن مختلف الكثير المعارف والعلوم قد خرجت من صلب العلوم والمعارف التي أصبحت اليوم زائفة، مثلا: هناك تأثير معين لعلم التنجيم على علم الفلك، على الرغم من رفض التنجيم كعلم في نهاية المطاف، وبالتالي "لا يتصدى أغلب العلماء بشكلٍ نشِط للمذاهب التي يصمونها بأنها «علوم زائفة». يمكنهم أن يذكروا بعض المذاهب التي لها صلة بمجال خبرتهم بالطبع، ولكن من النادر أن يحمِّل شخص نفسه عبء شن حملة للهجوم على المذاهب المؤذية ومن يمارسونها. وحتى أولئك الذين يعدهم العلماء «مهووسين» عادة ما يكونون «مهووسين غير مؤذيين»، ولا يستحقون إضاعة الوقت عليهم، كما أنهم لا يسببون أذًى كبيرًا.
في المسار المعتاد للأمور، ينظر الناس إلى العلوم الزائفة على أنها معتقدات ضالة، لكنها غير مزعجة كثيرًا، وهذا هو السبب في عدم شغل تفكيرهم بها كثيرًا. ولكن ليست جميع المذاهب غير ضارة. يجدر بنا في هذا السياق، ذِكر مجموعة من المذاهب وثيقة الصلة بالأنظمة السياسية القمعية، مثل ألمانيا النازية، وفترة حكم ستالين للاتحاد السوفييتي. يمكن أن نقول عن هذه المذاهب إنها «مفرطة التسييس». وعندما تفككت الأنظمة التي تدعمها، اختفى أنصارها من الساحة على نحوٍ كبير".[4]
[1] مايكل دي جوردين، العلوم الزائفة: مقدمة قصيرة جدًّا، ترجمة أحمد عبد المنعم مراجعة مصطفى محمد فؤاد، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ط.1، 2025م، ص.23
[2] نفسه، ص.9
[3] نفسه، ص.9
[4] نفسه، ص. 37
