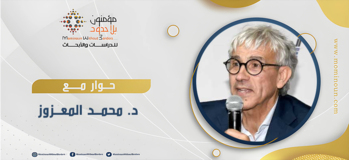في ماهية الاستطيقا والفن والعمل الفني
فئة : مقالات

في ماهية الاستطيقا والفن والعمل الفني
ما من شك أنَ الاستطيقا (Esthétique) هي بمثابة حقل فلسفي وعلمي في غاية الأهمية. فهي موضوع يجابهنا بأسئلة فلسفية وعلمية عميقة ومتنوعة، وذات أبعاد معرفية ووجودية وأخلاقية وجمالية. إنها حقل يحيل في ارتباطه بالفن والعمل الفني، على علم الجمال وفلسفة الفن اللَذيْن يشار إليهما عادة باسم الجماليات. لذلك، سنبحث في كل ما من شأنه أن يمكننا من معرفة دلالة ومعنى الاستطيقا على وجه الدقة، لنعمل من ثم على تحديد حقلها وموضوعها وظروف نشأتها وتطورها. فنسلط بذلك الضوء على تاريخ هذا الحقل الفلسفي وعلى هذا التخصص العلمي الذي يشار إليه باسم الجماليات، لنعرِّف به ونبرز أصوله وفصوله، قضاياه، تاريخه، اشكالاته ومفاهيمه.
لنحاول إذن مقاربة مفهوم كل من الاستطيقا والفن والعمل الفني، بهدف وضع تعريف لكل مفهوم على حدة، مع العلم أن كل مفهوم من هذه المفاهيم لا يفصح بحقّ عن مكنونه، إلا في علاقته بمفاهيم أخرى من قبيل الجمال والجميل والفكر والحقيقة وأحكام الذوق والوجدان والأحاسيس والتجارب الباطنية والمتعالية التي من خلالها يعيش الإنسان الحياة ويدرك الوجود، لنقف من ثم على دور هذه الأنشطة الإبداعية في الحياة الإنسانية فكرا وممارسة، ونحدد قيمتها المعرفية والأخلاقية انطلاقا من وظائفها الاجتماعية واسهاماتها الإبستيمولوجية وأصولها الأنطولوجية، واضعين نصب أعيننا الإجابة عن الأسئلة الأساسية التالية: ماهي الاستطيقا؟ ما هو الفن؟ وما هو العمل الفني؟
1) تعريف الإستطيقا
لقد تمتْ ترجمة مصطلح الاستطيقا إلى اللغة العربية بمفهوم الجماليات الذي صار يحمل كلَّ ما يتضمنه المفهوم الأصلي من معاني ودلالات؛ فهو ترجمة حرفية له. وعليه، فإن تعريف مفهوم الجماليات، يتوقف على تحديد معنى ودلالة مفهوم الاستطيقا الذي غالبا ما يأتي ذكره بطريقة منقْحرَة؛ أي بشكل يحافظ على بنيته الصوتية الأصلية. فما هي هذه الدلالة؟
لعله من الشائع أنها تدل على كل ما هو جمالي وفني، أي على كل ما يتعلق بالجميل من حيث هو شعور واحساس وذوق وحكم قيمة تختصّ به أحاسيسنا وشعورنا بالرضى والاعجاب والانبهار والسعادة والامتلاء والشوق...أو العكس؛ فهل هذه هي الدلالة التي حملها المفهوم حينما ظهر لأول مرة؟ لننظر إذن في تاريخ المفهوم لنرى متى ظهر وكيف؟ وما هي الأسباب والغايات التي كانت سببا في ظهوره؟
ما من شك أنّ الاستطيقا قد ظهرت لأول مرة في منتصف القرن 18م للدلالة على نظرية الفن والجميل؛ أي على ذلك التخصص المعرفي ذي الطابع الفلسفي والأدبي والفني، الذي يتخذ من أحكام القيمة الصادرة عن ملكة الذوق والمتعلقة بالجميل والقبيح موضوعا له؛ أي إن كلمة "استطيقا" قد استعملت كمفهوم للدلالة على ذلك التخصص الفلسفي الذي يعالج الفن. فهل يمكن القول من هذه الناحية إن الاستطيقا هي فلسفة الفن؟
إنّ أول من استخدم هذا المصطلح هو الفيلسوف الألماني بومجارتن (Alexandre Gottlieb Baumgarten 1714-176م)، الذي تبنى الكلمة الإغريقية ("إستيسيس" (aisthêsis)) الدالة على الإدراك والحس، ليعبِّر من خلالها عما اعتبره هو علم الإدراك الحسي؛ وقد ورد تعريفه للاستطيقا بهذا المعنى في الكتاب الذي خصه للتعريف بهذا العلم[1]. أما المصدر الذي استلهم منه هذا المصطلح، فهو ذلك "التقليد الفلسفي القديم، سواء عند فلاسفة الاغريق أو أباء الكنيسة، الذي كان يميّز بين العالم المحسوس والعالم المعقول؛ أي بين المدركات الاستطيقية بما هي مدركات حسية، وبين المدركات العقلية بما هي تعينات مجردة، على نحو ما سيعمق كنط ذلك، من خلال تمييزه بين عالم الظواهر الحسية وعالم الجواهر العقلية كالشيء في ذاته"[2]. على هذا الأساس، يمكن القول إن مفهوم الاستطيقا، قد استعمل للدلالة على ذلك التخصص العلمي الذي يهتم بدراسة عالم الظواهر المحسوسة؛ أي تلك التي تهتم بموضوعات الحس. وبما أن الفن هو أكثر الممارسات الانسانية ارتباطا بهذه الموضوعات، فقد أصبحت دراسة الفنون من مهام الاستطيقا أيضا. هكذا أصبحنا نطلق مصطلح الاستطيقا على "فلسفة الفن"، تماما كقولنا إن "الإيتيقا هي فلسفة الأخلاق"[3]؛ وهذا هو المعنى الذي صار متداولا في مختلف المعاجم اللغوية والفلسفية كما يجمع على ذلك مختلف الدارسين، وهو ما تلخصه كارول تالون-هيغون (Carole Taton-Hugon) بقولها: "لقد عرًف للاند الاستطيقا في المعجم التاريخي والنقدي للفلسفة، الصادر سنة 1980، بوصفها هي ذلك العلم الذي يتخذ من أحكام القيمة التي نميز بموجبها بين الجميل والقبيح موضوعا له؛ بيد أن معجم مصطلحات الجماليات، الصادر سنة 1990، اعتبرها هي فلسفة الفن وعلمه؛ بينما أجمع كل من تاريخ الفكر الفلسفي الصادر سنة، 1971 والموسوعة الفلسفية الصادرة سنة 1967، والموسوعة الأكاديمية الأمريكية الصادرة سنة 1993، على تعريفها بوصفها هي ذلك المسلك الفلسفي الذي يهتم بالفنون وبالجمال؛ والحال أن هذا التضارب في التعاريف، نلمسه حتى لدى الفلاسفة أنفسهم؛ فقد عرفها بومجارتن في كتابه التأملات الصادر سنة 1735، بكونها هي العلم بنمط المعرفة الحسية بالموضوع، بينما عرفها هيجل Hegel في كتابه دروس في علم الجمال (1818-1930)، بوصفها هي فلسفة الفن. ويزداد هذا الغموض إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، المعنى الذي يجتره أصل الكلمة نفسها؛ فـ "استطيقا" مشتقة من الكلمة اليونانية "إستيسيس" (aisthêsis) التي تدل على كل من ملكة وفعل الادراك الحسي في الوقت نفسه (الإحساس والإدراك)؛ ويبدو أن هذا الاشتقاق، يستدعي الجماليات، لتكون هي دراسة الأفعال أو الحدوس الحسية بالمعنى الواسع للكمة؛ أي المحسوسات (Les aisthêta) في مقابل الأفعال أو الحدوس العقلية (Les noéta)"[4].
إن الاستطيقا إذنْ وبالنظر إلى أصلها، هي دراسة العالم المحسوس أو الظواهر الحسية، انطلاقا من الذات المدركة لهذه الظواهر، لمعرفة طبيعة ما تخلِّفه فيها من إحساسات؛ وهذا ما يسمّى بـ "الموقف الاستطيقي" الذي يحدد طريقة خاصة ومعينة في الإدراك، أو انطلاقا من الموضوع الحسي الذي يولِّد مثل هذه الأحاسيس والانطباعات. لهذا السبب، نجد بومجارتن يعرفها انطلاقا من موضوعها هذا قائلا: "إن موضوع الاستطيقا من حيث هي نظرية في الفن، هو فن الإدراك الحسي؛ فهي تعلّمنا القواعد التي تحوّل الإدراك الحسي إلى جمال في حقل الممارسة الفنية، حيث تنمو ملكة الإحساس وتتحسن؛ ذلك أن الأعمال الفنية التي هي المجال الأمثل لكل من الجمال والحقيقة، حيث تبلغ الأحاسيس (الحساسية) أوجها وكمالها، هي بمثابة الإدراكات الحسية الأكر جمالا وواقعية وحقيقة"[5]. وهذا ما عبر عنه هيجل أيضا بقوله: "إن الفن هو العرض الفني للجميل، والجميل هو التجلي المحسوس للحقيقة"[6]، جاعلا بذلك من الفن والجميل والحقيقة شيئا واحدًا، على أساس أن الجميل هو التجلي المحسوس للفكرة، أو بالأحرى، هو "الظهور الخالص للفكرة أمام الإحساس" على حد تعبيره، وأن الجمال من حيث هو الفكرة وقد تـم الإمساك بها فنيا، "هو ما يجب بالتحديد أن يكون حقيقيا في ذاته"[7]؛ وليس مستبعدًا أن يكون هيجل قد استلهم تصوره هذا، رغم انتمائه الأصيل لفلسفته ولأطروحات جمالياته، من استطيقا بومجارتن نفسه، الذي ذهب قبله إلى حد القول: "إن القيمة المعرفية للجمال، تكمن في كونه إحدى الخصائص الممكنة لتجلي الموضوعات حسيا، وأنه شكل من أشكال الحقيقة، إن لم نقل بأنه هو الحقيقة ذاتها، من حيث هي محسوسة، وبالتالي فهو الموضوع المفضَّل للمعرفة بالمحسوس."[8]
لقد ازدادت أهمية الاستطيقا بازدياد أهمية التجربة الحسية، لا سيما عندما بدأ الاهتمام بملكة الذوق كمفهوم جديد، يفرض نفسه أكثر فأكثر، كما حصل مع كنط بالخصوص؛ ناهيك عن معظم فلاسفة القرن 18م الذين أرادوا من خلال توظيفهم لهذا المفهوم، إثارة الانتباه إلى ردود أفعال الإنسان تجاه الجمال والخصائص الجمالية والاستطيقية وأنماط تجاربه الحسية. هكذا أصبحت ملكة الذوق هي ملكة الحكم في التجربة الجمالية؛ فهي أيضا شأنها شأن الفن، عبارة عن حس مرهف وعن حدس مباشر بعيد عن المنفعة وعن الحاجات اليومية والظرفية. من هنا مصدر الفكرة القائلة إن التجربة الجمالية هي تجربة تعاش لذاتها بوصفها غاية في حد ذاتها، كما سنرى فيما بعد مع كل من كانط وهيجل بشكل خاص[9].
لقد تطورت الاستطيقا إذن كتقليد فلسفي، انطلاقا من اهتمام الفلاسفة منذ القديم بمفهوم الجميل، علما أن الجمال هو خاصية توجد في الفن وفي الطبيعة على حد سواء؛ الشيء الذي يعني أن مجال الاستطيقا واسع، ولا ينحصر فقط في دراسة الظواهر الفنية، ما دام أن الجمال ليس حكرا على الفن وحده؛ وقد ترتب عن هذا اللبس أن تمّ حصر الإستطيقا في فلسفة الفن بصفة خاصة، فتم بذلك الخلط بينهما وبين فلسفة الفن. والحال أن مجال الاستطيقا يمتد ليشمل ثلاثة أبعاد أساسية هي 1) الفن والعمل الفني، 2) الجمال والجميل، 3) التجربة الوجودية للإنسان في علاقتها بالفن والجمال؛ فالاستطيقا من حيث هي فلسفة الفن، تبحث في ماهية الفن والعمل الفني؛ وذلك انطلاقا من فرضية أساسية مفادها أن "الفن مجال لتجلي الحقيقة، وليس مجرد بهرجة، وأنه غير قابل للاختزال، وأن الفكرة التي يجليها الجميل ليست كونية بل متفردة، حيث إن الفن يجب النظر إليه بوصفه عرضا لحقيقة لا يمكن لها بتاتا أن تعرَض أو تترجَم في خطاب آخر خارج أو أسمى من الخطاب الفني"[10]. أما من حيث هي علم الجمال، فتبحث في ماهية الجمال والجميل في علاقتهما بالتجربة الوجودية المتعالية للإنسان بوصفها تجربة أساسها الذوق والاحساس والحدس العقلي والحسي. لهذا السبب، فهي تطرح أسئلة حول ماهية الفن والعمل الفني وحول قيمتهما ودورهما في التعبير عن ماهية الحقيقة وعن حقائق الوجدان والوجود، ومن ثم عن منزلة الفن ودور العمل الفني في المعرفة الإنسانية بوجه عام[11]. فما هو الفن إذن؟ وما هو العمل الفني؟ ما هو الجمال وما الجميل؟ ما قيمة الفن؟ وما دوره في بناء تجربة الإنسان في الحياة وفي الوجود؟ ما منزلته في الفلسفة؟ وما مدى قدرته على بلوغ الحقيقة وتبليغها كشكل من أشكال التعبير؟
2) في ماهية الفن والعمل الفني
ما من شك أن الفن يحيل على ممارسة إنسانية توصف بكونها خلقا وإبداعا، وهي تجربة ضاربة بجذورها في باطن النفس الإنسانية، وفي ماهية الحقيقة التي هي عين تلك التجربة الوجودية بالذات. إلا أن الفن يظل مع ذلك فعلا لا يفصح عن نفسه إلا مجسدًا في أشكال فنية، نصطلح عليها بالعمل الفني (Œuvre d’art). هذا الأخير لا يخلو بدوره من ازدواجية: فهو يرتبط من جهة بالحدس، لكونه لا يحيل مباشرة على الشخص الذي أنجزه، ولا على ظروف وتاريخ إنجازه، بقدر ما يحيل على قيمته ودلالته ومعناه وعلى ما يصلح له؛ ذلك أن ما يمجده العمل الفني ويحيل عليه كما يقول موريس بلانشو: "إنما هو العمل الفني نفسه والفن الذي تجمّع وتجسّد فيه"[12]. إلا أن هذا الطابع الرمزي والمثالي والدلالي للعمل الفني، لا يحول مع ذلك دون القول إنه مرتبط بالحواس، خاصة حاستي السمع والبصر؛ لأن الفن يتخذ بالضرورة من العمل الفني شكلا ماديا ليتجسد حسيا. بمعنى آخر، إن الفن "لا يتحقق إلا في العمل الفني الذي بواسطته يتجسد في العالم، مثلما يتجسد الشخص الإنساني في الجسد"[13]. إن ماهية العمل الفني وهويته إذن، "ترتبط دائما بهوية وماهية الموضوع الفزيائي الذي يجسده"[14]. هذه العلاقة الوطيدة بين الفن والعمل الفني، لا تحول دون تمايزهما واختلافهما؛ إذ لا يكون هناك وصل، إلا بقدر ما يكون هناك فصل. وهذه هي الحقيقة التي عبّر عنها هيدغر في مقالته: أصل العمل الفني، بقوله: "إن التجربة الجمالية (الإستطيقية) لا يمكنها أن تنفي الشيئة عن العمل الفني، كالحجر في التمثال والخشب في النقش على الخشب، والألوان في اللوحة، والصوت والإيقاع في الشعر والموسيقى...إلا أن الفن يظل مع ذلك، شيئا آخر يعلو على هذه الشيئية التي يبدعها الفنان بفضل مهنته.... إنه شيء آخر ليس أبدا، ولا يمكنه بتاتا أن يكون بمثابة شيء. إنه رمز وتجميع".[15]
هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى، فإن الفن ظاهرة تتجاوز نطاق الاعمال الفنية؛ فأن تكون فنانا، ليس معناه أن تعمل على إبداع أو صنع شيء ما، وإنما أن "تنخرط في مشروع ثقافي يسهر على اقتراح أعمال فنية وتثمينها"[16]. إلا أن ثمة سياقات ثقافية واجتماعية هي التي تحدَّد ما هو الفن وما هو العمل الفني الذي ينبغي أن ينتمي إليه؛ كما أن هذه السياقات هي التي يستمد منها دلالاته ومعانيه، لاسيما أن الفن في عالمنا المعاصر، قد أصبح أوسع من مجال الخلق والإبداع، إلى درجة أن "كل مزحة عن الفن يمكنها أن تتحول بدورها إلى عمل فني وتصبح جزءا من الفن ذاته".[17]
إن عالم الفن يمتد ليشمل الممارسة الفنية وما تنتجه من عمل فني، ويتجاوزهما في الوقت نفسه نحو الوجود والحقيقة. لكنه يظل في جميع الحالات مرتبطا بمجموعة من النُّظُم والخلفيات المرجعية والمؤسسات التي تسمح بإضفاء طابع العمل الفني على الموضوعات التي ينبغي لها أن تنتمي إلى "عالم الفن"، كالمسرح والنحت والأدب والموسيقى إلخ. فهذه كلها تشكل نظما وانساقا ومؤسسات اجتماعية، تنضوي تحت اسم الفن كمفهوم عام، مع العلم أن هناك أنساقا لا حصر لها، وأن "كل نسق عام وشامل، يتضمن بدوره نظما أخرى إضافية، تمكنه من استقبال الأنشطة الإبداعية الأكثر جذرية وغرابة"[18]؛ إذ من الممكن أن ينضاف نسق جديد كلية إلى نسق قديم شبيه به، مثل النحت الذي يوظف المخلفات الصناعية إلى درجة أن البدع قد تتحول بدورها إلى نظام ذي سلطة خاصة، يتحدد بموجبها ما ينبغي اعتباره عملا فنيًّا أو العكس. هكذا يكون النشاط الابداعي الجذري وروح المغامرة والحيوية، شيئا ممكنا في قلب مفهوم الفن ذاته، رغم أن هذا الأخير، يظل في جميع الحالات محددا بواسطة الشروط الضرورية الكفيلة بجعله منغلقا على نفسه ومكتفيا بها.
يتحدد الفن إذن بحوامله المادية والاصطناعية وبمنزلته المؤسساتية وسياقاته الاجتماعية والثقافية. ولكن، يمكنه رغم سلطة المؤسسة التي يخضع لها وصرامة مساطرها وإجراءاتها، أن "يقبل مع ذلك، النزق والطيش والفنتازيا"[19] وكل ما هو عجائبي وغرائبي، دون أن يفقد جديته وهدفه ومسؤوليته، لكونه "يقتضي بالدرجة الأولى، القصدية الإنسانية"[20] التي لا يكون الأثر المادي المجسد للعمل الفني، سوى تعبيرا عنها، حتى وإن افتقر العمل الفني إلى الخلق والإبداع، كإقامة معرض بدون معروضات، أو عرض لوحات من إنجاز القردة؛ فالخلق والإبداع الذي يجسده مفهوم الاصطناع، صفة قد تخلع على الموضوعات الفنية في بعض الأحيان، دون أن تكون بالضرورة نتيجة المجهود الإنساني الذي انصب عليها؛ إذ يكفي أن تحظى هذه الموضوعات أو المنتوجات الفنية بالعناية والتثمين وترشَّح للتتويج، لتصبح هي نفسها أعمالا فنية، رغم أنها لم تكن من عمل الفنان المبدع، لا سيما وأن "كل ما هو مرئي أو مسموع، يمكن النظر إليه جماليا؛ أي تأمله بهدف التعرف على خصائصه الجمالية."[21]
إن الفن والحالة هذه مثله مثل الفلسفة، ظاهرة ثقافية؛ وكل عمل فني خاص يتوقف في جانب كبير منه على المؤسسة والسياق الثقافي والاجتماعي الذي ينقل رسالته ويتداولها. إلا أن الأهم في كل هذا، هو أن هذه الرسالة التي ينقلها ويتداولها اجتماعيا وثقافيا، هي بمثابة فكرة قد تم حدسها وتجسيدها فنيا بواسطة العمل الفني؛ هذه الفكرة التي أساسها الحدس، والتي هي بمثابة تجربة جمالية، هي التي لا يمكن أن يتحقق الفن بدونها، ما دام أن العمل الفني لا يتحدد بخصائصه المؤسساتية وحوامله المادية، التي تحدد ما يكونه هذا العمل الفني أو ذاك، وإنما انطلاقا من التجربة الجمالية التي هي تجربة وجودية متعالية أساسها الحرية. إن مصدر الأعمال الفنية كما يقول هيجل: "هو الفعالية الحرة للخيال الذي هو في تخيلاته أكثر حرية من الطبيعة ...وبالتالي فبالحرية وحدها يكون الفن الجميل فنا حقيقيا. وهذا وحده يحقق مهمته القصوى عندما يتموقع في المجال ذاته على غرار الدين والفلسفة، وعندما يكون ببساطة طريقا واحدا يحمِّل عقولنا ما هو (إلهي) ويعبِّر عنه، وهذا هو أعمق مصالح البشرية وأكثر الحقائق استيعابا للروح. إن الأمم قد وضعت أثرى حدوسها وأفكارها الباطنية، في الأعمال الفنية. وغالبا ما يكون الفن عند العديد من الأمم، هو المفتاح الوحيد لفهم فلسفتها ودينها. إنه يشارك في هذه الرسالة مع الدين والفلسفة، ولكن على نحو خاص، ألا وهو عرض (الأعلى/المقدس) نفسه بشكل حسي".[22]
نفهم إذن لماذا لا يكون موضوع الاستطيقا التي تعالج موضوع الفن تحت مسمى التجربة الجمالية، هو وحده موضوع تفكيرها ومجال نظرها؛ أي إنها تتجاوز الفن إلى كل ما من شأنه أن يعبر عن هذه التجربة الإنسانية، ما دام أن كل شيء يمكن النظر إليه جماليا، وما دام أن الجمال كما سبق الذكر، كيفية نعثر عليها في الفن وفي الطبيعة على حد سواء. إن هذه الازدواجية التي يتميز بها الفن كما العمل الفني، هي ما يجعل منهما وجهان لعملة واحدة، هي التجربة الجمالية التي هي تجربة وجودية إنسانية متعالية. إنها التجربة التي تعطي للعمل الفني دلالته ومعناه وتجعل منه هدفا في حد ذاته. الشيء الذي يضفي عليه طابعا روحيا يتجلى في بعده المادي. لهذا السبب اعتبر كروتشه "أن الحدس هو أساس الفن"، منكرا بذلك "أن يكون واقعة مادية"[23]. إلا أن الحدس يتصف هو أيضا بالازدواجية، بوصفه حدسا حسيا لموضوعات العالم المادي من جهة، ولكونه يتمّ انطلاقا من الذات كتجربة وجودية واعية بذاتها، ولا تنشد غير ذاتها من جهة ثانية. لذا، يصح القول "إن الحدس لا يكون إلا حدسا غنائيا"[24]؛ أي فنيا، وأن الفن واقعة روحية قبل أن يكون واقعة مادية؛ فهو "من باب النظر لا العمل، أي من قبيل التأمل؛ وبالتالي لا يمكن تصنيفه كفعل نفعي، لأن هذا الاخير يروم الحصول على اللذة وتجنب الألم"؛ أو بالأحرى، "إن الفن لا شأن له باللذة، علما انه صورة خاصة منها"[25]. وقد سبق أن عبر كانط عن هذه الفكرة بقوله: "إن الفن ممتع في ذاته؛ فهو ليس جميلا؛ لأنه ممتع، بل إنه ممتع؛ لأنه جميل"[26]. كما أنه "ليس فعلا أخلاقيا؛ لأن الحدس من حيث هو فعل نظري، ليس نابعا من الإرادة، وبالتالي فهو يتعارض مع كل ضرب من ضروب التأثير العملي"[27]. إن الاستطيقا بهذا المعنى، تعالج موضوعها بوصفه نوعا من الوهم، نظرا لارتباطه بالحدس وخلوه من المنفعة وابتعاده عن الواقع العملي وعن مجال ممارسته اليومية، وهو ما يظهر جليا في قول هيجل الذي لا يختلف مع أطروحة كانط بهذا الصدد، حيث يقول: "عندما يكون الجميل موضع نظر، فإن الذات تلغي أغراضها في علاقتها بالموضوع وتعامله على أنه مستقل وعلى أنه غاية في ذاته...ذلك أن تأمل الجمال هو نوع حر. إنه يترك الأشياء وحيدة على أنها بالفطرة حرة ومتناهية، ولا توجد أي رغبة في امتلاكها أو الحصول على ميزة منها كأمر مفيد لتلبية احتياجات ومقاصد متناهية. وهكذا، فإن الموضوع لا يظهر من حيث هو جميل على أنه مفروض وحافل بالإرغام من جانبنا، كما أنه لا يظهر على أنه تجري محاربته وقهره من جانب الأشياء الخارجية الأخرى"[28]. يضاف إلى هذا أن اعتبار الحدس من حيث هو عين التجربة الوجودية المتعالية للإنسان، هو أساس ومنبع الفن والعمل الفني، يعني بالضرورة أنه "ليس معرفة مفهومية؛ لأن المعرفة المفهومية في صورتها الخالصة، واقعية النزعة دائما، لكونها تحاول أن تقرر الواقع في مقابل اللاواقع. أما الحدس، فمعناه ألا يكون هناك تمييز بين الواقع واللاواقع"[29]؛ أي بين الحقيقة والوهم كما سيقول نيتشه فيما بعد، حينما سيؤكد "أن فضل الفن علينا من حيث هو إرادة الوهم الصادقة والرغبة فيه عن قصد؛ أي من حيث هو ظاهرة إستطيقية تجعلنا قادرين على تحمل وجودنا، تتمثل في كونه يمنحنا الأعين والأيدي، وبالأخص الوعي السعيد الذي ينبغي توفره لكي نجعل من الحياة ظاهرة فنية قابلة؛ لأن تعاش انطلاقا من امكانياتنا الخاصة"[30].
إن الفن في العمق، تعبير عن التجربة المتعالية التي هي تجربة وجودية. هذه الصفة المثالية هي الميزة أو الخاصية الاساسية التي تميز الفن بما هو كذلك. وفي هذا الصدد، يقول كروتشه: "إن صفة المثالية هذه، هي الميزة الداخلية العميقة التي يمتاز بها الفن. فمتى تجرد التفكير من هذه الصفة المثالية، تبدد الفن ومات؛ مات في الفنان، فإذا به يصبح ناقدا بعد أن كان فنانا؛ ومات في المشاهد، فإذا به يصبح مجرد ملاحظ للحياة في حالة وعي، بعد أن كان يلاحظها في حالة وِجْد"[31]. إن حالة الوجد هذه التي توجد في أصل العمل الفني، هي التعبير الحقيقي والمظهر الفعلي للتجربة الوجودية المتعالية للإنسان التي تتحدد في العمق كما قلنا، بوصفها تجربة فنية شبه صوفية. ربما لهذه الأسباب مجتمعة، يلخص موريس بلانشو تعريفه للفن ولماهية العمل الفني بقوله: "إن هدف العمل الفني، هو العمل الفني نفسه؛ فهو ليس مجرد طريقة أو وسيلة للممارسة الفكر، بل إنه الفكر عينه الذي ليس بشيء إذا لم يكن عملا فنيا...فما هو العمل الفني إذن؟ إنه اللحظة المتميزة التي تصبح فيها الإمكانية قدرة، حيث يصير القانون والشكل الفارغ والفقير إلا مما ليس بمتحدَّد ولا بمتعين، وحيث يصير الفكر يقينيا بهذا الشكل المتحقق، وهو هذا الجسد المتعين في الشكل، وهذا الشكل الجميل الذي هو بمثابة جسد جميل. إن العمل الفني هو بمثابة فكر (حدس)، والفكر انتقال في العمل الفني من غير المتعين مطلقا في أقصى حالاته، إلى المتعين إلى أقصى حد. إنه انتقال فريد من نوعه، لا يكون واقعيا إلا في العمل الفني الذي هو على الدوام، أكثر واقعية وتناهيا، باعتباره ليس إلا إنجازا لما في الفكر من لا تناه، حيث يكون العمل الفني مناسبة للتعرف على ذاته ولممارستها بشكل لا محدود ولا متعين".[32]
لا شك أن مجمل هذه التصورات التي أتينا على عرضها حتى الآن، حول ماهية الفن والعمل الفني في علاقتهما بماهية الحقيقة والجمال والجميل والتجربة الجمالية للإنسان بوصفها تجربة وجودية متعالية، يمكنها أن تجد خلاصتها إن كانت سابقة، أو أصلها إن كانت لاحقة، كما هو الحال بالنسبة إلى هذا التعريف الذي قدمه موريس بلانشو، في فلسفة هيدغر بالذات، التي حملت على عاتقها مهمة التفكير في أصل ماهية الفن والعمل الفني بشكل أصيل، إلى درجة يمكن القول عندها، أن الأهمية التي يوليها الفكر المعاصر لهذا الموضوع، سواء عند ها برماس أو أدورنو وأتباع مدرسة فرنكفورت، ونقاد الحداثة عامة، إنما ترجع بالأساس إلى أصالة تأملاته هذه، التي ترى بأن "أصل العمل الفني هو الفنان، وبأن أصل الفنان هو العمل الفني، وبأن لا أحد منها يوجد بمعزل عن الآخر، إلا أنهما مع ذلك لا وجود لهما في ذاتهما، ولا في تلازمها وتشارطهما، إلا بفضل ذلك الطرف الثالث الذي يحظى بالأولوية، والذي هو ما منه يمتح كل من الفنان والعمل الفني ماهيته ويستمد اسمه، ألا وهو الفن"[33]. فالفن هو "أصل كل من العمل الفني والفنان"، وماهيته هي ماهية الحقيقة نفسها من حيث هي انكشاف وتجلي ورفع للحجب (أليتيا) وحصول وإشراقة مضيئة تعمل عملها في العمل الفني، حيث يكون ذلك "النور الذي به يتجلى ويظهر الظهور المتّسِق في العمل، هو الجمال"؛ أي إن الجمال والحالة هذه، ليس شيئا آخر غير انبجاس الحقيقة وتفتحها، أو بالأحرى، إن "التجلي من حيث هو كينونة الحقيقة التي تعمل عملها في العمل الفني، هو الجمال بالذات".[34]
نخلص إذن إلى القول إن أهمية الاستطيقا أو الجماليات قد كانت وماتزال نابعة من أهمية المكانة التي يحظى بها الفن في حياة الانسان، حتى إن دلالتها تكاد تنحصر في كونها عبارة عن مقاربة له. فهي تهتم بالفن بوصفه ممارسة ضاربة بجذورها في أعماق النفس الإنسانية؛ ممارسة توصف بكونها خلقا وإبداعا وطريقة في التفكير ووسيلة للتعبير ونمط حياة ووجود وكيفية في التدبير وخبرة للرفع من المردودية والإنتاج وتوجيه السلوك وقيادة الممارسة وطريقة لتحسين ظروف العيش والارتقاء بحياة الأفراد والمجتمعات. إلا أن اهتمام الاستطيقا أو الجماليات بالفن، لا ينحصر في مقاربتها له من هذه الجوانب فقط، بل إنها تذهب أبعد من ذلك إلى تناوله فلسفيا بوصفه الوسيلة المثلى لتجلي الحقيقة وقد تجسدت عملا فنيا. لذا، فهي تنظر إليه على أنه العرض الفني للجميل، وعلى أنه هو ما به يتجلى الجمال المعقول، المجرد والمطلق، حسيا. إنها السؤال عن الفن وعن العمل الفني وعن الجمال والجميل، وعن طبيعة الحقيقة التي لا يمكن عرضها بواسطة خطاب آخر غير الخطاب الفني. وبالتالي، فإن حقلها بوصفها تخصصا معرفيًّا، يمتد ليشمل ثلاثة أبعاد أساسية هي الفن والعمل الفني، الجمال والجميل، والتجربة الوجودية للإنسان بما هي تجربة جمالية وفنية وذوقية تتخذ طابعا حسيًّا يعكس أبعادها الروحية والوجدانية والمعرفية.
تبحث الاستطيقا أو الجماليات إذن، في ماهية الفن والعمل الفني وفي ماهية الجمال والجميل وفي علاقتهما بالتجربة الوجودية للإنسان من حيث هي تجربة متعالية أساسها الذوق والإحساس والإدراك العقلي والحدس الوجداني، وتطرح أسئلة حول قيمة الفن ومدى قدرة العمل الفني على بلوغ الحقيقة وتبليغها وكيفية التعبير عنها. ومعلوم أن هذه القضايا قديمة قدم الفكر الفلسفي نفسه؛ فهي جزء لا يتجزأ من الفلسفة. وقد كانت وما زالت من أهم المواضيع والإشكالات التي لا يكاد يخلو منها مذهب من مذاهبها. وها قد أصبحت اليوم من أهم القضايا التي تستأثر باهتمام الفلاسفة والمفكرين والنقاد والفنانين، إلى درجة يصح معها القول إننا نعيش اليوم عصر التفكير في الفن بامتياز، علما أن هذا الاهتمام قد ظهر، لا فقط بوصفه تفكيرا فلسفيا نشأ بنشأة الفلسفة، بل وأيضا – وهذا هو الأهم- بوصفه تفكيرا علميا، نشأ منذ العصر الحديث الذي بدأ فيه الاهتمام بملكة الذوق يفرض نفسه أكثر فأكثر، عند معظم فلاسفة القرن الثامن عشر، ليبلغ دروته اليوم.
لائحة المراجع
- أميرة حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، دار المعارف القاهرة، 1989
- جيروم ستولينز، النقد الفني، دراسة جمالية وفلسفية، ترجمة فؤاد زكري، المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- حسين علي، فلسفة الفن، رؤية جديدة، دار التنوير/ بيروت، 2010
- زكريا إبراهيم، مشكلة الفن، مكتبة مصر القاهرة، 1977
- كارول تالون-هيغون، الجماليات، ترجمة عبد الهادي مفتاح، الصفحة سبعة للنشر والتوزيع، السعودية، 2023
- ميشيل هار، فلسفة الجمال، قضايا واشكالات، ترجمة ادريس كثير وعز الدين الخطابي، منشورات ما بعد الحداثة، فاس، المغرب.
- هيجل، علم الجمال وفلسفة الفن، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الكلمة، القاهرة، 2009.
- كروتشه، فلسفة الفن، ترجمة سامي الدروبي، المركز الثقافي العربي، بيروت/الدار البيضاء، 2009
- Adorno. Theodor. W; Théorie esthétique, Gallimard, Paris, 1982
- Adorno. Theodor. W; Philosophie de la nouvelle musique, Gallimard, Paris, 1962
- Alexandre Gottlieb Baumgarten; Esthétique, précédée des Méditation philosophiques sur quelques sujets se rapportant à l’essence du poème et de la métaphysique, Traduction, présentation et notes par Jean-Yves Pranchère, Ed, L’Herne, Paris,1988
- Hegel; Introduction aux leçons d’Esthétiques, les intégrales de Philo, Nathan, Paris, 2003
- Hegel ; Esthétique ; T,1et2, tr, Charles Bernard, livre de poche, Gallimard, 1997
- Heidegger (M); L’origine de l’œuvre d’art, in, Chemins qui ne minent nulle part, Gallimard, Paris, 1962
- George Dickie; « Définir l’art », in, Esthétique et Poétique, Textes réunis et présentés par Gérard Genette, Seuil, Paris, 1992
- Kant. E ; Critique de la faculté de juger, Gallimard, 1985
- Maurice Blanchot; L’espace littéraire, Gallimard, Paris,1955
- Michel Harr; L’œuvre d’art, Essais sur l’ontologie des œuvres, Hatier, Paris, 1994
- Nietzsche; Le gai savoir, tr, Henri Albert, Idée, Gallimard, Paris, 1950
- Timothy Binkley; « Pièce »: contre l’esthétique, in, Esthétique et Poétique, Textes réunis et présentés par Gérard Genette, Seuil, Paris, 1992
[1] - إن الاستطيقا كما يقول برانشير (Jean-Yves Pranchère) في تقديمه لكتاب بومجارتن الحامل لعنوان "تأملات في الشعر": "ليست مجرد كلمة، بل هي تخصص أو حقل فلسفي قائم بذاته عمل بومجارتن على انشاءه؛ فمجهوده الجبار يكمن بالضبط في ابتكاره للـ"استطيقا" بالذات كـ"تخصص علمي جديد"؛ فقد كان بالفعل هو أول من أدرك أن تمة علاقة ماهوية تجمع بين ثلاثة حقول معرفية لطالما اعتبرت مستقلة عن بعضها البعض، ألا وهي الفن والجميل والإحساس في الذات الإنسانية؛ وهكذا فقد كان العمل على إيضاح هوية أو ماهية هذه الموضوعات الفلسفية الثلاثة، هو شغله الشاغل وهدفه الدائم وقضية فكره بامتياز. إن مؤلفه هذا هو بمثابة محاولة لتنظيم معرفة سبق وأن كانت موجودة من قديم. إن الأمر يتعلق كما يقول هو بتوحيد قواعد الجمال المتناثرة هنا وهناك، في علم نسقي واحد. وهكذا فجدة الاستطيقا لا تكمن في محتواها، بل في الشكل العلمي الذي تم عرضها من خلاله. إنها تكمن بالضبط في إضفاء الطابع العلمي على مادة معروفة سلفا، ألا وهي معايير الذوق التي سبق عرضها منذ القديم في أعمال فلسفية وأدبية كثيرة لطالما أحب بومجارتن نفسه الاستشهاد بها." انظر:
Alexandre Gottlieb Baumgarten, Esthétique, précédée des Méditation philosophiques sur quelques sujets se rapportant à l’essence du poème et de la métaphysique, Traduction, présentation et notes par Jean-Yves Pranchère, Ed, L’Herne, Paris, 1988, p.8
[2] - Timothy Binkley, «Pièce»: contre l’esthétique, in, Esthétique et Poétique, Textes réunis et présentés par Gérard Genette, Seuil, Paris, 1992, p.39
[3] - Ibid., p.40
[4] - كارول تالون-هيغون، الجماليات، ترجمة عبد الهادي مفتاح، الصفحة سبعة للنشر والتوزيع، السعودية، 2023. ص ص7-8
[5] - Alexandre Gottlieb Baumgarten, Esthétique, précédée des Méditation philosophiques sur quelques sujets se rapportant à l’essence du poème et de la métaphysique, op, cité, p.14
نقرأ أيضا في الصفحة 12 من المرجع نفسه (Esthétique): "إن حب الجميل هو الذي ينتزع الروح من المحسوس ليوقظ فيها الرغبة في تأمل المعقول"
[6] - Hegel, Introduction aux leçons d’Esthétiques, Nathan, Paris, 2003, p.20
[7] - هيجل، علم الجمال وفلسفة الفن، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الكلمة القاهرة، 2009، ص182/183
[8] - Baumgarten, Esthétique, op, cité, p.11
[9] - لقد عبر أدورنو عن هذه الفكرة بقوله: "في الفن، لا نهتم ابدا بما هو مفيد ونافع، فلا شيء من هذا القبيل يربطنا به، بل بانكشاف الحقيقة وتجليها". انظر:
Theodor. W. Adorno, Philosophie de la nouvelle musique, Gallimard, Paris, 1962, p13
[10] - Baumgarten, Esthétique, op, cité, p.21
[11] - هذا ما يؤكده بومجارتن بقوله: "إن العلم وحده لا يلبي حاجتنا إلى المعرفة، بل إن علينا أن نضيف إليه نمطا آخر من المعرفة التي تمدّنا بها الفنون الجميلة، والتي يتعيّن على الاستطيقا أن تصفها؛ فهي مجال مستقل بذاته، غير قابل للاختزال، وأفق معرفي لا يمكن تجاوزه". المرجع نفسه، ص13
[12] - Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Gallimard, Paris,1955, p.302
[13] - Timothy Binkley, « Pièce »: contre l’esthétique, in, Esthétique et poétique, op, cité., p.49
[14] - Ibid., P.61
[15] - Heidegger (M), L’origine de l’œuvre d’art, in, Chemins qui ne minent nulle part, Gallimard, Paris, 1962, pp16/17
[16] - Timothy Binkley, « Pièce »: contre l’esthétique, op, cité, p.59
[17] - ibid., p.65
[18] - George Dickie, « Définir l’art », in, Esthétique et Poétique, op, cité, p.21
[19] - Ibid., p.32
[20] - Ibid., p.30
[21] - Timothy Binkley, « Pièce »: contre l’esthétique, op, cité, p.48
[22] - لقد رأى هيجل أن "الفن هو أحد التجليات الثلاثة التي يتمظهر بها الروح المطلق في العالم إلى جانب كل من الدين والفلسفة، وأنه يتطلب بدوره، مقاربة فلسفية خاصة به، حتى يكون بالإمكان فهمه وتثمينه"، وأنه "إذا كانت فينومينولوجيا الروح تشمل كلا من دراسة الأنثروبولوجيا وفلسفة الدين، فإن فلسفة الفن أو الاستطيقا عنده قد جاءت تكميلا وتتمة لتاريخ الفلسفة". الشي الذي حدا بهيدغر في مقالته التي تحمل عنوان: أصل العمل الفني (ذكر)، إلى مدح مؤلف هيجل هذا (الاستطيقا) والثناء عليه، بوصفه الكتاب الأكثر سعة وعمقا في تناوله لماهية الفن، الذي يتوفر عليه الغرب، لكونه فكَّر في موضوعه انطلاقا من ماهية الميتافيزيقا." انظر:
Hegel, Introduction aux leçons d’esthétique, op, cité, pp.7/15/20
[23] - كروتشه، فلسفة الفن، ترجمة سامي الدروبي، المركز الثقافي العربي، بيروت/الدار البيضاء، 2009، ص36
[24] - المرجع نفسه، ص50
[25] - المرجع نفسه، ص36
[26] - إن الخبرة الجمالية في نظر كانط "لا ترجع إلى النشاط النظري الذي يقوم به الذهن، والذي يحدد شروط المعرفة في علوم الرياضيات والفيزياء، كما لا ترجع إلى النشاط العملي الذي يحدد السلوك الأخلاقي المعتمِد على الإرادة؛ ولكنه يرجع إلى الشعور باللذة الذي يستند إلى اللعب الحر بين الخيال والذهن." انظر: حسين علي، فلسفة الفن، رؤية جديدة، دار التنوير/ بيروت، 2010، ص16
[27] - كروتشه، فلسفة الفن، ذكر، ص36
[28] - هيجل، علم الجمال وفلسفة الفن، ذكر، ص187
[29] - كروتشه، فلسفة الفن، ذكر، ص36
[30] - Nietzsche, Le gai savoir, tr, Henri Albert, Idée, Gallimard, Paris, 1950, F107, p.150
[31] - كروتشه، فلسفة الفن، ص38
[32] - Maurice Blanchot, L’espace littéraire, op, cité, p107
[33] - Heidegger (M), L’origine de l’œuvre d’art, op, cité, p13
[34] - Ibid. pp, 61, 62, 80, 92
يقول هيدغر بصدد هذا المفهوم الإغريقي عن الحقيقة بوصفها "لا تحجبا" (أليتيا/ Alètheia): "عندما نترجم كلمة أليتيا بـ "اللا تحجب"، بدل أن نترجمها بـ "الحقيقة"، فليس ذلك لأن هذه الترجمة أكثر "حرفية" فقط، بل لأنها تتضمن مؤشرا يدفعنا إلى إعادة التفكير، بشكل أكثر أصالة، في المدلول المتداول عن الحقيقة كتطابق للمنطوق بمعنى (ما يزال غامضا) أن يكون منكشفا وبمعنى انكشاف الموجود. (منكشفا) لا يعني الضياع فيه، بل يعني القيام بتراجع أمام الموجود حتى يتجلى فيما هو عليه وكما هو، حيث يتمكن التطابق الاستحضاري من أن يحدده ويفهمه. إن تركا مثل هذا للموجود يوجد يعني أن نعرض أنفسنا أمام الموجود كما هو، وأن ننقل سلوكنا كله إلى مجال المنفتح. إن ترك الموجود يوجد، أي الحرية، هو في حد ذاته وجود في الخارج أمام الموجود. إنه وجود منفتح وبراني (Ek-Sistant). إن ماهية الحرية، منظورا إليها على ضوء ماهية الحقيقة، تبدو أمام الموجود خروجا وانفتاحا أمام الموجود من حيث إن له سمة كونه قابلا للانكشاف." انظر: هيدغر، التقنية-الحقيقة-الوجود، ترجمة محمد سبيلا وعبد الهادي مفتاح، المركز الثقافي العربي، 1995، ص24