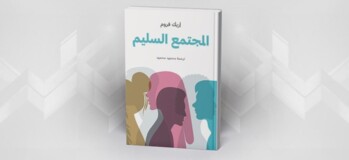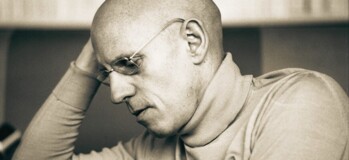الفن بين نيتشه وسبونفيل
فئة : أبحاث محكمة

الفن بين نيتشه وسبونفيل
ملخص:
يتناول هذا البحث قضية الفن من داخل التفكير الفلسفي، عبر استحضار منظورين فلسفيين حول الفن؛ إذ يخص المنظور الأول الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه الذي لطالما مجد الفن ودافع عن سموه، بوصفه حافزا لإرادة القوة والحياة، في حين يرتبط المنظور الثاني بالفيلسوف الفرنسي أندري كونت سبونفيل الذي نظّر للفن بوصفه شرطا إنسانيًّا بامتياز، يكمن دوره في الإجابة عن الأسئلة المربكة المرتبطة بالحياة والمصير والموت.
تروم هذه الدراسة كذلك بناء مقارنة بين هذين المنظورين؛ وذلك عبر الحفر في دلالة كل منظور، ورسم نقط الالتقاء والاختلاف بينهما، بالرغم من التفاوت الزمني الحاصل بين هذين الفيلسوفين.
مقدمة:
يعد الفن ممارسة إنسانية ضاربة في التاريخ، وعلامة فارقة على فرادة هذا الكائن، فهو جزء من التجربة الإنسانية طالما أن بمكنته قول كينونته والكشف عن وجوده. من هنا ابتدع أشكالا رمزية متعددة تمكنه من إعادة تشكيل العالم وفق رؤية جمالية حاذقة.
إذا كان الفن يحظى بأهمية بالغة عند الإنسان، فلا غرابة أن نلفي عناية خاصة به من طرف الفلسفة، منذ فجرها عند اليونان، لاسيما مع أفلاطون وأرسطو؛ إذ شغلت إشكالية الفن والجمال والذوق الفلاسفة على مر التاريخ، الأمر الذي أسهم في بلورة نظرية فلسفية بخصوص الفن والذوق الجمالي، بيد أنه لم يقتصر تناول الفن على الفلسفة اليونانية؛ إذ نجد هذا الاهتمام تبلور مع فلاسفة ينتمون إلى الفلسفة الحديثة توقفوا عند تحليله من قبيل كانط وهيوم...، كما واصل الفلاسفة المعاصرون التفكير في الفن من داخل القطائع الكبرى التي مسّت المناخ الفكري لهذا العصر.
يأتي في هذا الصدد، تصور كل من فريدريك نيتشه وأندري كونت سبونفيل في مقدمة الفلاسفة الذين تعاطوا وبنوا منظورًا فلسفيًّا متعلقا بالفن، فكيف نظر كل من نيتشه وسبونفيل للفن؟ ما هي القيمة التي شغلتها قضية الفن في تفكيرهما؟ ما هي حدود الاختلاف والتشابه في تصوريهما للفن كعملية إبداعية؟
أولا- الفن عند نيتشه:
كان طموح نيتشه هو التأسيس لقلب القيم وتحطيم الأوثان القديمة، عبر بناء فلسفة جديدة تتصالح مع الحياة ولا تقفز عليها، بوصفها عنصرًا حيويًّا. إن حب الحياة والشغف بها يمثل أساسا للإرادة والفعل والحب، وهذا الأمر هو ما يسميه بإجلال الحياة، وهذا ما نسمعه على لسان زرادشت "أنا لا أحب في الأساس غير الحياة"[1]. وبناء عليه، شكل هذا الأساس المدخل نحو نقد كل أشكال التعالي التي تجسد نوعا من الانحطاط في أوروبا.
بنى نيتشه نظرة أو تصورًا مخالفًا ومغايرًا للفن، فهو "ينادي بفن "سليم""[2]؛ أي فن يتخلص من ثقل التصورات الكلاسيكية، التي اعتادت على اعتبار العمل الفني مجرد إبداع للفنان؛ بمعنى أنه خاضع لسلطة المبدع وذاتيته بالخصوص، حيث يكون الخلق والإبداع بمثابة ممارسة إكراه على الطبيعة وتكريسا لهيمنة العقلانية المدمرة للحياة. وعلى النقيض من ذلك، يرى نيتشه أن الفن في الحقيقة لا يكشفه لنا الفنان. إن الفن بوصفه الحياة والمبدأ الذي يسير عليه الوجود، قائم بذاته، وكأن الحياة هي التي تتحدث وتنكشف في صيغة الفن حين تريد هي ذلك؛ أي الحياة بكل مفارقاتها وتناقضاتها، المندفعة بإيقاع إرادة القوة الديونيزوسي، والتي ترفض كل سكون أو فتور؛ لأنها مبنية على التوق دوما نحو الرقص والانتشاء والضحك أيضا؛ إذ "ينادي نيتشه بالرقص المرتبط بالضحك في تأسيس الخفة الديونيزوسية"[3] ضدا عن القوى الارتكاسية التي تعمل على تبخيس الحياة وكل ما هو فاعل فيها.
يمكن أن نلمس هنا تأثرًا جليًّا لنيتشه بالتراجيديا الإغريقية؛ فهذه الأخيرة تميزت بروحين أو إلهين: يمثل الأول الإله أبولون (إله النحت) الذي يجسد الاعتدال والحاكم الهادئ والحالم. أما الثاني، فهو ديونيزوس الذي يرمز إلى الإفراط والسكر المريع والرقص الطافح.
استنادًا إلى هذا المنطلق، يرى نيتشه أن الإغريق هم صناع أول حدث ثقافي في التاريخ، الأمر الذي يعد بمثابة معجزة؛ فالإغريق كما يوضح الباحث المغربي محمد الشيخ يمتلكون مجموعة من الفضائل والنوازع التي تميزهم عن غيرهم من الشعوب والحضارات الأخرى؛ وأولى هاته النوازع هي محبة الصراع أو النازع التصارعي، وثانيها هي إكرام وإجلال روح المدينة- الدولة (النازع الجمعي)، وثالثها هي الإيمان بالتفوق العرقي أو السلالي، وآخرها هي إجلال الخلف السالف.
إن هذه الفضائل هي التي دفعت بفيلسوف المطرقة نحو تمجيد الروح الإغريقية، واعتنائه بالتراجيديا الإغريقية، نظرًا إلى كونها تجسيدًا لإرادة القوة، بناء على ذلك يمكن فهم 'الرغبة في الألم' التي يتحدث عنها نيتشه من خلال هذه التراجيديا نفسها؛ فالألم المأساوي هو غيره الألم المسيحي الذي لا يفتأ يعمل على إلغاء ونفي مبدأ الحياة من خلال مقولة "الخلاص". أما الألم الذي يقصده نيتشه، فهو مصدر الانتشاء والمرح ذاته من خلال تكريس تناقضية الوجود وعبثيته، إذكاء للمفارقة الوجودية وتأكيدها والاعتراف بها، وبهذا المعنى يصير "الخلاص" بحسب نيتشه متجسدًا في الفن بالذات، فـ "منذ الآن لا نريد أن نستعمل الآثار الفنية إلا لكي نجر الكائنات المسكينة المنهكة والمريضة بعيدا عن شارع الآلام الإنسانية لمنحها لحظة وجيزة ذات شهوة عظيمة حيث نمنحها انتشاء وجنونا"[4].
يجسد الفن بهذا المعنى نوعا من الخلاص، لكنه خلاص أرضي يستبعد دلالته المسيحية والأفلاطونية التي ترى في الخلاص رغبة في السمو عن الوجود نحو اللانهائي واللاموجود، فهو يمكننا من علاج كل أشكال الانحطاط والنكوص، الأمر الذي جعل نيتشه يمارس نقده اللاذع لسقراط الذميم، الذي أفسد الفلسفة اليونانية؛ لأنه يضع العقل/الفضيلة كشرط محرر للإنسانية، بل يتعدى ذلك إلى الربط بين العقل والفضيلة والحياة السعيدة، وبالتالي يزكي الرغبة في التعالي والسمو الأخلاقي، وهذا النقد جزء من المهمة الجينيالوجية التي حملها نيتشه على عاتقه تجاه الأنساق التي شيدت ضمن تاريخ الفلسفة طالما أنها "تكرس الإعراض عما هو حياتي"[5].
يرى نيتشه أن "سقراط والفن على طرفي نقيض"[6]، ومرد ذلك إلى استحالة حدوث لقاء بين الحكيم الأخلاقي الذي يجسده سقراط، وبين الفنان المنتصر لإرادة الحياة؛ [7]* ذلك أن الحكيم الأخلاقي والفنان بهذا المعنى "ضدان ما كان من شأنهما أن يجتمعا"[8]، هذا الأمر ستتضح ملامحه أكثر مع أفلاطون الذي قرر طرد الشعراء(الفن) من الجمهورية المثالية، الشيء الذي يدل، حسب الباحث محمد الشيخ، على شيء من المرض في نفس الفيلسوف، سبب ذلك هو تنكر أفلاطون إلى طبيعته الشعرية وانقلابه على سجيته، وهذا المعطى هو ما سمح لنيتشه بوضع تضاد أو تقابل بين شخصية سقراط وديونيزوس، وعلى النحو ذاته نجد أفلاطون يقف متقابلا مع الشاعر هوميروس*. إن المبتغى الذي يسعى إليه نيتشه هو "تخليص الإنسان من طغيان المعقولية المنحدر نسلها من السقراطية كرمز فلسفي والأبولونية كرمز فني".[9]
إن من بين ما يتميز به تصور نيتشه للفن من فرادة، هو دفاعه عن استقلالية الفن عن كل ما هو أخلاقي؛ يظل الفن حسب فيلسوف المطرقة في صراع شرس مع "النزوعات الأخلاقية فيه"، التي تحاول أن تربطه بغايات خارجية بعيدة عنه. إن الفن هو أكبر مثير للحياة، حيث إنه يخلق فينا لذة ومتعة الوجود، لاسيما أننا "في حاجة إلى كل فن مرح، طاف، راقص، ساخر، طفولي وجدي."[10]، هكذا يربط نيتشه على نحو رشيق بين الفن والحياة التي تقوم على إرادة القوة والإعلاء من قيمة اللعب والجسد، خصوصا أن مهمة الفنانين، بالنسبة إليه، هي العودة بالإنسانية إلى مرحلة الطفولة؛ لأن هدف الفن يتجلى في إغراء الوجود وبناء نوع من الألفة مع الحياة التي لا تعدو أن تكون مجرد لعبة، ومنه فاللعب لا يفترض الجدية التي من شأن العقل أن يسلكها؛ ولا يفترض مسارًا خطيًّا للأشياء. إنه يبدأ وينتهي دون ذنب، ودون اعتبار لغاية ما سوى اللعب في ذاته، كذلك الوجود. إنه ينكشف تحت التأويل الجمالي متخففا من أعباء كثيرة؛ أعباء افلاطون الذي يحلم بعالم بلا خطيئة، ويهيئ الإنسان ليحمل ذنب الخطيئة الأولى، أو هيغل الذي يضع غاية للتاريخ، من هنا تتحول رمزية الوجود كلعبة إلى بديل تأويلي يحرر الإنسان من ثقل التراتب النافي للحياة.
إن الفن الذي ينافح عنه نيتشه يمجد الأرض ولا شيء سواها؛ إذ يتعين علينا أن نتصالح معها من جديد عن طريق حواس الجسد التي ستكشف لنا العالم تحت الشمس في منتصف النهار؛ لأن نيتشه "يجعل الحقيقة موجودة في منتصف النهار، حيث الظل ينكمش إلى أقصى حدوده، أو ينعدم تماما. وبهذا يقوم تقابل بين استعارتين كبيرتين هما: أسطورة الكهف الأفلاطونية والظل الأكثر قصرا النيتشوي".[11]
إذا كان نيتشه يرفض حصر الفن داخل مقولة "الجمال في حد ذاته"؛ إذ نجده يقول في هذا الصدد: "الجمال في ذاته، كلمة خاوية لا غير، وليست حتى مجرد فكرة"[12]، أو ربطه بأي رسالة أخلاقية أو دينية، فإنه في المقابل يجعل دور الفن متمثلا في دفعنا نحو السعي والشغف بالحياة "الفن هو أكبر منشط للرغبة في الحياة"[13]، حيث يوقظ فينا النشوة وكل الأحاسيس القوية، من قبيل نشوة الاحتفال، نشوة المبارزة، والانتصار. إن النشوة هي أساس الفن، وهذا ما يورده نيتشه في كتابه غسق الأوثان:
"لا وجود لفن أو لعمل فني أو نظرة جمالية دون عنصر النشوة"[14].
يشكل الفن محاولة لتوسيع إمكانات الحياة، عبر البحث عن منافذ أكثر اتساعا ورحابة، وهذا معناه أن الفن يخدم الحياة، ويزرع فيها الطبع الحيوي؛ ولتوضيح هذه النقطة يمكن لنا الوقوف عند تأويل دولوز لتصور نيتشه للفن؛ إذ يشكل هذا الأخير "حافزا لإرادة القوة"[15]، و"مثيرا للإرادة"[16]، وهذا ما يجعل نيتشه ينصب كل معاول الهدم والنقد تجاه كل تصور ارتكاسي للفن، ولعل هذا التصور هو امتداد للفلسفة النتشوية بصفة عامة التي تحاول القطع مع الحياة الارتكاسية والنكوصية التي تنتج الإنسان المدجن أو الكائن المطيع...
تأسيسا على ذلك، يمكن القول إن الفن عنده يقربنا أكثر من الحياة، من التدفق الحيوي للوجود، بغية بناء مصالحة مع الحياة. إنه ما يجعل الإنسان سعيدا بكل بساطة، فهو يغرس فينا فرحة الوجود؛ أي إغراء الإنسان بالإقبال على الحياة، [17] وبالتالي نشدان المرح والفرح والرقص.
ينتصر نيتشه لكل فن يقول "نعم" في مقابل ازدراءه للفن العدمي الذي يهتم بجمال الشكل كتعبير عن عجزه عن بلوغ الكمال. إنه بذلك يبحث عن أمل ما، عن وهم ما ينقصه. لذلك ربط نيتشه جيدا بين شرط فائض القوة وبين الفن، فلا يبدع إلا من يعطي، ولا يعطي إلا من يملك فائض القوة، "فالذي لا يستطيع العطاء لا ينال أي شيء"[18]. إن الفنان فاعل في حين أن المتشائم منفعل، إنه من يحول إبداعه بصفة دائمة إلى عرفان بالجميل لذاته؛ إذ إن الفن يؤكد ولا ينكر. وهكذا فمن شأن لوحة الرسام التي تصور فظاعات الحروب البشرية أن تثير في المتأمل مشاعر الروعة والانبهار دون أن تكون جميلة، ولكن اللوحة نفسها شاهدة على وجود إمكانية للحياة، رغم كل الآلام التي تصورها. ومن هنا صار الفن سبيلا لمقاومة فلاحة الموت وتجربة لا تنفك تخلق عند كل ريشة رسام، أو قلم شاعر، أو مقطوعة لموسيقي.
يشكل الفيلسوف نيتشه مغامرة لا مثيل لها في تاريخ الفلسفة. إنه ذلك الفيلسوف الهدام الذي عمل على النقد الجنيولوجي للعقل والتاريخ والاخلاق، فقد تأثر أساسا بكل من شوبنهاور وفاغنر، وكان نيتشه قد أبدى اعجابه بموسيقى فاغنز في لقاء حصل بينهما سنة 1868؛ إذ مجد موسيقى فاغنر لأنها "تحقيق لنبوءة شوبنهاور في الفن، وهي النظرية التي تريد أن تجعل من الفن عموما، والموسيقى على وجه التخصيص، الوسيلة الوحيدة للخلاص في الحياة ومن الحياة."[19]، إلا أن هذا الأخير قد خيب آماله، لهذا لم يتوان لحظة عن توجيه مطرقته نحو فاغنر مذ ظهرت عليه مظاهر "الانحطاط الأوروبي"؛ والمتمثلة أساسا في عنصري البحث عن الخلاص والقداسة. إنها كانت إشكاليته الكبرى التي تجسمت في العديد من أعماله شأن مسرحية "بارسيفال".
منذ اللحظة التي بدأ فيها فاغنر يهتم بالتأثير في الجماهير، ويختار لأجل ذلك "الجليل" بدلا من "الجميل"، أعلن نيتشه فك أي رابطة تربطه به، إن موسيقاه لم تعد تعدنا بالحياة بل بالخلاص، لقد جعل فاغنر من الموسيقى مجرد دعامة إيقاعية للحركات والتعبيرات وللتمثيل عموما. وفي المسرح يصبح الأفراد شعبا[20]، لقد أصبحت معه الموسيقى مجرد وسيلة للتأثير بأي طريقة، وفي خدمة فكرة مثالية بعد أن كفت عن أن تكون إثباتا للحياة، وفي المقابل بدت على موسيقى فاغنر مظاهر الانحلال عموما، لقد جعل الدور الرئيس للموسيقى يتمثل في إثارة الأعصاب من خلال الإمعان في الإثارة بالأصوات وهكذا حلت الفوضى محل الإيقاع.
تفطن نيتشه إلى أن كل موسيقى تسعى لأن تتلاءم مع الروح الحديثة تغدو منحطة، وتسير نحو الانحلال من خلال أخلاق الخلاص والمثالية والانتقام من الحياة، وهذا ما وقع فيه فاغنر، حين اختار التنكر للألم الديونيزوسي الذي يعترف بالحياة كقدر جميل وصيرورة حية. لم يحاول إنكار أسفه بسبب لعنة الخلاص التي حلت بموسيقى فاغنر فأردتها مجرد وسيلة في يد الجماهير/الشعب، الشيء الذي جعلها تغدو مجرد خادم للأخلاق الأوروبية الحديثة، وبهذا تكون موسيقى فاغنر شاهدا بارزا من بين الشواهد الأخرى على انحطاط الغرب.
جسدت الموسيقى إذن واحدة من أهم انشغالات واهتمامات الفيلسوف نيتشه، على غرار الأطعمة والمناخ والتسلية أو الأنشطة الترويحية، حسب ميشيل أونفري، كما تمثل جزءا من تجربة فيلسوف العلم المرح. إنها بمثابة شغف بالنسبة إليه، لاسيما أنه كان "ملحنا وموسيقيا قبل أن يدعوه فاغنر إلى التخلي عن فكرة مهنة موسيقية"[21].
لقد كان نيتشه مولعا لدرجة لا يمكن تصورها بالفن، والموسيقى بالخصوص، طالما أنها تجسد تجربة الحدود القصوى، لهذا كان يحب موزارت، باخ، بيتهوفن، شوبان، شوبرت، بصفتهم عباقرة الفن الذي يوقظ إرادة الحياة والشغف بالحياة، خصوصا أن نيتشه كان شديد الحساسية تجاه الموسيقى، لهذا "كان في بعض الأحيان، يحتاج إلى عدة أيام ليتعافى من موسيقى مسرفة في العنف كان قد استمع إليها"[22].
امتدادا لتصور فيلسوف المطرقة نجد أن مارتن هايدغر قد واصل الاعتناء بمفهوم الفن، ولكن ربطه أساسا باللغة ورأسا بالشعر. إن كل الفنون ترتد حسب فيلسوف الغابة السوداء إلى الشعر، منها تخرج وإليها تعود "الشعر طريقة من طرائق تصميم الحقيقة المنير"[23]، فكل فن ينطوي على عملية إبداعية ما، وليس الشعر شيئًا غير فعل إبداع.
يقدم هايدغر، بالإضافة إلى ذلك، مفهوم الأرض بوصفه شرطا لميلاد أي تجربة فنية؛ فالفن كامن في الطبيعة، ولا يفعل الفنان أكثر من إظهاره واستفزازه واستقدامه، إنه يضع بشكل ما "الحقيقة تحت الشمس"؛ لأنه بمثابة الصوت الذي تختاره الأرض كي تتفتح، وتظهر، وتوجد. وهنا تتبدى أهمية اللغة كأداة لتجلي الحقيقة/الوجود، كما يمكننا أن نفهم "أن كل الفنون التي نلتقي بها لدى شعوب العالم هي محاولات قام بها البشر من أجل إظهار المستخفي في باطن أرضهم"[24]. إن شعبا ما بوسعه التعبير عن العالم والأرض عن طريق اللغة بوصفها فنًّا، ومن هنا يمكن القول إن هايدغر انتقل بالتفكير الجمالي من سلطة الفنان وعبقريته إلى مجال العمل الفني؛ فهو التوقيع الحيوي الذي يشهد على أرض ما، وليس الفنان أكثر من الصوت الذي يستعيره العمل الفني من أجل الانكشاف. لقد حرر هايدغر مفهوم الفن/الإبداع من سلطة الفنان وعبقريته إلى فضاء أرحب وأوسع هو العمل الفني؛ فالعمل الفني ليس إلا إشعاعا للحقيقة عبر الموجود وتفتحا لها. إن هايدغر والحال هذه قد حرر التفكير الجمالي "من تلك التأملات العقيمة التي كانت تدور حول "عبقرية" الفنان أو "الإلهام" [25].
حاصل القول، إن نيتشه يرى أن من سمات الفن أن يجد طريقة ما للتوحيد بين العاطفة والمعرفة، بين الجسد الذي يحس والعقل الذي يفكر ويقيس، من دون افتراض أي تناقض بينهما، طالما أن الفن هو انكشاف للعالم من جديد في ما وراء فكر الخطيئة والذنب؛ أي في براءته، متحررًا من ثقل التراتب النافي للحياة.
ثانيا- الفن عند أندري كونت سبونفيل:
عمل أندري كونت سبونفيل في كتابه المترجم بـ: "تأملات فلسفية"[26] على تحديد أو تعيين دلالة الفن، بالقول "إن الفن من صنع الإنسان"[27]، فالفن هو فاعلية إنسانية. إنه بعبارة أدق خاصية تميز الكائن الإنساني وتشكل ما يتفرد به؛ لأن الإنسان وحده القادر على بناء وصناعة الفن، إن الإنسان هو سر الفن كما يقول سبونفيل؛ إذ يمثل الفن الإنسانية، حيث إن هذه الأخيرة تتكلم بواسطة الفن، الذي هو ضميرها وصوتها. إنه بمثابة مرآة كاشفة تنظر فيها الإنسانية إلى ذاتها؛ أي إلى تاريخها وأحوالها وأحاسيسها، لهذا اعتبرت الأعمال الفنية العظيمة بمثابة مدونة كبرى لتاريخ الإنسان ومحاولة لصون آثاره. من هنا، أمكن أن نفهم الفن بوصفه كاشفا عن الإنسانية، وهي تتساءل حول العالم، وتنذر نفسها للبحث عن حقيقة أو معنى ما موارب. لهذا تبدو أو تظهر الحاجة المسيسة للفن، مادام أن الإنسان يحتاج إلى الفن كي يكتشف ذاته.
ما الذي يريد الفن قوله؟ ما الذي يجسد الفن في عمقه؟ يقف أندري كونت سبونفيل عند هذين السؤالين معتبرا أن الفن يجسد الفرح الجمالي، الذي يشعر الإنسان بنوع من البهجة الداخلية، طالما أن العنصر الأساسي في الفن، خاصة الموسيقى هو الشعر.[28]. إن الفن هو بمثابة ترياق يمكن أن يخلصنا من الألم والجراحات والعذابات، لكنه يرفض في المقابل ربط الفن بالجمال؛ لأن هذا الأخير عنصر أو معطى يوجد في الطبيعة كزقزقة الطيور مثلا، فلا يمكن حصر الفن داخل دائرة الجمال فقط، فالجمال ليس كل الفن، ولكنه يشكل جزءًا منه، طالما أن الطبيعة تتميز في حد ذاتها بخصيصة الجمال، فهذا الأخير هو فقط "إحدى غايات الفن الممكنة على الأقل"[29].
يرى سبونفيل أن الميزة الأساسية للفن هي الابتعاد عن التقليد أو المحاكاة، مرد ذلك إلى كون محاكاة الطبيعة أو تقليدها ليس إلا إمكانية من بين إمكانيات أخرى، لاسيما أن المحاكاة، من وجهة نظره، تتعارض مع الفن لأنها تعمل على اختزال الفن في أفق ضيق وهش؛ إذ يبتعد الفن عن التقليد، فهذا الأخير لا مكان له داخل الفن، والفنان أبعد ما يكون عن مهمة التقليد؛ لأن "الفنان هو من يبدع وليس من ينسخ"[30]. إن الفنان يتعالى عن التقليد والمحاكاة، فهذين عنصرين مضادين للفن، وهذا ما شدد عليه كذلك الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط. "وفي الحقيقة، لا ينبغي أن نطلق "اسم الفن" إلا على النتاج الذي يحصل بحرية"[31]، لكن ما معنى الحرية داخل العمل الفني؟ إنها بمثابة "إرادة حرة تضع العقل في أساس كل نشاطاتها وأفعالها"[32]. ثمة إذن أهمية بالغة للحرية في ارتباط مع الفن؛ إذ لا يستقيم أحدهما دون الآخر، وجدير بالذكر أن كانط ميز بين الفن والحرفة أو المهنة؛ فالأول يرمز إلى الفعل الحر؛ أي ذلك النشاط الإنساني الحر والممتع في حد ذاته، بينما تتسم الحرفة بالتعب والشقاء والخضوع، لاسيما أن الحرفة ترتبط بتلك الالتزامات اليومية والروتينية. إن الشغل بكل بساطة يأتي من الخارج، كأنه يلقي بثقله علينا.
بالإضافة إلى ذلك، تشكل العبقرية ميزة أساسية أخرى للفن، فالذي يسم كل فن هو معطى العبقرية بوصفها الركيزة الأساسية داخل الفنون الجميلة، وهنا يستحضر سبونفيل تحديد كانط للعبقرية؛ أي تلك "القوة الإبداعية" التي يمكن أن تكون بالنسبة إليه إما فطرية أو مكتسبة، والتي تجعل العمل الفني غير قابل للاختزال في أي قالب أو قاعدة جاهزة، طالما أن العبقرية في الفن "هي ما لا يتعلم بل يعلم، إنها ما لا يقلد، بل ما نقلده".[33]
إذا كانت الفنون تنقسم إلى ستة أنواع، وهي: الرسم، النحت، المعمار، الموسيقى، الرقص، والأدب)، بالإضافة إلى الفن السابع، أي السينما، ثم أخيرا فن الرسوم المتحركة التي تسمى بالفن الثامن، فإن السؤال الأساس الذي يطرح نفسه هو كالتالي:
ما هو المشترك بين الفنون؟ بمعنى ما هي السمات أو الخصائص التي تعد بمثابة نقط مشتركة بين كل هذه الفنون؟
جوابا عن هذا السؤال، يرى سبونفيل أن الخصيصة التي تشترك فيها الفنون هي الذاتية التي يصطبغ بها عمل الفنان أو المبدع، هذا العمل يكشف عن نوع من العبقرية المتفردة[34]، التي تلفت الأنظار، فكل عمل فني يفجر الإحساس والمشاعر. إنه ترجمة لذاتية المبدع أو الفنان، فالذاتية تعني "أن نعبر عن هذا الفريد في حيواتنا على حد قول لوك فيري"[35]. أما الخاصية الثانية، فتتجلى في كونية العمل الإبداعي.
زيادة على ذلك، تتميز الفنون بأنها "تتقاطع أيضا مع ذلك الإحساس الممتع التي تزودنا به"[36]؛ ذلك أنها تروم تحقيق غايات جمالية مرتبطة بالمتعة، وهي بذلك تبتعد عن أي "رغبة في الامتلاك" أو ما يتعلق ببلوغ منفعة منتظرة[37]. من هذا المنطلق، يقر سبونفيل بوجود هوة أو مسافة شاسعة بين الفن والمنفعة أو المصلحة، طالما أن دور الفن يقتصر على إظهار الحقيقة أو نزع الحجاب عن الوجود لكي يصبح أكثر وضوحا وشفافية، ثم إن الغاية من الفن هي بلوغ المتعة التي ترتبط بتذوق الجمال.
إن الإغراء الذي يمارسه الفن على الفيلسوف الفرنسي سبونفيل هو ما حدا به إلى الوقوف عند تأمل بعض التجارب الموسيقية التي أسهمت في تشكيل وعيه وشخصيته بالأساس؛ لأنها شكلت امتدادا لطفولته المبكرة. لهذا أفرد فصلا كاملا من كتابه "L'inconsolable et autres impromptu"[38] لبيتوفهن بصفته فنانا أكثر تأثيرا وقوة حسب سبونفيل، بل يتجاوز ذلك نحو الحفر في الأعماق والدواخل بحثا عن المعنى، وهو بذلك يمنحنا الجرأة على التفكير أولا في الحياة، فالإنسان يحب الحياة، ويندفع نحوها، لذلك يظل هاجس البحث عن المعنى حاضرا دائما؛ إذ لا يلبث هذا الكائن يطرح الأسئلة الكبرى والقلقة والمربكة، حول الحياة والموت، الحب والفقدان، بالإضافة إلى المعنى والغاية من الحياة، وهنا يأتي الفن بوصفه محاولة للجواب عن هذه الأسئلة المستفزة. فلا غرابة أن نعد حسب سبونفيل، الفنانين من قبيل موزارات أو بيتوفهن أو ريلكه أو شوبر عباقرة حاولوا التصدي لهذه الأسئلة والاهتداء للجواب عنها، على هذا النحو يقدم الفنان نظرة مغايرة للحياة والوجود بصفة عامة، عنوانها اعتبار الفن درسا في الإنسانية.
يسعى الفن إلى تحرير الإنسان، الأمر الذي يجعل منه أداة لمقاومة الزمن الذي يجثم بثقله علينا، فلا غرابة أن نجد علاقة حميمية بين فعل الإبداع الفني وفعل المقاومة، وهذا ما دفع جيل دولوز للقول "إن الفن هو ما يقاوم، حتى ولو لم يكن الوحيد الذي يقاوم"[39]، صحيح أن الإنسان ابتكر على مر التاريخ أشكالا متعددة لبناء المقاومة، إلا أن الفن يشكل أبرز أشكال المقاومة التي اكتشفها الإنسان.
إن الفن هو أداة مقاومة بالأساس، فهو يسعى إلى كتابة تاريخ الإنسانية. لهذا كانت الغاية من اختراع الفن في البداية هو تجاوز خطر النسيان والمحو الذي يهدد الإنسان، بل الفناء والموت، بوصفهما الفاجعتين اللتين تهددان الوجود البشري، وتشهدان على تناهيه؛ فالموت هو قدر الإنسان، والأفجع هو وعي الإنسان بهذا الموت الذي يحدق به أو يسكنه باستمرار. لهذا، نجد بأن النقوش والرسوم التي ارتبطت بالكهوف كانت تهدف إلى هذه الغاية بالأساس.
ينتبه سبونفيل كذلك إلى نقطة بالغة الأهمية، تمس واقع الفن المعاصر، حيث يعتبر أن هذا الأخير يعرف العديد من التحولات والقطائع الكبرى أو المنعطفات؛ أي تلك التي تتصل بهيمنة السوق وثقافة الاستهلاك المرتبطة بوسائل الاتصال والإعلام، وهذا ما يشكل تهديدا أمام الفن، وكأنه يعيش ما يمكن أن نسميه بـ "جرح الفن" على حد تعبير أدورنو؛ لأنه صار مهددا بالتطور التقني والتكنولوجي؛ إذ سرعان ما يتم تحويله إلى مجرد بضاعة وسلعة نتيجة ما تفرضه الدعاية التجارية وكل ضروب الزيف وخلق المتع والبهرجة، لاسيما أننا نحيا في مجتمعات تسود فيها أشكال من العبودية الجديدة، فنحن نوجد في عصر القلق والسرعة، أو ذلك العصر الذي "يشوبه كثير من الخلط"[40]. لذا، يلازمنا سؤال أساسي: كيف للفن أن يعبر عن الإنسانية وينافح عنها في مجتمع أقل إنسانية؟[41].
إن هذه التحولات الكبرى التي يتسم بها العصر الراهن، تجعل العودة إلى الفن أمرا لا محيد عنه؛ لأنه يشكل ملاذا للإنسان، رغم أنه غير كاف، لكن يمنحه على الأقل الفرح الجمالي ويزرع فيه الشعور بالعالم، وبالتالي التعلق بالوجود والحياة، هكذا ينظر سبونفيل للموسيقى على سبيل المثال بوصفها ترياقا ضد العدمية وضد اليأس والحزن؛ إذ يحقق الفن للإنسان الانعتاق من العقلانية المفرطة وكل أشكال السيطرة المختلفة القديمة والجديدة، ولعل هذا التصور هو ما أسست له مدرسة فرانكفورت خاصة مع أدورنو وهوركهايمر.
يمكن أن نلتمس طريقا آخر للفن في علاقته بالحرية، ونقصد هنا الفن بوصفه خلقًا مستمرًّا لإمكانات جديدة للحياة كلما تم قتلها وإقبارها، لهذا تقول الباحثة التونسية أم الزين بنشيخة "أن المبدع هو من اقتدر على أن يحول حريته الجذرية إلى أثر فني"[42]، من هنا كان دور الفن هو تحرير الإنسان من مختلف ضروب الحتميات المحيطة به مهما غيرت من شكلها، فالعمل الفني هو بالأساس فعل حر، يأبى أن يتم حصره في قواعد أو معايير صنمية جامدة، وهذه نقطة بالغة الأهمية في فهم معنى الإبداع الفني الذي "ينتفض باستمرار ضد الأنظمة المتأتية من الخارج، وقد كان على الفن، في كل زمان، أن يقاوم كل المساعي الهادفة إلى فرض قوانين عليه... ورسم نهايات محددة للفن"[43].
لا شك في أن الإنسان بنى تصورًا جديدًا للحرية يطمح إليها وتتغنى به أفكاره وقوانينه وسياساته، إلا أن ما يبلغ منها يظل ناقصا بالنسبة إليه؛ فبالرغم من أن زمن العبودية انتهى تاريخيا إلا أن أشكال العبودية لا تزال مستمرة، فقد تغير شكلها فقط، وهنا صار لزاما على الفن أن يغير من وظيفته ومن معناه أيضا، ويمكن أن نؤسس لهذا التحول منذ ما يعرف نظريا بالمنعطف الجمالي الذي أسس له جملة من المفكرين من بينهم أدورنو الذي رأى أن الفن قد فقد معاييره الاستطيقية، حين تحول إلى إيديولوجيا.
خاتمة:
ختاما، يمكننا القول إن الفن هو تجربة إنسانية وجودية موغلة في العمق، وهذا ما يجعل منه موضوعًا متميزًا للتفكير الفلسفي، وقد كشفت تجارب العديد من الفلاسفة عن هذا الاهتمام المبكر، حيث حاولنا أن نقترب من نموذجين هما: فريدريك نيتشه وأندري كونت لاسبونفيل.
إن ما يربط بين تصوري نيتشه سبونفيل هو الاتفاق الحاصل بينهما بخصوص دور الفن، فكلاهما يؤكد أن دور الفن هو أن يقربنا من الحياة والعيش؛ إذ شكل الفن في تصور نيتشه مظهرًا من مظاهر القوة؛ لأنها شرط ضرروي لولادة الإبداع الفني؛ ما دام أن الفن يقوم بتجذير وجودنا وحضورنا في العالم. إنه يستنبت فينا شغف الحياة، ويجعلنا نقول: "نعم" كتوكيد للوجود، خارج كل تشاؤم ديني أو أخلاقي طالما أن "الأبطال هم الذين يقولون نعم لأنفسهم في خضم القسوة المأساوية"[44]. من نفس الزاوية، يرى سبونفيل أن "الفن يُعيننا على حب الحقيقة عبر الكشف عن جمالها"؛ لأنه يكشف عن الحقيقة ويعمل على إبرازها، لكن المقصود هنا هو تلك الحقيقة المعيشة والملموسة؛ أي حقيقة الوجود، ويستحضر هنا تجربة الروائي مارسيل بروست، الذي تحدث عن عظمة الأدب لكونه يفتحنا على الحياة ويمنحنا إمكانات أوسع للانوجاد، وهذا ما حذا بسبونفيل للقول إن الأدب هو ما يسعفنا على إدراك الحقيقة والتشبث بها كمأوى كملاذ لنا[45]، لكن لا ينبغي أن يفهم من هذا القول، جعل الأدب كبديل عن الحياة.
بالإضافة إلى ذلك، يلتقي سبونفيل مع نيتشه في مسألة الاهتمام بالشعر، فكلاهما يمجد الشعر والشعراء؛ إذ إن الإنسان لا يصبح إنسانا بالعقل والأخلاق فقط، بل إنه في أمس الحاجة إلى أشكال أخرى للعيش، ترتكز بالأساس على العاطفة والشعور والفن، وهذه العناصر مجتمعة هي التي تجعل من الإنسان أكثر إنسانية.
إذا كان نيتشه يشدد على أهمية الفن في حياة الكائن الإنساني، بوصفه في مسيس الحاجة إلى الجميل، قصد بناء فرحة الوجود، وهذا يمر عبر اعتبار الجميل أداة لإخفاء شقاء الوجود ومحو تجاعيده، فإن سبنوفيل ينتقد فيلسوف المطرقة في هذه النقطة، فالجميل لا يمكن بتاتا أن يغنينا على الحقيقة، ومن ثمة محدودية الفن؛ لأنه "لئن كنا بحاجة الى الجميل قدر ما أننا بحاجة إلى الحقيقة، فنحن بحاجة أكثر من ذلك إلى تلاقيهما معا والتحامهما وتوحدهما"[46].
إجمالا يمكننا القول، إن الفن ضرب من ضروب المقاومة؛ لأنه يمثل تجربة الألم التي يجترحها الإنسان في هذا الوجود، حيث "من غير جرح، لا الشعر ولا الفن ممكنان"[47]. إن الفن بهذا المعنى متعلق بمصير الإنسان الذي يتكلم بواسطته، ويعبر به عن كينونته، ويَفصح عن وجوده الحقيقي، ومنه فمهمة الفن هي جعل الإنسان أكثر إنسانية، وهذا لن يتحقق دون التحرر من براثين الأوثان التي قد تحد من حريته كيفما كانت. لذا، يتعين علينا أن نمجد الفن على الدوام، بوصفه شرطا لفرحنا الوجودي.
لائحة المراجع:
1- 1- باللغة العربية:
أدورنو، تيودور ف. نظرية استطيقية. ترجمة ناجي العونلي. بيروت: منشورات الجمل، 2017
إبراهيم، زكرياء. فلسفة الفن في الفكر المعاصر. الفجالة: مكتبة مصر للطباعة، 1966
أندلسي، محمد. نيتشه وسياسة الفلسفة. الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 2006
أونفري، ميشيل. الحكمة التراجيدية: في حسن توظيف نيتشه. ترجمة جلال بدلة. المملكة العربية السعودية: صفحة سبعة للنشر والتوزيع، 2023
بدوي، عبد الرحمن. نيتشه: خلاصة الفكر الأوروبي. الكويت: وكالة المطبوعات، 1975
بلعقروز، عبد الرزاق. نيتشه ومهمة الفلسفة: قلب تراتب القيم والتأويل الجمالي للحياة. الجزائر: منشورات الاختلاف، 2010
جيرار، روني. هداية الفن: نصوص جمعها بونوا شانتر وتريفور كريبن مرييل، ترجمة المصطفى صباني. المملكة العربية السعودية: صفحة سبعة للنشر والتوزيع، 2023
دولوز، جيل. خارج الفلسفة: نصوص مختارة. ترجمة عبد السلام بنعبد العالي وعادل حدجامي. ميلانو: دار المتوسط، 2021
دولوز، جيل. نيتشه والفلسفة. ترجمة أسامة الحاج. بيروت: المؤسسة الجامعية للأبحاث والدراسات والنشر والتوزيع، 1993
سبونفيل، أندري كونت. تأملات فلسفية. ترجمة حسن أوزال. الرباط: دار نشر إيدامانيا، 2022.
ستبيان، إدوويف. على دروب زرداشت. ترجمة فؤاد أيوب. بيروت: دار دمشق للطباعة والصحافة والنشر، 1983
العنيات، عبد الكريم. نيتشه والإغريق: إشكالية أصل الفلسفة. الجزائر: منشورات الاختلاف، 2010
المسكيني بنشيخة، أم الزين. الفن في زمن الإرهاب. بيروت: منشورات ضفاف، 2016
الشيخ، محمد. نقد الحداثة في فكر نيتشه. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2000
كانط، إيمانويل. نقد ملكة الحكم. باريس: طبعة فران، 1965
هيغل، فريدريك. المدخل إلى علم الجمال، فكرة الجمال. ترجمة جورج طرابيشي. بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1988
هان، ييونغ شول. خلاص الجمال. ترجمة بدر الدين مصطفى، المملكة العربية السعودية: دار معنى للنشر والتوزيع، 2020
نيتشه، فريديريك. إرادة القوة: محاولة لقلب كل القيم. ترجمة محمد الناجي. الدار البيضاء: إفريقيا الشرق، 2011
نيتشه، فريديريك. إنسان مفرط في إنسانيته، كتاب للمفكرين الأحرار، الكتاب الأول. ترجمة علي مصباح. بيروت: منشورات الجمل، 2013
نيتشه، فريديريك. العلم المرح. ترجمة حسان بورقية ومحمد الناجي. الدار البيضاء: إفريقيا الشرق، 2010
نيتشه، فريديريك. قضية فاغنر، يليه: نيتشه ضد فاغنر. ترجمة علي مصباح. بيروت: منشورات الجمل، 2017
نيتشه، فريديريك. غسق الأوثان أو كيف نتعاطى الفلسفة قرعًا بالمطرقة. ترجمة علي مصباح. بيروت: منشورات الجمل، 2010
نيتشه، فريديريك. هكذا تكلم زرادشت: كتاب للجميع ولغير أحد. ترجمة علي مصباح. بيروت: منشورات الجمل، 2008
2- باللغة الأجنبية:
Comte-Sponville, André. L'inconsolable et autres impromptus. Paris: Presses Universitaires de France, 2018
Comte-Sponville, André. Présentations de la philosophie. Paris: Éditions Le Livre de Poche,2002
[1] فريدريش نيتشه، هكذا تلكم زرادشت كتاب للجميع ولغير أحد، ترجمة على مصباح، الطبعة الأولى (كولونيا، منشورات الجمل، 2008)، ص 215
[2] ستبيان إدوويف، على دروب نيتشه، ترجمة فؤاد أيوب، الطبعة الأولى (بيروت، دار دمشق للطباعة والصحافة والنشر، 1983)، ص 29
[3] ميشيل أونفري، الحكمة التراجيدية: في حسن توظيف نيتشه، ترجمة جلال بدلة، الطبعة الأولى (المملكة العربية السعودية، صفحة سبعة للنشر والتوزيع، 2023)، ص156
[4] فريدريك نيتشه، العلم المرح، ترجمة حسان بورقية ومحمد الناجي، الطبعة الثانية (الدار البيضاء، افريقيا الشرق، 2010)، ص106
[5] روني جيرار، هداية الفن: نصوص جمعها بونوا شانتر وتريفور كريبن مرييل، ترجمة المصطفى صباني، الطبعة الأولى (المملكة العربية السعودية، صفحة سبعة للنشر والتوزيع، 2023)، ص 276
[6] محمد الشيخ، نقد الحداثة في فكر نيتشه، الطبعة الأولى (بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2000)، ص 236
* [7]يعد كل من سقراط وأفلاطون نموذجين للانحطاط، لكونهما أسهما حسب نيتشه في إنتاج إنسان مدجن أو كائن مطيع، وهذا الامر تجسد في بناء فصل بين الفن والحياة، والتركيز فقط على الأخلاق والعقل والفضيلة.
[8] المرجع نفسه، ص 236
* يستعمل هوميروس ألفاظ مرعبة: سكان الجحيم، أطياف، جهنم، ويقوم بإظهار الآلهة دامعة وفي نشيج من البكاء، وهذا ما يجعل أفلاطون يرفض أشعار هوميروس
[9] عبد الرزاق بلعقروز، نيتشه ومهمة الفلسفة: قلب تراتب القيم والتأويل الجمالي للحياة، الطبعة الأولى (الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2010)، ص144
[10] فريدريك نيتشه، العلم المرح، ترجمة حسان بورقية ومحمد الناجي، الطبعة الثانية (الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، 2010)، ص 119
[11] عبد الكريم عنيات، نيتشه والإغريق إشكالية أصل الفلسفة، الطبعة الأولى (الجزائر العاصمة، الجزائر، منشورات الاختلاف، 2010)، ص139
[12] فريدريك نيتشه، غسق الأوثان أو كيف نتعاطى الفلسفة قرعًا بالمطرقة، ترجمة علي مصباح، الطبعة الأولى (بيروت، منشورات الجمل، 2010)، ص 119
[13] المرجع نفسه، ص 120
[14] المرجع نفسه، ص 120
[15] جيل دولوز، نيتشه والفلسفة، ترجمة أسامة الحاج، الطبعة الأولى (بيروت، المؤسسة الجامعية للأبحاث والدراسات والنشر والتوزيع، 1993)، ص 130
[16] المرجع نفسه، ص 130
[17] محمد الشيخ، ص 154
[18] عبد الكريم عنيات، نيتشه والإغريق إشكالية أصل الفلسفة، مرجع سابق، ص 286
[19] عبد الرحمن بدوي، نيتشه: خلاصة الفكر الأوربي سلسلة الفلاسفة، الطبعة الخامسة (الكويت، وكالة المطبوعات، 1975)، ص11
[20]فريديريك نيتشه، قضية فاغنر، يليه: نيتشه ضد فاغنر، ترجمة علي مصباح، الطبعة الأولى (بيروت، منشورات الجمل، 2017)، ص99
[21] ميشيل أونفري، الحكمة التراجيديا: في حسن توظيف نيتشه، ترجمة جلال بدلة، الطبعة الأولى، (المملكة العربية السعودية، صفحة سبعة للنشر والتوزيع، 2023)، ص167
[22] ميشيل أونفري، الحكمة التراجيديا: في حسن توظيف نيتشه، مرجع سابق، ص 168
[23] مارتن هايدجر، أصل العمل الفني، ترجمة أبو العيد دود، الطبعة الأولى (ألمانيا، منشورات الجمل، 2003)، ص 145
[24] زكرياء إبراهيم، فلسفة الفن في الفكر المعاص، الطبعة الأولى (الفجالة، مكتبة مصر للطباعة، 1966)، ص230
[25] المرجع نفسه، ص 230
[26] صدرت النسخة الأولى من هذا الكتاب باللغة الفرنسية ثم ترجم بعد ذلك إلى اللغة العربية:
André Comte-Sponville, Présentations de la philosophie, 1ère édition (Paris, Éditions Le Livre de Poche, 2002(
أندري كونت سبونفيل، تأملات فلسفية، ترجمة حسن أوزال، الطبعة الأولى (الرباط، دار نشر إيدامانيا، 2022)
[27] المرجع نفسه، ص103
[28] Bertrand Saint-Etienne," Entretien sur la musique avec André Comte-Sponville, philosophe", resmusica, Le 31 janvier 2012 , 02 04 2025, https://shorturl.at/vpCZK.
[29] أندري كونت سبنوفيل، تأملات فلسفية، مرجع سابق، ص 103
[30] المرجع نفسه، ص 103.
[31] إيمانويل كانط، نقد ملكة الحكم، الطبعة (باريس، طبعة فران، 1965)، ص 134.
[32] المرجع نفسه، ص 134.
[33] أندري كونت سبونفيل، تأملات فلسفية، مرجع سابق، ص 107.
[34] يعد هيغل من أبرز الفلاسفة كذلك التي تناول مسألة الموهبة والمخيلة والعبقرية في حديثه عن الفن والمجال، حيث يقول: "العبقري هو من يملك القدرة العامة على الخلق الفني، وكذلك الطاقة الضرورية لممارسة هذه القدرة بأقصى النجع والفعالية"
هيغل، المدخل إلى علم الجمال، فكرة الجمال، ترجمة جورج طرابيشي الطبعة الثالثة (بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1988)، ص 443.
[35] أندري كونت سبونفيل، تأملات فلسفية، مرجع سابق، ص 109
[36] المرجع نفسه، ص 109
[37] المرجع نفسه، ص 109
[38] André Comte-Sponville, L'inconsolable et autres impromptus, première édition, (Paris, Presses Universitaires de France, 2018(
[39] جيل دولوز، خارج الفلسفة نصوص مختارة، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي وعادل حدجامي، الطبعة الأولى (ميلانو، دار المتوسط، 2021)، ص ص 180-181
[40] جيل دولوز، خارج الفلسفة: نصوص مختارة، 63
[41] تيودور ف. أدرنو، نظرية استطيقية، ترجمة ناجي العونلي، الطبعة الأولى، (لبنان، منشورات الجمل، 2017)، ص 24
[42] أم الزين بنشيخة المسكيني، الفن في زمن الإرهاب، الطبعة الأولى (بيروت، منشورات ضفاف، 2016)، ص55
[43] مارك جمينيز، ما الجمالية، ترجمة شرابل داغر، الطبعة الأولى (بيروت، المنظمة العربية للترجمة، 2009)، ص 219
[44] فريدريك نيتشه، إرادة القوة: محاولة لقلب كل القيم، ترجمة محمد الناجي، الطبعة الأولى (الدار البيضاء، افريقيا الشرق، 2022)، ص 295
[45] أندري كونت سبنوفيل، تأملات فلسفية، مرجع سابق، ص 110
[46] المرجع نفسه، ص 110
[47] ييونغ شول هان، خلاص الجمال، ترجمة بدر الدين مصطفى، الطبعة الأولى (المملكة العربية السعودية، دار معنى للنشر والتوزيع، 2020)، ص 44