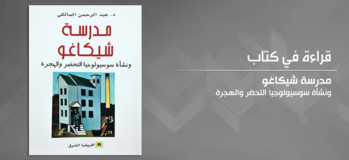قراءة في كتاب الثقافة والمجال دراسة في سوسيولوجيا التحضر والهجرة في المغرب
فئة : قراءات في كتب
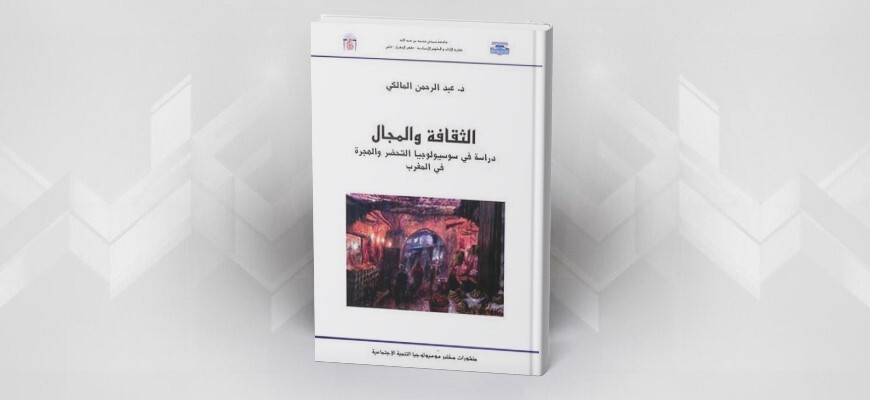
قراءة في كتاب الثقافة والمجال
دراسة في سوسيولوجيا التحضر والهجرة في المغرب
تمهيد:
لا شك أن متتبع إنتاجات علماء الاجتماع المغاربة في السنوات الأخيرة سيسجل اهتمامًا متزايدًا بظاهرة التحضر السريع التي يعرفها المغرب؛ وذلك بمحاولة تشخيص المتغيرات الشارطة التي تشكلها وتهيكلها وتحددها؛ أي عبر رصد محدداتها السوسيولوجية العامة، واستجلاء أبعادها وحواملها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والايكولوجية المختلفة.
ولعل من نافلة القول أن هذا الاهتمام المتزايد يعكس اهتماما مجتمعيًّا خاصًّا بهذه الظاهرة، وطلبا مكثفا للسوق الثقافية على الأبحاث التي تتناولها. وهو، بالتالي، نوع من المواكبة العلمية الأهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسة التي مست المغرب في السنوات الأخيرة، التي من أهم مؤشراتها وصول نسبة التحضر فيه إلى 60.3 في المئة سنة 2014 في المقابل 55.1 في المئة سنة 2004، وتعدد أشكاله وتضخمها، وتفاقم السكن "السري"، وتناسل مدن الصفيح، وهجرة قروية كثيفة...إلخ[1].
وفي هذا السياق، قام عالم الاجتماع المغربي عبدالرحمان المالكي بتأليف كتاب موسوم بـ "الثقافة والمجال، دراسة في سوسيولوجيا التحضر والهجرة بالمغرب"، يجمع بين الأبعاد النظرية والمنهجية والتطبيقية في مقاربة ظاهرة التحضر والتحولات التي طرأت على المدينة المغربية نتيجة حركات الهجرة الداخلية، وكذا على الإنسان في مجاله الحضري، والذي سنحاول أن نقدم قراءة أفقية في مضامينه بشكل مقتضب.
1- لمحة مقتضبة عن عناوين المواد التي يحتويها الكتاب:
كتاب "الثقافة والمجال، دراسة في سوسيولوجيا التحضر والهجرة بالمغرب"[2] لمؤلفه عالم الاجتماع عبدالرحمان المالكي[3]، ، يضم بين دفيته سبعة فصول، موزعة على 309 صفحة من القطع الكبير، والتي يمكن بسطها في التالي:
الفصل الأول معنون بـ"من السوسيولوجية الحضرية إلى سوسيولوجيا التحضر"، والفصل الثاني موسوم بـ "الثقافة والمجال". أما الفصل الثالث، فقد عنونه بـ "التحضر والهجرة في المغرب (رصد تاريخي ديموغرافي)، ثم الفصل الرابع الذي وسمه بـ "بناء الموضوع والمقاربة المنهجية (المفاهيم والتقنيات)". أما الفصل الخامس، فقد عنونه بـ "المهاجر قبل الهجرة (محددات الهجرة القروية وأسبابها)، ثم الفصل السادس الموسوم بـ "صورة المدينة وصورة البادية بعد الهجرة (إدراك الفروق الريفية الحضرية)، وأخيرا الفصل السابع الذي عنونه بـ "من الثقافة القروية على الثقافة الحضرية (سيرورة الاندماج في الحضر).
2- أطروحة الكتاب وإشكاليته:
يعالج هذا الكتاب "الثقافة والمجال، دراسة في سوسيولوجيا التحضر والهجرة بالمغرب" العلاقة بين الثقافة والمجال؛ أي مسارات الانتقال من التحضر الكمي إلى التحضر الكيفي[4]، انطلاقا من فرضية مركزية مؤداها أن التحضر الكمي الذي تعرفه المدينة المغربية الحديثة بفعل الهجرة القروية (فاس نموذجا) يتحول تدريجيا إلى تحضر كيفي تختفي فيه الفوارق القروية/الحضرية.
3- قراءة في مضامين الكتاب:
بعد أن عرضنا أطروحة عناوين المواد التي يحتويها الكتاب، وأطروحة الكتاب واشكاليته، ننتقل الآن إلى تقديم قراءة أفقية في مضامين الكتاب، حيث سأقوم بعرض قراءة أفقية في مضاميته.
يتناول صاحب الكتاب، في الفصل الأول من الكتاب والموسوم بـ "من السوسيولوجية الحضرية إلى سوسيولوجيا التحضر"، مسألة الموضوع والنظرية في السوسيولوجيا الحضرية، حيث يشير في هذا السياق، إلى أن الوسيولوجيا الحضرية، وإن كانت من أكثر فروع علم الاجتماع إثارة للاهتمام واستقطابا للدارسين والباحثين. فإنها، ومع ذلك تعاني "أزمة الموضوع"، ويرجع ذلك بالأساس حسب الكاتب إلى التغيرات الاجتماعية الهائلة والمتواصلة التي يشهدها العالم المعاصر، حيث أصبح علماء الاجتماع يتساءلون اليوم: أين المدينة، وأين القرية؟ وهل بقيت هناك حياة قروية خالصة؟[5].
ويستحضر الكاتب بعض علماء الاجتماع الذين تطرقوا لهذه المسألة، وأبرزهم عالم الاجتماع مانويل كاستيل (Manuel Castells)؛ وذلك من خلال مقالته الموسومة بـ "هل هناك سوسيولوجيا حضرية؟"
وانطلاقا من استحضار أبرز الرواد الذين تناولوا "الأزمة العلمية للسوسيولوجيا الحضرية" من بينهم مانويل كاستيل في مقالته الموسومة بـ "هل هناك سوسيولوجيا حضرية؟"، يخلص الكاتب إلى أن العلاقة بين الثقافة والمجال تعد الاشكالية المركزية بالنسبة إلى كل علماء الاجتماع الذين اهتموا بدراسة التحضر. يقول المالكي في هذا السياق: "إن موضوع السوسيولوجيا ظل حبيس إشكالية العلاقة بين الثقافة والمجال، أي من يؤثر في الآخر هل البنيات المادية (المدينة، العمل، التجهيزات...) هي التي تحدد البنيات الذهنية (المواقف القيم) أم على العكس من ذلك أن هذه المواقف والقيم الفردية (أي الثقافة) هي التي تخلق وتحدد تلك البنيات المادية. إن كل هذا النقاش - بالرغم من أهميته الكبرى- يدخل في اعتقادنا في إطار إشكالية السوسيولوجيا الحضرية وليس موضوعها. هذا بالرغم من صعوبة الفصل بين حدود الموضوع النظري للعلم وإشكاليته".[6]
بعد ذلك، ينتقل الكاتب إلى تحديد مفهوم التحضر كمفهوم سوسيولوجي، ويستحضر عالم الاجتماع مانويل كاستيل في هذا السياق في دراسة عن "المسألة الحضرية"، يقول:
في أدغال التعاريف الدقيقة التي أغنانا بها علماء الاجتماع، يمكننا أن نميز بوضوح معنيين متمايزين جدًّا لكلمة التحضر:
- التحضر بوصفه تركزا مجاليا للسكان انطلاقا من حدود معينة من حيث الحجم والكثافة.
- التحضر بوصفه انتشار لنسق من القيم والمواقف والسلوكات يسمى "ثقافة حضرية".[7]
ويخلص المالكي عموما إلى أن مفهوم "التحضر" يتخذ ثلاثة أبعاد أساسية، وهي:
ü التحضر بوصفه امتدادا جغرافيا (أو مجاليا) للمدينة وتهتم بدراسته الجغرافيا.
ü التحضر بوصفه نموا سكانيا للمدينة، وتهتم بدراسته الديموغرافيا.
ü التحضر بوصفه انتشارا لنمط عيش خاص هو نمط العيش الحضري وهو ما تهتم بدراسته السوسيولوجيا[8].
يقول المالكي: "إن التحضر في كل معانيه السابقة يتخذ وفي جميع الحالات شكل 'سيرورة' ويرى كل من جون ريمي وليليان فواييي أن استعمال مفهوم "السيرورة" (Processus) لوصف ظاهرة التحضر، جاء بقصد "الإلحاح على تمفصل ممارسات تتم في الزمن. إن هذا المنظور يساعد على المقارنة بين حالة وضعية ما في الزمن 1، وحالتها في الزمن 2، لنرى هل تعلق الأمر بمجرد إعادة انتاج، أم على العكس من ذلك بتغير"[9].
أما في الفصل الثاني من الكتاب، والموسوم بـ "الثقافة والمجال". فبعد ما قام صاحب الكتاب بتحديد مفهوم التحضر كمفهوم سوسيولوجي في الفصل السابق، يشير في هذا الفصل أيضا إلى أن "التحضر من المنظور السوسيولوجي يعني انتشار واستيعاب أنساق وقيم ومواقف؛ أي تبني نمط عيش معين ننعته بالحضري، وهذا ما يسميه بعض علماء الاجتماع بالثقافة الحضرية؛ أي الثقافة التي ينتجها ويحتويها ويبثها المجال الحضري[10]. وفي هذا السياق، يتساءل صاحب الكتاب، "هل هذا المجال هو مصدر تلك الثقافة؟ أم إنه هو بدوره ليس إلا نتيجة لها؟ ومن ثم تطرح مسألة العلاقة بين الثقافة والمجال، أو بين البنيات والذهنيات. وهذا ما يستدعي بعض التوضيح. فما الثقافة؟ وما المجال؟ وما العلاقة بينهما؟
ينتقل بعد ذلك المالكي للإجابة عن هذه الأسئلة، بدءا بتحديد مفهوم الثقافة، حيث يشير إلى أنه لا يمكن تناول إشكالية العلاقة بين الثقافة والمجال دون التطرق لبعض المفاهيم الأساسية. ومن بين هذه المفاهيم وأكثرها إثارة للجدل السوسيولوجي هناك مفهوم الثقافة. ويشير صاحب الكتاب إلى أنه من الصعب الوصول إلى تعريف واحد أو مشترك لمفهوم الثقافة.
عموما، إن الثقافة بمفهومها المتداول في العلوم الاجتماعية قد ارتبطت بالأنثروبولوجيا، في الفترة التي نشط فيها الاستعمار وحركة الاستكشافات الجغرافية. وفي هذا الإطار، وكي نتجنب المقدمات الطللية، لا بد من استحضار الأنثروبولوجي البريطاني إدوارد برنيت تايلور (E.B. Tylor) في وضع أول تعريف أنثروبولوجي للثقافة، وهو التعريف الشهير الذي يقول: "إن الثقافة أو الحضارة في مفهومها الإثنولوجي الأوسع هي كل مركب يضم المعرفة، والمعتقدات، والفن، والأخلاق، والقانون، والأعراف، وكل المهارات الأخرى أو العادات المكتسبة من طرف الإنسان باعتباره عضوا في المجتمع".[11]
إن هذا التعريف الذي أعطاه تايلور لمفهوم الثقافة، سيجعل هذا المفهوم يترسخ ويتجذر في كل العلوم الإنسانية؛ لأنه تعريف واضح وشامل، ويتناول الثقافة من حيث هي تعبير عن الحياة الاجتماعية الكلية للإنسان، ومن حيث هي قدرات ومهارات وعادات وتقاليد تكتسب في الجماعة وغير متوارثة بيولوجيا.
بعد ذلك ينتقل لتحديد مفهوم المجال، وفي هذا السياق يطرح صاحب الكتاب سؤال جوهري، يتمثل بأي معنى يستعمل علماء الاجتماع الحضري مفهوم المجال؟
إن تناول مفهوم المجال في علم الاجتماع الحضري، يقول المالكي انه ننتقل تلقائيا إلى تناول مسألة العلاقة بين الثقافة والمجال؛ لأن الثقافة تحدد المجال، كما أن المجال يحدد الثقافة.
عموما، إن دلالات مفهوم المجال متعددة: فالمجال يمكن أن يكون هو المجال الفيزيقي (البنية المكانية للمدينة أو الحي أو القرية)، الطبيعي الجغرافي. ويمكن أن يكون هو المجال المبني أو المكيف بحسب رغبات وتمثلات الإنسان، وهو ما يمكن نعته بالمجال السوسيو-جغرافي، (أو المجال الاصطناعي/ Artificiel) ثم هناك المجال الاجتماعي الذي يعيش فيه الناس، والذين يتراوح إدراكهم له بين الذاتية والموضوعية.[12]
وبالنسبة إلى مجال تناولنا الذي يندرج في إطار سوسيولوجيا التحضر، فإن ما يهمنا بالأساس هو "المجال الحضري"؛ أي مختلف أنماط المجال العامة والخاصة التي يمارس فيها السكان الحضريون حياتهم العادية، وهذا المجال ليس مجالا مجردا، بل هو مجال "مبني" ماديا وذهنيا في الوقت نفسه.
في إطار تحديد المفاهيم السالفة الذكر، ينتقل المالكي إلى إشكالية العلاقة بين الثقافة والمجال، وقد استحضر الكاتب مجموعة من الدراسات الميدانية السوسيولوجية والفلسفية التي تناولت مسألة العلاقة بين الثقافة والمجال، ليخلص بالأخير إلى، أن مسألة العلاقة بين الثقافة والمجال علاقة فيها مد وجزر من جهة، ويتبادل طرفاها التأثير في بعضهما البعض (علاقة الفكر والواقع، أو الوجود والمعرفة، أوبين البنيات الاجتماعية الرمزية والمادية). وفي هذا السياق، يؤكد المالكي أن كل فرد يتأثر بالوسط الذي يعيش فيه، ولكنه في نفس الوقت يؤثر بدوره في هذا الوسط.
وفي الفصل الثالث من هذا الكتاب، المعنون بـ "التحضر والهجرة في المغرب (رصد تاريخي ديموغرافي)"، يتناول الكاتب ظاهرة التحضر في المغرب، وما عرفته هذه الظاهرة من تطورات، وتغيرات؛ ذلك أن المدن التاريخية التي عرفها المغرب قد شهدت "تحضرا طبيعيا" ناشئا عن الحاجات والقدرات الذاتية لمجتمع عاش لقرون طويلة في عزلة وانطواء. غير أن هذا المشهد الحضري الطبيعي أو التقليدي سيعرف خلخلة ابتداء من بدء التدخل الأجنبي في المغرب؛ أي بعد فرض الحماية الفرنسية على المغرب.
وفي هذا السياق، يرصد المالكي تطور ظاهرتي التحضر والهجرة بعد استعمار المغرب، من خلال رصد تاريخي للتحولات التي عرفتها البنية الحضرية في المغرب. بدءا بالمدن الأصلية بالمغرب التي كانت تعيش حياتها الخاصة داخل أسوارها، والتي كانت تنظمها وتنتظمها أساسا مبادئ التشريع الإسلامي. ومن ثم، ستشهد تحولات هائلة وتغيرات عميقة إثر خضوع الدولة المغربية للاستعمار الفرنسي الذي سيأتي معه بنموذج حضري جديد، سيهمش النموذج الحضري القديم وسيحاصره ليسيطر عليه ويقوضه في النهاية. من خلال الطلاق الذي أحدثه المقيم العام الأول المارشال اليوطي بين المدينة الأصلية، وبين المدينة الجديدة، والذي يتجلى في نقل العاصمة من فاس إلى الرباط، وخلق ميناء كبير بالدار البيضاء، وإنشاء مدينة جديدة شمال الرباط هي مدينة بور اليوطي (القنيطرة حاليا)... وغيرها من القرارات الذي خلق وعزز عناصر التباين والصراع بين هذين النموذجين الحضرين منذ ذلك التاريخ إلى اليوم.
أما الفصل الرابع، والمتعلق بالشق الميداني لهذه الدراسة، والموسوم بـ "بناء الموضوع والمقاربة المنهجية" (المفاهيم والتقنيات)"، في هذا الفصل تناول المالكي تجربة هذه الدراسة الميدانية كما خاضها من جهة، وكما تمت في الواقع، وذلك بغاية الوصول إلى الدروس والاستنتاجات المستخلصة منها، وهذا لأجل توضيح العلاقة بين السوسيولوجيا ودراسة الهجرات، وتوضيح بعض المفاهيم ذات الصلة بالموضوع.
فبالنسبة إلى المنهج، من حيث التقنيات المعتمدة في هذه الدراسة هناك (استمارة، مقابلة، تعيين، إنجاز، تفييء، ترميز، تحليل مضمون، تفسير سببي...)، وهناك من جهة أخرى مسألة نظرية المنهج أي ما بعد المنهج، أو ما بعد التقنيات، أو ما يمكن الاتفاق على تسميته بعلم المنهج أو الميتودولوجيا (méthodologie) حيث يمكن التساؤل عن مدى نجاعة أو عدم نجاعة، صلاحية أو عدم صلاحية، صدق أو عدم صدق تقنية من التقنيات أو منهج من المناهج لمقاربة الواقعة الاجتماعية التي تم اختيارها كموضوع للدراسة.[13]
بعد ذلك انتقل صاحب الكتاب إلى تحديد اطار نظري عام عن السوسيولوجيا ودراسة الهجرات، حيث يرى الكاتب أن ظاهرة الهجرات يمكن أن تُدرس من وجهات نظر متعددة؛ ذلك أن كل علم من العلوم الإنسانية يتناولها من زاوية معينة؛ وذلك لأن هذه الظاهرة تشكل بامتياز >>الظاهرة الاجتماعية الكلية<< التي لا يمكن فهمها والإلمام بها إلا بمساءلة البنيات الكلية للمجتمع... وقد حدد الكاتب بعض المفاهيم الأساسية في هذا الإطار من قبيل مفهوم الحراك والهجرة والهجرة القروية Exode rural والمهاجر القروي، والذي يمكن تعريفه بأنه "ذلك الشخص الذي انتقل من القرية إلى المدينة بقصد العمل ولازالت تربطه بقريته علاقات (عائلية أو اقتصادية أو غيرها...) تجعله يزورها من حين لآخر، والذي يمكن القول إن وضعه في المدينة لم يتحدد بعد بصفة نهائية"[14].
وفي السياق نفسه، استحضر الكاتب خصوصية البحث السوسيولوجي الميداني، يقول المالكي: "إن إنجاز أي بحث سوسيولوجي ميداني يمر بعدة مراحل أولها التهييء النظري للبحث من خلال تجميع البيبلوغرافيا واستغلالها والتعرف على تجارب الآخرين والتراكم المعرفي في المجال المختار للدراسة، زمن خلال القراءات والملاحظات المباشرة والزيارات الاستطلاعية للميدان تأخذ في الظهور أنماط الأسئلة، وأشكال الوقائع والظواهر التي يمكن ان تشكل الموضوع النظري للدراسة".[15] بلغة أخرى، عندما يشرع الباحث في عمل بحث سوسيولوجي ميداني، يبدأ أولا بجمع وقراءة الدراسات والكتب المتعلقة بموضوعه، ليعرف ما كتبه الآخرون ويتعلم من تجاربهم. وهذا ما يساعده على بناء فكرة واضحة عن موضوع البحث. ثم يذهب الباحث إلى الميدان، أي المكان أو المجتمع الذي يريد دراسته، ويلاحظ ما يحدث فيه مباشرة. وخلال هذه الزيارات الاستطلاعية، تظهر له أسئلة جديدة ويبدأ في فهم الظواهر الواقعية التي ستشكل موضوع بحثه. بهذه الطريقة، تجمع المرحلة النظرية (القراءة والدراسة) مع المرحلة الميدانية (الملاحظة والزيارة) لتساعد الباحث على وضع خطة واضحة ومنظمة لبحثه أو لدراسته.
فيما يخص المنهج المعتمد لهذه الدراسة يشير المالكي على: إن تفضيل أو تبني المقاربة الكيفية يقتضي تبني تقنياتها، وهي تقنيات تتجسد في عدة أدوات من أهمها: الملاحظة المشاركة، والمقاربة البيوغرافية (حكايا الحياة) والمقابلات الحرة أو نصف الموجهة.
عموما، إن التقنية المعتمدة في هذا البحث لمقاربة الواقع الاجتماعي في هذه الدراسة هي تقنية >>المقابلة نصف الموجهة<< (l’entretien semi-directif)؛ وذلك حسب الكاتب نظرا لقدرة هذه التقنية على التكيف حسب المواقف والأوضاع التي يجد الباحث فيها نفسه.
وقد تم إنجاز 107 مقابلة من طرف الباحث نفسه وثلة من الطلبة الباحثين الحاصلين على دبلوم الدرسات المعمقة في علم الاجتماع. ويشير الكاتب في هذا السياق إلى أن العينة التي تم تطبيق دليل المقابلة عليها تتكون من المهاجرين والمهاجرات من مختلف الأعمار، الذين ازدادوا وأقاموا بالبادية، وغادروها للانتقال للمدينة بعد تجاوز سن العشرين، وذلك بقصد العمل والإقامة النهائية، واختاروا الالتحاق بالأحياء الشبه حضرية كمجال للاستقرار الأولي.
يشير الكاتب إلى أن غايته من هذا البحث تنحصر بالأساس في محاولة >>فهم<< سيرورة الانتقال من حالة >>القروية<< (ruralité) إلى حالة >>الحضرية<< (urbanité)؛ أي عملية التحضر (urbanisation). ولبلوغ هذا الهدف ارتأى الكاتب إلى ضرورة اعتماد التعيين الكيفي (échantillonnage qualitatif) والذي بمقتضاه يتم الحرص بالأساس على بلوغ مستوى >>التشبع[16]<< (Saturation).
ينتقل بعد ذلك الكاتب إلى معالجة المعطيات (تحليل المضمون)، وفي هذا الإطار يرى صاحب الكتاب أن تقنية تحليل المضمون هي أكثر التقنيات استعمالا في تحليل المقابلات. ويعرفها بالاستناد إلى ما انتهت إليه لورانس برادن (L. Badrin) في كتابها تحليل المضمون، تقول: "نعني على العموم بتعبير تحليل المضمون مجموعة من تقنيات تحليل التواصل، تسعى من خلال مجموعة من الطرائق النسقية والموضوعية وصف محتوى الرسائل (messages) بغاية الوصول إلى مؤشرات (كمية أو غير كمية) تسمح بالاستنباط المنطقي لمعارف تتعلق بظروف إنتاج/تلقي متغيرات مستنتجة من هذه الرسائل. (أنظر الكتاب الثقافة والمجال تأليف عبدالرحمان المالكي، ص: 142). وفي هذا الصدد، يشير صاحب الكتاب إلى كيفية التعامل مع كلام الناس، حيث يقول: إن ما يقوله الناس في محادثاتهم اليومية العادية (اللغة العادية) أو ما يقولونه لما يطلب منهم ذلك في إطار مقابلات البحث الميداني هو ما ينبغي أن ينصب عليه تحليل المضمون. ويشير أيضا في هذا السياق إلى "إن المبدأ الذي ينبغي أن ينطلق منه الباحث السوسيولوجي في تعامله مع المقابلات المنجزة هو أن ما يقوله المبحوث >>حقيقة<< أي حقيقته هو على الأقل، والتي يتصرف على ضوئها ويؤمن بها، والتي قد يحدث أن تتعارض أو تتنافى مع تصوراتنا وقناعاتنا حول نفس الموضوع".
عموما، يشير المالكي إلى "إن التحليل هو بناء مشترك (co-construction) يتم بين متن أنتجه محاور أو محاورون وبين محلل واحد أو عدة محللين. ولهذا من الأليق أن نسجل بالنسبة إلى تحليل معطيات المقابلات أن أنماط تحليل المضمون السائدة والشائعة، والتي تتداولها وتتناولها كتب مناهج علم الاجتماع بكثرة هي التي يمكن حصرها في الأنماط التالية: التحليل السياقي (l’analyse contextuelle)، التحليل مقابلة مقابلة (l'analyse par entretien)، التحليل الموضوعاتي (l’analyse thématique) .... ودون الخوض في عرض مختلف هذه الأنماط، نكتفي بعرض نمط التحليل الذي يستعمل أكثر في تحليل المقابلات المنجزة في إطار الدراسات السوسيولوجية الميدانية، يتعلق الأمر بالتحليل الموضوعاتي الذي اختاره الباحث في هذه الدراسة. يشير صاحب الكتاب في هذا السياق، إلى أنه يرى أغلب المهتمين بمنهجية علماء الاجتماع أن هذا النوع من التحليل قد يكون صالحا لمّا نكون بصدد دراسة تمثلات أو أفكار أو أيديولوجيا جماعة من الجماعات.
يقول المالكي: ومن خلال تبني >>المنهج المقارن المتصل<< تمكنا من الوصول إلى الخلاصات والاستنتاجات التي تتضمنها الفصول التالية من الكتاب، وهي الفصل الأول (الفصل الخامس من الكتاب) الذي يتناول المهاجر قبل الهجرة (وفيه يتم التطرق لسبب الهجرة، وكيف تم اتخاذ قرارها، وكيف تم تنفيذه وفي أي ظروف، وكيف تتشكل العلاقة الذهنية الأولى مع المدينة، وكيف تتشكل وتعمل الشبكات الهجروية...)، ثم الفصل الثاني (الفصل السادس من الكتاب) الذي يتطرق إلى إلتقاء المهاجر بالمدينة (صورة المدينة قبل وبعد الهجرة، وماهي الفروق التي يلمسها المهاجر بين البادية والمدينة على مختلف المستويات، وما هو شعوره بعد الهجرة، هل الارتياح أم الندم...)، وأخيرا الفصل الثالث (الفصل السابع من الكتاب)، الذي خصصه الكاتب لوضعية المهاجر في المدينة (مسألة أو درجة الاندماج في المدينة وكيف يتم، كيف يتمثل المهاجر "مدينته" وكيف تتشكل لديه ولدى أبنائه الهوية والثقافة الحضرية...)
يردف المالكي في نفس السياق: "إن تحديد هذه الفصول التي تسعى إلى ضبط "سيرورة الهجرة" من خلال توزيعها على ثلاث مراحل، يتضمن من دون شك بعض "التعسف"؛ لأن عملية الهجرة (أي فعل الانتقال من البادية للمدينة بقصد العمل والعيش فيها) هي عملية شمولية متصلة. وفي بعض الحالات يمكن القول إن كل مراحل الهجرة تختزل في "الفقرة الأولى"، فالمهاجر لا يتخذ قرار الهجرة ولا ينفذه إلا بعد أن يكون قد قام بعملية ذهنية حسابية، فالمهاجر -من خلال زياراته السابقة للمدينة، ومن خلال علاقات الصداقة والعائلة- تتشكل لديه صورة معينة عن مساره الهجري وأفقه، فهو يتصور وضعه البعدي من خلال النماذج التي يشكلها المهاجرون السابقون.[17]
ينتقل صاحب الكتاب بعد تحديد المنهج والتقنيات والأدوات التي استعملها في هذه الدراسة، إلى محددات الهجرة القروية وأسبابها إلى مدينة فاس. وقد خصص له فصل سمّاه بـ "المهاجر قبل الهجرة (محددات الهجرة القروية وأسبابها)"، وهو الفصل الخامس من هذا الكتاب. وقد حاول الكاتب في هذا الفصل للوصول إلى تحديد وتصنيف مختلف دواعي وأسباب وظروف الهجرة من جهة، وتحديد أساليب وطرائق التعبير عن ذلك من طرف المهاجرين من جهة أخرى. وخلص إلى أن هناك أسبابا كبرى أو عامة تتشابه، وأسباب صغرى أو خاصة تختلف من مبحوث إلى أخر. ويمكن القول إن الأسباب العامة الكبرى يمكن تصنيفها إلى: "أسباب أيكولوجية/ اقتصداية، وأسباب عائلية/ اجتماعية"، وهي أسباب عادية ومتنوعة ومعروفة على العموم. ويمكن بسط العوامل الاقتصادية في: (تراجع الإنتاج الفلاحي بفعل عامل الجفاف، تدهور الوضع الاجتماعي، ضعف المدخول، الفقر...إلخ). أما الأسباب الاجتماعية: (زواج، تضامن عائلي، ضغط اجتماعي، المشاكل العائلية، وفاة الأب، أو الأم...إلخ). ويشير المالكي في هذا السياق، إلى أن هذه العوامل الاختزالية إن صح التعبير لمسار الهجرة، لا تنطبق بالضرورة على كل الحالات، ولكنها تنطبق على الأغلبية الساحقة منها. إنها بمثابة "مثال نموذجي" للهجرة القروية إلى مدينة فاس.
عموما، يخلص صاحب الكتاب في هذا الفصل، إلى أن كل الذين قرروا ونفذوا الهجرة ينطلقون من صورة ذهنية (وواقعية) سلبية عن البادية (لأن عوامل الطرد أقوى من عوامل الجذب بها). وينطلقون في نفس الوقت من صورة ذهنية (واقعية) إيجابية عن المدينة (لأن عوامل الجذب إليها أقوى من العوامل الطاردة منها). إن هذا يدفع صاحب الكتاب على طرح بعض الأسئلة، أهمها: كيف تكون نظرة المهاجر للمدينة قبل الهجرة؟ وماهي صورتها بعد الهجرة؟ وماهي الفوارق التي أدركها المهاجر بعد الهجرة بين العيش والعمل في البادية، والعيش والعمل في المدينة؟ وكيف يتحول الاندماج الأول في المدينة (على مستوى المجال والعيش والعمل) إلى اندماج ثان (على المستوى الاجتماعي الثقافي)؟ وهو ما تطرق له في الفصلين الآخرين من الكتاب.
وفي هذا السياق، تطرق صاحب الكتاب في الفصل السادس إلى "صورة المدينة وصورة البادية بعد الهجرة (إدراك الفروق الريفية الحضرية)". وقد حاول الكاتب تتبع بدء المسار الاندماجي للمهاجر؛ وذلك من خلال التطرق إلى نظرته للمدينة قبل الهجرة إليها وبعد الهجرة وماهي الفروق التي بدت له بين ظروف العيش في البادية وظروف العيش في المدينة. وتماشيا في نفس الطرح، خصص الكاتب محور معنون بـ "الفروق الريفية الحضرية (سيرورة الاندماح في الحضر)"، وقد تمكن من الوقوف على الفوارق الأساسية بين المدينة والقرية من وجهة نظر المهاجر، وتبين عموما أن المهاجرين وهم يسعون إلى ذكر تلك الفوارق من خلال المقابلات التي وجهت لهم، فإنهم سرعان ماينخرطون في المقارنة والمفاضلة بين المدينة والقرية. يقول المالكي: وأحيانا تكون هذه الأخيرة (القرية) أفضل (بالنسبة للعلاقات الاجتماعية، والأخلاق، والتنشئة الأسرية...)، ولكن المدينة تبدو هي الأحسن في العديد من الميادين (العمل، التطبيب، والتمدرس، المعيشة، الحرية...). يُردِف المالكي في نفس الإطار: إن الفروق بين البادية والمدينة هي التي تساهم في نهاية الأمر في تشكيل صورة كل من البادية والمدينة في ذهن المهاجر. وهذه الصورة من الأهمية بمكان، فقد تبين لنا أن لكل مهاجر تصوره الخاص عن المدينة والقرية، وأن هذا التصور قد تم بناؤه انطلاقا من تجربة العيش في المجالين معا، وأنه يتغير باستمرار، وهو الذي يوجه المهاجر في سلوكه، ومن خلاله >>يتكيف<< و>>يتأقلم<< مع المدينة. ومن تجربة العيش والعمل والسكن في المدينة تبدأ في الظهور معالم شخصية المهاجر الجديدة: >>الشخصية الشبه حضرية<<. فالمهاجر لم يعد قرويا، ولكنه في نفس الوقت ليس مدينيا. وبعبارة روبيرت بارك >>إنسان مجتمعين، وإنسان ثقافتين<<.[18]
وفي الفصل الأخير من هذا الكتاب، والموسوم بـ "من الثقافة القروية إلى الثقافة الحضرية (سيرورة اندماج المهاجر في الحضر)". في مقدمة هذا الفصل، يشير صاحب الكتاب إلى أن اللقاء الأول بالمدينة غالبا ما يكون من خلال الالتقاء بحي من أحيائها >>الشعبية<<. وهذا الحي بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المهاجرين هو عبارة عن حي جديد، على هامش المدينة، يستقطب المهاجرين القرويين الوافدين من مختلف الأفاق. ويتساءل الكاتب عن كيف يرى المهاجر ساكنته، وكيف يرى نوعية العلاقات الاجتماعية فيه. ثم ماهي نظرة المهاجر للمجال الواسع الذي أصبح ينتمي إليه (فاس)...إلخ، وماهي الهوية المرجعية الأساسية التي يفضل الانتماء إليها، أو يرى أنه ينتمي إليها؛ أي في النهاية كيف تتشكل لديه >>الهوية الحضرية<<؟ وسيحاول الكاتب في هذا الفصل استجلاء كيف يدرك المهاجر ويحلل الفوارق بين البادية والمدينة على مستوى نسق >>الهوية والانتماء<<، وكيف يرى ويعيش انتقاله من مجال حياتي لآخر، ومن ثقافة لآخرى...
عموما، إن المهاجر حسب صاحب الكتاب، بقدر ما يتقادم في المدينة، بقدر ما تتغير نظرته لها، وتتغير المعايير التي يعتمدها للمقارنة بينها وبين البادية. يردف صاحب الكتاب في نفس السياق: بل إننا نلاحظ أن المهاجر لما يطول مقامه في المدينة وتصبح بالنسبة إليه هي >>مكان استقراره<<. فإن نظرته تأخذ في التغيير، ويصبح لا يقارن بين نمط العيش في المدينة ونمط العيش القروي...، وبالتالي، وبعد أن كان يرى المدينة -وهو في طريق الهجرة إليها- كلها إيجابيات، ستبدو له جوانبها السلبية أيضا. لنجد أنفسنا يقول المالكي ونحن نحلل آراء المهاجرين الوافدين على مدينة فاس، في صلب النظرة الأزلية للمدينة ذات الوجهين: فهي بالفعل مجال الحرية، والتقدم، والإبداع، وفرص الترقي الاجتماعي، ولكنها أيضا وفي نفس الوقت مجال انعدام الأمن، والانحراف، والفوارق الاجتماعية الصارخة، والفردانية، وضياع القيم...(أنظر الصفحة 244 من كتاب الثقافة والمجال لعبد الرحمان الماكي).
لقد حاول صاحب الكتاب في هذا الفصل رصد مواقف المهاجر القروي وتمثلاته للبيئة والثقافة الحضرية. ذلك يقول المالكي، إن هذا المهاجر ينخرط منذ وصوله للمدينة في سيرورة التحضر. >>وكل سيرورة تحضر تتضمن بعدا إدماجيا؛ وذلك نظرا لكون هذه السيرورة تمكن من جعل مجموعة من الناس والأنشطة والمجالات في وضعية تعايش وتفاعل<<. إن التحضر من هذا المنظور يعني عملية تعايش وتفاعل وتثاقف (Acculturation) بين المهاجر ومحيطه. وفي هذا الفصل تمكن صاحب الكتاب من إدراك التغيرات التي تطرأ على نظرة المهاجر لمدينته من خلال حيه وساكنته، يقول المالكي: "فهو ينظر لهذا الحي في البداية على أنه >>المدينة<< وأنه هو المجال الوحيد الذي يمكنه الاستقرار فيه، ولكن ما أن يستمر لبعض الوقت في المدينة حتى تبدأ نظرته في التغيير ومطالبه ومطامحه تتسع، فالحي الشعبي (المهمش والفقير وغير المتحضر) ليس هو المدينة، وسكانه ليسوا >>مدنيين<< ولا متمدنين في تصرفاته وأفعالهم؛ لأنهم >>عروبية<< جاءوا من جهات مختلفة ومتباينة.
خاتمة:
ختاما، وبالعودة إلى الفرضية المركزية التي انطلق منها الكاتب، والتي تمت صياغتها كالتالي: "إن التحضر الكمي الذي تعرفه المدينة المغربية الحديثة بفعل الهجرة القروية (فاس نموذجا) يتحول تدريجيا إلى تحضر كيفي تختفي فيه الفوارق القروية/الحضرية." يمكن القول إن صاحب الكتاب ينتهي إلى تأكيد أن التحضر المجالي (اتساع مساحات المدن ومداراتها الحضرية) والديموغرافي (ارتفاع عدد ساكنة هذه المدن باستمرار) لابد أن يتحول إلى تحضر ثقافي (أي اكتساب وتبني منظومة سلوك وقيم جديدة، تختلف عن المنظومة السائدة في البادية)؛ وذلك يقول المالكي ماعبرنا عنه بعملية الانتقال من >>التحضر الكمي<< إلى >>التحضر الكيفي<<[19]. ويشير المالكي إلى أن محاولة تفكيك، وتحليل، وتوضيح عملية الانتقال تلك هي ما شكل الهاجس الأساسي والأول لهذا الكتاب أو الدراسة.
المراجع والمقالات:
*- بالعربية
- كتب:
المالكي عبدالرحمان، الثقافة والمجال، دراسة في سوسيولوجيا التحضر والهجرة بالمغرب، مختبر سوسيولوجيا التنمية الاجتماعية/جامعة سيدي محمد بن عبدالله فاس/المغرب، سنة النشر 2015
- المقالات:
شهبار خالد، سوسيولوجيا الهجرة والتحضر أمام اختبار البراديغم البنائي، Sociology of Migration and Urbanization in View of the Structural Paradigm test، مجلة عمران، العدد 18/5 خريف 2016
[1] - خالد شهبار، سوسيولوجيا الهجرة والتحضر أمام اختبار البراديغم البنائي، Sociology of Migration and Urbanization in View of the Structural Paradigm test، مجلة عمران، العدد 18/5 خريف 2016
[2] عبد الرجمان المالكي، الثقافة والمجال، دراسة في سوسيولوجيا التحضر والهجرة بالمغرب، مختبر سوسيولوجيا التنمية الاجتماعية/جامعة سيدي محمد بن عبدالله فاس/المغرب، سنة النشر 2015
[3] - أستاذ علم الاجتماع ومدير مختبر سوسيولوجيا التنمية الاجتماعية بكلية الآداب، ظهر مهراز، جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، يهتم بسوسيولوجيا التحضر والهجرة والفقر والمسألة الاجتماعية.
[4] - نفس المرجع السابق، انظر الصفحة 284
[5] - عبد الرجمان المالكي، الثقافة والمجال، دراسة في سوسيولوجيا التحضر والهجرة بالمغرب، مختبر سوسيولوجيا التنمية الاجتماعية/جامعة سيدي محمد بن عبدالله فاس/المغرب، سنة النشر 2015، ص: 13
[6] - عبد الرجمان المالكي، الثقافة والمجال، ... نفس المرجع السابق، ص 20
[7] - نفس المرجع السابق، ص: 22
[8] - نفس المرجع، ص 24
[9] - نفس المرجع السابق، ص 24
[10] - نفس المرجع، ص 42
[11] - نفس المرجع، ص ص 43-44
[12] - نفس المرجع السابق، بتصرف، ص 52
[13] - نفس المرجع السابق، ص 113
[14] - نفس المرجع، ص: 126
[15] - نفس المرجع، ص: 30
[16] - إن التشبع حسب دانييل برطو هو الظاهرة التي من خلالها - وبعد إنجاز عدد معين من المقابلات (البيوغرافية أو غيرها- يتكون لدى الباحث أو فريق البحث الانطباع بأن إنجاز المزيد منها لا يؤدي إلى معرفة جديدة، على الأقل بالنسبة إلى الموضوع السوسيولوجي للتحقيق. انظر الكتاب الثقافة والمجال للكاتب عبدالرحمان المالكي، ص ص: 139-140
[17] - نفس المرجع السابق، ص 155
[18] - نفس المرجع السابق، ص ص: 239-240
[19] - عبدالرحمان المالكي، الثقافة والمجال، ...، ص ص: 284-285