كيف تقرأ كيركجارد
فئة : قراءات في كتب
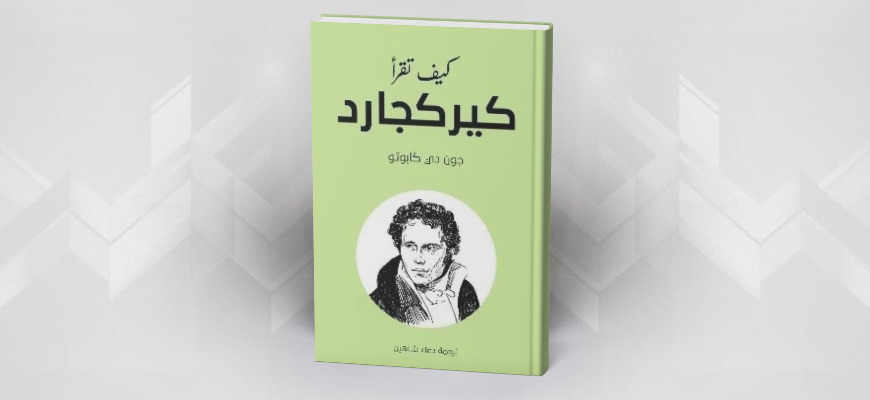
كيف تقرأ كيركجارد
جون دي كابوتو
ترجمة دعاء شاهين
مراجعة هبة عبد العزيز غانم
فكرة الكتاب
كيركجارد فيلسوف دانماركي (1813م-1855م)، ركزت فلسفته على تعرية الأخلاقيات المسيحية كما تصورها وتفهمها المؤسسة الكنيسة حينها، مع تركيزه على فكرة التمييز بين الإنسان والله، كان ينتقد بشدة تطبيق المسيحية كدين للدولة، من أبرز رواد الفلسفة الوجودية، وهي مدرسة فلسفية تتخذ من الإنسان موضوعًا لها، ليس فقط من خلال التفكير، وإنما من خلال الفعل والشعور؛ أي إنها ترتبط بالإنسان، ولا شك أن الوجودية ليست مذهبا واحدًا؛ إذ يمكن التمييز بين وجودية إيمانية ووجودية عكس ذلك، ففلسفة كيركجارد فلسفة وجودية تدور في دائرة الإيمانية، في مقابل وجوديات أخرى من قبيل وجودية سارتر(-1980م) ذات النزعة الماركسية. فالوجودية في المنشأ ذات نزعة إيمانية نقدية؛ إذ "ساهم اللاهوت البروتستانتي في بلورة اللاهوت الوجودي أكثر من اللاهوت الكاثوليكي؛ وذلك منذ أن ربط لوثر بين الحقيقة الدينية والإيمان الشخصي في اللحظة وليس في التاريخ. فالإيمان علاقة رأسية بين الله والإنسان، وليس علاقة أفقية بين المسيح والكنيسة. فالإيمان شخصي وليس تاريخيًّا، والوحي في الكتاب وليس في التراث الكنسي. ويتم الخلاص بالإيمان وحده — التقوى الباطنية، وليس بالأعمال — أفعال الشريعة والمظاهر الخارجية."[1] وهذا لا يعني أن الوجودية ذات أبعاد متعارضة أو متصارعة، فالفكرة المتفق عليها بشكل أكطبر في الفلسفة الوجودية مفادها تفق على مبدأ أنه لا يوجد هدف واحد أو حقيقة واحدة يعيش من أجلها الجميع وكل فرد في الأرض له الحق والحرية الكاملة في اختيار الحياة التي يرغبها والهدف الذي يسعى له ويعيش من أجله، وليس من حق الغير تحديد خيارات الآخرين
لقد أثرت كتابات كيركجارد على كثير من المثقفين والفلاسفة من بينهم "كارل بارث، ومارتن هايدجر. وقد قدَّما بدورهما كيركجارد إلى «الفلاسفة الوجوديين الفرنسيين»، جان بول سارتر، وألبير كامو، وسيمون دي بوفوار، حيث تعرَّضت مسيحيَّته الراديكالية لتحوُّل إلحادي في أربعينيات القرن العشرين. [...] وبحلول خمسينيات القرن العشرين، كثُرت الكتابات الشارحة لأفكار كيركجارد؛ أبو الفلسفة الوجودية. لقد تمكَّن كيركجارد من الوصول إلى ثقافة مجتمع النخبة، لتصبح أفكاره مادةً خصبة لنكات وودي آلن عن القلق (وهو أحد أشهر أفكار كيركجارد)، وجزءًا دائمًا من مراجع الفلسفة الرئيسية".[2]
وفق هذا السياق العام الذي يدور حول التذكير بأهمية كتابات كيركجارد وطبيعة الأسئلة التي طرحها، لأن الوجودية يهمها السؤال أكثر ما يهمها الجواب، يأتي هذا الكتاب الذي نحن بصدده ليقربنا، أكثر عن طبيعة وكيفية قراءة، كتابات كيركجارد وهي كتابات تفصلنا عنها فترة زمنية تتجاوز قرن ونصف من الزمن. السؤال هنا كيف بالإمكان استرجاع واستثمار أفكار كيركجارد؟ في زمن اتضح فيه بأن الفكرة الدين مكون وبعد لا مهرب عنه في الوجود الإنساني، في زمن تظللنا فيها مختلف العلوم، بما فيها الذكاء الاصطناعي.
موضوعات الكتاب
لا شك أن التراث الذي خلَّفه كيركجارد وراءه هو إرث مبهر "لكن السؤال عن كيفية قراءتها معقَّد. فهو كاتب ديني عميق، ولكنه مربك أيضًا. من ناحية (فيما أسماه أعمال يده اليمنى)، نجد تيارًا متدفقًا بانتظامٍ لأطروحاتٍ دينية واضحة، تنصح بالاقتداء بالمسيح. كان من الممكن أن تظل هذه التأملات التنويرية، المختلفة تمامًا عن أفكار كامو وسارتر، مجرَّد أعمال عبقري ديني محلي لولا ما أسماه بأعمال اليد اليسرى. هذه الأعمال هي الكتب، الموقَّعة بمجموعة متنوِّعة من الأسماء المستعارة مثل يوهانس كليماكوس ويوهانس دي سيلينتيو، ويُعَد بعضها من أمهات كتب الفلسفة الأوروبية، وهي التي استمد كيركجارد منها شهرته. وإذا ظهر اسمه على الإطلاق في هذه الأعمال، فهو يظهر فقط محررًا أو مسؤولًا عن النشر. يخبرنا قراؤه الراديكاليون المنتمون إلى مدرسةِ ما بعد الحداثة، الذين اقتربوا من أعماله في أعقاب دريدا والمذهب التفكيكي، أن أعمال اليد اليسرى هي عبارة عن نِكات مركبة، وأنه إذا ما أخذنا الأسماء المستعارة في أعماله على محمل الجِد، فنحن الملومون"[3]
وفق هذا الإطار، تأتي مختلف موضوعات الكتاب ونذكر منها: الحقيقة الحقيقية بالنسبة إليَّ. الجمالية. الأخلاقية. فارس الإيمان. الحقيقة هي الذاتية. الأسماء المستعارة. العصر الحالي. الحُبُّ. الذات.
أسلوب وجودية كيركجارد
استخدم كيركجارد الشِّعر، والسخرية، والفكاهة، "كاستراتيجية وطريقة للتواصل مع قرَّائه. لقد طرح نقدًا فلسفيًّا واضحًا لِعُقم التكهنات الميتافيزيقية الصاعدة، واستبدل بها وصفًا حساسًا وثاقبًا للتجربة الإنسانية الفعلية، والتي كان يحب أن يسميَها حياة «الفرد الموجود المسكين». رافق هذه الحجةَ وجهةُ نظر دينية متزمتة إلى حدٍّ كبير، يمكن اقتفاء أثرها في كتاباته الموقَّعة بأسماء مستعارة، وتظهر بوضوحٍ في الكتب الموقَّعة باسمه. استخدم كيركجارد أسماءً مستعارة لا لأنه كان متشككًا في آرائه، بل لأنه اعتبر المؤلِّف عنصرًا «غير مهم»؛ فما يقال في هذه الكتب لا علاقة له بما إذا كان المؤلِّف يعتمر قبَّعة (أو أن ساقَي بنطاله غيرُ متساويين طولًا). بصفته الكاتب، جادل كيركجارد بأنه لا يشكِّل أيَّ فارق، وأنه غير مهم على الإطلاق مقارنةً بثِقل وأهمية القدَر الوجودي للقارئ. ما يشكِّل فارقًا هو الرقصة، تلك الحركة الجدلية بين الاحتمالات المثالية التي ينجذب القارئ إليها شخصيًّا. هذه الكتب ليست سوى فرصة لحثِّ القراء، وحتى إغرائهم، على اتخاذ قرارات لأنفسهم."[4]
تضعنا مؤلفات بقالبها النقدي للكنيسة ولتصوراتها في فهم المسيحية أمام، فكرة مفادها أن المشكلة لا تعود إلى الديانة المسيحية بقدر ما ترتبط بالفهم المؤسسة الدينية الكنسية لها، وهو يدعو الفرد لينهج نهجًا خاصا به في فهم روح فكرة المسيحية بمعزل عن، عن الكنيسة وتصوراتها، وهذه فكرة في غاية الأهمية، تأخذنا لطبيعة التمييز المنهجي عند كيركجارد بين الدين الذي يحمل الفكرة الخالصة في بعدها الكلي والمطلق، والتدين الذي يعكس ظروف الفرد وحيثيات زمانه، أو ظروف ومصالح الكنيسة التي تستحضر فهما وتقصي فهم آخر دونه.
وفي هذا الإطار، ميز كيركجارد بين التدين الإنساني العام، وهو تدين مفتوح على العالم وعلى مختلف القيم التي تشترك فيها الإنسانية، وبين تدين منسد في الكنيسة المسيحية، لا يسع ما هو عام، ويدور فيما هو خاص ومحلي وظرفي. "إن «التديُّن أ» هو دِين إنساني عام، وليس دِينًا مسيحيًّا على وجه الخصوص. لكن مع قدوم «التديُّن ب»؛ أي المسيحية، ازداد الصراع بين ظروفنا الخارجية وعالمنا الباطني إلى ما لا نهاية، ليصل إلى ذروته عبر طرح التناقض المطلَق المتمثِّل في نموذج الله-الإنسان، أي الأبدي الذي حلَّ في الزمن. كما أن التداعيات «الجدلية»، التي يطرحها هذا النموذج المتناقض في قلب الدِّين المسيحي، تُبرز التناقض وتَزيد من حدة الصراع، لتحثَّنا على القيام بالقفزة الوجودية. في «التديُّن أ»، يحافظ المرء على علاقة مطلَقة مع المطلَق، مع الله، بينما في «التديُّن ب» (المسيحية)، يواجه المرءُ الإنسانَ الذي خلَقه الله، اللهُ الذي حلَّ في الزمن، وهو ما يعمِّق حدةَ التناقض ويبرِزه. في نموذج «التديُّن ب»، نحن نبني سعادتنا الأبدية برُمَّتها على حدثٍ بعيد فُقد، بشكلٍ موضوعي، وسط ضباب التاريخ، الأمر الذي يعمِّق حدةَ المعاناة أو الأسى. إن الإيمان المسيحي قائمٌ على حدثٍ ما في الماضي - وهو حياة المسيح وموته - وهو أمرٌ لا يمكن التأكد من حقيقته بصورة موضوعية. هنا تقوم البِنية الجوهرية «للذنب» (أ) بتمهيد الطريق أمام «إدراكٍ أكثرَ عمقًا للخطيئة» (ب)، وهو ما يتطلب قدوم الله-الإنسان للتحرُّر من الإثم؛ تقوم البِنية الجوهرية «للمعاناة» (أ) بإفساح المجال ﻟ «هجومٍ» أكبرَ على الفهم (ب). إن «التديُّن ب» محيكٌ من نسيج «التعالي»؛ أي عبر الوحي المسيحي."[5]
هذه المقاربة التي قال بها كيركجارد، في نقده للاهوت الديانة المسيحية، والتي قامت على التمييز بين التدين العام المرتهن لما هو كوني وإنساني، ومستقبلي في سياق كل ما هو متعالٍ وخلاق، والتدين المحلي المرتهن إلى ما مضى من الزمن، والمنشد إلى نسخة في الماضي، يقيس عليها كل شيء، تصدق في نقد مختلف الأديان عبر العالم. ومن هنا تأتي أهمية العناية بفلسفة وكتابات كيركجارد، بالعمل على توظيف روح الفكرة الدينية في نقد الخطاب الديني.
[1] يمنى طريف الخولي، الوجودية الدينية: دراسة في فلسفة باول تيليش، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ط.1، 2018م، ص. 12
[2] جون دي كابوتو، كيف تقرأ كيركجارد، ترجمة دعاء شاهين مراجعة هبة عبد العزيز غانم، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ط.1، 2024م، ص.11
[3] نفسه، ص ص 14-15
[4] نفسه، ص. 15
[5] نفسه، ص.64






