نزع الصفة الدينية عن الأسس السياسية للاجتماع
فئة : قراءات في كتب
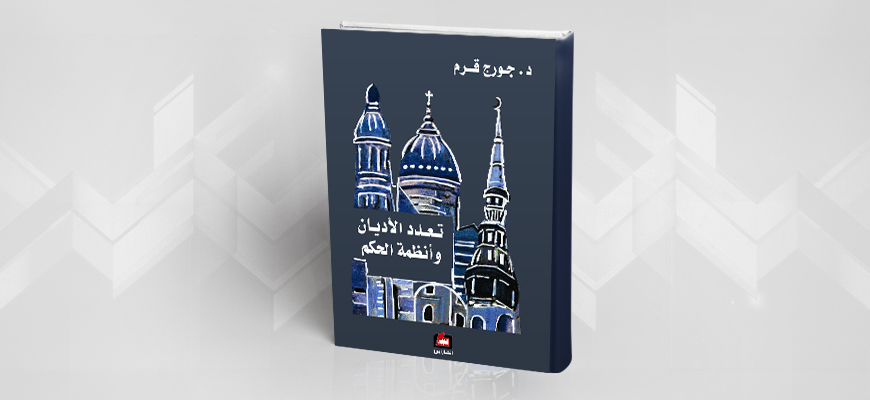
الكتاب: تعدّد الأديان وأنظمة الحكم
المؤلف: د. جورج قرم
الناشر: دار الفارابي، بيروت،2011، 447 صفحة
الكتاب في أصله دراسة نال عليها المؤلف الدكتوراه من جامعة باريس، ونشرت بالفرنسية عام 1971، وقد قسمه المؤلف إلى ثلاثة فصول: الأول يبحث في المسائل الدينية والعلاقات بين الطوائف الدينية منذ القدم، قبل التأسيس السياسي للديانات التوحيدية (اليهودية والمسيحية والإسلام)، ويعالج في الفصل الثاني العلاقات بين الطوائف الدينية في المجتمع المسيحي، والنظرة المسيحية إلى الكون، وأهمية الفكر المسيحي تجاه العالم غير المسيحي، ويتناول الفصل الثالث العلاقات بين الطوائف داخل المجتمع الإسلامي، وكذلك تأثير الحداثة الأوروبية السياسية على مجمل العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين في الدولة العثمانية، ثم الدول العربية التي تشكلت بعد انهيارها.
يعمل المؤلف أستاذاً في الجامعة اليسوعية في بيروت، وقد عمل أيضاً خبيراً اقتصادياً ووزيراً للمالية في لبنان (1998 ـ 2000).
يقول المؤلف، إنّ الأحكام القانونية ظهرت باعتبارها منبثقة عن الدين، كما في الحضارات المصرية والعراقية والبابلية والعبرية، ويقول فوستلد دي كالانج: "كانت الفكرة الدينية لدى القدامى هي المبدأ الملهم والمنظم للمجتمع، وفي زمن السلم، كما في زمن الحرب، كان الدين يوجه الأعمال جميعاً، كان كلي الحضور يطوّق الإنسان من كل جانب، وكان كل شيء؛ الروح والجسد، والحياة الخاصة والعامة، والمآكل والأعياد، والمحافل والمحاكم والمعارك، كل شيء يخضع لسلطان ديانة الحاضرة، كان الدين أهم ناظم لأفعال الإنسان، والمرجع الأول والأخير لكل ما يأتيه في كل لحظة من لحظات حياته ومعيار عاداته وأعرافه، وكان في الدين في تحكمه بالكائن الإنساني مطلق السلطان، فما كانت تقوم قائمة لشيء خارج إطاره". (ص 53)
ولم تنعتق أنظمة الحقوق في الغرب من الدين شكلاً ومضموناً إلا في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، ولا يزال القانون الإسباني والبرتغالي والإيطالي موسوماً بطابع طائفي واضح، وقد كان للمسيحية منذ اندماجها بالإمبراطورية الرومانية وحتى قيام الثورة الفرنسية تأثير حاسم على السلطة والقانون. (55)
ألغت الثورة الفرنسية كل وسيط بين الدولة والفرد، فما عادت الدولة مجرد ناظر على التجمعات البشرية، بل تماهت في تجمع واحد هو الأمة. ولكنّ مشرّعي 1789 وكتّاب القرن التاسع عشر وفلاسفته الألمان فتحوا الطريق للسلطة القومية لتكون بديلاً للدين، وكانت التجربة الهتلرية أسطعَ برهان على إمكانية انبعاث الأسطورة الدينية تحت ستار الأيديولوجيا العرقية. (56 ـ 57)
وقد تأكد أنّ الفروق القائمة بين الثيوقراطيات المسيحية واليهودية والإسلامية، على صعيد المؤسسات القانونية، فروق في الدرجة أكثر منها في الطبيعة. (64)
ويرى المؤلف أنّ هناك نموذجين قانونيين للعلاقات ما بين الطوائف: نموذج المجتمع القديم الكلاسيكي، ونموذج المجتمع التوحيدي (اليهودي والمسيحي والإسلامي) الذي لم يُخلِ مكانه إلا في زمن متأخر للنموذج العلماني في العالم الغربي، وقد كان النموذج الأول يرمي إلى تأمين الاندماج الاجتماعي ـ السياسي للعناصر الطائفية المتباينة تحت راية حكم سياسي واحد، وأمّا النموذج الثاني، فكان يحول دون الاندماج الاجتماعي السياسي بين الطوائف والأديان. (375 ـ 377)
ويجد في الخاتمة أنه لا جدال في أنّ النموذج القانوني العلماني للعلاقات الطائفية هو النموذج الذي تقف بموجبه الدولة موقفاً محايداً تماماً وغير متحيز على الصعيد الديني؛ ويكون القانون المدني على أساسه واحداً للجميع وعلى نحو إلزامي، وهو كما يقول الحل الأمثل لمشكلة العلاقات الطائفية؛ ففي إطاره يبقى المواطن حراً في أن يأتي سلوكه الخاص مطابقاً لمبادئه الدينية، غير أن النظام القانوني الساري المفعول ينهاه عن كل سلوك اجتماعي قد يجرح مشاعر المواطنين الآخرين، بل إنّ الدولة نفسها تجهل بموجب هذا النظام دينَ شتى رعاياها، وتعاملهم وفق معايير العقل الذي باتت المسيحية اليوم تسلّم بأنه لا يخالف الإيمان والعقيدة الدينية. (377)
العلاقات بين الطوائف في مجتمع العصور القديمة:
يعرض المؤلف في هذا الفصل العلاقات الطوائفية في مجتمع العصور القديمة، اعتقاداً بضرورة العودة إلى الجذور التاريخية للعلاقات بين الجماعات الدينية المختلفة التي تحيا ضمن إطار سياسي واحد، ولأجل استكناه طبيعة هذه العلاقات والكيفية التي انعقدت بها أواصرها من البدء، ويعاين طبيعة العلاقات الطوائفية وتطورها. ويلاحظ المؤلف كيف أربك تطور التوحيد اليهودي حركة الانصهارات الدينية القومية التي كانت تتم في إطار الكونية الكبرى طبقاً لمخطط متجانس إلى حد كبير، وتطورت سلسلة من القواعد القانونية المتعلقة بالعلاقات بين اليهود وغير اليهود، ولأجل دمج غير اليهود قسراً في المجتمع اليهودي، ولتمكين اليهود من الحفاظ على عبادتهم ذات النزعة الخصوصية خارج دائرة التنظيم العام للدولة غير اليهودية. (161 ـ 162)
لقد مرّ تطور الجماعة البشرية بالأسرة فالعشيرة فالقبيلة فالشعب، وكان اتحاد عدة أسر في عشيرة واحدة وعدة عشائر في قبيلة هو الاتحاد الذي كان أساس نشوء المجتمعات، وكانت الجماعة مرتبطة بالقربى التي تعود إلى سلف مشترك جرى تأليهه تدريجياً مع مرور الزمن، فكل إهانة تلحق بعضو في الجماعة تغدو في الحال إهانة دينية؛ فالدين يعبر عن علاقة جميع الأعضاء بقوة تسهر على خير هذه الجماعة وتحرس القانون والنظام الأخلاقي، وفي سياق كهذا يتطابق كل من الدين والقومية تمام التطابق، وكانت الروابط الدينية كالروابط السياسية يتوارثها الابن عن الأب. (75 ـ 77)
الانتقال من نمط تجمع أدنى إلى نمط تجمع أعلى وأرحب يفضي على الدوام إلى تضاعف عدد العناصر العبادية، ذلك التضاعف في حد ذاته كان مصدراً لتطور القواعد والأعراف الاجتماعية. وتظهر الحضارة المصرية والبابلية توسع الجماعة البدائية، وهناك نماذج عدة للتوسع نحو إنشاء حواضر واتحادات قبائلية، وفي المثال العبراني يمكن ملاحظة المرحلة السابقة للمحكمة القائمة على تجمعات عشائرية ثم اتحدت معاً، لتكوين مملكة مركزها أورشليم، وأمّا الحاضرة الرومانية، فقد كانت ذات طابع أرستقراطي. (81)
وفي هذا التوسع والانصهار بين الجماعات تمّ انفتاح العبادات على بعضها بعضاً، وازدواجها وتحولها إلى عبادات رسمية عامة ملزمة لجميع أعضاء الجماعة يلتئم حولها شمل الولاءات. وعندما احتل داريوس الفارسي بابل ومصر صار يَنسب نفسه إلى اهرا مزدا في فارس ومردوخ في بابل وأمون في مصر... كما لو أنه مفوض من آلهة رعاياه جميعاً، ومسؤول بالتالي أمامها. ولذلك اقتبس عن الفراعنة المصريين وملوك بابل فكرة السلطة الملكية المتماهية والعدالة، فهو سيكون حامي الضعفاء وممثل النظام وحارس الخير. (112)
كانت تسود لامركزية دينية في ظل الإمبراطوريات الفارسية والإغريقية والرومانية، وهذا ما كرّس تعددية دينية متجاورة في مكان واحد، الزرادشتية إلى جانب الكلدانية، ومعابد أدونيس وأوريزيس ومذابح لزفس مجاورة لمذابح يهوه، يقول جوستر: "كان العصر القديم يحترم إلى درجة عالية جداً مبدأ الحرية الدينية". (126)
العلاقات الطوائفية في المجتمع المسيحي:
يستشهد المؤلف بما جاء في رسالة بطرس الأولى (الإصحاح الثاني): "أمّا أنتم أيها المسيحيون فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمّة مقدسة، شعب اقتناء لكي تخبروا فضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب"، ليلاحظ طابع السعي للانتشار والانفتاح لدى المسيحية، وقد أمكن للمسيحية، بصفتها ديانة مفتوحة تستقبل جميع الأمم، أن تنطلق مظفرة لغزو المجتمع الوثني، وكانت المسيحية في ذلك تقوم على حس الوحدة (ليكن الجميع واحداً. إنجيل يوحنا) والحاجة إلى نشر المسيحية والتبشير لأجل إله واحد في السماء وإمبراطور واحد على الأرض، والدفاع عن العقيدة. (164)
ومع تنصّر الإمبراطورية الرمانية وضعت كل آلة القوة العامة في خدمة "الإمبريالية الدينية" وتأمين النصر لعقائد الكنيسة. ومع أفول الوثنية كان من المحتم أن يؤدي غزو العنصر الديني لحياة الجماعات الاجتماعية الوثنية إلى سيطرة جو دائم من الريبة والقلاقل والاضطهادات على العلاقات الطوائفية. (182)
وما أن أنزل الدين المسيحي منزلة دين الدولة، وترجمت المثل العليا الدينية إلى لغة القانون والسياسة بأمل الوصول بسرعة إلى تحقيق المثل العليا من أجل خلاص الإنسانية، حتى اكتسبت مسألة العلاقات الطوائفية طابعاً متزايد الحدة، وصارت السلطة في خدمة المثل العليا؛ أي أن تستخدم في محاربة اليهود والمهرطقين والوثنيين والمرتدين والكفار، ومن هنا كانت كثرة التدابير التشريعية في مضمار العلاقات الطوائفية.
وكانت الثورة الفرنسية (1789) بداية لتشكل جديدا للدول والمجتمعات على أسس سيادة الأمة، وأن الناس يولدون ويموتون أحراراً ومتساوين في الحقوق، ما يعني نزع الصفة الدينية عن الأسس السياسية للمجتمع، لقد طوحت هذه المبادئ بالبناء الاجتماعي القائم على أسس دينية.
علمنة المجتمع المسيحي التي أطلقت الثورة الفرنسية شرارتها الأولى لم تتم بلا مصادمات ومعارضات عنيفة، ولكن في المحصلة كان إلغاء تنظيم علاقات المواطنين فيما بينهم أو علاقات المواطنين بالدولة بحكم انتمائهم الطائفي، وهذا هو وحده ما أوجد الشروط لاندماج اجتماعي حقيقي في رحم الأمة الحديثة.(216)
العلاقات الطوائفية في المجتمع الإسلامي:
استلهم التشريع الإسلامي التطبيقي التشريعات الفارسية والبيزنطية، إضافة إلى أحكام القرآن، وقد طبقت التشريعات المتعلقة بالطوائف غير الإسلامية بتسامح، وأقامت الحاضرة الإسلامية على وفائها لرؤية القرآن التعددية للكون "ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة" (النحل: 93)، ولكنها رؤية يقض مضجعها الآية "ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين". (آل عمران: 85)
والواقع، كما يرى المؤلف، أن الطوائف غير الإسلامية كانت بمثابة حواضر صغيرة مستقلة ذاتياً في حياتها وعبادتها لا تتدخل فيها السلطة الإسلامية، وأنشأ ذلك نظاماً طائفياً للإدارة الذاتية للطوائف، ثم نصت على ذلك أكثرية دساتير أقطار الشرق الأوسط التي تحيا فيها أقليات غير إسلامية.
كانت المؤسسة الطائفية موجودة قبل الإسلام، واستمرت في المرحلة الإسلامية، وقد أطلقت الدولة الإسلامية لكل الكنائس والأديان حرية العمل وإدارة شؤونها الداخلية؛ ما تسبب في استياء بعض الطوائف التي كانت تضطهد طوائف أخرى قبل الإسلام، وتعتبرها مهرطقة.
وفي ظل العباسيين كان البطريرك النسطوري يحظى بأهمية خاصة، وتنظر إليه السلطة الإسلامية، باعتباره رئيساً زمنياً وروحياً لجميع النصارى بلا تمييز، وفي طور لاحق لم يعترف العثمانيون لحقبة مديدة من الزمن إلا بسلطة بطريرك الروم في آسيا الصغرى، وسلطة بطريرك أقباط مصر وسلطة بطريرك الأرمن، وفي المقابل استنّ بطاركة الموارنة لأنفسهم تقليد الاستقلال الواسع النطاق عن السلطة الإسلامية، وفي القرن التاسع عشر توسعت الكنائس المستقلة أو المرتبطة بالكنائس المركزية بعيداً عن الدولة العثمانية التي دخلت في مرحلة من التراجع.






