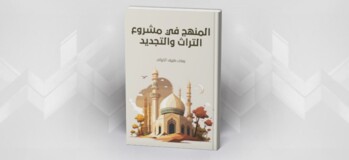ابن رشد عند محمد عابد الجابري الاستعادة ورهان التوظيف
فئة : أبحاث محكمة
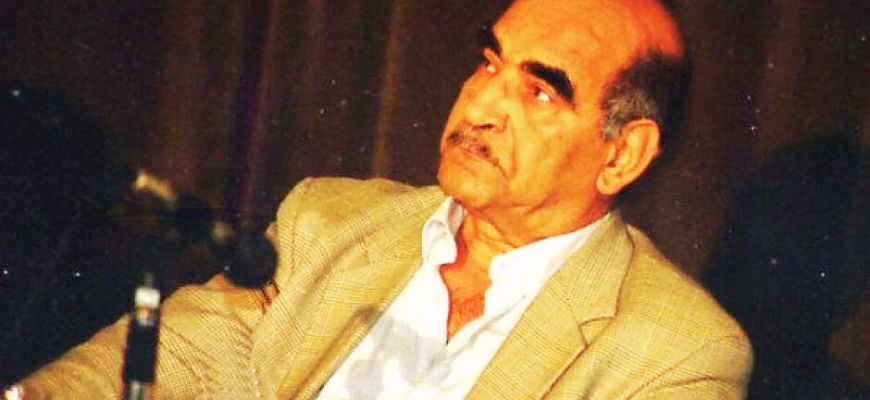
ابن رشد عند محمد عابد الجابري
الاستعادة ورهان التوظيف
ملخص الدراسة
تنطلق هذه الدراسة من محاولة رصد الحضور الرشدي في الفكر الفلسفي في المغرب؛ وذلك بالوقوف عند الكيفية التي تم بها استحضار ابن رشد واستعادة إرثه الفلسفي عند محمد عابد الجابري.
ويعد الجابري واحدًا من أهم من اهتموا بابن رشد في السياق الأكاديمي المغربي، حيث عمل على تحديد معالم "رشدياته" انطلاقا من عمله الموسوم ب "نحن والتراث"، ليقوم تاليا بمحاولة توضيحها وتعضيدها وتأسيسها تاريخيا، متوّجا كل ذلك بعمله الموسوم "ابن رشد سيرة وفكر".
ويمكن القول إن الفكرة الأساسية في "رشديات" الجابري، هي قوله بالقطيعة الإبستيمولوجية التي أحدثها ابن رشد بينه وبين فلاسفة المشرق. معتبرا فيلسوف قرطبة صاحب مشروع علمي تصحيحي إصلاحي مسّ كافة الميادين المعرفية في عصره من شريعة وعقيدة وفلسفة وعلم وسياسة. مشروع بأفق معرفي واسع وبخطاب نقدي برهاني، جعل منه ممثل العقلانية-البرهانية في تراثنا تتضمن مجموعة من العناصر القابلة للتوظيف ضمن انشغالاتنا المعاصرة. ومن هنا، كانت الاستعادة الجابرية لابن رشد، استعادة "إيديولوجية" تمليها هموم الحاضر وانشغالات الفكر العربي المعاصر.
مقدمة عامة
لقد حظيت الدراسات الرشدية باهتمام بالغ في الفكر الفلسفي بالمغرب؛ إذ عرفت حضورًا متميزًا في الساحة الأكاديمية العربية من لدن مجموعة من الدارسين الذين عرفوا بأعمالهم التي تندرج ضمن حقل الدراسات الرشدية. وقد شمل هذا الحقل مجموعة من الأبحاث ذات الطابع الأكاديمي التي جعلت من النص الرشدي المادة الأساس التي عملت على قراءته وتأويله وتحقيقه، وهي أبحاث ربطت صلتها بابن رشد عن طريق إثارتها الانتباه إلى ضرورة الوقوف عند فيلسوف قرطبة وفلسفته، كونها جديرة بالرجوع إليها بهدف المزيد من البحث والتأمل فيها، وهي عودة تحفز الذات وتمكنها من »استئناف قول فلسفي عربي مستقل يستجيب لتحديات نظرية وعملية في الحاضر العربي«[1].
ومن بين هؤلاء الباحثين الذين ارتبطت أسماؤهم بالدراسات الرشدية، حيث أسسوا انتماءهم البحثي عن طريق الانتساب إليها، نجد كلاًّ من المصباحي محمد جمال الدين العلوي، ومحمد عابد الجابري الذي سيكون موضوع دراستنا. فما يجمع بين هؤلاء بحثيًّا، هو الاهتمام بالنص الرشدي، وإذا كان هذا الأخير هو ما يوحد هؤلاء جميعًا، فإن القراءة التي قدمت بصدده عرفت تباينا واختلافا من طرفهم، حيث نلفي أنفسنا أمام أفهام متباينة حول الكيفية التي يحضر بها ابن رشد في كل قراءة من تلك القراءات، مما يجعلنا نستنتج الآفاق الواسعة التي يختزنها النص الرشدي، وما يتضمنه من إمكانات واسعة قد تسعفنا في الإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي ترتبط بشواغلنا المعاصرة.
ضمن هذا السياق، تندرج قراءة محمد عابد الجابري للتراث الفلسفي لابن رشد؛ إذ عمل الجابري على تحديد معالم "رشدياته" منذ كتابه "نحن والتراث"، ثم عمل تاليا على البحث فيها، واستجلاب ما يؤكدها وتأسيسها تاريخيا في أعماله اللاحقة، خصوصا في ثلاثيته الشهيرة "نقد العقل العربي"، ليصل إلى إخراج نصوص ابن رشد بالتحقيق والضبط، ويتوج بعد ما جمع له من مواقف وآراء في مساره العلمي وقراءاته المتعددة كتابه "ابن رشد سيرة وفكر". فطيلة هذه المسيرة العلمية الأكاديمية، ظل الجابري مدافعا عن القول الرشدي ومنافحا عنه، متمثلا "الروح الرشدية" في كل ما كتب تقريبا. ويمكن القول إن الفكرة الأساسية في "رشديات" الجابري، هي قوله بالقطيعة التي أحدثها ابن رشد مع الفارابي وابن سينا في المشرق الإسلامي، وهي الفكرة التي سعت جل أعمال الجابري إلى توضيحها وتأسيسها تاريخيا. فراهنية النص الرشدي عند الجابري تكمن في كونه »يجيب عن شواغل إصلاحية وعن نقد إصلاحي للعقيدة، ونقد للمجتمع ونقد للمتكلمين. وهذا النقد هو الذي تم تغييبه بين تلافيف الطبعات العربية، واكتفت بتكريس أطروحة التوفيق بين الدين والفلسفة، وهي أطروحة النزعة الاستشراقية«[2]. فابن رشد حسب الجابري، هو صاحب مشروع علمي تبلور في ذهنه من خلال الممارسة العلمية كرسالة تصحيح في كافة المجالات، مجال العقيدة ومجال الفلسفة والعلوم، ليمتدّ هذا العمل التصحيحي الإصلاحي إلى مجال السياسة في أواخر حياته كما يدعي ذلك. فقد كان مشغولا بهواجس نهضوية تجسدت في إعادة بناء الذات العربية من خلال العمل على استعادة الأبعاد العقلانية من ترثنا وتوظيفها في معالجة شواغلنا المعاصرة؛ إذ اعتمد الجابري مفهوما للتراث، لا تكون استعادته عن طريق استعادة المادة المعرفية، وإنما توظيف مضامينها الإيديولوجية خدمة لقضايا معاصرة.
ومن هنا، كان وقوفه عند فلسفة ابن رشد وتشبثه بها، مبرزا طابعها العقلاني البرهاني، وهو ما دفعه إلى وضع ابن رشد في مرتبة عليا سما به إلى مقام النموذج أو البراديغم بالنسبة إلى الثقافة العربية كما يقول محمد المصباحي.
من هذا المنظور، سنسعى إلى تقديم قراءة محمد عابد الجابري للإرث الفلسفي لابن رشد، محاولين تجميع عناصر الرؤية الجابرية لهذه الفلسفة، وطبيعة القراءة التي سلكها في استعادة صورة ابن رشد وفلسفته، وكذلك الرهانات التي كانت هذه القراءة تبتغيها. الأمر الذي سيدفعنا إلى حصر عناصر الإشكالية التي نبتغي الوقوف عندها في دراستنا هذه، ضمن مجموعة من التساؤلات التالية: كيف تحضر الفلسفة الرشدية في القراءة الجابرية؟ ما هي العناصر المؤسسة لهذه القراءة؟ كيف استعادت هذه القراءة صورة ابن رشد واستحضرتها؟ وما هي الرهانات التي كانت تبتغيها من وراء هذه الاستعادة وهذا الاستحضار؟
أولا: قراءة الجابري للتراث الفلسفي الرشدي
1: القطيعة ووحدة الخطاب عند ابن رشد
ينطلق الجابري في تعامله مع نصوص ابن رشد بوصفها خطابًا فلسفيًّا واحدًا يتمحور حول قضية واحدة تستوعب جميع التحولات التي يتحرك من خلالها فكر ابن رشد الفلسفي. لهذا يؤكد أن كل قراءة لهذه النصوص الرشدية تستمد مصداقيتها من مدى "تمكن القارئ من ربط النصوص مع بعضها البعض، ويجعل بعضها يشهد على بعض في عملية استنطاق متواصلة قوامها الألفة والتآلف...فابن رشد كان ذا مشروع فكري إصلاحي تصحيحي، وأن الوعي بهذا المشروع بدأ يفرض عليه نفسه مع تقدمه في عمله العلمي"[3]. لهذا كان يعيب الجابري على القراءات السابقة للنصوص الرشدية، عربية واستشراقية، السقوط في التجزيئ، حيث ظلت في غالب الأحيان مرتبطة بشروحاته على أرسطو دون أن ترقى إلى استشكال التراث الفلسفي لابن رشد، مغيبة »الموضوعات التي يطرحها(ابن رشد) في مؤلفاته الأصيلة، والتي تتناول قضايا من صميم الفكر العربي ...وقد بقيت مغيبة مهجورة مع أنها هي التي تدعو الحاجة إلى استئناف النظر فيها في أفق تدشين رشدية جديدة في عملية النهضة والتجديد«[4].
فقراءة الجابري قراءة مغايرة لتراث ابن رشد الفلسفي، تستند أساسًا على القطيعة التي أحدثها فيلسوف قرطبة مع فلاسفة المشرق السابقين خصوصا الفارابي وابن سينا. وقد استند الجابري في هذه القراءة على جملة من المفاهيم التي تنتمي إلى حقول معرفية معاصرة، من أهمها مفهوم القطيعة الإبستيمولوجية لإظهار أوجه التباين والاختلاف بين المدرسة الفلسفية في المشرق خصوصا مع الفارابي وابن سينا، والمدرسة الفلسفية في المغرب التي وصلت ذروة تطورها العقلاني مع ابن رشد؛ إذ وعلى الرغم من الاتصال الظاهري بينهما "بوصفهما تنتميان معا إلى ما اصطلح على تسميته بالفلسفة الإسلامية أو الفلسفة في الإسلام، لا ينبغي أن يخفي انفصالا أعمق بينهما"[5]. فهو ينطلق من جود مدرسة فلسفية في المغرب اتخذت العقلانية-البرهانية نهجا لها مع ابن رشد، معتبرا هذه المدرسة لحظة إعادة تأسيس في الثقافة العربية الإسلامية وصلت أوج ذروتها العقلانية مع فيلسوف قرطبة الذي جاءت أعماله لمواصلة "عمل ابن باجة، بما ألفه في العلم الطبيعي الأرسطي-البرهاني وشروح تجاوز فيها ليس الفارابي وابن سينا وحسب، بل وابن باجة نفسه خاصة في شرحه الكبير. ولم يقف ابن رشد عند حدود التأسيس البرهاني للعلم الطبيعي، بل عمم عملية إعادة التأسيس تلك لتشمل المنطق وما بعد الطبيعة وما استغلق من النصوص الأرسطية بسبب قلق العبارة التي وقع فيها الشراح السابقون، وخصوصا تلك التي ارتكبها ابن سينا"[6].
وفي تصنيفه للأنظمة المعرفية الثلاثة: البيان والعرفان والبرهان، يرى الجابري أن لكل نظام مسلكا خاصا به، ويشتغل وفق شبكة مفاهيمية مرتبطة به، وأن كل تداخل بينها سيؤدي إلى حصول أزمة، وهذا ما حصل في ق 5 هجري مع الغزالي. وهي الأزمة التي شهدت حلا لها في المغرب والأندلس، حيث تم الاعتماد على المنهج البرهاني، مما شكل قطيعة مع المشرق. هذه القطيعة يمثل ابن رشد قمة تجلياتها، حيث تمكن من »تحقيق قطيعة ابستيمولوجية مع ابن سينا؛ (أي) إنه فكر في إشكالية غير إشكاليته بجهاز معرفي غير جهازه«[7].
فالقطيعة الإيبستيمولوجية التي أحدثها ابن رشد مع فلاسفة المشرق السابقين وخصوصا ابن سينا، تمت حسب الجابري على ثلاثة مستويات: المنهج، والمفاهيم، والإشكالية النظرية.
فالجابري يرى أن ابن رشد ينطلق من وجود وحدة على مستوى المنهج لدى المدرسة في المشرق تجمع بين »ابن اسينا والغزالي وسائر المتكلمين...لا يستعملون الطرق البرهانية، وإنما يعتمدون طريقة في الاستدلال لا تبلغ مرتبة اليقين في القضايا الفلسفية...فابن رشد ينظر إلى الفكر النظري في المشرق كفكر تجمعه وحدة المنهج، وأنه يرفض هذا المنهج بقوة لأنه منهج غير برهاني«[8]. الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول هذا المنهج الدي اعتمده ابن سينا والغزالي وسائر المتكلمين، وهو المنهج الذي يعدّه ابن رشد منهجا يشوش على الفلسفة والدين سواء بسواء. إنه المنطق الإسلامي الثلاثي القيم أو »القياس باصطلاح النحاة أو الأصوليين أو "الاستدلال بالشاهد على الغائب" باصطلاح المتكلمين. وتكاد تنحصر آلية هذا القياس في البحث عن قيمة ثالثة تكون جسرا بين الشاهد والغائب...لا يهدف إلى البحث عن النتيجة كما هو الشأن في القياس الأرسطي، بل كل هدفه البحث عن الحد الأوسط، ذلك لأن النتيجة معطاة سلفا«[9]. وخطأ ابن سينا حسب ابن رشد هو اعتماده هذا المنهج في القضايا الفلسفية؛ إذ إن "نقطة الضعف في هذا الاستدلال- في نظره- أنه يجمع بين عالمين مختلفين تماما، عالم الطبعة وعالم ما بعد الطبيعة...في حين أن هذا الاستدلال لا يصلح - كما يقول - إلا حيث تكون النقلة معقولة بنفسها؛ وذلك عند استواء طبيعة الشاهد والغائب...ولذلك لا يصحّ قياس أحدهما على الآخر«[10]. ومن هذا المنظور النقدي لمنهج ابن سينا والمتكلمين، سيرفض ابن رشد المفاهيم الأساسية التي وظّفها هؤلاء جميعًا في محاولاتهم الرامية إلى التوفيق بين الدين والفلسفة. فرفض المنهج يستتبع بالضرورة رفض المفاهيم التي تصدر عنه.
أما على مستوى البنية المفاهيمية، فالجابري يرى أن بنية الفكر النظري الفلسفي والديني في المشرق تتحرك وفق مفاهيم مثل »الحدوث والقدم، الممكن والواجب، العلم الإلهي والعلم والإنساني النهاية واللانهاية، الكثرة والوحدة، السببية وحرية الإرادة...يتعلق الامر بمجموعة من المفاهيم المتناقضة، ولكن المترابطة المتضايفة. فالمعنى الذي نعطيه للحدوث مثلا لا يؤثر على معنى القدم فقط، بل ينسحب أثره على جميع تلك المفاهيم. من هنا كان اتخاذ موقف من حدوث العالم أو قدمه يستلزم موقفا مماثلا إزاء كل زوجين من هذه السلسلة...والفكر النظري في المشرق، كلاما وفلسفة، كان مركزا كله على محاولة التوفيق بين هذه الأزواج المتنافرة من هذه المفاهيم، أي التوفيق بين النقل والعقل (إشكالية المتكلمين) أو دمج الدين في الفلسفة (إشكالية الفلاسفة الفارابي وابن سينا خاصة) والهدف من كل هذا بناء بنية جديدة ترضي النقل والعقل معا"[11]. وابن رشد، حسب الجابري، يرفض المضامين التي قدّمت لهذه المفاهيم، موجها نقدا لها ومقترحا بديلا عنها، وهي مفاهيم حركت بنية هذا الفكر النظري، بنية "تعتمد في ديناميتها الداخلية على نوع من الاستدلال يعمد دوما إلى مقايسة ما هو ميتافزيقي بما هو فزيقي(طبيعي) مجتهدا في البحث عن قيمة ثالثة تمكن من التوفيق بين عالم الغيب وعالم الشهادة...الشيء الذي طبع الفكر النظري في المشرق بالطابع التوفيقي الواضح«[12].
أما القطيعة الإبستيمولوجية على مستوى الإشكالية النظرية، فيعمل الجابري على تحليل عوامل تشكل الفكر النظري في المشرق على عهد العباسيين خاصة، ليخلص إلى أن »المشكل الأساسي الذي تمحورت حوله حركة هذا الفكر ونشاطه، هو مشكل التوحيد والتعميم: توحيد اللغة والقانون والعقيدة والإيديولوجية السياسية وتعميمها في مجتمع قدّر له أن يكون ملتقى للأجناس والديانات والعادات والأفكار ولكل الميولات السياسية والفكرية، مجتمع جديد خلقة الإسلام الذي غزا مراكز الحضارات القديمة التي عرفها الشرق الأوسط«[13]. أمام هذا الوضع، ستصبح المشكلة الأساسية في هذا المجتمع هي تحقيق نوع من الوحدة تضمن له السلطة والاستمرارية، مما جعل من وحدة السلطة واستمرارية الدولة، الإشكالية العامة للفكر النظري في المشرق في بعديها السياسي والاجتماعي. على العكس من ذلك، نجد أن هذه الإشكالية الفكرية ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية، ليس لها ما يبرر وجودها في المغرب والأندلس على عهد الموحدين كما يرى الجابري. »فلم يكن المغرب والاندلس يعانيان في تلك الفترة من تلك الكثرة الكاثرة التي عان منها المجتمع الإسلامي في المشرق على عهد العباسيين...وهكذا وجد فلاسفة المغرب والاندلس أنفسهم متحررين من العوامل السياسية والثقافية والاجتماعية التي حركت إشكالية زملائهم في المشرق، فلم يعد هنا مبرر ولا دافع لتلك المحاولات الرامية إلى دمج الدين في الفلسفة...فسيعمل (هؤلاء) وابن رشد خاصة على الفصل بين الدين والفلسفة إنقاذا للدين والفلسفة سواء بسواء«[14]. فبنية الفكر النظري في المشرق (علم الكلام والفلسفة) تقوم على تصور للعلاقة بين الدين والفلسفة، قوامها دمج الدين في الفلسفة والفلسفة في الدين. فإذا كان الأشاعرة سعوا إلى إنشاء توفيق أفقه جعل الدين (النص) هو الأساس وله الأسبقية، فإن الفلاسفة عمدوا إلى نوع من آخر من التوفيق يكون فيه العقل هو الحكم والأساس. غير أن الذي سيحصل مع ابن رشد-حسب الجابري- هو الفصل التام بينهما، حيث دعا إلى فهم الدين داخل الدين وبمعطيات الدين وفهم الفلسفة داخل الفلسفة طبقا لمقدماتها وأصولها.
فاستنادا إلى مفهوم القطيعة الإبستيمولوجية هذا، كمفهوم إجرائي، يقدم الجابري قراءته للفلسفة العربية الإسلامية عموما ولفلسفة ابن رشد بشكل خاص. قراءة تقدم نفسها بوصفها مغايرة تماما للقراءات التي قدّمت للتراث الفلسفي لابن رشد، سواء العربية منها أو الاستشراقية.
فابن رشد تمكن من إحداث قطيعة مع فلاسفة المشرق خاصة الفارابي وابن سينا، وهي القطيعة التي يحصر الجابري تجلياتها على ثلاثة مستويات: على مستوى المنهج ومستوى المفاهيم ثم مستوى الإشكالية النظرية. فضمن هذا الأفق تحرك فكر فيلسوف قرطبة حسب الجابري، جعلته صاحب مشروع علمي تصحيحي في جل الميادين المعرفية في عصره، الديني منها والفلسفي والعلمي والسياسي.
2 - المشروع العلمي لابن رشد عند الجابري: تصحيح في كافة المجالات المعرفية
يقدم الجابري ابن رشد في صورة فيلسوف له مشروع علمي قوامه التصحيح في كافة ميادين المعرفة في عصره. فالعمل التصحيحي الرّشدي مس الميدان الديني والفلسفي والعلمي والسياسي أيضا.
وسنحاول أن نقدم بشكل مقتضب، العناصر الأساسية للعمل التصحيحي الذي أنجزه ابن رشد في المجالين الفلسفي والسياسي حسب الجابري.
على مستوى ميدان الفلسفة، يذهب الجابري إلى أن ابن رشد أنجز مهمة تصحيح وضع الفلسفة في السياق العربي الإسلامي، نظرًا إلى ما تعرضت له من تغيير بسبب انخراط المشتغلين بها (خاصة ابن سينا) في إشكاليات المتكلمين، وصرفها نحو أفق يعمل على دمجها في بنية الدين، مما أبرز الحاجة إلى التصحيح لبيان "تهافت" المتجادلين فيها. كما أنها (الفلسفة) تعرضت لتغيير آخر، حسب الجابري، قبل الإسلام بسبب اجتهادات المفسرين والشراح، فكان لا بد من قيام عملية تصحيح أيضا أنجزها ابن رشد بطلب من الأمير "أبي يعقوب يوسف" من خلال تلخيص كتب أرسطو ورفع القلق عن عباراتها ليسهل على الناس فهمها، وهو العمل الذي أنجزه بداية من خلال الجوامع والمختصرات والتلاخيص، قبل أن ينتقل في مرحلة تالية إبّان ممارسته للتدريس والتأليف، إلى توسيع الآفاق نحو تمثل واستيعاب للمنظومة الأرسطية عن طريق العمل ب "الشروح الكبرى" والمقالات والبحوث المتخصّصة، مكنته من الارتفاع إلى مستوى الفيلسوف الأصيل الذي يمتلك مواقف خاصة تلقي أضواء كاشفة عن الأصالة في تفكير ابن رشد الذي سينتقل من "الشارح" إلى الفيلسوف. ويمكن اعتبار كتاب " تهافت التهافت" لابن رشد حسب الجابري، أبرز عمل يمكن أن نستشف فيه العمل التصحيحي لوضع الفلسفة في السياق العربي الإسلامي؛ فهو عمل يندرج ضمن الأعمال الأصيلة لفيلسوف قرطبة، حيث لا يعد شرحا ولا تلخيصا مباشرا لكتاب معين.
ويحدد الجابري بعدين في هذا الكتاب للقيام بمهمة تصحيح وضع الفلسفة من طرف ابن رشد. أما البعد الأول، فيتمثل في اعتبار ابن رشد بمثابة القاضي في الفلسفة، حيث قام بالفصل في النزاع القائم بين "الغزالي" و"ابن سينا" من خلال اعتماده مبدأي العدل والإنصاف معا. فتوجه بالنقد إلى "ابن سينا" مبيّنا موطن الانحراف عن أصول الفلاسفة وبالأخص أرسطو. أما البعد الثاني، فيتمثل في تلك الصورة الإبداعية الأصيلة لفكر ابن رشد كما حددها الجابري، والمتمثلة في كون أن ابن رشد لم يكن مقلدّا لأرسطو، بل إن الشرح على النص الارسطي من خلال أنماط الكتابة المتعددة التي اعتمدها ابن رشد ما بين الجوامع والمختصرات والتلاخيص مثّلت بداية تصحيح وضع الأرسطية، مما شابها من قلق وغموض عباراتها، ثم من خلال الشروح والمقالات في مرحلة تالية ...جعلته يتجاوز أرسطو في الكثير من المسائل وفق ما يقتضيه مذهب أرسطو ذاته.
هذان البعدان هما اللذان حدّدا صورة التصحيح الفلسفي الذي قام به فيلسوف قرطبة كما يرى الجابري.
أما على مستوى ميدان السياسة، فيرى الجابري أن فيلسوف قرطبة سيطرق عمله التصحيحي مجال "العلم المدني"؛ إذ لمّا لم يتمكّن من الحصول على "كتاب السياسة" لأرسطو، عمد إلى تلخيص كتاب جمهورية أفلاطون، وهو العمل الذي سيمكّننا، كما يدعي الجابري من اكتشاف ابن رشد آخر كان مجهولا لدينا، الذي يواجه السياسة لأول مرة في تاريخ الفكر العربي الإسلامي بخطاب سياسي صريح مندّدا بالاستبداد في بلده، ومبرزا الحاجة إلى الإصلاح، مما مكنه من الظهور بصورة المصلح الذي يعمد إلى تصحيح السياسة كعلم بالارتفاع بها من المستوى الجدلي إلى المستوى العلمي؛ وذلك باستخراج الأقاويل العلمية من جمهورية أفلاطون دون الجدلية، مؤكدًا على إمكانية تحقيق المدينة الفاضلة واقعيًّا بطريق غير طريق أفلاطون. كما نقف على البعد التطبيقي في عملية التصحيح هذه من خلال التنديد بالوضع السياسي في الأندلس وإحلال أمثلة من التاريخ السياسي العربي الإسلامي عوضا عن اليوناني كما وظفه أفلاطون.
ففي تلخيص ابن رشد لكتاب "جمهورية" أفلاطون، والذي اقترح له الجابري عنوان سمّاه "الضروري في السياسة، مختصر السياسة لأفلاطون. عمل ابن رشد حسب الجابري على صياغة آراء أفلاطون الواردة في كتابه الجمهورية صياغة علمية ترفع السياسة إلى "علم" يجعل من "العلم الطبيعي" أساسا له. هذا الجانب الإبستمولوجي المنهجي هو ما قاده إلى تجاوز أفلاطون، وعدم التقيد بطريقة كتابة هذا الأخير المبنية على الحوار الجدلي، بل » تجاوزها إلى خطاب تحليلي تركيبي...خطاب برهاني...لم يتقيد فيه فيلسوف قرطبة بالطريقة التي سلكها أفلاطون في تبويب كتابه (إلى عشرة أبواب)، بل خط ل "مختصره" تبويبا منطقيًّا جديدًا يستجيب للصياغة العلمية التي توخاها فجعله ثلاث مقالات«[15]. فالمسألة المنهجية التي واجهت ابن رشد حسب الجابري، هي تحويل النص الأفلاطوني من محاورة تعتمد الجدل إلى نص يعتمد التحليل والتركيب، وتلخيصه من كل الأساطير التي لا تدخل ضمن العقل العلمي. لهذا، يصبح التصحيح السياسي الرشدي من منظور الجابري، جعل الفكر السياسي يرتفع من المستوى الجدلي إلى المستوى العلمي. الأمر الذي سيدفع الجابري مرة أخرى إلى الإقرار بنوع من القطيعة على مستوى الفكر السياسي الرشدي والفكر السياسي المشرقي، خصوصا مع الفارابي في كتابيه "الملة" و"آراء أهل المدينة الفاضلة"، »حيث نجد أنفسنا أمام نفس الحقيقة، وهي أن فيلسوف قرطبة قد قطع مع نوع من الكلام الذي تكلمه الفارابي في السياسة والمدينة الفاضلة، ليدشن خطابا جديدا في العلم المدني يواجه السياسة بخطاب سياسي صريح وشجاع«[16]. ويسجل الجابري فرقا في تعامل كل من الفارابي وابن رشد مع جمهورية أفلاطون؛ إذ يرى أن »مؤلفات الفارابي السياسية لا يمكن فصلها عن نظامه الميتافزيقي العام، ولا فهمها خارجه. لقد بنى الفارابي مدينته الفاضلة على غرار نظام الكون الذي شيّده على أساس نظريته في الفيض(فهو) لا يهتم ب "المدينة" كمجتمع ودولة واقتصاد وتربية وعلاقات اجتماعية، وإنما يهتم أساسا ب"الآراء"...أما ابن رشد...فقد عرض لموضوعات السياسة في استقلال تام عن الفلسفة الميتافزيقية. لقد اهتم - شارحا أفلاطون- بتحليل أنواع الحكم...وكيفية تحول نوع منها إلى آخر وأسباب ذلك. وأكثر من ذلك حرص على تلخيص آراء أفلاطون مما يتخللها من "أقاويل غير برهانية«[17].
ويعدّد الجابري المناسبات التي يستحضر فيها ابن رشد الواقع العربي الإسلامي عامة، والأندلسي خاصة، وهو بصدد شرح آراء أفلاطون في أنظمة الحكم؛ منها مثلا عندما »كان ابن رشد بصدد شرح آراء أفلاطون في سلوك أصحاب مدينة الكرامة(=التيموقراطية) طالبي المجد والشرف الذين يجمعون أحيانا بين حب المال وسلوك مسلك العبيد في مواقف معينة، ومسلك السادة الطغاة في مواقف أخرى...(وكذلك) عندما كان بصدد شرح رأي أفلاطون في تحول المدنية الجماعية(=الديمقراطية) إلى مدينة التغلب والاستبداد... (وكذلك) في سياق شرحه لآراء أفلاطون حول تحول الحكم الجماعي إلى حكم الطغيان«[18]، وهي المناسبات التي يرتبط فيها فيلسوف قرطبة حسب الجابري بالواقع السياسي الأندلسي خاصة، مما يعطي للخطاب السياسي البرهاني الذي رام تشييده من وراء تلخيصه لجمهورية أفلاطون طابعًا نقديًّا، قد يؤول ضده نظرا إلى ما فيه من نقد صريح، ومن تكرار إلى الإشارة إلى حكم زمن خلافة يعقوب المنصور الموحّدي .
الأمر الذي دفع الجابري إلى استنتاج، أن كتاب ابن رشد هذا أي "الضروري في السياسة، مختصر السياسة لأفلاطون" هو السبب الأول في نكبة ابن رشد. فيتوجه بالنقد لبعض التفسيرات المقدّمة لتفسير هذه النكبة معتبرا إياها مجرد تخمينات تجعل الحدث مفهوما والتفسير المقترح مقبولا دون أن تتمكن من الكشف عن السبب الحقيقي وراء هذه النكبة، ليخلص في النهاية إلى اعتبار أن »نكبة ابن رشد كانت بسبب ما نسب إليه من أمور ذات طبيعة سياسية، هي ما ورد في كتابه جوامع سياسة أفلاطون من انتقاد للأوضاع السياسية في الأندلس، وهي انتقادات كان لابد ان تثير شكوك حول علاقته بأبي يحيى أخ المنصور...فلم يكن سبب نكبته هو ما ذكره المنشور الذي أصدره الخليفة المنصور الذي يتهم ابن رشد وجماعة من أصحابه بالاشتغال بالفلسفة والعلوم القديمة. كلا، لقد وقعت الفلسفة هنا مرة أخرى ضحية السياسة، وبدلا من أن يأمر الخليفة المنصور بإحراق الكتاب الذي أثار غضبه، كتاب "جوامع سياسة أفلاطون" أمر بإحراق الكتب كلها ليس انتقاما من الفلسفة ذاتها، بل تغطية للكتاب المقصود بالذات«[19]. فابن رشد يحضر هنا في تصور الجابري وقراءته لأسباب النكبة، بصفته »مناضل ومعارض للخليفة يعقوب المنصور الموحّدي الذي تم تقديمه في شخص حاكم مستبد ومغتصب للخلافة من إخوته بعد وفاة أبيه، ومن خلال تصوره المتمثل في مغامراته العسكرية«[20].
ثانيا: أبعاد القراءة الجابرية للتراث الفلسفي لابن رشد
إن استعادة ابن رشد عند الجابري لا تكاد تنحصر في استخراج مخطوطاته ونصوصه وتحقيقها وقراءة مضامينها وفقط، بل هي استعادة قوامها "التوظيف" فيما يمكن أن يفيد في شواغلنا المعاصرة ضمن ما يسميه الجابري ب "تأصيل الحداثة في الفكر العربي المعاصر من الداخل". إنها استعادة "إيديولوجية" تجعل من ابن رشد أبرز ممثلي الاتجاه العقلي في الفكر العربي، يمكن توظيف مقولاته ومواقفه في انشغالاتنا الحاضرة وإخراجه إخراجا حداثيا عصريا بوصفه فيلسوف العقلانية والبرهان والتنوير...
إنه صورة النموذج الذي نجد عنده حلول لبعض المشكلات التي نعاني منها هنا والآن. فالتراث الفلسفي لابن رشد بالنسبة إلى الجابري يتضمن مجموعة من العناصر القابلة للتوظيف ضمن شواغلنا المعاصرة، منها مثلا، ما قدمه بخصوص طبيعة العلاقة بين الفلسفة والدين وتقديمه لبديل قابل للتوظيف لبناء علاقة بين تراثنا والفكر العالمي المعاصر بشكل يحقق ما تنشده الذات العربية من أصالة ومعاصرة...وكذلك قدرة الرشدية على تحقيق قطيعة مع "السينيوية" وعلم الكلام في المشرق كفكر متجه إلى الوراء...كما يمكن أن تسعفنا-حسب الجابري دائما- في مسألة التعامل مع الغير، وهي المعاصرة اليوم، والتي كانت توازي الفلسفة اليونانية زمن ابن رشد...
إن الصورة التي يحضر بها ابن رشد في فكر الجابري كنموذج استثنائي، يمكن اختزالها كما يقول الأستاذ محمد المصباحي في "العقلانية". إنها تلك العقلانية البرهانية التي كانت مطمع الجابري في زرع "بذورها" في الفكر العربي المعاصر لتمكين الذات العربية من مقومات المجابهة والتحدي الحضاري.
فعودته إلى ابن رشد، ليست فقط عودة من أجل شرح مؤلفاته، بل سيعمد إلى تأويل وقراءة المتن الرشدي بهدف تقريبه إلى عصر الحداثة، وجعله المدخل الضروري لكل تجديد في الثقافة العربية الإسلامية من داخلها معتبرا التعريف »بسيرته وفكره خطوة ضرورية في استنبات رشدية عربية إسلامية، هي وحدها القادرة على أن تعطي لحياتنا الثقافية ما هي في حاجة إليه من القدرة الذاتية على التصحيح والتجديد«[21]؛ إذ إن الجابري يصدر في أطروحته العامة ضمن مشروعه النقدي للعقل العربي، عن تأصيل الحداثة في الفكر العربي من الداخل؛ »فهو يبحث إيجابا عن البرهانية والعقلانية، وسلبا عن اللاعقلانية في التراث«[22]. من هنا تكتسي العودة لابن رشد عنده أهمية بالغة تستمد قوة حاجتها مما يعيشه الفكر العربي المعاصر؛ إذ يصرح بجملته الشهيرة: "ما تبقى من التراث لا يكمن أن يكون إلا رشديا، وما تبقى من ابن رشد لا يمكن أن يكون إلا الروح الرشدية". وهكذا أضحت العودة إلى ابن رشد، ضرورة تاريخية وحضارية تمليها طبيعة الواقع العربي بأعطابه التي تعمل على حصر زمنه ضمن سلسلة من الإخفاقات المتتالية دون القدرة على النهوض نحو أفق قادر على بناء ذات عربية لها مقومات التحدي والمجابهة الحضارية. عودة لا تنحصر في تحقيق النصوص، وإخراج المخطوطات ومساءلة ومضامينها...وإنما تلك العودة القادرة على التمكين من استيعاب الماضي واستشراف سبل تعكس مستوى من مستويات الوعي المعاصر. إن استعادة ابن رشد في فكر الجابري تتجاوز مستوى تحقيق النصوص وإخراجها وتأويل مضامينها، إلى مستوى آخر يتضمن رهانات لها أبعاد وثيقة الصلة بما يعيشه الفكر العربي المعاصر. إن الرغبة في العودة إلى فيلسوف قرطبة عند الجابري، مسكونة بمآزق الذات العربية هنا والآن. فاستعادة ابن رشد، ضرورة تمليها اللحظة المعاصرة بحثا عما يمكن به أن نجدد ونعمل على تأصيل الحداثة من الداخل.
يذهب الأستاذ محمد المصباحي إلى أن رهان الجابري في احتفائه بفيلسوف قرطبة، واستعادته في اللحظة الراهنة للسياق التاريخي والحضاري للواقع العربي، يتحدد في »هاجس تصحيح صورة ابن رشد، هذا الهاجس الذي تولد لديه مبكرًا منذ بدايات أبحاثه؛ أي منذ ما يناهز 25 سنة في خضم تطلعه المحموم لتحيق حلم زرع بذور العقلانية. لقد حاول الجابري أن يقوم إزاء ابن رشد بما قام به ابن رشد إزاء معرفة زمانه إنقاذا للأمة التي كانت مهددة آنذاك في وجودها. فإذا كان أبو الوليد قد قام بواجب "التصحيح"...في مختلف حقول المعرفة، فإن الجابري وجد نفسه مدفوعا للقيام بتصحيح صورة ابن رشد في الفكر العربي مما شابها من قلق وتشويه وغموض وضبابية في مخيلة الجمهور العربي...فقد تقمص(الجابري) صورة ابن رشد في رغبته في الإصلاح الشامل، في إرادته في إحياء القول الفلسفي العربي، وعثوره على جملة من العلاقات البنيوية التي كانت وراء إقدام ابن رشد على صياغة مشروع عقلاني نقدي مناهض للمشروع السينوي، وهو شبيه بابن رشد في ارتباطه بالواقع التاريخي والفكري للإنسان العربي...وفي دعوته للعقل والبرهان«[23]. هكذا يحضر ابن رشد في فكر الجابري كفيلسوف عقلاني مؤسس لخطاب برهاني نقدي، خطاب قادر على استيعاب اللحظة الراهنة للذات العربية. وبحكم تضمنه للعقلانية النقدية وامتلاكه لروح تجديدية اجتهادية؛ فهو النقطة النيرة في التراث العربي الإسلامي القادر على تزويد الذات العربية بكل المقومات التي تحتاجها ضمن مجابهة التحديات والرهانات الحضارية. إنها صورة الفيلسوف الذي »يجمع بين التجديد والتنوير، بين العلم والأخلاق، بين الالتزام والتعالي...إن ابن رشد بالنسبة إلى الجابري يلخص علاقة التراث بالحاضر...لقد تناول(الجابري) ابن رشد خطابيا فتصوره كما أراد أن يكون؛ أي من حيث كونه معاصرا لنا، صالحا لأن يؤدي دور الرمز والشعار في إصلاح المدينة...وإذا جاز لنا أن نلخص صورة ابن رشد في الرؤية الجابرية بكلمة واحدة، فإنها ستكون حتما "العقلانية"...فالعقلانية الرشدية هي عقلانية برهانية...وعندما تصل هذه الأخيرة عند ابن رشد إلى أوجها تنتقل إلى مرتبة الأكسيومية...كما يمكن وصفها بالواقعية...والنقدية، وعقلانية تاريخية«[24].
كما تتجلى كذلك الاستعادة الرشدية، في كون أن تاريخ ابن رشد يشبه إلى حد كبير تاريخ الفكر العربي حيث الصراع الفكري والإيديولوجي والسياسي. وحيث كذلك تلك القدرة التي أبانها ابن رشد عن انتمائه إلى الثقافة الانسانية نأت به عن أشكال التعصب والانغلاق. فكانت استعادة الجابري لابن رشد واستحضاره وتجديد القول في تراثه، تعبيرا عن الحاجة إليه لا لاتخاذه كمنطلق ثابت، بل للاستئناس بفهمه ومنهجه ورؤيته كفيلسوف استطاع ان يعيش عصره، بالرغم من المحن التي تعرض إليها. ولعل في هذا ما يشد الجابري إلى الاهتمام به، انطلاقا من حاجة معاصرة لعقلنة التراث. فالجابري قد سما بابن رشد إلى »النموذج أو البراديغم بالنسبة إلى الثقافة العربية المعاصرة، فهو يتكلم عنه كما لو كان رافعا شعار: "يا مثقفي العالم العربي اتحدوا حول هذا الفيلسوف المتنور واقتفوا أثره«[25]؛ إذ يعد الجابري ابن رشد النموذج الأمثل للمثقف المطلوب اليوم، حيث إن »الجيل الصاعد إما أن يكون رشديا، فيتقدم على مدارج الأصالة والمعاصرة معا، وإما أن لا يكون ولا مكان له في هذا العالم«[26]. إن صورة ابن رشد المستعادة من طرف الجابري، هي صورة ذلك المثقف القادر على أن يجيب عن مجموعة من الأسئلة المرتبطة بشواغلنا المعاصرة. فاستعادته »ضرورة تمليها علينا، ليس فقط المكانة المرموقة التي يتبوؤها هذا الرجل في تاريخ الفكر الإنساني، والتي غابت في تاريخ فكرنا العربي، بل تمليها علينا كذلك حاجتنا اليوم إلى ابن رشد ذاته: روحه العلمية النقدية الاجتهادية، واتساع أفقه المعرفي، وانفتاحه على الحقيقة أينما تبدت له، وربطه بين العلم والفضيلة على مستوى الفكر وعلى مستوى السلوك سواء بسواء«[27].
هذا الإعجاب الفائق بابن رشد كنموذج استثنائي، والاحتفاء به في فكر الجابري يعود إلى اتصاف هذا النموذج بجملة من الخصال قلما اجتمعت في شخص واحد، يحددها الجابري في أربعة أنواع من الخصال. فهو يتميز بكونه مالكا ل »خصال إبداعية: إذ إن مشروعه لم ينحصر في القيام بإصلاحات معرفية محدودة أو تقويم أخطاء جزئية وقع فيها السابقون عليه وبخاصة ابن سينا ومن تبعه، بل كان غرضه إحداث القطيعة معهم وتقديم بديل جديد كل الجدة. ولذلك، لا نستغرب إذا كان لديه وعي واضح بجدة آرائه...خصال علمية: حيث كان مسكون بهاجس الحقيقة حريص على قولها بالطابع العلمي الصرف، له نظرة كلية شاملة ترقى إلى مستوى عال من النسقية المحكمة والنزعة الأكسيومية الصارمة...كما يتميز بتطويع آراء الآخرين لخدمة مشروعه العلمي...(ثم) خصال عملية: اتصافه بمجموعة من الخصال الأخلاقية والاستثنائية كتميزه بصرامة وأمانة علمية نادرة«[28]. كل هذا يضفي على فكر ابن رشد سمة أخرى هي الخلود؛ إذ تصل »درجة تجاوزه للزمن عند الجابري إلى اعتبار نقد ابن رشد للغزالي وابن سينا هو في الوقت نفسه نقد للفكر الكلامي الفلسفي العربي الإسلامي في عصرنا، لا بل جزء مهم وأساس من نقد العقل العربي نفسه. وترجع قدرة تجاوز فكر ابن رشد للزمن ومقاومة الصيرورة إلى كونه أحدث قطيعة مزدوجة إزاء السينيوية وإزاء الكلام، أي إزاء الفكر المتجه إلى الوراء«[29].
إن أهمية ابن رشد من هذا المنظور، تتحدد أساسا في عقلا نيته البرهانية، وهي عقلانية تفرض الحاجة اليوم، بالنظر إلى الوضعية التي يعيشها الفكر العربي المعاصر، إلى استعادتها لتحديد موقفنا من ثقافة الآخر. فما تبقى من تراثنا اليوم، ويمكن توظيفه في معالجة شواغلنا لا يمكن أن يكون إلا رشديًّا. ويحدد الجابري مجموعة من العناصر ضمن المشروع الرشدي يراها كفيلة بالتوظيف ضمن اهتماماتنا وشواغلنا المعاصرة لبناء ذات قادرة على مجابهة التحديات والرهانات الحضارية. فابن رشد قطع مع »الطريقة التي عالج بها الفكر في النظري-كلاما وفلسفة- في المشرق علاقة الدين بالفلسفة. لقد رفض طريقة المتكلمين في التوفيق بين العقل والنقل ورفض طريق الفلاسفة في دمج الدين في الفلسفة...فلنأخذ هذه القطيعة ولنتجنب تأويل الدين بالعلم وربطه به؛ لأن العلم يتغير ويتناقض ويلغي نفسه باستمرار، ولنتجنب تقييد العلم بالدين لنفس السبب. إن العلم لا يحتاج إلى أية قيود تأتيه من الخارج؛ لأنه يصنع نفسه بنفسه...(وكذلك قدم) البديل في مجال العلاقة بين الدين والفلسفة، يقبل أن نوظفه لبناء العلاقة بين تراثنا والفكر العالمي المعاصر بشكل يحقق لنا ما ننشده من أصالة ومعاصر... فلنقتبس منه كذلك هذا المنهج، ولنبنِ بواسطته علاقتنا بتراثنا من جهة والفكر العالمي المعاصر، الذي يمثل ما كانت تمثله الفلسفة اليونانية لابن رشد من جهة أخرى...لقد طرح ابن رشد مسألة التعامل مع "الغير"؛ أي ما نسميه اليوم "المعاصرة" (وكان الغير بالنسبة إليه هم العلماء أصحاب العلم أي اليونان)، فعالجها معالجة علمية ما أحوجنا إلى اقتفاء خطابها. لقد ميز في فكر الغير بين "المادة" و"الآلة"؛ أي بين المنهج والنظرية«[30]. إن ما نحتاجه الوم هو ما يسميه الجابري بالروح الرشدية ذات الطابع العلمي النقدي الاجتهادي.
يمكن القول إن الحافز الذي دفع الجابري نحو الرشدية، يكمن في العقلانية البرهانية النقدية لفيلسوف قرطبة، فعمل على توضيحها واستعادتها والتحاور معها؛ لأنها كفيلة بالإعانة على تحديد موقفنا من ثقافة الآخر. وهو ما دفعه إلى تصحيح صورة ابن رشد في الفكر العربي المعاصر بهدف تدشين رشدية جديدة قادرة على بناء النهضة والتقدم. »فما ننشده اليوم من تحديث للعقل العربي وتجديد الفكر الإسلامي، لا يتوقف على مدى استيعابنا للمكتسبات العلمية والمنهجية المعاصرة، مكتسبات ق 20 م وما قبله وما بعده، بل أيضا، ولربما بالدرجة الأولى، تتوقف على مدى قدرتنا على استعادة نقدية ابن حزم وعقلانية ابن رشد وأصولية الشاطبي وتاريخية ابن خلدون. هذه النزوعات العقلانية لابد منها إن أردنا أن نعيد ترتيب علاقتنا بتراثنا بصورة تمكننا من الانتظام فيه، انتظاما يفتح مجالا للإبداع«[31].
خاتمة عامة:
إن احتفاء محمد عابد الجابري بابن رشد، والعمل على التعريف به في الساحة الثقافية والأكاديمية تحليلا ونشرا، يكاد يوازي العمل الجماعي المنظم من داخل المؤسسات البحثية من لدن الجماعة العلمية. فالرجل منذ عمله "نحن والتراث" الذي بسط فيه "رشدياته"، وهو يعمل على توضيحها طلية مسيرته الأكاديمية حتى توّج جماع ذلك بعمله "ابن رشد سيرة وفكر".
ويذهب الأستاذ محمد المصباحي، إلى أن وصفه (أي الجابري) لشخصية ابن رشد فيه شيء من الجابري. فهو »فهو تقمص صورة ابن رشد في رغبته في الإصلاح الشامل، في إرادته إحياء القول العربي، وعثوره على جملة من العلاقات البنيوية التي كانت وراء إقدام ابن رشد على صياغة مشروع عقلاني وواقعي ونقدي مناهض للمشروع السينوي، وهو شبيه ابن رشد في ارتباطه بالواقع التاريخي والفكري للإنسان العربي«[32].
فابن رشد في فكر الجابري يحضر بوصفه فيلسوف العقلانية بامتياز. فيلسوف تمكن من إحداث قطيعة إيبستمولوجية مع فلاسفة المشرق السابقين، خصوصا الفارابي وابن سينا. فهو يمثل ذروة تطور العقلانية في المدرسية الفلسفية في المغرب والأندلس. هذه المدرسة التي يعدّها الجابري لحظة إعادة تأسيس في الثقافة العربية الإسلامية.
فأصالة إشكالية ابن رشد في تصور الجابري، تتحدد في كونها تتميز بالاستقلالية عن الفلسفة الإسلامية في المشرق؛ لأنها تعبير عن مشروع تاريخي مباين للمشروع الذي تم تبنيه هناك. هذا الترتيب المنهجي الذي كان منطلق الجابري في "رشدياته" والمبني على مفهوم القطيعة الإيبستمولوجية التي يرصد مستوياتها في ثلاثة جوانب: مستوى المنهج ومستوى المفاهيم ومستوى الإشكالية النظرية كما بيّنا في الفصل الأول، جعل صورة ابن رشد عند الجابري تتمثل في كونه صاحب مشروع علمي قوامه التصحيح في كافة ميادين المعرفة في عصره. فواجب التصحيح الذي أنجزه فيلسوف قرطبة، مسّ العقيدة والشريعة والفلسفة العلم والسياسة حسب الجابري. مشروع بأفق معرفي واسع وبخطاب برهاني نقدي. وحاولنا أن نقدم عناصر التصحيح الذي أنجزه ابن رشد حسب الجابري على مستوى الفلسفة ومستوى السياسة كما بيّنا في الفصل الثاني.
فالجابري يجعل من ابن رشد معاصرًا لنا من حيث كونه صالحًا لأن يؤدي دور الرمز والشعار كما يقول الأستاذ محمد المصباحي، من أجل إصلاح المدينة وإصلاح النظام الثقافي والاجتماعي والسياسي في العالم العربي. إنها تلك الاستعادة لابن رشد بهدف توظيفه ضمن انشغالات الذات المعاصرة؛ فهي استعادة برهانات إصلاحية تتوخى تمكين الذات العربية المعاصرة من إمدادها بما يجعلها قادرة على التحدي والمجابهة الحضارية ضمن ما يسميه الجابري "بالتجديد من الداخل". هذه الصورة التي يحضر بها فيلسوف قرطبة عند الجابري، هي ما يسميه الباحثين ب "الصورة الإيديولوجية"، فهي لا تتوخى من استعادة ابن رشد وتراثه الوقوف عند نصوصه قراءة وتأويلا لمضامينها فقط، بل تتجاوز ذلك إلى محاولة توظيفه ضمن انشغالات الذات العربية المعاصرة وهموم الفكر العربي المعاصر. فلم يكن الهدف من بحثه في الرشديات علمي أو فلسفي، وإنما كان إيديولوجي حسب تعبير الأستاذ محمد المصباحي؛ أي تحريك المحتوى لكي يصبح ملائما مناسبا لتطلعات الحاضر، فعّالا لإصلاح الفكر والدولة والتاريخ...
هذه الصورة التي رسمها الجابري عن ابن رشد، وقرأ من خلالها تراثه الفلسفي، جوبهت بمجموعة من الردود والانتقادات من طرف مجموعة من الباحثين في الدراسات الرشدية؛ إذ حاولوا بيان محدودية هذه القراءة الإيديولوجية التي قدمها الجابري نظرا إلى كونها تعمل على توظيف النصوص الرشدية وتأويلها وفق أفق يخرج بها عن مبتغى ومقصد صاحب النص نفسه. وهي ردود وانتقادات من الكثرة والغنى لا حصر لها، تجعل من الجابري واحدا ممن أثروا في الفكر العربي المعاصر، وتقوم دليلا على ما يختزنه مشروع الجابري من أفق معرفي واسع قد يكون سبيلا لبيان بعض جوانب قصور الفكر العربي المعاصر.
المراجع المعتمدة:
- محمد عابد الجابري، ابن رشد سيرة وفكر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 1999
- محمد عابد الجابري، نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، المركز الثقافي العربي، الطبعة السادسة 1993
- محمد عابد الجابري، ابن رشد سيرة وفكر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 1999.محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة التاسعة 200 ابن رشد، الضروري في السياسة مختصر السياسة لأفلاطون، نقله عن العبرية أحمد شحلان مع مدخل ومقدمة تحليلية للمشرف محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 1998
- محمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية 2000
- المصباحي محمد، جدلية العقل والمدينة في الفلسفة العربية المعاصر، منتدى المعارف الطبعة الأولى 2013.
- الشيخ محمد، مسألة الحداثة في الفكر المغربي المعاصر، منشورات الزمن 2004
- مصطفى حنفي، الجابري ومشروع تحقيق المتن الرشدي، ضمن ندوة قراءة علمية في كتب محمد عابد الجابري على الرابط التالي: 21/05/ 2025 https://www.mominoun.com
- محمد بن حماني، الرشد يون الجدد: رؤى ومناهج، مؤسسة مؤمنون بلا حدود عبر الرابط الالكتروني 20.05.2025 https://www.mominoun.com
[1] محمد بن حماني، الرشد يون الجدد: رؤى ومناهج، مؤسسة مؤمنون بلا حدود عبر الرابط الإلكتروني 20.05.2025 https: www.mominoun.com
[2] مصطفى حنفي، الجابري ومشروع تحقيق المتن الرشدي، ضمن ندوة قراءة علمية في كتب محمد عابد الجابري على الرابط التالي:
21/05/ 2025 https: //www.mominoun.com
[3] محمد عابد الجابري، ابن رشد سيرة وفكر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 1999، ص 84
[4] نفسه ص 10
[5]محمد عابد الجابري، نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، المركز الثقافي العربي، الطبعة السادسة 1993 ص 211-212
[6] محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة التاسعة 2009 ص 529-530
[7] محمد عابد الجابري، نحن والتراث قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي، المركز الثقافي العربي ص 9
[8] نفس المرجع السابق ص 214
[9] نفسه ص 215
[10] نفسه ص 218
[11] نفسه ص 219
[12] نفسه ص 226
[13] نفسه ص 232
[14] نفسه ص 234
[15]نفسه ص 246
[16] ابن رشد، الضروري في السياسة مختصر السياسة لأفلاطون، نقله عن العبرية أحمد شحلان مع مدخل ومقدمة تحليلية
للمشرف محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 1998 ص 26
[17]محمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، مركز دراسة الوحدة العربية 138_139
[18] نفسه ص 145-146
[19] نفسه ص 134_135
[20] مزوز محمد، ابن رشد بين اخلاق أرسطو وسياسة افلاطون، تمييز مجلة تاريخ الأفكار العلمية والفلسفية، العدد 2 دجنبر 2024
[21] ابن رشد سيرة وفكر ص 11
[22]الشيخ محمد، مسألة الحداثة في الفكر المغربي المعاصر، منشورات الزمن 2004 ص 129
[23]المصباحي محمد، جدلية العقل والمدينة في الفلسفة العربية المعاصر، منتدى المعارف الطبعة الأولى 2013، ص 219
[24] نفسه ص 233
[25]نفسه ص 228
[26] ابن رشد سيرة وفكر، مرجع سابق ص 11
[27]نفسه ص 10
[28]جدلية العقل والمدينة، مرجع سابق ص 230
[29]نفسه ص 231
[30]نحن والتراث، مرجع سابق ص ص 50-51
[31]بنية العقل العربي، مرجع سابق ص 552
[32]جدلية العقل والمدينة، مرجع سبق ذكره ص 219