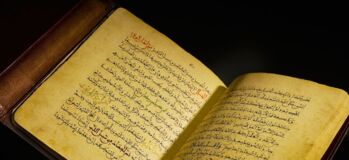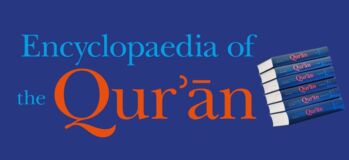التراث والتجديد: قراءة في مشروع حسن حنفي لتجديد أصول الفقه
فئة : أبحاث محكمة
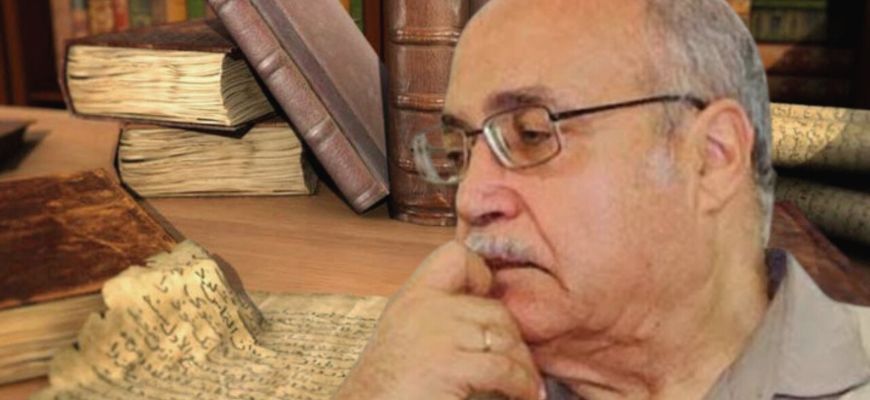
التراث والتجديد: قراءة في مشروع حسن حنفي لتجديد أصول الفقه
يُعدّ الباحث المصري حسن حنفي (ت2021م) أحد أهم المفكرين العرب المعاصرين. اشتهر حنفي بصفته منظر تيار اليسار الإسلامي، وعُرف بمقارباته المتميزة في مجالات تجديد الخطاب الديني، وعلم الاستغراب، فضلًا عن جهوده في حقل التنوير والتحديث.
تقع قضية "التراث والتجديد" في القلب من مشروع حنفي الفكري؛ إذ يعبر المفكر المصري عن أهمية تلك القضية وعلاقتها الوطيدة بالواقع بقوله: "...مهمة التراث والتجديد التحرر من السلطة بكل أنواعها. سلطة الماضي وسلطة الموروث، فلا سلطان إلا للعقل ولا سلطان إلا لضرورة الواقع الذي نعيش فيه وتحرير وجداننا المعاصر من الخوف والرهبة والطاعة للسلطة...".
في هذا السياق، قدم حنفي مقاربة جديدة لعلم أصول الفقه، وهو العلم الذي يُعرف بوصفه مجموعة من القواعد الكلية التي يتوصل بها الفقيه إلى استنباط الأحكام الشرعية. لقد اعتمد حنفي في مقاربته على إعادة بناء علم الأصول، بهدف تجديده، ليصبح ملائمًا للظرف الحاضر. وفي هذا الإطار، وصف المفكر المصري مشروعه بأنه "مرحلة جديدة في تطور علم الأصول والتحوّل فيها من النص إلى الواقع؛ أي من الحرف إلى المصلحة استئنافًا للشاطبي والطوفي..."؛ وذلك بعكس المشاريع السابقة له، والتي لم تتعد أن تكون "محاولات جزئية مترددة" على حد وصفه.
تتمثل إِشكالية الدراسة في رصد أهم معالم أطروحة حسن حنفي في مجال تجديد علم أصول الفقه. عملت الدراسة على تحليل مقاربة حنفي من خلال إلقاء الضوء على مفهوم "بنية النص"، وهو المفهوم الذي استخدمه المفكر المصري كثيرًا في كتاباته. وحللت الدراسة الأُطر المفاهيمية التي اقترحها حنفي لتكون بديلة للمصطلحات الفقهية التراثية؛ ومنها التجربة النموذجية/ السنة، التجربة المشتركة/ الإجماع، القياس/ التجربة الفردية. كما عملت على تبيين نقاط الاختلاف الرئيسة بين مقاربة حنفي من جهة، والمقاربات التراثية التقليدية من جهة أخرى.
حسن حنفي ومشروع التجديد
ولد الدكتور حسن حنفي بالعاصمة المصرية القاهرة في سنة 1935م. والتحق بجامعة القاهرة، وتخرج منها في سنة 1956م، ثم سافر إلى فرنسا ليحصل على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون في سنة 1966م، وعاد بعدها إلى مصر، ليعمل بالتدريس في قسم الفلسفة بكلية آداب القاهرة، ثم ترقى بعدها ليشغل منصب أستاذ مساعد بالقسم، قبل أن يُعين في وظيفة أستاذ في سنة 1980م، فرئيسًا للقسم في سنة 1988م. بالتوازي مع تلك المناصب، عمل حنفي في وظيفة أستاذ زائر بالعديد من الجامعات العالمية، ومنها جامعات اليابان، والمغرب، وألمانيا.
كان التراث والتجديد أحد المباحث التي شغلت حسن حنفي طوال مسيرته العلمية، حيث أصدر العديد من المؤلفات الفكرية التي سلطت الضوء على العديد من الإشكاليات التراثية العالقة في التاريخ الإسلامي. كما اهتم بالتقريب بين المذاهب بغية دمجها مع بعضها البعض في وحدة واحدة([1]). ومن أهم المؤلفات التي قدمها حنفي عبر مسيرته كل من "التراث والتجديد" الصادر في القاهرة في سنة 1980م، و"من العقيدة إلى الثورة" الصادر في القاهرة في خمسة أجزاء في سنة 1988م، و"الدين والثورة في مصر" في ثمانية أجزاء في سنة 1989م، و"من النقل إلى الإبداع" في تسعة أجزاء في سنة 1999م، و"الدين والثقافة والسياسة في الوطن العربي" الصادر في القاهرة في سنة 1998م، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الكتب التي ألفها باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
تجديد علم أصول الفقه في مشروع حسن حنفي
بعد أن انتهى حنفي من طرح مشروعه التجديدي في مجالي العقائد والفلسفة، شرع في عرض رؤيته لتجديد علم أصول الفقه. فقد أصدر في سنة 2004م الجزء الأول من كتابه "من النص إلى الواقع ... محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه"، وحمل هذا الجزء عنوان "تكوين النص". وبعد سنة واحدة، أصدر الجزء الثاني من الكتاب بعنوان "بنية النص".
منذ الصفحات الأولى للكتاب، تظهر النزعة التجديدية للمؤلف بشكل صريح؛ فهو يصدّر كتابه بإهداء عمله البحثي إلى "كل من يُعطي الأولوية للمصالح العامة على النصوص والحروف". كما يؤكد أنه طرح مشروع إعادة بناء علم الأصول -بالأساس- للفقهاء الذين يحسنون الاستدلال "من أجل تغليب المصلحة العامة، وهي أساس التشريع، على حرفية النص، وإعطاء الأولوية للواقع على النص"([2]).
من جهة أخرى، يبدو حنفي واضحًا إلى حد بعيد في تحديد هدفه من مشروعه الرامي إلى إعادة بناء أصول الفقه؛ إذ يؤكد أنه لا يبتغي إثارة النقاش فيما يخص المسائل الجزئية أو الفرعية، بل إنه يرمي إلى إعادة تأسيس هذا العلم على أصول عقلية تتفق - بالمقام الأول- مع حاجات الناس ومشكلاتهم الحياتية اليومية المتكررة. من هنا، تتأتى أهمية مشروع حنفي في إعادة بناء علم أصول الفقه؛ فهو لا يقدم المشروع للقارئ بوصفه مشروعًا خطابيًّا يتمتع بأريحية الترف الفكري البعيد عن إشكاليات الأمر الواقع، بل على العكس من ذلك، عرض حنفي مشروعه بوصفه اجتهادًا مناسبًا للاشتباك مع مفردات الواقع الصعب، ويتضح ذلك في قول حنفي: "...إن أصول الفقه ُ الجديدة تبدأ من الواقع ومن مصالح الناس المتغيرة بتغير العصور. وهو رد فعل على ما يحدث في هذا العصر من تضحية بالمصالح العامة باسم النص، وتراكم مآسي الناس ٌ باسم الشريعة. صحيح أنه كانت هناك محاولات لإصلاح قانون الأحوال الشخصية، ولإعادة النظر في قضايا الربا والفائدة وعوائد شهادات الاستثمار وصناديق التوفير، ولكنها ما زالت ُمترددة، لها مؤيدوها ومعارضوها. إنما الإصلاح الجذري هو العودة إلى أصول التشريع ومناهج الاستدلال وإعادة بناء علم أصول الفقه نفسه استئنافًا للشاطبي في َّ "الموافقات"، وللطوفي في "المصالح المرسلة"، ولعلال الفاسي في "مقاصد الشريعة ومكارمها"، ولجمال الدين عطية في "تفعيل مقاصد الشريعة"..."([3]).
لقد اعتمد حنفي في دراسته لعلم أصول الفقه على عدد كبير من المصادر الفقهية والأصولية؛ يأتي في مقدمتها كل من "الرسالة" لمحمد بن إدريس الشافعي المتوفى 204هـ، و"المستصفى" لأبي حامد الغزالي المتوفى 505هـ، و"الموافقات" للشاطبي المتوفى 790هـ، وأخيرًا، "إرشاد الفحول" للشوكاني المتوفى 1255هـ.
فيما يخص المنهج الذي اتبعه المفكر المصري في بحثه، فإننا نجده يلجأ للمنهج التاريخي بشكل واضح. كما أنه يستفيد في دراسته من أطروحات المادية الجدلية والديالكتيك على نحو موسع؛ وذلك دون مواربة أو خجل. ظهرت علامات هذا المنهج في العديد من المواضع من الكتاب، ومنها إقرار المؤلف بأن علم أصول الفقه مرآة انعكست فيها الصراعات الاجتماعية "بين قوة تُعطي الأولوية للنص على الواقع، وهي القوى المحافظة التي في الغالب ما تكون قريبة من السلطان، وقوة تُعطي الأولوية للواقع على النص، والتي في الغالب ما تكون خارجة عن إطار الحكم..."([4]). كما ظهرت اعتبارية المؤلف للمنهجية التاريخية الديالكتيكية في كشفه للتطور الكبير الذي لحق ببنية علم أصول الفقه على مر القرون؛ إذ يقول: "...البنية ليست موضوعًا سابقًا على التاريخ، في الذهن أو في الواقع، بل هي شيء يتخلق عبر العصور، ويتطور بتطور روح الحضارة، قوةً وضعفًا، بداية ونهاية، نشأة واضمحلالًا..."([5]). وفي السياق نفسه، ضرب حنفي نموذجًا لدور العوامل التاريخية في تطور وتشكل علم أصول الفقه. فقال عاقدًا المقارنة بين التعاطي السني- الشيعي مع هذا العلم: "...وكون أصول الفقه الشيعي قد تأخر في الظهور عن أصول الفقه السني بقرنين من الزمان لا يحتاج إلى دفاع لارتباط أصول الفقه السني بالسلطان، وأصول الفقه الشيعي بالمعارضة... انشغل السنة بالتقنين وإيجاد شرعية للسلطة، بينما انشغل الشيعة بالتغيير وزعزعة السلطة القائمة من أجل العودة إلى الشرعية المُغتصبة..."([6]).
تكوين النص والبُنى المتعددة
في الجزء الأول من كتابه "من النص إلى الواقع ... محاولة الإعادة بناء علم أصول الفقه"، اهتم حسن حنفي بدراسة الطرائق المختلفة التي انتهجها الأصوليون في كتابة وعرض مؤلفاتهم المرتبطة بعلم أصول الفقه؛ وذلك من خلال القراءة المتأنية للعشرات من المتون الأصولية، حيث قسم حنفي الكتب التراثية الخاصة بأصول الفقه إلى مجموعات متباينة؛ اعتمدت المجموعة الأولى على "بنية أحادية" تدور حول الفرق بين الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والمندوب والمحظور، أو المحرم والمكروه والمُباح. من الكتب التي تنتمي لهذا النوع "المقدمة في أصول الفقه" للقاضي عبد الوهاب المالكي المتوفى 422هـ. تقوم كتابات المجموعة الثانية على "بنية ثنائية". وفيها تنتظم أصول الفقه في بنية ثنائية "الأوامر والنواهي" و"العموم والخصوص". ومن الكتب التي تنتمي إلى هذا النوع "قواطع الأدلة في الأصول" لأبي المظفر السمعاني المتوفى 486هـ. أما كتابات المجموعة الثالثة، فتقوم على "بنية ثلاثية"، تستند إلى القرآن، والحديث النبوي، والإجماع والقياس، والتعارض والتراجيح. ويُعدّ كتاب "الرسالة" للشافعي من أهم الكتب التي تنتمي لتلك المجموعة.
في المجموعة الرابعة، تأتي "البنية الرباعية"، وتدور على الأدلة الشرعية الأربعة وحدها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يقول حنفي مبينًا السمات المميزة للكتابات التي تنتمي لتلك المجموعة: "ابتلع الوعي التاريخي، المصادر الشرعية الأربعة، كل مسائل الوعي النظري والوعي العملي؛ فالنص حوى كل شيء، اللغة في طرائق الاستدلال، والفعل في أحكام التكليف. ويكثُر فيه الاعتماد على الشواهد النقلية، ويتغلب الحديث على القرآن. ويغيب الشعر بعد أن تحول الإبداع العربي إلى العقل. ويتقدم الشافعي وأبو حنيفة على مالك وأحمد، والأشعري وعمر والأصحاب"([7]). ويُعدّ كتاب "المستصفى من علم الأصول" للغزالي من أهم الكتب التي تنتمي إلى كتابات تلك المجموعة. بعد ذلك، تأتي الكتابات التي تعتمد "البنية الخماسية"، والتي تقوم على المنطق (التعاريف العقلية)، واللغة (التعريفات اللغوية)، والأحكام الشرعية، وأدلة الأحكام، وأخيرًا الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والتراجيح. ومن كتب تلك المجموعة كتاب "تقريب الوصول إلى علم الأصول" لأحمد بن جَزي المالكي المتوفى 741هـ، ثم يشير حنفي إلى الكتابات ذات "البنية السباعية"، والتي تعتمد الكتاب والسنة والإجماع، ثم النواهي والعموم والخصوص، ثم القياس والاجتهاد والتعادل والتراجيح. ومنها كتاب "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" للشوكاني. وأخيرًا، يتطرق المفكر المصري إلى الكتابات ذات "البنية الثمانية"، والتي تعتمد على القرآن، والحديث، والإجماع، والقياس، والاستدلال، والترجيحات، والاجتهاد، والفتوى. ويعبر عن هذا النوع كتاب "البرهان" لأبي المعالي الجويني المتوفى 487هـ.
بنية النص والأصول
بعد أن انتهى حنفي في الجزء الأول من كتابه من عرض الملاحظات السيميائية الخاصة بالكتابات الأصولية، نجده في الجزء الثاني - والذي حمل عنوان بنية النص- يقوم بمناقشة الأصول الواردة في تلك الكتب، حيث يتعرض لها بالشرح والتحليل حينًا، وبالتعديل والتفنيد في أحيان أخرى.
يبدأ حنفي الجزء الثاني من كتابه بتناول القرآن/ الكتاب، وهو الأصل الأول - والأكثر أهمية واعتبارية- من أصول الفقه؛ فقد ذكر أن الوحي هو البيان؛ أي "الإعلان والتجلي والظهور والحضور"([8]). ويسمي الكتاب بـ "التجربة الإنسانية العامة"، ويفسر ذلك بكونها التجربة التي تلخص حكمة الشعوب وخبرات التاريخ المتتالية وقوانينها العامة. "لم يدع أحد تأليفها. تطابق تجارب الأفراد والجماعات من مختلف الثقافات والعصور..."([9]).
يقرر حنفي حقيقة أن القراءات المتواترة للقرآن تفيد بالحجج القطعية، بعكس القراءات الشاذة التي تمثل حجة ظنية. كما ينبه على أهمية اللغة التي دون بها النص القرآني؛ فالقرآن نزل باللغة العربية، ولذلك لا يمكن فهم معانيه ودلالاته إلا بالرجوع إلى معاجم وتقاليد اللغة العربية "فهو خطاب عربي في الوحي والشعر. ولا يوجد في القرآن ما ليس من لغة العرب وكلامها. وإن كان فيها فقد تم تعريبها من قبل مثل استبرق الفارسية، ومشكاة الهندية، والصراط الرومية..."([10]).
من جهة أخرى، يرى حنفي ضرورة اللجوء إلى الاجتهاد لفهم معاني القرآن الكريم؛ إذ يرجع للمقولة الشهيرة المنسوبة إلى علي بن أبي طالب، والتي تفيد أن القرآن كتاب مسطور لا ينطق، وإنما ينطق الرجال بما فيه. ويعرج حنفي بعدها على ظاهرة النسخ، وهي إحدى أهم الظواهر المرتبطة بالقرآن. في هذا السياق، يبيّن المفكر المصري المعاني المختلفة المرتبطة بالنسخ، فيقول: "...والنسخ عند الأصوليين المتقدمين أعم منه عند المتأخرين. فقد يطلق النسخ على تقييد المطلق. وتخصيص العموم بدليل منفصل إلى متصل، وبيان المبهم والمجمل. كما يطلق على رفع الحكم الشرعي المتقدم بحكم شرعي متقدم آخر لاشتراك الأمرين في معنى واحد وهو إيقاف العمل بالنسخ، وبداية العمل بالناسخ والأمثلة كثيرة على أن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ النسخ بيان ما فى تلقى الأحكام من مجرد ظاهرة إشكال وإيهام المعنى غير مقصود الشارع. فهو أعم من اختلاف الأصوليين. ولا يدخل "جبريل" في النسخ؛ لأنه موضوع علم أصول الدين وليس علم أصول الفقه"([11]).
بشكل عام، وعلى عكس الأغلبية الغالبة من الباحثين الحداثيين، يثبت حنفي وجود النسخ في القرآن، ويذكر أن الحكم المنسوخ أدى دوره في تطور الواقع ودفعه دفعًا نحو التقدم، ومسايرة عجلة الزمن. بموجب تلك النظرة، فالنسح أداة من أهم أدوات تطور التشريع الإسلامي. ويرد حسن حنفي على إحدى الشبهات القديمة المُثارة حول قضية النسخ في القرآن، والتي يرفض أصحابها النسخ لكونه مناقضًا لصفة القدم التي وجب أن يتصف بها كلام الله عز وجل، فيقول إن: النسخ نوع من أنواع التشريع، وليس صفة قديمة للذات الإلهية. كما أن النسخ إنما يتعلق بالإنسان المُكلف وليس بالله المُكلِف. فهو بذلك "يتعلق بأفعال الناس وليس بما دون مع المحفوظ، الموضوع بين قوسين"([12]).
وعلى الرغم من ذلك، يعود حنفي سريعًا، فيقرر أن النسخ لا يمكن أن يشمل كل شيء في القرآن. فالقيم الإنسانية العامة كالصدق والعدل ثابتة لا يسري عليها النسخ، ولا تشملها يد التبديل والتحريف. كما أن النسخ إنما يكون في الأحكام وليس في العقائد، ويكون ميدانه "علم أصول الفقه"، وليس "علم أصول الدين". وهو في كل ما سبق يختلف بشكل كامل عن "النسخ الكلي"، والذي يُقصد منه نسخ شريعة كاملة بشريعة أخرى مخالفة، مثل "نسخ الشريعة المسيحية للشريعة اليهودية، ونسخ الشريعة الإسلامية للشريعتين اليهودية والمسيحية"([13]). بعدها، يوضح المفكر المصري أشكال النسخ المختلفة التي من الممكن أن يتضمنها النص القرآني، فيقول: "...ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم من أجل صباغة أولية أكثر إبداعًا. ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة من أجل إظهار تغير الحكم وتطور الزمان مع بقاء الإبداع الأدبي، ويجوز نسخ الحكم والتلاوة معا وهو الأقل، وهو جائز عقلًا وواقع شرعًا. ونسخ التلاوة من أجل تلاوة أبلغ، ونسخ الحكم من أجل حكم أكثر تطابقًا مع الواقع المتغير. وإذا كانت التلاوة متضمنة حكمًا واجبًا ولم تنسخ تلاوتها فإن فيها عبادة والتزامًا بأدلة الواجب فالخطاب لفظ وفحوى صياغة وحكم، صورة ومضمون"([14]).
أما فيما يخص السؤال حول حدود نسخ القرآن للسنة، والسنة للقرآن، فيرى حنفي استحالة وقوع ذلك بأي شكل من الأشكال؛ لأن هناك مصدرا واحدًا لكل من القرآن والسنة. فمن جهة، لا يجوز نسخ القرآن بالسنة؛ لأن "المقطوع لا يُرفع بالمظنون"([15])، ويرى أن ما اعتبره البعض نسخًا للقرآن من السنة ما هو في الحقيقة إلا نوع من أنواع التخصيص والتقييد. ومن جهة أخرى، لا يجوز نسخ السنة بالكتاب. ولو حدث ذلك، فهو مجرد تصحيح أو تذكير ليس إلا. ويختتم حنفي تناوله لظاهرة النسخ بربطها بأسباب النزول والوعي التاريخي، فيقول إن: الوحي لم يأت لغرض حل معين أو إجابة معينة، بل جاء لترجيح أحد الحلول على الأخرى، ولتأكيد مجموعة من الإجابات التي قدمها العقل البشري بحثًا عن الخروج من بعض الإشكالات الصعبة التي فرضها الأمر الواقع. بناء على ذلك، يقرر حنفي أن "الوحي مثبت لا مشرع، ومؤكد لحكم بادئًا به السؤال من الواقع، والإجابة من الوحي. ومن ثم تتجدد الأسئلة، وتتجدد الإجابات طبقًا لروح العصر..."([16]).
يتطرق حنفي بعد ذلك لدراسة السنة، وهي الأصل الثاني من أصول الفقه. ويسميها المفكر المصري بالتجربة النموذجية، فيقول: السنة هي "التجربة النموذجية الأولى لتحقيق التجربة الإنسانية العامة في الزمان والمكان"([17])، وتعني لغةً الطريقة والعادة، وشرعاً العبادات النافلة فيما صدر عن الرسول من قول وفعل وإقرار.
في بداية حديثه عن السنة، يعمل حنفي على توضيح العلاقة المنعقدة بين القرآن والسنة، بوصفهما المصدرين الأولين من مصادر التشريع الإسلامي، فينتهج في سبيل ذلك نهجًا وسطًا بين الحداثيين من جهة، والتراثيين من جهة أخرى، فيقول: "...السنة ما جاء منقولًا عن الرسول وما لم ينص عليه في الكتاب بل كان بيانًا وتفصيلًا له. هي المصدر الثاني، ومتأخرة عن الكتاب لأن الكتاب قطع والسنة ظن. والسنة بيان للكتاب أو تفصيل له. كما دلت الأخبار على تأخر السنة على الكتاب في الترتيب ليست السنة قاضية على الكتاب ولا هي مرجحة عليه). السنة راجعة في معناها إلى الكتاب. فهي تفصيل المجملة، وبيان المشكلة، وبسط المختصرة. ويدل على ذلك النصان نفساهما. كما يدل الاستقراء على اندراج كثير من الجزئيات في السنة تحت أصل الكتاب. ولا يعني ذلك الاقتصار على الكتاب وإزاحة السنة كما يفعل بعض مدعى الحداثة أو مدعى الأصالة السنة بيان لما في الكتاب وتفصيل لأوجه تطبيقه"([18]).
يركز بعدها حنفي على واحدة من أهم المسائل الإشكالية المرتبطة بالحديث النبوي والسنة، ألا وهي تمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف أو الموضوع. فيضع بعض المعايير التي استقاها من خبراته الكبيرة في ميادين الفلسفة والمنطق، يقول: "لا يحكم بأن كل ما أخبر به الرسول فهو حق وصدق سواء كان خبرًا أو تكليفًا دون أن يدخل في نظرية الخبر العامة في الصدق والكذب). ولا يفيد صدق الخبر عصمة الأنبياء؛ لأن الصدق موضوع للنقد التاريخي للخبر وليس موضوعًا للإيمان..."([19]). ويعدد حنفي سبعة أنواع من الأخبار الواجب تصديقها، وهي الخبر المتواتر، والقرآن الذي تم جمعه في مصحف عثمان، وقول النبي، وما نُقل عن الأمة، وكل خبر وافق الخبر المتواتر ووافق العقل والسمع، وكل خبر سمعه الرسول ولم يعترض عليه، وكل خبر أمسكت جماعة عن تكذيبه. أما فيما يخص الأخبار التي يجب تكذيبها، فهي أربعة، وهي كل الأخبار التي تعارض العقل أو الحس أو المشاهدة أو التواتر "وما خالف المعلوم مثل الجمع بين الضدين وإحياء الموتى أو القعود على جناح نسر أو العيش في قاع البحر"([20]). وما خالف النص القاطع من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة، وما كذبه جمع من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب، وما سكت الجميع عن نقله أو التحدث به مع جريان الواقعة أمامهم "مثل انشقاق القمر وكون المعوذتين من القرآن ولم ينكرهما إلا ابن مسعود، ونقل النصارى معجزات عيسى دون الكلام في المهد..."([21]).
بعدها، ينتقل المفكر المصري للحديث عن الأصل الثالث من أصول الفقه، وهو الإجماع، حيث يسمي حنفي هذا الأصل باسم "التجربة المشتركة"، ويعرفه بأنه "عمل إرادي وجهد جماعي على القرار والفعل. يعني الاتفاق والإزماع والفعل المشترك. وهو التجربة غير النصية للجماعة خوفًا من التفرد بالرأي. وهو ضد الخلاف والتفرق، وإيجاد تجربة مشتركة يعيشها الجميع. هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة واتفاق جميع المجتهدين في البقاع"([22]). ويذكر حنفي أن الإجماع موجب للعلم، وأنه "حجة قطعية مثل الكتاب والسنة المتواترة. ويستحيل الخطأ فيه؛ لأن التجربة المشتركة أكثر أمنًا من التجربة الفردية وأكثر موضوعية"([23]).
يطرح حنفي بعدها سؤالًا مهمًّا عن المجمعين، وكيف يمكن تحديدهم في كل عصر. يجيب المفكر المصري عن هذا السؤال فاتحًا الباب أمام المشاركة الجماعية التي تقترب من الديمقراطية الحديثة، يقول إن: المجمعين هم كل المجتهدين، أهل الحل والعقد "الأئمة والفقهاء العالمين بالأصول. والقادرين على استنباط الفروع". ويضيف "بتصور دخول العوام في الإجماع فيما يخص المصالح العامة وأزمات العصر. فهم أصحاب المصلحة وغالبية الأمة. وخلاف العوام لا يُعتد بهم إن كانوا مجرد دهماء. أما إذا عبروا عن مصالح الأغلبية ويُعتدّ بهم"([24]).
على الرغم من تقديره الكبير لأصل الإجماع/ التجربة المشتركة، يحذر حنفي من الإفراط في وصف معارضي الإجماع بالبدعة، ويؤكد أن سلاح البدعة شهر ضد كل مجتهد لم توافق عليه الأغلبية التقليدية، والمتعاونة مع السلطان في العديد من الفترات التاريخية([25]).
من جهة أخرى، فتح حنفي الباب أمام مشاركة العديد من الفئات في الاجتهاد المفضي للإجماع؛ ومن تلك الفئات الكافر غير المسلم إذا كان "من أهل الاختصاص" في المسألة المختلف عليها([26]). وعلى النحو ذاته، يدخل الكتابي في دائرة الإجماع "أما الكتابي، فإنه إن استطاع السيطرة على الأهواء فإنه يكون قادرًا على "التعبير عن هوية الأمة"([27]). يفسر المفكر المصري هذا الطرح بأن الأمة الإسلامية مكونة من عدة أمم ليست كلها إسلامية الدين، بل فيها اليهود والمسيحيون والمجوس والصابئة. وفي السياق نفسه، يعتد في الإجماع بالنساء والعبيد، وغير ذلك من الطبقات التي تم تهميشها اجتماعيًّا. كما يرفض الآراء التراثية التقليدية التي قصرت الإجماع على آراء أهل المدينة "فكما أن الإجماع ليس محددًا بزمـان محدد سابق فإنه أيضًا لا يكون محددًا بمكان مثل إجماع أهـل المدينـة... فمثل المدينة مثل مكة والكوفة والبصرة. ليس لأهل المدينة ميزة على سائر المدن، ولا للحجاز ميزة على العراق والشام ومصر..."([28]).
بعد أن انتهي حنفي من مناقشة أصل الإجماع، بدأ في تناول أصل الاجتهاد، والذي سماه بالتجربة الفردية. وعرفه بأنه "إفراغ الوسع وبذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي"([29]). ورآه "مستنبطًا من بديهة العقل"([30]). ويشير حنفي إلى أن معظم الفقهاء والأصوليين قد أطلقوا على الاجتهاد اسم القياس، وشاعت تلك التسمية في العشرات من المؤلفات الفقهية. ورغم ذلك، يوضح أن هناك فرقًا واضحًا بين القياس والاجتهاد. فالاجتهاد اسم عام لجميع الأشكال والصيغ التي يتم فيها إعمال العقل للوصول للحكم الشرعي. أما القياس، فهو شكل واحد من تلك الأشكال. ووفق ذلك، يمكن القول إن: القياس فرع من الاجتهاد. وأن كل قياس اجتهاد، وليس كل اجتهاد قياس.
ويوسع حنفي مجال الاجتهاد بشكل كبير، فهو لا يشترط دراية المجتهد بجميع مسائل الكتاب والحديث، بل يرى أنه يكفي على المجتهد أن يحيط بمجمل العلوم النافعة في مجال الاجتهاد، ومنها أسباب النزول، والتفريق بين الخاص والعام، والمقيد والمطلق، وغير ذلك من الأدوات التي لا غنى عنها لكل مفتي. أما الشرط الاساس الذي يضعه حنفي للوصول لمرتبة الاجتهاد، فهو توافر صفتين، وهما: "فهم مقاصد الشريعة، والتمكن من الاستنباط بناء على فهمها"([31]).
من جهة أخرى، لا يرى حنفي بأسًا في كثرة المجتهدين "فكل مجتهد مصيب. ولا يأثم المخطئ في الاجتهاد"([32]). وفي السياق نفسه، يرى أن هناك إمكانية للاجتهاد مع وجود نص؛ لأن "للواقع الأولوية على النص"([33])، ويستدل على ذلك بمجموعة من الحوادث التاريخية المتواترة التي وقعت في زمن خلافة عمر بن الخطاب؛ ومنها تعطيل حد السرقة في عام الرمادة، ورفض إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة بعد أن قوي الإسلام.
من النقاط المهمة التي يجدر ذكرها، أن حنفي ربط بين فتح باب الاجتهاد من جهة، وحرية الإبداع الإنساني والإرادة الإنسانية من جهة أخرى؛ ففتح باب الاجتهاد "أقرب إلى حرية الفكر وحق الاختلاف والتعددية الفكرية. في حين جعل المصيب واحدًا تضييق على حرية الفكر، وإنكار لاختلاف المشارب والمناهج وتعدد الآراء لحساب الرأي الواحد والحزب الواحد والسلطان الواحد، وهو رأى الفرقة الناجية في علم أصول الدين"([34]).
أيضًا، وفي سياق التأكيد على أهمية الاجتهاد، هاجم حنفي التقليد وأهله، فقال إن: المقلدين يتسببون في تعطيل حركة التجديد الفقهي. في هذا المقام، فرق المفكر المصري بين التقليد والتقدير. فلا يجوز تقليد الصحابي حتى إذا لم يعلم خلاف رأيه "ومدح الصحابة لا يستدعي تقليدهم، بل الاستمرار رؤاهم المتعددة بمزيد من البراهين. ولا يجـوز تقليد التـابعي المجتهد. فالاجتهاد إعمال للنظر وليس تبعية بالتقليد. ولا يجـوز تقليد الأئمة الأربعة المجتهدين. فلكل عصر اجتهاده. والمصـالح متغيرة من عصر إلى عصر. والاجتهاد قادر على تحقيق المصـالح المتغيرة عبر العصور"([35]).
المقاصد أولًا وأخيرًا
تحت عنوان "مقاصد الشريعة" يصل حنفي في أطروحته للثمرة النهائية من مشروعه في حقل تجديد علم أصول الدين؛ إذ يحاول إنزال الشريعة من السماء إلى الأرض، وإعادة تفسيرها في ضوء الغايات والأهداف الحياتية، يقول إن: الشريعة بالأساس هي "علة غائية"، ويذكر أن هدفها الأسمى هو "تحقيق مقاصد عامة لا يختلف عليها الأفراد والشعوب"([36]). بحسب رأي حنفي، فإن تلك الأهداف هي الثوابت. أما الأحكام، فتتغير بتغير الزمان والمكان. ولا بأس في ذلك على الإطلاق؛ لأنها -أي الأحكام- إنما تتناسب مع ظروف ومجريات كل عصر.
يخطو حنفي خطوة جريئة أخرى في أطروحته، عندما حصر مفهومي المصالح والمفاسد بأمور الدنيا دون الآخرة؛ فعلم أصول الفقه يجب أن يعتبر المصالح/ المفاسد الدنيوية، وأن يتعاطى مع آثارها في معايش الناس وحيواتهم "أما ما ينتج عنهما من ثواب وعقاب في الآخرة فهو أدخل في علم أصول الدين. ولا توجد وسيلة لمعرفتها إلا قياسًا للغائب على الشاهد..."([37]).
يرى حنفي أن الضروريات الخمس التي اعتبرها علماء أصول الفقه، يجب ترتيبها وفهمها على أسس عقلية موضوعية؛ فهي -من وجهة نظره- تبدأ بحفظ النفس أولًا، ثم يأتي العقل ثانيًا "فالحياة هي الحياة العاقلة، والإنسان حيوان عاقل كما قال الحكماء قديمًا"، ثم يأتي الدين الذي يمثل "القيمة أو المبدأ الكلـى الذي يدركه العقل"، ثم يأتي العرض أو الكرامة، وأخيرًا يأتي المال، وهو "المقوم المادي للحياة"([38]).
يظهر تجديد حنفي في تفسيره المهم للضروريات الخمس؛ إذ رفض فهمها في صورها التراثية القديمة، وعمل على تأويلها بشكل مرن، يعكس ثقافة عصرية منفتحة على التسامح والتعايش واستيعاب كافة الاختلافات والتباينات. على سبيل المثال، يرفض حنفي قصر ضرورة النفس على الإنسان فحسب، بل يوسعها حتى تشتمل على الحياة الحيوانية والنباتية. وبذلك يصبح التصحر والتلوث مظهرين من مظاهر الاعتداء على المصلحة الفقهية. كذلك وسع حنفي من دائرة الدين لتشمل كافة الأفكار والمعتقدات والقيم الإنسانية. وبالمثل، رفض فهم "العرض" بمعناه المادي الضيق، بل فهمه بشكل أكثر انفتاحًا ليشمل "الأرض عند الفلاح. والكرامة الوطنية لدى الأمم المغلوبة والشعوب المحتلة، وهو علامة على كل ما يتعلق بالخصوصـية والذاتية والاستقلال"([39]). ويدعو حنفي إلى الاستفادة من كافة التجارب البشرية في المجال الفقهي العام "فالمسلمون أمة مثل باقي الأمم. تسري عليهم قوانين التاريخ كما سرت على الشعوب السالفة"([40]). وفي هذا السياق، يمكن الرجوع لأفكار كونفوشيوس الصيني، وحمورابي البابلي، وأخناتون المصري، وبوذا الهندي.
في خاتمة كتابه، عمل حسن حنفي على وضع خطة عمل لتجديد علم أصول الفقه. فأشار أولًا، إلى أهم المشكلات الكامنة في بنية ومنهج هذا العلم. وحددها بنقطتين رئيستين، وهما تضخم الوعي النظري" على حساب "الوعي العملي". وإعطاء الأولوية للنص على حساب الواقع، على الترتيب. يذكر حنفي أن أطروحته هدفت إلى تجديد علم أصول الفقه عن طريق تحويله من علم فقهى استدلالي استنباطي منطقي "إلى علـم فلسـفي إنسـاني سلوكي عام"([41]). ومن هنا، تتأتى أهمية المصطلحات التي استخدمت في تلك الأطروحة، مثل التجربة الشخصية، والتجربة العامة، والوعي النظري، والوعي العملي...إلخ([42])؛ لأن تلك المصطلحات تسببت في تغيير النظرة التراثية التقليدية لعلم أصول الفقه؛ وذلك من خلال وضعه في سياق إنساني معرفي رحب، دون التقيد بحدود التجربة التاريخية، أو الخصوصية الأيديولوجية. يتضح هذا التوجه في دعوة حنفي للانفتاح على التجارب المشابهة لعلم أصول الفقه في شتى الحضارات والأديان الأخرى. فلماذا لا يستعين المفكرون المسلمون بجهود اليهود والمسيحيين وأتباع كونفوشيوس والهندوس والبوذيين في هذا المجال؟
يجب حنفي عن هذا السؤال، فيؤكد إمكانية وقوع هذا التلاقي. وعندها من الممكن أن يتشكل "علم أصول الفقه المطلق"، والذي "يجمع بين التاريخ واللغة والفعل، بين الأخذ بالوعي التاريخي والفهم بالوعي النظري والعطاء بالوعي العملي بين الماضي والحاضـر والمستقبل، بـين الرسالة والمرسل إليه والمرسل إليهم. فتنتهي القطيعة باسم النص، والحداثـة باسم اللغة. ويتوجه الجميع نحو الفعل"([43]).
الخاتمة
نجحت أطروحة حسن حنفي في إثارة الجدل بين الفقهاء والباحثين. وألقت حجرًا في مياه التقليد الراكدة منذ قرون. في هذا الإطار، يمكن أن نحدد مجموعة من النقاط المهمة المميزة لمشروع حنفي التجديدي في مجال إعادة بناء علم أصول الفقه.
من أبرز تلك النقاط:
- تأكيد حنفي على ضرورة اللجوء للاجتهاد لفهم معاني القرآن الكريم، ورفضه الركون للتقليد المتوارث.
- فهم حنفي للنسخ كأداة من أدوات التطور التشريعي، الأمر الذي ساعد في إعادة النظر للفقه بوصفه منتجًا اجتماعيًا تاريخيًا بالمقام الأول.
- استخدام حنفي لأدواته البحثية المستقاة من علمي الفلسفة والمنطق في سبيل وضع معايير لتمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف أو الموضوع.
- ربط حنفي بين أصل الإجماع ومفهوم الديمقراطية الحديثة، وإشراكه لغير المسلمين في دائرة الإجماع.
- لم يشترط حنفي دراية المجتهد بجميع مسائل الكتاب والحديث، بل ذهب إلى أنه يكفي على المجتهد أن يحيط بمجمل العلوم النافعة في مجال الاجتهاد. الأمر الذي يسهم في فتح باب الاجتهاد على مصراعيه.
- ذهب المفكر المصري إلى أن مقاصد الشريعة الإسلامية هي الثوابت التي ينبغي تحقيقها. أما الأحكام، فتتغير بتغير الزمان والمكان. ولا بأس في ذلك على الإطلاق؛ لأنها -أي الأحكام- إنما تتناسب مع ظروف ومجريات كل عصر.
- حصر حنفي مفهومي المصالح والمفاسد بأمور الدنيا دون الآخرة. فعلم أصول الفقه يجب أن يعتبر المصالح/ المفاسد الدنيوية. وأن يتعاطى مع آثارها في معايش الناس وحيواتهم. أما ما ينتج عنهما من ثواب وعقاب في الآخرة، فقد أدخل في علم أصول الدين.
- يظهر تجديد حنفي في تفسيره المهم للضروريات الخمس؛ إذ رفض فهمها في صورها التراثية القديمة. وعمل على تأويلها بشكل مرن، يعكس ثقافة عصرية منفتحة على التسامح والتعايش واستيعاب كافة الاختلافات والتباينات.
- تجديد علم أصول الفقه عن طريق تحويله من علم فقهى استدلالي استنباطي منطقي إلى علـم فلسـفي إنسـاني سلوكي عام.
مصادر الدراسة
- حسن حنفي، اليمين واليسار في الفكر الديني، دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، دمشق، 1996م
- المؤلف نفسه، من العقيدة إلى الثورة، دار نشر هنداوي، القاهرة، 2017م
- المؤلف نفسه، من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه، مؤسسة هنداوي، القاهرة، 2023م
- عبد العزيز محمد الجابر، الإجماع ومآزق تجديده عند حسن حنفي، مجلة تبيين، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، العدد 40، ربيع 2022م https: //doi.org/10.31430/QYZP8395
([1]) يقول حسن حنفي مبينًا هذا الهدف: "إذا كان هدف القدماء بيان مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فإن هدفنا هو بيان مقالات المسلمين واتفاق المصلين" حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، دار نشر هنداوي، القاهرة، 2017م، ج1، ص33
([2]) حسن حنفي، من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه، مؤسسة هنداوي، القاهرة، 2023م، ج1، ص15
([25]) يقول حسن حنفي مبينًا أوجه التشابه بين التضييق على العقل لصالح النقل من جهة، وشيوع الديكتاتورية وروح التسلط في التاريخ الإسلامي من جهة أخرى: "إن تقديم النقل على العقل تسبب في حماية النظم الرجعية، كما افسح المجال للسلطة السياسية لفرض استبدادها في المجال العام". حسن حنفي، اليمين واليسار في الفكر الديني، دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، دمشق، 1996م، ص18
([26]) حسن حنفي، من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه، ج2، ص202
([42]) من الجدير بالذكر، أن استخدام حنفي لتلك المصطلحات لاقى اعتراض من قِبل العديد من الباحثين. والذين ذهبوا إلى أن "المصطلحات لا تنشأ من خلال معاني الكلمات المستخدمة في التواصل العام، وإنما من خلال المفاهيم المتفق عليها بين طائفة المتخصصين". عبد العزيز محمد الجابر، الإجماع ومآزق تجديده عند حسن حنفي، مجلة تبيين، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، العدد 40، ربيع 2022م، ص113
https: //doi.org/10.31430/QYZP8395
([43]) حسن حنفي، من النص إلى الواقع: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه، ج2، ص ص593- 594