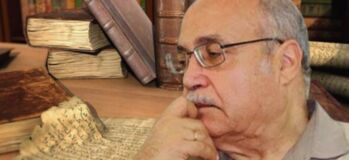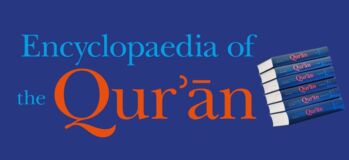النبي المشرع: بين الوحي والاجتهاد
فئة : مقالات
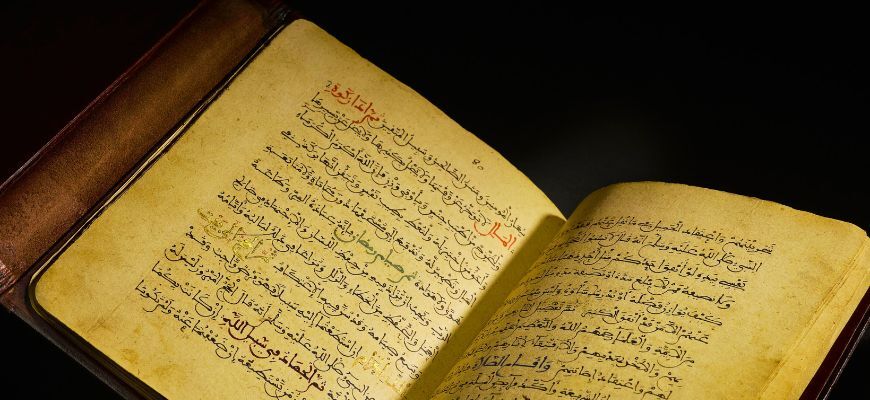
النبي المشرع:
بين الوحي والاجتهاد
تعد إشكالية العلاقة بين النص القرآني والتشريع النبوي من المحاور الأساسية في المنظومة الأصولية والكلامية، حيث يتقاطع فيها الوحي والاجتهاد والسياق والنص والثابت والمتغير. فبينما يؤكد القرآن على كماله وشمولية أحكامه: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38]، نجد أن السنة النبوية تحتل مكانة مهمة في البنية التشريعية الإسلامية، وهو ما يجعلنا أمام تساؤلات حول طبيعة التشريع النبوي: ما إذا كان وحيًا مستقلًّا أم اجتهادًا بشريًّا؟ وهذه الإشكالية تفرض أسئلة فرعية مثل مراحل تطور التشريع الإسلامي من المرحلة المكية إلى المدنية، والمواقف الكلامية والفقهية إزاء التشريع النبوي، خاصة مع وجود أحاديث تتعارض ظاهريًّا مع النص القرآني.
يحيل لفظ التشريع في الاصطلاح الإسلامي إلى الأحكام الشرعية التي تنظم حياة المسلمين والمنصوص عليها في القرآن عن طريق الوحي من الله، وهو الشارع الأعلى. وقد اختلفت الآراء حول وجود تشريع نبوي مستقل عن التشريع الإلهي؛ إذ يرى البعض أن للنبي اجتهادًا خاصًّا به في إطلاق أحكام جديدة لم ينص عليها القرآن بصريح اللفظ، ولكنها لا تتعارض معه ولا مع مقاصد الشريعة، وهي إما وحي أو اجتهاد مصوب بالوحي، وهو ما يشكل التشريع النبوي في ما يخص العقائد والأحكام المصيرية. أما البعض الآخر، فيرى أن التشريع من خاصيات الله وحده لا يشاركه فيها أي من البشر؛ فهو المشرع المطلق، والنبي مبلغ للوحي مبين له، وكل ما صدر عنه هو بوحي من الله، وبالتالي هو جزء من التشريع الإلهي. ولنفهم أكثر هذه الآراء، وجب تتبع مسار تطور التشريع الإسلامي.
لقد نزل القرآن الكريم منجّمًا طيلة ثلاث وعشرين سنة على مرحلتين: المرحلة المكية والمدنية، وقد اختلفت كل مرحلة على مستوى مضامين الآيات. فالقرآن المكي، الذي امتد قرابة ثلاثة عشر عامًا، كان همه التشريعي إصلاح العقيدة وتعميق جذورها، وإرشاد الناس إلى التصديق القلبي بوحدانية الخالق. فالقرآن الكريم في العصر المكي كان يخاطب الإنسان بالمنطق الفطري، في آيات قصيرة المقاطع، قوية الحجة؛ وذلك لإبطال ما توارثته الجاهلية من عقائد فاسدة وعادات باطلة، وحثّهم على مكارم الأخلاق وتطهير أنفسهم. فكان هاجس هذه الجماعة الدينية الجديدة، بقيادة النبي محمد، ترسيخ العقيدة وتحقيق التمايز عن محيطها المشرك، فكان لها هويتها العقدية المستقلة. غير أنها لم تكن تملك جسمًا قويًّا يؤهلها لبناء هوية تشريعية تميزها عن غيرها من أهل الكتاب، ومن هنا يمكن أن نستنتج أن التشريع القرآني لم يكن منشأه مكة؛ فآيات الأحكام لم تظهر سوى في السنوات الأخيرة من حياة النبي. وحسبنا هنا أن نطرح سؤالًا في غاية الأهمية: ما السبب الذي جعل من ظهور التشريع القرآني حاجة ملحّة؟
كان حادث الهجرة نقطة تحوّل في تاريخ الإسلام، حيث استقرت العقيدة الإسلامية في نفر من المهاجرين والأنصار ممن بايعوا الرسول. وبذلك، تكوّنت النواة الأولى للمجتمع الإسلامي، واتخذت من المدينة مستقرًّا لها، فبدأت الدعوة في طور عملي تنظيمي جديد، واتجه التشريع صوب بناء الأمة وتحديد علاقاتها الاجتماعية. وكانت المدينة بعد الهجرة فسيفساء قبلية وعقدية، فكانت تضم قبليًا الأوس والخزرج. أما عقديًّا، فكان الجسم اليهودي حاضرًا بقوة، ونذكر منهم ثلاث قبائل: بنو النضير، وبنو قينقاع، وبنو قريظة، إلى جانب المهاجرين، ذلك الجسم الموحّد عقديًا المتنوّع قبليًّا.
في البداية، كان أهل الكتاب أمة واحدة، والنبي محمد سلطة تحكيمية يفصل بينهم، وقد جاء في أول صحيفة المدينة ما يؤكد هذا القول: "هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس". لكن لم تسر الأمور في هذا السياق، فجماعة اليهود أظهروا الخضوع للإسلام وأضمروا العداء للنبي، وكذبوا نبوّته رغم أنهم قرؤوا في كتبهم المقدسة ورأوا فيها البشارة برسالة محمد، فكذبوه بعد أن بُعث. قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [البقرة: 89]، فسعت الجماعة الدينية الجديدة بعد أن تمايزت عن المشركين إلى التمايز عن أهل الكتاب وتكوين هويتها الخاصة، فكان حدث تحويل القبلة في السنة الثانية من الهجرة إعلانًا صريحًا بهذا التمايز، وفصلًا بين ملّتين متقاربتين ومتباعدتين في آن واحد.
لكن اليهود مع هذا، كانوا يحتكمون إلى النبي، لكن بصفة انتقائية حسب مصالحهم، كتعاملهم مع التوراة، وهذا ما ذكره القرآن: ﴿يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾ [آل عمران: 73]. غير أن النبي كان مخيّرًا في مسألة الحكم بين اليهود، فإن لم يحتكم فلا ضرر، وإن فعل، فواجب العدل ضروري. قال تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: 42]. إلا أن احتكام اليهود إلى النبي لم يكن غايته البحث عن حكم الله، فهو موجود في التوراة أيضًا، فإما أن يكون ما جاء به القرآن تثبيتًا لما في التوراة، أو أن اليهود يختبرون صدق نبوّة النبي. قال تعالى: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 43]، ثم دعت آيات أخرى النصارى إلى الاحتكام بالإنجيل: ﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: 47]. ثم دعا النبي، بعد بيان منزلة الكتاب مما سبقه من الكتب، إلى أن يُحتكم إليه، وألّا يُتخذ المؤمنون اليهود والنصارى أولياء: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: 48].
وهنا يظهر جليًّا أن هذه الملل الثلاث لا يمكن أن تكون أمة واحدة، وأن الله جعل لكل منها شريعة ومنهاجًا، قال تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: 48]. لقد نشأ التشريع القرآني في إطار تميز الجماعة الدينية الجديدة عن غيرها من أمم الكتاب، فمثّل القرآن كتابًا ومصدرًا يُحتكم إليه، وبذلك انبنت الهوية العقدية الخاصة لهذه الجماعة ضمن مجتمع جديد غادره اليهود، وهو ما ساعد هذه الجماعة في أن تصبح نواة لدولة جديدة.
وبالتالي، عاش النبي مرحلتين من حياته: مرحلة في مكة كان فيها داعية لدين جديد، مبلّغًا ومبشّرًا ونذيرًا، وكان القرآن يذكّره بأن ليس عليه إلا البلاغ، وأنه ليس عليهم بمسيطر، ومرحلة في المدينة انتقل فيها من النبي الداعية إلى النبي المشرّع، تاركًا بعد وفاته إرثين للمسلمين يتمثلان أساسًا في القرآن، بعضه مدوّن وبعضه محفوظ في صدور الرجال، وإرث ما بقي من سنته العملية، وما يتذكره مخالطوه من أقواله. فأما القرآن، فقد جرى تدوينه بعد فترة قصيرة من وفاة النبي، فانتقل من قرآن يُتلى إلى مصحف يُقرأ، فأصبح للمسلمين مدوّنة يرجعون إليها ويستنبطون منها الأحكام بالقياس والمقارنة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفقه، في مرحلة متقدمة من تطوره، انتهى إلى بناء نظري محكم لأدلة الأحكام، فرتبها على الأدلة الأربعة المشهورة، قبل أن يُلحق بها أدلة أخرى، وجعل الكتاب أول الأدلة، جامعًا لأربعة أنواع من الحجية: الأولية والثبوت والشمول واللزوم. ثم جعل سنة النبي ثانيًا، رافعًا إياها إلى مرتبة الوحي الشفوي، وحدد الإجماع بعدها، ثم الاجتهاد، من حيث هو قياس ما ليس فيه نص على ما فيه نص.
وقد نُسب إلى النبي حديث معاذ يُعلّمه كيف يستخرج الحكم، إذ سأله إن صعب عليه أمر ما ماذا يصنع. قال معاذ: "أقضي بكتاب الله"، قال: "فإن لم تجد؟"، قال: "فبسنة رسول الله"، قال: "فإن لم تجد؟"، قال: "أجتهد رأيي ولا آلو"، فضرب الرسول صدره وقال: "الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يُرضي رسول الله". لم يكن هذا الحديث على درجة عالية من التوثيق، لكنه أصبح مسلّمًا به نظرًا لشيوعه، وهو بمثابة الحجة على أن ترتيب الأدلة منصوص عليه، وليس اجتهادًا بشريًا، وهذا ما ذهب إليه الأصوليون. والواقع أنه اجتهاد إنساني بحت، وهناك محاولات أخرى في ترتيب الأدلة تدعم هذا الرأي. فواصل بن عطاء، مؤسس فرقة المعتزلة، رتب الأدلة على النحو التالي: كتاب ناطق، وخبر مجتمع عليه، وحجة عقل، وإجماع. أما إبراهيم النظام المعتزلي، فيقترح ثلاثة أدلة: نص من تنزيل لا يعارض بالتأويل، وإجماع الأمة على نقل خبر واحد لا تناقض فيه، وجهة عقل وضرورته. والجاحظ يقول: يُعرف الحلال والحرام بالكتاب الناطق، والسنة المجمع عليها، والعقول الصحيحة، والمقاييس المصيبة. كل هذه النماذج تؤكد أهمية الكتاب والسنة كمصدري تشريع يحظيان بإجماع المسلمين، لكن الخلاف كان قائمًا في عدد الأدلة وترتيبها وطبيعة السنة المقبولة.
وبالعودة للإرث النبوي المتعلق بسنته، فقد ظل باقيًا في هيئتين: هيئة عمل أهل المدينة بوصفه اتباعًا فعليًّا لما رأوا النبي يفعله، وهيئة أحاديث كان الخلاف في تدوينها وروايتها. وعندما انتشر الصحابة في الأمصار، أخذ كل واحد منهم ما يتذكره من أفعال النبي وأقواله إلى الأمصار التي استقر فيها. ولما ظهرت الرغبة المتزايدة في رواية الأحاديث، كثر النقل عن النبي في المسائل التشريعية، وكثر اللغط، واختلط الكذب بالصدق، واختلط ما قاله النبي بما لم يقله. وتجدر الإشارة إلى أن التشريع النبوي ينقسم إلى نوعين: يتمثل النوع الأول في التشريع عن طريق الوحي المباشر، وهو ما كان يتلقاه النبي مباشرة من عند الله قرآنا يتلى أو وحي غير متلو في مسائل مختلفة وطارئة، وهذا النوع لا خلاف في وجوب اتباعه. أما النوع الثاني، فهو التشريع بالاجتهاد في الرأي، ويتمثل في كل ما صدر عن النبي من أحكام توصل إليها باجتهاد شخصي في أمور لا وحي فيها. وقد اختلف العلماء في هذا النوع؛ حيث ذهب البعض إلى اعتبار أن محمدًا يجتهد في مسائل لم يرد فيها نص قرآني صريح برأيه الخاص، وإن أخطأ نزل الوحي مصوبًا له، بينما رأى البعض الآخر أن النبي كان مسددًا بالوحي في كل ما يصدر عنه. وهو ما أبرز مواقف تاريخية متباينة إزاء الدور التشريعي للنبي.
فمنذ العصر الأموي ثار الجدل حول مدى حجية السنة النبوية، وفي العصر العباسي انتظم الجدل في إطار مدارس كلامية وفقهية أبرزها مدرسة أهل الحديث التي أطلقت على النبي لقب المشرع، حيث اعتبرت سنته تشريعًا ملزمًا، إلى جانب مدرسة أهل الرأي التي صوبت تركيزها نحو الاجتهاد ومنحت النبي دورًا تشريعيًّا. أما المعتزلة، فكانوا حذرين جدًا في المرحلة الأولى من تاريخهم من الأحاديث المنسوبة إلى النبي، متشددين في قبولها، لكنهم انتهوا إلى جملة من المعاني المتعلقة بالتشريع النبوي؛ إذ يشرّع النبي ما له صلة بأحكام القرآن، وما ذكر له في الكتاب، وما يشرعه لا يشرعه اجتهادًا خالصًا منه كبشر كسائر البشر، بل يشرعه نبي يوحى إليه. فليس على المسلمين خيار فيما شرعه النبي، بل عليهم الطاعة المطلقة، إذ طاعة الرسول من طاعة الله.
وبالنسبة إلى آراء السنة والشيعة في المسألة، فقد ذهب علماء الشيعة إلى القول بأن التشريع النبوي هو جزء من التشريع الإلهي؛ فمحمد مبلغ للوحي ومبين للأحكام، يشرع بإذن الله وليس بصفة مستقلة. أما بالنسبة إلى آراء أهل السنة والجماعة، فتشكل السنة لديهم ثاني مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن، وتعدّ دليلاً شرعيًّا إلزاميًّا للمسلمين. ومن أبرز من دافع عن حجية السنة ورسخها في مواجهة التيارات الفكرية التي حاولت تقليص دورها، مثل القرآنيين الذين أنكروا حجيتها، هو محمد بن إدريس الشافعي صاحب "الرسالة". وقد بيّن حجية السنة من خلال علاقتها بالقرآن، حيث يرى الشافعي أن السنة توضيح القرآن وتفصيل ما أجمله، وتقييد ما أطلقه، وتخصيص ما ورد فيه على وجه العموم، ويجب اتباعها لأن الله فرض طاعته وطاعة رسوله: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ [آل عمران: 32]، كما أكد أن السنة النبوية ليست مجرد شرح للقرآن، بل تأتي أيضًا بأحكام تشريعية مستقلة لا نص فيها. وقد استدل أيضًا بأحاديث النبي، ومنها قوله: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه"، وهو ما يعني أن السنة تشارك القرآن قداسته. وقد وضع الشافعي شروطًا لقبول السنة النبوية القولية لغزارة مادتها، خاصة في الروايات المنقولة عن طريق الآحاد؛ إذ أكد ضرورة توفر العدالة والضبط في الراوي، واستقامة السند، وخلوّ النص من التعارض مع القرآن أو الحديث المتواتر. فما رواه الصحابة عن النبي، ورواه عنهم التابعون، تنظمه أحاديث ذات نظام إسنادي يمكن من خلاله معرفة الحديث الصحيح من غيره. ولهذا كان يُكثر الاستشهاد بجملة عبد الله بن المبارك: "الإسناد من الدين".
وبعد أن قمنا باستعراض الآراء الكلامية حول التشريع النبوي وعلاقته بالوحي، سننتقل إلى الجانب التطبيقي لهذا التشريع من خلال نموذجين عملين هما عقوبة الزاني والمرتد. ففي حكم الزنا، حدد القرآن عقوبة بعينها وهي الجلد مائة جلدة، ونص على عدم الشفقة وتطبيقها: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 2]، لكن العقوبة الشرعية عند الفقهاء المسلمين كانت الرجم حتى الموت للزاني والزانية إذا كانا محصنين، ودليلهم في ذلك أن النبي حكم بالرجم عمليًا، وأن آية قرآنية نُسخت تلاوة دون أن يُنسخ حكمها، وهي القائلة بخبر من أخبار الآحاد: "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم". وجاء في البخاري عن عمر: "رجم رسول الله، ورجمنا بعده، وأخشى أن يقال في زمن لاحق: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله".
ونجد في حكم المرتد عن دينه أن القرآن وصفه بأنه عمل قبيح فاعله وله الخزي في الدنيا والآخرة: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 217]، لكنه لم يحدد له عقابًا دنيويًا، بينما الحديث المنسوب إلى النبي: "من بدل دينه فاقتلوه" اعتُمد في العمل التشريعي باتفاق المذاهب، إلى أن استحال هذا الحكم مع الزمن إلى حديث ثابت عقديًا يؤمن به العامة. ما نخلص إليه هو أنه توجد ثلاثة أبواب في علاقة التشريع النبوي بالقرآن من حيث كونه تشريعًا غير مطابق مع النص القرآني، وتتمثل في ما ذكره القرآن ولم يحدد له حكمًا عمليًّا فأُسند إلى النبي الحكم فيه، وما حدد القرآن له حكمًا وأُسند إلى النبي خلافه، وأخيرًا ما لم يذكره القرآن ولا وضع له حكمًا وأُسند إلى النبي ذكره والحكم فيه.
لقد أُسند إلى النبي في التراث أقوال وأفعال تنتمي إلى المجال التشريعي، ومنها ما لا يتطابق مع القرآن وأحكامه، وحجتهم في ذلك قاعدة عامة تقول إن النبي لا يُحل إلا ما أحل الله، ولا يُحرّم إلا ما حرّم الله، وهذا يعني استحالة حدوث اختلاف تشريعي بين الإرادة الإلهية والتشريع النبوي، لكن لا يزال الإشكال قائمًا نظرًا للمادة التشريعية الغزيرة المنسوبة إلى النبي، والتي فاقت حجم المادة القرآنية. يوجد في أفعال النبي التشريعية ما أخبرنا به القرآن، وأخرى لم يخبرنا عنها، بل عرفناها من التراث الإسلامي حديثًا وسيرة وتفسيرًا. والقاعدة ثانية تتمثل في نفي التعارض بين ما يشرعه النبي وما جاء في القرآن، بالقول إن النبي لا يُحرّم إلا ما حرّم الله، ولا يُحلّ إلا ما أحل الله، لقوله: "إني لا أُحلّ إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أُحرّم إلا ما حرّم الله في كتابه". وهذا الحديث يُبيّن أن الحلال والحرام راجعان إلى الله وحده، وأن تشريعات النبي من أصل قرآني إلهي. أما القاعدة الثالثة فهي رفض الاحتجاج بالقرآن وحده من حيث كونه الكتاب الحاكم على غيره، وقد أُسند في تثبيت هذا المعنى أحاديث للنبي ترفض الفصل بين القرآن والسنة. إذا نتبيّن أهمية طاعة النبي من حيث هي طاعة لله، وهي طاعة مطلقة لا تقتصر على طاعة الأحكام القرآنية فقط، بل باعتبار النبي حكمًا يحكم بين الناس: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]. والسؤال هنا: بِمَ كان يحكم؟ وما هي الخلفية التشريعية التي اعتمدها في الفصل بين الناس إضافة إلى القرآن؟
كان النبي، إضافة إلى القرآن واجتهاده الشخصي، يحكم بالأعراف القائمة، ومن أمثلة ذلك القسامة عند القتل، فجانب من التشريع النبوي مأتاه الأعراف العربية الموروثة. وقد حدث أن حرّم النبي ما أحلّه الله لأسباب دنيوية، وهو ما تكشفه الآية الأولى من سورة التحريم، القائلة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التحريم: 1]. والحكاية أن مارية، مملوكته القبطية، حرّمها على نفسه بيمين أنه لا يقربها، طلبًا لرضا حفصة بنت عمر، زوجته، لأنها غارت من خلوة النبي بمارية في يومها وفي حجرتها. ثم يُخلص القول إلى أن الذي حرّمه النبي على نفسه شيء كان الله قد أحلّه له، وجائز أن يكون جاريته أو شرابًا من الأشربة، فعاتبه الله لتحريمه ما أحله.
أُسندت إلى النبي في المدينة وظيفة التشريع، وهي لا تقتصر على شرح أحكام القرآن وتفصيلها وبيان كيفية تطبيقها، بل تتعدى ذلك إلى إنشاء أحكام لا وحي فيها. وقد اعتمد النبي، إلى جانب القرآن واجتهاده، الأعراف القائمة في الحكم بين الناس، وسيُضاف هذا كله إلى السنة، بوصفها ما أقرّه النبي، حتى وإن لم يكن من القرآن ولا من وحيه.
وقد آثرت إشكالية التشريع النبوي على أصول الفقه وفروعه، وأدت إلى تطور علم أصول الفقه من خلال ظهور رؤى متعددة حول حجية السنة؛ إذ وقع تأصيل مبدأ نسخ القرآن بالسنة، واعتبار اجتهاد النبي نموذجًا للاجتهاد. أما على مستوى الفروع الفقهية، فقد ظهر الاختلاف في حجية أفعال النبي، وهل كانت كل أفعاله تشريعًا لكامل الأمة أو بعضها خاص به، إضافة إلى الاختلاف في مدى إلزامية أحاديث الآحاد في الأحكام العقدية.
في الختام، تظل مسألة الدور التشريعي للنبي محمد من بين أكثر المسائل تعقيدًا في التراث الإسلامي. والواضح من خلال ما عرضنا أن كان للنبي دور تشريعي حقيقي، لكنه لم يكن مستقلاً عن الإرادة الإلهية، بل جاء مسددًا بالوحي، وهنا نتحدث عن المسائل العقدية والأحكام التشريعية التي يحتاجها المسلم في دينه ودنياه، وهي ما تقتضي تشريعًا إلهيًّا. فما صدر عن النبي في أمور العقيدة والدين، إما وحيًا مباشرًا أو اجتهادًا خاصًا يقره الوحي إذا أصاب ويصوبه إذا أخطأ. أما بالنسبة إلى الأمور الدنيوية التي لا تتعلق بالعقيدة ولا تؤثر في كمال الرسالة، فقد كانت اجتهادًا لنبي بشري يخطئ ويصيب. وهذه الرؤية تدعم بشرية النبي في أمور الدنيا، وعصمته وتسديده بالوحي في أمور الدين، كما أنها تقر بأهمية القرآن كمصدر تشريعي أول، والسنة كمصدر تشريعي ثانٍ تفصل وتوضح النص القرآني دون أن يكونا في نفس المرتبة من القداسة. إذا فهم طبيعة التشريع النبوي يساهم في تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة التي ترسخت عبر العصور، ويسمح بقراءة معاصرة للنص الديني تتوافق مع مقاصد الإسلام وجوهره.
قائمة المصادر والمراجع
ـ القرآن الكريم.
ـ الشافعي، محمد بن إدريس. الرسالة. تحقيق أحمد محمد شاكر. القاهرة: 1938
ـ البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري.
ـ الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الموافقات في أصول الشريعة. تحقيق عبد الله دراز. بيروت: دار المعرفة، 2004.
ـ جعيط، هشام. في السيرة النبوية، الوحي والقرآن والنبوة. بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1999
فهرست الآيات القرآنية
البقرة: الآية 217
آل عمران: الآيتان 32، 73
النساء: الآية 2
المائدة: الآيات 42، 43، 47، 48
الأنعام: الآية 38
النور: الآية 2
التحريم: الآية 1
الحشر: الآية 7