أزمة الحقيقة وعالم ما بعدها
فئة : مقالات
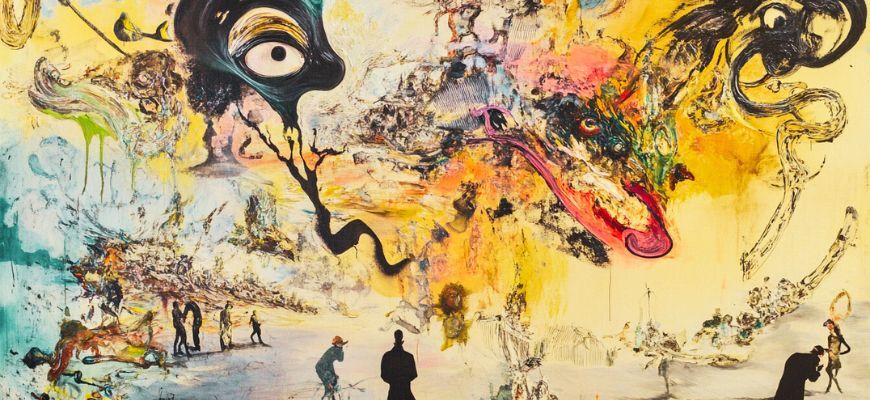
أزمة الحقيقة وعالم ما بعدها
انشغل الإنسان بالبحث عن الحقيقية منذ زمنٍ مبكر من تاريخه، وأولى أهمية بالغة في تطوير الأدوات التي تُساعده في محاولاته للكشف عنها، وتنقية/تحديد ما هو "حق" و"صحيح" و"صادق" عمّا هو "زائف" و"خاطئ" و"كاذب". وكان السحر والأديان والفلسفة وصولاً إلى العلوم الحديث بمختلف مجالاتها بمثابة سلاسل إمدادات طويلة استخدمها البشر في أزمان وحُقب مختلفة في سبيل الحصول على الحقيقة واحتكارها.
وفي كل مرّة تتعرض فيه الأداة التي اكتسبت صلاحية أو معقولية في حقبةٍ ما لأزمة، تتعرض في المقابل كل ما اُعتِبر في الماضي حقائق مفروغ منها لأزمة ثقة تتفاوت في عمقها. ولعل أبرز الأزمات أو محطات الانتقال في هذا الصدد، أو ما سمّاها فرويد بـ"الإهانات الثلاث" الكُبرى التي هزّت الوعي البشري السائد، هي: اكتشاف أن البشرية ليست مركز الكون، وفكرة تطور الكائن البشري التي تتعارض كلياً مع المفاهيم والتصورات التقليدية والدور الكبير للاوعي في تحديد تصرفاتنا، ثم أضيف إليهم "الإهانة الرابعة" بعد انتصار الحاسوب "ديب بلو" على غاري كاسباروف عام 1996 في لعبة الشطرنج.
لقد ظلّت الحقيقة مطلباً أساسياً وحيوياً في حياة البشر، والبحث عنها مثّل أحد المواضيع الجوهرية في الفلسفة عبر عصورها ومختلف مدارسها الفكرية. وظلّت التساؤلات الفلسفية مشغولةً بماهية الأشياء؛ أي حقيقتها، وبمدى وكيفية قدرتنا على إدراكها، وهل تُوجد "حقيقة" أصلاً خالية من كل الشوائب والتأثيرات، وما هي المعايير الموضوعية لتحديدها أو لتحديد العبارات الصادقة...
اعتبر سقراط البحث عن الحقيقة واجباً أخلاقياً، والحقيقة تُولَد من خلال الحوارات والتفكير المشترك. وتحت إلحاح مبدأه الشهير (الحياة غير المُختبرة بالتساؤل لا تَستَحِق أن تُعاش) سخّر حياته كلها لاصطياد مواطئ الوهن في التصورات والأفكار السائدة أو الإجابات الجاهزة التي تضطجع في العادة على وسائد اللاوعي الفردي أو الجمعي وبأريحية. وقد حاول سقراط الكشف عن مدى التباساتها وتناقضاتها عبر تمريرها على فِخاخ مجموعة من الأسئلة الجدليّة[1]. وإذا كانت الأسئلة حول ماهية الأشياء هي الكفيلة بالكشف عن الماهيات وفقاً للأسلوب السقراطي، آمن أفلاطون بوجود حقيقة مطلقة وثابتة ومستقلة في عالم المُثل الأبدي، ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال المعرفة (الحقة) التي تختلف عن الرأي، فالرأي يستند إلى قناعة الفرد الحالية، بينما تستند المعرفة إلى مبررٍ ملموسٍ لهذا الرأي. وقد شبّه طبيعة الاختلاف بين الموقفين في تشكيل تصوراتهما عن الواقع بتمظهراته المختلفة بسجناء الكهف الذي لا يرون سوى ظلالا، وبالنسبة إليهم ستكون هذه الظِلال هي الحقيقة حرفياً. وبناء على ذلك، فإن الفيلسوف العارف الذي يأخذ على عاتقه الارتفاع عن العالم المحسوس إلى عالم المُثل هو وفقاً لأفلاطون المعني بحراسة الحقيقة، وهو الذي يأخذ بأيدي الناس لتحريرهم من فخ الوهم والزيف إلى رؤية الأشياء الحقيقية التي لم يدركوا منها في السابق سوى ظلالها[2].
عارض أرسطو التصور الأفلاطوني، ورأى أن الحقيقة شيءٌ مُعطى في العالم قبل تفكيرنا ومستقلةً عنه، وقد كثّف مقاربته في عبارته التقريرية الشهيرة: "إن القول بأن الوجود ليس موجودًا أو أن العدم موجودٌ هو قولٌ باطلٌ؛ ومن ناحية أخرى، فإن القول بأن ما هو موجودٌ موجوداً والعدم ليس كذلك هو قولٌ صحيحٌ"[3]. فالبشر في سياق تفكيرهم ومعرفتهم لا ينتجون سوى مقولات أو اعتقادات؛ أي لا يضيفون سوى صفاتاً أو تخيّلات لما هو "حقيقي" أو "زائف". وكل مقولة أو اعتقاد لن يكون صحيحاً ووجيهاً إلا إذا تطابقت الصفة تماماً مع الموصوف. فقولنا / اعتقادنا مثلاً بأن الطيور تستطيع أن تطير، لا يعني هذا أننا أوجدنا الحقيقية من العدم، فالحقيقة في الأصل/الواقع هي أن الطيور تطير.
في الفلسفة، يُعتبر أرسطو هو مؤسس ما يُعرف بـ"نظرية التطابق" التي وضعت معيارًا لاختبار ما هو "حقيقي" و"صادق" بناء على تطابق القول أو الاعتقاد مع الواقع. ظهرت فيما بعد "نظرية التناسق" أو "نظرية الاتساق المنطقي"، التي زعمت بأن العبارة الصادقة لا يمكن الإقرار بها بمجرد تطابقها مع العالم الخارجي، بل في مدى انسجامها وتماسكها مع نظام من المعتقدات أو الجمل الأخرى ودون أن تتناقض معها. وإذا استخدمنا مثل الطيور الشهير، فإن القول بأن "جميع الطيور تطير" يتناقض مع واقع البطريق الذي لا يستطيع الطيران، ولكنه مصنّفٌ في الأخير ضمن فئة الطيور. أما "النظرية البراغماتية/العملية" فقد شدّدت على أن كل حقيقة يجب أن تكون له نتائج نافعة. في الفلسفة الحديثة، خصوصاً مدرسة ما بعد الحداثة التي تأثرت كثيراً بأفكار نيتشه، رأت بأن الحقيقة مجرد بناء اجتماعي أو لغوي، وليست شيئًا موضوعيًّا ومستقلاً بذاتها، بل هي نتيجةٌ طبيعيةٌ للخطابات (الأنظمة اللغوية والثقافية) التي تُنتجها وتفرضها. فلا حقيقة خارج النص (دريدا)، وحدود لغتي هو حدود عالمي (فيتغنشتاين)، واللغة بيت الوجود أو بيت الكينونة (هايدغر). ويبدو هنا واضحاً، أن الفلسفة الحديثة التي دخلت منذ وفاة هيغل مرحلة ما سُمي بـ"عصر الأزمة الدائمة"[4] بفعل/بجانب الضربات الكبيرة التي مارستها مطرقة التقدم الواثق في العلوم الطبيعية والمناهج التجريبية، اضطرت في نهاية المطاف إلى التخلى عن واحدة من أبرز مهامها (الكشف عن الحقيقة)، وانهمكت في إعادة النظر ونقد وتفكيك المنظورات والأفكار التي شغرت أماكن واسعة في إرث المدارس الفلسفية والفكر الفلسفي.
لطالما تساءل الفلاسفة عن الوسيلة التي تمكننا من الحصول على معرفة (مؤكدة). وبما أن المعرفة الحقَة عَنَت في لحظة ما اتساق الإدراك مع حالة يُفْتَرَض وجودها، فقد بدا أن العلم الحديث وبما قدمه من معارف ومناهج وتقنيات، خصوصاً العلوم الطبيعية، بات قادراً على التعامل مع الواقع بالشكل الأمثل من خلال قوانين رياضية بحتة. وفي هذا السياق، كانت الحقيقة تعني، في المقام الأول، الواقع نفسه؛ أي في إطار قابليته للمعرفة والإدراك على نحوٍ دقيقٍ. لزمنٍ طويل ساد الاعتقاد بأن أساس التفسيرات العلمية هو التجربة التجريبية، والدقة أو الصحة تكون ثمرة تلقائية لحالة التوافق أو التطابق التام مع نتائج التجربة التجريبية. مثّلت "النظرية النسبية" انعطافه كبيرة ليس في تاريخ العلوم الطبيعية فحسب، بل كان لها تأثيراً بالغاً على مختلف العلوم والتخصصات.
فالقول بأن الزمان والمكان نسبيان ويخضعان لمنظورات الراصد لم يكن يعني طي صفحة التصور النيوتني عن الزمان والمكان (المُطلقين) فقط، والذي ساد لزمنٍ طويلٍ، بل أصاب فكرة الحقائق المُطلقة، بل وحتى الحقيقة الموضوعية، في مقتلٍ. فضلاً عن أنه كان يُنظر إلى أن العلم يتطور بطريقة تواصلية وتراكمية، لكن هذا الإحلال وهذه القطعية أو التناقض بين التصورات المصنفة "علمية"، قادت في نهاية المطاف إلى الحديث عن "حقائق مؤقتة" تسود في حقبةٍ زمنيةٍ معينةٍ حتى وإن ظهر في حقبةٍ لاحقةٍ عدم صحتها. لكن كيف/هل يمكن للعلم أن يتطور بدون وجود هذه الحقائق التي ستكون خاطئة أو معرفة زائفة في حقبة لاحقة؟ غاستون باشلار الذي رأى بأن تاريخ العلم ما هو إلا تاريخ تصحيح الأخطاء، حاول أن يجد صيغة توفيقية بين حقائق العلم وأخطائه (الحقيقة العلمية أخطاء مُصحَّحة)[5]. وضعت هذه الاستنتاجات الموثوقية بالعلم وقدرته على كشف الحقائق في مرمى الشك والسؤال، على الرغم من أن هذه الصيغة التوفيقية تشي من زاوية ما بأن العلم ماضٍ في طريقه الطويل إلى "الحقيقة" عن طريق تصحيح الأخطاء، لكن من زاويةٍ أخرى يعني أن العلم أصبح غارقاً في متاهة تصحيح أخطائه أو مكبلاً بها وعلى طريقة سجناء الكهف في التصور الأفلاطوني، لكن هذه المرة لم يَعُد بمقدور لا الفيلسوف ولا العالم أن يقطع وعداً بإمكانية الوصول إلى ضوء الحقيقية في نهاية النفق/الكهف، وسيتم الاكتفاء بالظلال بوصفها "حقائق مؤقتة".
قادت رحلة البحث عن الحقيقة المحفوفة بكل مظاهر وبواطن الشك والحيرة إلى التساؤل حول مدى قدرة الكائن البشري على الوصول إلى الحقيقية أو إلى أي حقيقية موضوعية، هذا الكائن الذي ينمو ويتطور داخل مجموعة من أقفاص بشريته: الذاتية (النفسية والذهنية)، والجماعية (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وعند محاولة التفحّص جيداً في التفسيرات التي تقدمها العلوم الطبيعية؛ وفيما إذا كانت تُشتق فعلاً من خبراتنا المبنية على الاختبار والملاحظة أم إن التجربة العملية ليست سوى أحد الحيل لتبرير محاولة إثبات صحتها، وجد كارل بوبر وآخرون بأن الأساس الفعلي لكل تفسير هي المفاهيم العقلية الكامنة فيه، ولا يمكن لأي ملاحظة تجريبية أن تتم دون مفهوم. والمفاهيم التي نشرح بها شيئًا ما كانت قد تطورت دائماً في وقتٍ سابقٍ وستكون هي الأساس الذي يُشتق منه كل تفسير، وليست الشيء المراد تفسيره[6]. وهو الرأي الذي يتفق معه توماس كون في تحليله للطريقة التي يتشكل ويسود بها "النموذج القياسي/الإرشادي" (الباراديم) في عصرٍ من العصور[7].
كان فكرة أن كل شيءٍ نسبيٌّ ويخضع لمنظورات الذات الفاعلة أو المتفاعلة هو الخلاصة النهائية للرحلة العلمية والفلسفية في معاول البحث عن "الحقيقة" خلال العقود الماضية. لكن الاعتراف بأن كل شيء مبني (حصرًا) على الحقيقة الذاتية لا يحل هذه المعضلة على الإطلاق، بل يفتح السياق على كومة من الإشكاليات لا نهاية لها؛ فمثلا القول بضرورة حماية الأطفال من العنف لا يمكن أن يخضع للجدل بوصفه فكرة نسبية تماماً يمكن قبولها أو رفضها دون أن يعني الرفض أو القبول شيئاً.
وفي عصر يشهد كثافة تواصلية وعولمية لا نظير لها، وتداخلات واختلافات ثقافية واجتماعية جارفة، وذكاء اصطناعي[8] يستطيع أن يوفر كل ما لذ وطاب من "الحقائق البديلة" لكل شيءٍ ومزودة بأدلة يَصْعًبُ دحضها، فإنه في حال وسعّنا أو شجّعنا التدافع في الاختلاف بناء على الاعتقاد بوجود حقيقة نسبية فقط، سنكون بصدد مشاكل لا نهاية لها. يَسُوق تينو ومَتِيَاس شميدت مؤلفا كتاب "إمكانية تبرير الحقيقة" (Die Begründbarkeit der Wahrheit) مثالاً دالاً على ذلك وهو اتفاق عشرون أعمى، من خلال الاعتراف المتبادل بحججهم، على لون كوب وجدوه. ما سيتوصلون إليه لن يُشير إلى لونه الحقيقي - حتى لو أُدرج عشرون أعمى آخرون في الحوار. والمشكلة الأكبر، أنه في ظل الافتراض بنسبية الحقيقة وضرورة وجود مساومات للاتفاق حولها لن يُغيّر من النتيجة شيئاً فيما لو أُضيف شخص واحد غير أعمى ولا مُصاب بعمى الألوان. لكن دوامة الجدل المعاصر لن تتركنا عند قضية إدراك اللون على اعتبار أن الإنسان مُقيد في النهاية بإدراكه الذاتي، بل تتجاوز إلى التساؤل حول مفهوم اللون، وفيما إذا كانت هناك "ألوناً" أصلاً في حقيقة الأمر[9]!
لقد كانت من أبرز تجليات هذه المخاضات الحائرة هو "عصر المابعد"، والذي أصبحت - بحسب أورتوين رين - لازمة لغوية في كل المجالات تدل على عدم اليقين في زمنٍ مُعقدٍ وغير قابل لإدارة التوافقات، حيث بات الناس متأكدين من ذهاب القديم لكنهم لا يعرفون كيف سيبدو عليه الجديد. ورين هو عالم اجتماع مختص في الأزمات ويكتب باستمرار عن عدم اليقين الذي يسود في عصر "ما بعد الحقيقة" (بالإنجليزي: post-truth، وبالألماني: postfaktisch. ويمكن ترجمتها إلى عصر ما بعد الموضوعية، أي غير المرتبط بالحقائق المتوافق عليها). يرى رين بأنه في هذا السياق يمكن ترسيخ أي نوع من ادعاءات الحقيقة، بغض النظر عن طبيعتها، فقط من خلال صياغة الحجج المناسبة، إذا لم تعد توجد جهة (محايدة) تقرر أي من هذه الادعاءات صحيحة بالفعل وأيها غير صحيحة. وهذا يعني، ضمن ما يعنيه، أن المنظور النسبي التام بمثابة الإعلان عن إفلاس العلم؛ مع إن العلم لا يدعم فكرة أن الحقيقة يمكن الوصول إليه بشكلٍ تعسفيِّ/اعتباطي، بقدر ما يتحدث ضمن علاقة السبب والنتيجة عمّا هو "ممكن"، "مُرجح"، "مُحتمل" و"شبه مؤكد"[10].
لقد حاولت بعض مدارس الفلسفة المعاصرة المهتمة بجوانب وأبعاد "الفعل التواصلي" أن تقترح حلًّا توافقياً يقوم على فكرة أن الحقيقة يمكن أن تُبنى من خلال التفاهم الجماعي بشرط أن يتم ذلك في ظروف حوار مثالية. لكن على كل حال تبقى الخشية قائمة ووجيهة في ظل التفسيرات والتصورات شديدة التغيّر والتضارب والاضطراب للعالم. فالمشكلة في هذا السياق لا تكمن في تعدد المنظورات في مقاربة الحقيقة بحد ذاته، أو حتى في تعدد الحقائق نفسها، بل في ذوبان فكرة الحقيقة ذاتها في متاهة واسعة من الإجابات التي قد لا تقول أو تُقدّم شيئاً في نهاية المطاف!
[1] برتراند راسل، حكمة الغرب، الجزء الأول، ترجمة فؤاد زكريا، عالم المعرفة، الكويت، فبراير ١٩٨٣، العدد ٦٢، ص ٨١ – ٨٢.
[2] أفلاطون، المحاورة الكاملة، كتابة الجمهورية، المجلد الأول، ترجمة شوقي داود تمراز، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٩٤، ص ٣١٩ – ٣٢١
[3] إمام عبد الفتاح إمام، مدخل إلى الميتافيزيقا مع ترجمة للكتب الخمسة الأولى من ميتافيزيقا أرسطو، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، أكتوبر ٢٠٠٥، الطبعة الأولى، ص ٣٥٤ – ٣٦٠
[4] Herbert Schnädelbach, Philosophie in Deutschland 1831–1933, Suhrkamp Verlag AG, Franfurt am Main, 1983, P. 15
[5] عبد السلام بنعبد العالي، غاستون باشلار والمعرفة – الضد، مؤمنون بلا حدود، أخر تحديث ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠.
[6] يُنظر: كارل بوبر، منطق البحث العلمي (الطبعة العاشرة)، ترجمة محمد البغدادي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، فبراير ٢٠٠٤، الطبعة الأولى، ص ١٠٤ – ١٠٧. Tino Schmidt und Matthias Schmidt، Die Begründbarkeit der Wahrheit، J.B. Metzler Verlag، Deutschland، 2024، P. 29
[7] توماس كون، بنية الثورات العلمية، ترجمة شوقي جلال، عالم المعرفة، الكويت، ديسمبر ١٩٩٢، العدد ١٦٨، ص ١٦٣ - ١٦٥
[8] أحد التجارب الشخصية التي بتنا نخوضها مع أولادنا خصوصاً فيما يتعلق بتلك المعلومات التي نقدمها لهم على شكل "حقائق" ونحن تلقفناها ضمن سياق فخر وطني أو ثقافي ودون أن يتم تمحيصها (مثل البُن اليمني أفضل بُن في العالم)، وعندما يلجئون إلى ChatGPT للتأكد من دقة المعلومات، يقوم تطبيق الذكاء الاصطناعي بتزويدهم بمعلومات/حقائق أخرى، ونجد صعوبة في إقناعهم عن طريق النقاش كالقول إن الإحصائيات والتقييم عادة يمارس ظلماً على تلك الدول التي لا تتوفر لديها إمكانيات لعرض منتجاتها بالشكل المطلوب، كما نجد صعوبة في الاحتفاظ بصورتنا باعتبارنا مصدر موثوق. والمشكلة أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يوفر حقائق موثوقة، وحتى وإن حاولنا في سياق نقاشنا معهم دفعهم إلى التفكير والتمحيص بما تقدمه تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن طريق سؤالها عن معلومات تتعلق بمجال اهتماماتهم، وعندما يُقدِّم لهم معلومات أخرى تتقاطع مع قناعاتهم المسبقة أو دوائر انحيازاتهم، إلا أنهم لا يكفون عن اللجوء إليه في كل مرة، حتى وإن قدّم لهم في كل مرة حقائق مختلفة عمّا قدمها في السابق بعد تغيير صيغة الأسئلة قليلاً. وما لاحظته من خلال هذه التجربة الشخصية أنه لا يمكن الاستغناء عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لسهولتها وسرعتها الفائقة، لكن ما تقدّمه سيخضع للنظر والفحص فقط طالما تعارض مع قناعاتنا المسبقة، وسنجد المبررات والحجج اللازمة للدفاع عن قناعاتنا.
[9] Tino Schmidt und Matthias Schmidt، مرجع سابق، ص ٢٤.
[10] Ortwin Renn, Orientierungslos im postfaktischen Zeitalter: Ursachen und Lösungen. Die Mediation: Fachmagazin für Konfliktlösung - Entscheidungsfindung - Kommunikation, 2025(1), 26-29 (قمتُ بترجمة المقال إلى العربية تحت عنوان "التوهان في عصر ما بعد الحقيقة: الأسباب والحلول، وستُنشر قريباً).


