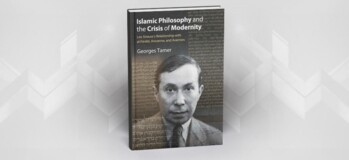الإلحاد لا يقي من المثالية والغيبيات
فئة : مقالات

"إن أكثر ما يضر بالفلسفة هو التخاذل النقدي والمهادنة مع الدين، أو محاولة إيجاد ذرائع للتخفيف من حدة التعارض الجوهري بين العقلانية الفلسفية، من جهة، وبين المنظومة الدينية ... التي، ما تزال قائمة إلى يومنا، وتستمر في استقطاب الجموع وتجنيدهم بكل الوسائل، من جهة أخرى"[1]. إذن، الأطروحة تقول: ثمة تعارض جوهري بين العقلانية الفلسفية، والمنظومة الدينية. الأطروحة ليست جديدة، كان هناك ما يشبهها في الفلسفة اليونانية ما قبل السقراطية، وقد شغلت الفلاسفة والمتكلمين على مر العصور. ولكن، تبدو لنا المسألة الأساسية مضمًّنة في وصف المنظومة الدينية التي "لا تزال قائمة إلى اليوم"! فإن جميع حجج الملحدين وحجج المؤمنين لا تجيب عن هذه المسألة.
لا نريد تكرار إجابة ماركس عن المسألة، بأن الدين باق معنا، لبقاء الأسباب التي أدت إلى نشوئه، لأن الإجابة ذاتها تحتاج إلى تفسير وإيضاح، بل إنها تطرح سؤالاً آخر: هل استمرار ظاهرة ما، كالظاهرة الدينية، يرجع إلى استمرار أسباب نشوئها في الوجود؟ أي هل يقدم لنا المنطق إجابة حقيقية، لا صورية فقط؟ وهل يمكن أن تستقل ظاهرة كهذه عن أسباب نشوئها، وتولِّد من ذاتها ومن تفاعلاتها مع ظواهر أخرى، أسباباً جديدة لدوامها؟ لعل تاريخ الظاهرة ينطوي على هذه الأسباب، وكيفية تولدها. إذاً، الإجابة الشافية قد نجدها في التاريخ، لا في المنطق، ولا في الفلسفة، إلا بقدر ما تقارب هذه وذاك منطق التاريخ، وهو في اعتقادنا منطق جدلي، ديالكتي. نضرب على ذلك مثلاً من تعريف الديالكتيك نفسه، بأنه تعارض بين حدين في "كلية عينية" أو "وحدة تناقضية"، لا وجود لأحدهما إلا بوجود الآخر، وانتفاء أحدها أو زواله هو انتفاء الآخر أو زواله، وكل تغيُّر يعتري أحدهما يؤثر في الآخر بالضرورة، ويؤثر من ثم، في التركيب الذي ينتج من تفاعلهما بالضرورة أيضاً، هذا أولاً. ثانياً إن كل واحد من الحدين قابل لأن يتحول إلى الآخر، لوجود ما هو مشترك بينهما. ثالثاً، ينتج من تعارضهما أو من جدلهما أو تفاعلهما تركيب جديد، في كل مرة، ليس أياً منهما. على هذا النحو فقط يكون الديالكتيك منطق الصيرورة، ومنطق الواقع ومنطق التاريخ، أو منطق النمو، إذا شئتم، وتحول ما هو موجود بالقوة إلى موجود بالفعل، أو تحقق ممكنات على حساب ممكنات أخرى، ولعل هذا هو المعنى الأدق للتاريخ.
الحدان هنا هما العقل والدين، أو العقل والإيمان أو الفلسفة والدين، أو العقلانية الفلسفية والمنظومة الدينية. فهل ثمة ما هو مشترك بين العقل والدين، أو العقل والإيمان أو الفلسفة والدين أو بين العقلانية الفلسفية والمنظومة الدينية، هل هما حدان في كلية عينية؟ نعتقد أن هذا السؤال هو من نوع الأسئلة التي لا تحتمل إلا واحدة من إجابتين، بالإيجاب أو بالنفي؛ لذلك يذهب النظر في اتجاهين مختلفين: الأول لكي يبين العناصر المشتركة بين الحدين والروابط التي تربط أحدهما بالآخر، ويبرهن على ادعائه، والآخر يهتم بتفنيد نتائج الأول ودحضها، لأنه لا تمكن البرهنة على وجود ما ليس موجوداً، لذا تبدو مهمة الثاني، النافي، أسهل. السهولة هنا تأتي من نفي وجود القضية أصلاً، فتغلق باب النقاش. الصعوبة كلها تكمن في البرهنة على وجود عناصر مشتركة وروابط بين الحدين المعنيين. وهذا ما سنقوم به، على اعتبار "الكلية العينية" المقصودة هنا هي الإنسان: الفرد / النوع. والتدين، في اعتقادنا، يستمد مشروعيته من اللاتدين، ولا يستمدها من ذاته. هاتان المقدمتان لا بد منهما.
لعل الفلاسفة الألمان من كنط إلى ماركس، مروراً بهيغل وفويرباخ وشتراوس وباور .. كانوا من أكثر الفلاسفة انشغالاً بهذه القضية. ونخص من بين هؤلاء الفلاسفة فويرباخ، الذي كان أكثر حسماً، في نقد الدين والكشف عن "ماهية الدين"، أو "جوهر الدين"، إذ اعتبره أنثربولوجيا مقلوبة، فأحالنا على الأنثربولوجيا، وعلى فرع خاص من فروعها هو الأنثربولوجيا الثقافية: الإنسان وضع خصائصه الإنسانية، ماهيته أو جوهره، في الطبيعة، فقدسها، ثم ألَّهها، ثم جرَّدها من عينيتها وثقالتها المادية، ورفعها إلى السماء، وسماها "الله"، بلغات مختلفة وخصائص مختلفة وكيفات مختلفة ورموز مختلفة و"هيئات" مختلفة أيضاً[2]. وإذ يمكن اعتبار فويرباخ مؤسساً للإلحاد العقلي، لا يمكن التغاضي عن عدد من الإحداثيات في منظومته الفلسفية، أولى هذه الإحداثيات وأهمها أن جوهر الدين هو جوهر الإنسان نفسه، وماهية الدين هي ماهية الإنسان نفسه؛ ومن ثم فإن فويرباخ لا يؤسِّس الإلحاد، بل يوسِّس الدين، برده إلى مصدره: الإنسان. والثانية أن الظاهرة الدينية قديمة قدمَ الاغتراب، Alienation، الذي هو علة نشوء الدين، في نظر فويرباخ، وعلة نشوء الملكية الخاصة، في نظر ماركس، الذي لم ينف فرضية فويرباخ، وهذا يعني أن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين الدين، في سيرورة نموه وتطوره، وبين الملكية الخاصة للأرض، ثم لوسائل الإنتاج الأخرى، واقترانها باستعباد النساء. فأن ينتج من الاغتراب ظاهرتين مختلفين اختلافاً بيِّناً شيء لافت للنظر، ومدعاة إلى التفكير: سبب واحد تنتج منه نتيجتان مختلفتان، هذا مؤدى نقدنا للسببية البسيطة، وعدم الاكتفاء بتفسير ماركس المشار إليه فوق.
وإذ افترضنا أن فويرباخ قد أسس الدين، برده إلى الإنسان، لا بد أن نشير إلى أننا نعرِّف الإنسان، الفرد الإنساني، العياني، بأنه كائن كلي، فرد - نوع، عاقل وأخلاقي، وهذا يساعدنا في رد الدين إلى الأخلاق، التي هي ما يميز الإنسان من سائر الكائنات الحية، على كوكب الأرض، لا العقل، لأن بعض العمليات العقلية والوظائف العقلية مشتركة بين الإنسان والحيوان، بل لأن الأخلاق هي قوام الاجتماع البشري، وأسُّ الروابط الاجتماعية والإنسانية، أكثر من العقل، ولكن معه بالطبع. فبوسعنا أن نقول اليوم إن المجتمع نظيمة أخلاقية، والمجتمع الحديث نظيمة أخلاقية - عقلانية. من هذه الزاوية، ربما، يمكننا تأويل أخلاق الواجب، عند كنط، الذي لم يتوان عن تأليف كتاب "الدين في حدود مجرد العقل"، على الرغم من قولة الشاعر الألماني، هاينه: إن كنط "قطع رأس الألوهة بسيف النقد"، لدى مقارنته بروبسبيير.
وإذا أرجعنا الدين إلى عناصره الأساسية، الإيمان أو اليقين والتقديس والتأليه، بصرف النظر عن العبادات والطقوس، التي هي مجرد أشكال للتعبير عن هذه العناصر، مختلفة باختلاف الجماعات والمجتمعات، واختلاف الأزمنة، ولا تزيد اليوم عن كونها نوعاً من فولكلور، يمكن أن نجد بين الدين والإلحاد العقلي عنصرين مشتركين، على الأقل، هما الإيمان والتقديس، على اعتبار الأول: اليقين، حاجة عقلية، من نوع الحاجة إلى مبادئ ثابته، وقيم مشتركة، والحاجة إلى معرفة الحقيقة، وتعيين معايير الحق والخير والجمال. والثاني "عنصر في الشعور الإنساني"، (مرفوع إلى الحد الأقصى)، لا يمكن نفيه، إلا بنفي الشعور نفسه. ويمكن القول: إن الإلحاد، الذي لا يتضمن هذين العنصرين، نوع من العدمية. وهذه، أي العدمية، نفي للعقل والأخلاق معاً. ولعل الشك العقلي، لا الارتياب، قاسم مشترك أولي، بين إيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين، إذ لا نظن أن هنالك عاقلا لا يشك.
هنا نفترض أن القول بعدم وجود الله، لا يعادل القول بعدم وجود الدين، أي عدم وجود الإيمان والتقديس والتأليه في حياة الأفراد والجماعات والمجتمعات، علاوة على أن "وجود الله" ليس علَّة الظاهرة الدينية، وكذلك توحيده. فإذا وُضعت المسألة هذا الوضعَ، أو على هذا النحو، يصير الحديث عن "الإلحاد" غير الحديث عن الدين، لأنه إذا كان الألحاد نفياً للدين، يكون نفياً للواقع والتاريخ، فالظاهرة الدينية متعالقة مع غيرها من الظواهر الواقعية في العالم وفي التاريخ، كظاهرة السلطة، أو التفاوت الاجتماعي، مثلاً.
من الممكن التشكيك بوجود الله، ونقد الوحي نقداً جذرياً وتقويض أصوله الأسطورية، كما يمكن تشريح الكتب المقدسة وإجراؤها على محك العقل وتبيين تناقضاتها البنيوية والبرهنة على أنها خطابات أسطورية خرافية[3] .. إلى آخره (أو العكس)، لكن هذا كله: الله والوحي والكتب المقدسة، لا يستنفد الدين، ولا ينفي وجود الإيمان والتقديس والتأليه. ثمة أديان لا تقول بالوحي، وليس لديها كتب مقدسة، وثمة من يقدس الأئمة ويؤله بعضهم، كمؤلِّهة الإمام علي بن أبي طالب، علاوة على تأليه المسيح، وإن بصيغة "ابن الله".
فالقول بأن الاعتقاد بوجود الله هو صلب الدين قول غالط، لأن الدين كان موجوداً قبل الاعتقاد بوجود الله، ثم قبل الاعتقاد بوحدانية الله. إذا كان الأمر كذلك، فإن عدم الاعتراف بوجود الله ليس هو صلب الإلحاد. وعدم الاعتراف هذا لا يقي من المثالية، ولا من الإيمان بالخرافات والأساطير والغيبيات، ولا يقي من فساد العقل والأخلاق، اللذين يمكن أن يفسدهما بالفعل دين الفقهاء، مثلما يمكن أن تفسدهما الأهواء الطائشة والنزوات، المنفلته من رقابة العقل والأخلاق. لا نروم الدفاع عن الدين، فإن أسوأ ما يمكن أن ينزلق إليه العقل هو الدفاع عن الدين. الدين لا يحتاج إلى من يدافع عنه، وكذلك الأمر في شأن عدم التدين أو في شأن الإلحاد. نعتقد أن الأخلاق هي صلب الدين، لأنها مصدره وعلة نشوئه.
نقد الدين واجب معرفي وأخلاقي، بصفته شأناً من شؤون الدنيا، وعنصراً في نسيج التاريخ. والنقد الجذري نفي جذري، ولكن من أجل إثبات، هو نفي إيجابي، من أجل حقيقة ليست موجودة في أي مكان، إلا لدى البشر الأحياء، هنا والآن.
[1]- محمد المزوغي، تحقيق ما للإلحاد من مقولة، منشورات الجمل، مكتبة الفكر الجديد، بيروت وبغداد، 2014، ص 6
[2]- راجع/ي، سيغموند فرويد، موسى والتوحيد، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، للمقارنة بين صورة إله موسى المصري، وصورة يهوه الغضوب، إله البراكين.
[3]- المزوغي، ص ص 7 - 8