الدين والتدين ... المعضلة البسيطة: محاولة تربوية لفك الالتباس في الرؤية
فئة : مقالات
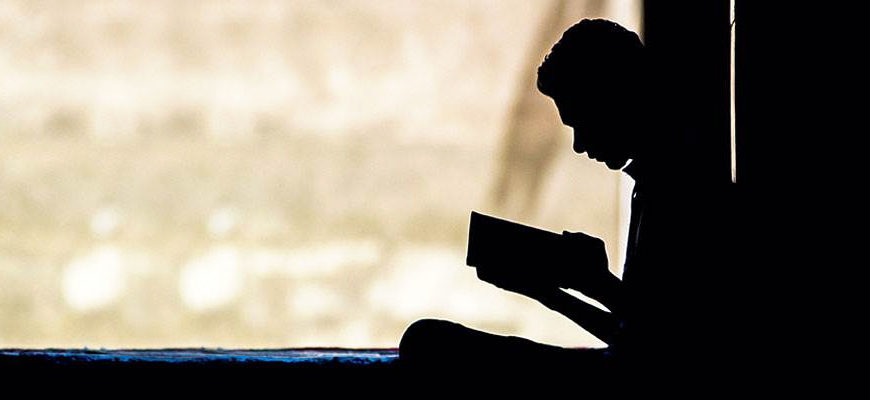
تصاعدت في السنوات الأخيرة في عالم الكتابة النوعية وتيرة بحوث "الدين والتدين" بوصفها إحدى أكبر جدليات الفكر المعاصر، ألقت بظلالها على براديجمات التفكير المتسمة بخصائص العلم وحقوق الإنسان، من حيث هي براديجمات أكثر اهتماماً بتكسير الطابوهات الدينية والسياسية، قد يكون أكثرها ضمن الأفق الإيجابي وبدافع تجاوز مضار تقسيم الناس إلى مؤمنين وكافرين، غير أنه ـ في ما أرى ـ تجاوز الأفق الإيجابي إلى الأفق السلبي، عندما فاض في طموحه ليطال فطرة الإنسان فأضرّ بها كتكوين خَلقي وخُلقي، حيث اعتدى في كثير من نماذجه على ما عرف بمسلمات الوجود الإنساني المستعصية للتجاوز في كل المحاولات القبلية، كالقصدية والغائية والمثنوية والمعنى والأزواج.
تحت هاجس البحث عن البديل الأرضي في الدين والأخلاق يكون ناظماً مكتفياً بذاته بدون ما هو سماوي باعتباره ضاغطاً، أخضعت الظاهرة لتفكيك بنيوي في شقيها، لتفكيك التدين كعادات سلوكية، ولتفكيك الدين كنص ثابت، ثم تفكيك العلاقة بينهما، إن كلفظين لغويين متلازمين، وإن كظاهرتين سيكولوجيتين وسوسيولوجيتن متلازمتين إحداها تدل عن الأخرى، ثم تفكيك المجتمع المتدين والجماعة المتدينة إنثروبولوجياً، فانخرطت النخب في إعادة صياغة ظاهرة الدين كما لو أنه ظاهرة بشرية ومن إبداعات الإنسان بدلالة تنوع الدين كنص وكل ما عرف بالكتب السماوية المقدّسة، وتنوع التدين كطقوس سلوكية جمعية وفردية، وتأويل وتفسير تطورها عبر الزمن واختلافها من إثنية دينية إلى أخرى.
ففي ظلّ براديجمات التحليل السيكولوجي والسوسيولوجي والأنثروبولوجي والإبستمولوجيو الإكسيولوجي القائمة على مبادئ حرية التفكير والنقد والإبداع وآليات المنهج العلمي المعاصر، أدرجت الظاهرة كما لو أنها ظاهرة تجريبية إمبيريقية بالأساس، لا تتجزأ عن التجربة التاريخية النفسية للإنسان، ممّا يستوجب بحثها في عمقها الواقعي، في دردشات الناس وطرق معيشتهم وقيمهم وتربيتهم وطقوسهم الموسمية واقتصاداتهم وعقلهم الجمعي وأخلاقياتهم وأعراسهم ودفنهم ومعاملاتهم وقوانينهم القبلية وحروبهم ...إلخ، بعيداً عن مقولات الدين، وفرخت مصطلحات من مثل التدين التجريبي والتجربة الدينية، وتجربة الوحي، والتجربة النبوية ...إلخ، بل صار الحديث عن التدين ـ تحت هيمنة المقولات الداروينية ـ كما لو أنّه أصل للدين، وكأنّي بهم بحثوا عن ذرة الدين في التدين وبأسلوب العينات، وبغواية المشابهات سقطوا في التعميم على كل الأديان، وهي في الحقيقة ـ كما أظنها ـ متشابهات زجّت بهم في مغالطات كبرى، فبلغت المقاربات تلك مبلغها في العلمنة والأنسنة قد تفوق أنسنة نتشه ذاته، إذ ألقت التأويلات والتفسيرات ذات المتكأ السيكولوجي بظاهرة الدين والتدين في اللاوعي (الذرة) بأنواعه الثلاثة (سيكولوجي، وجمعي، ومعرفي)، فبات الدين كما لو أنّه ظاهرة للطابوهات المنتجة للمكبوتات طارئة في سياق فكرة تطور الأنواع وانتخاب الطبيعة للكائن الرمزي الخيالي، والتدين تبعاً لذلك اغتراب للذات في الذات وعن الذات.
في حين ألقت بها التأويلات ذات المتكأ المؤسسي السوسيولوجي في إدراج الدين كما لو أنّه مؤسسة الأوامر والنواهي، ابتدعها المجتمع كحاجة تكاد تكون فطرية تتعلق بالمعيارية الضرورية للاستقرار الاجتماعي، فاضطرب المفهوم وأنتج جدلاً بين ما هو أخلاقي ـ من ضوابط ومعيارية وقيم ـ أنتجه الإنسان الجمعي كضرورة لاستقراره الاجتماعي، وبين ما هو ديني فوقي إلهي من الأخلاق، وألقت به تأويلات الجدل التاريخي في ظل قانون صراع الأضداد إلى الأفيوينة، فكأنّ التدين ما هو إلا صورة الإنسان المخدر المسلوب الإرادة في ما هو من البناء الفوقي.
فكل التأويلات تكاد تتفق على أنّ الدين مهما كانت صورته وصيرورته هو التعبير عن حالة اغتراب الإنسان حتى في صيغة "الخطيئة الأبدية" والتكفير عن الذنب، أو في صيغة رسالة الاستخلاف القائمة على التوبة بوصفها سلسلة من الأفعال التصحيحية تمارسها الذات والأجيال بتعلم القطيعة مع الخطأ، أو في صيغة الوضع الصناعي السالب لإرادة الإنسان كما يصفه الماركيوزيون، وبهذا اختلط ـ داخل التفكير الديني نفسه وخارجه ـ مفهوم الدين بالتدين عند البعض، وفصل بينهما عند بعضهم، واختلط أنثروبولوجياً بما هو سياسي وأخلاقي وتاريخي، وهو منحى يكاد يكون ـ تحت هيمنة الأنسنة والعلمنة الصلبة ـ ترجمة للمفهوم الدهري للدين والتدين، إذ أنّ نزعة النقد أطلقت العنان للعقل ليغوص في الظاهرة بقدر استطاعته لا تحده حدود خارج طبيعته، فلم تتوقف عند حدود نقد التدين بوصفه جهوداً بشرية للتأويل والتفسير وإنتاج صيغ الممارسة لما يُعدّ من الدين، بل طال حتى الدين ذاته كمحاولة لنزع القدسية عن الدين بوصفه معرفة إلهية.
وبالتالي نعتت ذات المتدين كما لو أنّها ذات صراعية في مكوناتها كما في نموذج فرويد التحليلي، بل صار الشكل الصراعي يطال الضمير نفسه حيث بات ضمير الذات ـ إن صح التعبير ـ يعاني هو الآخر من انقسام بين الأخلاق العملية والأخلاق النظرية، وما هو منها ديني قيمي وما هو منها دنيوي نفعي وسياسي. فالمتدين تبعاً لذلك شخص مريض عصابي يجب علاجه بما تبدعه من استراتيجيات سيكولوجية وسوسيولوجية وسياسية تنصح بها للتخلص من الدين والتدين...، وهو ما اعتبره سكباً مرّة أخرى للزيت على نار نزعة العدوان المتأصلة في النفس الإنسانية.
ولا بأس أن أسجل هنا رأيي في أنّ نزعة نقد الدين لا تخلو من فائدة كونها وقوداً يكاد يكون ضرورياً لتنشيط الفكر الديني ذاته، فهي ليست عندي من الطابوهات إلا عندما تكون مجرد رفض، حيث تصبح أيديولوجية، كالنقد الفيورباخي والماركسي للدين مثلاً، أو هي مجرد تحريف للنصوص وهرطقة يصبح ما يعتبر نصاً دينياً مجرد تزييف في المعرفة الدينية أشبه ما يكون بالتحريف الذي طال النص المسيحي (التوراة والإنجيل)، ـ غير مقبول علمياً، ويمكن إدراجه ضمن موجة خرق "الطابوهات" ولست ممّن يحبذ الخوض في ذلك"، لأنني أعترف بأنّ البحث في كلّ ما هو من غير ذات الله، من حيث هي غير قابلة للإدراك البشري، هو من المباح الفكري فيتسع العقل باتساع ظواهر الكون وما انطوى عليه سلوك الإنسان.
فكما أنّ العقل حر في قراءة الكون بما في ذلك النفس، فإنّه حر في قراءة النص الديني، وحر في أن يدحض استنتاجاته كل حين، كما أنني لست ممن يسعون لتكريس الطابوهات، إذ أنّ نزعة فرض الدين أو فرض صيغة للتدين، ليست عندي مقبولة كذلك مهما كانت درجة مقبوليتها في المجتمع المتدين، ومهما كانت فعاليتها في التاريخ البشري الدعوي منه والتربوي، من حيث أنّ الفرض هو خارج نطاق القرآن يقود إلى التسليم والانقياد، فيصبح من غير المقبول بموازين ومعايير الحرية المسؤولة، فلست من كل ذلك بقدر ما أنا في هذا المقام أحاول أن أكون حيال هذه المسألة (الدين والتدين) أكثر انحيازاً لطلب الفهم ووعي بالتفهم دون الدخول في الجدالات العقيمة الفلسفية منها أو الموصوفة بالعلمية أو الطائفية.
وتحيزنا ليس ذاتياً صرفاً بقدر ما هو انحياز آتٍ ممّا يمكن أن نعتبره حالة يأس من محاولات فهم الدين والتدين بمناهج تفكيكية عمقت من الانفصالات، وقد زادته تعقيداً، إن في التناول الوضعاني الذي بات فيه الإنسان ظاهرة صراعية يكرس بقوة (هم ونحن) في كل ما يعرف بالسرديات الكبرى كالدوركايمية والاسميثية والماركسية والفرويدية والداروينية، وإن في حالة العقل التواصلي كباراديغم جديد بديل عن السرديات وما عرف بالعقل الأداتي ومنطق حتميات التاريخ والانتخاب الطبيعي والاستقراء وما يسميه الماركيوزيون بـ "إنسان البعد الواحد"، فكل ذلك يشرعن لإعادة طرح الدين والتدين قضية جوهرية إنسانية، فأعادت مدرسة العقل التواصلي طرح مسألة الانفتاح على الدين كجزء ممّا تريد تأسيسه وسمّته "العقل التواصلي"، غير أنّه لم يستطع هو الآخر أن يستوعب عالم الغيب، لأنّه غير كوني كما هي مواصفاته في بعض الأطروحات الإسلامية المعاصرة الناقدة. وهي أطروحات تؤكد أن تفكير الإنسان ممتد بامتداد الكون ليصل عالم الشهادة بعالم الغيب كشرط لوجود بعضهما بعضاً في عالم الكينونة.
ومن المفيد أن نذكر في هذا المقام أنّ العقل التواصلي والمنهج التفكيكي والجدل الصراعي، حول قضايا الدين والتدين لم تكن عندنا حالة إبداع بقدر ما كانت حالة استنساخ، إذ وفدت إلينا، فانقسمنا حيالها بين من دخل في جحر ضب كما دخلوه، وبين من أعاد إنتاج المنهج والموضوع، وبين من تمركز في أصالته.
وإذ أنني أفضل في هذا المقام النأي بالنفس عن الدخول في الجدل الفلسفي الذي لا أجيد ألاعيبه كما ينبغي وكما يتطلبه الموضوع، فلا أنشغل بالمواقف المتشنجة من الدين كالنتشوية التي تعيد تركيز الدين في بشرية البشر فأنسنته بإبداع صورة الإنسان الأعلى الفائق في إنسانيته الكامل العدمية بموت الإله، أو أنشغل بالكانطية التي تخلط الدين بالتدين، وخلطه بين الميتافيزيقا والدين والأخلاق، وحشر الكل في خانة تأويل الوجود وظيفياً، ولا أدخل كذلك في جدل المقاربات الموصوفة بالعلمية المتخصصة التي عادت معظمها إلى صور الحياة البدائية وما يعرف بـ "اللامنطية" لفك أسرار سلوك التدين كما يتجلى في الحياة المعيشية للبدائي، فأصلت الدين في التدين وليس العكس، وكلها في نظر النقاد ليست إلا تفسير الكلي بالجزئي، في نطاق جدل الإنسان والطبيعة كمنهج للعلوم الغربية في طبعته الوضعانية.
ومع تسجيلي لأهمية هذا الإنجاز العلمي والفلسفي في كسر الطابوهات وإزالة بعض الغموض والوقوف على كثير ممّا كان مجهولاً لدى الإنسان عن الإنسان وتدينه، أسجل أيضاً انتهاك وحدة الإنسان في ما آلت إليه صورة الإنسان في العلوم من حالة الفصل بين تجليات أفعاله في ذاته، حيث تشكل الإنسان كمفهوم، أو تجليات للأفعال والمشاريع عبر نماذج الحياة والأنماط الأيديولوجية، كما لو أنّه ذات تتصارع فيها أفعال الدين والسياسة والأسطورة والخرافة، وما هو اجتماعي بما هو سيكولوجي ...إلخ.
ومع ذلك أترك هذا الجدال العلمي كله لحوار المنهجيين، لأنها برأيي هي ـ وظيفياً في ثقافتنا ـ من المعارف الخاملة التي لا تفيد كثيراً واقعنا وتأسيساتنا المعرفية المبنية على "الإنسان الأحسن تقويماً" المستوي للسجود، المتنافر مع مفهوم "الإنسان القرد" المتصارع، ولأنها كذلك باتت عاجزة عن الصمود أمام ما بدا للعلم ذاته من أنّ الدين ليس شرطاً سببياً للآخرة وشأناً خاصاً بالمتدينين فحسب، ولا هو لمجرد إملاء الفراغ الروحي الرهيب الذي يعيشه الغربي، بل ينظر إليه كقوة روحية لا غنى عنها في الحفاظ على البقاء والحياة، وليس كمثله شيء في ذلك. وسألتزم بحصر الموضوع في نطاق الجدال الداخلي بين الفئة البشرية المتدينة تاركاً الجدال الخارجي، إذ أنّ المتدين هو من يعطي البعد الغيبي لأفعاله، فلا يأكل لمجرد أن يحيا ويصح في ذاته، ولا يدفن موتاه خوفاً من بطش وتمزيق جثثهم من الطيور الجارحة والحيوانات المفترسة، بل يدفن الموتى تكريماً لهم، لأنّهم مكرمون من فوق السماوات العليا.
ولا أناقش كذلك ما يعتقد أّنه تناقض كشفه الحفر العلماني الناشط على هامش القرآن، في عقيدة المتدين من أنّ الله شديد العقاب وأنّه في الوقت نفسه رحيم بالعباد، واختلط الأمر على المتدين أيتدين خوفاً من الله أو محبة فيه، ففسر ذلك بالتناقض في الدين ذاته، فيقول على الله ما لا يعلم، ولا أتورط كذلك في الجدل الأكثر انغماساً في الطائفية والمذهبية عندنا (السلفية والشيعية والصوفية والماتريدية والأشعرية...إلخ) التي ابتعدت في رأيي عن هويتها كمدارس علمية منذ أن أغلق الاجتهاد العقلي، وابتعدت مسافات بعد ذلك عمّا هو محل إجماع من سلوك التدين الإسلامي، حين انغمست في ما تضخمت فيه وانقلب إلى دين تتدين به، وورثته الأنساق الثقافية النمطية فينا، فلم تترك فينا مساحة للتعلم التأملي والتجربة الذاتية، فسقطنا في كثير من سلوكياتنا ومعارفنا في ما سقطت فيه من القول على الله ما لا تعلم وما لا نعلم. فما أخطر أن تتحول تجربة التدين أو التدين التجريبي إلى ما يشبه الدين ذاته، فتقدس التجربة وتصبح وثناً يعبد ويضحى من أجلها، وتقدم له القرابين حتى ولو بنشوب حروب، فتغدو كأنها استئناف لوثنيات الجاهلية وحروبها القبلية المتعصبة.
فلا أخوض إذن في تقويم تجربة التدين الطقوسي بالتقليد أو التدين بإتيان المناسك والفرائض والواجبات والسنن الثابتة الجامعة عند كل دين، وتقرير ما هو صحيح منه وما هو خاطئ، كما أفضل النأي بالنفس عن التجربة الكلامية المعرفية من حيث هي تجربة تدينية بشرية قامت حول أصل أفعال الإنسان، وما جرى من جدل حول خلق القرآن والأفعال، وما نشأ عنها من تنشيط لعقلية التكفير بالفتاوى وتسلط التغلب بالسياسة، ومنع الاختلاف، وما نشأ كذلك من جدال عن أنّ التدين تعبد عقلي قبل أن يكون جوارحيّاً خارجيّاً، أو هو عشق روحي باطني، قبل أن يكون عقليّاً أو جوارحيّاً، والانشغال بالمقدمات والحواشي وتفسير المفسر ...إلخ.
فكلّ ذلك أراه بحثاً وتكراراً لمعرفة خاملة لا تفيدنا، بل أعتبرها من التجربة التدينية التلقينية الملتبسة كثيراً بالتعلم الخاطئ التي تضخمت فيه الأهواء، فأترك ذلك للمتخصصين في اصطفاء التجارب والخبرة التعبدية ممّن نسميهم "الراسخون في العلم". سأخوض في المسألة فقط في ما أتاحته لي أخلاق النقاش والتخصص العلمي، ومن موقعي بصفتي مسلماً موحداً غير متخصص، يؤمن بكلّ الأديان السابقة السماوية كما لو أنّها دين واحد من أصل واحد ينعكس في تجربة التدين المتنوعة.
ومع احتفاظي بالنأي بالنفس، فإنني أسست خوضي في مشروعية البحث في الدين والتدين لا على معرفتي بالنص أو بالتجربة التاريخية، بل أسسته على ما توفر لدي من منظومة إدراكية فكرية تعلمية، أتاحت لي تمييز ما بدا لي إشكالاً مفتعلاً في منظومتنا المعرفية قد يصل إلى حد الخلط بين الدين والتدين، عندما بحثت بأدوات أفضت على تجربة التدين الإسلامي بعض تفسيرات ومعاني التجارب الكهنوتية، وفي بعضها أظهرت التجربة كأنها تضخم للدين في المجتمع على حساب التجربة النفسية، أو العكس، فأخلت بأخلاق القرآن كخطاب للنفس المسؤولة، باستخدامه في تفريخ فتاوى تضفي على التجربة قداسة وعلى التشريع أبدية، وهي أدوات تفكيكية ـ في نظرنا ـ تبطل الكليّة، وتنغرس كثيراً في التأويل السببي للدين كتجلٍ في الظاهرة الاجتماعية، ليست من جنس "التدين بالدين" بوصفها تعلماً يجري في سياق تجربة الإنسان بهويتها الإنسانية والمتضمنة في الوقت ذاته للبعد الغيبي أزلياً، ومن ثمّة فإذا وضعت تدخلي هذا ضمن المنهج العلمي فإنني سأنطلق من الإشكالات التي آلت إليها التحليلات المغيبة للبعد الغيبي في الظاهرة، إذ لم يترك براديغم الانتخاب الطبيعي كمهيمن فرصة لحضور الغيب والتأمل العقلي في نظرية الخلق وتدبر أمر الله لبعض الإنسانية بأن تكون "قردة خاسئين"...، ممّا جعلني مضطراً لعدم قبول منهج التفكيك، وأدعو في هذه المقالة إلى إعادة قراءة ما يُعدّ من سلوك الإنسان أفراداً وجماعات تديناً بدلالة الدين، وليس العكس، وهو المنهج الذي يساعدنا أكثر في نظري على التمييز بين ما هو من العادة والأسطورة والخرافة ومن الكلام المحرف عن مواضعه، وبين ما هو من صحيح الدين المقدّس فنتدين به.
ومن حيث إنني أتحرك في هذه المقالة على هامش القرآن لا من عمقه ولا من سطوحه، وأحذر أن أقول على الله ما لا أعلم، فإنني سأصطف مع القائلين بالعلاقة الثلاثية الناظمة للوجود (الغيب، الإنسان، الطبيعة) من حيث هي علاقة لا تدرك إلا بالقرآن وما كان قبله من صحيح الصحف المقدّسة المتنوعة والتي اعترف بها القرآن وسماها كلها بـ "الإسلام"، من حيث هو صورة الدين الذي اكتملت فيه مكارم الأخلاق، "إنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق"، وصار خطاباً للعالمين وأخلاقاً مجسّدة في شخص الرسول بوصفه "قرآناً يمشي"، هذا الاصطفاف ليس اصطفافاً أيديولوجياً بقدر ما هو اصطفاف مع طبيعة الوجود وطبيعة الإنسان، وطبيعة الموضوع (الدين والتدين).
فمن حيث هو اصطفاف مع طبيعة الوجود، فلأنّ الوجود محكوم أزلياً بقانون "الانفصال والاتصال"، فكلّ شيء منفصل في هويّة ومتصل في آن واحد بغيره، فلا انفصال للطبيعة عن الغيب، ولا انفصال للإنسان عن الطبيعة، ولا انفصال للغيب عنهما، ولا انفصل للولد عن أمّه حين ولد، ولا انفصال آدم عن الجنة حين أخرج منها، فالكلّ متصل ومنفصل في هويّة، فلا انفصال لتدين الإنسان كطقوس جامعة وشرائع وشعائر وسياسات واجتهادات عن الدين، ولا هويّة له حين الانفصال، حيث يصير التدين مجرد أساطير ملحقة بما هو خرافي منها وتجربة سيكولوجية للإنسان معزولة، ولا انفصال للدين كنصوص مقدّسة ونواميس إلهية، تضمنت واحتوت أزلياً تجربة الإنسان الدنيوية، ولا هويّة له حين الانفصال، حيث يصير الدين من غير تجربة الإنسان كهنوتاً فوقياً مضاداً لمقصد الاستخلاف والتعلم.
ومن حيث هو اصطفاف مع طبيعة الإنسان، فلأنّ الإنسان مخلوق بدأ كاملاً في إنسانيته مفطوراً، واستمرّ في الأرض تجربة، مفطوراً على التعلم بالمحاولة والخطأ، فلم يبدأ جاهلاً ولا أبكم ولا همجياً، علم الأسماء كلها ورزق التوبة (النفس اللوامة)، بما يكفي لإدارة جدله بذاته حراً مسؤولاً، وفي ذلك كان ظلوماً جهولاً، لا تحركه خطيئته ـ كما تقول تحريفات الكلم عن مواضعه ـ بقدر ما يحركه صوابه وخطؤه من حيث أنّ الخطأ يؤجر عليه كالصواب حين يتبع بالتوبة ما لم يكن نابعاً من عناد وإصرار كالذي يقود للعصيان والشرك والكفر كما يظهر عند كلّ من استزله الشيطان...إلخ، فالإنسان صيرورة من التعلم في نطاق الاستخلاف باعتباره تجربة للتدين تستخلفها الإنسانية جيلاً بعد جيل كتجربة نفسية ارتقائية.
ومن حيث هو اصطفاف مع طبيعة الموضوع، فلأنّ موضوع "الدين والتدين" محكوم بالأخلاق يتعلق بارتقاء سلوك البشر تربوياً وعبر ما يمكن تشبيهه بما يسميه "موران" بـ "الحوسبة الروحية" باتجاه يعزز اكتساب أو تمثل معنى حياة الوصل والفصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وهو إحدى المقاصد الجوهرية ـ في نظري ـ بحديث الرسول "إنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق"، من حيث إنّ "الإتمام" هو وصل تجربة الإنسان الأخلاقية بما هو غيب، وهي رسالة دائمة للعقل في البحث في ما هو مكتمل، يستأنفها ورثة الأنبياء من العلماء والراسخون في العلم والشيوخ ومراكز البحث والتربية ومؤسسات التنشئة ...، وقد أسّسه الرسول وجسّده ـ في نموذجه التعليمي والتربوي ـ في تعليم الصحابة مضموناً عقيدياً واحداً لتربية الشخصية الاعتبارية فيهم، دون أن يمسّ بفطرية القيم الإنسانية التي أودعها الله فيهم وفينا وفي غيرنا كأنسي، فكانوا متفردين.
وتأسيساً عليه يتعين علينا أن نحدد معنى التدين والدين من منظور تربوي تعلمي، فالدين كـ "مهيمن" من حيث إنّ الهيمنة هنا لا تفيد السيطرة بقدر ما تفيد حضور الغيب وإضفاء المعنى على كلّ الحياة، كما أحضره الرسول في خلقه من حيث إنّ عملية الإحضار ليست بالنسبة إلى الرسول تدين كالبشر بقدر ما هي وحي، (إن هو إلا وحي يوحى)، هو الفعل والقول الثقيل المكتمل لا يحتاج إلى غيره، يمتد معناه ليشمل الكون المنظور بسننه والكون المقروء بمعانيه (الوحي)، ويتجلى بالمفهوم التعلمي كمعرفة موضوعية سابقة لا ينفد معينها، تستثير العقل لإتمام الأخلاق كما أتمّها الرسول في نموذجه، فالدين هو موضوع للعلم وللمعرفة والتدبر العقلي، ثابت وواحد، ولو بدا وكأنه تجربة تنزيل للنص المقدّس، فتجلت متعددة من آدم إلى نبي الإسلام محمد رسول الله خاتمهم، وإن تعددت في نزول القرآن متساوقة مع الأسباب، فهي ـ إن صحّ التشبيه ـ أشبه ما يكون بتعدد صيغ الخلق من خلق آدم من طين، وخلق حواء من ضلع آدم، وخلقنا نحن من فعل التناسل، وخلق عيسى بالنفخ بالروح، وكلها خلق الله وإن تعددت لنا صوره، محكومة بقانون كن فيكون.
والتدين من حيث هو اجتهاد في انعكاس الدين في الذات وحياة المجتمع ما أمكن، إن بإتيانه كفرائض وشعائر مأخوذة عن الأنبياء والرسل، وإن كفتاوى واجتهاد في برامج وسياسات وعلوم...، لا تكون إلا ناقصة تحتاج لغيرها من المعارف في بعدها الغيبي والإنساني، هو موضوع للتربية ويعالج في نطاق المعلم والمربي المريد، من حيث هما يتلقيان من تجربة الإنسان التفاعلية مع المحيط بوصفه خلاصة تجربة نفسية لها قيمتها التاريخية في التعلم الإنساني بالمحاولة والخطأ، وموضوع للسياسة والثقافة من حيث هما لا يخرجان عن الفعل التربوي في تدبير المحيط بسياسات وثقافات تستحضر فيه الغيب ما أمكن حتى يكون الشارع والمؤسسة متناغماً مع الذات المتدينة فيستثيرها بشكل إيجابي، ويحضرني هنا ذلك المثل الذي ساقه مالك بن نبي في وصفه حال المسلم الذي يتأثر بخطبة المسجد لحد البكاء وبمجرد الخروج من المسجد تتجمد عواطفه التدينية كالدش الأسكتلندي السريع الانتقال من السخونة إلى التجمد، لأنّ محيط المسلم (الشارع، والمؤسسة، والتربية) يعجّ بما يناقض المسجد.
ولا نعتقد أنّ القول الثقيل المتأتي للإنسان عن طريق الأنبياء ومن حيث هو إصلاح مستمر، في الاجتهاد بإصلاح الذات ودنيا الإنسان والناس أجمعين بوصفهم مستخلفين بعضهم عن بعض يصنعون التاريخ، سيكون متيسراً للفهم من دون تعلم العلوم وما تراكم من خبرات لدى الإنسان، مثله مثل ظواهر الكون الأخرى تقتضي التعلم ومساعدة مختلف العلوم، فالتدين يجب ألا يبقى خبرة ثابتة عامية متكررة عند كلّ الناس كما تتكرر خبرة تعاقب الليل والنهار والموت والحياة، دون بحث الارتقاء بها. فالتدين ليس تكراراً للطقوس، بقدر ما هو تجديد مستمر لمعاني الدين ـ إن صح التعبير ـ وهو مجال للاجتهاد واسع، وفي التجربة الإسلامية نماذج للاجتهاد العلمي، تجلى في تعدد التفسير ومناهجه وتعدد لمدارس وتعدد لبرامج وتعدد لصيغ الحياة، وهي ظاهرة تدينية صحية.
ومن ثمّة فالتدين تجربة تاريخية ناتجة عن تفاعل الإنسان المتدين بالاقتداء بالرسول وتأويل النص والقانون الطبيعي والحادثة والتاريخ، متطورة ومتغيرة في الزمان والمكان لا قرار لها، وقابلة للدحض والنقد في كلّ حين، ممّا يسمح لنا بعدئذ بالحديث عن تجربة التدين أو التدين التجريبي، من حيث إنّها تجربة من عند أنفسنا، فلا يصح رفعها إلى قدسية الدين، كتلك القراءات لما هو تدين، والتي تريد أن تلبس الأحداث والوقائع الاجتماعية بالنص الديني في ما يُسمّى فيما بعد القرآن المكي، وقراءته كتجربة تنزيل مقسم إلى مكي ومدني تأسيساً على تطور الوقائع الاجتماعية، ممّا سمح ببعض الشطط والغلو في القول بانتظار القرآن لحدوث الوقائع حتى ينزل، فكلها تُعد من تجربة التنزيل واحدة مقدّسة لا تقبل النقد ولا التجزئة، لأنّ نقدها يدخل العقل البشري في الندية وهو شرك، وتجزؤها زمنياً يخلطها بالتجربة السيكولوجية والسوسيولوجية فينفي أزليته وهو ما قاد في نظري إلى جدليات لا طائل من ورائها، كجدل النزول المجمل والقول بالتنجيم،...إلخ.
فكلّ الوقائع الاجتماعية والغزوات والتنصيص الفقهي العقلي للوقائع والأحداث تُعدّ تديناً وتجربة نفسية محملة بالخطأ البشري ليست مقدّسة. تبقى بهويتها منفصلة عن الوحي رغم وصلها بقراءة وترجمة الوحي بشرياً، ومن ثمّة فالتدين يمكن أن يصنف منهجياً ضمن ما يمكن التنبؤ بمقتضياته، وبالتالي يمكن التحكم فيه وتعديله بالعلم والتعلم، والدين يمكن أن يصنف منهجياً ضمن النبوءة التي لا يمكن التحكم بمقتضياته الأزلية، من حيث إنّ التنبؤ صفة بشرية علمية لا ترقى إلى النبوءة، ولكنهما لا ينفصلان ولا ينصهران (قانون الاتصال والانفصال)، حيث ينشط فعل التنبؤ الإنساني المتدين في فضاء النبوءة الدينية من حيث هي الغيب المستوعب للظواهر الاجتماعية قبل حدوثها.
فهذا التفريق بين المفهومين يجعلنا نتحفظ على أنّ الدين تجربة، حتى لا نعيد الخلط المفاهيمي بين الدين والتدين وننتج تقسيمات الأنثروبولوجيا للإسلام من جديد (الإسلام السياسي، الإسلام الريفي، الإسلام الحضري، الإسلام الأنثوي، الإسلام الذكوري ...إلخ)، فالدين ليس كالنظريات تنمو بالتجربة والممارسة وتتعدل وتتطور بشكل تاريخي زمني، بل هو تاريخاني ـ إن صح التعبير ـ أزلي فوق الزمن، منزه صادر عن الله، حتى ولو خلق الكون في ستة أيام، وخلق الإنسان أطواراً، ونزل الأديان متفرقة زمنياً، ونزل القرآن بالتدرج، إلا أنّ مصدره إلهي مقدّس يخضع لقانون "كن فيكون"، فإذا قبلنا بمصطلح "التجربة الدينية" أو تجربة الوحي أو تجربة النبي فنقبلها إذا أسندت إلى الأنبياء الموحى إليهم وتمثلوا الدين عبر قانون "كن فيكون"، أو حادثة شق الصدر (عند اكتمال صورة الدين)، من حيث هي ـ في بعدها الرمزي ـ فعل غيبي عزلت فيه بشرية الرسول عند تلقي الوحي عند لحظة التلقي، فكانت استجابة النبي استجابة روحية صافية منزوعة من خطأ البشر. فيخرج الوحي من ذات الرسول كما دخل، محصناً من الاستجابات النفسية التاريخية.
ومن ثمة أرى أنّ كل مظهر لتعدد الدين (مسيحي، يهودي، إسلامي، ...) هو تعدد تاريخاني من مصدر غيبي يفهم في نطاق التنزيل التدرجي المناسب لقوانين التاريخ الفوقية غير قابلة للتأثير بما هو زمني (سوسيولوجي)، لأنّه أزلي حفظت واحديته ووحدته في خلاصة سميت أزلياً بالإسلام، وأنظر لتعدد التدين تعدداً تاريخياً وتجربة نفسية مصحوبة بالخطأ البشري المحتمل، ممّا يجعلني أنظر إلى دعاوى تقليص المسافة بين فعل التدين والدين بشيء من الريبة، قد يكون ظاهرها حقاً يتعلق بإلغاء الفصل بين ما هو ديني وما هو غيبي كما يبرر، إلا أنه كثيراً ما انزلق على مستوى التدين الفردي إلى ما يعرف بوحدة الوجود وفكرة الحلول اللاغية للانفصال، وكثيراً ما انزلق على مستوى التدين الجماعي ليتحول إلى دين (لاهوت أرضي) يعبد بحد ذاته عند إلغاء الانفصال، كالصنمية التي عاشتها المجتمعات البشرية ونعيشها في الصيغ المذهبية والطائفية التي تحولت إلى أديان يكفر ويشجب بعضها بعضاً.
ولا أستثني من ذلك صنمية النظريات والأنساق الكبرى التي انتصبت كما يصفها بوبر كما لو أنّها تاريخانية فوق زمنية تحدد مصير الإنسان والتاريخ، كالفرويدية والماركسية والداروينية، ..إلخ. كما لا أستثني من ذلك صنمية بعض الفتاوى والاجتهادات التاريخية الفقهية والعقدية.
وعليه فقراءة "الدين والتدين" في نطاق قانون الاتصال والانفصال بين الذوات والمسخرات من الطبيعة والغيب، ليست للزج بالموضوع في فلسفة العلوم وتعقيداتها، بقدر ما هو بحث في إمكانية تحديد البعد الإجرائي الذي يجسّد هذا الاستحضار للغيب في حياة الناس وعلاقاتهم مع محيطهم الفيزيقي، فتأسيس التدين بالدين على "اقرأ باسم ربك" من حيث هي قراءة تؤكد على إلحاق النسبي بالكلي المطلق كما هي قراءة في نطاق أخلاق القرآن كخطاب للعالمين غير محدد بجغرافيا عرقية أو إيكولوجية أو ثقافية، ونطاق أخلاقيات تجربة التعلم كفعل بشري فطري، من شأن هذا المفهوم وتلك القراءة أن تؤهلنا ـ إن صيغت كبراديغم ـ لتجاوز ذلك التجاوز الحاصل في خرق قانون الوصل والفصل بين الغيب والطبيعة والإنسان في التجربة المعرفية الكهنوتية والعلمانية والطائفية على حد سواء.
وقراءة الدين والتدين بالتعلم يمكن أن نعتبرها إعادة صياغة التدين كمفهوم وممارسات طقسية وسيكولوجية وسوسيولوجية، ضمن رسالة الاستخلاف وتركيز الوعي الإنساني في ما نسميه مع حاج حمد بـ "الوعي الكوني" المتجاوز لكلّ المركزيات الأرضية ومركزيات التدين الضاغطة كالتي تعيشها الفرق والمذاهب، مستحضراً مركزية الدين في التعلم من حيث إنّ الدين كونياً بطبعه، كما هو القرآن الكريم يدرج عالم الغيب وعالم الشهادة كحياة، تنتفي فيه أسبقية الدين عن فعل التدين، كما هو الحال في تجربة الكهنوتيات، أو أسبقية الأنسنة بما تحتويه من تدين، على الدين كما هو الحال لدى فلاسفة أنسنة الدين وعلمنته وكان التعلم بـ "المحاولة وتجنب الخطأ"، بوصفه تجربة ينشأ عنها ما يمكن ان يُسمّى "الحوسبة الروحية" تحمي الإنسان من التصلب أو التجمد المعرفي، فتدفعه إلى حالة التوتر المعرفي الدائم، من حيث هي الأرضية "النفس معرفية" التي تؤهل الشخصية لكل تجاوز وكل اجتهاد وكل إبداع، وتحميها من كل ما اعتدناه من إكراه وتنميط واستلاب باسم الدين ذاته، كما هو في حالة "تربية الخلاص المسيحي الكهنوتي". فـ (لا إكراه في الدين) يفضي بالضرورة إلى (لا إكراه في التدين).
ولا نرى في هذه القراءة بالتعلم وفي ظل الوصل والانفصال إلا إجراء تربوياً أخلاقياً بالدرجة الأولى، نؤسسه على زمنين بينهما حضور للوحي كتنزيل مكثف ينير للعقل سبيله، زمن بدأ الخليقة بآدم كمتعلم، تعلم الأسماء والبيان، بما زود به من استعدادات فطرية، وما زود به من معين الشخصية الاعتبارية زمن إتمام الأخلاق، من حيث هو زمن تركيز العقل في ما هو تام مجسد في الكونين (المسطور والمنظور) يتوقف فهم أحدهما على فهم الآخر، وبالتالي فهو بهذه القراءة زج بالدين والتدين في رسالة إتمام مكارم الأخلاق الاستخلافية، كرسالة للأديان البشرية من حيث هي رسالة استخلاف يستخلفها نبي لنبي عبر الوحي، وعبر التعلم ـ لا عبر صرامة الضبط الاجتماعي ـ يستخلفها إنسان لإنسان وجماعة بشرية متدينة لجماعة، في سلسلة من التنوع لا نهائي في الفرادة، أي أعني الزج به في نطاق التعلم، ببعديه: الأزلي (وعلم آدم الأسماء)، والتعلم التجريبي إن صحّ التوصيف (بالسمع والبصر والفؤاد)، من حيث إنّ البعد الأول ببعده المادي (العالم) وبعده الرمزي (النص والكلمة) ميدان للتعلم التجريبي بوصفه هو منبع الذات في كلّ تجلياتها الوجودية، أو بالأحرى هو فعل التاريخ، وهو الشكل التعليمي أو ما يمكن تسميته بباراديغم التفكير الذي تنعدم فيه ـ أو على الأقل تخفف ـ جميع أشكال التضخمات الآيلة إلى "التطرفات" كتضخم ما هو من الأنا (عقل، رغبات، عواطف، أهداف ...) في التدين أو العكس، أو تضخم ما هو من المجتمع (ثقافة، عادات، سياسات، مؤسسات)، في الدين أو العكس.
أو تضخم المجتمع كقيم في الذات الفردية أو تضخم الفردية في الهويّة المجتمعية. ذلك أنّ التعلم التجريبي من شأنه أن يجعل التدين محكوماً بمنطق التبليغ لا منطق "الفرض" ممّن هو أعلى على من هو أدنى، ولا ممّن هو أكثر على من هو أقل، ولا ممّن هو أقدم على من هو جديد، ولا ممّن هو جديد على من هو قديم، بل يمنع الشخصية الاعتبارية من حجب الشخصية الفطرية، ويجعل من التقوى مفهوماً لأكثر صيغة تساوقية مع الدين في كليّاته وجزئياته، فيتعلم المستخلفون من بعضهم بعضاً تجربة التدين بالدين ولا يفرضونها على بعضهم بعضاً، فتتشكل نماذج التفكير وأفكار جمعية وبراديجمات تؤهل الأفراد والجماعات لممارسة التمييز والمقارانات والترجيحات بين الموضوعات والمفاهيم والسلوكيات في نطاق ما اكتسبوه من معيارية مرنة دينامية.
ونخلص في نهايات هذه المقالة إلى ضرورة بيان ما يمكن إدراكه من هذه القراءة التعلمية التربوية في فك ما أحاط مفهوم "التدين والدين" من التباس وغموض في تجارب "التطرفات"، إن في الوصل أو في الفصل بينهما، ويمكن تلخيص معالمه المفتاحية ـ التي تبقى محل نقاش ـ كالتالي:
ـ بما يمكن الاصطلاح عليه بقانون الفصل والوصل وفق أخلاقيات القرآن يجعل تجربة تديننا غير منفصلة عن تدين من سبقونا من أهل الكتاب والأديان التي تمتد إلى آدم عليه السلام، من حيث هم روافدنا التاريخية بموجب وجوب "إتمام مكارم الأخلاق"، وهو القانون الذي يجعلنا بالضرورة في حوار مستمر مع كل أشكال التدين، فالفترة طويلة وما زالت حبلى وثرية بالمدد الغيبي، "ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك"، تحتاج إلى بحوث علمية من نوع أنثروبولوجيا التدين للاستكشاف واستخلاص العبر من أقوام متدينة وأخرى غير متدينة، وبه نتموضع فكرياً في "التسامح الديني"، ويمنعنا بـ "التعلم" ـ من حيث هو تغيير في السلوك ـ من أي تعصب يولد فينا مواقف عدائية أو إكراهية تكفيرية لغيرنا، إلا من تحدى خاتم النبيين، بل إنّ أخلاق التعلم القرآني تجعلنا دائماً حين تمثلها في حالة الاستجابات الإيجابية تجاه الآخرين المختلفين، فقد وجهنا القرآن بآية لا نظير لها في علاقات التسامح والتعاون مع الآخرين بأن أمر بالمشاركة في حماية المتدينين المخالفين في ظل احترام المواثيق (فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير) الأنفال 72.
كما تساعدنا على تجاوز ما أوقعنا فيه من فصل بين ما يعتبر أخلاقاً عامة ذات مصدر ديني، وبين أخلاق ذات المصدر السيكولوجي أو الذاتي الفطري، أو ذات المصدر المهني، كما هي في بحوث "الإتيقا"، فالإسلام يعيد التجربة الإنسانية الأخلاقية ليضعها في سياق الإسلام من حيث هو المتمم لكل الأخلاق، ويعطي لمعتنقيه فرصة الإتمام بحرية في إنتاج صيغه، ذلك أنّ التجربة التاريخية للإنسان أوجدت نماذج من الأخلاق، فنتحدث عن الأخلاق البوذية والطاوية والكونفوشيوسية والأخلاق القبلية والرأسمالية والأخلاق الاشتراكية والعملية والنظرية...إلخ، بل نتحدث عن الأخلاق السيئة والأخلاق الحسنة. فالأخلاق بما تشتمل عليه من قيم ومعايير هي متغيرة ـ في نظرنا ـ بفعل التعلم من الدين، أو من التجربة الإنسانية، ومن ثمّة فالأخلاق حين تكون سلوكاً تدينياً، فلن تكون من منظور إسلامي إلا بمقاصد ثلاثة (الله، راحة النفس، إسعاد الآخرين)، وبالتالي فلن تكون إلا جزءاً من منظومة الحياة المتدينة من حيث هي الحضور لعالم الغيب في كل علاقات الإنسان، أي أنّ كل سلوك ينسجم مع "الكليّة من عالم الغيب وعالم الشهادة" باعتبارها جوهر الدين، كالعدل والإحسان والصدق والأمانة والإخلاص والتقوى والعلم ...إلخ تصبح تديناً تعزل فيه كل السلوكيات التي لا تنسجم مع أمانة الاستخلاف، من حيث هو تعلم في مجال عالم التسخير المتبادل، لعزل صور الهيمنة والعبادة إلا لله وحده، وتلك هي صورة إتمام تجربة الأخلاق، فالأخلاق صيرورة في مفهوم "إنّما بعثت لأتمّم مكارم الاخلاق"، ومفهوم "كان قرآناً يمشي".
وليست مجرد وسيلة، أو ليست شيئاً أنهاه الرسول مع اكتماله، بقدر ما هي صيرورة ورسالة بشرية للإنجاز العقلي المستمر، ومن ثمّة فلا مجال لحصر مفهوم التدين في طقوس موروثة وفروض مفروضة وواجبات موجبة، فذلك كله خارج مفهومنا للتعلم من الدين من حيث هو تعلم تجريبي لكل صيغ الحياة التي يحياها الإنسان في سيكولوجيته ومعاشه وسياسته ومؤسساته وعلاقاته، فلا نعتقد أن يكون التدين سليماً إذا فقد المتدين ما يشبع تدينه في الشارع والمؤسسة، فيصبح فقيراً في تدينه أو متطرفاً أيديولوجياً رافضاً، وبالتالي فإنّ حصر التدين وعزله عن مناشط الحياة ورفض حضوره في السياسة والمؤسسة هو إعادة إنتاج تجربة "الطابوهات"، ممّا يجعنا نؤكد على حضور التدين في كل مناشط الحياة، ونتحفظ على عزل الدين عن الحياة أو تجزئة الدين إلى قطاعات كقولنا بالإسلام السياسي والإسلام الثقافي والإسلام العقيدي ...إلخ، فالإسلام كلي لا يتجزأ إلا زمنياً في التدين كطقوس وبرامج ومشاريع متجددة.
ويساعدنا في تجاوز ما حدث من خلط في المفاهيم في مجال الإرادة الإلهية والتجربة النفسية جراء ـ في نظري ـ عدم تقدير وظيفة "الفصل والوصل" في سياق الإدراك الكلي لأخلاق القرآن أحسن تقدير، وقاد إلى بعض الشطط الفكري سجله التاريخ الثقافي والسياسي كنقيصة وعيب من عيوبنا أساء لتديننا، فقد حدث أن اختلطت الإرادة الإلهية بما هو بشري في المفاهيم والنظم الإدراكية، تجلى ذلك في إسقاط "القدر الأزلي" على تجربة الإنسان، فأضفى ذلك على تشريع الإنسان بعض القدسية المانعة للنقد، من حيث هو أساس التعلم في سياق إتمام الأخلاق، والسقوط في ما يشبه الكهنوتية، والتلاعب السياسي ببعض مفاهيم متولدة من التجربة، كمفهوم "خلق القرآن" الملتبس بخلطه بما هو نزواتي أهوائي أو أيديولوجي، حين استعمل ضد الدولة الأموية ومقولاتها الجبرية، واستعمل في ما بعد ضد معارضي الدولة العباسية.
فانتهكت في التجربتين حقوق الإنسان كمستخلف حر، ومن شأن هذه القراءة أن تساعدنا على تجاوز التقسيمات الحادة المفتعلة في تجربة علم الكلام بين العقل والنص وحدوث التنافر، ومن ثمّة إمكانية إطفاء أو على الأقل منع إعادة تجربة التصلب الكلامي والتعصب المذهبي، وتخرجنا من فروض التاريخ وفتاويه وتكفيره وحتميات الثقافة، وتبدد فينا العقل الطائفي، فلا نكرر تجربة جدل خلق الكلام والأفعال، حين تكون أفعالنا في عقولنا خبرة تنمو بالتعلم وتتعدل كتجربة كل حين، لا جبر فيها ولا أزلية ولا قدرية لتصرفاتنا بوجب حريتنا المسؤولة في حمل الأمانة، وتكون كل أفعالنا بالتالي هي من عند أنفسنا نختبرها، فنتوب في حالة خطئها ونبحث عن ما هو أفضل من صحيحها دائماً، بمعايير الشخصية الاعتبارية للرسول المتمم لمكارم الأخلاق، وبذلك نعيد تجاربنا المعرفية إلى رسالتنا كمستخلفين نقلل ما أمكن من "الفرض" الداخلي أو الخارجي، حتى نتحاشى الرفض كرد فعل انعكاسي.
كما تساعدنا على تجاوز جدل البناء على القبليات العلمية والتوقعات والثورة عليهما، فالخبرة نمو مستمر وتعلم من تجنب الخطأ واستشراف لمعاني جديدة، فلا تسمح باستمرار الخطأ القديم الثابت خطؤه. فالقبليات العلمية حاضرة في النظم الإدراكية، لاستكشاف واستخلاص الإشكالات الجديدة، إذ لا يمكن عزل النظم الإدراكية في أي بحث وقراءة جديدة للنص واختلاف المبدع والمفسر والمجتهد في ملاحظة واقع التدين باختلاف أنظمتهم الإدراكية هي نعمة تتيح تصور التوقعات وإعادة تركيب التجربة المعرفية أو السلوكية، وتمنع فرض منطق أو تفكير أو ثقافة جيل على جيل، وتتيح إنتاج الصيغ الأكثر وصلاً بمقاصد الدين من حيث هي مقاصد للإعمار في الأرض في الزمان والمكان.
يمكن لهذه القراءة أن تضع حداً بصفة آلية لتطييف الإسلام وتعصب الشخص المتدين داخل الطائفة تحجب عنه الإسلام، كما تضع ظاهرة التدين ضمن الطائفة خياراً، لأنّ الطائفة بذاتها ليست إلا خياراً وتطوراً طبيعياً للتدين والتنوع، إلا أنّ ابتعادها عن الإسلام قد يضعها في خطر التحول إلى دين، كما حصل التفكير الطائفي في نمطيات وعادات في التدين وشخصيات اعتبارية متضادة، حجبت كل ظهور للقيم الفطرية السيكولوجية أو الشخصية الفردية كحالات خاصة، كما يمكنها أن تسحب الطوائف من التدين المذهبي المانع عن إدراك سعة الإسلام.
كما بدأ مع آدم يمنع العبودية إلا لله في كل صيغ الحياة، وبدأ مع روح رسالة إتمام الأخلاق كما أسسها الرسول، إلى حيث التدين الإسلامي الذي يعيد للعقل حريته في تجاوز نمطية التفكير، وتحرير مفاهيم العقيدة والأخلاق والحسن والقبيح والانتحار والاستشهاد...إلخ من أسر المعاني الطائفية وألعاب الأيديولوجيا، وتقويم ما يُضفى من معانٍ أبدية على الأفعال، وتعيد كذلك من حيث هي قراءة تربوية تعلمية صياغة المذهب كما لو أنّه جماعة علمية تؤسس مخابر علمية متنوعة بدل تكوين ميلشيات وضباط المذهب، تنتج الأفكار من الكونين المنظور والمسطور في نطاق التجربة التاريخية والحاجة الحضارية، إذ قد يتعذر فهم المسطور بدون فقه المنظور، وتبعث محاسن وأفضل حالات التاريخ العلمي للتجربة بوصفها حالة تواصلية بين عالم الشهادة وعالم الغيب، ولا تعيد تكرار الخروج عن إتمام مكارم الأخلاق كالحالات التي سقطت في العقل الصراعي، الذي وصلت الألعاب الأيديولوجية فيها إلى حد التصلب الذي يرى في سب العلماء والصحابة ورموز عهد النبوة واللعان على المنابر والتكفير جزءاً من التدين، وقد انزلق اليوم إلى صورة بشعة تسمى التدين بالاستشهاد لا تبعث فيها الطوائف لبعضها البعض وللأخرين إلا الموت.
كما يساعدنا في نقاوة التدين الشخصي بأسلوب الارتقاء بالفطرة إلى الفضيلة من حيث هو ارتقاء بالشخصية الفطرية إلى الشخصية الاعتبارية القائمة على ما يمكن استعارته وتسميته بـ "الحوسبة الروحية" بعيداً عن التنميط والقولبة وعزل الشخصية السيكولوجية، وهو ما يمكن من حل التناقض الذي يمكن أن ينشأ عن الشخصية الاعتبارية والشخصية الفطرية التي أودعها الله في الإنسان.
وبذلك تحفظ الشخصية وتحمى من التشتت الفكري في الهويّة أو في الأهواء، واحتمال السقوط في الشعوذة والسحر والخرافة، كما تنزلق فيه بعض التجارب التدينية الإيمانية الموغلة في الروحية وما يُسمى بالعشق الإلهي أو في الفناء في ما هو كلي (النرفانا)، ونرى هذه التجربة قد اكتملت كصورة معيارية في نموذج تربية الرسول وتعليم أصحابه وذويه ومن والاه، حيث إنّه باكتمال الأخلاق الدينية بالدين الإسلامي وتمثل الرسول لأخلاق القرآن كصورة تامة كاملة، ربى الشخصية الاعتبارية في أصحابه دون المساس بشخصياتهم الفطرية التي تعكس ذواتهم، فتنوعوا وتمايزوا في الفرديات.
ونحن بعدئذ بمنظور الاستخلاف وممارسة التوبة، من حيث هي النقد الذاتي المستمر أتاحته لنا النفس اللوامة، علينا أن نهجر أنماط تدريسنا التي تتراوح بين التدريس الآمن، وهو ذلك النمط من التدريس الساكن المسكن المؤمن ضد إثارة السؤال النقدي، وبين التدريس الأمني من حيث هو التدريس الترهيبي التحكمي المؤمن هو الآخر ضد كل سؤال إبداعي متجاوز، فلا ندرس التلاميذ ولا نربيهم ليكونوا غيرهم نستنسخ فيهم الآخر أو التراث كما لو أننا من عبدة الأسلاف. بل ندرسهم ليكونوا هم، يمارسون بأنفسهم "الاستخلاف" في السلوك والفكر والعقيدة تتخلص من كلّ عبودية إلا لله وحده، فالتربية هي تربية للهويّة الشخصية المسؤولة لتعبر عن رأيها في الأخلاق والتدين والقيم والعلم والسياسة في كل حين.
أي هي شخصية مبدعة في الآن والهنا، إذ أنّ أفضل التعلم هو الممارسة من حيث هي هنا (تجربة التدين)، ومن ثمّة فلا نكون بتبنينا للاعتبارية من زمرة من وصفهم "فروم" بمنظوره السيكولوجي التحليلي ممّن يعيش أخطر حالات السلبية في الذات، من حيث هي تلك الذات كما يريدها الآخر، وليس كما تريد هي أن تكون، فملاءمة الذات وفقاً لما يريده الآخر، هي بحث عن الذات السلعة، لا علاقة لها بالذات الاعتبارية المسؤولة المستخلفة، فلا الشيخ ولا المؤسسة الدينية ولا الراسخون في العلم ولا محتكرو الطقوس والشعائر والمناسك من رجال الدين لهم الحق في فرض صيغة التدين، فليست وظيفتهم إلا من وظيفة الرسول من حيث هي التبليغ غير الإكراهي يستهدفون تكريس قانون الانفصال والاتصال في الوجود الإنساني، حيث الإثراء والتدافع من غير صراع في إنتاج صيغ التدين في العلم والسياسة والتربية والاقتصاد والأخلاق والاجتماع.
وخلاصة الخلاصة ومن أجل الخروج من حالة تشرذم ذات الإنسان في ما يشبه كنتونات متصارعة داخلياً، يتعين علينا إعادة صياغة مفهوم التدين وانتشاله ممّا حشر فيه في زوايا الطقوس المتعلقة بإتيان الفروض اليومية والأسبوعية والسنوية...، فأخرجه من الروح الكليّة للإنسان، ونعيده في هذه المقاربة إلى مفهوم يتعلق باستحضار الغيب في الحياة، فيصبح سلوك المتدين متديناً كليّاً، لا يقتصر على سلوك دون آخر، فأينما يكون الإنسان في موقف حيال المحيط، فثمة حضور ما للدين، باختيار المتدين لصيغة التدين، وبالتالي سيكون مسؤولاً عن صيغة تدينه بما أوتي من مؤهلات فطرية واستخلفه كخبرة بسمعه وبصره وفؤاده، أي بالحوسبة الذاتية لبعدي الشخصية (الفطري والمعياري). وبهذا يمكننا أن نحرر بداية نظامنا المعرفي من ثنائية (الدين والدنيا) طالما نشطت كإعاقات إبستمولوجية ونمط سلوكياتنا في سلوكيات متدينة وسلوكيات متمدنة وانقسمت علومنا تبعاً لذلك إلى علوم شرعية وأخرى غير شرعية، أو علوم دينية وأخرى دنيوية، وكأننا حين ندرس وندرس علوم الرياضة والهندسة والمعرفة الأرضية، نكون في أوضاع غير متدينة، فضاعت الوحدة العضوية للعلوم والمعرفة، فأضفى هذا الازدواج تعقيداً على تعقيد كانت تطورات طبولوجيا العلوم قد أسسته في تقسيم العلوم إلى علوم إنسانية وعلوم طبيعية، فضاعت في الكل كليّة الإنسان، وضاعت في المعرفة كليتها المادية والروحية.
وحتى نوقف تصاعد مشاريع الرفض الآتية من الحداثة، ومشاريع الإغلاق الآتية من التراث، والتي لا تنتج إلا مزيداً من تصاعد المشاريع الانتحارية، فيضفى عليها الطابع الاستشهادي زوراً، وحتى لا يكون تديننا في كل صيغه (سنية شيعية صوفية تديناً صراعياً ميلشياوياً مفصولاً عن روح ديننا).
وحتى لا يكون تديننا مصدر خوف أو قلق للآخر، فيتداعى علينا باسم حماية حضارته وقيمه من إرهابنا وتديننا الإرهابي، ويعيد التاريخ نفسه في ذلك كما كان الحال في تخلفنا مصدر قلق، فاحتلنا وقتلنا بحجّة تحضيرنا وتأهيلنا وتهذيب بربريتنا، ومن ثمّ تأهيلنا لاستئناس استعباده لنا.
ولمنع توريث السيء والاستخلاف السيء ـ إن صح التعبير ـ والكف عن اللعان المستشري بين الأجيال، ولكي لا يلعننا من سيخلفنا لأننا إكراهيون منغلقون متصارعون، فلنبدأ في اقتحام العقبة من حيث هي تحرير للرقبات من كل أشكال التدين المضاد لكليّة القرآن وروحه، من حيث هو تدين تجريبي تعلمي موصول بالغيب، لا مفصول ولا مسلوب. فلا شكّ أنّ ذلك دونه خرط القتاد. والله أعلم.
أهم مراجع الموضوع
ـ مصطفى ملكيان، جدلية الدين والأخلاق، ت. أحمد القبانجي، ط1/2013، الانتشار العربي.
ـ محمد مجتهد الشبستري، هرمنيوطيقا القرآن والسنّة، ت. أحمد القبانجي، ط1/2013، دار الانتشار العربي، بيروت لبنان.
ـ الشيخ محمد مجتهد الشبستري، قراءة بشرية للدين، تعريب أحمد القبانجي، ط1/2009، الانتشار العربي، بيروت، لبنان.
ـ كارل بوبر، بؤس الأيديولوجيا، نقد مبدأ الأنماط في التطور التاريخي، ت. عبد الحميد صبرة، ط1/1992، دار الساقي بيروت، لبنان.
ـ محمد جعفر مصفا، التفكير الزائد، ت. احمد القبانجي، ط1/2012، الانتشار العربي، بيروت، لبنان.
ـ محمد آيت حمو، مشكلة الأفعال الإنسانية، بين الخلق الاعتزالي والكسب الأشعري، المركز الثقافي العربي، مؤمنون بلا حدود، ط1/2015، الدار البيضاء، المغرب.
ـ العربي بلقاسم فرحاتي، اضطراب مفهوم الدين في علوم الحداثة وتداعياته، ط1/2015، كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر.
ـ عبد الجواد ياسين، الدين والتدين، التشريع والنص والاجتماع، ط2/2014، المركز الثقافي العربي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الدار البيضاء، المغرب.
ـ محمد مجتهد الشيستري، الإيمان والحرية، ت. أحمد القباجي، ط1/2013، الانتشار العربي، بيروت، لبنان.
ـ عبد الكريم سروش، العقل والحرية، تعريب. أحمد القباجي، ط1/2010، الانتشار العربي، بيروت، لبنان.






