"السّلطة في الإسلام" لعبد الجواد ياسين
فئة : قراءات في كتب
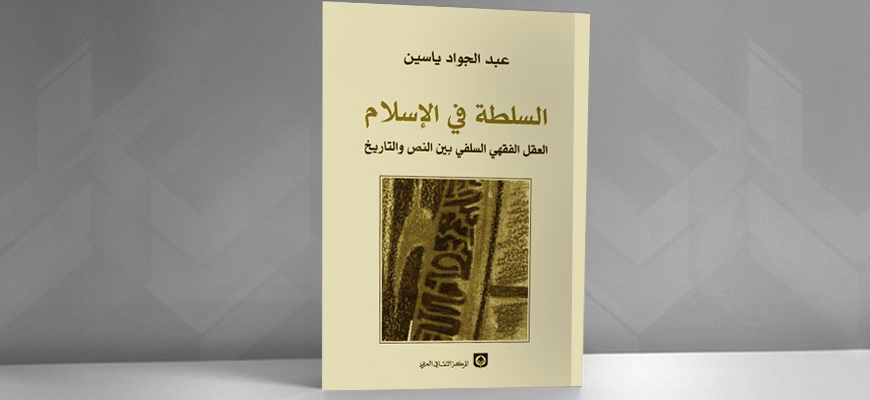
في إطار الاهتمام الكبير والمتزايد لدور الثّقافة العربية في السّنوات الأخيرة بالمشاريع والأبحاث التي تهتمّ بإعادة البحث والقراءة في التّراث الإسلامي، وتفكيك الأسس التّقليدية والنمطية التي بني عليها تاريخ هذه الأمّة، صدر عن المركز الثّقافي العربي - في طبعة ثانية سنة 2000 - كتاب "السّلطة في الإسلام: العقل الفقهي السّلفي بين النّص والتّاريخ" لعبد الجواد ياسين، والذي عمل من خلاله على تشريح (ونقد) الاتّجاهات الفقهية السّائدة في التّاريخ الإسلامي وأدواتها الاستدلالية ومصادرها التّشريعية، وهو ما أثار لغطًا كبيرًا في الأوساط الفقهية التّقليدية في العالم العربي، باعتبار ما قام به يعدّ عملية تكشف عن خبايا جديدة، من شأنها أن تتجاوز وأن تفكّك البنى الثّابتة والنّمطية وما تشكّل عنها من آليات عبر قرون طويلة من التّراكم الفقهي والأصولي.
وعبد الجواد ياسين باحث مصري تدرّج في سلك النّيابة والقضاء بدولته الأم، عمل قاضياً كذلك في دولة الإمارات العربية المتّحدة، من المهتمين بدراسة الفكر السّياسي الإسلامي، ودراسة قضايا الفلسفة والشّريعة والقانون، له مجموعة من الأعمال نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: كتاب "مقدّمة في فقه الجاهلية المعاصرة"، وذلك عام 1986، وبعد ذلك بعامين أصدر كتاب: "تطوّر الفكر السّياسي في مصر خلال القرن التاسع عشر" وكتاب "الدّين والتديّن: التّشريع والنصّ والاجتماع".
وكتاب "السّلطة في الإسلام: العقل الفقهي السّلفي بين النّص والتّاريخ" يقع في 342 صفحة من الحجم الكبير، قسّمه صاحبه إلى مقدّمة ومدخل وثلاثة فصول، كان الهدف منه كما يظهر من المقدّمة هو الدّعوة بشكل صارم إلى تجاوز الآلية السّلفية في التّعامل مع النصوص وإصدار الأحكام التي يرى أنها وسَّعت كثيراً من دائرة المحظور في الشّريعة على حساب دائرة المباح الواسعة أصلاً، وأنّها اعتدت على "النص" لكونها أضافت مصادر "غير نصية" في التّشريع والاستدلال، كالإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وغيرها، وهو ما ضيّق مساحة الحرّية الإنسانية وأضفى على الإسلام صبغة تاريخية غير قادرة على مسايرة التّقدم الحضاري والمستجدات السّـائدة في عالم اليوم.
في المدخل "قراءة في الجدل مع التّاريخ" ذهب عبد الجواد ياسين إلى أنّ الحديث عن فجوة الخصام التي وقعت بين النّص والتّاريخ يستلزم منا الكلام على "إسلامين" اثنين؛ أوّلهما: إسلام النّص الثّابت بالوحي كتابًا أو سنّة، وهو دون غيره الإسلام الذي نبحث عنه، وثانيهما: إسلام الواقع التّاريخي المتمثل أولاً في أنظمة الحكم المتعاقبة، التي قامت على أرض الإسلام وانتسبت إليه عادة لا بسبب من التّمثل الموضوعي لقيّمه ومبادئه، وإنّما بسبب الرّاية الاسمية التي ظلّت مرفوعة به ردحًا من الزمن، والمتمثّل كذلك في قواعد الفقه الاجتهادية التي لا يمكن أن تكون مصدرًا أبديًّا متمتّعًا بقداسة الوحي أو فرضية النّصوص، لا سيما وأنّ هذه القواعد لم تكن في معظمها أكثر من انعكاس لاحق على الواقع الذي فرضه الحكّام، معبّرة عن هذا الواقع وشارحة له، والتي غالبًا ما اكتفت بمهمّة الشّرح والتّبرير، وتقاعست عن سائر وظائفها التي تؤهلها لنقد الواقع وتوجيهه، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.
وفي هذا المدخل أيضًا تحدّث الكاتب بإسهاب عن مرحلة تدوين القرآن والسنة، مشيرًا إلى نهي النّبي عن هذه العملية في أوّل الأمر، كما أكّد أنّ السنّة قولية كانت أو فعلية على خلاف القرآن لم تكتب في لحظة التّلقّي الأولى، وإنّما تأخّر ذلك إلى وقت لاحق، أو بمعنى أدقّ إلى أوقات لاحقة، "متقطّعة أو متتابعة، كانت الأحداث فيها تجري والدّول تتعاقب، والأنظمة الحاكمة تتبدّل، والفرق السّياسية تتناحر والفرق الكلامية تتجادل، والمذاهب الفقهية تتفاصل، وإذا كلّ دولة وكلّ فرقة وكلّ نظام وكلّ مذهب يستخدم الحديث ويطلبه، وإذا الطّلب في النّهاية على الحديث قد زاد على المعروض منه"[1].
في الفصل الأول "قانون النّص، قراءة في العقل الفقهي المسلم" أكّد الكاتب حقيقة مفادها أنّ الإسلام لم يكن قبل الوحي الثّابت بالكتاب والسنّة، أو بمعنى آخر لم يكن ثمة إسلام قبل النّص، وهذا يؤدّي حتمًا إلى القول بأنّ الحجّية في الإسلام هي النّص وليست شيئًا آخر[2]، ولقد ظلّت هذه الحقيقة مهيمنة على العقل المسلم لفترة من الزّمن، لم يكن للإسلام فيها سلف ولا تاريخ، وهذا الأمر كان في مرحلة التّكوين الأولى، منذ المنشإ حتى مشارف عصر التّدوين، فعلى مدى هذه المرحلة التي لم تدم طويلاً كانت الحجّية منحصرة في الوحي، وبوجه خاص في القرآن، على اعتبار أنّ السنّة في معظمها كانت تطبيقًا عمليًّا للقرآن، أو شرحًا شفهيًّا له، ولم يلتفت إليها في الوعي الفقهي بوصفها مصدرًا كامل الاستقلالية عن القرآن إلّا في وقت لاحق، حين بدأت عملية الطّلب الواسعة النّطاق على الحديث بشكل مقصود ومبالغ فيه أدّى فيما بعد إلى ظاهرة التّضخم الكمّي في الحديث على مستوى السّند والمتن.
وفي هذا الفصل أيضًا أشار الكاتب إلى أنّ العقل الإسلامي الرّاهن في مجمله مؤسّس على الفقه أكثر ممّا هو مبني على النّص، بمعنى أنّه يستمدّ الخلفية أو المرجعية على مستوى الوعي والفكر والشّعور من تلك المنظومة الفقهية المدوّنة، التي لم تكن في ذاتها نصّية بالقدر المطلوب، مما أدّى إلى فجوة كبيرة وواسعة بين العقل الإسلامي الرّاهن وبين متطلبات العصر الحديث، فالعقل الإسلامي الرّاهن في الحقيقة "ما هو إلّا امتداد للعقل السّلفي الأوّل، الذي ما زالت قضاياه الفكرية ومشكلاته الكلامية ومعاركه الفقهية، حاضرة في الطّرح الرّاهن للإسلام، في تجاهل كامل للحقيقة التي أشرنا إليها من قبل بخصوص المناخ الجغرافي الزمني، الذي أفرز هذه القضايا وتلك المشكلات، من خلال الجدل مع الآخر العقلي أو الثّقافي أو السّياسي أو الفقهي"[3].
ولم يفت الكاتب في هذا الفصل أن يشير إلى ذكر جهود مجموعة من العلماء في محاربة المنظومة الفكرية السّلفية، متعمدًا ذكر ابن حزم والاقتباس عنه، لأنّه يمثل في نظره نموذجًا استثنائيًّا وراقيًا لحالة القدرة في العقل المسلم على النّفاذ والتّخلص من سلطان السّلفية التّاريخية التي زاحمت النّص في كثير من صلاحياته، وقدّر لها بعد ذلك أن تشكّل البنية الفقهية للعقل الإسلامي بكاملها على وجه التّقريب، فلقد جاء ابن حزم المتوفّى سنة 456 هـ بعد اكتمال المنظومة الفكرية الفقهية السّلفية واستتباب سلطانها، مؤكّدًا في مشروعه الفكري على ما يعرف بمفهوم الإلزام الذي يعني في مجمله أنّ الحجية في الإسلام ليست في شيء سوى النّص الخالص كتاباً أو سنّةً، وأنّ الإلزامية في النّص الخالص ليست في شيء سوى الأمر الجازم أو النّهي الجازم وجوبًا أو حرمةً[4].
وفي ختام هذا الفصل خلص عبد الجواد ياسين إلى أنّ المشكلة التي نواجهها اليوم تكمن في تلك المصادر المرجعية اللّانصية كالإجماع والقياس وقول الصحابي وعمل أهل المدينة وأقوال الفقهاء من أصحاب المذاهب أو ما اصطلح عليه الكاتب "بالمنظومة السّلفية"، التي وُضعت إلى جوار النّص الخالص واكتسبت صلاحياته المقدّسة والتّشريعية، ثم ساهمت بالنّصيب الأوفى في عملية التّدوين الكبرى للإسلام، الأمر الذي يعني في النّهاية تضاؤل حضور النّص في تشكيل العقل المسلم الرّاهن، و"استبداد السلف بالتّفكير والمعرفة"[5].
في الفصل الثّاني "في القرآن: قراءة في التّأويل السّياسي للنّص" عمل الكاتب على بيان أنّ الواقع السّياسي الدّيني اللاحق لزمن النبوة أضاف إلى النّص القرآني الخالص – لا سيما في موضوع السّلطة- أبعادًا تأويلية لم تكن وقت التّنزيل؛ لقد راحت كل فرقة من فرق الصّراع الناجم عن الفتنة لا سيما الشّيعة وأهل السنّة، تؤوّل آيات القرآن تأويلاً موافقًا لنظريتها السّياسية في السّلطة، فزعمت الشّيعة أنّ في القرآن نصوصًا تثبت الوصية لعلي بن أبي طالب وأبنائه من بعده، أما أهل السنّة فمنهم من ذهب إلى أنّ القرآن يؤيّد خلافة أبي بكر، ومنهم من اكتفى بالقول بأنّه يثبت النظرية السنّية للخلافة[6]، على أنّ الشّيعة في الحقيقة كانوا هم الأكثر تأويلاً لآيات القرآن في شأن الإمامة، كما كانوا الأسبق في استخدام التّأويل، ومن بعدهم وكردّ فعل في الغالب بدأ السنّيون في تعاطي التّأويل وتوظيفه في الردّ على الشّيعة ثمّ في تأسيس ما صار يعرف بنظرية الخلافة.
كما أكّد الكاتب في هذا الفصل أنّ النّص القرآني في لحظته النّصية الأولى يؤكّد خلوّه من الوصية بالسلطة لفرد أو أسرة كما تزعم الشّيعة؛ فقد لجأ العقل الشّيعي إلى التّأويل الذي كان بدوره بحاجة إلى أسانيد ترفعه إلى النبيّ أو الأئمة الذين تجري أقوالهم مجرى النّصوص النبوية، فمن خلال هذه التّأويلات نجد أنفسنا أمام نموذج مجسّد للكيفية التي أثّر بها التّاريخ في النّص، وبالتّالي في العقل المسلم الذي يحمل اليوم في طيّاته ودون أن يشعر إسلامًا تاريخيًّا صاغته السّياسة أكثر من كونه إسلامًا نصّيًّا شكّله الوحي، وهو وصف ينطبق على العقل المسلم بجناحيه الشّيعي والسنّي، وإن كان نصيب الطّرح الشّيعي من صبغة التّاريخ أوفر من نصيب الطّرح السنّي، لأسباب تتعلق بالمسار التّاريخي ذاته، ذلك الذي فرض على الطّرح الشّيعي أن يولد داخل إطار متواصل من القمع والانهزام، "وهكذا كان النّص القرآني يوظّف بالتّأويل في خدمة النّظرية السّياسية الشّيعية، التي كانت تتشكّل مع التّاريخ فكرةً فكرةً، ومفهومًا مفهومًا، هكذا كان التّاريخ يفعل في النّص، فيلوي أعناقه للتّوافق مع الفكر الوضعي الذي لم يقدّم نفسه أبدًا بهذا الوصف، بل قدّمها كحقيقة مطلقة منصوصة تحمل اسم الدّين"[7].
وإذا كانت النّظرية الشّيعية في الإمامة تعتمد منذ البدء على النّص لا سيما نصّ الوصية، فإنّ النّظرية السنّية في الخلافة تقوم بصفة رئيسية على الإجماع، وهو مصدر له قوة النّص في المفهوم الأصولي السنّي، فدليل الإجماع هو الدّليل التّقليدي الأوّل الذي يستند إليه العقل السنّي السّلفي في تأسيس ولاية أبي بكر، ومن ثمّ في تأسيس مبدأ الاختيار المناقض للوصية الشّيعية، وفي مرحلة لاحقة وعندما بدأت النّظرية الشّيعية في التّبلور بعد جهود جعفر الصّادق التّأصيلية والمبنية على النّص، أبدى الطّرح السنّي ضربًا من الاستجابة لهذا المنبه، وذلك بالنّزول إلى ساحة "التّنصيص"، وقد واكب ذلك وساعد عليه تنامي عملية الطّلب على الحديث النّبوي، التي كانت المنظومة السنّية قد شرعت فيها بكثير من المبالغة والنّهم، مما أدّى إلى توافر كميات هائلة من النّصوص المنسوبة إلى السنّة، لكن على الرغم من ذلك ظلّ دليل الإجماع أي فعل الصحابة هو الدّليل الرّئيسي في عملية تأسيس الخلافة.
في الفصل الثّالث "في السُنّة: بين سلطة النّص ونصّ السّلطة" أشار الكاتب إلى أنّ الفتن السّياسية التي ظلت ملازمة لتاريخ المسلمين منذ مقتل عثمان ساهمت في "صناعة" جزء لا يستهان به من النّصوص المنسوبة إلى السنّة[8]، ومن هنا فإنّ طغيان الدّور الذي أدّاه التّاريخ السّياسي في تكوين العقل المسلم لا يتمثل في مزاحمته للنّص الشّرعي الخالص فحسب، بل يتمثل أيضًا في تصنيعه لجزء من بنية هذا النّص، وعليه فإنّ حقيقة "التّنصيص" السّياسي، من حيث هي واقعة مادية، كان الهدف منها هو إسباغ الشّرعية النّصية على سلطة الحكم، لا سيما في مرحلته المبكّرة، حيث كانت الروايات تتناقل بالشّفاهة من غير نصّ مكتوب تنضبط إليه، الشّيء الذي جعل من الحديث ينتشر في الآفاق بمجرد اختلاقه، ولم يكن من العسير على من اختلق المتن أن يختلق الإسناد، فكم من أحاديث مختلقة باعتراف علماء الحديث تمّ تركيبها على أسانيد مقبولة عندما أصبحت الأسانيد المقبولة "جواز مرور" رسمي للحديث.
هذا وقد دعا الكاتب في هذا الفصل إلى اعتماد المنهج التّاريخي لقراءة النّصوص وتمحيصها، والذي من شأنه أن يقود بالضّرورة إلى الإحساس بإشكالية النّص السنّي، المتمثّلة في كون هذا النّص البالغ الضّخامة والتّنوع قد تمّ تدوينه عبر مراحل زمنية متعدّدة وطويلة، وأنّه شهد على مدى هذه المراحل كافّة ضروب الصّراع بين الدّول والفرق والمذاهب، حيث تمّ تدوينه على وقع السيوف ليخرج في الأخير مصبوغًا بصبغات متعدّدة، تعدّد الأيدي التي كتبته، وبالطّبع كان الشقّ السّياسي من هذه النّصوص هو الأكثر حضورًا، وهو ما يعني استحالة فهمه أو فكّ رموزه، بل والتثبّت من ثبوته إلّا على ضوء التّاريخ.
وفي ختام هذه الدّراسة خلص عبد الجواد ياسين إلى كون النّصوص منذ أن دوّنت لا سيما نصوص "السنّة في كتب مستقلّة كمتون سردية صرف، بغير إشارة إلى سياقات الواقع التي كانت تلابسها في لحظات التّلقي الأولى، أو في ظروف التّدوين المتأخّرة، والعقل الإسلامي يتعاطى معها ككائنات تشريعية مطلقة وكاملة الكينونة، بمعزل عن العوامل الخارجية. لقد قرأنا بعض الأحاديث في كتب السنّة الصرف فلم نفهمها، فلما قرأناها في كتب التّاريخ فهمناها، كما قرأنا أحاديث في كتب السنّة الصرف فقبلناها، ثم قرأناها في كتب التّاريخ فلم نقبلها"[9].
المصدر:
عبد الجواد ياسين، السّلطة في الإسلام: العقل الفقهي السّلفي بين النّص والتّاريخ، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 2000.
[1]- عبد الجواد ياسين، السّلطة في الإسلام: العقل الفقهي السّلفي بين النّص والتّاريخ، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 2000، ص 25
[2]- في حوارات أجراها الكاتب مع نواف القديمي أكّد على ضرورة تقديم منهجية جديدة مستمدة من العصر تمارس الحرية والعقل بغير سقف، إلا من ثوابت النّصوص القطعية التي هي قليلة جدّاً بطبيعتها، ونقطة البدء في ذلك خطوتان أساسيتان أولاهما أن تُنحّى كل المصادر اللّانصية التي اعتمدتها المنظومة السّلفية كالإجماع والقياس وقول الصحابي وعمل أهل المدينة، وهو ما يعني إعادة قراءة علم "أصول الفقه" ثم كتابته، وثانيتهما أن تحذف كل الإضافات التي حملت على نصّ السنّة من جرّاء المنهج الإسنادي في جمع الروايات والأخبار، وهو ما يعني إعادة قراءة "علم الحديث" ثم كتابته، ولا يتمّ ذلك بغير ممارسة الحاسّة النقدية بنت العقل والحرية. أنظر: نواف القديمي، محاورات: الإسلاميون وأسئلة النهضة المعاقة، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، الطبعة الأولى، 2006، ص ص 30-31
[3]- عبد الجواد ياسين، السّلطة في الإسلام، ص ص 35-36
[4]- في هذا الأمر يقول ابن حزم: "كان الدّين والإسلام لا تحريم فيه، ولا إيجاب، ثم أنزل الله تعالى الشّرائع، فما أمر به فهو واجب، وما نهى عنه فهو حرام، وما لم يأمر به ولا نهى عنه فهو مباح مطلق، حلال كما كان، هذا أمر معروف ضرورة بفطرة العقول من كلّ أحد، ففي ماذا يحتاج إلى القياس أو إلى الرأي؟. أليس من أقرّ بما ذكرنا ثم أوجب ما لا نصّ بإيجابه، أو حرّم ما لا نصّ بالنهي عنه، قد شرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى؟ وقال ما لا يحلّ القول به؟ وهذا برهان لائح واضح وكاف لا معترض فيه". ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مكتبة عاطف، القاهرة، الطبعة الأولى، 1978، ج.8، ص: 1351.
[5]- أنظر: محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة التاسعة، 2009، ص 135
[6]- النّظرية السنّية للخلافة تقوم على أساس الانتماء إلى قريش شرطًا من شروط الحاكم لا يجوز التّنازل عنه، ومع أنّ هذه النظرية ظلّت على خلاف مثيلتها الشّيعية تتمتّع بقدر وافر من المرونة مكّنها في سبيل مسايرة الواقع السّياسي من التّخلي عن شرط العدالة ذاته فضلاً عن شرطي العلم والفضل إلا أنّها لم تتخل قطّ عن شرط القرشية، وفي ذلك يقول أحمد بن حنبل: لا يكون من غير قريش خليفة. أنظر: أبو يعلى محمد بن الحسين الفرّاء، الأحكام السّلطانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983، ص 20
[7]- عبد الجواد ياسين، السّلطة في الإسلام، ص 227
[8]- بعد أن انقسم المسلمون إلى طوائف مُتعدّدة حاول كلُ حزب أن يؤيّد موقفه بالقرآن وبالسُنّة، فعملت بعض الطوائف على تأويل القرآن على غير حقيقته، وتحميل نصوص السُنّة ما لا تحتمله، واتّخاذها وسيلة لخدمة الأغراض السّياسية والانقسامات الدّاخلية، بل وضع بعضهم على لسان النّبي أحاديث تؤيّد دعواه، ومن هنا كان وضع الحديث وكثرته، واختلاط الصّحيح منه بالموضوع، وكان أوّل ما تطرق إليه من وضعوا الحديث هو فضائل الأشخاص، فقد وضعوا الأحاديث الكثيرة في فضل أئمّتهم ورؤساء أحزابهم، ويُقال: إنّ أوّل من فعل ذلك الشيعة على اختلاف طوائفهم، وقد قابلهم جهلة أهل السُنّة بالوضع أيضاً. أنظر: مصطفى السباعي، السُنّة ومكانتها في التّشريع، دار السلام، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2006، ص ص 93-94
[9]- عبد الجواد ياسين، السّلطة في الإسلام، ص 242






