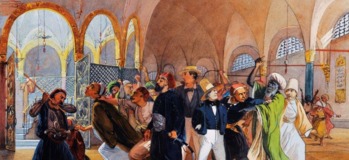هل القلب للشرق والعقل للغرب؟
فئة : مقالات

هل القلب للشرق والعقل للغرب؟
بين فكر الأمة وفكر الطبقة:
في نقد الاستشراق وتمثلاته عند إدوارد سعيد والمفكر مهدي عامل
لطالما شكّلت العلاقة بين الشرق والغرب محورًا أساسيًّا للنقاشات الفكرية والسياسية والاجتماعية؛ إذ تتشابك فيها قضايا التمثيل الثقافي، السلطة، والمعرفة في شبكة معقدة تحدد ملامح الخطاب الغربي عن الشرق، وكذلك الخطاب المحلي الذي يحاول تمثيل "فكر الأمة". ومن هذا التقاطع، ينبثق السؤال المركزي: "هل القلب للشرق والعقل للغرب؟"، وهو ليس مجرد استفسار نظري، بل مفتاح لفهم البنية الأيديولوجية التي أسهمت في صياغة طرائق إنتاج المعرفة عن الشرق منذ الحقبة الكولونيالية وصولًا إلى العصر المعاصر[1]. يستند هذا المقال إلى منهجية تحليلية مزدوجة، تجمع بين النظرية النقدية لإدوارد سعيد، التي تُبرز الترابط بين المعرفة والسلطة، والمقاربة الطبقية لمهدي عامل، التي تركز على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للخطاب المحلي، قصد دراسة إنتاج المعرفة عن الشرق في مستوياته المختلفة: الغربي، المحلي، والداخلي. ويسعى البحث إلى إبراز كيفية تحويل الثقافة إلى أداة للهيمنة الرمزية والمادية، وتوضيح دور البنى الطبقية في إعادة إنتاج هذه السيطرة عبر الخطابات الفكرية والثقافية.
يتضح البُعد التحليلي عند قراءة خطاب المستشرقين، وكذلك الخطابات المحلية للنخب التي تدّعي تمثيل "فكر الأمة"؛ إذ يمكن التمييز بين بعدين رئيسين: الأول، وفقًا لإدوارد سعيد، يتمثل في أن الاستشراق ليس مجرد وصف أو دراسة للشرق، بل خطاب إنتاجي متداخل مع منظومة السلطة والمعرفة، يعيد تشكيل الشرق كمجال متخيّل خاضع للهيمنة الغربية[2]. أما الثاني، فيرتبط بمهدي عامل، الذي يربط بين الخطاب الثقافي للنخب والبنية الطبقية للمجتمع، موضحًا أن ما يُقدّم على أنه "فكر أصيل" ليس سوى انعكاس لموقع طبقي مهيمن يتخفّى وراء شعارات الأمة والهوية. ومن هذا المنظور، لا يمكن النظر إلى الصورة التي يعيد الغرب إنتاجها عن الشرق على أنها مجرد أثر استعماري تاريخي، بل هي صورة متجددة داخل الخطابات المحلية التي تعيد تثبيت المنطق ذاته بوسائل مختلفة، وغالبًا بطريقة أكثر دهاء ومواربة. وهكذا، يمكن أن يتحوّل الخطاب الذي يرفع شعار الأصالة أو الهوية المستقلة إلى أداة لإعادة إنتاج الهيمنة الداخلية، خصوصًا حين تصدر عن مواقع اجتماعية تنتمي إلى الطبقة المسيطرة.[3]
إن هذا التحليل يؤكد أن الهيمنة لا تقتصر على السيطرة العسكرية أو الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى الهيمنة الرمزية على أنماط التفكير وآليات التمثيل، مما يجعل إنتاج المعرفة أمرًا محفوفًا بالمعضلات الأخلاقية والسياسية. وعليه، يصبح الخطاب التحرري معرضًا للانزلاق، إذا لم يُفكّك شروط إنتاجه ومصادره، إلى مجرد استنساخ مموّه للخطاب الاستشراقي نفسه. ومن هذا المنطلق، تظهر أسئلة جوهرية: هل يمكن إنتاج خطاب تحرري أصيل من داخل بنية طبقية مهيمنة؟ وهل يمتلك الشرق القدرة على التفكير في ذاته باستخدام أدوات نظرية مستمدة من منطق الهيمنة ذاته؟ هذه التساؤلات تحدد إطار البحث، وتوجهه نحو دراسة العلاقة الجدلية بين المعرفة والسلطة، بين التمثيل الثقافي والهيمنة الطبقية، في محاولة لرصد إمكانيات إنتاج خطاب نقدي متحرر يوازن بين الفهم النظري والتحليل الاجتماعي والسياسي.
الاستشراق بين إنتاج المعرفة والهيمنة الرمزية
إن دراسة تجربة الشرق من منظور الاستشراق لا تقتصر على رصد الصور النمطية أو الأحكام المسبقة فحسب، بل تمتد إلى تحليل الآليات المعقدة التي تُنتَج من خلالها المعرفة عن "الآخر"، وكيف يُعاد إنتاج هذه المعرفة داخل الفكر الغربي وفي بعض الخطابات المحلية التي تدّعي تمثيل "فكر الأمة"[4]. فالاستشراق، وفقًا لإدوارد سعيد[5]، ليس مجرد تجميع لملاحظات أو تصورات مغلوطة عن الشرق، وإنما هو منظومة معرفية متشابكة مع بنى السلطة والهيمنة، تعمل على صياغة الشرق كحقل متخيَّل يخضع لآليات السيطرة الغربية، ويصبح معيارًا يقيس الغرب من خلاله ذاته، مثبتًا مركزية منظومته الفكرية والحضارية، ومكرسًا لفكرة تفوقه الرمزي والثقافي والسياسي. ومن خلال هذا التمثيل، لا يُعرَّف الشرق في ذاته فحسب، بل يُستَخدم أيضًا كأداة لإعادة إنتاج الهيمنة الرمزية، وهو ما يتيح للغرب الاحتفاظ بالسيطرة الفكرية حتى في سياقات يُفترض أن تكون مستقلة.
في المقابل، يرى مهدي عامل[6] أن النخب المحلية كثيرًا ما تعيد إنتاج هذه الصور في ثوب وطني أو ثقافي، حيث يتحوّل ما يُسمّى "فكر الأمة" إلى تجلٍّ مموّه للهيمنة الطبقية، وهو ما يجعل المشروع النقدي عرضة للانزلاق نحو إعادة إنتاج النسق ذاته الذي يسعى إلى تفكيكه. فاعتماد الأدوات المفاهيمية المستعارة من الخطاب الغربي، مهما بدت محلية أو أصيلة، لا يفضي بالضرورة إلى التحرر من شروط الإنتاج المعرفي المهيمن، بل قد يكرّسها بطرائق جديدة، مما يحدّ من قدرة الفكر النقدي أو المشروع التحرري على تجاوز بنيتها. ومن ثمّ، يصبح أي تحليل جزئي بدون فهم السياق الاجتماعي والسياسي للمنتِج معرضًا لتكرار منطق الهيمنة ذاته، رغم النوايا التحررية الظاهرة، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لفهم العلاقة بين المعرفة والسلطة والتمثيل الطبقي بطريقة نقدية شاملة تدمج بين التحليل الثقافي والاجتماعي والسياسي.
إن مواجهة الواقع المعيشي والثقافي للشرق تكشف بوضوح الفارق بين الصور النمطية والانطباعات المسبقة من جهة، والواقع المعاش من جهة أخرى، حيث يكتشف الباحث أو الزائر مجتمعًا غنيًا بالتنوع ومتشابكًا بالتناقضات الاجتماعية والثقافية، وهو ما يفرض عليه إعادة تقييم المفاهيم المسبقة والتحرر من الانطباعات الضيقة والمحدودة. ومن خلال اللقاء المباشر مع الآخر، تتاح الفرصة لإعادة النظر في الذات الغربية ذاتها، وتفكيك الصور المهيمنة التي طالما سيطرت على وعي الغربيين، الأمر الذي يعزز قدرة المشروع النقدي على استيعاب البنى الرمزية وإعادة إنتاجها، ويؤكد أن المعرفة ليست مجرد محتوى نظري منفصل، بل ممارسة اجتماعية وسياسية ترتبط بالموقع الاجتماعي والسياسي للمنتِج، حيث يصبح التحرر الحقيقي مرهونًا بقدرة الفكر النقدي على تفكيك هذه البنى وإعادة إنتاج خطاب مستقل، قادر على تجاوز الهيمنة التاريخية والمعرفية.
مهدي عامل ونقد الاستشراق من منظور ماركسي
إذا كان إدوارد سعيد[7] قد ركّز على البعد الثقافي والمعرفي للاستشراق، محدّدًا علاقته العضوية بالهيمنة الإمبريالية الغربية، فإن مهدي عامل[8] انطلق من منظور ماركسي، مؤكدًا أن الاستشراق ليس مجرد خطاب خارجي، بل مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنية الطبقية وبآليات التبعية داخل المجتمعات العربية. فبالنسبة إليه، لا يمكن فهم الاستشراق بمعزل عن المشروع الأيديولوجي الذي يسعى إلى تكريس تبعية الشرق للغرب؛ إذ يعمل الخطاب الاستشراقي على إعادة إنتاج وعي زائف يحجب طبيعة التناقضات الداخلية ويعزز سلطة الطبقات المسيطرة في المجتمع المحلي. ويشير عامل إلى أن هذه العملية لا تقتصر على المعرفة المهيمنة من الغرب فحسب، بل تشمل أيضًا النخب المحلية التي تعيد إنتاج الصور النمطية في ثوب وطني أو ثقافي، ما يحوّل ما يُسمّى "فكر الأمة" إلى تجلٍّ مموّه للهيمنة الطبقية، ويحدّ من قدرة النقد على تجاوز النسق الاجتماعي الذي أنتج هذه الصور.
يركّز مهدي عامل على أن الاستشراق يتحوّل إلى آلية "هيمنة مزدوجة"، تجمع بين سيطرة الخارج الإمبريالي وهيمنة الداخل الطبقي، ويؤكد أن الخطاب الثقافي ليس حياديًّا، بل جزء من منظومة السيطرة الشاملة التي تشمل الثقافة والرموز والمعرفة. كما ينتقد خطاب الأصالة والهوية الذي غالبًا ما يُستدعى لمواجهة الاستشراق، واصفًا إياه بـ"الأصالوي"؛ إذ يعيد إنتاج تبعية فكرية تحت غطاء التراث أو الماضي، بينما يغيب عن النظر التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تحدد حياة الفئات الشعبية. وهكذا، يلتقي الاستشراق والخطاب المحلي في إنتاج وعي مثالي يغيب عنه إدراك التناقضات الجوهرية، فيحوّل النقد إلى ممارسة رمزية لا تمس جذور البنية الطبقية، ويجعل مقاومة الهيمنة مجرد مواجهة شكلية للغرب دون معالجة الهيمنة الداخلية.
ومن هنا، يرى عامل أن إعادة إنتاج الصور النمطية عن الشرق في الخطاب الغربي أو المحلي تعمل على إخفاء الصراعات الطبقية وتشريع الهيمنة الرمزية للطبقات المسيطرة، ويصبح النقد الاستشراقي جزءًا من مشروع شامل لفك سيطرة النخب الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد مقاومة رمزية للغرب. ويؤكد على الترابط بين النقد الفكري والنضال الاجتماعي، معتبرًا أن تحرير الوعي من الصور الاستشراقية لا يقل أهمية عن تحرير المجتمع من التبعية الاقتصادية والسياسية. فالاستشراق ليس مجرد أداة معرفية أو ثقافية، بل أداة ضمن منظومة هيمنة شاملة تعمل على تشكيل الإدراك الجمعي للمجتمعات الشرقية، حيث تبدو التبعية مقبولة ومشرّعة، مما يجعل مقاومته مشروعًا مزدوجًا: فكريًا لتحرير الخطاب، واجتماعيًّا وسياسيًّا لمواجهة الهيمنة الاقتصادية والطبقية، مع تعزيز قدرة الفئات المهمشة على إنتاج خطاب مستقل ومباشر قادر على مواجهة الهيمنة التاريخية والمعرفية.
الآخر والنتاج الإنساني للتحرر
إن دراسة الآخر من منظور الاستشراق ونقده لا تقتصر على تحليل الصور النمطية أو الجوانب الثقافية السطحية، بل تمثل محاولة لفهم التجربة الإنسانية بكل تعقيداتها وتناقضاتها، وفهم كيف يعيش الآخر واقعه الاجتماعي والسياسي والثقافي، ويحمل وعيه وتاريخه الخاص. فالآخر ليس مجرد موضوع معرفي أو تجريبي يمكن تسجيله وحسب، بل كيان كامل تتفاعل خبراته وتجربته اليومية مع السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيش فيه، مما يفرض على الباحث إعادة النظر في أدواته التحليلية ومفاهيمه النظرية؛ إذ إن أي معرفة عن الآخر تتجاهل تجربته الواقعية تصبح ناقصة وتفتقر إلى البعد الأخلاقي والإنساني، فلا يمكن الاكتفاء بنقد الاستشراق بوصفه خطابًا غربيًّا، بل ينبغي إدماج تجربة الفرد الشرقي ضمن التحليل، وإشراكه في إنتاج المعرفة نفسها. ومن خلال هذا النهج، يصبح النقد عملية جدلية، تربط بين البعد الفكري والاجتماعي والسياسي، وتؤكد أن المعرفة الحقيقية ليست مجرد محتوى نظري، بل ممارسة مرتبطة بالمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية تجاه الآخر.[9]
تظهر التجربة الإنسانية للآخر بشكل جليٍّ عند اللقاء المباشر معه، سواء عبر البحث الميداني أو التفاعل الاجتماعي المباشر؛ إذ يكشف هذا اللقاء عن الفجوة الكبيرة بين الصور النمطية التي أنتجها الخطاب الغربي أو المحلي، وبين الواقع المعاش للآخر. ويجبر هذا الواقع الباحث على مواجهة أحكامه المسبقة وإعادة ترتيب رؤيته، مع إدراك التعددية والتنوع الثقافي والاجتماعي داخل المجتمعات الشرقية. فالتجارب اليومية للفئات المختلفة، من حيث التعليم والعمل والحقوق المدنية، تشكل فسيفساء معقدة تتطلب تفكيك التعميمات النمطية التي غالبًا ما يفرضها الخطاب المهيمن. وبهذا، يتيح فهم الآخر الشرقي بعمق إنتاج معرفة تحررية تعترف بالتنوع الداخلي والتناقضات الاجتماعية والاقتصادية، وتربط البعد المعرفي بالبعد الإنساني والسياسي، ما يجعل من عملية إنتاج المعرفة تجربة أخلاقية متكاملة، وليست مجرد تسجيل للوقائع أو إعادة إنتاج للصور النمطية.[10]
كما أن إدماج الفئات المهمشة في عملية إنتاج المعرفة لا يمثل واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة معرفية لتحرير الخطاب من الهيمنة الرمزية. فهذه الفئات هي حاملو الخبرة اليومية للآخر، وتجربتهم تقدم مرآة لفهم الصراعات والتناقضات المجتمعية العميقة، وتمكن الباحث من إنتاج معرفة متحررة تعطي الفرصة للآخر ليكون طرفًا فاعلًا في صياغة خطاب مستقل يعكس واقعه، بعيدًا عن أيديولوجيات الاستشراق أو الأصالة المقلدة. ومن هذا المنظور، يصبح مفهوم "التحرر" مرتبطًا بالبعد الإنساني للمعرفة، حيث تتحول المعرفة إلى أداة للتغيير الاجتماعي، تعيد ترتيب العلاقة بين الباحث والموضوع، وتتيح الفرصة لبناء خطاب نقدي قادر على مواجهة السلطة والهياكل الطبقية، مع تعزيز وعي نقدي حقيقي لدى الباحث والمجتمع على حد سواء. إن هذا النهج يجعل من دراسة الآخر ممارسة متكاملة تجمع بين النقد الفكري، والتحليل الاجتماعي، والمسؤولية الأخلاقية، بما يضمن إنتاج معرفة تعكس الواقع وتساهم في التحرر الإنساني والاجتماعي.[11]
الخاتمة
حاولنا في هذا المقال، من خلال التحليل المقارن لخطابي إدوارد سعيد ومهدي عامل أن نبيّن أن فهم الاستشراق يتجاوز حدود دراسة الصور النمطية أو المواقف الثقافية، ليصبح مدخلاً لفهم العلاقة المعقدة بين المعرفة والسلطة، بين الفكر والطبقة، وبين الثقافة والسياسة. فإدوارد سعيد قدّم تصورًا نقديًّا يؤكد أن الاستشراق ليس مجرد دراسة للشرق، بل خطاب إنتاجي متداخل مع الهياكل الإمبريالية الغربية، يحدد صورة الشرق في أذهان الغرب ويبرّر سلطته التاريخية والسياسية[12]. وفي المقابل، يضيف مهدي عامل بعدًا طبقيًا حيويًّا، مبيّنًا أن الاستشراق لا يظل محصورًا في الغرب فحسب، بل يُعاد إنتاجه محليًّا من قبل نخب الطبقة المسيطرة، في نسق متشابك من الهيمنة الداخلية والخارجية، مما يحوّل النقد إلى عملية مزدوجة: مواجهة الهيمنة الغربية وفهم الهيمنة المحلية، وتحليل الديناميات التي تربط الثقافة بالاقتصاد والسياسة[13]. تؤكد هذه الرؤية أن نقد الاستشراق لا يمكن أن يقتصر على تمرين نظري أو رمزي، بل يجب أن يتحول إلى ممارسة نقدية شاملة، تجمع بين الفكر والتحليل الاجتماعي والسياسي لتفكيك الشبكات المعقدة للهيمنة، مع إدراك أن الآخر ليس مجرد موضوع معرفي يُدرس أو يُوصف، بل هو كيان يعيش واقعه ويشارك في إنتاج وعيه وهويته.ومن ثم، فإن أي تحليل نقدي يظل ناقصًا إذا تجاهل التجربة المباشرة للآخر، وإمكانية إشراكه في إنتاج المعرفة. فالتفاعل مع الآخر يفرض على الباحث مراجعة أدواته ومفاهيمه النظرية، ويضعه أمام مسؤولية أخلاقية واضحة: ألا تتحوّل المعرفة إلى مجرد آلية للهيمنة أو إعادة إنتاج التمثلات النمطية، بل إلى وسيلة لفهم الواقع اليومي للآخر، ومنح الفئات المهمشة القدرة على إنتاج خطابها الخاص. ويؤكد هذا البعد الإنساني أن المعرفة المتحررة ليست محتوى نظريًا فحسب، بل ممارسة أخلاقية واجتماعية، قادرة على إعادة توزيع السلطة الرمزية والثقافية، وتعزيز القدرة على الفعل المجتمعي والسياسي.[14]
علاوة على ذلك، يظهر أن النقد الحقيقي للاستشراق يتطلب إدراك التعددية والتنوع داخل المجتمعات الشرقية؛ إذ لا يمكن اختزالها في صورة واحدة أو رؤية أحادية. فالواقع الاجتماعي الشرقي معقد، مليء بالتناقضات الاقتصادية والسياسية والثقافية، والفهم النقدي له يتطلب تجاوز الصور المرسومة مسبقًا في الخطاب الغربي أو المحلي، وفك القيود الرمزية للطبقات المهيمنة. ومن هنا، يصبح النقد مشروعًا مزدوجًا: فكريًّا لتحرير الخطاب من قيود الهيمنة الرمزية، واجتماعيًّا وسياسيًّا لتمكين الفئات المهمشة من إنتاج خطابها الخاص الذي يعكس تجربتها اليومية واحتياجاتها الحقيقية، بما يجعل المعرفة أداة فعلية للتغيير الاجتماعي والتحرر الشامل.
في الختام، يمكن القول إن مشروع نقد الاستشراق، سواء من منظور سعيد الثقافي أو منظور عامل الطبقي، يبرز ضرورة إنتاج معرفة إنسانية متحررة، تعترف بتعددية التجارب الإنسانية وتفهم الديناميات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تشكل حياة البشر. فالتحرر الفكري لا يتحقق بمجرد تبني خطاب نظري أو رمزي، بل عبر ممارسة نقدية متكاملة تشمل الفكر والمجتمع، وتمكّن الفئات المهمشة من المشاركة الفاعلة في إنتاج معرفتها. وبهذا، يصبح نقد الاستشراق فعلًا إنسانيًّا واجتماعيًّا حقيقيًا، يعيد بناء العلاقة بين المعرفة والسلطة، ويعزز القدرة على التفكير النقدي والتحرري لدى كل من الباحث والمجتمع، مع إرساء أسس العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
لائحة المراجع
*- إدوارد سعيد، الاستشراق: المعرفة والهيمنة والإنشاء، ترجمة كمال أبو ديب، بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1981
*- مهدي عامل، هل القلب للشرق والعقل للغرب؟، بيروت: دار الفارابي، 1986
[1] إدوارد سعيد، الاستشراق: المعرفة والهيمنة والإنشاء، ترجمة كمال أبو ديب، بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1981، ص. 27-45
[2] نفس المرجع، ص. 46-63
[3] مهدي عامل، هل القلب للشرق والعقل للغرب؟، بيروت: دار الفارابي، 1986، ص. 15-35
[4] إدوارد سعيد، الاستشراق: المعرفة والسلطة والإنشاء، ترجمة كمال أبو ديب، بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1981، ص. 25-30
[5] نفس المرجع، ص. 45-60
[6] مهدي عامل، هل القلب للشرق والعقل للغرب؟، بيروت: دار الفارابي، 1986، ص. 45-60
[7] إدوارد سعيد، الاستشراق: المعرفة والسلطة والإنشاء، ترجمة كمال أبو ديب، بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1981، ص. 45-60
[8] مهدي عامل، هل القلب للشرق والعقل للغرب؟، بيروت: دار الفارابي، 1986، ص. 45-70
[9] إدوارد سعيد، الاستشراق: المعرفة والهيمنة والإنشاء، ترجمة كمال أبو ديب، بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1981، ص. 45-60
[10] مهدي عامل، هل القلب للشرق والعقل للغرب؟، بيروت: دار الفارابي، 1986، ص. 73-90
[11] نفس المرجع، ص. 91-105
[12] إدوارد سعيد، الاستشراق: المعرفة والهيمنة والإنشاء، ترجمة كمال أبو ديب، بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1981، ص. 27-50
[13] مهدي عامل، هل القلب للشرق والعقل للغرب؟، بيروت: دار الفارابي، 1986، ص. 15-40
[14] نفس المرجع، ص. 41-60