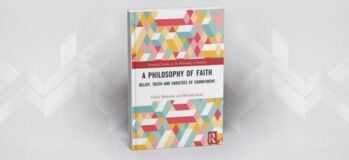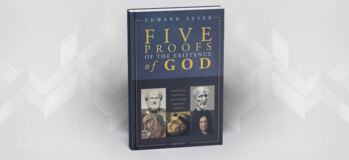الهوس الثيوماني وعلامات الساعة الكسمولوجية
فئة : مقالات

«يُحِبُّهم ويُحِبُّونَهُ» (المائدة، 54)
شيئان مترابطان ومتآزران ويُغذّي أحدهما الآخر: «الباريدوليا» (Pareidolia, paréidolie) و«الثيومانيا» (Theomania, théomanie). للتبسيط نقول بأن «الباريدوليا» هي رؤية صورة كائن حي (بشري أو حيواني) أو كتابة مقدَّسة في علامة طبيعية (مثلا: رؤية حصان شكلته الغيوم في السماء، أو وجه في الصخور، أو اسم الجلالة في شجرة أو ثمرة)؛ «الباريدوليا» هي نوع من «التشبيه الإنساني» (anthropomorphisme) يتم إسقاطه على أشياء الطبيعة. الطبيعة تُشبهنا، قيل قديماً. ونقول بأن «الثيومانيا» هي الهوس بالإله إلى حد التطرف والانتحار؛ نوع من الفكرة الميتافيزيقية الثابتة والراسخة التي يكون مفعولها على التصورات والسلوكيات قوياً وحاسماً. هشاشة الإيمان وفقدان الثقة في النفس برَّرا نوعا ما استفحال «الباريدوليا» بالبحث عن علامة كسمولوجية خارجية (صورة العذراء في الجدران وهي تبكي دماً، صورة اسم الجلالة «الله» في السماء أو في أشياء الأرض، إلخ) تُعوّض الفراغ الباطني؛ وزادا من حدَّة «الثيومانيا» إلى درجة التشدُّد وغلق منافذ الاستشعار (empathie) وأبواب الإنصات إلى الآخر. «الثيومانيا» تُعْدم وتصبُّ في العدمية.
التشبيه البشري مدخلاً نحو الهوس الثيوماني
إنها إفناء للحضور البديهي للآخر: «إليك عني، لا أراك!»، معناه لا أراك كما أرى نفسي في محض تعلُّقي بالفكرة التي أشكّلها حول ذاتي ومعتقدي وهويتي. هشاشة الإيمان وفقدان الثقة في النفس وراحة البال هي علامات التمرُّغ في «الثيومانيا» التي تجعل الشخص يدافع عن الإله بشراسة أو شراهة «المومياء» (zombie) بأكل لحوم الذوات الأخرى (cannibalisme)؛ تجعل الشخص في الوضعية «البانوبسية» (panoptisme) أو الشمولية في مراقبة الأفعال والحكم عليها ومعاقبتها. سؤالي: هل استشرت «الثيومانيا» في الجسد الفردي والاجتماعي، وحتى في الجسد التشريعي بمعاقبة المفطرين في رمضان مثلاً، مع أن هذا السلوك (الإفطار) لم يكن يؤرق فيما مضى الدولة السيادية؟ هل يحتاج الإيمان إلى علامة برَّانية من خارج الشرط الباطني في محض اعتقاده الخالص؟ هل يحتاج إلى زوائد وإلى توكيد؟ إما أنه ليس بإيمانٍ أصلاً، وإما أن مفعول «الباريدوليا» قوي جداً، لأن هذه «الباريدوليا» منغرسة في الذاكرة التشبيهية للنوع البشري: يبحث الإنسان عن شيء من شبيه جنسه أو صورته؛ شيء يقترب ممَّا قاله الكاردينال نيكولا الكوزي (1401-1464) في إحدى مناجاته: «لا يستطيع الإنسان أن يحكم سوى بشكل إنساني. إلهي، عندما أضفى عليك الإنسان وجهاً، لم يجده خارج النوع البشري، لأن حكمه كامن في الطبيعة البشرية. وفي حكمه، لا يفلت الإنسان من هذا الاختزال الذي يُميّزه. تماماً مثلما لو أن الأسد أضفى عليك وجهاً، فسيحكم بأنه سيكون وجه أسد، وبالنسبة إلى الثور، سيكون وجه ثور، وبالنسبة إلى النسر، سيكون وجه نسر».
«إليك عني، لا أراك!»، علامة مَرَضية على الوجه الآخر للثيومانيا، لكنه يمسُّ هذه المرة الإنسان تحت مسمَّى «إيروتومانيا» أو هوس الحب (érotomanie) كما عالجها غايتان كليرامبو (1872-1934): كيف لشخص يهوى شخصًا آخر لكن موضوع الحب ينتفي؟ «جاءت ليلى إلى قيس، وهو يصيح: ليلى ليلى! ويأخذ الجليد ويلقيه على فؤاده فتذيبه حرارة الفؤاد، فسلَّمت عليه وهو في تلك الحال، فقالت له: أنا مطلوبك، أنا بغيتك، أنا محبوبك، أنا قرَّة عينك، أنا ليلى! فالتفت إليها وقال: إليك عنّي، فإن حبَّك شغلني عنك». إذا تسنَّى لنا دراسة هذه الحالة الإيروتومانية وربط شكليتها بالحالة الثيومانية، فإننا نخلص إلى أنهما تسيران وفق منطق واحد وهو التعلُّق بالموضوع بفقدان ذات الموضوع. ماذا أحبَّ قيس «الإيروتوماني» في ليلى؟ ماذا أحبَّ المتديّن «الثيوماني» في الإله؟ هل أحبَّ قيس فعلاً ليلى أم فقط صورة أيدولية (eidolôn) عن ليلى؟ هل أحبَّ المتديّن الإله أم صورة صنمية عن الإله صنعها في ذاته، «أنشأ في نفسه ربًّا يعبده»؟
لفهم هذا التشاكل بين الهوس الإنساني والهوس الإلهي، الذي ينجرُّ عنها عُنفاً موضوعياً تتبدَّى آثاره القصوى في القتل والإرهاب والترويع، يمكن اللجوء إلى المراحل التي عدَّدها كليرامبو في الإيروتومانيا وهي: لحظة الأمل، ثم لحظة الغيظ، وأخيراً لحظة الضغينة وإتلاف ذات الموضوع. الإيروتومانيا، بما هي حُب متفاقم، أو عشق مفرط، أي حب غير طبيعي أو غير سليم، تُغذّيه جروح ذاتية أو نرجسيات، تبدأ إذن، بالأمل بأن يهوى الشخصُ شخصاً آخر؛ لكن سرعان ما يختفي الشخص المحبوب وراء ظلّه، ويقوم العاشق بالتعلُّق بالموضوع (المتخيَّل أو الذهني)، لأن العاشق يصنع موضوعاً متوهَّماً يدبّره كيف يشاء، بمعزل عن الشخص المحبوب الذي يمكنه أن يرفض حُب العاشق. بصناعة موضوع محبوب (هو مجرَّد صنم أو أيدولة)، تبقى للعاشق سُلطة التحكُّم في المحبوب، ويُسند إليه عبارات أو إشارات، فيُؤوّل كل حركة أو غمزة أو كلمة على أنها تنعته، تنعتُ العاشق.
عندما لا يستجيب الشخص المحبوب، ينتقل العاشق إلى حالة الغيظ التي تُولّد في ذاته عُقَد وتنعكس على المعيش انتظاراً مؤلماً واكتئاباً؛ ثم يصل في النهاية القصوى إلى الضغينة بأن يسعى إلى إتلاف موضوع حبّه بأن يُتلف الشخص المحبوب بالاغتيال أو يُتلف نفسه بالانتحار. يقول كليرامبو أن الشخص المحبوب غالباً ما يكون ذو شهرة أو صيت عالٍ كأن يكون كاتباً أو سياسياً أو طبيباً أو أستاذاً، أي كل من له مكانة اجتماعية؛ ويُلتمَس منه الاعتراف. الجرح الذي يمسُّ العاشق أن المحبوب الذي يتمتَّع بمكانة راقية هو غاية الاعتراف. لكن إذا لم يأتِ هذا الاعتراف، فإن الحُب المكنون يتحوَّل إلى حقد مدسوس وكبرياء جريح. هذه الكراهية الدفينة هي نوع من الحب المعكوس، حب مرآوي (معكوس الواقع)، لأنه حب نرجسي؛ وهو أيضاً حب عُظامي (paranoïaque)، لأنه نابع من القناعة أن العاشق ضحيَّة اضطهاد من لدن المحبوب الواقعي الذي لا يتطابق مع المحبوب المتخيَّل أو الموضوع المصطنع في ذات العاشق.
عندما نقرأ السلوك الثيوماني على المستوى الديني، نرى بأنه يشترك مع السلوك الإيروتوماني على صعيد العلاقات الاجتماعية الحميمية في النقاط التالية:
1- يبحث الشخص الثيوماني عن الاعتراف من لدن شخصية راقية تتلبَّس أدواراً عُليا كأن تكون هذه الشخصية عالماً أو داعية، أو حتى الشخصيات المنقضية (صحابياً كان أم نبياً) أو حتى الإله المتشخّص.
2- في مرحلة الأمل، يسعى الشخص الثيوماني إلى الترويج لنماذج مثل الخلافة أو يلجأ إلى العلامة للتوكيد على صدق رسالته، أي العلامة الباريدولية بأن يبحث في الأرض أو في السماء عن اسم الجلالة، أو يؤوّل سقوط المطر بالرضى والزلزال بالسخط، تماماً مثلما يؤوّل الإيروتوماني الحركات والإشارات لدى المحبوب على أنها حب موطَّد، بل ويؤوّل حتى الرفض على أنه قبول، على اعتبار أن الحب الإيروتوماني هو معكوس الواقع، لأنه حب مرآوي أو نرجسي.
3- في مرحلة الغيظ، يسعى الشخص الثيوماني إلى فرض أفكاره وتأويلاته بالترهيب، بأن يُعنّف من لا يستجيب إلى دعوته؛ يستعمل طرقاً في الإكراه، وأساليب الوعيد بالتذكير بالعقاب والنار.
4- في مرحلة الضغينة، يلجأ الشخص الثيوماني إلى حمل السلاح الرمزي أو المادي، بإشهار القرآن أو السيف والقذيفة، يدخل معترك الصراع مع الآخر الذي لا يستجيب إلى دعوته، ولا يعترف بما يراه طوبى لأهل الأرض، مثل الخلافة والحاكمية وتطبيق الشريعة؛ فتكون خاتمة ذلك هي حتف الموضوع بالاعتداءات الإرهابية التي تحمل أيضاً جانباً من حتف الذات بالانتحار والتلف الجسدي.
السياج الثيوماني المغلق: الأفق المسدود
مثلما ينتمي الحُب النرجسي إلى نظام المخيال (l’imaginaire) بالمعنى الذي نجده عند جاك لاكان، كذلك ينخرط الهوس الثيوماني في نظام المخيال المركَّب من هواجس وأحلام وتمثُّلات منعرجة أو معوجَّة عن الواقع، لتُشكّل عالماً مستقلاً أو سياجاً مغلقاً، ينخرط في الدعوة إليه والقتال من أجله. لا يمكن لهذا الانزواء الذُرّي أن ينتقل إلى نظام الرمزي (le symbolique)؛ أي إلى اللغة والتبادُل مع الآخر بالذهاب نحو الآخر؛ لكنه يبقى حبيس نوع من الدافع الرؤيوي (pulsion scopique) القائم على الترقُّب، وعلى المراقبة، وعلى الهجوم على الآخر بالنظر (le regard)، وبالتوجُّس من عُريه، وباستهجان ملابسه (ما يُسمَّى بالسفور عند المرأة). هذا النظر الثيوماني هو معكوس الدافع الرؤيوي في صيغته الجنسية، أي النظر إلى الآخر بعين اللذَّة لملامح الوجه أو أبعاد الجسد. سيكون الدافع الرؤيوي في الهوس الثيوماني هو إرادة حتف الآخر الذي يتبدَّى عارياً أو سافراً: «إليك عني، لا أراك!». يرفض الشخص الثيوماني عُري الكينونة، لأنه يكشف في ذاته عن عراء السريرة، وفقدان الإيمان.
عندما درس فرانك بول بومان السلوك الثيوماني في النزعات المسيحية للأزمنة الرومانسية، توقَّف عند ما تشترك حوله هذه النزعات بمختلف تيَّاراتها وألوانها، وهي الرؤيا الممزوجة بالنبوءة والأحلام الطوباوية والخيالات الفاسدة والأهوال القيامية أو الأخروية؛ نوع من السوداوية أو الميلانخوليا (mélancolie) التي تُعدّل من الرؤية إلى العالم فيما هي تُعدّل أساساً من الشرط الإنساني للشخص الثيوماني، تحت وطأة الهوس بالإله أو بالأشياء الدينية، التي يجعلها الأس والهدف أو المبدأ المطلق والغاية القصوى، لا يمكن الخروج من سياجها سوى بدفع ضريبة الحتف أو التلف. يقول بومان: «لا يُوفّر الجنون الديني سوى حالة متطرّفة من نزوع تاريخي عام، حالة متطرّفة يمكن تفسيرها على أساس الحاجة المتفاقمة إلى الأمل». ما يأمل فيه الشخص الثيوماني ليس من هذا العالم. بل ينبغي حتف العالم لتتراءى الحقيقة في أبهى نصاعتها، ولكي تنكشف مملكة الله.
الأمل الممزوج بالمعكوس اللغوي وهو الألم في أشكاله المحتدَّة (سوداوية، كآبة، ضغينة، كراهية الآخر بكراهية الذات...)، ما هو سوى دواء غُفل (placebo)، يوهم بالعلاج لكنه يُفاقم من الداء؛ لأنه لا يوفّر للشخص الثيوماني سوى بدائل (Ersatz) لا تُشبع الحاجة المتفاقمة إلى الأمل، فيلجأ إلى هجران العالم والانعتاق من شِراكه. بعد الأمل المفقود ثمَّ الألم المستشري، تتبدَّى أشكاله في الغيظ والضغينة التي تصل في منتهاها إلى حتف الآخر بالأعمال الإرهابية ونسف الذات بالعمل الانتحاري. لهذا الألم أمارات: البكاء أو النحيب، الغيظ ولفظ الغير، الكبرياء الجريح. وحده الأمل الذي يمرح، لأنه شروق الحقيقة في أفق الكينونة. هل نتعجَّب من أن زمن الأنوار (القرن الثامن عشر) هو زمن «الأمل» بحديث فلسفات التاريخ وقتئذٍ عن التقدُّم والغاية القصوى التي تصل إليها البشرية، وجاءت لتُعوّض (ولتُقوّض أيضاً) الأزمنة الحالكة (القرن السابع عشر)، زمن «الألم» الذي تعاظمت فيه الفاقة والسوداوية، أزمنة العالم الباروكي، انعكست باطنياً في النفسية المنكسرة والمتفاقمة، وخارجياً في التعابير الأدبية والفلسفية المعتمة.
إذا عُدنا إلى السلوك الثيوماني في الإسلام المعاصر، هل نعزو ذلك إلى معطيات مادية مثل الاقتصاد، باستفحال الفقر والبطالة وانسداد الأفق التنموية؟ هل نعزو ذلك إلى معطيات رمزية تنتمي إلى الاندحار الحضاري الذي نحياه منذ قرون والذي يُعدُّ بالنسبة إلينا عبارة عن جرح نرجسي؟ هل ننسب ذلك إلى فشل النهضة على صعيد الأفكار وتطبيقاتها الاجتماعية والسياسية، أي الإخفاق في تكوين نموذج تنظيمي في الإدارة والسياسة والاجتماع البشري من شأنه أن يُوسّع آفاق الأمل ويحصر من تبعات الألم والشعور باليأس والقنوط؟ كل هذه العوامل مجتمعةً هي السبب الرئيس في بلورة السلوك الثيوماني، أي التشبُّث اليائس والبائس بالفكرة الدينية في أشكالها الصنمية، أو ما سمَّيته في مناسبات أخرى «العصر الأيدولي للفكرة الدينية»، وأقصد بالأيدولة، الفكرة وقد تحوَّلت إلى صنم وانْعَقَدَت في الذات «عُقْدةً» متينة صعبة الانفكاك، علاوة على كونها «عقيدة» ثابتة من حيث التصديق والإذعان.
بات النزوع الثيوماني في الإسلام المعاصر يُهدّد الأفراد والمجتمعات وحتى المؤسسات التي تقوم عليها الدولة، والتي من المفروض أن تكون محايدة. ما السبب في الميْل نحو الشعور الثيوماني؟ بأي معنى تُنصّب المؤسسات نفسها الراعية على إسلام السَّواد بدحر الاختلاف والخوف على «رابطة الأمَّة» من القرصنة البرَّانية في شكل فكر حُر أو مذهب روحي؟ أعزو ذلك بلا مواربة إلى هذا الشعور الثيوماني الذي يقول بأن العصر الأيدولي للفكرة الدينية يمكنه أن يُنتج الارتماء في العدم مثلما يرتطم الفراش بالنيران الوهَّاجة أو الأنوار الساطعة. هناك ميْل عجيب نحو حتف الجسد الذي لا يطيق حَمْل الكبرياء الإلهي مثلما لا يتحمَّل النسبي لانهائية المطلق «حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِيَاطِ» (الأعراف، 40). في غياب رؤية عميقة في الذات، في شرطها الوجودي واشتراطها الاجتماعي والسياسي، لا يمكننا سوى أن نتوقَّع مزيداً من السلوك الثيوماني، نوع من الهوس الذي لا يُفكّر سوى من داخل السياج المغلق الذي ارتضاه لنفسه؛ ليس فقط لأن الأفق مسدود (انتفى الأمل بأن ارتدَّ إلى الألم)، وإنما أيضاً لأن السلوك الثيوماني، يقول بالفعل انتفاء الإنسان لصالح مضاعفٍ له: فكرة اصطنعها في ذاته وأضحت صنماً، أو صورة بلورها في نفسه وأصبحت وثناً.
Nicolas de Cues, De visione Dei sive De icona (1453), Le Tableau ou la vision de Dieu, trad. Agnès Minazzoli, éd. Cerf, 1986, coll. "La nuit surveillée", p. 41-42
2 ابن عربي، الفتوحات المكية، 2/325، باب المحبة (دار صادر، بيروت).
المرجع نفسه، 2/389
Gaétan Clérambault, Œuvre psychiatrique, I, Paris, PUF, 1942
Frank Paul Bowman, « Une lecture politique de la folie religieuse ou théomanie », in: Romantisme, 1979, n°24, p. 87