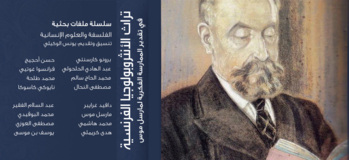تحدِّي تغيُّر المناخ: أيَّ طريق نسلك؟
فئة : قراءات في كتب

تحدِّي تغيُّر المناخ: أيَّ طريق نسلك؟
روبرت إل روثستاين ودانيال دي بيرلمتر
ترجمة أحمد شكل مراجعة ضياء ورَّاد
يشكل تغير المناخ أحد أبرز التحديات الوجودية التي تواجه البشرية في العصر الراهن. تترتب على هذه الظاهرة تداعيات كارثية وواسعة النطاق، تشمل ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وذوبان الكتل الجليدية القطبية والأنهار الجليدية، وارتفاع منسوب سطح البحر، بالإضافة إلى تواتر وتفاقم الظواهر الجوية المتطرفة كالفيضانات، والجفاف، والعواصف العنيفة.
لا تقتصر هذه التغيرات على تهديد الأنظمة البيئية فحسب، بل تمتد لتُؤثر سلبًا على الاقتصادات العالمية، وتُهدد الأمن الغذائي والمائي، وتُعرض الصحة العامة للخطر، مما يُلقي بظلاله على حياة ملايين البشر. ويظهر من خلال الجهود المبذولة من قبل الحكومات والهيئات الدولية اليوم وعياً متزايداً بخطورة تغير المناخ، وتزايداً في الأطر القانونية والتعاونية. ومع ذلك، فإن حجم التحدي يتطلب تسريعاً غير مسبوق في الوتيرة، وزيادة في الطموح، وتحقيقاً كاملاً للالتزامات، خاصة فيما يتعلق بتمويل المناخ، لضمان مستقبل مستدام للكوكب.
فالمناخ إذن هو الشرط الأول في العيش على الأرض المُنَاخُ هو متوسط حالات الطقس على المدى الطويل، ويُحتسب عادةً على مدى 30 عاماً. من متغيرات علم الأرصاد الجوية التي تُقاس بشكل عام: درجة الحرارة ورطوبة الهواء والضغط الجوي والرياح والهطول المطري. بمعنى أوسع، المناخ هو حالة مكونات النظام المناخي، والتي تشمل المحيطات والجليد على الأرض.
التفكير في "المناخ مهم بالنسبة للقرارات طويلة المدى. إذا كنت تدير مرفقًا كهربيًّا، فعليك أن تهتم بالمناخ؛ لأنه لو ارتفع متوسط درجة حرارة الصيف، يشغل الناس المكيفات أكثر وقد تحتاج إلى بناء المزيد من المولدات لتلبية الاحتياجات الكهربية المطردة. وإذا كنت مسؤولًا في مدينة، فسوف تهتم بالمناخ؛ لأن إمدادات المياه في المدن تأتي عادة من الخزانات التي تغذيها الأمطار أو الثلوج. التغير في متوسط درجة الحرارة أو توقيت سقوط الأمطار أو كميتها، يمكن أن يغير إمدادات المياه أو الاحتياجات إليها. وإذا تغير المناخ، فقد تحتاج المدينة إلى توسيع القدرة على تخزين المياه أو نقلها، أو العثور على إمدادات جديدة، أو تطوير سياسات للحد من استخدام المياه في أزمنة الجفاف."[1]
*- موضوعات الكتاب
الاحترار العالمي وتغير المناخ قضيتان متشابكتان ومعقدتان من قضايا السياسة العامة والمفاوضات المتعددة الأطراف والتقدم التكنولوجي. يستكشف هذا الكتاب الفرص التي تتيحها الاتفاقيات الدولية للتعامل مع هاتين القضيتين والمشاكل التي تنجُم عنها، ويَدرس التطورات التكنولوجية والأهداف السياسية التي يمكن السعي لتحقيقها من أجل إحداث التغييرات الضرورية. ويمثِّل جهدًا مشتركًا بين اثنين من الكتَّاب من خلفيتين مختلفتين تمامًا (الهندسة والعلاقات الدولية) "الكتاب يتنقل بين نقيضين. فنحن نعتقد أن ظاهرة الاحترار العالمي تَحدث وأن تصرفات البشر عامل رئيسي في ذلك الاحترار، ولكننا لسنا مقتنعين بأن كل شيء سيضيع إذا لم تُطبَّق على الفور وفي كل مكان تغييراتٌ هائلة في السياسات وأنماط الحياة؛ فلدينا وفق حساباتنا «فرصة سانحة» لفترة من عشرة إلى عشرين عامًا لوضع سياسات ستكون فاعلة في تسهيل التكيُّف مع المستويات الحالية من الاحترار العالمي، والتخفيف من أسوأ آثار الزيادة الخطيرة للغاية والطويلة الأمد في درجات الحرارة العالمية. سوف تكون هذه السياسات مكلِّفة، وسوف تتطلب مواءمات صعبة على نحو متزايد بينما يجري تدشين اقتصادِ طاقة جديدٍ، وسوف تحدث «صدمات» سياساتية وأخطاء مكلفة على طول الطريق، ولكن التغييرات لن تكون بالغة التكلفة أو مستنزفة بما لا طاقة لنا به ولن تُباغتنا «إذا» لم نستخدم الشكوك والصراعات الأيديولوجية كأعذار للمماطلة"[2] وأهم موضوعات الكتاب: نظرة على السياسة الجغرافية/ نظرة عامة على نطاق العمل/ الاحترار العالمي/ الطاقة المتجددة/ تخزين الطاقة/ عملية التفاوض/ من النظرية إلى التطبيق العملي/ أين وجهتنا من هنا؟ / آفاق ما بعد كوبنهاجن.
*- المشكلة وتحديات الوقاية
هناك إجماع واسع النطاق عبر الأوساط العلمية والسياسية على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات بشأن استهلاك الطاقة العالمي. هذا ليس مجرد نقاش نظري؛ بل هو مواجهة للواقع الذي لا يمكن إنكاره بأنماط استخدام الطاقة الحالية تدفع إلى تغيرات عالمية مستمرة، مما يؤدي إلى تدهور بيئي خطير. يلوح شبح الاحترار العالمي غير المنضبط في الأفق، متوعدًا بعواقب وخيمة على كوكبنا وشبكاته المعقدة من الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ضرورة التغيير واضحة، لكن المسار إلى الأمام غير واضح على الإطلاق.
على الرغم من هذا الاتفاق الواسع على ضرورة العمل، هناك فجوة كبيرة من الخلاف عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل: ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها، ومتى يجب تنفيذها، وكيف يمكن توزيع التكاليف الهائلة بشكل عادل. هذا التباين في الآراء ليس مستغربًا عند النظر في التحديات المتعددة الأوجه المعنية، حيث يواجه المجتمع العلمي، وإن كان موحدًا على ضرورة العمل، شكوكًا بشأن المدى الدقيق للتغيرات المتوقعة والجداول الزمنية الطويلة المرتبطة بها. التنبؤ بتأثيرات المناخ المستقبلية بيقين مطلق أمر معقد بطبيعته، ويمكن أن يغذي هذا الغموض العلمي الشكوك ويؤخر اتخاذ القرارات السياسية الحاسمة.
لن يكون الانتقال إلى اقتصاد طاقة جديد ومستدام رخيصًا، فالتكاليف المحتملة هائلة، مما يؤدي إلى قلق مفهوم. يشير البعض إلى أن هذا الانتقال قد يتطلب إعادة تفكير أساسية، أو على الأقل تعديلًا كبيرًا، لنظرياتنا الراسخة حول النمو الاقتصادي. هذا يتحدى النماذج الاقتصادية الراسخة ويثير تساؤلات حول من يتحمل العبء المالي لمثل هذا التحول الجذري. كما يتطلب تنفيذ التغييرات الضرورية مستوى غير مسبوق من التعاون الدولي ودرجة من الاتفاق السياسي الداخلي تبدو بعيدة المنال بشكل متزايد. غالبًا ما تتصادم المصالح الوطنية، وجماعات المصالح القوية والراسخة تقاوم بشدة تغيير النظام القديم. هذه الجماعات، التي تستفيد غالبًا من نظام الطاقة الحالي، تمارس نفوذًا كبيرًا، مما يجعل تحقيق توافق سياسي واسع معركة صعبة.
ربما تكون الحقيقة الأكثر إزعاجًا هي أن المحرك الأساسي للمجتمع الحديث – النشاط الاقتصادي الطبيعي، الذي يشمل النمو، والتنمية، والتجارة، والتصنيع – هو السبب الأساسي لأزمات الطاقة والبيئة. هذا الارتباط الجوهري يعقد البحث عن حلول، حيث يشير إلى أن تحقيق تغيير ذي معنى قد يتطلب إعادة تقييم لنماذجنا الاقتصادية ومحادثة صعبة حول التوازن بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية. إن تحقيق توافق بشأن هذه القضايا العميقة، عندما يكون نسيج حياتنا الاقتصادية نفسه متورطًا، يصبح مشكلة معقدة للغاية يجب حلها. هذه الشبكة المعقدة من الشكوك العلمية، والآثار الاقتصادية الهائلة، والعقبات السياسية الجسيمة، والارتباط المتأصل بين التقدم الاقتصادي والتحديات البيئية، تخلق مشهدًا معقدًا ومتقلبًا. إن معالجة أزمات الطاقة والبيئة العالمية هذه لا تتطلب فقط إجراءات عاجلة، بل تتطلب أيضًا مستويات غير مسبوقة من التعاون والاستعداد لمواجهة الحقائق غير المريحة حول هياكلنا المجتمعية.[3]
والحقيقة أن العقبات التي تعوق وضع السياسات الوطنية والدولية الفاعلة، وهي:
-(1) جماعات المصالح القوية والغنية - ولا تزال - عقبةً أمام الإصلاح الرئيس في اقتصاد الطاقة الموجود.
-(2) توجد اختلافات شديدة في المصالح بين البلدان المتقدمة وبلدان العالم الثالث، التي لا تثق في أيِّ فكرة بالابتعاد عن استراتيجيات التنمية القائمة على التصنيع السريع والاستخدام المكثف لمصادر الطاقة التقليدية.
-(3) التكاليف المحتملة باهظة ولا تلقى قبولًا في فترة الخوف والاضطراب الاقتصادي.
-(4) الرأي العام ليس له (هل يمكن أن نقول حتى الآن؟) صوت قوي يؤدي إلى العمل والتضحية.
-(5) لا يوجد نظام سياسي بارع في اتخاذ الحاجات الطويلة المدى على محمل الجد؛ أيِ البذل الكبير الآن لضمان فوائد مستقبلية أو لتجنُّب أخطار قد لا تقع أبدًا. الخيار الأسهل هو «التحرك دون تخطيط» أملًا في أن يظهر شيء ما، أو أن يتحمل شخص آخَر وزر ما سيحدث.[4]
[1] أندرو دسلر وإدوارد أ. بارسون، تغيُّر المناخ العالمي بين العلم والسياسة: دليل للمناقشة، ترجمة عبد المقصود عبد الكريم، مؤسسة هنداوي، ط.1، 2024م، ص.32
[2] روبرت إل روثستاين ودانيال دي بيرلمتر، تحدِّي تغيُّر المناخ: أيَّ طريق نسلك؟، ترجمة أحمد شكل، مراجعة ضياء ورَّاد، دار هنداوي، المملكة المتحدة، ط.1، 2015م، ص.15
[3] نفسه ص.20
[4] نفسه، ص. 24