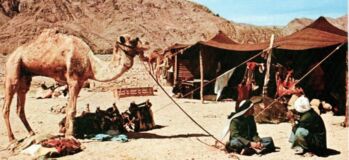عقل الإسلام أم عقل البداوة؟
فئة : أبحاث محكمة
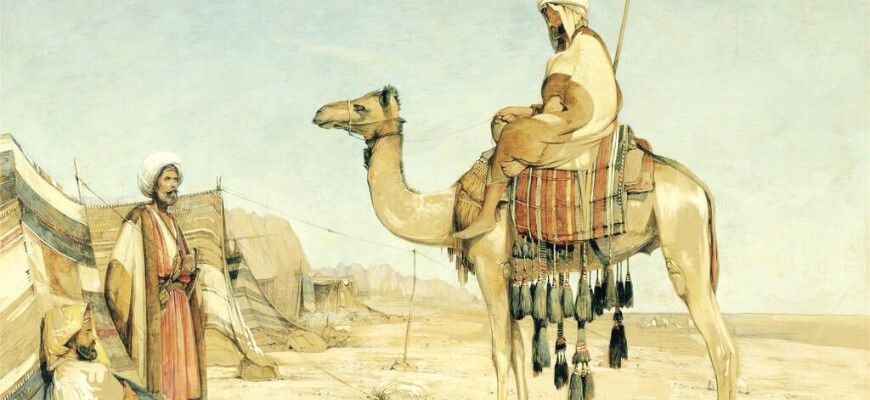
عقل الإسلام أم عقل البداوة؟
«فالعقل غير مستقل البتة، ولا ينبني على غير 'أصل' على الإطلاق، وإنما ينبني على 'أصل' متقدم مُسلَّم على الإطلاق». الشاطبي
في إطار السعي، على مدى ربع القرن الأخير، إلى الإمساك بالجذور المختفية الغائرة للأزمة الجاثمة الراسخة التي انفتح جرحها الموجع على أثر الهزيمة العربية المُذِلَّة في ستينيات القرن المنصرم؛ وأعني غير تلك الجذور التي كان قد عرَّاها سيل النقد الإيديولوجي الجارح الذي تسيَّد الفضاء العربي على مدى السنوات اللاحقة للهزيمة، فإنه قد جرى اكتشاف مفهوم «العقل» -الذي يفكر به العرب- بوصفه واحداً من الجذور الحية التي تغتذي منها تلك الأزمة التي يتزايد تفاقمها باطراد ملفت. وإذ كان لابد أن يصبح هذا المفهوم، منذئذ، موضوعاً لحفر يتغيا تعيين بنيته ونظامه طرائق اشتغاله وآليّاته، والسعي إلى الإمساك بتاريخه واكتشاف أصوله من داخل الإسلام، ومن خارجه، فإن ما راح يلفت النظر، حقاً، في هذا العمل الحفري هو ما بدا وكأنه تعمد تجاهل حقبة «البداوة» -ما قبل الإسلامية- كأحد الساحات الجديرة بإجراء هذه الأركيولوجيا المعرفية فوقها.
وهكذا، فرغم الاتساع الهائل، مكانياً وزمانياً، لمجال هذا العمل الأركيولوجى الذي تمدد مكانياً ليشمل كافة المراكز الحضارية في الشرق القديم (إنطاكية وحران ونصيبين وأفامية وجنديسابور والإسكندرية وغيرها)، وامتد زمانياً إلى العصرين الهليني والهلنستي، بل وحتى إلى تاريخ العقل في المجتمعات الكتابية السابقة على الإسلام، فإن حقبة البداوة التي سادت شبه الجزيرة، حيث انبثق الإسلام، لم تكن موضوعاً لعمل أركيولوجي من أي نوع. ومن هنا، فإنّه إذا كان صاحب «تكوين العقل العربي» يقرر أن «العقل العربي هو البنية الذهنية الثاوية في الثقافة العربية كما تشكلت في عصر التدوين»[1]، وبما يعنيه ذلك من التماس أصول ذلك العقل من داخل «النسق المدوَّن أو المكتوب» في الإسلام فقط، وليس أيضاً في «النسق الأنثروبولوجي المُعاش» السابق عليه، فإن صاحب «العقل الإسلامي» لا يرى لهذا العقل أصولاً خارج ظاهرة «الوحي» التي هي أهم محددات ما يمكن اعتباره عقلاً ثيولوجياً «شغَّالاً وفعَّالاً ماضياً وحاضراً في كل مجتمعات الكتاب»[2]، حيث يحصر هذا العقل «تساؤلاته وتحرّياته وإنجازاته داخل الحدود المنصوص عليها من قبل ظاهرة الوحي المسجّلة في الكتب المقدسة: توراة، إنجيل، قرآن، وهي الكتب التي شكّلتها الأمم المفسّرة في الأديان الثلاثة على هيئة نصوص رسمية»[3]. وهكذا، فإن القصد يتجه هنا أيضاً إلى التماس أصول ذلك العقل في «الثيولوجي»، وليس في الأنثروبولوجي؛ وبما يعنيه ذلك من أن التباين في وصف العقل بالعربي أو بالإسلامي لا يلغي الاتفاق على رد هذا العقل إلى التراث المكتوب في الإسلام. وإذا كان الفرض المضمر في تلك الحفريات المعرفية المهمة هو أن ذلك الأنثروبولوجي «البدوي» لم يكن يملك ما يمكن أن يسهم به في إضاءة تاريخ العقل في الإسلام، فإن القراءة التي تعرض لها هذه الدراسة تجادل، في المقابل، بأن هذا المسكوت عنه الأنثروبولوجي قد لعب الدور الأبرز في بناء العقل في الإسلام، ولو كان ذلك من خلال توجيهه الحاسم لبناء وتدوين التراث المكتوب.
وهكذا، فإنه ورغم ما تحفل به الكتابات العربية القديمة والحديثة من شيوع توظيف مفهوم البداوة كأداة تحليل مهمة، وعلى درجة عالية من الكفاءة التفسيرية، لكل من تجربة التاريخ والسياسة في الإسلام[4]، فإن ما يلفت الانتباه حقاً هو الغياب الكامل لذلك المفهوم في حال تعلُّق الأمر بتحليل ظاهرة العقل، أو حتى بتفسير الظاهرة المعرفية في الإسلام على العموم. ومن هنا، فإنّ مجال تحليل تلك الظاهرة (المعرفية) لم يتجاوز حدود ما هو مشهور من الارتداد بها إلى مصادر لها في نصوص الإسلام المؤسِّسة أو خارج فضاء الإسلام (عند اليونان والفرس وحتى الهنود والرومان)، وبالطبع مع السكوت عن أي دور يمكن أن تكون حقبة البداوة السابقة قد لعبته في بناء تلك الظاهرة. ويُصار في تفسير ذلك إلى أن شيئاً من فلسفات أو أفكار كبرى، يمكن أن يكون قد لعب دوراً في بناء الظاهرة المعرفية التي سادت في الإسلام، لم يتخلف عن حقبة البداوة، بل إنه قد استقر التقليد على وصمها بحقبة «الجاهلية»؛ الأمر الذي كان لابد معه من القطع بأنها ليست خلواً فحسب مما يمكن أن ترفد به الإسلام من الأفكار والمفاهيم الكبرى[5]، بل والحكم عليها بكونها النقيض المرذول الذي جاء الإسلام يسعى إلى رفعه، والانبناء كلّياً خارج حدود نظامه. وهكذا، فإنه وبالرغم من أن الإسلام قد استبقى الكثير من قيم البداوة وممارساتها المعاشية وطقوسها التعبُّدية والشعائرية[6]، فإنه، وعلى صعيد النظام أو البنية المعرفية بالذات، لم يرث عنها -بحسب الافتراض السائد- أي شيء ذا بال، ليس لأنه قد اختلف مع ما قدمته له على هذا الصعيد فحسب، بل لأنها -وهو الأهم- لم تكن تملك ما يمكن أن تقدمه له أصلاً.
وانطلاقاً من استحالة أن يشتغل مفهوم ما على ساحة ما (كالسياسة والتاريخ مثلاً)، ثم يغيب كلّياً عن الاشتغال على ساحة أخرى (كالمعرفة) تشترك مع الأولى في التحقق والانبناء داخل نفس التجربة (التاريخية) الأوسع من جهة، وابتداءً كذلك من ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لذلك التداخل غير القابل للانفصام بين السياسي والمعرفي في الإسلام، من جهة أخرى، فإنه يمكن الذهاب إلى أن مفهوم البداوة قد اشتغل -وكان ذلك لازماً[7]- على الساحة الثقافية والمعرفية في الإسلام، ولكن بكيفية مخالفة لتلك التي اشتغل بها في ساحات المجتمع والسياسة مثلاً؛ وأعني من حيث إنها (أي هذه الكيفية) كانت بالغة النعومة والمراوغة، وبالشكل الذي لم يقدر معه الوعي على الإمساك بقواعد اشتغالها إلا متأخراً جداً. فلقد كان لزاماً على الوعي أن ينتظر إلى أن يتم التمييز في «فعل المعرفة» بين مضمونه الظاهر (القابل للتعيين والتحديد والإمساك به) ونظامه الكامن (المتخفي تحت سطح ذلك المضمون القابل للتعيين) ليتسنّى له الإمساك بالكيفية التي اشتغلت بها البداوة على ساحة الإسلام المعرفية، لا من خلال المضمون الظاهر المتعيِّن في شكل أفكار ومفاهيم كبرى ملموسة، يكاد يتفق الكافة على الغياب الكلّي والشامل لها من عالم البداوة، بل من خلال تسريبها لآلياتها وطرائقها في التفكير والإنتاج المعرفي. وإذ يحيل ذلك إلى أن تغييب مفهوم البداوة عن سياق تحليل الظاهرة الثقافية والمعرفية في الإسلام، إنما يرتبط بما ساد من تصور الفكر مُختزلاً في مضمونه (الظاهر) القابل للتعيين؛ وأعني من الأفكار والمفاهيم المحددة، وليس بما هو بنية ونظام شفافان لا يظهران على نحو مباشر، رغم اختراقهما للمضمون وإمساكهما به على نحو يستحيل فهمه دونهما، فإنه يمكن أن نخلص من ذلك إلى أن الاتساع بمعنى الفكر ليستوعب، بالإضافة إلى مضمونه (الظاهر)، نظامه وآلياته وطرائقه (المتخفية) في التشكُّل والانبناء يمكن أن ينكشف عن دور مركزي لعبته البداوة، بالفعل، في بناء الظاهرة المعرفية في الإسلام، وإلى حد يمكن معه التأدي إلى الاستغلاق شبه الكامل لتلك الظاهرة أمام التحليل، في حال غياب مفهوم البداوة. وبالطبع، فإن ذلك يعني أن كون البداوة لم تكن تملك ما تقدمه، للظاهرة المعرفية في الإسلام، على صعيد «المضمون»، لم يمنعها من أن تسرِّب لتلك الظاهرة أهم وأخطر ما تنبني عليه؛ وأعني به نظامها وطريقتها في التفكير وإنتاج المعرفة. وفقط فإنه كان عليها أن تنتظر إلى حين إتمام التمييز -الذي لم يتحقق إلا متأخراً- في الفعل المعرفي بين مضمونه ونظامه، لكي يصبح الوعي بحضورها وكيفية اشتغالها ممكناً، وهو الحضور الذي تعدت فيه فاعليتها حدود الإسلام إلى ما بعده من عالم الحداثة وما بعدها مما يثرثر العرب بمفرداته الزاهية الآن.
ومن هنا ما تدافع عنه هذه القراءة، هو أن نظام العقل العربي[8] السائد؛ وأعني به ذلك الذي يحدد كافة أشكال وضروب الممارسة العربية الراهنة، ويتجلى فيها في الآن نفسه، إنما يجد ما يؤسسه كاملاً في نظام للتفكير يضرب بجذوره، لا في عالم الإسلام فحسب، بل وكذا في العالم الأبعد السابق عليه. وإذ يعني ذلك أن انقطاعاً معرفياً لم يتحقق، على صعيد آليات وطرائق إنتاج المعرفة، بين كلا النظامين للآن، فإنه يكشف عن أن ما بات يُعرف، على مدى القرنين المنصرمين، بخطاب الحداثة العربي قد جرى استيعابه بحسب نظام ذلك العقل المتحدِّر من عوالم قديمة أبعد؛ الأمر الذي يقطع بالمتواتر من أن الحداثة العربية لم تكن حداثة «نظام عقل وطرائق تفكير»، بقدر ما كانت -في الجوهر- حداثة «مضمون جديد» وجد العرب أنفسهم واقعين في أسره مبهورين -أو حتى مضطرين تحت وطأة الضغوط الأوروبية العاتية- فراحوا يفكرون فيه بنفس النظام المعرفي المنسرب إليهم من نسق ثقافتهم الذي يضرب بجذوره في أعماق القديم. وهكذا، فإن ما يظهر جليّاً على سطح الممارسة الراهنة، من عقل لا يعرف إلا أن يفكر بنموذج جاهز متقدم ومسلَّم به كأصل شارط لأي تفكير لاحق[9]، لا يعدو أبداً كونه مجرد امتداد لذلك العقل المنسرب من غابر الأحقاب، والذي جرى القطع -على قول «الشاطبي» في مفتتح تلك القراءة- بأنه «لا ينبني على غير أصل على الإطلاق»، وهو العقل الذي ترسَّخ على مدى القرون من دون انقطاع، بعد أن تحققت له الهيمنة في الإسلام؛ وذلك بالرغم مما سيجليه التحليل عن كونه (أي ذلك العقل) يضرب بجذوره الأعمق في ثقافة العالم السابق الذي يُقال إن الإسلام قد جاء -وللمفارقة- لكي يقوّضه ويعلن نهايته.
وإذ يحيل ما سبق إلى إمكان التمييز في العقل ذاته (وأعني أيّ عقل بالطبع) بين مضمون ظاهر ونظام كامن، فإنه يمكن القول إنه فيما أمكن للعقل العربي أن يحقق الانفصال، إبان القرن التاسع عشر، مع المضمون الذي اشتغل عليه على مدى قرون سابقة، فإنه قد عجز عن القطع مع آليات وطرائق إنتاج المعرفة التي ظلت -رغم انتسابها إلى تلك القرون الماضية- هي المحددة لطبيعة بنائه. لذا، يُشار إلى أنه فيما تنصرف دلالة المضمون إلى قاموس الأفكار والمفردات والمفاهيم التي يسعى من خلالها العقل إلى مقاربة واقعه في لحظة ما، فإنه يبدو أن تحولاً قد طرأ، بالفعل، على هذا القاموس منذ بدايات القرن التاسع عشر، وحيث حلت مفاهيم ومفردات جديدة (وأعني من قبيل التمدُّن والترقي والتنظيمات والدساتير المُقيدة للحكومة والانتخاب وغيرها) محل مفاهيم السياسة الشرعية (الراعي والرعيَّة والبيعة وأهل الحل والعقد وغيرها) التي ظل العرب يقاربون عالمهم من خلالها على مدى قرون سابقة. وأما طرائق وآليات اشتغالهم المعرفي، فإنها قد ظلت ثابتة من دون أن يطالها أي انقطاع. وفي كلمة واحدة، فإن ما قطع معه العقل العربي بالفعل، وإن على نحو نسبي بالطبع، كان هو ما «يشتغل عليه وفيه» من مضامين ومفاهيم ظاهرة. وأما ما «يشتغل به» من طرائق وآليات ونظام معرفي كامن، فإنه قد ظل عصياً على الانقطاع للآن.
وإذ يتحدد العقل، جوهرياً، بنظامه في التفكير، وليس أبداً بالمضمون الذي يشتغل عليه -أو حتى ينتجه- هذا النظام، وإلى الحد الذي يكاد ينصرف معه جوهر العقل إلى محض نظامه وطرائق وكيفية اشتغاله، والتي هي الأصول التي يكتسب منها المضمون (المُفَكَّر فيه) شكل حضوره ومدى إنتاجيته في الواقع، فإنه يلزم التأكيد أن هذا النظام ذاته، لا ينبثق أولانياً كانبناء ذاتي للعقل، بقدر ما هو تكوين في قلب ثقافة ما، وبما لابد أن يؤول إليه ذلك من إن العقل هو -بهذه الكيفية- تكوينٌ، لا معطى، وفاعلية وصيرورة، وليس جوهراً أو كينونة تفرض نفسها أولانياً كبناء جاهز[10]. وبما هو حدثٌ وفاعلية تتحقق داخل ثقافة بعينها، فإن العقل لابد أن يحمل ثوابت ونظام تلك الثقافة بالطبع، وإلى حد ما يبدو من أن هذا النظام الخاص بالثقافة ينطبع -كالوشم- على قسمات وملامح ذلك العقل. وهكذا، فإن عقلاً يشتغل على نحو ما (أسطوري سحري أو تفسيري علمي أو تبريري نصي)، لا يكون محكوماً في كيفية اشتغاله تلك، بما ينتمي إلى طبيعة ذاته (التي هي أدنى إلى مجرد قابلية للتشكُّل)، بل بما ينتمي إلى طبائع الثقافة التي يحدث داخلها هذا التشكُّل بالأحرى؛ ذلك أن الفرد الذي يتحدد «فيزيقياً» بالوسط الطبيعي المحيط به، إنما يتحدد نظام اشتغاله «العقلي» -بالمثل- بالوسط الثقافي الذي يجد نفسه منخرطاً فيه، كجزءٍ منه. وبالطبع، فإن ذلك يتجاوب مع تصور للعقل (بمعناه الفردي) أدنى إلى مجرد الإمكانية أو الصفحة البيضاء التي يخط عليها نظام الثقافة (أو العقل المجاوِز لما هو فردي) -وليست فقط تجربة «فرانسيس بيكون» الشهيرة- سطوره وثوابت بنيته العميقة[11].
وحين يُضاف إلى ذلك أن نظام الثقافة يكاد يكون، هو ذاته، استجابة لإشكاليات واقع ما، فإن ذلك يؤول إلى وحدة الهوية بين كل من العقل والثقافة والواقع، وعلى نحو ينحل فيه التعارض بينها جميعاً، وإلى حد ما يبدو من أن الواحد منها يكاد يحدد الآخر، ويتحدد به على نحو كامل. ومن ثمة، فإن «التاريخ» يتبدى بوصفة القوة الجبارة التي تنتج المطابقة بين كل من العقل والواقع؛ وأعني من حيث إن ما جرى من تصور الواقع -مثلاً- كصيرورة، انطلاقاً من كونه مجرد نتاج لوعي الإنسان وفعله في العالم -واللذين لا يمكن تصورهما أبداً خارج دائرة التجاوز والتخطي الدائمين؛ وذلك ابتداءً من إنسانيتهما بالذات- كان لابد أن يقترن بتصور العقل هو، بدوره، صيرورة أو قوة نفي ورفض لكل وضع قائم يتصوره مُنتجوه كاملاً ونهائياً؛ وبما يعنيه ذلك من دخول التاريخ كمكون جوهري في بناء كل من العقل والواقع في آن معاً[12]. وبالطبع، فإن الثقافة تبقى هي الفضاء الواسع الذي تنفتح فيه هويات كل من العقل والواقع والتاريخ على بعضها بعضاً، وإلى حد ما يبدو من انصهار هذه المقولات جميعاً فيها. وإذ يلعب كل من الواقع والتاريخ، والحال كذلك، دوراً في بناء العقل عبر وساطة الثقافة، فإن في ذلك ما يعزز القول بأن العقل ليس جوهراً مفارقاً أو قوة تفرض نفسها من الخارج، بقدر ما هو حدثٌ في الثقافة التي تتبلور، بدورها، كحدثٍ في واقع ما، داخل لحظة تاريخية بعينها؛ وبما يؤول إليه ذلك كله من ضرورة الإمساك بالعقل داخل تاريخه، وليس أبداً خارجه. وإذن، فإنه ليس من قبيل العقل الصوري؛ الذي هو أدنى ما يكون إلى عقل أولاني لا تاريخي، بل هو العقل التكويني الذي يكون قاراً في قلب تجربة يتعذر فهمه خارجها.
وابتداءً من ضرورة تباين أنظمة الثقافة، بحسب تباين إشكاليات الواقع والتاريخ، فإن ذلك لابد أن يؤدّي إلى وجوب تباين العقول واختلافها (زمانياً ومكانياً). ولعل القيمة القصوى لذلك لا تتأتى، فحسب، من تفسير التباين بين عقل (بالمعنى الحضاري الجمعي) وآخر، بل ومن حيث ما يقدمه ذلك، من إمكان تصور العقل مفهوماً دينامياً يقبل الصيرورة والتغيُّر، وليس كياناً جامداً أو هوية مغلقة لا تقبل التحوُّل والتطور. وإذن، فالأمر لا يتعلق فحسب بما يشير إليه ذلك من جوهرية التباين بين عقول متعاصرة تنتمي، في لحظة واحدة، إلى وحدات حضارية مختلفة (كالإسلامية والآسيوية والأوروبية مثلاً)، بل وبما يدل عليه -وهو الأهم- من إمكان -بل لزوم- التباين، عبر زمان ممتد، داخل تاريخ عقل واحد كالعقل العربي الإسلامي مثلاً. وإذ يحيل ذلك إلى إمكان أن تحدث انقطاعات داخل تاريخ عقل بعينه؛ فإنه يلزم الوعي بأن الأصل في حدوثها يقوم في عجز نسق الثقافة الذي ينتسب إليه هذا العقل، ويتكون داخله، عن تقديم إجابات منتجة لما يطرحه الواقع من أسئلة وتحديات على الجماعة الحضارية الحاملة لهذا النسق، وعلى نحو يندفع معه الوعي إلى التماس تلك الإجابات من خارج ذلك النسق الذي استنفد طاقته وبات نسقاً خاملاً مُغلقاً. وإذ تظل تلك الإجابات تتراكم خارج إطار النسق القائم (والذي بات خاملاً)، فإنها -وعبر ذلك التراكم بالطبع- تتمخض في النهاية عن تشكّل نسق ثقافي بديل، ينبثق داخله عقل مغاير لذلك الذي يقترن بالنسق المُزاح الذي يصبح -والحال كذلك- جزءاً من التراث المملوك للجماعة. وإذ يقع الانقطاع، هكذا، فإنه يتحقق من داخل تاريخ العقل نفسه، ومن دون أن يكون أبداً من خلال التموضع ضمن تاريخ عقل آخر (أو مرحلة متأخرة في مسار تطوره بالأحرى)[13]. ولعل منطقية حدوث ذلك الانقطاع داخل تاريخ العقل نفسه، تتأتى من أن الثقافة هي فضاءٌ تتوزع وتتناثر فيه أنساق متباينة يعبر كل واحد منها عن رؤية محددة للعالم (مشروطة تاريخياً ومعرفياً). وعلى الرغم من أن واحداً من تلك الأنساق يقوم، على مستوى السياسة والثقافة، بطرد ما عداه، محققاً لهيمنته المنفردة على ساحتهما (وهو النسق الذي لابد أن يتبلور داخله العقل السائد في الثقافة)، فإن الأنساق المُهمشة الطريدة تبقى حاضرة، ولو كأنقاض مبعثرة، داخل النسق المهيمن؛ وبما يعنيه ذلك من حضورها، على نحو ما، ضمن تركيب العقل المُتكوِّن داخل هذا النسق ذاته. وإذن، فإنها تظل جزءاً من تاريخ العقل المهيمن، حتى ولو كان -هذا التاريخ- تاريخاً للنبذ والتهميش والإقصاء. ولعل ما يبدو من كون العقل يلعب دوراً فاعلاً في تشكيل نسق الثقافة الذي ينبثق كبديل لذلك الذي دخل إلى دائرة التكرار والجمود، بعد أن فقد قدرته على تقديم إجابات منتجة لإشكاليات تظل، لذلك، راسخة الحضور، ليكشف عن حقيقة أن العقل لا يكتفي أن يتحدد بأنظمة الثقافة من جانب واحد، بل إنه يحددها أيضاً، وإن في لحظة بعينها على الأقل، وعلى نحو لابد أن يؤول إلى جدلية العلاقة بين العقل من جهة، وبين نسق الثقافة الذي يتبلور داخله، من جهة أخرى.
وإذ يؤول ذلك إلى أن تحليل نظام الثقافة هو، في الآن نفسه، تحليل لنظام العقل المنبني داخلها، وبما يعنيه ذلك من استحالة أي قول عن العقل بمعزل عن الثقافة التي يتبلور فيها، فإن أي قولٍ عن العقل في الإسلام لا يمكن أن ينبني بمعزل عن القول في الثقافة التي تبلور بحسب نظامها[14]. وإذ لابد أن يُصار إلى أن تلك الثقافة التي تبلور العقل في الإسلام داخلها، لا يمكن أن تكون إلا «الثقافة الإسلامية» بالطبع، فإن التمييز، هنا، يبدو لازماً حقاً، بين مفهوم «الثقافة الإسلامية» من جهة، ومفهوم «الثقافة التي سادت في الإسلام» من جهة أخرى. فإذ ينصرف مفهوم «الثقافة الإسلامية» إلى ذلك الفضاء الرحب الفسيح الذي توزعت فيه أنساق شتى يعبر كل واحد منها -انطلاقاً من موقعه التاريخي الاجتماعي الخاص- عن رؤية للعالم تختلف عن تلك التي يعبر عنها الآخر؛ ولكن من دون أن يسعى الواحد منها إلى إقصاء الآخر ونفيه، بل يتحاور ويتفاعل مع غيره، وبكيفية يحدد فيها الواحد منها الآخر ويتحدد به في آن معاً، فإن مفهوم «الثقافة التي سادت في الإسلام» ينصرف إلى ما يكاد أن يكون النقيض الكامل لهذا المعنى؛ وأعني من حيث يحيل إلى أن واحداً من هذه الأنساق قد راح يُضيِّق حدود هذا الفضاء الرحب عبر الاستيلاء منفرداً على ساحته الواسعة بالكامل؛ وأعني مُقصياً لغيره، ومُلقياً به إلى خارج حدود الأمة والملة معاً[15]. وليس من شك في أن عقلاً يتبلور ضمن سياق «التفاعلية» التي يحيل إليها مفهوم «الثقافة الإسلامية» المنفتح بلا ضفاف؛ وإلى حد اتساعه لكل ما جرى إنتاجه داخل تلك الثقافة ولو من غير المسلمين، لابد أن يختلف جذرياً عن عقلٍ يتبلور ضمن حدود التسلطية التي تلازم الإقصائية الكامنة في مفهوم «الثقافة المهيمنة في الإسلام».
وإذا كان ما جرى الاصطلاح على أنه العقل الإسلامي قد تبلور -لسوء الحظ- داخل فضاء نسق الهيمنة الإقصائي التسلطي الذي ساد الإسلام وتخفَّى -وهو الأخطر- تحت قناعه، فإن ذلك يعني استحالة اعتباره «العقل الإسلامي»، بقدر ما يصح القول بأنه «العقل الذي تحققت له السيادة العليا في الإسلام». لذلك، وجب التمييز بين كلا المفهومين؛ وأعني من حيث إنه فيما يحصر مفهوم «العقل الإسلامي» وصف «الإسلامي» في عقل بعينه تحققت له السيادة في الإسلام بالفعل، وحيث يبدو وكأنه، لا مجرد «عقل» من بين عقول أخرى تتشارك معه في إظهار ما ينطوي عليه الإسلام -الذي تنتسب إليه جميعاً- من ثراء وتنوع، بل يكون هو وحده «العقل الإسلامي» بألف لام العهد؛ وذلك ابتداءً من كونه العقل الذي صاغه -أو بالأحرى فرضه- الإسلام كأحد تجلياته ولوازمه[16]، وبما يعنيه ذلك من احتكاره وحده لوصف «الإسلامي»، وعلى نحو كان لابد معه أن يُلقي بغيره (منبوذاً ومتسربلاً برداء الخروج والهرطقة) خارج حدود هذا الوصف. والحق أن هذا المفهوم يؤول إلى استحالة أن يقدر الوعي على الإحاطة بمآلات العقل في الإسلام؛ وأعني من حيث يرتد بأصل العقل، ابتداءً من مطابقته مع الإسلام، إلى المثالي والمتعالي المفارق، وليس إلى ما جرى في تاريخه بالفعل. والحق أن الأمر لا يتعلق أبداً بعقل قد فرضه الإسلام وكأنه أحد أسسه وأركانه، حيث لا وجود لمثل هذا العقل أبداً، بقدر ما يتعلق بعقل اتخذ من الإسلام ساحة لاشتغاله وبناء هيمنته.
وهنا، بالذات، تتبدى الكفاءة التفسيرية لمفهوم «العقل الذي ساد في الإسلام»؛ وأعني من حيث يتكشَّف عما يبدو وكأنه تاريخ تحقيق هذا العقل لهيمنته وسيادته. وحيث يبدو -تبعاً لهذا المفهوم- أن عقلاً من بين عقولٍ أخرى، كانت ممكنة مثله، قد ارتفع إلى مقام السيادة العليا في الإسلام؛ وذلك بفضل شروط ينبغي التماسها داخل تاريخه، وليس أبداً خارجه. ولأنه قد راح يرتقي إلى ذلك المقام، ليس فقط عبر الإقصاء الدؤوب للعقول المغايرة عبر وصمها بالابتداع والضلال، بل وأيضاً عبر ترسيخ المخايلة بتطابقه وتماهيه مع مقدس الإسلام الذي كان لابد أن يستحيل، تبعاً لذلك، إلى مجرد ساحة لهيمنته المنفردة، فإنه قد راح يُضيِّق الساحة الرحبة للإسلام، وحيث لم تعد رقعتها الواسعة تتجاوز الحدود التي يقف عليها ويفرضها هذا العقل الجامد المغلق. إنها المطابقة، لا بين العقل والإسلام (بما هو النموذج والمثال)، بل بين العقل وتاريخه، هي ما يرسخه مفهوم «العقل الذي ساد في الإسلام». والحق أن الارتداد بذلك العقل الذي تحققت له السيادة في الإسلام، إلى تاريخه الفعلي وليس إلى هوية مثالية مفترَضة، أو بالأحرى مُتخيَّلة، ليكشف عن عقل يسعى إلى إخفاء ذلك التاريخ المُثقل بضروب من الصراع والتخفي والمراوغة؛ وذلك ليخايل بأسباب لهيمنته تسكن خارج ما يطفح به هذا التاريخ من عنف ودنس؛ الأمر الذي تتحصن معه تلك الهيمنة ضد ما يجعلها موضوعاً للتفكيك والإزاحة. والملاحظ أن تاريخ هذا العقل يكشف، بجلاء، عن أنه لم يحقق الهيمنة؛ لأنه كان وحده «الإسلامي»، بل إنه قد أصبح وحده الموصوف بأنه «الإسلامي»؛ لأنه كان قد حقق -بالأحرى- هيمنته المطلقة قَبْلاً. ومن هنا، لو كانت المصادفة قد حققت الهيمنة لعقل آخر غيره، لكان هذا العقل (الآخر) -وعلى فرض ربطه لهيمنته بطرد ما سواه- قد احتكر لنفسه وصف «الإسلامي»، وألصق بكل عقل سواه -ومن بينها ذلك (العقل المهيمن) الذي لا يكف عن الادعاء بأنه هو «الإسلامي» وحده- وصمة «العقل الهرطقي»[17]. وإذ يدفع ذلك إلى تصور أنه كان ممكناً أن ينبني عقلٌ آخر في الإسلام، على نحو مغاير بالكلية لنظام ذلك العقل الذي تحققت له السيادة داخله بالفعل، فإن لذلك الإمكان أهميته القصوى، وخصوصاً مع الوعي بما سوف يجليه التحليل، لاحقاً، من أن ما ساد في الإسلام (سواء كان نسقاً ثقافياً أو عقلاً مقارناً له) قد تبلور مسكوناً -وللمفارقة- بروح ما جاء الإسلام يسعى لرفعه، بأكثر مما كان تجلياً لجوهر الإسلام نفسه. ومن هنا، فتحقيق العقل الذي ساد في الإسلام لهيمنته، إنما يرتبط بتجاوبه، في العمق، لا مع الإسلام، بل مع نظام الثقافة التقليدي الذي انسرب من عالم البداوة السابق عليه، وهو العالم الذي وصمه الإسلام، وللمفارقة، بالجاهلية. وهكذا تترسخ استحالة أي قول عن العقل في الإسلام بمعزل عن المهاد الأنثروبولوجي الأسبق الذي يجد فيه هذا العقل أصوله من جهة، وبعيداً عن التاريخ الصراعي الذي حقق فيه هيمنته داخل الإسلام، من جهة أخرى.
ومن هنا، فإنّ نقطة البدء في اكتناه نظام العقل الذي ساد في الإسلام، تنطلق من الوعي بما سبق الإلماح إليه من أنه يحمل ملامح عالم ما قبل الإسلام. والغريب حقاً أن يكون العقل نفسه قد استحال، وابتداءً من مجرد تعريفه في اللغة، إلى ساحة للصراع بين الإسلام وبين العالم السابق عليه[18]. وعليه، يجدر التنبيه إلى ما سرَّبته اللغة، عبر سلطة التسمية (التي هي غير بريئة في معظم الأحايين)، إلى العقل من ملامح العالم السابق على الإسلام، والتي يبدو أنها لم تفارق طبيعة بنائه حتى الآن. فإذ العقل، في اللغة، «مأخوذ من عقال البعير (لأنه) يمنع ذوي العقول من العدول عن سواء السبيل»[19]، فإن ذلك يكشف عن مركزية الدور الذي لعبته البداوة في تحديد العقل منذ البدء؛ وأعني من حيث جعلت البعير[20] -الذي هو مركز محيطها وأساس وجودها كله- هو أساس التحديد اللغوي للعقل وأصله. ولسوء الحظ، فإن الأمر لم يقف عند مجرد تحديد البداوة للعقل «لغوياً»، بل ويتجاوز إلى الدور الذي لعبته في تحديده «بنيوياً» أيضاً؛ وبما يعنيه ذلك من أن بنية العقل ونظامه الكامن هي انعكاس، في الجوهر، لنظام عالم البداوة. وإذا كان التحديد اللغوي للعقل قد جعل منه «قيداً» ابتداءً من اشتقاقه من «عقال البعير»، فإنه قد تحدد بنيوياً -وقبل ذلك وظيفياً- كقيد يكبل حامله بسلطة الآباء الأوائل والأسلاف الغابرين. ولعل ذلك ما تؤكده حقيقة أن البداوة تعود فتربط هذا العقل بالتقليد؛ إذ ترتد بأصلهما اللغوي معاً إلى مجال دلالي واحد يتعلق بضبط البعير وإسلاس قياده[21]. ورغم ما يبدو من تسرّب هذا النظام البنيوي للعقل إلى العقل المهيمن في الإسلام[22]، فإن المفارقة تنبثق زاعقة، من حقيقة أن المجال التداولي للفظة العقل في القرآن الذي هو نص الإسلام التأسيسي الأول، يكاد ينطوي على ما يناقض الدلالة الظاهرة لذات اللفظة في اللغة، والتي تطفح بما يربطها بعالم البداوة. وإذا كانت دلالة اللفظة الظاهرة في اللغة تنطوي على ما يدنيها من معنى «القيد أو سلطة الضبط المفروضة من الخارج»؛ وأعني من حيث إن عِقال البعير المأخوذة منه اللفظة، هو قيدٌ يتم ربطه من الخارج، وليس قوة تحديد من الداخل، فإن تداول اللفظة، في القرآن، يحيل إلى تصور العقل، لا بحسبانه «فعل تقييد»، بل بما هو «فاعلية إدراك»[23]، وعلى النحو الذي يدنيه -بدلالة فعل الإدراك- من أن يكون، في الجوهر، «فعل تحرير»، وبما يتجاوب مع تصور الدين نفسه كفعل تحرير في الأساس. والحق أنه وحتى حين بدا أن ثمة من راح يشتق تسمية العقل من فعله؛ لأنه إنما قد «سُمي عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك»[24]، فإن دلالة الضبط والتقييد لم تفارق هذا الاشتقاق بدوره؛ وبما يعنيه ذلك من الهيمنة الكاملة لتصور العقل، في اللغة، كقوة «للتقييد السلوكي والأخلاقي»، في حين يغلب تصوره كفاعلية «إدراك -وبالتالي تحرير- معرفي» في القرآن[25]. وبالطبع فإن العقل يكون، ضمن هذا السياق، قوة تحرير من «سلطة الآباء الغابرين» التي حمل عليها القرآن بلا هوادة؛ لأنها كانت العائق الأهم أمام الإنصات لوحيه، وهي السلطة التي اقتضت صياغة للعقل، في عالم البداوة السابق، كقيد لا يسمح لحامله بغير الخضوع لسطوتها[26]. لذا، يكون الإلحاح على التقيُّد بسلطة الأسلاف، في مقابل السعي إلى نقضها والتحرر من سطوتها هو جوهر التقابل بين عالمين وتصورين للعقل[27]؛ وبما يؤكده ذلك من أن تاريخ الواحد من العقل أو الواقع، يكاد أن يكون تاريخاً للآخر.
وعلى الرغم مما يبدو وكأن القرآن، هكذا، قد راح يسعى إلى ترسيخ دلالة للعقل على أنقاض دلالة ترسَّخت على مدى القرون قبلاً، فإنه يبدو -وللمفارقة- أن تلك الدلالة التي اتجه القصد إلى إزاحتها قد اخترقت الإسلام، ولعبت دوراً مركزياً في صياغة العقل الذي ساد داخله. ولأنه كان لزاماً أن يتبلور هذا العقل حاملاً -كالوشم الذي لا ينمحي- لثوابت العالم الذي انبثق فيه، فإن وعياً بطبائع عالم البداوة يكون هو السبيل إلى اكتناه نظام هذا العالم وسياق تشكُّله وانبنائه. وإذ تشير طبائع العمران البدوي، بحسب أهم مُنظِّريه على الإطلاق، إلى أن العرب «بطبيعة التوحش الذي فيهم أهل انتهاب وعيث، ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر، ويفرون إلى منتجعهم بالقفر، ولا يذهبون إلى المزاحفة والمحاربة إلا إذا دفعوا بذلك عن أنفسهم. فكل معقل أو مستصعب عليهم فهم تاركوه إلى ما يسهل عنه، ولا يعرضون له. والقبائل الممتنعة عليهم بأوعار الجبال بمنجاة من عيثهم وفسادهم، لأنهم لا يتنسمون إليهم الهضاب، ولا يركبون الصعاب، ولا يحاولون الخطر. وأما البسائط متى اقتدروا عليها بفقدان الحامية وضعف الدولة، فهي نهب لهم وطعمة لأكلهم، يرددون عليها الغارة والنهب والزحف لسهولتها عليهم، إلى أن يصبح أهلها مُغَلَّبين لهم... فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناس، وأن رزقهم في ظلال رماحهم، وليس عندهم في أخذ أموال الناس حد ينتهون إليه، بل كلما امتدت أعينهم إلى مال أو متاع أو ماعون انتهبوه»[28]، فإن ذلك يكشف عن أن البداوة، كأحد أنماط العمران، لم تعرف إلا التعيُّش على «الجاهز» الذي ينتجه الغير، ومن دون أن تتجاوز «الفاعلية» التي يمارسها البدوي، في إطار نمط عمرانه، حدود انتهاب هذا الجاهز واستهلاكه، ليس فقط من دون حد ينتهي إليه في ذلك، بل ومن دون معاناة أي جهد تقريباً. فهو إذ يمارس الانتهاب «من غير مغالبة ولا ركوب خطر؛ (لأن) كل معقل أو مستصعب عليه فهو تاركه إلى ما يسهل عنه»، فإنه يكون بذلك قد تنزَّل بما يمارسه من الفاعلية إلى الحدود الدنيا؛ وأعني إلى مجرد نمط من الاستهلاك المجاني الرخيص وغير المُكلِّف. والحق أن فاعلية تقوم على مبدأ «اقتصاد الجهد»، وتنعدم إنتاجيتها إلى هذا الحد، لابد أن تكون من قبيل «الفاعلية السلبية» التي تخايل لصاحبها بفاعلية ما، ولكنها فاعلية لا تؤثر في العالم، ولا تؤول إلى تغييره، بل تنتهي بالأحرى -وللمفارقة- إلى تخريبه[29]. وبما أن فاعلية «الانتهاب» لا تتجاوز حدود استهلاك ما أنتجه الغير بفعله، فإنها تكاد تنعكس كلياً في فاعلية «الكسب» الأشعري؛ بما هي محض اكتساب، أو حتى استهلاك، لفعل الله[30]؛ وأعني من حيث يبدو الإنسان في الحالين كمجرد عالة على فعل غيره. ومن هنا إمكان المصير إلى أن فاعلية «البداوة» المُختَزَلة في انتهاب واستهلاك نتاج الغير، هي الأصل في ما سيرسخه النسق الأشعري المهيمن في الإسلام من فاعلية «اكتساب أو استهلاك» فعل الغير؛ على أن يكون مفهوماً أن «الغير» هنا هو «الله» هذه المرة. لكنه وفيما ترتبط فاعلية «الانتهاب»، في حال البداوة، بطبائع العمران المحتومة، فإن فاعلية «الاكتساب» سوف تتقنَّع في النسق الأشعري، وراء ما يدَّعيه من القصد إلى إثبات الفاعلية مطلقة وكليَّة لله وحده[31]. وأياً ما كان القصد، فإنه يبدو أن النسق لم يفعل -في الحقيقة- إلا أن راح يخفي «الأنثروبولوجي» وراء قداسة «الديني»؛ ومن هنا ما يبدو من أنه كان -عبر هذا الإخفاء الذي تواتر حصوله في أكثر من سياق؛ وخصوصاً فيما يتعلق ببناء نظام كل من «العقل» و«السياسة» بالذات- أداة البداوة في اختراق الإسلام، وتثبيت حضورها الفاعل في قلبه.
وليس من شك في أن عقلاً ينبثق في سياق هذا العمران وثقافته، والتي هي، هنا، الثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي الواسع الذي يتعدى ويسبق الشكل المكتوب الذي أخذته بعد ذلك في الإسلام، لا يمكن أن يكون إلا عقل تفكير بالجاهز والمجاني (الذي لا يكون نتاج جهد أو نَصَبْ)، أو بعبارة الشاطبي -السابق ذكرها- «عقل الركون إلى التقليد، لا جواب السؤال». والحق أنه يبدو جلياً أن نمط المعاش البدوي قد عكس نفسه كاملاً على نمط التفكير ونظام العقل المتبلور داخله. لذلك، فإن نمط العيش على «الجاهز» الذي أنتجه الغير، وهو النمط الذي طبع العمران البدوي تماماً، قد اقترن به نمط في التفكير بالجاهز الذي هو مأثور الأسلاف وأخبارهم. وضمن سياق هذا العيش على الجاهز والتفكير به، فإنه إذا كان هذا العمران لم يعرف في المعاش، وبحسب ما لاح آنفاً، إلا فاعلية «النهب»، فإنه لن يعرف، في التفكير، إلا فاعلية التقليد و«النقل»؛ وذلك من حيث لا يمكن أن يكون «الجاهز» إلا موضوعاً لمجرد النهب (في المعاش) والتقليد والنقل (في التفكير) فحسب. وبالتالي، يتجاوب «النهب» كشكل في المعاش، مع «النقل والتقليد» كآلية إنتاج للمعرفة؛ وأعني من حيث لا يعرف المرء بحسبهما إلا استهلاك وتداول ما ينتجه الغير[32]. ومن جهة أخرى، فإن «النقل» كنمطٍ للمعرفة يتسق تماماً -بل لعله يتوحد بحسب الاشتقاق من نفس الجذر اللغوي- مع «التنقل» كشكل في المعاش البدوي، بل إن ثمة من مضى إلى أن هذا «التنقُّل» ذاته هو خصيصة جوهرية لتفكير البداوة، حيث لوحِظ أن «تفكير البدوي يتميز بالتنقل دون أن يهتم بالروابط بين الأشياء، فإذا وصف بعيراً مثلاً، فقد يبدأ بذكر أذنه ثم ذيله، ثم يعود إلى وصف رأسه ورجله وسنامه، وهو يدقق في وصف كل هذه الأشياء تدقيقاً رائعاً، ولكنه لا يتبع طريقاً منطقياً في تسلسل الأجزاء التي يصفها؛ هذا إلى أنك لو قرأت وصفه للبعير ولم تكن قد رأيته، فإنك قلّما تستطيع أن تتصوره من وصفه»[33]. إن ذلك يعنى أن الفعل المعرفي المُقارن للبداوة قد انبنى، من جهة، على «النقل عن مصدر جاهز» وعلى «التنقُّل بين الجزئيات المحسوسة» من جهة أخرى؛ وبما يرتبط بهما من غياب الوعي بالروابط بين الأشياء[34]. ولعل ذلك يتفق تماماً مع ما صار إليه الشهرستاني -في سياق تقسيمه أهل العالم- إلى «أن العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد، وأكثر ميلهم إلى تقرير خواص الأشياء والحكم بأحكام الماهيات والحقائق واستعمال الأمور الروحانية. والروم والعجم يتقاربان على مذهب واحد، وأكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الأشياء والحكم بأحكام الكيفيات والكميات واستعمال الأمور الجسمانية»[35]. فإذ يحيل «تقرير خواص الأشياء، والحكم بأحكام الماهيات» -على ألا تُفهم الماهية هنا على أنها ما به يكون الشيء، بل بما هي أهم خواصه- إلى «عقل» لا ينشغل بما يجاوز «وصف المحسوس»، فإن ما يفيده «تقرير طبائع الأشياء، والحكم بأحكام الكيفيات والكميات» من الانشغال بما به يكون الشيء، يحيل إلى عقلٍ ينشغل بالسبب والعلة، وبما يقتضيه ذلك من تفعيل النظر. ولعل ذلك ما يؤكد أنه إذا كان الشهرستاني قد ربط مذهب الروم والعجم بما «يغلب عليهم من الجهد والاكتساب»، فإنه قد ربط مذهب العرب والهنود -في المقابل- بما «يغلب عليهم من الفطرة والطبع»[36]. فإنه إذا كان منطق «الجهد والاكتساب» يرتبط بما يدخل تحت قدرة الفرد واكتسابه، فإن منطق «الفطرة والطبع» يتعلق بما يتعدى أي قدرة أو اكتساب، وبما يدنيه مما سيدعوه الأشاعرة «علم الاضطرار» الذي هو «ما لزم أنفس الخلق لزوماً، لا يمكنهم دفعه والشك في معلومة نحو العلم بما أدركته الحواس الخمس (الطبع) وما ابتدى في النفس من الضرورات (الفطرة)»[37]. وهكذا، فإن ما يغلب على العرب من «الفطرة والطبع» هو أحد لوازم مذهبهم في «اعتبار خواص الأشياء» التي لا سبيل إليها إلا عبر الحواس. وعليه، فإن ثمة تأكيداً، من جهة، على ربط علم البداوة بمجرد «الوصف الحسي»؛ وذلك على نحو ما يقطع به مذهبهم في «اعتبار خواص الأشياء» (وليس طبائعها)، وبما يؤدى إلى أن يكون الغالب عليهم هو «علم» الفطرة والطبع، الذي هو علم الاضطرار أو علم الحواس بحسب التعبير الأشعري. وثمة التأكيد، من جهة أخرى، على تمييز هذا العلم البدوي عن علم «التفسير وإدراك الروابط»، الذي ينبني على مذهب الروم والعجم في «اعتبار طبائع الأشياء»، وبما يؤدى إلى أن يكون غالب علمهم هو علم «الجهد والاكتساب»، الذي هو «علم النظر والاستدلال» ذو الطابع العقلي. وهكذا، تقوم طبيعة الفعل المعرفي البدوي على مجرد وصف الأشياء المحسوسة، مع عدم إدراك الروابط بين جزئياتها، بل هو محض التنقُّل بين تلك الجزئيات من دون ترتيب أو نظام.
وإذا كان اعتبار علم البداوة هو علم «طبع واضطرار»، وبما يعنيه ذلك من تصوره ليس واقعاً تحت قدرة العبد، هو مما يتجاوب مع ما سيمضي إليه الأشاعرة -لاحقاً- من الإنكار الكامل لقدرة العبد في مجال العلم وغيره، فإن الأشاعرة سوف يُلحقون بهذا العلم الضروري «العلم المُختَرَع في النفس بما تواتر الخبر عن كونه واستفاض عن وجوده، نحو العلم الواقع عند إخبار المخبرين عن الصين وخراسان وفارس وكرمان، وعن ظهور موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى جميع النبيين، والخبر عن الوقائع والفتن والممالك والدول، وغير ذلك من الأمور الحاصل الخبر عنها من قوم قطع العذر نقلهم ووجب العمل عند خبرهم»[38]. ويضيف الأشاعرة «النقل» إلى «الوصف» بوصفهما جوهر الفعل المعرفي المُقارن للبداوة، وهي الإضافة التي تجد ما يبررها في حقيقة أن الإنسان لا يملك إلا محض التلقي عن الأشياء (واصفاً) وعن المخبرين (ناقلاً).
إن الطبيعة المحايثة للفعل المعرفي المُقارن للبداوة (والتي تقوم، فيما بدا، على قران الوصف والنقل)، كان لابد أن تحدد طبيعة الإنتاج المعرفي الصادر عنها. ومن هنا، فإنّ المعارف التي أنتجتها البداوة لا تجاوز حدود «الأخبار ومعرفة السير والأعصار»، حيث «علم العرب الذي كانوا يفتخرون به (هو) علم لسانهم ونظم الأشعار، وتأليف الخطب وعلم الأخبار ومعرفة السير والأعصار. قال الهمذاني: 'ليس يوصل إلى أحد خبر من أخبار العرب والعجم إلا بالعرب؛ وذلك أن من سكن بمكة أحاطوا بعلم العرب العاربة وأخبار أهل الكتاب، وكانوا يدخلون البلاد للتجارات فيعرفون أخبار الناس، وكذلك من سكن الحيرة وجاور الأعاجم علم أخبارهم وأيام حمير ومسيرها في البلاد، وكذلك من سكن الشام خبَّر بأخبار الروم وبني إسرائيل واليونان، ومن وقع في البحرين وعمان فعنه أتت أخبار السند والهند وفارس، ومن سكن اليمن وعلم أخبار الملوك جميعاً لأنه كان في ظل الملوك السيارة»[39]. وعليه، فإن جل ما تواتر عن العرب أنهم «نقلة» أخبار، وأنه لا شيء يجرى تداوله في إطار عمرانهم إلا «علم الأخبار ومعرفة السير والأعصار». ولأن تداولهم هذا النمط من «المعرفة الإخبارية» كان من قبيل التداول الشفاهي -حيث لم توفر طبائع هذا العمران المترحّل الشروط اللازمة لظهور الكتابة التي ترتبط بالعمران المستقر- فإنه كان لابد أن يجعل من «العرب أصحاب حفظ ورواية»، بل وحتى «أحفظ الناس بالجملة»[40]. وضمن سياق ما جرى التأكيد عليه من الارتباط بين المعرفي والوجودي أو المعاشي، فإنه يبدو وكأن «الحفظ» قد تبلور بما هو نمط معاش؛ وأعني من حيث أنه كان أداتهم التي «ضبطوا بها أنسابهم وأسماء فرسانهم الذين نزلوا في ميادين حروبهم، وأنهم من أي قبيلة وإلى أي أبٍ ينتهون من الآباء الأولين وأسلافهم السابقين»[41]. فلم تكن تلك المعرفة، بحسب ابن خلدون، مقصودة لذاتها، بل لما تؤدي إليه «من النعرة والقَوَد وحمل الديات وسائر الأحوال»[42] التي يستحيل دونها العيش في البوادي والقفار. ولعل ذلك يعنى أن ما تبلور في هذا المهاد الأنثروبولوجي البدئي من «العقل النقلي الإخباري» الذي تحدد مجال اشتغاله بمأثور الأسلاف، وأخبار الغير، لم يكن مجرد ضرورة معرفية فقط، بقدر ما كان ضرورة وجودية ومعاشية في الأساس.
ولعل تسرّب هذا العقل إلى الإسلام لا يرتبط فحسب بما صار إليه عمر بن الخطاب من أن «الأعراب هم أصل العرب ومادة الإسلام»[43]، وحيث يبدو تأثير الأعراب حاضراً بقوة في «العرب» بما هم أصلهم، وفي «الإسلام» بما هم مادته، بل ويتعلق أيضاً بما يبدو من أن العرب، حين خرجوا من باديتهم ليستقروا في مواطن الحضارة الجديدة التي فتحها الإسلام، قد أخذوا معهم نظام عمرانهم[44]، ومعه -لا محالة- طابعه الأثير؛ وأعني به استهلاك الجاهز مجلوباً من الغير، من دون معاناة جهد أو نَصَبْ[45]، «ولهذا نجد أوطان العرب وما ملكوه في الإسلام قليل الصنائع بالجملة حتى تُجلب من قطر آخر»[46]. وإذ تكشف عبارة ابن خلدون عن حقيقة أن نظام وطبائع العمران البدوي قد تعدَّت «أوطان العرب» إلى «ما ملكوه في الإسلام» كذلك؛ وبما يعنيه ذلك من استمرار نفس نمط المعاش، فإنه، وعبر التوسّع بدلالة «الصنائع» عنده لتشمل «المعارف»، يمكن المصير إلى أن نمط التفكير المُقارن لذلك النمط المعاشي قد استمر أيضاً؛ وأعني بما هو تفكير نقلي في الجوهر. ومن هنا ما لاحظه ابن خلدون، نفسه، من الهيمنة الكاملة لهذا الطابع النقلي، في إنتاج المعرفة، على ما أنتجه العرب من معارف في «أول الملة» التي «لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى أحوال السذاجة والبداوة، وإنما أحكام الشريعة، التي هي أوامر الله ونواهيه، كان الرجال ينقلونها في صدورهم وقد عرفوا مآخذها من الكتاب والسنة بما تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه، والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين، ولا دُفعوا إليه، ولا دعتهم إليه حاجة. وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين، وكانوا يسمون المختصين بحمل ذلك ونقله القراء؛ أي الذين يقرؤون الكتاب وليسوا أميين؛ لأن الأمية يومئذ صفة عامة في الصحابة بما كانوا عرباً»[47]. وحين بدا أن المعارف قد انشعبت وتضخمت على نحو راح يعجز معه النقل «الشفاهي» عن استيعابها، وحيث اقتضى الأمر تأسيساً للعلم وتدويناً له، فإن «النقلية» الطابعة لعقل البداوة قد حالت بين العرب، وبين الإسهام الفاعل في تلك الحركة التأسيسية، «فصارت العلوم لذلك حضرية، وبَعُدَ عنها العرب وعن سوقها»[48]. ورغم ما بدا من أن ابن خلدون قد راح يلتمس تفسيراً لذلك في «السياسة»، حيث العرب، على قوله، قد «شغلتهم الرياسة في الدولة العباسية وما دُفعوا إليه من القيام بالملك عن القيام بالعلم» فإنه سرعان ما تدارك نفسه، مرتداً بالأمر إلى «ما يلحقهم من الأنفة عن انتحال العلم بما صار من جملة الصنائع»[49]، وبما يعنيه ذلك من أن الأنفة المنسربة من عالم البداوة، من انتحال الصنائع والقيام بها، والاكتفاء -بدلاً من ذلك- بمجرد الاستهلاك، من غير جهد، للجاهز المجلوب من الغير منها، كانت هي الأصل في «ابتعاد العرب عن العلوم وعن سوقها»، وليس مجرد القيام بأعباء المُلك والسياسة.
وإذ يبدو، هكذا، أن نمط المعيش البدوي قد عكس نفسه على بناء العقل، في شكل «تفكير بالجاهز»، فإنه يلوح، بالمثل، أن نظام انبناء القبيلة (وهي الوحدة السوسيوسياسية في العمران البدوي) قد راح، بدوره، ينعكس كاملاً في نظام تبنين العقل. وإذا كان مفهوم «الأصل الأول» يحتل موقعاً مركزياً في بناء القبيلة؛ وأعني ابتداءً من تخلُّقها حول «أبٍ» تنتهي إليه من الآباء الأولين، هو أصل وجودها ومركزه (ومن هنا ما يحتله مفهوم الأصل في النسب من هيمنة، لا تقبل الزحزحة، في الذاكرة العربية)، فإن ذلك يتجاوب، على نحو كامل، مع تصور العقل «لا ينبني على غير أصل على الإطلاق»، وبما يعنيه ذلك من أن مركزية «الأصل» في بناء القبيلة، تتجاوب مع -أو حتى تؤول إلى- مركزيته في بناء العقل. لذا، إذا كان قد تم تديين نمط المعيش البدوي القائم على انتهاب الجاهز من الغير؛ وأعني من حيث اعتبار الغصب من قبيل الرزق، فإنه سوف يتم بالمثل إضفاء قداسة الدين على «الأصل في النسب». ويُشار هنا إلى «إن الرسول الكريم الذي نادى في خطبة الوداع: إن مآثر الجاهلية موضوعة، فلتذهب نخوة الجاهلية وفخرها بالآباء، كان نفسه حريصاً على حفظ الأنساب، ولذلك قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان يفخر بقومه، فيقول: نحن بنو النضر بن كنانة، ثم يذكر أن الله جعل العرب بيوتاً 'فجعلني في خيرهم بيتاً'، بل كان يخشى أن يلوث نسبه. فقد استأذنه حسَّان في هجاء المشركين، فقال له: كيف بنسبي؟ قال حسَّان: لأسُلَّنك منهم كما يُسلُّ الشعر من العجين. وكان الرسول كثيراً ما يذكر أفخاذ الأنصار ويفاضل بينهم»[50]. ورغم ما يبدو من أن الأمر -بحسب النص- يتجاوز مجرد ذكر النسب إلى حفظه والفخر به، فإن ما ينسبه المصدر ذاته إلى الرسول من القول «ليس رجل ادُّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادَّعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار»؛ سوف يؤول، بدلالة اعتبار الكفر بالأب بمثابة كفرٍ بالله، إلى أن الإقرار بالأصل في النسب يوازى الإقرار بالله في المعتقد؛ وبما يعنيه ذلك من أن إنكار الأصل هو، في حقيقته، إنكارٌ للدين، يؤول بصاحبه إلى الخسران المبين[51]. لقد راح «الأنثروبولوجي» يواصل -عبر هذا الانتقال بمركزية الأصل من «النسب» إلى «المعتقد»- دورة تخفيه وراء «الديني»، وعلى لسان النبي، صاحب السلطة العليا في الإسلام هذه المرة. وبالطبع، فإن هذا التخفي قد أتاح لمفهوم الأصل أن يتسلّل من بناء القبيلة إلى بناء العقل في الإسلام، وبكيفية راحت معها «الأبوية»، بما هي تمركزٌ حول الأب/الأصل؛ كسلطة أولى لا سبيل للانفلات من سطوتها أبداً، تتحول من بناء مجتمعي إلى بناء عقلي، لم يزل هو الحاكم للآن، رغم غياب القاعدة المجتمعية الحاملة له.
ومن ثمة، فإنه وحتى فيما يتعلق بالعلوم التي أنتجها الحضر جاهزة ليفيد منها العرب الذين انشغلوا عنها بالملك والسياسة، أو منعتهم عنها أنفة البداوة، فإن ما تحققت له الغلبة والسيادة من بين هذه العلوم، داخل ما عُرف بالثقافة الإسلامية، لم يكن إلا ما يتجاوب منها مع نظام العقل الذي انبنى بحسب بناء القبيلة المتمركز حول سلطة الأب. وأعني بالطبع، أن «النموذج المعرفي» الذي غلب على بناء تلك العلوم، وهو نموذج التمركز حول سلطة «نص أو أصل أول» هو أساس كل معرفة[52]، لا يعدو أن يكون امتداداً، في العمق، لتمحور بناء القبيلة، حول سلطة «أب أول» هو أصل كل وجودها المادي والمعنوي. وبالطبع، فإنه كان لابد من طرد وإقصاء كل ما يمثل تحدياً لنظام ذلك النموذج الغالب، لا إلى خارج مجال الثقافة فقط، بل وإلى خارج إطار الأمة والملة أيضاً.
والملاحظ فيما يتعلق بالتحول من البداوة إلى الإسلام، أنه كان تحوّلاً من مضمون يشتغل عليه العقل إلى مضمون آخر فقط، وأما آليات ونظام اشتغال هذا العقل فإنها قد ظلت هي نفسها من دون تغيير؛ وأعني أنه قد ظل يشتغل بآلية نقل الجاهز والتفكير به، وظل نظامه يعكس تقيُّده بسلطة متقدمة ومسلَّم بها تقوم خارجه. وفقط مع تحوير طفيف جرى التحول بمقتضاه من «الجاهز» الخاص بسلف غابرين لم يكونوا صالحين، إلى جاهزٍ بديل يخص سلفاً قريبين صالحين، كما جرى الانتقال من سلطة «العرف» إلى سلطة «النص». لذا، يكون العقل البدوي قد أحال النص/الوحي إلى سلطة مُقَيِّدة للعقل في الإسلام؛ وأعني من حيث جرى تصور هذا «العقل غير مستقل البتة، ولا ينبني على غير أصل، وإنما ينبني على أصل متقدم مسلَّم على الإطلاق»[53]، وذلك بمثل ما كان، العقل البدوي نفسه، مُقَيَّداً بسلطة السلف/العرف؛ الذي لا يفارق، بدوره، موقع الأصل المتقدم[54]. والغريب حقاً أن تكون تلك الإحالة قد تأدت إلى الانحراف بالنص/الوحي عن الموقع الذي أراده لنفسه كنقطة ابتداء لضروب من التفكير الواعي الحر، وليس أبداً كسلطة تقييد، لابد أنها سوف تؤول إلى تقييد، بل وحتى تبديد، النص/الوحي نفسه، وذلك حين تُقيِّد العقل الذي هو الأصل فيما يتمتع به هذا النص/الوحي من خصوبة وحياة، وذلك بما يسمح له من التفتح عن ثراء ما يحويه ويضمره من ممكنات كامنة. وإذ يعني ذلك أن النص أو الوحي لم يضع نفسه كسلطة أو كمعطى أول مُقيِّد للعقل[55]، بقدر ما إنه قد جرى فرض ذلك الوضع عليه من الثقافة (بالمعنى الأنثروبولوجي) المهيمنة خارجه، فإن ذلك يؤول إلى أن كسر سطوة عقل البداوة، هو بمثابة تحريرٍ للنص من وضع يحول دون أن تكون له حياته الحقة، والتي لا يمكن أن تكون إلا، وتلك هي المفارقة، بأن يكون نقطة انطلاق لضروب من التفكير الإبداعي الخلَّاق؛ وليس بما هو سلطة تعوق هذا النوع من التفكير.
وإذ يبدو، هكذا، أن «العقل الأنثروبولوجي» قد راح عبر ما جرى من الإبدالات، على صعيد المضمون (انتقالاً من «مأثور» الآباء والأسلاف إلى «نص» الوحي) وعلى صعيد النظام (تحولاً من سلطة «الأب» في القبيلة إلى سلطة «الأصل» في التفكير)، يحِيل نفسه -من خلال آليات التخفّي والمراوغة- إلى ما يبدو أنه «العقل الديني»، ليكتسب عبر هذا التخفي وراء المتسامي الديني ما له من القداسة والحصانة التي يتحصن وراءها من أي نقد أو مساءلة. لقد راح بذلك يحتل موقع السيادة العليا في الإسلام، وبكيفية راح معها يعيد إنتاج نفسه من دون انقطاع حتى الآن؛ وأعني حتى مع غياب قاعدة البداوة المادية الحاملة له في الواقع. والحق أن الأمر لم يقف عند مجرد إعادة إنتاج هذا العقل لذاته فحسب، بل وتجاوز إلى إنجاز عملية تأسيسه النظري والمفهومي داخل نصوص الآباء الكبار من بناة الثقافة في الإسلام؛ وأعني عند كل من الشافعي والأشعري بالذات.
فإذ تبنى الشافعي إستراتيجية في بناء أصول الفقه، تقوم على الاتساع بالأعلى من هذه الأصول ليستوعب ما تحته من أصول كان عليها، بالتالي، أن تضيق لتقبل الإدماج ضمن ما فوقها؛ وبما يعنيه ذلك من أن الأصل الأعلى عنده، وهو النص، قد راح يتسع ليستوعب سائر أصول الفقه تحته، فإنه قد انتهى إلى استحالة أي تفكير في الفقه إلا بالنص، وهو أصل الأصول؛ وبما يترتب على ذلك من طرد كل ما سواه (وأعني الرأي والاستحسان والمصلحة والأعراف المحلية وغيرها من أصول تنفتح على الواقع والعقل والتاريخ) من فضاء التفكير الفقهي، فإن الأشعري -بالمثل- قد أسس عمله الكبير في العقائد على ما سماه هو نفسه، بطريقة الاستدلال بالأخبار التي لا تعني إلا التفكير بالنص أيضاً، والتي كانت هي طريقته في التمرد على طريقة الاستدلال العقلية التي اشتغل بها، هو نفسه، حين كان يفكر ضمن الفضاء المعتزلي، الذي نشأ وترعرع فيه أولاً[56]. وإذ بدا أن الرجلين يصطنعان، هكذا، طريقة في التفكير بالنص/ الخبر، فإنه يُلاحظ أن هذه الطريقة قد استحالت إلى جزء من بنية ومضمون مذهبيهما؛ وإلى حد إمكان القول إن فصلها عن هذين المذهبين يؤول إلى إهدار اتساق مضمونهما (وهو ما جرى بالفعل حين راح أتباع الأشعري يستعيرون طريقة المعتزلة العقلية للاستدلال بها على منظومتهم العقائدية التي أسسها رائدهم الكبير على الأخبار). ولأن كلا المذهبين قد راحا يحققان سيادتهما داخل الإسلام من خلال التماهي مع الدين نفسه، فإن طريقة التفكير المُنتِجة لهما كان لابد أن تصبح جزءاً من الدين بالمثل. وإذ يبدو، تبعاً لذلك، أن أي انحراف عن تلك الطريقة سيكون منظوراً إليه كانحراف عن الدين ذاته، فإن ذلك يعني أنها قد راحت تكتسب قداسة الديني وحصانته. لذلك، فإن ما فعله الرجلان حقاً، لم يكن تأسيس مجرد مذهبين في الفقه والعقيدة سرعان ما تسيَّدا ثقافة الإسلام، بقدر ما كان تحويل نظام العقل النقلي الإخباري من عقل يتحدد بواقع أنثروبولوجي معين، وبكيفية يتعذر معها تفسيره خارج هذا الواقع، إلى عقل يمارس مراوغة التحدد بالدين[57]، رغم أنه كان هو المُحدد للدين في العمق. لذا، فإن جوهر ما أنجزه الرجلان، بالفعل، لم يكن -وفي كلمة واحدة- إلا إخفاء الأنثروبولوجي وحجبه وراء أستار الديني وقناعه المقدس السميك.
والحق أن التماثل بين عقل البداوة ووريثه «الأشعري» الذي ساد في الإسلام، إنما يتجاوز مجرد الانبناء على نحو يبدو فيه العقلان خاضعين لسلطة الأصل/الخبر، إلى ما يبدو وكأنه التماثل، أيضاً، على مستوى المضمون المُفكَّر فيه بواسطتهما، بل وحتى على مستوى المفاهيم المتداولة ضمن ذلك المضمون. فإذ يُفهم مما تواتر من المرويات أنه «في الطور الذي كانت تمر به العرب في الجاهلية (يعني طور البداوة) يتجلى ضعف التعليل؛ أعني عدم القدرة على فهم الارتباط بين العلة والمعلول والسبب فهماً تامّاً. يمرض أحدهم ويألم من مرضه، فيصفون له علاجاً، فيفهم نوعاً من الارتباط بين الداء والدواء، ولكنه لا يفهمه فهم العقل الدقيق الذي يتفلسف، بل يفهم أن عادة القبيلة أن تتناول هذا الدواء عند (حصول) هذا الداء. وهذا في نظره كل شيء»[58]، فإن ذلك الفهم لعلاقة التعليل -ومع صرف النظر عن إدانته بعدم الدقة الفلسفية، هو بعينه- وبذات المفاهيم المتداولة (وأعني مفهوم العادة بالذات) -ما سوف يؤبده الأشاعرة، بعد قرون، لكن لا بوصفه جزءاً من عادات القبيلة، بل كأحد مقتضيات الإقرار بمطلقية القدرة الإلهية وشمول فعلها[59]. ومن ثم، فإن الأشاعرة حين مضوا إلى «أن الاقتران بين ما يُعتقد في العادة سبباً، وبين ما يُعتقد مسبباً، ليس ضرورياً عندنا، بل كل شيئين ليس هذا ذاك، ولا ذاك هذا، ولا إثبات أحدهما متضمناً لإثبات الآخر، ولا نفيه متضمناً لنفي الآخر، فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر، مثل الري والشرب، والشبع والأكل.....، والشفاء وشرب الدواء وإسهال البطن واستعمال المسهل، وهلم جراً، إلى كل المشاهدات، من المقترنات في الطب والنجوم والصناعات والحرف[60]...، و(أن) الإنسان إنما يدرك هذه (الاقترانات) المطردة في العالم بعادة ناتجة عن تكرار المشاهدة[61]...، والمشاهدة تدل على الحصول عندها (يعني حصول الاحتراق عند ملاقاة النار مثلاً)، ولا تدل على الحصول بها»[62]، لم يفعلوا إلا أن بلغوا بما بدا، وكأنه فهم البداوة الساذج للاقتران الحاصل بين المشاهدات، إلى مقام البناء الذي اكتسب قوة التأسيس النظري والمفهومي.
وإذا كان الإنكار الأشعري للارتباط الضروري بين الظواهر قد قام على تصور العالم «كتلة منفصلة الأجزاء، ولا فعل لجزء منه في الآخر»[63]، فإن الغريب حقّاً أن هذا التصور الأشعري للعالم يعكس، على نحو تام، بناء عالم البداوة؛ وأعني من حيث ينبني هذا العالم، كوريثه الأشعري تماماً، على ذات «التفكك والانفصال»، وإلى حد إمكان القول إن العالم الأشعري المركب من «جواهر فردة أو ذرات لا تقبل القسمة» هو امتداد، على نحو ما، لعالم البدوي المكوَّن من «ذرات الرمال». فإن عالم البدوي مفككٌ كصحرائه، ليس فقط من حيث إنها تكوين من ذرات رمال منفصلة، بل ومن حيث إن ما تعرفه من أشكال وجود (طبيعي أو بشري) قائم بدوره على البعثرة والانتثار. فإنه إذا كانت الصحراء لا تعرف إلا «المزروعات (التي) لا تنمو إلا كلاً مبعثراً هنا وهناك»[64]، فإنها -بالمثل- قد «بعثرت الأعراب في البوادي على شكل قبائل وعشائر»[65]، و«حيث بقيت هذه المراكز جُزراً متباعدة غير متصلة بشكل عضوي، وذلك ما أدى إلى إضعاف التواصل الحضري في نسيج المجتمع العربي الذي ظل 'مجزأ' على صعيد القاعدة المادية الأرضية إلى يومنا هذا»[66]. والظاهر أن هذا الانفصال الذي يتبدى كواقعة معاشية بالأساس، قد ترك بصمته الظاهرة على كافة مناحي عالم البداوة وثقافتها. فالبدوي «منفصلٌ» عن المكان لا يستقر فيه، حيث «غاية الأحوال العادية كلها عنده (هي) الرحلة والتقلب»[67]، و«منفصلٌ» عن إلهه يتوسل إليه بالوسائط والأوثان، بل إنه «منفصلٌ» عن نفسه وأناه التي يفنيها في كيان القبيلة الأوسع التي ينتمي إليها، و«منفصل» عن الزمان التاريخي المتحرك، وقائمٌ في الزمان الطبيعي، حيث يكتنف السكون والثبات عالمه كله[68]. ولعل الأمر يتجاوز ما يبدو من أن الانفصال قد استحال إلى «طريقة حياة»، إلى ما يمارسه من دور حاسم في بناء «طريقة التفكير»؛ وأعني من حيث إنه هو ما يجعل تأسيس النقل كأداة «معرفية» ممكناً. فإن تصور «المعارف» في حال من الانفصال الذي لا تتقيد فيه بأي سياق يحددها ويشرطها ويربطها بما لا يمكنها الفعل خارجه، هو -لا سواه- ما يفتح الباب أمام جعل «النقل» هو الآلية الرئيسة في مقاربتها والتعامل معها.
ولعله يبقى لزوم التأكيد أن مركزية مفهوم «الأصل الأول» في بناء العقل (سواء كان بدوياً أو أشعرياً)، تتجاوب مع مركزيته الكاملة في بناء مثل هذا العالم؛ وأعني من حيث إن تصوره على هذا النحو من الانفصال والتفكك، وبما يستتبع ذلك من إنكار الارتباط الضروري بين ظواهره، إنما يرتبط بأن «جميع الموجودات ممكنة، والممكن وجوده ليس لازماً لا لذاته، ولا لصفة من صفاته، والاختصاص بفعل معين يقتضى فاعلاً على الاختيار، فالطبيعة يستحيل أن تكون فاعلاً، بل الفاعل هو الله الذي هو فاعل بالاختيار، ولا إيجاب هناك ولا ضرورة»[69]. وعليه، يرتبط الإمكان، وبما يرتبط به من إنكار الضرورة ونفيها، بتصور عالم لا مجال فيه إلا لفاعلٍ أوحد مطلق[70]، هو بمثابة الأصل الذي يستفيد منه العالم، لا مجرد وجوده وفعله الأول، بل واستمراره في هذا الوجود والفعل أبداً؛ وبما يعنيه ذلك من الانعدام الكامل لأي استقلالية -حتى ولو كانت نسبية- له، واستفادته لفعل وجوده، بل واستمراره في هذا الوجود، من خارجه؛ وعلى نحو يستحيل معه الحديث عن مبدأ أو قانون باطن، أو أي شيء يتقوَّم بذاته في العالم. ومن هنا أن أهم ما يسم العلاقات بين موجودات هذا العالم وظواهره هو خارجيتها -وبالتالي- هشاشتها واعتباطيتها.
والملاحظ أن هذا التصور للعلاقة، بين المُشاهدات في الوجود، تكون «خارجية واعتباطية» قد انعكس كاملاً على تصور طبيعة العلاقة بين الفعل والقيمة؛ وأعني من حيث جرى تصور القيمة «خارجية» وطارئة على الفعل من خارجه، بالمثل. لكنه وفيما يبدو أن «القوة» هي الأصل المحدد لنوع القيمة المُضافة إلى الفعل عند أهل البداوة، حيث الفعل يستفيد «رفعته» أو «وضاعته» مما يقترن به من «القوة» أو «الضعف»، فإن «الشرع» هو المُحدد لحسن الفعل أو قبحه عند ورثتهم الأشاعرة[71]. وبالطبع، فإن ذلك يعني أن الفعل -عندهما- ينبني، بدوره، بحسب منطق التحدد بأصل مُسلَّم به، وأنه يكون، في ذاته، خلواً مما يجعله رفيعاً/حسناً أو وضيعاً/قبيحاً، وأن ذلك ينضاف إليه من «أصل» أو وازع يقوم خارجه. ومن ثمة، يتكشَّف التحليل عن انبناء كل من العقل والعالم والفعل، بحسب سلطة «أصل أول» هو المحدد لها على الإطلاق.
وفي الختام، فإن التحليل يكاد يقطع أيضاً، بأن هذا العقل المنفلت من أي هيمنة، قد اخترق جدار الحداثة العربية الهش؛ وعلى النحو الذي عجزت معه عن أن تكون حداثة حقة، وأعني ابتداءً من تحوّلها -بحسب نظام هذا العقل الذي راح، منذ تخفيه وراء قناع الدين، يشتغل متعالياً خارج شرطه- إلى محض «نموذج جاهز» يجرى التفكير به، والتنزُّل به كالقدر الذي لا راد له على واقع مجتمعات تنتمي إلى سياق تطور مختلف، ويُظن أنه لا سبيل لإخراجها من جمودها وتقليديتها إلا عبر إخضاعها، بالإكراه والعسف، لسطوة هذا النموذج الجاهز. ومن هنا أن مفكراً حداثياً كبيراً لم يجد عند تدقيقه في ثقافته السائدة «الحديثة» إلا ما يبدو أنه ثوابت نظام البداوة، حيث مضى يقول: «إن ثقافتنا السائدة هي ثقافة اللا ثقافة، هي ثقافة اغتراب الإنسان عن ذاته، عن قضايا وطنه ومجتمعه وعصره وإنسانيته (وبما يعني أنه يعيش واقعة الانفصال التي حددت نسق البداوة كاملة). إنها ثقافة الانفتاح على أسواق المتاجرة والمضاربة والربح السريع والمتع الرخيصة وتكديس الدولارات.. (وعلى نحو يذكِّر بسيادة مفهوم الاستهلاك المجاني الرخيص على نسق البداوة). إنها ثقافة التلقي والتقليد البليد (أو الامتثالية والأبوية)، ثقافة التسطح والتشتت والتمزق النفسي والاجتماعي والقومي والإنساني (أي التشظي والبعثرة). إنها ثقافة التسلية الفجة والاستمتاع المبتذل (أو الترف بالمعنى الخلدوني). إنها ثقافة الغيبة في مطلقات الماضي ومسلماته، أو الضياع في شطحات مستقبل هو مستقبل معكوس (أي ثقافة الأبوية ماضوية ومستحدثة)»[72]. وهكذا -أيضاً- فإن غياب القاعدة الواقعية الحاملة للبداوة لم يمنعها من الاستمرار في شكل عقل يؤسس بفاعلية -وبحسب قراءة كلمات الحداثي الكبير- لكل ضروب الممارسة العربية الراهنة، فإنه «في الوقت الذي تتطور فيه البنى التحتية لنمط الإنتاج الرأسمالي المسيطر (الحديث)، فإن تطوراً مساوقاً لا يمس البنية الفوقية»[73]، وبما يعنيه ذلك من ثبات البنى الفوقية (وهي الفضاء الذي ينبني فيه العقل)، رغم كل ما يطال البنى التحتية من تحولات، بل يمكن القول، حتى فيما يتعلق بالبنى التحتية، إن الأمر لا يتعلق بتطور، بل بمحض تحوُّل تستوعب فيه البنية القبلية التقليدية الأبنية والمؤسسات الحديثة. وبالطبع، فإن ذلك كله لابد أن يؤول إلى أن عالَماً وخطاباً عربياً جديدين حقّاً، إنما يمكن أن ينبعثا، وفقط، من أنقاض هذا العقل الذي يلزم، لذلك، نقضه وتفكيكه من دون ترددٍ أو خوف، وهو العقل الذي يكشف تاريخه -لحسن الحظ- عن حقيقة أن الإسلام لم يكن أبداً صانعه، بقدر ما كان -ومعه الحداثة بالطبع- هو مجرد ضحيته.
وعلى ضوء هذا، فقد بدا أن ذلك الذي يحتشد أوصياء هذا الزمان تحت رايته، وباسمه يصادرون حق الناس في التفكير والسؤال، لا يخص الإسلام ولا ينتمي إليه، بقدر ما هو -وللمفارقة- من مواريث عالم جاء الإسلام لكي يخلخله ويزيحه، لذا لزم التنويه.
[1] - محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي (دار الطليعة للطباعة والنشر) بيروت، ط1، 1984، ص71 وهكذا، فبالرغم من إشارة الجابري إلى «إن الرجوع ببنية العربي إلى البنية الذهنية الحضارية في الشرق المتوسطي الآسيوي القديم عمل مشروع، تماماً مثلما هو مشروع جعل بداية تشكل نفس البنية -بنية العقل العربي- في العصر الجاهلي» إلا أنه يتجاوز ذلك مقرراً «أما نحن، فقد اخترنا أن ننظر إلى العقل العربي لا من خلال ما هو حي-ميت أي ما هو باق من النقوش والآثار والأصول اللغوية التي تمتد بعيداً، ربما أبعد مما اصطلح القدماء على تسميته بالعرب البائدة، بل لقد فضلنا أن نحدد ونعرف العقل العربي من خلال ما هو حي فيه؛ أي من خلال الثقافة التي صنعته، الثقافة العربية التي ما زالت تحتفظ بها إلى اليوم كتب ومجلدات عديدة لا تحصى»، ص54. وغنيٌّ عن البيان ما يعنيه ذلك من أن أصول العقل لا تجاوز، عنده، حدود الثقافة المكتوبة في الإسلام (والتي كانت ساحة لاندماج عناصر ثقافية أولية متعددة) إلى الثقافة الأنثروبولوجية السابقة عليه (والتي هي ثقافة البداوة).
[2] - محمد أركون: تاريخية الفكر الإسلامي، ترجمة: هاشم صالح (منشورات مركز الإنماء القومي) بيروت، ط1، 1986، ص71. والحق أن قراءة لما كتب «أركون» عن العقل الإسلامي تكشف عن تصوره له بوصفه ذلك العقل الذي أنتجته «لحظة التفاسير وبلورة واستنباط الأحكام»؛ وبما يعنيه ذلك من أنه نتاج عمل «المفسرين والفقهاء». وبالرغم من تلميح أركون إلى أن عمل هؤلاء المفسرين والفقهاء كان مؤطراً بالعديد من الإكراهات والقيود الاجتماعية-الاقتصادية الخاصة بالمجتمعات التي اشتغلوا فيها، والتي جعلتهم يتلاعبون بالآيات القرآنية من أجل تأسيس علم يتناسب معها، فإنه لم يتطرق -لسوء الحظ- إلى الشرط المعرفي المنسرب من عالم ما قبل الإسلام كأحد الشروط الفاعلة في إنتاج هذا العقل، بل إنه قد راح يلح على الفصل بين ما اعتبره «الفكر المتوحش» الجاهلي (وبالطبع البدوي) قبل الإسلامي وبين الفكر «العليم» الإسلامي؛ وبما يمكن أن يعنيه ذلك من أن «العقل الإسلامي» مقطوع الصلة بما قبله من الفكر المتوحش الذي هو فكر البداوة الجاهلي. انظر: محمد أركون: من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، ترجمة هاشم صالح (دار الساقي) لندن، ط1، 1991، ص67، وكذا: محمد أركون: الفكر العربي، ترجمة عادل العوا (سبق ذكره) ص ص27-28
[3] - محمد أركون: معارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية، ترجمة: هاشم صالح (دار الساقي) بيروت، 2001، ص56
[4] - فمن (الغزالي) الذي راح يقرأ الإمامة بمفاهيم الغلبة والشوكة التي تنتمي إلى فضاء البداوة، مجاوزاً ما استقرت عليه الأشعرية التي ينتمي إليها عقائدياً، من قراءتها في ضوء مفاهيم شبه مثالية كالاختيار والبيعة، إلى (ابن خلدون) الذي محوَر تجربة الإسلام التاريخية بأسرها حول مفهوم العصبية ذي الصبغة البدوية اللافتة، إلى (الجابري) الذي أقام تحليله للعقل السياسي العربي على مقولات ثلاث حاكمة، استفاد منها اثنتين (هما القبيلة والغنيمة) من عالم البداوة؛ وذلك في مقابل واحدة فقط (هي العقيدة) تخص الإسلام، ثم أخيراً إلى (الأنصاري) الذي راح يقرأ التأزم السياسي العربي الراهن في ضوء سوسيولوجيا البداوة؛ يمتد تاريخ متصل لقراءة التاريخ والسياسة في الإسلام من خلال البداوة. انظر: للغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد (مكتبة مصطفى البابي الحلبي) القاهرة، الطبعة الأخيرة، دون تاريخ، وفضائح الباطنية، تحقيق: نادي فرج درويش (المكتب الثقافي) القاهرة، دون تاريخ. وكذا: ابن خلدون: المقدمة، تحقيق وتقديم: علي عبد الواحد وافي (دار نهضة مصر للطبع والنشر)، القاهرة، بدون تاريخ. وأيضاً: محمد جابر الأنصاري: التأزم السياسي عند العرب وسوسيولوجيا الإسلام (المؤسسة العربية للدراسات والنشر) بيروت، ط2، 1999. وأيضاً: محمد عابد الجابري: العقل السياسي العربي (مركز دراسات الوحدة العربية) بيروت، ط1، 1990
[5] - وكيف ذلك وقد «فشا الجهل بينهم وقلَّ العلم فيهم وأضاعوا صنائعهم وتشتتوا في الأطراف والأكناف، ووقع التنازع والتشاجر بين القبائل، وتكاثرت البغضاء بينهم، فلم يبق عندهم علم منزَّل ولا شريعة موروثة من نبي، ولا هم أيضاً مشتغلون ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوهما، إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم، أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب ونحو ذلك. وكانوا يُقال لهم الأمة الأمية. قال تعالى {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ} [الجُمُعَة: 2]». انظر: محمود شكري الألوسي: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، عُني بشرحه وتصحيحه: محمد بهجة الأثري (المطبعة الرحمانية بمصر) ج3، القاهرة، ط2، 1924، ص81. وفي إطار مقارنتهم بغيرهم من الأمم، فإن ثمة من مضى -في السياق ذاته- إلى أنه: «لم تزل الأمم كلها من الأعاجم في كل شق من الأرض لها ملوك تحميها ومدائن تضمها وأحكام تدين بها، وفلسفة تنتجها، وبدائع تفتقها في الأدوات والصناعات، مثل صنعة الديباج ولعبة الشطرنج، ومثل فلسفة الروم في ذات الخلق والقانون والإسطرلاب. ولم يكن للعرب ملك يجمع سوادها، ويضم قواصيها ويقمع ظالمها، وينهي سفيهها، ولا كان لها قط نتيجة في صناعة، ولا أثر في فلسفة، إلا ما كان من الشعر، وقد شاركتها فيه العجم». نقلاً عن أحمد أمين: فجر الإسلام (الهيئة المصرية العامة للكتاب) القاهرة 1996، ص51 ولعله يُلاحظ على هذا النص الأخير ذلك الحرص الجلي (والذي لا يغيب عن النص الأول على نحو ما) على الربط بين الفكر والمُلك؛ وهو أمر دال على أن إنتاج «الفكر» مرتبط بالاستقرار الذي يحدثه «المُلك»، وبما يعنيه ذلك من عدم مناسبة البداوة لإنتاج الفكر.
[6] - انظر: أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية: المُحبَّر، نشرة إيلزة شتيتر (مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية) حيدر آباد- الدكن 1942، وكذا: أحمد محمد الحوفي: الحياة العربية من الشعر الجاهلي (مكتبة نهضة مصر) القاهرة، ط3، 1956. وأيضاً: سمير السعيدي: أصل العائلة العربية (مطبعة دار عكرمة) دمشق، ط1، 2001
[7] - وأعني من حيث إن الدور المركزي الحاكم الذي لعبته السياسة في تحديد وتوجيه المعرفي في الإسلام، كان لابد أن يؤول إلى تسريب النظام الثاوي لعالم البداوة إلى بناء المعرفة؛ وذلك ابتداءً من الدور الحاكم الذي لعبته (أعني البداوة) في بناء السياسة.
[8] - ينتمي العقل، كتحقق وفاعلية، إلى جماعة ما بالمعنى الحضاري (عربية أو أوروبية أو آسيوية)؛ وذلك ابتداء من وحدة المشترك الثقافي بينها، ومن دون أن يكون أبداً مما يفرضه دينٌ بعينه. ورغم ما يبدو من أن فاعلية عقل ما قد تتجاوز، لأسباب تتعلق بالانتماء إلى دين واحد، حدود الجماعة الثقافية التي ينتمي إليها ذلك العقل إلى غيرها من جماعات مختلفة ثقافياً وعرقياً؛ وذلك كالحال مع العقل الذي يجرى الاصطلاح على تسميته «بالعقل الإسلامي» الذي تتجاوز فاعليته حدود الجماعة العربية إلى جماعات متباينة ثقافياً وعرقياً، ولكن موحَّدة دينياً، فإن ذلك لا يعني أبداً أنه عقلٌ يفرضه الإسلام، بقدر ما يبقى أنه عقل يرتبط بجماعة، راحت تؤسس لهيمنته عبر إخفائه وراء الإسلام، وحيث راح الآخرون يتقبلونه، لا بوصفه عقلاً يخص تلك الجماعة، وإنما باعتباره عقل الإسلام ذاته. ومن هنا، فهو لا محالة عقل «العرب»، لا عقل «الإسلام»، وحتى ضمن سياق أنه «عقل العرب»، فإنه كان عقل «البدو»، بما هو عقل امتثالي ناقل، وليس عقل «الحضر» الذي يتعذر تصوره إلا على نحو يكون فيه منفتحاً منتجاً.
[9] - وأعني به عقل النهضة أو الحداثة الذي أحال «أوروبا» -التي اصطدم بها عند مطلع القرن التاسع عشر بعد قرون من القطيعة والانفصال- من «تجربة مشروطة» تاريخياً ومعرفياً إلى «نموذج متعال»، وعلى نحو لم يتوقف معه عن اعتبارها، بما هي نموذج، «أصلاً» لكل تفكير في النهضة.
[10] - ولعل الإلحاح على اعتبار العقل جوهراً، إنما يرتبط بالنظر إليه -في التقليد المتوارث عن فلاسفة اليونان- كمقوَّم جوهري للإنسان يتميَّز به عن غيره من الكائنات. وكأداة فصل وتحديد للكائن الإنساني بما هو كذلك، فإنه كان يلزم تصوره جوهراً باطنياً أو مقوِّماً ذاتياً. وبالطبع، فإن هذا العقل الجوهراني يبقى هو أدنى ما يكون إلى العقل بالملكة أو بما هو استعداد وقوة خالصة، ولم يتحول بعد إلى فاعلية. ولكن العقل حين يتجاوز كونه مجرد «إمكان محض»، إلى الدخول في سيرورة يبتدئ فيها تحققه «بالفعل»، فإن ذلك لا يكون إلا داخل ثقافة تحدده. وفي كلمة واحدة، فإن ذلك يعني أن العقل «بالقوة» هو فقط ما يمكن النظر إليه كجوهر. وأما العقل المتحقق «بالفعل» فإنه لا يمكن تصوره إلا كتكوين مشروط داخل ثقافة بعينها.
[11] - حين ميّز ابن خلدون بين ثلاثة أنماط من العقول؛ هي التمييزي (الحسي)، والتجريبي (العملي)، والنظري (المعرفي)، فإنه قد جعل العقل التجريبي من نتاج التجربة (بمعناها العملي وليس العلمي) من جهة، ثم العرف أو التقاليد من جهة أخرى؛ وذلك «إذا قلد فيها الآباء والمشيخة والأكابر ولُقِّن عنهم ووعى تعليمهم، فيستغني عن طول المعاناة في تتبع الوقائع واقتناص هذا المعنى بينها». وعلى الرغم من كونه قد وقف، هكذا، عند حدود العقل العملي «الذي يفيد الآراء والآداب في معاملة أبناء جنسه وسياستهم»، ولم يتجاوز إلى العقل النظري المعرفي الذي هو موضوع التحليل هنا، فإنه يبقى -على أي حال- أنه قد مس فكرة العقل بما هو انبناء في الواقع والثقافة. لكنه يلزم التنويه، على أي حال، بأن هذا التصور الخلدوني لما سماه بالعقل التجريبي (العملي) يكاد يعكس بناء التاريخ الذي لم يحل اتساعه للتجربة -عنده- دون تمحوره حول مفهوم العصبية المتسرب من التقاليد القديمة؛ وبما يعنيه ذلك من كون التجربة والتقليد يحكمان تصوره لبناء كل من التاريخ والعقل العملي. والحق أنه يمكن اعتبار هذا العقل عنده، بمثابة العقل التاريخي. انظر: ابن خلدون: المقدمة، تحقيق وتقديم: علي عبد الواحد وافي (سبق ذكره) ج3، ص1013، 1009
[12] - ولعله يُشار هنا إلى أن مفهوم «نهاية التاريخ» الذي يجري تداوله بكثافة في السياق المعاصر، إنما يعكس ما يمكن اعتباره نهاية بالمثل لكلٍّ من العقل والواقع؛ وأعني من حيث يرتبط هذا المفهوم بتصور الواقع بما هو معطى نهائي ثابت، والذي يحيل، بدوره، إلى نوع من العقل الإذعاني التسليمي، غير النقدي. وغنيٌّ عن البيان أن هذين التصورين المتلازمين لكل من العقل والواقع يدنوان من أن يكونا بمثابة إعلان عن نهايتهما؛ وأعني من حيث يتم تجريدهما، في هذين التصورين، مما هو جوهر حياتهما الحقة؛ والتي هي التطور (خاصية الواقع الرئيسة) والنفي أو النقد (وهما جوهر بناء العقل).
[13] - ولعل مثالاً على ذلك يأتي من العقل الأوروبي الحديث الذي هو بمثابة انقطاع متحقق داخل تاريخه؛ وعلى نحو يستحيل فهمه بما هو كذلك خارج هذا التاريخ أبداً.
[14] - يلزم التمييز بين مستويين للثقافة التي تبلور العقل في الإسلام بحسب نظامها، والتي يجب القول عنها. فثمة الثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي الواسع الذي يرتد إلى حقبة ما قبل الإسلام، والتي كان لابد أن تترك بصمات لا تنمحي على هذا العقل، نظراً لامتداداتها الغائرة في الزمن الأبعد. وثمة مستوى الثقافة المكتوبة في الإسلام؛ والتي تكاد، بامتداداتها الأقرب نسبياً، أن تمثل فضاءً لظهور نظام عقل يجد أصوله الأنثروبولوجية الأبعد فيما يقوم قبلها، ولكن من دون أن يؤثر على حقيقة أن الثقافة المكتوبة في الإسلام كانت، وكنتيجة لتحولها إلى فضاء تتفاعل داخله جماعات حضارية مختلفة، ساحة لظهور أنواع أخرى من العقل، لم يُقَدَّر لأي واحد منها أن ينازع سلطة تكاد أن تكون مطلقة لذلك العقل المتجذر أنثروبولوجياً.
[15] - ولم يكن ذلك إلا النسق الأشعري الذي يظل يمارس، للآن، من خلال ما يقوم من التجاوب بين آليتي التقديس والتدنيس من جهة، والهيمنة والإقصاء من جهة أخرى. وإذ يستحيل التقديس، ضمن هذه الممارسة، إلى قناع لترسيخ هيمنة هذا «النسق» الخاصة، فإن التدنيس لم يكن إلا محض أداته في إقصاء الآخر المخالف. والحق أن حديث «الفرقة الناجية» الشهير، قد كان هو ساحة المجابهة بين كلا المفهومين، الاستيعابي والإقصائي، للثقافة في الإسلام. إذ فيما جرت قراءته من جانب النسق المهيمن على أن فرقة واحدة بعينها هي الناجية، وكل ما عداها هالكون في النار، فإن آخرين راحوا يقرأونه على أن فريقاً هو الأكثر براً وتقوى من غيره، ولكن من دون أن يعني ذلك أن ما سوى هذا الفريق من الهالكين. وبالطبع فإنه فيما تنطوي القراءة الأولى على ضرب من الإقصاء الصارخ للمغاير، فإن الثانية تحيل إلى استيعاب المغاير على نفس الساحة التي يتنافس عليها الكافة. وبالطبع فإنه فيما ترتبط القراءة الأولى بما يمكن اعتباره «عقلاً إقصائياً»، فإن الأخرى تؤشر على ما يبدو أنه العقل الاستيعابي. وكمثال على القراءتين انظر: البغدادي: الفَرق بين الفِرق، وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكة (دار الآفاق الجديدة) بيروت، ط1، 1973، ص4-5، وكذا: أحمد بن يحيي المرتضى: باب ذكر المعتزلة، نشرة توما أرنولد (مطبعة دائرة المعارف النظامية)، حيدر آباد الدكن، ص4
[16] - حين راح «محمد أركون» يحدد ما سماه بالعقل الإسلامي بكيفية اشتغاله على نحو يكون فيه تابعاً ومُقيَّداً (بالوحي)، وذلك ليميزه عن العقل العربي الذي حدده بأنه «العقل الذي يعبر بالعربية»، فإنه -ومن دون أن يدري- كان يتبنى تصوراً لعقل إسلامي ذي طبيعة محددة، صاغه وفرضه الإسلام. ولعل للمرء أن يتساءل عما إذا كان ثمة -بالمثل- عقلٌ يتحدد باللغة التي يعبر بها.
[17] - وبالطبع، فإن السيادة لو كانت قد تحققت لعقل أكثر انفتاحاً وتسامحاً؛ وبكيفية يكون معها قادراً على التحرر من الطبيعة التسلطية للعقل الذي تحققت له السيادة بالفعل، لأمكن تصور أن يرى هذا العقل نفسه كمجرد عقل -ضمن عقول أخرى- داخل الإسلام، ولا يتميز من غيره من تلك العقول التي تقف معه على نفس الساحة، إلا بأنه الأكثر قدرة من غيره على التجاوب الخلَّاق مع ما يزخر به واقعه من إشكاليات تفرض نفسها عليه بقوة.
[18] - بل إن باحثاً كبيراً، هو عبد العزيز الدوري، يرى «أن تاريخ الإسلام (بأسره) هو تاريخ صراع بين القبيلة والإسلام». نقلاً عن حليم بركات: المجتمع العربي المعاصر (مركز دراسات الوحدة العربية) بيروت، ط2، 1985، ص231
[19] - الجرجاني: التعريفات (مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر) القاهرة 1938، ص133
[20] - «إن الكلام على الإبل أخذ نحو جزء من أجزاء الكتاب (لسان العرب) السبعة عشر، فأنت إذا قلت: إن ما ورد في كلام العرب مما يتعلق بالإبل جزء من سبعة عشر جزءاً من مجموع اللغة العربية، لم تكن بعيداً عن الحقيقة، وهي نسبة جد كبيرة، ولكنه الجمل عماد الحياة العربية البدوية». انظر: أحمد أمين: فجر الإسلام (سبق ذكره)، ص77
[21] - إذا كان العقل مأخوذاً في اللغة من عقال البعير، فإن التقليد «في اللغة مأخوذ (بدوره) من قلادة البعير، فإن العرب تقول: قلَّدت البعير إذا جعلت في عنقه حبلاً يُقاد به، فكأن المقلد يجعل أمره لمن يقوده حيث شاء». وبهذا يتجلى العقل -بدلالة ارتداده مع التقليد إلى نفس الأصل اللغوي- بوصفه قوة «تقييد» في الأساس. انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: عماد زكي البارودي، وخيري سعيد (المكتبة التوفيقية) القاهرة 2008، ج2، ص188
[22] - ولعل المدخل لهذا التسرب يكمن فيما أورده القرطبي من أنه «ليس قول أهل الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا أئمتنا وآباءنا والناس على الأخذ بالكتاب والسنّة وإجماع السلف الصالح من الأمة، من قولهم: إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا وكبراءنا بسبيل؛ لأن هؤلاء نسبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول وأولئك نسبوا إفكهم إلى أهل الأباطيل، فازدادوا بذلك في التضليل، ألا ترى أن الله سبحانه أثنى على يوسف (عليه السلام) في القرآن حيث قال: {إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ *وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنا وَعَلَى النّاسِ} [يُوسُف: 37-38]. فلما كان آباؤه عليه وعليهم السلام أنبياء متبعين للوحي، وهو الدين الخالص الذي ارتضاه الله، كان اتباعه آباءه من صفات المدح». انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (سبق ذكره) ج2، ص189. لم يعد التقليد، إذن، مرذولاً بما هو كذلك، بل يكون مقبولاً إذا كان تقليداً للتنزيل، ومرذولاً إذا كان تقليداً لأهل الأباطيل. وحين يدرك المرء أن التقليد بذاته لا يمكن أن يكون سبيلاً لتعيين الحق من الباطل فيما يجري تقليده، بل إن ذلك يتحقق بفعل نظر وتعقل مجاوز للتقليد، فإن ذلك يؤول إلى أن التقليد بما هو كذلك هو فعلٌ واحد سواء كان تقليداً «للتنزيل» أو تقليداً «لأهل الأباطيل»، وأن ما يجعله مقبولاً في آن ومرذولاً في آن آخر، إنما هو فعل النظر الذي يقوم به العقل.
[23] - ومن هنا، فإنّ كل ما ورد من مادة «العقل» في القرآن، قد ورد في صيغة «الفعل» (تعقلون 24 مرة، ويعقلون 22 مرة، وعقلوه -نعقل- يعقلها، كل منها مرة واحدة). والعجيب أنها وردت كلها، إلا مرة واحدة، في صيغة الفعل للجمع، وليس للمفرد، وبما يعنيه ذلك من تصوره كفاعلية جمعية؛ وعلى نحو يدنو به من أن يكون العقل بمعناه الثقافي المجاوز للعقل الفردي.
[24] - ابن منظور: لسان العرب، ج4، (دار المعارف بمصر) القاهرة، بدون تاريخ، ص3046
[25] - وإذا كان الجابري قد انتهى، بعد قراءته لمادة «العقل» في اللغة وفي القرآن، إلى «إن معنى العقل في اللغة العربية، وبالتالي في الفكر العربي يرتبط أساساً بالسلوك والأخلاق»، فإنه يبدو أن قراءته لتلك المادة في القرآن قد خضعت تماماً لتوجيه المعنى القاموسي المرتبط بسياق عالم البداوة. انظر: الجابري: تكوين العقل العربي (سبق ذكره) ص ص30-31. فالسياق الذي يرد فيه فعل «التعقل» هو سياق تحرير في الأغلب؛ وأعني من حيث يتكشف عن السعي إلى فك ارتباط البشر مع تصورات يقيدون أنفسهم بها لوثوقهم في مصدرها (الذين هم الآباء الأوائل)، وليس لكونها موثوقة في ذاتها. ولعله يرتبط بذلك أن الفعل كثيراً ما يرد في سياق نوع من التساؤل الذي يعكس استنكار القرآن الفادح لهذا القيد الأبوي.
[26] - ولأن «الشاطبي» راح يبرر الخضوع لسطوة تلك السلطة بأن «رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل، وفي جاهلية جهلاء لا تعرف من الحق رسماً، ولا تقيم به في مقاطع الحقوق حكماً، بل كانت تنتحل ما وجدت عليه آباءها، وما استحسنه أسلافها من الآراء المنحرفة، والنحل المُخترعة، والمذاهب المُبتدعة»، فإنه قد راح يلمح ما ارتبط بذلك من رسوخ «آلية التقليد» حيث «أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في محاجة قومه: {قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها عاكِفِينَ *قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ *أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ *قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} [الشُّعَرَاء: 71-74]. فحادوا كما ترى عن الجواب القاطع المورد، فورد السؤال إلى الاستمساك بتقليد الآباء. وقال الله تعالى: {أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ *بَلْ قالُوا إِنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنّا عَلَى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ} [الزّخرُف: 21-22]. فرجعوا عن جواب ما أُلزموا به إلى التقليد، فقال تعالى: }قل أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟{. فأجابوا بمجرد الإنكار ركوناً إلى ما ذكروا من التقليد، لا بجواب السؤال». انظر: الشاطبي: الاعتصام (مطبعة المنار بمصر) ج1، الطبعة الأولى، القاهرة 1913، ص5-7. يمكن الوقوف عند ما أدركه الشاطبي، لا من قران التقليد بالخضوع فحسب، بل وإلى أن الركون إلى ما يقدمه التقليد من إجابات جاهزة، يرتبط بالنزوع إلى الاستهلاك المجاني غير المكلف للجاهز من الإجابات؛ وذلك بدلاً من عناء إنتاج إجابات حقة يقتضيها السؤال.
[27] - والحق أن هذا التقابل بين ما قصد الإسلام إلى ترسيخه من أنماط تفكير وممارسة، على أنقاض أنماط مناوئة لم تقبل الإزاحة، لم يقف عند حدود تصور «العقل» فقط، بل وتجاوز إلى تصورات أخرى منها -على سبيل المثال- السياسة؛ التي يكشف تحليلها، ممارسة وتنظيراً، عن الاختراق شبه الكامل للمخيال السياسي البدوي والقبلي، للمجال السياسي في الإسلام؛ وإلى حد ما يبدو من أن بنية المفاهيم السياسية قد استحالت إلى ساحة للاصطدام بين دلالات تنتمي إلى عالمين متصارعين؛ وأعني بالطبع عالم البداوة من جهة، وعالم الإسلام الذي جاء يسعى لرفعه من جهة أخرى.
[28] - ابن خلدون: المقدمة (سبق ذكره) ج2، ص ص513-514
[29] - ومن هنا ما لاحظه ابن خلدون من «أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب... (وذلك لأن) غاية الأحوال العادية كلها عندهم (هي) الرحلة والتقلُّب، وذلك مناقض للسكن الذي به العمران ومناف له؛ فالحجر مثلاً إنما حاجتهم إليه لنصبه أثافي للقِدر، فينقلونه من المباني ويخربونها عليه، ويعدونه لذلك. والخشب أيضاً إنما حاجتهم إليه ليُعَمِّدوا به خيامهم، ويتخذوا منه الأوتاد لبيوتهم، فيخرِّبون السقف عليه لذلك. فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل العمران». انظر: ابن خلدون: المقدمة (سبق ذكره) ج2، ص514
[30] - ولعله يمكن أن يُصار، هنا، إلى أن الأمر قد آل بالنسق الأشعري إلى تديين أو إضفاء الصبغة الدينية على «الانتهاب البدوي»، وذلك عبر اعتباره من قبيل الأرزاق. ومن هنا ما جرى المصير إليه، داخل النسق، من أن «كل ما غصب غاصب أو أخذه من المال أخذاً غصباً، فهو من الله له بتقدير وعطاء ورزق». وإذ يلزم عن ذلك «أن يكون الغصب رزقاً للغاصب»، وهو ما كان محلاً لاستنكار أظهره البعض بالفعل، فإن «الجويني»؛ وهو الرائد الأشعري الكبير، لم يتورع عن الإقرار بأن «هذا الذي استنكروه (هو) نص مذهبنا». وعليه، لم يعد الغصب، أو «النهب» في مصطلح «البداوة» ممارسة يأباها الدين، بل أصبح -بتعبير الجويني- «نص المذهب» الأشعري المهيمن. والغريب أنه وحتى حين راح الأشاعرة يربطون اعتبارهم «الغصب رزقاً» بتصور الرزق ليس «هو الملك»، بل هو «الانتفاع من غير رعاية الملك»، فإنهم كانوا يبررون، دينياً، ما تمارسه البداوة من انتهاب «ملك» الغير للانتفاع به. والحق أن «الانتفاع من غير رعاية الملك» الذي هو تعريف الأشاعرة للرزق يصلح بنصه أن يكون تعريفاً للنهب. انظر: يحيى بن الحسين: الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية، منشور ضمن: محمد عمارة: رسائل العدل والتوحيد (دار الهلال) القاهرة 1971، ج2، ص172. وكذا: الجويني: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق: محمد يوسف موسى (وآخر)، (مكتبة الخانجي) القاهرة، 1950، ص361-362
[31] - وإذ يبدو أن الأشعرية لم تفعل حقاً، من خلال الاختباء وراء هذا القصد النبيل، إلا أن جعلوا من ذات الله موضوعاً للتشويش والارتباك، فإن ذلك يحيل إلى أن الأمر إنما يتجاوز هذا القصد المعلن إلى ما يقوم، متخفياً، وراءه من مقاصد سياسية حاضرة أو مواريث أنثروبولوجية غائرة؛ أو حتى هما معاً.
[32] - وحتى حين بدا وكأن ثمة جهداً مبذولاً في المعرفة؛ وأعني في صورة الاجتهاد، فإنه يُلاحظ أنه لم يتبلور بما هو سعي إلى إنتاج معرفة جديدة تتجاوز المعرفة الجاهزة المُعطاة، بقدر ما انطوى على القصد إلى إلحاق فرع بأصل، أو إدراج ضروب الوقائع المُستجدة تحت المبادئ المُعطاة الجاهزة؛ وبما يعنيه ذلك من أن بذل الجهد يستهدف تثبيت سطوة الجاهز، وليس أبداً تجاوزه. لذا، فإن حدود الاجتهاد لا تجاوز دائرة المعرفة الاستلحاقية أو الاستتباعية.
[33] - صالح أحمد العلي: محاضرات في تاريخ العرب (مطبعة المعارف- بغداد) ج1، 1955، ص107 ولقد مضى البعض إلى أن «هذه الخاصة في العقل العربي هي السر الذي يكشف لك ما ترى في أدب العرب -حتى في العصور الإسلامية- من نقص تلمحه في كتب الأدب، حيث لا تجد موضوعاً واحداً أُلقيت عليه نظرة عامة دفعة واحدة، ثم وُضع في مكان واحد، ولكن هنا لمحة وهناك لمحة، وتدخل من باب فيُسْلمك إلى باب آخر لأقل مناسبة، حتى يعيا الباحث إذا أراد أن يقف على كل ما كُتب في موضوع معين». انظر: أحمد أمين: فجر الإسلام (سبق ذكره) ص ص69-70. وإذ يحيل ذلك إلى أن البعثرة والتشظي -التي تتبدى في أن معظم الإنتاج الأدبي للبداوة يقوم على التجاور بين عناصره وليس وحدتها الباطنة- هي أهم المآلات التي ينتهي إليها «التنقّل» بما هو سمة جوهرية للتفكير البدوي؛ فإن ذلك بعينه هو ما سيعيد النسق الأشعري المهيمن في الإسلام إنتاجه على صعيد البناء الأنطولوجي للعالم؛ وأعني من خلال تصوره كعالم مفكك يتخلله التقطُّع والانفصال، وليس ثمة ارتباط باطني بين ظواهره البتة. وبما هو كذلك، فإنه لا شيء يقوم بين هذه الظواهر إلا محض تجاورها؛ وأعني من حيث لا مجال لأي تداخل -ناهيك عن تفاعل- بينها. وإذ يقوم ذات الانفصال بين آنات الزمان أيضاً، فإن ذلك يحيل، ليس فقط إلى زمان مفتت لا ارتباط بين آناته، بل -والأهم- إلى تاريخ لا ترابط بين لحظاته؛ وبكيفية يسهل معها القفز -أو الطفر باللغة الأشعرية- من إحدى لحظاته إلى الأخرى، ومن دون أن تقوم بينهما أي علاقة، وهي الآلية التي تؤسس لسعى العقل العربي الراهن إلى تجاوز أزمة واقعه عبر القفز إلى ماضي الذات أو حاضر الآخر. وبهذا يكون «التنقُّل» -وبما يقترن به من تصور الأشياء مُفككة لا ترابط بينها- قد انعكس في أدب البداوة غياباً للوحدة وانعداماً للترابط الباطني بين عناصره، ثم راح ينعكس في بناء كل من العالم والزمان والتاريخ التي راحت تنبني جميعاً -في النسق الأشعري المهيمن في الإسلام- على نحو من الانفصال والخواء الذي يسمح لقوة مطلقة تقوم خارجها بالتدخل والتأثير فيها على نحو دائم؛ وذلك على حساب تصور قوانين باطنة تفعل فيها. انظر تفصيلاً لذلك في: علي مبروك: عن الإمامة والسياسة والخطاب التاريخي في علم العقائد (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) القاهرة 2002
[34] - «لقد كان اهتمامهم (أي العرب) السائد والحصري تقريباً مركزاً على الأشياء العيانية المفردة، أو بالأحرى على الأوجه المحسوسة من الأشياء المحسوسة. ويبدو وكأن لدى العرب متعة لا حدود لها بتفحُّص تفصيلات الأشياء العيانية التي كانوا يرونها حولهم بعيون نافذة. ومن هنا كان الغنى المذهل للمعجم العربي المعبر عن كل الأوجه التي يمكن ملاحظتها في الأشياء المحسوسة، إلا أنهم كما يبدو كانوا يفتقرون إلى القدرة العقلانية المتفوقة للذهاب في الاتجاه المضاد؛ أي ذلك الاتجاه الذي يخص التقدم خطوة بعد خطوة من الأشياء العينية والفردية وأوجهها المادية المحسوسة إلى الأفكار العامة المجردة متتبعين المسار المنطقي للعلاقة بين الأشياء المحسوسة والأفكار المجردة». انظر: توشيهيكو إيزوتسو: الله والإنسان في القرآن، ترجمة هلال محمد الجهاد (المنظمة العربية للترجمة) بيروت، ط1، 2007، ص119
[35] - الشهرستاني: الملل والنحل، تحقيق: عبد العزيز الوكيل (مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع) القاهرة، 1968، ج1، ص10
[36] - المصدر السابق، ج3، ص76
[37] - الباقلاني: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، نشرة محمد زاهد الكوثري (المكتبة الأزهرية للتراث) القاهرة 1369، ص13
[38] - الباقلاني: التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، نشرة محمود الخضيري ومحمد عبد الهادي أبو ريدة (دار الفكر العربي) القاهرة 1947، ص37
[39] - حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (منشورات مكتبة المثنى)، بغداد1386، ج1، ص32. ورغم ما يبدو من أن موضوع النص هم عرب الحواضر المشتغلين بالتجارة، وليس عرب البوادي المشتغلين بالإغارة، فإنه يُلاحظ أن هؤلاء الحضر كانوا أيضاً أهل «نقل»؛ وبما يعنيه ذلك من رسوخ «النقل» وثباته، وإلى حد استحالته إلى آلية تنتج نفسها في انفصال كامل عما يمكن اعتباره الشرط الاجتماعي التاريخي المحدد لظهورها واشتغالها.
[40] - المصدر السابق، الصفحة نفسها. وكذا: محمود شكري الألوسي: بلوغ الأرب (سبق ذكره) ج1، ص39.
[41] - محمود شكري الألوسي: بلوغ الأرب (سبق ذكره) ج1، ص38
[42] - ابن خلدون: المقدمة (سبق ذكره) ج2، ص487
[43] - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (دار المعارف بمصر) القاهرة ط4، 1979، ج4، ص277. وإذا كان طه حسين قد فسر مقولة عمر بأن العرب كانوا مصدر القوة العسكرية للإسلام، فإن خليل عبد الكريم ينعي على هذا التفسير أنه «اقتصر على جانب يسير وترك باقي الجوانب، بل أخطرها، ألا وهو أن العرب هم مصدر الكثير من الأحكام والقواعد والأنظمة والأعراف والتقاليد التي جاء بها الإسلام أو شرعها، حتى يمكننا أن نؤكد، ونحن على ثقة شديدة، بأن الإسلام ورث من العرب الشيء الوفير، بل البالغ الوفرة في كافة المناحي التعبدية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية». انظر: خليل عبد الكريم: الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية (سينا للنشر) القاهرة، ط1، 1991، ص ص11-12. ولعله يلزم التنويه بأن المنحى المعرفي أو النظري (الذي يتعلق بنظام العقل وآليات اشتغاله بالذات) -والذي لم يُشر إليه عبد الكريم حيث وقف عند حدود المناحي العملية- يكاد أن يكون هو الأخطر والأهم في الكثير مما ورثه الإسلام عن العرب.
[44] - «فقد حافظ العرب على نظامهم القبلي، عندما استوطنوا الأمصار الإسلامية، فكانت هذه الأمصار مقسمة إلى قبائل، ولكل منها خطة خاصة يسكن أفرادها معاً فيها، كما كانوا يستلمون عطاءهم سوية، وعلى كل قبيلة عريف خاص بها؛ والغالب أن أفرادها يحملون مسؤوليات مشتركة. فيدفعون دية القتل غير العمد الذي قد يرتكبه أحد أفرادها، كما تكون لهم الشفعة أو حق الأفضلية في شراء البيت الذي يُباع في خطتهم، ويرثون مال من لا وارث له في عشيرتهم، ويتحملون مسؤولية المشاغبين والمتمردين في عشيرتهم. ومن ثم، صار نظام القبائل هو أساس التنظيم الاجتماعي والإداري والمالي والجبائي في الأمصار الإسلامية. ولما ظهر الفقهاء في هذه الأمصار ودونوا معظم مظاهر الحياة فيها، وبذلك سجلوا كثيراً من النظم البدوية باعتبارها جزءاً من الشريعة الإسلامية، وقد صارت بذلك هذه النظم البدوية جزءاً من الشريعة الإسلامية المقدسة» انظر: صالح أحمد العلي: محاضرات في تاريخ العرب (سبق ذكره) ج1، ص109، 105. وبالتالي، لابد من ملاحظة الكيفية التي راح بها التقليد «البدوي» يخترق «الإسلامي» ويتخفى وراءه، وذلك عبر استمرار نظام عمرانه وطبائعه.
[45] - ولعل وقائع الاختلاف الشهير حول أرض السواد الذي نشب بين بعض كبار الصحابة، وبين عمر بن الخطاب، الذي أصر على عدم تقسيمها بين الفاتحين الذين كانوا، في معظمهم، من البدو، والذين تمسكوا -وعلى رأسهم بلال الحبشي- بوجوب تقسيمها عليهم إعمالاً لما جرى عليه النبي ثم خليفته أبو بكر، لتكشف، على نحو نموذجي، عن الكيفية التي راحت «طبائع العمران البدوي» تتخفى بها، وراء «طبائع العمران المغايرة» التي عرفتها البلدان التي فتحها الإسلام (والتي كان عمرانها أكثر تحضُّراً من ذلك الذي عرفته قبائل الجزيرة التي خرجت للجهاد والفتح)، وكذا عن الطريقة التي راحت تسبغ بها على نفسها قداسة «الدين» ومهابته. إذ الحق أن بمقدور المرء أن يلتمس شيئاً مما ينتمي إلى عالم البداوة السابق، قابعاً فيما وراء كل ما قيل من أسباب في تبرير إحجام عمر عن تقسيم تلك الأراضي المفتوحة على فاتحيها. فإذا استقر في وعي البدوي -بحسب ما سيؤكد ابن خلدون- «أن الفلاحة من معاش المستضعفين، ويختص منتحله بالمذلة... والسبب فيه ما يتبعها من المغرم المُفضي إلى التحكم واليد العالية، فيكون الغارم ذليلاً يائساً بما تتناوله أيدي القهر والاستطالة»؛ وبما يعنيه ذلك من استحالة أن تكون «الفلاحة» مما ينتحله البدوي، فإن «عمر» لم يكن مشغولاً فحسب بما يمكن أن يؤول إليه توزيع تلك الأراضي على البدو، مع احتقارهم المتأصل للفلاحة، من تخريبها وتعطيلها عن الإنتاج، أو لأن «قسمتها بين من حضر، لن تجعل لمن بقي بعدهم شيء»؛ بل لعله كان قلقاً -وهو الأهم، بما لابد أن يؤول إليه ذلك من جعل العربي، وبالذات حال قيامه على أمر تلك الأرض بنفسه (زراعة واستثماراً)، من أهل «المغرم المفضي إلى التحكم واليد العالية، فيكون ذليلاً». والملاحظ أن الوعي قد أبى إلا أن يجعل «الديني» متمثلاً في حديث النبي وقد رأى السِّكَّة (أو المحراث) ببعض دور الأنصار: «ما دخلت هذه دار قوم إلا دخله الذل»، وكذا حديثه -الذي يجعل فيه الاشتغال بالزرع حاملاً لدلالة الخروج عن الدين ذاته- «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم»، يتجاوب مع «الأنثروبولوجي» في اعتبار الفلاحة مورثة للمذلة. ومن هنا ما يُصار إليه من أنه «قد اتفقت كلمة عمر والصحابة على أن الأرض المفتوحة عنوة لا تُباع رقبتها ولا تُورث، بل تبقى على الملكية العامة (التي هي طابع حياة البداوة)، ولا يُباع حق استثمارها لمسلم (والأدق أن يُقال لعربي)، لما فيها من الخراج -وهو جزية الأرض- وهو يحمل من معاني الذل والصغار ما يحمل، وقد صدرت الأوامر من عمر بعدم شراء أراضي أهل الذمة -وهي الأراضي التي فُتحت عنوة وأُقر أهلها عليها، وضُرب عليها الخراج- فقال رضي الله عنه: لا تشتروا من عقار أهل الذمة ولا من بلادهم شيئاً، وقال: وأراضيهم فلا تبتاعوها، ولا يقرَّن أحدكم بالصغار (مذلة الخراج) بعد أن نجاه الله». وإذن، فإن الخشية من أن يصبح العرب أهل مغرم ومذلة، عبر الاشتغال بالأرض، كانت من بين ما دعا عمر إلى عدم تقسيمها بينهم، إبعاداً لهم عن التلوث بما يجلبه هذا الاشتغال من المذلة، ولكن مع التمتع بنتاجها كخراج يدفعه أهل المغرم والذل القائمون عليها إلى سادتهم الذين تولوا أمرهم. وهكذا احتفظ عمر للبدوي بأنفته من انتحال الصنائع والقيام بها (وأدناها الزراعة) من جهة، وكذا بتعيُّشه على ما ينتجه الآخرون في شكل خراج يدفعونه لسادتهم من جهة أخرى. وفي كل الأحوال، فإنه لم يكن للبدو أن يندمجوا، كمنتجين، في دورة إنتاج تفرضها طبائع عمران مغاير حلُّوا عليها، بل راحوا يحتفظون بطبائع عمرانهم البدوي طافية على سطح أنماط العمران السائدة في البلدان المفتوحة التي كان عليها أن تصب حصيلة إنتاجها بين يدي سادة لم يكفوا، ربما للآن، عن قطف ثمرات عمل الغير والتمتع بها. انظر: ابن خلدون: المقدمة (سبق ذكره) ج2، ص ص926-927، محمد روّاس قلعجي: موسوعة فقه عمر بن الخطاب، حلب 1396، ص65
[46] - ابن خلدون: المقدمة (سبق ذكره) ج2، ص941
[47] - المصدر السابق، ج3، ص1257
[48] - المصدر السابق، ج3، ص1258
[49] - المصدر السابق، ج3، ص1259. وتستمر أنفة البداوة من الصنائع حتى اليوم، «فالصناعات على اختلافها معدودة من المهن الخسيسة التي تحط بقدر صاحبها. ولذا، فالذين يحترفون هذه الصناعات، إما من غير العرب أو من العرب الذين ينتمون إلى أصول غير مشهورة أو غير قبيل. ومما يدل على احتقار الصناعات ألفاظ السباب المعروفة عند العرب (يا ابن الصانع) إذا أرادوا تحقير إنسان وسبه بكلمة تكون مجمع السباب، وبهذه المناسبة نذكر أن الملك ابن سعود في مجمع كبير (وكان حانقاً على آل عايض حكَّام أبها السابقين لما تكرر من خيانتهم له) قال لأحدهم هذه الكلمة (أي يا ابن الصانع)، فعندما انصرفوا وذهبوا إلى بيوتهم ابتدرته زوجته، وقالت له: لا يمكن أن أعاشرك بعد الآن؛ لأنك من أبناء الصُّنَّاع، لا من أبناء القبائل، وابن سعود لا يكذب، ولولا أن أُفهمت بعد أن ذلك كان عن بادرة غضب، ما أمكن أن تقتنع بالرجوع إلى بنيها. ولا تزال التجارة في البحرين من الحرف التي لا يصح اشتغال العربي الأصيل بها، ولذا كانت الأيدي غير العربية هي القابضة على زمام التجارة في البحرين، ومن الغريب أن العربي لا يزال يفضل رعاية الإبل والغنم والخدمة وراء الحمير على البيع والشراء والصناعة». انظر: حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر) القاهرة، ط1، 1935، ص ص152-153. وبالطبع، فإن العربي الأخير قد توقف -بعد ثلاثة أرباع القرن- عن رعاية الغنم والإبل وتفرغ للاستمتاع بفوائض نفطه التي لا يعرف حتى كيف يرعاها فوضعها بين أيدي الآخرين. ولأنه كذلك، فإنه وبعد أن ينضب نفطه، قبل أقل من ثلاثة أرباع قرن أخرى، سيكون مضطراً للعودة مرة أخرى إلى رعاية الغنم والإبل؛ فيما يبدو وكأنه انتقام «التاريخ» من أولئك الذين يظلون أسرى «الطبيعة» الجامدة.
[50] - السلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسول: طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب، تحقيق: ك. و. سترستين (مطبعة الترقي بدمشق)، 1949، ص ص4-5. ولعله يلزم التنويه هنا بأن علم الأنساب سوف يتحول من كونه أحد أهم علوم البداوة ليصبح علماً شرعياً بالأصالة، حيث إنه «لا خفاء أن المعرفة بعلم الأنساب من الأمور المطلوبة، والمعارف المندوبة؛ لما يترتب عليه من الأحكام الشرعية والمعالم الدينية؛ فقد وردت الشريعة المطهرة باعتبارها (أي الأنساب) في مواضع». انظر: القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، تحقيق إبراهيم الإبياري (الشركة العربية للطباعة والنشر) القاهرة، ط1، 1959، ص6
[51] - تجدر الإشارة إلى ما يبدو من التماثل الدال في العقاب الذي ينزل بمن يخرج على مقتضيات الإقرار بالأصل، في النسب، طرداً من القبيلة؛ على نحو ينتهي بهذا الطريد إلى معاناة الموت في شكليه المعنوي والفيزيقي، وبين العقاب الذي يلحق بمن يخرج عما يجري تصويره على أنه «قواعد الدين»، طرداً من الجماعة المؤمنة؛ ينتهي بفاعله أيضاً إلى الموت بمعنييه.
[52] - حيث «أنه قد عُلِم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول، على الجملة، لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي (الأصل)، فالابتداع مضاد لهذا الأصل». وبالطبع، فإن ذلك قد اقتضى تصور «الوحي» كأصل أول «لأن آدم عليه السلام لما أُنزل إلى الأرض، عُلِّم كيف يستجلب مصالح دنياه؛ إذ لم يكن ذلك من معلومه أولاً، إلا على قول من قال: إن ذلك داخل تحت مقتضى قول الله تعالى (وعلَّم آدم الأسماء كلها)، وعند ذلك يكون تعليماً غير عقلي، ثم توارثته ذريته كذلك في الجملة. لكن فرَّعت العقول من أصولها تفريعاً تتوهم استقلالها به. فلولا أن منَّ الله على الخلق ببعثة الأنبياء لم يستقم لهم حياة، ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم. وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين». انظر: الشاطبي: الاعتصام، ج1 (سبق ذكره) ص43-45
[53] - الشاطبي: الاعتصام، ج1 (سبق ذكره) ص45
[54] - ولعله يرتبط بذلك ما مضى إليه أحد المعاصرين من أن «علماء نجد محافظون على القديم جداً، ولاسيما ما يتعلق بالدين، فهم يرون بقاء العقيدة سليمة كما وردت في الكتاب والسنة من غير حاجة إلى تأويل، ويقولون ليسعنا ما وسع عصر النبوة وخير القرون، وترى كتبهم مشحونة بالرد على الفرق التي تجنح إلى التأويل أو تطبيق النظريات الفلسفية في العقائد». انظر: حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين (سبق ذكره) ص150. وفي كلمة واحدة فإنه الانتقال من سلطة «السلف/العرف» إلى سلطة «السلف/النص».
[55] - ومن هنا أن ما صار إليه «محمد أركون» في توصيفه لما اعتبره «العقل الإسلامي» من أنه عقلٌ «يتقيَّد بالوحي أو المعطى المُنزَّل، ويقر أن المعطى هو الأول لأنه إلهي، وأن دور العقل ينحصر في خدمة الوحي....، فالعقل تابعٌ وليس بمتبوع إلا بالقدر الذي يسمح به اجتهاده المُصيب لفهم وتفهيم الوحي»، إنما ينطبق على عقل البداوة الذي اخترق الإسلام، وتحققت له السيادة داخله من خلال التخفي تحت أقنعة مذاهب فقهية وعقائدية ترسَّخت وسيطرت. لذلك، فهو ليس عقلاً فرضه الإسلام، بقدر ما هو عقلٌ جرى فرضه داخله. والغريب حقاً أن أركون نفسه يشير إلى أنه «لو استمرت المناظرات بين العقل (المعتزلي) القائل بخلق القرآن، وبين العقل الخادم الخاضع للقرآن غير المخلوق (الأشعري السني)، لكان الوضع المعرفي للعقل الإسلامي اليوم على غير ما هو عليه، أعني أن الفسحة العقلية ما كانت لتصبح ضيقة محدودة تسودها الأرثوذكسية العقائدية إلى الدرجة المعروفة اليوم»؛ وبما يعنيه ذلك من أنه كانت هناك إمكانية لعقل آخر، لو كانت الغلبة قد تحققت للعقل المعتزلي؛ الذي يكاد يحمل، في المقابل، سمات العقل الحضري المنفتح والمنتج للمعرفة، وليس العقل الامتثالي الناقل لها فحسب. وإذ يبدو هكذا أنه لا وجود لما يُقال إنه «العقل الإسلامي»، بل ثمة وجود فقط لعقل حدث في الإسلام وتحققت له السيادة داخله، فإن ذلك يحيل إلى أن مفهوم «العقل الإسلامي» -الذي يستخدمه أركون- مسكون بحمولة إيديولوجية طاغية. إن إيديولوجيته، ولا علميته، تتأتى من إشارته إلى ما لا وجود له (أي العقل المنسوب إلى الإسلام بما هو أصله)، وإخفاء ما هو موجود بالفعل (أي العقل الذي نشأ في الإسلام وتسيَّد داخله). ولا سبيل للاحتجاج هنا بأن أركون قد استحضر مفهوم «العقل الإسلامي» قصد نقده، لأن هذا النقد يبقى نقداً زائفاً ابتداء من تعلقه بما لا وجود له. ومن جهة أخرى، فإن الحديث عن «عقل إسلامي» يحمل سمات بعينها، يحيل إلى ما يبدو وكأن تلك السمات قد فرضها الإسلام؛ وعلى النحو الذي يؤدي إلى أنه إذا كان هذا العقل يبدو مقيداً وخادماً لما يقوم خارجه، فإنه سيُصار إلى أن هذا التقييد للعقل يكون من فعل الإسلام؛ وبما يعنيه ذلك من أن الإسلام هو الأصل في عجز هذا العقل. وهكذا يؤول الأمر إلى التطابق مع خطاب هجاء الإسلام وتبخيسه بما هو أصل كل الشرور والآثام التي تعانيها المجتمعات الإسلامية. وبالطبع فإنه لا مجال للشك بحال فيما يطفح به هذا الخطاب الأخير من نزعة إيديولوجية زاعقة، ولا علاقة لها بأي معرفة علمية أبداً، حيث إنه يعكس مقولات الخطاب الاستشراقي الكلاسيكي؛ وأعني في أكثر صورها عنصرية ولا علمية.
[56] - انظر تحليلاً وافياً لذلك في: على مبروك: ما وراء تأسيس الأصول؛ مساهمة في نزع أقنعة التقديس (دار رؤية للنشر) القاهرة 2007. ويكاد الكتاب بأسره أن يكون بمثابة بيان لهذه الأطروحة.
[57] - ويُشار هنا إلى أن باحثاً كبيراً، بحجم أركون، قد انساق وراء هذه المراوغة، ولم يقدر -انطلاقاً من فرضيته الحاكمة أن ثمة عقلاً قد فرضه الإسلام- على كشف ما تنطوي عليه من إيهام؛ وذلك حين مضى إلى أنه «ينبغي على التحليل النقدي الذي نقوم به الآن أن يبين كيف أن هذا المرور (أو الانتقال) من الاعتقاد إلى العقل هو شيء عام ومشترك لدى كل أنواع الفكر الخاضعة لإكراهات الإيمان وأوامره. إنها تحول الفرضيات غير المُبرهن عليها والكائنات العقلية غير اللازمة إلى نوع من الحقائق الموضوعية المُبرهنة المُتحقق منها بمعونة القواعد المشتركة لدى كل مستخدمي العقل التطبيقي أو بالأحرى العملي». وإذ يبدو أن هذا العقل الذي يتحدد -حسب أركون- بالإيمان أو الدين، هو ما يؤسس لقوله ليس فقط عن «العقل الإسلامي»، بل وعما يمكن تسميته بالعقل الكتابي؛ الذي هو «عقل ثيولوجي شغَّال وفعَّال ماضياً وحاضراً في كل مجتمعات الكتاب»، فإنه يلزم التنويه بما تجادل به هذه القراءة من التحديد الأنثروبولوجي، وليس الديني، لهذا العقل، ليس فقط في الإسلام، بل وحتى في المجتمعات الكتابية. انظر: محمد أركون: تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ترجمة: هاشم صالح (سبق ذكره) ص ص70-71
[58] - أحمد أمين: فجر الإسلام (سبق ذكره) ص64. ولعل ذلك الفهم، بحسب العادة، هو ما يكاد يقطع به قول ابن خلدون من أن «للبادية من أهل العمران طب يبنونه في غالب الأمر على بعض الأشخاص متوارثاً عن مشايخ الحي وعجائزه. وربما يصح منه البعض، إلا أنه ليس على قانون طبيعي، ولا على موافقة المزاج»، بل إنه -ويمكن للمرء أن يُكمل- كان على مجرى عاداتهم. انظر: ابن خلدون: المقدمة (سبق ذكره) ج3، ص1143
[59] - وبعبارة أخرى، فإنه فيما كان إنكار البداوة لفكرة الضرورة المجردة ينبني على نزعة حسية لا تجاوز حدود الملموس، فإن الإنكار في السياق الأشعري قد استند إلى أساس ميتافيزيقي لا يرى في العالم فعلاً إلا ويلزم نسبته إلى الله في الحقيقة.
[60] - الغزالي: تهافت الفلاسفة، تحقيق: سليمان دنيا (دار المعارف بمصر) القاهرة، ط2، 1947، ص223
[61] - الطوسي: الذخيرة (بهامش تهافت الفلاسفة) تحقيق: رضا سعادة (الدار العالمية- بيروت) ط2، 1983، ص323
[62] - الغزالي: تهافت الفلاسفة (سبق ذكره) ص226
[63] - دي. بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة: محمد عبد الهادي أبوريدة (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر) القاهرة، 1938، ص70
[64] - أحمد أمين: فجر الإسلام (سبق ذكره) ص73
[65] - جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (دار العلم للملايين) بيروت، ط2، 1976، ج8، ص18
[66] - محمد جابر الأنصاري: التأزم السياسي عند العرب وسوسيولوجيا الإسلام (سبق ذكره) ص59
[67] - ابن خلدون: المقدمة، ج2 (سبق ذكره) ص514
[68] - ومن هنا ما يُقال «كأن في البدو سراً ليس في الحضارة، فإن الطبيعة قد قضت على الحضر بالتقلُّب والتخلُّق، وعلى البدو بالثبات على حالة واحدة؛ فالبدوي أشبه برحى تدور على محورها، وترجع إلى حيث كانت دون أن يؤثر فيها الدوران». انظر: سليم البستاني: البدو، مجلة المقتطف، مجلد 12(مطبعة المقتطف) مصر، 1887، ص134
[69] - السنوسي: عقيدة أهل التوحيد الكبرى (مطبعة جريدة الإسلام) مصر، 1898، ص87
[70] - حين يقطع الشيخ «جابر الصباح» الأخ الشقيق لحاكم الكويت آنذاك، في مواجهة مُحدِّثه -في بداية القرن الماضي- قائلاً: «الرعية مثل الغنم كلما طال صوفها جذذناه، وإن الحاكم يجب أن تكون يده مطلقة في كل شيء؛ في المال وفي الأرواح والرعية»؛ فإن المرء يتساءل عما إذا كان هذا النزوع الإطلاقي اللافت يرتد إلى بداوته أم إلى أشعريته. وهي الإطلاقية التي قطع بها أحد مشايخ بدو نجد، حين هتف -بعد أن سمع عن ملوك أوروبا أنهم يتقيدون بالقوانين- قائلاً: «ليس هؤلاء ملوكاً، فإن من لا تُطلق يده على الخزانة، ومن تكف يده (عن الأرواح) بهذا الشكل، ليس بملك». انظر: حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين (سبق ذكره)، ص155، 157. والحق أن هذه الإطلاقية التي تأخذ مضموناً سياسياً مع البداوة، هي الوجه المتعيِّن للإطلاقية الأشعرية التي تأخذ وجهاً دينياً مراوغاً يتخذ فيه الحاكم من الله قناعاً يتخفّى خلفه.
[71] - ولعل هذا الإبدال للشرع بالقوة كمحدد للقيمة ووازع للإنسان، يتبدى فيما أشار إليه ابن خلدون من «أنهم (أي العرب) لخلق التوحُّش الذي فيهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرياسة؛ فقلما تجتمع أهواؤهم. فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم، وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم، فسهل انقيادهم واجتماعهم؛ وذلك بما يشملهم من اللين المُذهب للغلظة والأنفة الوازع عن التحاسد والتنافس». وهكذا يتبدل الوازع من «القوة الغليظة» إلى «الشرع أو الدين السمح»، ولكن بكيفية يظل معها هذا الوازع خارجياً على الدوام.
[72] - محمود أمين العالم: مفاهيم وقضايا إشكالية (دار الثقافة الجديدة) القاهرة، ط1، 1989، ص138
[73] - عادل مجاهد سلام: التحضُّر والبنية القبلية في اليمن، أطروحة ماجستير غير منشورة، قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ص273