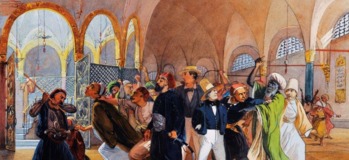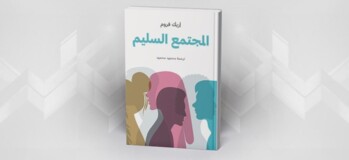الوعي بوصفه جسراً معرفياً نحو الحرية
فئة : مقالات

الوعي بوصفه جسراً معرفياً نحو الحرية
(تحليل نقدي للعلاقة التأسيسية بين الوعي والتحرر في المجتمعات العربية المعاصرة)
”إن المعرفة هي الشرارة الأولى التي توقظ الوعي من سباته، والوعي هو البصيرة التي تهدي الإنسان إلى نفسه والعالم. أما الحرية، فلا تهبط من السماء، بل تنمو كنبتة من هذه الأرض المعرفية الواعية، فكل إنسان بلا معرفة عبد وهو لا يدري، وكل وعي بلا حرية نداء لا يُسمَع“. (الكاتب)
الملخص:
يحاول هذا المقال الكشف عن العلاقة المتشابكة بين المعرفة والوعي والحرية بوصفها سلسلة مترابطة تشكل أساس التحرر الإنساني والاجتماعي. تنطلق الدراسة من مقولة علي شريعتي: ”لا حرية دون وعي، ولا وعي دون معرفة“، لتسبر أغوار كيفية تحول المعرفة إلى وعي نقدي، وكيف يمكن للوعي أن يمكّن الإنسان من ممارسة حرية حقيقية ومسؤولة. كما يعرض المقال أدوات وآليات تمكين الأفراد من فهم هذه العلاقة، مع تحليل نقدي لمأزق العالم العربي في استثمار هذه السلسلة التأسيسية. وأخيراً يعتمد المقال على المنهج التحليل والنقدي في مناقشة هذه العلاقة.
المقدمة:
تعد مفاهيم المعرفة والوعي والحرية من أعمدة الفكر الفلسفي والاجتماعي والسياسي، فهي ليست مجرد مصطلحات نظرية، بل أدوات فاعلة لفهم الواقع وتحقيق التحول الفردي والاجتماعي. الفلاسفة الاجتماعيون المعاصرون شددوا على أن الحرية الحقيقية لا تتحقق إلا عبر وعي متأصل بالذات وبالواقع المحيط، وأن هذا الوعي لا ينشأ إلا من معرفة نقدية دقيقة.
وفي هذا السياق، يبرز علي شريعتي (1933-1977) بمقولته الشهيرة التي تربط بين المعرفة والوعي والحرية، موضحاً أن تحرر الإنسان من القيود الخارجية لا يمكن أن يتحقق إلا إذا سبقته رحلة معرفية وعقلية نقدية.
يسعى هذا المقال إلى تقديم قراءة نقدية لهذه السلسلة المعرفية، مع إبراز الآليات التي تجعل المعرفة أساساً للوعي، والوعي شرطاً للحرية، وتوضيح سبل التمكن من فهم هذه العلاقة في السياق العربي الراهن.
بناءً على ما تقدم، سنسعى إلى مناقشة العناصر التالية:
1- المعرفة كأصل لبناء الوعي: إن المعرفة ليست مجرد تراكم للمعلومات، بل هي أداة تحليلية تمكن الفرد من فهم الواقع وتفسير الظواهر الاجتماعية والثقافية والسياسية وفق معايير دقيقة. وقد قسم الفلاسفة المعاصرون المعرفة إلى مستويات متدرجة، تشمل المعرفة الحسية والمعرفة العقلية وصولاً إلى المعرفة النقدية التي تتيح التقييم الموضوعي للأحداث والأفكار.
وفي السياق العربي، يشير محمد عبد الجابري (1935-2010) إلى أن المعرفة ليست هدفاً في حد ذاتها، بل وسيلة لبناء وعي نقدي يمكّن الفرد من التعامل مع تحديات الواقع بشكل عقلاني ومنهجي، فالمعرفة تمنح الإنسان القدرة على التمييز بين الحقيقة والدعاية، وتمييز التحليل الصحيح عن التكرار الأعمى، والمعلومة عن الافتراض.
ويرى الجابري أن العلم لا يؤمن بمصدر آخر للعقل وقواعده غير الواقع. ومن دون شك، فإن قواعد العقل إنما تجد مصدرها الأول في الحياة الاجتماعية التي تشكل أول أنواع الواقع الحي الذي يحتك به الإنسان، بل ويعيش في كنفه. والحياة الاجتماعية لا تستقيم إلا بقواعد للتعامل، والإنسان لا يحيا حياة اجتماعية إلا بخضوعه لتلك القواعد.
بذلك تتجلى أهمية المعرفة أيضاً في كونها تمثل أرضية خصبة لنشوء التفكير النقدي المستمر، فهي لا تقتصر على جمع الحقائق، بل تمتد إلى فهم العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية بعمق، وهو ما يمهد الطريق لبناء وعي متكامل. كما يشير حسين مؤنس (1911-1996) في كتابه "تاريخ موجز للفكر العربي" إلى أن المعرفة في السياق العربي يجب أن تتجاوز التلقين التقليدي لتصبح قوة محركة للتحول الاجتماعي والثقافي.
وهذا يعني أن تجاوز المعرفة لحدود التلقين التقليدي يعتبر أحد الشروط الأساسية لنهضة الفكر العربي وإمكاناته التجديدية على اعتباره السبب الرئيس في ركود الفكر العربي وتوقفه بعد حقبه من الزمان طويلة. بذلك يرتكز تجديد الفكر العربي بشكل أساسي على تجديد العلم أو توسيع قاعدة المعرفة والاطلاع، وهو ما يعبر عن إدراك عميق بأن الاقتصار على التلقين الجامد يبقي المعرفة حبيسة الإطار المدرسي الضيق، ويحول دون تحولها إلى قوة حقيقية في صياغة الوعي الجمعي. إن استدعاء هذه الفكرة يكشف عن بُعد سوسيولوجي وفلسفي في آن معاً؛ إذ يربط بين المعرفة كعملية ديناميكية مستمرة، وبين قدرتها على إحداث التحول الاجتماعي والثقافي. فالمعرفة، بحسب هذا التصور، ليست تراكماً معلوماتياً ينقل من جيل إلى جيل، بل هي ممارسة نقدية تعيد تشكيل الوعي، وتمنح الفرد والجماعة أفقاً للحرية، ووسيلةً لمواجهة تحديات الواقع المعاصر. ومن هنا، يغدو التجديد الفكري، عبر الانتقال من المعرفة الموروثة إلى المعرفة الفاعلة، التي تتجاوز النقل السلبي لتصبح شرطاً للتحرر الاجتماعي والثقافي. وهذه محاولة لإعادة النظر في التراث العربي الفكري كله.
وفي النهاية، يذهب الجابري في كتابه "تكوين العقل العربي" أن الفكر بوصفه أداة للإنتاج النظري صنعتها ثقافة معينة لها خصوصيتها، هي الثقافة العربية بالذات، الثقافة التي تحمل معها تاريخ العرب الحضاري العام، وتعكس واقعهم أو تعبر عنه وعن طموحاتهم المستقبلية كما تحمل وتعكس وتعبر، في ذات الوقت، عن عوائق تقدمهم وأسباب تخلفهم الراهن.
2- الوعي كوسيط بين المعرفة والحرية: يتشكل الوعي عندما يتحول الإنسان من مجرد ناقل للمعلومات إلى مفكر ناقد قادر على تحليل الواقع بعمق. فالوعي هو الإدراك العميق للبنى الخفية التي تشكل الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية، بما في ذلك القوى المؤثرة على الفرد والمجتمع، مثل: الأعراف والعادات، القيم الثقافية، والدعاية السياسية.
ولا يمكن للوعي أن يظهر دون معرفة نقدية؛ إذ إن المعلومات وحدها لا تكفي لتشكيل فهم حقيقي للواقع. الإنسان الذي يفتقر إلى وعي نقدي قد يظن نفسه حرًّا، لكنه في الواقع يسير وفق التوجيهات الخارجية أو العادات الاجتماعية الجامدة. يؤكد شريعتي في كتابه "النباهة والاستحمار" أن القدرة على التساؤل والبحث والتفكير المستقل هي شرط أساسي للنجاة من العبودية الفكرية والاجتماعية.
وبذلك، يصبح الوعي الجسر الحيوي الذي يحول المعرفة النظرية إلى إدراك عملي يمكّن الفرد من اتخاذ قرارات حرة ومسؤولة، بعيدًا عن التأثيرات الخارجية الخفية أو التقليد الأعمى.
3- الحرية كثمرة للوعي والمعرفة: باختصار شديد إن الحرية الحقيقية ليست مجرد غياب القيود، بل هي القدرة على اتخاذ قرارات واعية ومدروسة وفق مبادئ أخلاقية وعقلانية. والحرية تتحقق عندما يمتلك الإنسان وعياً نقديًّا قائمًا على معرفة دقيقة تمكنه من إدراك خياراته وفهم الآثار المترتبة على أفعاله. بذلك تصبح "الحرية المسؤولية".
ففي المجتمعات التي تفتقر إلى وعي نقدي، يبدو الأفراد أحراراً، بينما في الواقع يخضعون لعوامل غير مرئية مثل التقاليد الاجتماعية أو الخوف أو الدعاية السياسية. وعليه، لا يمكن أن تتحقق الحرية إلا على أرض معرفية صلبة، حيث تتكامل المعرفة والوعي لتنتج تحرراً حقيقياً على الصعيدين الفردي والاجتماعي.
خلاصة القول إن الحرية عملية مركبة، تتداخل في توليدها معطيات كثيرة، وتستوجب "... ثلاثة شروط في حالة يصح أن تنطبق عليها كلمة حرية، أولاً: المعرفة الواعية، ثانياً: إمكانية الاختيار، ثالثاً: القدرة على تنفيذ هذا الاختيار".
4- آليات الترابط بين المعرفة والوعي والحرية: إن العلاقة بين المعرفة والوعي والحرية ليست عشوائية، بل هي سلسلة مترابطة متكاملة. تبدأ بالمعرفة التي تمد الفرد بالمعلومات الضرورية، ثم يتحول هذا الأساس إلى وعي نقدي قادر على التحليل والتقييم، لينتج في النهاية حرية حقيقية ومسؤولة. أي خلل في أحد هذه العناصر يضعف الآخر، ويحوّل مفهوم الحرية إلى وهم.
ويخبرنا التاريخ السياسي أن المجتمعات التي تمكنت من نشر المعرفة النقدية وتعزيز الوعي استطاعت تحقيق تغييرات اجتماعية وسياسية ملموسة، بينما المجتمعات التي غابت عنها هذه العناصر بقيت رهينة للجمود الفكري والسياسي.
كما يمكن ملاحظة ذلك من التاريخ العربي الحديث، حيث أثمرت بعض الثورات الكبرى في العالم نتيجة امتلاك وعي جماعي نابع من المعرفة، في حين فشلت محاولات التحرر في مجتمعات أخرى بسبب غياب هذا التأسيس المعرفي والنقدي ومن بينها المجتمعات العربية.
ويعتقد شريعتي أن هذا الوضع ناتج بشكل أساس عن مفهوم الاستحمار الذي يعني تزييف ذهن الإنسان ووعيه وشعوره وحرف الإنسان عن ذاته ووعيه للوجود وغاياته، ولفلسفة الحياة بما تنطوي عليه من شبكة من العلاقات بين الإنسان والمجتمع، والإنسان والطبيعة والإنسان والله. ويرى أن هذا المفهوم ينقسم إلى قسمين أساسيين: الاستحمار المباشر يقوم في نظر شريعتي على تجميد الأذهان، والجهل والضلال والانحراف. أما الاستحمار غير المباشر، فهو عبارة عن إلهاء الأذهان بالحقوق الجزئية لتنشغل عن المطالبة أو التفكير بالحقوق الأساسية الكبرى. وأول خطوة من خطوات الاستحمار هي الاستنزاف وتعني استنزاف الوعي، أو سلب الوعي، وحين يُسلب الوعي يسلب الإنسان كإنسان، ولا يبقى بعدها ذو خطر، سواء كان إنساناً عادياً، أم عالماً أم مثقفاً أم فيلسوفاً.
ويذهب شريعتي إلى أن الاستحمار، هو الاستعمار الجديد، القائم على السيطرة النفسية والروحية غير المباشرة على الشعوب والجماعات والأفراد في العالم. ففي كتابه "النباهة والاستحمار" يعتقد شعريتي جازماً أن الاستحمار هو بمثابة الاستعمار الجديد الذي يسلب الإنسان وعيه؛ إذ لا يمكن لإنسان أن يكون حرّاً وهو لا يمتلك وعياً بناه على أساس معرفي، فحرية الإنسان تبدأ من معرفته بذاته ومجتمعه، فإذا جَهِلَ فقد وُضِع في قيد وإن ظن أنه طليق، وهذا يعني أن الوعي ليس شعاراً، بل ثمرة معرفة، وبدون وعي لن تتحرر الشعوب.
5- سبل التمكن من فهم العلاقة: تمكين الأفراد من إدراك العلاقة بين المعرفة والوعي والحرية يتطلب تبني نهج شامل يشمل على التعليم النقدي الذي يعزز التحليل والمناقشة بدل الحفظ والتلقين، الانخراط الفعلي في النقاشات الفكرية والسياسية، واستخدام المصادر العلمية الموثوقة للتفريق بين الحقيقة والدعاية.
كما يعد تشجيع القراءة المستمرة والبحث الشخصي عاملاً محوريًّا في بناء وعي نقدي يمكنه تمكين الفرد من ممارسة الحرية على أسس متينة. ويشير الطهطاوي (1801-1873) في كتابه "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" أن التمدن لا يتحقق إلا بالعلوم والعقل، معتبراً أن التعليم أساس الرقي معنى ذلك أن الثقافة العربية تحتاج إلى إعادة بناء شاملة للوعي المعرفي عبر التعليم والممارسة النقدية لتجاوز الجمود التقليدي.
6- مأزق العالم العربي في إدراك العلاقة: على الرغم من غنى التراث العربي الفكري، تشير الدراسات النقدية إلى وجود ضعف في استثمار المعرفة لبناء وعي يؤدي إلى حرية فعلية. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها الجمود التعليمي الذي يركز على الحفظ دون النقد، الضغوط السياسية والاجتماعية التي تحد من النقاش الحر، والهجوم على المثقف المستقل.
ويُعرَّف التراث بأنه ما خلفه الأجداد لكي يكون عبرةً من الماضي ونهجاً يستقي منه الأبناء الدروس ليعبروا بها من الحاضر إلى المستقبل. والتراث في الحضارة بمثابة الجذور في الشجرة، فكلما غاصت وتفرعت الجذور كانت الشجرة أقوى وأثبت وأقدر على مواجهة تقلبات الزمان. ... كذلك فكل الناتج الثقافي للأمة يمكن أن نقول عنه ” تراث الأمة “.
وفي حقيقة الأمر يخضع الفكر العربي لوصاية التراث والمجتمع، ولم يتجرأ حتى الآن على خوض الصراع مع المرجعية التراثية (العادات والتقاليد والخرافة والمعرفة اللا علمية)، التي تأخذ في كثير من الأحيان طابع المقدس في المخيلة العربية، حيث إن كل ماضٍ مقدس، وكل مقدس يتم توارثه دون مراجعة. فالمجتمعات التي تقدس التراث يكون العقل أول ضحاياها. وهذا يصدق على الواقع الاجتماعي الذي تحكمه العادات، والذي لكثرة ما سمعه الناس، وَقَر في نفوسهم كشيء مقدس. والإنسان العربي عموماً هو ضحية هذه النظرة اللا عقلانية، التي تضع التاريخ والثقافة خارج النقد والتقويم، مما يعيق دور علم الاجتماع بمعالجة المشاكل الجوهرية التي يعاني منها الواقع العربي.
نتيجة لذلك، يبقى الإنسان العربي في مأزق بين المعرفة النظرية والوعي العملي، مما يحد من قدرته على ممارسة الحرية الفعلية. فالمجتمعات التي تفتقر إلى هذه السلسلة التأسيسية تبقى غير قادرة على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية المعاصرة، ويصبح التحول الحقيقي في مستوى الأفراد والمجتمع مستحيلاً بدون إصلاحات شاملة.
خلاصة القول، يؤكد المقال أن المعرفة والوعي والحرية تشكل سلسلة مترابطة لا يمكن فصل عناصرها دون الإضرار بالكل. أي محاولة للتحرر دون أساس معرفي أو وعي نقدي ستظل سطحية وغير فعالة. ويبرز دور التعليم النقدي والانخراط المجتمعي واستخدام المصادر الموثوقة كأدوات حقيقية لتأسيس وعي متكامل يؤدي إلى حرية حقيقية ومستدامة.
وبذلك، يمكن للعالم العربي تجاوز مأزقه الحالي في مواجهة القيود الفكرية والاجتماعية، وتحقيق تحرر فردي ومجتمعي مبني على أسس معرفية وعقلية صلبة، تتيح للفرد ممارسة اختياراته بحرية ومسؤولية، وتعزز قدرته على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل بثقة ومعرفة.
أما على الصعيد الأكاديمي لدور علم الاجتماع في بناء الوعي العربي وتحريره، نجد أن دور علماء الاجتماع العرب ومسؤوليتهم الأخلاقية والعلمية تلعب درواً مهمًّا في هذا السياق، فمن المعلوم أن النظريات والمناهج الاجتماعية طورها علماء وهبوا أنفسهم للعلم، وقد فهم هؤلاء العلم رسالة ومسؤولية، رسالة لفهم الكون وتفسيره والحفاظ عليه. ومن ثم، فإن للمناهج بعدا قيميا وأخلاقيا وإنسانيا، وهذا تأخذه عن الثقافة. وقيم المفكرين تجسدها مناهجهم، وهذا ما تعبر عنه علاقة المنهج بالإيديولوجيا، وبإنتاج المعرفة والفكر مرتبطتين بطريقة رؤيتنا للكون. فعلى سبيل المثال، فإن المنهج الفيبري، أو المنهج التاريخي الاجتماعي المطبق على دراسته (الأخلاق البروتستانتية والروح الرأسمالية)، يرى أن حركة الإصلاح البروتستانتية، هي التي أسست الحضارة الغربية، فهو يقرأ تقدم المجتمعات وتخلفها من خلال حركة الإصلاح البروتستانتي. كما نجد إيديولوجيا ماركس قائمة في منهجه، وكذلك إيديولوجيا فيبر وبارسونز.... إلخ، والإيديولوجيا فكر وقيم سياسية وثقافية ومعرفية. ولا نجد عالماً ذا مدرسة دون هذا البعد الإيديولوجي، والعلوم الاجتماعية كلها ليست بعيدة عن الإيديولوجيا، والإيديولوجيات هي الرؤى المتعددة للكون، وإن هذه الرؤى المختلفة هي التي تكون النظريات والمدارس، فتبرز المدراس الفكرية بقدر ما يوجد من اتجاهات نظرية.
نستنتج مما سبق أن مدراس علم الاجتماع طورها مفكرون وعلماء أصحاب رؤى اجتماعية. وهذه الرؤية تسعى إلى تطوير الواقع الاجتماعي؛ لأنها قائمة على المنهج والنظرية. فالبعد الإيديولوجي، أو الحكم القيمي هو أساس التنظير ولما غاب التنظير عن علم الاجتماع العربي، فقد غابت عنه المدارس والاتجاهات الفكرية المفسرة للمجتمع؛ ذلك أن التنظر ليس عملية خارج المجتمع والتاريخ، وإنما يتم في سياق ثقافي ومجتمعي وتاريخي معين. وما سردناه عن النظريات السوسيولوجية ينطبق على المناهج وطرائق البحث الاجتماعي، فهذه تمثل جانب الضعف في علم الاجتماع، وهي مرتبطة بالنظريات فلا يقوم التنظير دون منهج، ولذلك نلاحظ أن غياب الاتجاهات والمدارس عندنا، إنما يعود إلى ضعف الانتماء النظري والمنهجي.
يؤكد العرض والتحليل السابق أن أزمة العلوم الاجتماعية في العالم العربي ناتجة عن ظروف مجتمعية وشروط موضوعية أفرزها موقف الدولة السلبي تجاه تلك العلوم، ونظرة المجتمع الدونية إليها، وعدم رغبة معظم الطلبة النابهين في التخصص في مجالاتها المتعددة، لكن هذا الرصيد السلبي المتراكم لا ينفي وجود بعض المحاولات الهادفة لتوطين تلك العلوم الاجتماعية في بيئاتها العربية، ونذكر على سبيل المثال محاولات توطين علم الاجتماع في البيئة العربية، وتجربة أسلمة علم التاريخ بوصفهما من المحاولات الجديرة بالمراجعة والتقييم في إطار عرضنا للتحديات التي تواجه العلوم الاجتماعية في العالم العربي عموماً.
وفي ذات السياق، بدأت المحاولات لتوطين علم اجتماع عربي بكتابات عالم الاجتماع العراقي علي الوردي (1913-1995) التي استند فيها إلى خصوصية البيئة العربية والتراث النظري لابن خلدون، ويذكر الوردي في هذا الاتجاه أننا لو ألقينا نظرة على خارطة الكرة الأرضية، لوجدنا المنطقة العربية، هي المنطقة الوحيدة التي تمتد من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، تتميز عن غيرها من مناطق العالم بكونها أكبر امتداد صحراوي على وجه الكرة الأرضية، ومعنى هذا أنها أكبر منبع للبداوة في العالم كله، لكن النظريات الاجتماعية التي ظهرت في الغرب لا تولي أي اهتمام للبداوة، ولا غرابة في ذلك؛ لأن علماء الغرب لا يجدون أي أثر للبداوة في مجتمعهم، وهذا هو الذي يدعونا إلى دراسة مجتمعنا في ضوء منهج خاص بنا، يختلف في بعض الوجوه عن علم الاجتماع الغربي. ولتأسيس إطار (نظري للمنهج) الذي ينشده يقول الوردي آن الأوان لكي نرجع إلى الأساس الذي وضعه ابن خلدون لعلم الاجتماع، والذي أهملناه طويلاً، فنزيل عنه تراب الزمن، نلقحه بما ظهر مؤخراً من نظريات ومفاهيم اجتماعية جديدة وبهذا نتمكن من بناء علم اجتماع خاص بنا يلائم المجتمع الذي نعيش فيه.
وبهذه الكيفية فتح الوردي الباب واسعاً للعديد من الندوات والدراسات التي انتقدت مخرجات البحث الاجتماعي في البلدان العربية، وأرجعت إخفاقات الباحثين الاجتماعيين في تأسيس علم اجتماع عربي يعالج مشكلة التخلف إلى أزمة ثلاثية مركبة، قوامها أزمة الإطار النظري الاجتماعي، وأزمة المنهج العلمي وأدواته البحثية، وأزمة العلاقة التبادلية مع المجتمع.
إن مستقبل علم الاجتماع في العالم العربي، إن كان له مستقبل، سيكون في الثورة على السلطة، أي سلطة، وفي الحد الأدنى إزعاجها بالنقد وكشف آليات الهيمنة التي غالباً ما تلجأ إليها لدوام تسلطها. ومن أنواع السلطة التي يفترض أن نثور عليها تلك المعارف المحافظة التي تأبى التغيير لما صاحبها من أرثوذكسية حولها في رؤوسنا، وقد يصعب الانقلاب عليها دونما سوسيولوجيا ثائرة ومناضلة ضد السائد والمألوف، وما هو متفق عليه، ومن دون ذلك سيطول مكوث هذا السائد فينا وبيننا، الأمر الذي يجعل من الرؤية النقدية لأدواتنا المعرفية أمراً ملحّاً، شرط أن نكف عن اعتبار الناقد عدوّاً، ما دام يمتلك عناصر البرهنة على ما يراه نقداً. ولعل أفضل طريقة لتقدير باحث وما أنتجه من بحث هي محاولة البرهنة على ما فيه من تقصير علمي بوضع أسئلة جديدة غير الأسئلة الموضوعة. والأسئلة الجيدة أفضل من الإجابات الجيدة.
- المراجع المعتمدة:
- أبو شوك، أحمد. وآخرون. 2021. أزمة العلوم الاجتماعية (المظاهر والآفاق). ط1. مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية. قطر.
- الجابري، محمد. 2009. تكوين العقل العربي. ط10. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت.
- آلدمير، تورغاي. بدون تاريخ. الوعي والمعرفة. ط1. ترجمة: علاء الدين حسو. دار تيرا. إسطنبول.
- الطهطاوي، رفاعة رافع. 2010. تخليص الإبريز في تلخيص باريز. ط2. مؤسسة هنداوي. المملكة المتحدة.
- العظم، صادق. 1970. نقد الفكر الديني. ط2. دار الطليعة. بيروت.
- باقادر، أبو بكر أحمد. عرابي، عبد القادر. 2006. آفاق علم اجتماع عربي معاصر. ط1. دار الفكر. دمشق.
- بوبر، كارل. 2006. منطق البحث العلمي. ط1. ترجمة: محمد البغدادي. المنظمة العربية للترجمة. بيروت.
- جميل قاسم. 2010. علي شريعتي الهجرة إلى الذات. ط1. مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي. بيروت.
- دواق، الحاج أوحمنه. 2021. جدلية الوعي والحرية في فكر علي شريعتي. بحث محكم. مؤسسة مؤمنون بلا حدود. الدار البيضاء (المغرب).
- سعيد، إدوارد. 2024. الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق. ط3. مؤسسة هنداوي. المملكة المتحدة.
- سعيد، جودت. 2016. حتى يغيروا ما بأنفسهم. ط50. تقديم: مالك بن نبي. دار تيرا. إسطنبول.
- شريعتي، علي. 1984. النباهة والاستحمار. ط1. الدار العالمية. بيروت.
- شريعتي، علي. 2022. في علم الاجتماع الإسلامي. ط1. ترجمة: دعاء إبراهيم. مراجعة وتدقيق: محمد حسين بزي. دار الأمير للثقافة والعلوم. بيروت.
- عمارة، محمد. 2007. رفاعة الطهطاوي رائد التنوير في العصر الحديث. ط3. دار الشروق. القاهرة.
- فياض، حسام الدين. 2023. إشكاليات تمكين علم الاجتماع في البلدان العربية. موقع أنطولوجيا. مصر. https://alantologia.com/blogs/64466/
- فياض، حسام الدين. 2024. الاستقلال السوسيولوجي مهمة لم تنجز بعد في الجامعات العربية. موقع الحوار المتمدن. https://ahewar.net/m/s.asp?aid=830753&r=50&cid=0&u=&i=13780&q=
- مؤنس، حسين. 1996. تاريخ موجز للفكر العربي. ط1. دار الرشاد. القاهرة.
- مؤلفين، مجموعة. 2014. مستقبل العلوم الاجتماعية في الوطن العربي. ط1. تحرير وتقديم: ساري حنفي ومصطفى مجاهدي. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت.
- Giddens, Anthony.1991. The Consequences of Modernity. Stanford University Press. Stanford
- Habermas, Jürgen. 1996. The Theory of Communicative Action, Vol. 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason. Translated by Thomas McCarthy. Beacon Press. Boston.