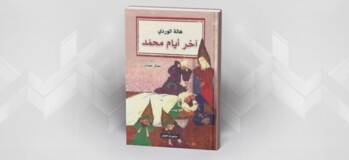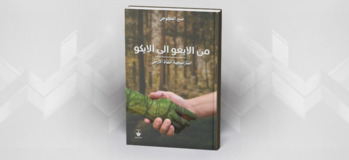الإنسان بين السرد والطقس: مقاربة أنثروبولوجية للثقافات وتجليات الحياة اليومية
فئة : أبحاث محكمة

الإنسان بين السرد والطقس:
مقاربة أنثروبولوجية للثقافات وتجليات الحياة اليومية
”حكايات البشر ليست مجرد سرديات، بل مرايا تكشف عمق الثقافة الإنسانية وتعيد تشكيل معنى الوجود في طقوسهم وعاداتهم وأماكنهم“.
”عالم الناس لا يُفهم إلا من بوابة الطقوس التي تحول العادي إلى استثنائي والخاص إلى جماعي“ (الكاتب)
- الملخص:
تتناول هذه الورقة البحثية أهمية علم الأنثروبولوجيا في دراسة الإنسان والحياة الاجتماعية، انطلاقاً من منظور شمولي يدمج الأبعاد البيولوجية، والثقافية، واللغوية، والتاريخية من خلال استعراض المناهج الرئيسة للأنثروبولوجيا، كما توسع النظر إلى مجالات متعددة تشمل الدين، والمجتمع، والمعرفة، والاقتصاد، والفنون، والسياسة، والبيئة. وتختتم الورقة باستشراف آفاق مستقبلية لتطبيقات الأنثروبولوجيا في مواجهة التحديات العالمية، مع توجيه توصيات بناءة لتعميق دراسة الواقع الاجتماعي المعاصر.
من هذا المنطلق تصبح قراءة الحكايات والطقوس أنثروبولوجيًّا ليست استعادة للماضي فحسب، بل استشراف لطرائق العيش الممكنة.
- المقدمة:
في عالم متسارع التغير، تتداخل فيه الثقافات وتتقاطع المجتمعات على نحوٍ لم يسبق له مثيل، يبرز دور الأنثروبولوجيا كعلمٍ فريد يجمع بين حدّة الملاحظة الميدانية ودقة التحليل النظري، ليعيد توجيه اهتمامنا إلى عمق الخبرة الإنسانية وتنوعها. فمن خلال فهمنا للطقوس اليومية، والأنظمة القيمية، وأنماط التفاعل الاجتماعي، يقدم هذا العلم أدواتٍ حيوية لفهم ظواهر مثل العولمة، والهوية، والصراعات الثقافية.
وهكذا يعدّ هذا العلم والتخصص من أروع العلوم؛ لأن دراسته تفتح العقل والقلب على كل ما يخص الإنسان وعلاقاته بالآخرين. فالأنثروبولوجيا هي علم الإنسان بكل تفاصيله: كيف عاش؟ ويعيش، كيف يفكر؟، كيف يمارس التمريض ويتعالج نفسه عند المرض؟ كيف يكون مجتمعه؟ كيف يمارس عبادة ربه وطقوسه الدينية؟ ما شكل نظامه السياسي؟ وكيف يعمل ويعيش ويحب ويكره؟ ... وغيرها من هذه المجالات. كما أنه علم يحاول يفهم الإنسان ليس من الظاهر فقط، بل علم يفهم الإنسان من الداخل، من خلال روحه وثقافته وعاداته وتاريخه.
وأخيراً، تهدف هذه الورقة إلى تقديم رؤية شاملة لدور الأنثروبولوجيا في دراسة الإنسان والحياة الاجتماعية، من خلال شرح مبادئها الأساسية، واستعراض مناهجها، وتحليل تطبيقاتها النظرية والعملية في مجموعة من المجالات الإنسانية والمحورية.
بناءً على ما سبق، تطرح هذه الورقة البحثية التساؤل المركزي التالي:
كيف يمكننا فهم حكايات الناس وعوالمهم من خلال رحلة الأنثروبولوجيا المتعمقة في الثقافات والطقوس والأعراف والتقاليد الاجتماعية للمجتمعات الإنسانية؟
سنحاول الإجابة عن هذا التساؤل من خلال مناقشة وتحليل العناصر التالية:
1- المنظور الأنثروبولوجي (الشمولي):
يُعرف المنظور الشمولي بأنه المنهج الذي يسعى إلى دراسة الإنسان في جميع أبعاده - البيولوجية، والثقافية، والاجتماعية، واللغوية، والبيئية - ضمن تفاعلها المتبادل. هذا التكامل المنهجي يجنب التبسيط المفرط، ويتيح فهماً متكاملاً للظواهر، مثل ربط الممارسات الغذائية بالتغيرات البيئية والصحية.
وتبرز أهمية هذا المنظور في تحليل الإنسان ضمن نسق متكامل، بدلاً من تجزئته كما تفعل بعض العلوم المتخصصة. فعلى سبيل المثال، في دراسة طقس ديني في مجتمع معين، لا يقتصر التحليل على المعتقد الديني، بل يشمل السياقات الاجتماعية، والاقتصادية، والرمزية. ويتم تطبيقه في البحوث الميدانية، حيث يتبع الأنثروبولوجيون هذا المنظور لتفسير الممارسات الثقافية ضمن بيئتها الشاملة، ما يسهم في بناء فهمٍ أكثر اتساقاً للظواهر الاجتماعية.
2- نسبية الثقافة والتعددية:
تؤكد نسبية الثقافة على وجوب فهم الممارسات والقيم ضمن سياقها الخاص، بعيداً عن الأحكام المسبقة والإثنوسنتريّة (التمركز العرقي). وبذلك يعترف الباحث بالتنوع الثقافي ويحترم خصوصيات الجماعات، مما يعمق التفاهم ويمنع الانكفاء على الذات. بمعنى آخر تقوم على مبدأ أن القيم والمعايير يجب أن تُفهم ضمن السياق الثقافي الخاص بها، لا من خلال إسقاط معايير ثقافة الباحث عليها.
أما التعددية الثقافية، فتشير إلى الاعتراف بتنوع الثقافات الإنسانية واحترام خصوصياتها.
تمكن أهمية المبدأ بأنه يعتبر حجر الزاوية في الدراسات الأنثروبولوجيا، حيث يجنب الباحثين الوقوع في فخ الذاتية والأحكام المسبقة من خلال الحكم على الآخرين من منظور ثقافتهم الخاصة. ويمكن لنا تطبيق هذا المبدأ، الأنثروبولوجي لكي نستطيع فهم لماذا تعد ممارسات معينة "منطقية" أو "مقبولة" داخل ثقافة معينة، حتى لو بدت غريبة خارجيًّا، مثل طقوس العبور أو أنماط الزواج.
3- المنهج الإثنوغرافي:
الطريقة الإثنوغرافية، المبنية على الملاحظة بالمشاركة والمقابلات المتعمقة، تُمكن الباحث من الدخول إلى داخل العالم الاجتماعي الذي يدرسه. ومن خلالها تتولد بيانات حقلية أولية تفيد في بناء نظريات قائمة على أدلة مباشرة، كما حدث في دراسة برونيسلاف مالينوفسكي لقبائل تروبرياند، حيث استخدم هذا المنهج أثناء دراسته لقبائل جزر تروبرياند، عندما عاش معهم لسنوات، مما مكّنه من فهم أنظمتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية غير السوقية وطقوسهم المرتبطة بالتبادل "نظام الكولا"، حيث يسمح هذا النظام الاجتماعي للزعماء بتعدد الزوجات، ويفضل الزعماء الزواج بالنساء اللائي لهن إخوة أغنياء ليكون لهم عدد من الأصهار الأثرياء وبما أن النظام الأمومي في تروبرياند يضع واجبات على الأخ نحو أخته، فإن الزعيم يجد نفسه غارقاً في الثروة التي تقدم لزوجاته من أخواتهن.
بذلك تكمن أهمية هذا المنهج بأنه يوفر بيانات نوعية عميقة وغير ممكنة من خلال الأساليب الكمية فقط. إنه يسمح للباحث بفهم الحياة اليومية كما يراها الأفراد أنفسهم، في سياقاتهم الحقيقية.
4- المقارنة والتحليل التطوري:
يعتمد هذا المنهج على مقارنة الجماعات الإنسانية عبر الزمان والمكان، لكشف أنماط مشتركة واختلافات أساسية في تنظيم المؤسسات الاجتماعية، مثل الأسرة والدين والاقتصاد. ويساهم ذلك في رسم مراحل التطور الاجتماعي وفهم العلاقات بين المجتمعات التقليدية والحديثة. بمعنى آخر، يسمح هذا المنهج للأنثروبولوجيين بفهم كيف تطورت بعض المؤسسات مثل الأسرة أو الدين، وكيف تختلف أو تتشابه عبر الثقافات، ما يساهم في بناء نظريات اجتماعية أكثر دقة. ويمكن تطبيق هذا المنهج في الدراسات التي تقوم على المقارنة بين المجتمعات التقليدية الزراعية والمجتمعات الحديثة الصناعية، حيث تظهر نتائجها أن التنظيم الأسري قد يختلف، لكن وظائفه الأساسية - كالرعاية الاجتماعية والتكاثر- تظل قائمة وإن اختلف أسلوبها وقناعاتها.
5- الأنثروبولوجيا التطبيقية:
يشير هذا الفرع إلى استخدام الأدوات والمناهج الأنثروبولوجية لحل ومعالجة قضايا عملية وراهنة في مجال الصحة العامة، والتنمية، والتعليم، والعمل الإنساني... وغيرها. وتكمن أهمية هذا التوظيف بأنه يجعل من الأنثروبولوجيا أداة فعالة لفهم مشاكل العالم المعاصر من منظور ثقافي حساس، وهو ما ينعكس في تصميم تدخلات وسياسات تراعي الفروقات الثقافية والخصوصيات المحلية. ويتم تطبيق هذا النوع من الدراسات في مجال الصحة العامة على سبيل المثال، حيث ساعدت الأنثروبولوجيا في تحسين حملات التطعيم في المجتمعات الريفية من خلال فهم معتقداتهم حول المرض والدواء، ومن ثم صياغة رسائل صحية تراعي ثقافتهم.
ختاماً، تظهر المبادئ والمنهجيات الخمسة أعلاه كيف أن الانثروبولوجيا لا تكتفي بمجرد دراسة الإنسان، بل تسعى إلى فهمه من الداخل، في تفاعله مع بيئته، وفي عمق ثقافته وتاريخه ومعانيه الرمزية. هذه المقاربات لا تعزز فقط من القيمة العلمية للبحث، بل تسهم أيضاً في إعادة تشكيل وعينا بالإنسان والاختلاف والتعدد. فالأنثروبولوجيا، بما تمتلكه من أدوات تحليلية دقيقة ونظرة شمولية وإنسانية، تمنحنا فرصة فريدة لتجاوز السطح والانفتاح على فهم الآخر كمرآة لفهم الذات. إنها ليست مجرد علم وصفي، بل مشروع لفهم العالم وفك شيفراته الثقافية، وهو ما يجعلها ضرورة فكرية وأخلاقية في عالم تزداد فيه الحاجة إلى الحوار بين الثقافات واحترام التنوع الإنساني.
- المجالات الأساسية للدراسات الأنثروبولوجية:
تعدّ الأنثروبولوجيا من العلوم الإنسانية الأكثر شمولاً وعمقاً في دراسة الإنسان، حيث تنفرد بقدرتها على النفاذ إلى صميم التجربة البشرية في تنوعها وتعقيدها. فهي لا تكتفي برصد الظواهر المجتمعية، بل تسعى إلى تحليلها ضمن سياقاتها الثقافية والتاريخية والمعرفية لفهم ما وراء السلوك والعقيدة والعادة. وفي هذا السياق، تتداخل الأنثروبولوجيا مع ميادين متعددة مثل: الدين، والاقتصاد، والسياسة، والعلم، والفنون، والصحة، لتقدم تفسيراً شاملاً لسلوك الإنسان ومؤسساته الرمزية والمادية.
تتناول هذه الفقرة باقة واسعة من الموضوعات التي تمثل ركائز العمل الأنثروبولوجي، مستعرضة كيفية مقاربة هذا الحقل الأكاديمي لظواهر كالطقوس الدينية، وتنظيم المجتمع، وإنتاج المعرفة، والفنون الشعبية، والممارسات السياسية، والعلاقات الاقتصادية، والتفاعل البيئي، وحتى الأسئلة الأخلاقية. ويبرز من خلال ذلك أن الأنثروبولوجيا لا تقتصر على الدراسة من "البرج العاجي"، بل تنزل إلى حيث يعيش الناس، تتلمس حكاياتهم، وتنصت إلى أصواتهم، لتبني معرفة حية نابعة من الواقع.
وعليه، فإن هذا العرض لا يهدف فقط إلى تقديم وصف وصفي للمجالات التي تدرسها الأنثروبولوجيا، بل يسعى إلى إبراز الرؤية الفلسفية الكامنة خلفها: رؤية تعيد تعريف الإنسان عبر فهمه لنفسه والآخر، وتُعمق وعينا بالاختلاف الثقافي بوصفه جوهر التجربة الإنسانية لا استثناءً لها، من أهم هذه المجالات ما يلي:
أ- الدين وطقوس العبادة والمعتقدات:
تعدّ الأنثروبولوجيا الدين نظاماً رمزيًّا ينظم العلاقة بين الأفراد والكون، وتدرس كيف تشكل الطقوس والانتماءات الدينية الهوية الجماعية وتعزز التماسك الاجتماعي؛ بمعنى آخر تشرح كيف تتشكل الطقوس والممارسات والمعتقدات الدينية، ولماذا الناس تؤمن وتعبد الإله، كما أنها تبين أن الدين ليس فقط نصوص، بل تجارب حية وثقافات قائمة.
ب- المجتمع والحياة الاجتماعية:
تركز على تحليل الهياكل الاجتماعية - كالأسرة والشبكات والطبقات - للفهم كيفية توزيع السلطة والموارد داخل المجتمعات. كما أنها تشرح كيف تتكون العلاقات الاجتماعية، والعائلة، والزواج، والتربية، حتى إنها تشرح كيف نتواصل ونتحدث ونتعامل مع الآخرين، كما أنها تبين لنا طبيعة الأدوار التي نقوم بها في حياتنا اليومية.
ت- العلم والمعرفة:
تبحث في أنظمة المعرفة المحلية والعلمية، مستكشفةً آليات إنتاج ونقل المعرفة داخل المؤسسات الأكاديمية والتقليدية. بمعنى أوسع، تُعنى الأنثروبولوجيا بدراسة العلم والمعرفة بوصفهما ظاهرتين ثقافيتين واجتماعيتين تخضعان، مثل غيرهما من النظم الرمزية، للسياقات التاريخية والثقافية. فهي لا تتعامل مع العلم على أنه كيان محايد وعالمي بالضرورة، بل تدرسه بوصفه نشاطاً إنسانياً متجذراً في بنى اجتماعية، وتصورات معرفية، وأنماط تواصل، ومصالح مؤسسية.
وتعنى الأنثروبولوجيا كذلك بدراسة المعرفة المحلية أو "المعارف الأصلية "Indigenous Knowledge، حيث تولي أهمية لفهم طرائق إدراك وتفسير العالم في المجتمعات التقليدية، بما في ذلك نظم الطب، والزراعة، والفلك، والبيئة. فالمعرفة هنا لا تفهم كمجرد معلومات، بل كمنظومات تأويلية حية تكتسب عبر التجربة، والملاحظة، والنقل الشفوي، وتترجم في الممارسة اليومية. ومن خلال مقارنة هذه النظم المعرفية بالمعرفة العلمية الحديثة، تبرز الأنثروبولوجيا إمكانات التفاعل والحوار المعرفي بدلاً من الاستعلاء الثقافي أو الاستيعاب القسري.
إن دراسة الأنثروبولوجيا للعلم والمعرفة تطرح أسئلة جوهرية حول ما يعدّ "علماً"، ومن يملك سلطة تعريفه وتطبيقه، وكيف يتفاعل الأفراد مع المعرفة ويعيدون إنتاجها في حياتهم اليومية. إنها تعيد موضعة العلم داخل الثقافة، وتكشف عن الطابع المركب والمعولم لإنتاجه، وتدعو إلى الاعتراف بتعدديته ونسبيته. ومن ثم، فهي تُسهم في بناء فهم نقدي للعلم لا بوصفه نقيضاً للثقافة، بل كتعبير عنها.
ث- الاقتصاد (المال والأعمال): تنظر إلى كل فعل اقتصادي كظاهرة اجتماعية، من خلال دراسة الأسواق التقليدية والاقتصاد غير الرسمي لفهم القيم والمعايير المتعلقة بالتبادل. كما أنها تدرس كيف الناس تعمل وتنتج وتستهلك، وكيف تتغير القيم حسب الفقر أو الغنى؟ وكيف أن المال يغير النفوس والمجتمعات؟ وما هو معنى العمل وقيمه بكل مكان؟ كيف تتم عملية توزع الأموال؟
ج- الفنون والحياة الثقافية: تتعامل مع الفنون بوصفها وسائل للتعبير عن الهوية والقيم والمفاوضة بين التقليد والحداثة عبر السياقات الثقافية. باختصار شديد تدرس كل ما يتعلق الفنون الشعبية والفلكلور ونشاط الانسان في الإبداع والاهتمام بكل شيءٍ جميل أبدعه الإنسان وما هي الغاية منه، لذا تدرس الرموز، القصائد، الأغاني، العادات، اللبس، الأكل، وكل شيء نمارسه يومياً وكأنه عادي، لكن وراء هذا الشيء تاريخ كبير وأثر وعمق.
ح- السياسة وممارساتها: تفحص كيفية ممارسة السلطة وبناء الشرعية، من المجتمعات التقليدية إلى الدول الحديثة، مع التركيز على الديناميات بين القواعد والمؤسسات. كما أنها تفهمنا كيف تتكوّن الأنظمة السياسية، لماذا الشعوب تثور أو تسكت؟ وكيف تتوزع القوة بين الناس من خلال بناءات القوة والضعف في الحياة الاجتماعية؟
د- الشخصية الإنسانية: تعتبر دراسة الشخصية الإنسانية أحد المحاور المركزية في الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية، خصوصاً في التقاليد التي تأثرت بمدرسة "الثقافة والشخصية"Culture and Personality التي برزت في القرن العشرين، مع باحثين بارزين مثل روث بنديكت Ruth Benedict ومارغريت ميد Margaret Mead، حيث تهدف هذه المقاربة إلى فهم الكيفية التي تُشكّل بها الثقافة الخصائص النفسية للفرد، وتفكك الثنائية الكلاسيكية التي تفصل بين الطبيعة الإنسانية والتنشئة الاجتماعية. فالأنثروبولوجيا لا ترى الشخصية بوصفها جوهراً ثابتاً أو كياناً بيولوجياً مستقلاً، بل بوصفها نتاجاً لتفاعل مستمر بين الفرد وبنية المجتمع والثقافة، حيث تعيد الجماعات البشرية تشكيل الذات من خلال الأنماط التربوية، والأدوار الاجتماعية، وأنظمة القيم والمعاني.
ويتم ذلك عبر منهج إثنوغرافي نوعي يركز على الملاحظة بالمشاركة، والسير الذاتية، والمقابلات المعمقة، بغرض تفكيك التمثلات الثقافية للسلوك، والعاطفة، والانفعالات، ومراحل الحياة (الطفولة، البلوغ، الشيخوخة). فعلى سبيل المثال، يظهر البحث الأنثروبولوجي أن مفاهيم مثل "الذات" أو "الاستقلالية" أو "الذنب" تبنى بطرائق مختلفة جدًّا بين الثقافات الغربية والفردية، مقارنة بالمجتمعات الجماعية مثل مجتمعات شرق آسيا أو بعض قبائل إفريقيا.
كما تتقاطع دراسة الشخصية الأنثروبولوجية مع علم النفس الثقافي، لكنها تختلف عنه من حيث تركيزها على السياق الثقافي الأوسع، وعدم اعتمادها النماذج النفسية الغربية كمقياس كوني. وهي تفسر الفرضيات الشائعة حول "الطبيعة البشرية" وتظهر كيف أن ما يعتبر طبيعيًّا أو سويًا في مجتمع ما قد يعد غريباً أو شاذًّا في مجتمع آخر. كما تسهم في إعادة التفكير في مفاهيم مثل "النضج"، "الهوية"، "المسؤولية" بوصفها مفاهيم ثقافية متغيرة وليست حقائق نفسية ثابتة.
وتبرز أيضاً أهمية هذا التوجه الأنثروبولوجي في هذا السياق من خلال التطبيقات العملية، لمحاولة فهم صراعات الهوية في المجتمعات متعددة الثقافات، أو تطوير برامج تعليمية وتربوية تراعي الفروق الثقافية في تشكيل الشخصية، ما يعكس البعد الإنساني العميق في علم دراسة الإنسان بوصفه أداة لفهم الذات والآخر في آن واحد.
ذ- الصحة والطب: تبين كيف يرى المجتمع موضوع المرض والشفاء، وكيف أن العلاج تختلف، كما أن الطب ليس علم فقط، بل ثقافة، وكيف كانت المجتمعات تتعالج، كيفية ربطه بالمعتقدات الاجتماعية السائدة.
في واقع الأمر، تُعنى الانثروبولوجيا الطبية بدراسة كيفية فهم المجتمعات لمفاهيم الصحة والمرض والشفاء، وتفسيرها لهذه الحالات ضمن سياقاتها الثقافية والاجتماعية والرمزية. ينطلق هذا الحقل من افتراض أساسي بأن المرض ليس ظاهرة بيولوجية خالصة، بل تجربة إنسانية عميقة محكومة بمنظومات القيم والمعتقدات والمعارف المحلية. وبالتالي، لا تركز الأنثروبولوجيا الطبية على مسببات المرض البيولوجية فحسب، بل تسعى إلى فهم كيفية تفسير الأفراد لأعراضهم، وأنماط سلوكهم تجاه الرعاية الصحية، وتفاعلهم مع الأنظمة العلاجية التقليدية والحديثة على حد سواء.
ويبرز هذا التخصص العلاقة التفاعلية بين الجسد والثقافة، حيث تختلف تصورات المرض والمعاناة بين المجتمعات. فمثلاً، في بعض الثقافات يُفسر المرض على أنه نتيجة اختلال في التوازن الروحي أو الاجتماعي، كما في أنظمة الطب التقليدي في الصين أو الهند أو بين الشعوب الأصلية، بينما تعتمد الثقافة الغربية على تفسير علمي صرف يستند إلى البيولوجيا. وقد أظهرت أعمال باحثين مثل آرثر كلاينمان 1980 Kleinman أهمية التمييز بين المرض (Disease) بوصفه تشخيصاً طبيًّا، والمعاناة (Illness) بوصفها تجربة شخصية ذات معنى ثقافي.
كما توظف الأنثروبولوجيا الطبية المنهج الإثنوغرافي لدراسة العلاقات بين المرضى ومقدمي الرعاية، أو بين الدولة والمجتمع في سياسات الصحة العامة. وتركز على قضايا مثل عدم المساواة الصحية، والعوائق الثقافية أمام الوصول للعلاج، وتأثير العولمة على النظم الصحية التقليدية، إضافة إلى دراسة الأمراض الوبائية ضمن بنيات اجتماعية (مثل الإيدز، السل، أو فيروس كورونا). وتعد الأبحاث التي أجراها بول فارمر Paul Farmer مثالاً بارزاً في هذا السياق؛ إذ كشف في دراسته عن المناطق الريفية في هايتي (الدولة الكاريبية) كيف تتداخل العوامل السياسية والاقتصادية والفقر في إنتاج المرض.
تكتسب الأنثروبولوجيا الطبية أهمية متزايدة اليوم في ظل التحديات الصحية العالمية؛ إذ تساعد في تصميم سياسات صحية تراعي الحساسيات الثقافية، وتعزز التفاعل الإنساني الفعال بين النظم الصحية والسكان المحليين. كما أنها تمكن من فهم الديناميكيات المعقدة للصحة والمعاناة البشرية من خلال عدسة ثقافية شاملة، تسهم في إعادة إنسانية الطب وتطوير ممارسات صحية أكثر شمولية وعدالة.
ر- الأخلاق والمبادئ: تسألنا ما هو الصح؟ وما هو الخطأ؟ وكيف نعتبر شي معين أخلاقي وشي ثاني لا؟ ومن هو المسؤول عن تحديد هذا الأمر بالأصل؟ وهل الأخلاق ثابتة أم أنها نسبية تختلف من مكان لمكان؟
تُفسر الأنثروبولوجيا الأخلاق والمبادئ باعتبارها أنساقاً ثقافية تتجسد في الممارسات اليومية، والخطاب الاجتماعي، والطقوس الجماعية، لا كمعايير عقلية مجردة أو كظواهر قانونية فحسب. ينطلق هذا التوجه من فرضية أن "الأخلاق" ليست ملكاً للفرد وحده، بل تنتج وتعاد إنتاجها عبر العلاقات الاجتماعية: في الأسواق يشهد الباحث نشوء "اقتصاد أخلاقي" يضبط سلوك البائع والمشتري، وفي الطقوس الدينية تبرز قوة "المحرمات" والواجبات في تنظيم الجماعة، وفي قصص الحياة اليومية يتحدد "خط الصواب" و"حد الخطأ" داخل المجتمع.
ويعتمد الأنثروبولوجيون في هذا المسعى على أدوات نوعية: الملاحظة بالمشاركة لفهم كيف يتحدث الناس عن "الضمير" و"الواجب"، تحليل الخطاب لاستجلاء الخطابات الأخلاقية التي تبرر الفعل أو تحاسبه، ودراسات الحالة التي توثق النزاعات الأخلاقية المحلية (كالخيانة أو الرشوة) ونظم التراضي الجماعي أو العقاب.
ز- البيئة والتفاعل الإنساني- البيئي: يستكشف هذا المجال كيف تتفاعل المجتمعات مع بيئاتها الطبيعية، وكيف تُشكل المعرفة البيئية الممارسات المستدامة أو غير المستدامة. بذلك تختص الانثروبولوجيا البيئية بدراسة الكيفية التي يتفاعل بها الإنسان مع بيئته الطبيعية والاجتماعية، مركزة على الأنماط الثقافية والسلوكيات البشرية المرتبطة باستغلال الموارد، والتكيف مع الظروف المناخية، وإدارة النظم البيئية. وهي فرع متداخل بين الأنثروبولوجيا الثقافية وعلم البيئة، يدمج المعطيات البيولوجية والتاريخية والرمزية لفهم التفاعل البشري– البيئي. لا تنظر الأنثروبولوجيا البيئية إلى البيئة كمجال خارجي محايد، بل ككيان مُشكل ثقافيًّا ومعاش ضمن سياقات رمزية واجتماعية، حيث تختلف تصورات الناس للطبيعة وفقاً للثقافة والمعرفة المحلية.
يعتمد هذا الحقل على مناهج إثنوغرافية ومقارنة لفهم الكيفية التي تصوغ بها المجتمعات ممارساتها الزراعية، الصيد، الرعي، بناء المسكن، أو التكيف مع التغيرات المناخية والبيئية. فعلى سبيل المثال، أظهرت أبحاث روبرت نيتز R. Netting 1993 كيف أن المزارعين في المناطق الجبلية في نيجيريا يطورون نظماً زراعية شديدة الكفاءة تتوافق مع محدودية الأرض والماء.
كما تكتسب الأنثروبولوجيا البيئية أهمية متزايدة في ظل التغيرات المناخية العالمية؛ إذ توفر أدوات لفهم الاستجابات الثقافية المحلية لتغير المناخ، والجفاف، والتصحر، أو الكوارث البيئية. كما تسهم في الكشف عن المعرفة البيئية التقليدية Traditional Ecological Knowledge التي طورتها المجتمعات المحلية عبر قرون، وتعد اليوم مورداً هاماً في السياسات البيئية والتنمية المستدامة. من جهة أخرى، توجه الانثروبولوجيا البيئية نقداً إلى الخطابات البيئية الغربية التي تفترض نموذجاً واحداً للتنمية أو الاستدامة، داعية إلى الاعتراف بالتعدد البيئي الثقافي، وضرورة إدماج أصوات المجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار البيئي.
وبالتالي، لا تدرس الأنثروبولوجيا البيئية البيئة كموضوع "خارج" الثقافة، بل تسعى إلى تحليل الأنماط المتشابكة بين الثقافة، والمعرفة، والممارسة البيئية، في سبيل بناء فهم شمولي لتفاعل الإنسان مع محيطه الطبيعي. وهذا يجعل منها علماً لا يقتصر على التشخيص، بل يمتلك قدرة تطبيقية في دعم السياسات البيئية العادلة ثقافيًّا واجتماعيًّا.
في واقع الأمر الأنثروبولوجيا علم يدخل بتفاصيل التفاصيل، كما يوجد في الأنثروبولوجيا مُحاكمة ثقافية... يعني ذلك أن الأنثروبولوجيا تعلمنا كيف نتقبل الآخر، نحترم الاختلاف، حتى أنها تجعلنا نرى الحياة بمنظار أوسع ومختلف، وتجعلنا نفتهم لماذا بعض الشعوب تفعل أشياء معينة نحن نستغرب منها، وتبين لنا أنه خلف كل سلوك معنى وثقافة وفكر.
فالأنثروبولوجيا لا تعمل من بُرج عالي على الإطلاق، بل تنزل للشارع، للأسواق، للقرى، للقبائل، للمدن، للمستشفيات، للسجون، للبيوت، تجلس مع الناس، تسمع إليهم، وتقترح الحلول، وتعالج المشاكل المختلفة التي نتجت عن الاجتماع الإنساني، فهي ليست علم فقط، بل هي رحلة لفهم الإنسان كإنسان، بكل ضعفه وكل عظمته. وهذا الاختصاص ليس فقط دراسة، بل هو نظرة متكاملة، وأسلوب حياة، وعيون جديدة نرى من خلالها العالم ونفهم من خلالها الآخرين، كما أنها تجعلنا نفهم أنفسنا أكثر فأكثر.
وأخيراً الأنثروبولوجيا "ليست علم يدرس الناس فقط، بل علم يجعل الإنسان يعيد اكتشاف نفسه بين سطور حضاراته، وآلامه، وأحلامه وتطلعاته". فإذا أردت أن تعرف الإنسان، ينبغي أن تحب الأنثروبولوجيا وتعمل بهذا التخصص الرائع والشامل.
خلاصة القول، يُجسد علم الأنثروبولوجيا جسراً بين الفهم النظري والتطبيق العملي لمختلف الظواهر الإنسانية؛ إذ يمتد تأثيره من تفسير الرموز الثقافية إلى تصميم البرامج التنموية والسياسات الصحية والحفاظ على التراث. ومع تصاعد تحديات القرن الحادي والعشرين- كالتغير المناخي، والهجرة، والأزمات الصحية العالمية، والتحولات الرقمية - تتضاءل الحدود بين التخصصات، ويبرز دور الأنثروبولوجيا متعددة الأبعاد في تقديم رؤى عميقة وشاملة.
رؤية مستقبلية (مقترحة)، التوجه نحو دراسات أنثروبولوجية رقمية تستغل البيانات الضخمة ووسائط التواصل الاجتماعي لفهم التحولات الثقافية الحديثة. وتعزيز التعاون بين الأنثروبولوجيا وعلوم الأرض والبيئة لتطوير استراتيجيات مواجهة التغير المناخي. بالإضافة إلى توسيع التطبيقات في مجال الصحة العقلية عبر اعتماد مناهج إثنو- طبية لفهم الممارسات العلاجية التقليدية. وفي النهاية ستظل الانثروبولوجيا، بروحها الشمولية والتعددية المنهجية، أداة أساسية لفهم التحولات الإنسانية المعقدة وصياغة سياسات تستجيب لاحتياجات المجتمعات وتعزز من قدرتها على التكيف.
المراجع المعتمدة:
- أحمد أبو زيد: محاضرات في الأنثروبولوجيا الثقافية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط2، 1978
- السيد الحسيني، محمد الجوهري: مقدمة في الأنثروبولوجيا العامة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الجزء: 01، ط1، 1990
- حسن شحاتة سعفان: علم الإنسان (الاأنثروبولوجيا)، منشورات مكتبة العرفان، بيروت، ط1، 1966
- حسين عبد الحميد أحمد رشوان: الأنثروبولوجيا في المجالين النظري والتطبيقي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ط1، 2010
- حسين فهيم: قصة الأنثروبولوجيا- فصول في تاريخ علم الإنسان، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد: 98، فبراير 1986
- توماس هيلاند إريكسن، فين سيفرت نيلسن: تاريخ الأنثروبولوجيا، ترجمة وتقديم: عبده الريس، المركز القومي للترجمة، القاهرة، العدد: 2152، ط1، 2014
- زينب زيود: علم الإنسان (الأنثروبولوجيا الثقافية)، منشورات جامعة دمشق، دمشق، ط1، 2017/2018.
- محمد الجوهري وآخرون: الأنثروبولوجيا الاجتماعية قضايا الموضوع والمنهج، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2004
- محمد الجوهري، علياء شكري: مقدمة في دراسة الأنثروبولوجيا، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة، ط1، 2007
- دافيد لوبروتون: أنثروبولوجيا الجسد والحداثة، ترجمة: محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط2، 1997
- عاطف وصفي: الأنثروبولوجيا الاجتماعية، دار النهضة العربية، بيروت، ط3، 1981
- عائشة حمزة: دور الأنثروبولوجيا التطبيقية في مجالات التنمية الصحية، مجلة آداب ذي قار، العراق، العدد:35، 2021
- عيسى الشماس: مدخل إلى علم الإنسان (الأنثروبولوجيا)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2004
- فاروق مصطفى إسماعيل: الأنثروبولوجيا الثقافية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، الجزء: 02، 1984
- فريدرك بارث وآخرون: الأنثروبولوجيا حقل علمي وأربعة مدارس، ترجمة: أبو بكر أحمد باقادر وإيمان الوكيلي، مراجعة: ساري حنفي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، ط1، 2017.
- مجموعة باحثين: الأنثروبولوجيا قراءة تحليلية – نقدية في سياقاتها التاريخية (مناهجها، نظرياتها، ومبانيها)، تقديم وتحرير: سامر توفيق عجمي، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، النجف (العراق)، ط1، 2023.
- محمد الخطيب: الأنثروبولوجيا الاجتماعية، دار علاء الدين، دمشق، ط1، 2005.
- وسام العثمان: المدخل إلى الأنثروبولوجيا، دار الأهالي، دمشق، ط1، 2002.
- ياس خضر عباس عباسي: الأنثروبولوجيا الثقافية في ميدان الأخلاقية، مجلة نسق، الجمعية العراقية للدراسات التربوية والنفسية، العدد: 18، بغداد (العراق)، 2018.
- H. Russell Bernard: Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative, Rowman & Littlefield Publishers; Sixth edition, November 17, 2017
- Sheena Nahm, Cortney Hughes Rinker: Applied Anthropology Unexpected Spaces, Topics and Methods, Published by Routledge, November 2, 2015
- Rashmi Sinha: Issues and Perspectives in Anthropology, Rawat Publications, New Delhi, 2019
- Bronisław Malinowski: Argonauts of the Western Pacific, London: Routledge,1922
- Clifford Geertz: The Interpretation of Cultures: Basic Books, New York, 1973
- Conrad Phillip Kottak: Cultural Anthropology: Appreciating Cultural Diversity, McGraw-Hill, New York, 15th ed, 2013
- Victor Turner: The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual, Cornell University Press, Ithaca, 1967
- Sherry. B Ortner: Life and Death on Mt. Everest: Sherpas and Himalayan Mountaineering, Princeton University Press, Princeton, 1999
- Michael R. Dove: The Anthropology of Climate Change: An Historical Reader, Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011
- Robert McC Netting: Smallholders, Householders: Farm Families and the Ecology of Intensive, Sustainable Agriculture, Stanford University Press, 1993
- Arthur Kleinman: Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry, University of California Press, 1980
- Paul Farmer: Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor, University of California Press, 2005