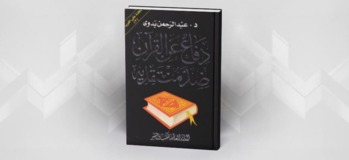فتح السّجلّات
فئة : ترجمات
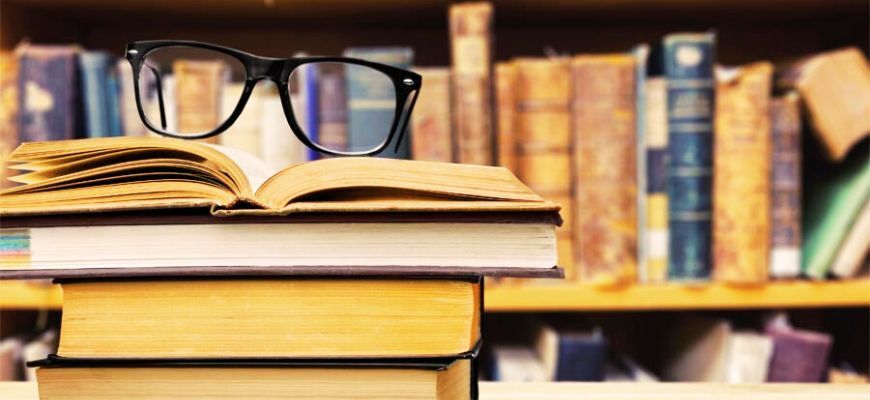
فتح السّجلّات[1]
لقد أخذنا فكرة عامّة وسريعة عمّا نعرفه وما لا نعرفه عن السّياقات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة التي عاش فيها عيسى ومحمّد؛ ننتقل الآن إلى الأدلّة المُتعلّقة بالرّجليْن أنفسهم. يجب ألّا نتوقع الكثير؛ إذ لا توجد محفوظات، ولا سجلّات معموديّة أو زواج، كما لا توجد أيّ من الوثائق الأوّلية التي اعتاد مُؤرّخو الحقبة اللاحقة العمل من خلالها. ما لدينا هو في الأساس بقايا أدبيّة، وكتابات لاحقة حول الرّجليْن. هناك بالطّبع بعض الأدلّة الماديّة المعاصرة، لا سيّما في حالة عيسى، ولكنّها مجرّد تأكيدات: فهي تُؤكّد أن بيلاطس البُنطي Pontius Pilate كان حاكم يهودا في القرن الأوّل، وأنّ الحياة الزّراعيّة في الجليل كانت كما وصفها يسوع في الأمثلة التي رواها للعبرة، وأنّه كان هناك بِركة بها خمسة أروقة تقع شمال منطقة الهيكل في القدس، وبالتّحديد ما قد ينطوي عليه الموت بالصّلب، لكن تظلّ الحقيقة الأساسيّة هي: أنّ الأدلّة المتبقّية بشأن عيسى ومحمّد أدبيّة في مجملها.
سجلّ عيسى
تنقسم الأدلّة الأدبيّة على وجود عيسى بشكل ملائم، وإن لم تكن بشكل متناسق، إلى ثلاث فئات: تلك التي أنتجها الوثنيّون، وتلك التي أنتجها الكتّاب اليهود، وأخيراً وبدرجة كبيرة، تلك التي أنتجها تلاميذ عيسى أنفسهم.
مصادر الوثنيّين
لا أحد يعلم تماماً ما هي الوثنيّة على وجه التّحديد، ولا حتّى الوثنيّون، الذين لم يفكّروا أبداً في أنفسهم على هذا النّحو. المُؤكّد هو أنّ المصطلح مُهين: استخدم المسيحيّون الصّفة paganus لوصف آخر معاقل الصّامدين ضدّ المسيحيّة في المناطق النائية، كلّ أولئك الذين تشبّثوا بطوائفهم القديمة، ورفضوا كلّاً من التّوحيد والإيمان بعيسى كابن الله. على أيّ حال، يبدو أنّ الوثنيّين الكلاسيكيّين قد اختفوْا من الغرب، تاركين فقط الملحدين واللّاأدريّين الأكثر تشدّداً ليقيموا الحواجز ضدّ الطوائف الدّينيّة (1).
إنّ المصادر الوثنيّة عن يسوع النّاصري هي مصادر وهميّة إلى حدّ ما. إنّها تتعلّق أساساً بالمسيحيّين بدلاً من عيسى، الذي لم يُدْعَ أبداً باسمه العبريّ أو الآراميّ، ولكن يشار إليه باسم «كريستيس» Christus أو «كريستوس» Chrestos. وكما هو الحال في الأدلّة المادّيّة، فإنّ المُؤلّفين الوثنيّين يُؤكّدون لنا فقط أو، في أفضل الأحوال، يوسّعون معرفتنا بالسياق. فهم يكملون ما غاب من معلومات عن مهنة بيلاطس البُنطي، على سبيل المثال، أو عن نظام جمع الضرائب تحت رعاية الرّومان في فلسطين. وفي أفضل الحالات، فهم يُؤكّدون أنّه في ستّينيات القرن الأوّل الميلادي كان هناك في روما مجموعة من المُتعصّبين الدّينيّين الذين أطلقوا على أنفسهم اسم «Christers»، والذين تسبّبوا في مشاكل -غير محدّدة- للسلطات الرومانية في روما وأماكن أخرى (2). والأكثر صلة بالموضوع هو ما كتبه المُؤرّخ تاسيتوس Tacitus في مطلع القرن الثّاني:
نيرون... ألقى أقسى أنواع التّعذيب على مجموعة من النّاس المكروهين بسبب فظاعاتهم، والمعروفين شعبياً باسم «المسيحيّين». جاء اسمهم من كريستوس، الذي قُتل في عهد سيادة طبريّة على يد الوكيل بيلاطس البُنطي. على الرّغم من التحقّق من ذلك لبعض الوقت، إلّا أنّ الخرافات المدمّرة اندلعت مرّة أخرى، ليس في يهودا فقط، حيث بدأ أذاها، ولكن حتّى في روما، حيث تصبّ فيها كلّ الإساءات المقيتة والمخزية، الآتية من كلّ العالم، والتي تجد التّرحيب. (حوليات 44:15)
وهذا تلخيص لذلك؛ كان هناك رجل مقدّس في «يهودا» يُدعى كريستوس أعدمه الرّومان في وقت ما بين 26 و36 بعد الميلاد، وكان أتباعه في ستّينيات القرن الأوّل قد شكّلوا في روما وأماكن أخرى طائفة دينيّة مُميّزة حملت اسمه من بعده.
المصادر اليهوديّة
فلافيوس جوزيفوس
تبدو المصادر اليهوديّة أكثر إفادة إلى حدّ ما. ولقد سبق ذكر جوزيفوس من قبل. وفي كتابه الآثار لا يقدّم جوزيفوس فقط سياقاً سياسيًّا ودينيًّا وافراً للعصر، ولكنّه يذكر أيضاً في فقرة أو أكثر يوحنّا المعمدان (18: 116-19) ويسوع (18: 63-64، 20: 200) ويعقوب، شقيق يسوع (20: 200-203). وللوهلة الأولى، فإنّ هذه ضربة حظّ غير عادية للمؤرّخ. ففي المقطع الأوّل، يقول جوزيفوس إنّ عيسى كان صانع عجائب ومعلّماً، وقد حُكم عليه بالإعدام من طرف الحاكم الرّوماني بيلاطس، وقد ادّعى أتباعه لاحقاً أنّه بُعث من بين الموتى، لكنّه يقول أيضاً «كان هو المسيح»، وأنّه ظهر لأتباعه بالفعل بعد وفاته!
لكنّ هذا الحظّ السّعيد يتحوّل فوراً إلى الشّك في أنّ المسيحيّين قد تلاعبوا لاحقاً بنصّ جوزيفوس، أو ربّما أدخلوا هذه الفقرة بأكملها في نصّه. قد يكون الأمر كذلك بالفعل، ولكن في القرن العاشر، اقتبس مؤلّف عربيّ مسيحيّ هذا المقطع نفسه من جوزيفوس بدون العناصر المبشّرة بالمسيحيّة، وبالتّالي بالشّكل الذي يعتقد الكثيرون أنّ جوزيفوس كتبه في الأصل:
في تلك الحقبة من الزّمن، كان هناك رجل حكيم يُدعى يسوع. وكان سلوكه حسناً، وهو الذي عُرف باستقامته. وقد صار كثير النّاس، من بينهم اليهود والأمم الأخرى، من تلاميذه. حكم عليه بيلاطس بالصّلب والموت. ولم يهجره أولئك الذين أصبحوا تلاميذه. وذكروا أنّه ظهر لهم بعد صلبه بثلاثة أيام، وأنّه على قيد الحياة. وبناء على ذلك، ربّما كان هو المسيا الذي روى عنه الأنبياء المعجزات. (أغابيوس المنبجي، كتاب العنوان) (3).
لقد نجم عن هذا المقطع في كتاب الآثار كتابات غزيرة ومثيرة وساخنة في بعض الأحيان. لكنّ جوزيفوس بدا أكثر إنارة في نواحٍ أخرى، لا سيّما في الاهتمام الكبير الذي يوليه لظاهرة النّبوءة الكارزمية، التي غالباً ما ترتبط بالعصيان، في فلسطين في تلك الحقبة. يتناسب عيسى تماماً مع نموذج الأنبياء المسيانيّين الذين ظهروا بين اليهود قبل حياته وأثناءها. لقد كانوا من صنّاع المعجزات الكارزميّين استمدّوا إلهامهم من موسى، وكانوا محاطين بفرق من الأتباع المخلصين. كانوا أكثريتهم العظمى متورّطين في نوع من العمل السياسي، سواء بشكل مباشر عن طريق حمل السّلاح ضدّ الرّومان أو بشكل غير مباشر من خلال التّظاهر ضدّ السلطة أو انتقادها، وواجه معظمهم نهاية عنيفة.
مخطوطات البحر الميّت
يصف جوزيفوس التّيّارات الدّينيّة في ذلك الوقت من حيث الأداء. يمكننا تمييز بعض الأجواء في الأدبيات التي أنتجتها مجموعات دينيّة مختلفة، سواء المعروفة منها، مثل الأسّينيّين الذين أنتجوا مخطوطات البحر الميّت، أو المجهولة الهويّة، مثل شتّى الطّوائف التي تقف وراء الكتابات الرّؤيويّة والمؤذنة بنهاية العالم التي لم تُدرج أبداً في البيْبل، لكنّها كانت شائعة في تلك الحقبة. إنّ التنبّؤ بنهاية العالم (apocalypse) تعني حرفيّاً الكشف. وفي هذه الحالة، فالمقصود هو الكشف عن أحداث الأيام الأخيرة من تاريخ البشريّة، وستكون خاتمة الله في خلقه وما كان مأمولاً فيه بكلّ إجلال وحبّ، التأييد النهائي لإسرائيل في مواجهة أعدائه. إنّ من شأن زمن الرّعب أن يخضع لزمن النّصر، وفي خضمّ زمن النّصر هذا تقف شخصيّة تخليص بني إسرائيل، الممسوح أو المسيح. لم يؤمن كلّ اليهود في زمن عيسى باقتراب نهاية الزّمان ولا بمسيح، ولكن من الواضح أنّ أتباع عيسى قد آمنوا بذلك، ويُمكن قراءة شكل إيمانهم ولونه من صفحات هذه الكتابات الرؤيويّة. تكشف مخطوطات البحر الميّت عن جماعة واحدة فقط من هذه الجماعات الرؤيويّة أسيرة انتظار نهاية الزّمان. لقد كانت حركة عيسى حركة أخرى.
مصادر الحاخامات
كما أنّ الحاخامات يناقشون موضوع عيسى، وإن كان ذلك من بابل البعيدة، كما كان يسمّى العراق، في فترة أربعمائة إلى ستّمائة سنة بعد الحدث (4). وكما لوحظ مؤخّراً، فإنّ ما يقولونه يكشف عن وضع اليهود في عراق ما قبل الإسلام أكثر ممّا يكشف عن عيسى التاريخي. وفقاً لتصريحات التلمود بشأن عيسى، فإنّ ولادته كانت غير شرعيّة: فهو ابن مريم (حسب إحدى الرّوايات، مصفّفة شعر) التي حملت من Pantheros، وهو جندي روماني. وحسب الروايات نفسها، فقد قُتل عيسى على يد اليهود، إمّا بالصّلب أو شنقاً، بتهمة كبرى هي تضليل النّاس. يسوع، إذن، في الروايات المتداولة -أي الحاخامية- قد تمّ القبض عليه ومحاكمته وإعدامه من قبل السلطات اليهوديّة في عصره بتهمة الخيانة.
المصادر المسيحيّة
أخيراً، نأتي إلى دليلنا الرئيس على عيسى؛ أي المواد الموجودة في الكتابات التي تمّ جمعها والمعروفة باسم العهد الجديد. العهد الجديد هو في الواقع حجّة أو رسالة تمّ تجميعها لإثبات أنّ عهد إبراهيم وموسى (berith بالعبرية؛ و testamentum باللاتينية) قد أعيد رسمه في شخص عيسى، المسيح الذي وعد به الأنبياء.
تتكوّن الوثائق التي تمّ جمعها من أربعة أعمال تسمّى الأناجيل أو «البشارة»؛ ومؤلّف تاريخيّ يسمّى (بشكل مضلّل إلى حدّ ما)، «أعمال الرسل»؛ ومن عدد من الرّسائل، وعلى رأسها رسائل بولس، وهو يهوديّ آمن بعيسى في وقت مبكّر جدّاً. وتشتمل أيضاً على الرّسائل المنسوبة إلى الرّسل بطرس ويوحنّا ويهودا، وإلى شقيق يسوع، يعقوب، وتحتوي أخيراً على سفر الرؤيا، الصيغة المسيحيّة للشّكل الأدبيّ اليهوديّ المألوف، رؤيا تكشف عن نهاية الزّمان، كما يُنظر إليها الآن من منظور مسيحيّ. يبدو أنّ تاريخ جميع هذه الوثائق يعود إلى القرن الأوّل: أقدمها بالتّأكيد هي رسائل بولس المكتوبة في خمسينيات القرن الأوّل وآخرها سفر الرؤيا، والتي ربّما تمّت كتابته في نهاية ذلك القرن.
الأناجيل
على الرّغم من أنّ رسائل بولس هي أقدم الوثائق في العهد الجديد، إلّا أنّها تنقل، كما سنرى، الشّيء اليسير جداً عن حياة يسوع النّاصري وتعاليمه. يأتي معظم ما نعرفه عن عيسى في الواقع من مجموعة واحدة من الكتب، وهي الأناجيل الأربعة التي تسمّى بالأناجيل القانونيّة للعهد الجديد.
إنّ «القانونيّة» هي حكم لاهوتيّ، وليست حكم مُؤرّخ، وحقيقة أنّ الكنائس المسيحيّة قد وصفت هذه الأناجيل الأربعة باسم «القانونيّة» لا يجعلها بالطّبع، بشكل أكثر أو أقلّ، وثائق تاريخيّة أصليّة. وبالفعل، فإنّ من أكثر المناقشات الساخنة حالياً حول مصادر عيسى هي تلك التي تتعلّق بدرجة المِصداقيّة التي يجب أن تُمنح لبعض المواد، بما في ذلك الأناجيل التي لم يتمّ تضمينها في العهد الجديد. وقد ظلّ معظم المُؤرّخين غير مقتنعين بقيمتها، ولا زال أغلبهم يعملون على أساس أنّه إذا كان سيتمّ استخراج عيسى التاريخيّ من أيّ وثائق؛ فمن المرجّح أن تكون الأناجيل التي سُمّيت بعد متّى ومرقس ولوقا ويُوحنّا، والتي ألّفها مؤمنون مسيحيّون في وقت ما، وهذه عبارة مهمّة، ما بين 60 و100 بعد الميلاد؛ أي ثلاثين إلى سبعين عاماً بعد وفاة يسوع (5).
قبل التّطرّق إلى تحديد زمنها، يجب أن ننظر إلى الأناجيل الأربعة للعهد الجديد على أنّها وثائق. لقد تمّ عرضها في شكل سيرة ذاتية، وعلى الرّغم من أنّها لا تُسمّى على هذا النّحو في اليونانيّة -الكلمة اليونانيّة للسيرة الذاتية هي bios، أو «الحياة»- فإنّها «البشارة» في يوناجليون اليونانيّ Greek euangelion. ولقد استخدمت هذه الكلمة الأخيرة بالمفهوم التّقني سابقاً، حيث كانت تشير إلى بيان، عادة ما يكون ذا طبيعة رسميّة، لبعض الوثائق المهمة من المعلومات. ومع ذلك، لا تظهر على أنّها مُسمّى لعمل أدبيّ.
تعرّف الأناجيل نفسها بشكل منفرد، وليس تحديداً من قبل المؤلّف. ويحمل كلّ منها عنوان «البشارة» حسب متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنّا. وهكذا قيل لنا في البداية من أنّنا نحصل على أربع صيغ مختلفة لما هو في الأساس البشارة نفسها؛ ثلاث صيغ من الصّيغ الأربع -تلك الخاصّة بمتّى ومرقس ولوقا- متشابهة تماماً في هيكلها، وأسلوبها، وما تتضمّنه، وغالباً ما تكون كلماتها ذاتها. ولأنّها تتناول نفس الأحداث بالطّريقة ذاتها، فإنّه يُطلق عليها الآن اسم الأناجيل الإزائيّة «Synoptic»، غير أنّ يوحنّا مختلف تماماً؛ فهو يتناول أحداثاً مختلفة، بترتيب مختلف ووفقاً لتسلسل زمنيّ مختلف. في الأناجيل الإزائيّة، يتحدّث عيسى عموماً في الأمثال أو في الأمثال العائليّة. أمّا في يُوحنّا، فإنّه يعبّر عن نفسه في الخطابات الطّويلة التي تتّسم بدرجة عالية من التّطوّر اللاهوتي. يحذف الإنجيل الرّابع كثيراً ممّا هو موجود في الأناجيل الإزائيّة، ويضيف إليها قدراً كبيراً لا تَتضمّنه.
التّرتيب والغربلة: من الواضح أنّ الأناجيل الإزائيّة الثلاثة مرتبط بعضها ببعض بطريقة غير واضحة تماماً، ولفهم تلك العلاقة المتداخلة، فمن الضروريّ أوّلاً محاولة ترتيبها. إنّها ليست بالمسألة الهيّنة والبسيطة؛ وذلك لعدم وجود ركائز داخليّة يمكن أن نحدّد بها التّواريخ. إنّ إنجيل مرقس هو أقصر الأناجيل الثلاثة، وأسلوبه هو الأكثر بدائيّة والأقلّ تهذيباً، وسرده هو الأكثر وضوحاً. ولكلّ هذه الأسباب، هناك توافق عامّ في الآراء -وهو أفضل ما يمكن أن نأمله في هذا النّوع من التّحقيق؛ الإجماع هو مفهوم عابر- أنّ مرقس هو أقدم الأناجيل الإزائيّة، وكان يُعْتقد في السّابق أنّه أفضل مصدر حقيقيّ لعيسى التاريخيّ.
وبمجرّد الاعتراف، كما هو الحال عموماً، بأنّ إنجيل مرقس هو أوّل إنجيل يتمّ تأليفه، فيصبح من الواضح، من مائتيْ آية أو نحو ذلك من الآيات المتطابقة في الأناجيل الثلاثة جميعها، أنّ متّى ولوقا قد اضطرّا إلى استخدام إنجيل مرقس لتأليف كلّ واحد منهما إنجيله، وأنّ هناك مصدراً مكتوباً غير معروف، والذي نطلق عليه الآن «مرقس»، كان موجوداً بين يديهما عندما قاما بتأليف نسخهما من البشارة. كما أنّنا في وضع يسمح لنا بأن نلاحظ بدقّة، وباهتمام كبير، كيف استخدم كلّ من متّى ولوقا إنجيل مرقس، وكيف عدّلا أو صحّحا أو وسّعا الإنجيل السّابق.
لكن هناك شيء آخر واضح، إذا وضعنا الأناجيل الإزائيّة الثلاثة جنباً إلى جنب، توجد أكثر من مائتي آية أخرى متطابقة إلى حدّ ما في متّى ولوقا، ولكنّها غير موجودة في مرقس. إنّ التّفسير الأسهل هو أنّ الإنجيلَيْن يجب أن يكون لديهما مصدر آخر قاما بإدراجه في عملهما. نحن لا نعرف ما هو، ولكنّنا نعرف فقط ما تضمّنه، أو بعض ما تضمّنه؛ أي تلك الــــ 235 آية المتطابقة غير المرقسيّة التي وردت في متّى ولوقا. لقد أطلق عليها علماء القرن التّاسع عشر الذين شكّلوا هذه الفرضيّة المقنعة اسم «Q»؛ أي كلمة Quelle الألمانيّة، التي تعني «المصدر».
إذا قمنا بعزل ما يشكّل Q ونظرنا فيه عن كثب، سيتّضح أنّ Q كانت عبارة عن مجموعة من أقوال يسوع، أو logoi، كما كان يُطلق عليها في أيّامه، وهي مجرّد أقوال فقط. الغريب أنّه لا يوجد موت بالصّلب ولا انبعاث في إعادة البناء الافتراضي في Q. مَن الذي سيقوم بمثل هذه المجموعة ولماذا؟ هل تعلّق الأمر بقدّاس بدائيّ يكون بمثابة مقدّمة لحركة عيسى، تاركاً الأجزاء الصّعبة إلى وقت لاحق؟ هل كان يُعتقد أنّ الأمر يتعلّق بإنجيل حقيقيّ؟ هل تعلّق الأمر ببشارة مختلفة تماماً، وربّما بيسوع مختلف تماماً، وحتّى بعيسى الحقيقيّ، كما يقترح بعضهم الآن؟
اعتقد الباحثون بشأن عيسى في القرن التّاسع عشر، أنّهم اكتشفوا في Q مصدراً جديداً مثيراً للاهتمام لمتّى ولوقا. لم يُضف ذاك المصدر بالتّأكيد أيّ معلومات جديدة؛ لأنّ مادّة Q كانت موجودة في هذيْن الإنجيليْن منذ البداية، لكنّ المُؤرّخين في النّصف الثّاني من القرن العشرين بدأوا ينظرون إلى Q بطريقة مختلفة تماماً، كما سنرى لاحقاً بمزيد من التّفصيل. ومن بين أسباب ذلك هو اكتشاف مخطوطة في عام 1945 تسمّى كذلك «إنجيل توما». هذا الإنجيل الموصوف بذاته عبارة عن مجموعة من 114 قولاً لعيسى، بعضها صدى للأناجيل القانونيّة، وبعضها الآخر غير ذلك. لكنّ الشيء المهمّ هو أنّه كان إنجيلاً بشكل رسميّ. لذلك، كان من الممكن تصوّر مجموعة أقوال مثل Q على أنّها إنجيل حقيقيّ، وإعلان رسميّ عن رسالة يسوع. ويقدّم لنا «توما»، تماماً مثل Q، يسوع الذي لم يمت على صليب، ولم يبعث من بين الأموات. كان يسوع كلّ من توما و Q مجرّد معلّم وواعظ.
من الواضح أنّ Q قد ظهرت في وقت مبكّر، على الأقلّ في وقت قبل إنجيل مرقس، ولكن من أين ومتى جاء توما؟ إنّ إنجيل توما المحفوظ، وهو ترجمة قبطيّة لأصل يونانيّ معروف الآن في أجزاء فقط، لم يكن، في أيّ حال، سجلّاً موثوقاً به. لقد كان جزءاً من مكتبة طائفيّة من القرن الرّابع تمّ اكتشافه في نجع حمّادي في مصر. لقد عُرف الطّائفيّون بالغنّوصيّين، والغنّوصيّة هي حركة مسيحيّة مبكّرة أدانتها الكنائس المهيمنة، وتضمّنت مكتبتهم عدداً من الأعمال التي تحمل عنوان «الإنجيل»، ولكنّها لا تظهر في العهد الجديد، ثمّ أصبح يطلق عليها «أبوكريفا».
الأبوكريفا: الكلمة تعني «مُحتفَظ به» أو «محدود»، و«أبوكريفا» هو مصطلح يستخدم لوصف الأعمال غير المدرجة في المجموعة الرّسميّة. إذن، يوجد الأبوكريفا البيْبليّة، مثل الأعمال اليهوديّة المذكورة سابقاً المنسوبة إلى إدريس Enoch وباروخ Baruch، والتي لم يتمّ تضمينها في البيْبل اليهوديّ، ويوجد أيضاً، كما في هذه الحالة، أبوكريفا العهد الجديد، وهي الأعمال التي يدّعي بعضهم مصداقيّتها -لمجرّد أنها تسمّى ببساطة بــــ«الإنجيل»- لكنّها ليست جزءاً من العهد الجديد للمسيحيّين. مَنْ الذي اتّخذ ذلك القرار المهمّ؟ بعبارة أخرى: مَن الذي أوجد «العهد الجديد»؟ ومن الذي قرّر ما كان وما لم يكن يتضمّنه؟
إنّ العهد الجديد هو مجموعة الكتابات القانونيّة للكنيسة المسيحيّة بأكملها، وإذا تمّ فهمه بهذه الطريقة، فمن الواضح أنّ مجموعة الكتابات القانونيّة هي نتاج عصر نشأت فيه الكنيسة العلميّة أو الكاثوليكيّة، كما كان يُطلق عليها. إنّ بداية تأسيس الكنيسة العالميّة كانت دعوة رسميّة لجميع أساقفتها في نيقيّة عام 325 بعد الميلاد بأمر من الإمبراطور قسطنطين. ومنذ ذلك الوقت وفي السّنوات التّالية، أصبح ممكناً التّصديق على مجموعة الكتابات القانونيّة وإصدارها، لكن تلك فقط هي نهاية الرّواية. تقود كلّ الأدلّة إلى أنّ المسيحيّين كانوا يستخدمون بالفعل بحلول القرن الثّاني، هذه الأناجيل الأربعة وحدها دون غيرها في خدماتهم الكنسيّة. ولذلك يبدو أنّ قانوناً إنجيليّاً توافقيّاً قد تطوّر، في وقت مبكّر نسبياً، بين الأبرشيات المسيحيّة المستقلّة (ekklesiai) التي ظهرت إلى الوجود حول حوض البحر الأبيض المتوسّط.
ولماذا استقرّ أمرهم على هذه الأناجيل الأربعة؟ من الواضح تماماً أنّ القانون في هذا السّياق هو مصطلح لاهوتيّ وقضائيّ. إنّ الأمر يتعلّق بحُكمٍ، حيث إنّ هذه الأعمال، مثل العهد الجديد في مجمله، تحمل شاهداً حقيقيّاً على عيسى بصفته المسيح وابن الله. هذا هو معيار الكنيسة، لكنّه لا يفيد المُؤرّخ إلّا عندما يعكس حكماً حول تاريخيّة الأناجيل. هذا ما يقوم به في جزء منه -بالنّسبة إلى المسيحيّين، إنّ عيسى «الحقيقي» كان دون شكّ عيسى التاريخيّ- ولكن كان هناك ما هو أكثر من التّاريخ على المحكّ في صياغة هذا القانون، والمُؤرّخون المعاصرون على وجه الخصوص حريصون على عدم إعطاء أهمّية للأناجيل «القانونيّة» للكنائس. هم يريدون إلغاء التمييز بين «قانونيّ» و«أبوكريفا»: ينبغي أن يُحكم على كلّ إنجيل على أساس موضوعيّته كوثيقة تاريخيّة.
ما يبحث عنه المؤرّخ هو مصدر حول عيسى يكون في الوقت ذاته مبكّراً ومستقلّاً؛ أي إنّه لا يكرّر أو يعيد صياغة ما استمدّه من وثائق سابقة أخرى. تندرج معظم الأناجيل الأبوكريفيّة المحفوظة -وتُعرف العديد منها من خلال عناوينها فقط، ضمن صنف الوثائق المستنبطة. يعتقد الكثيرون أنّ إنجيل توما، على سبيل المثال، يعتمد على الأناجيل الإزائيّة. أمّا بعض الأناجيل الأبوكريفيّة الأخرى، فهي إبداعات متأخّرة بشكل واضح مكرّسة لتوضيح أو تضخيم قصّة عيسى المعروفة بالفعل من الأناجيل القانونيّة. أفضل مثال معروف على ذلك هو بلا شكّ ما يسمّى بإنجيل يعقوب الأوّلي الذي يعيد سرد قصّة ولادة عيسى، كما تمّ العثور عليها في روايات طفولتيْ متّى ولوقا. إنّه مليء بالتفاصيل الغريبة والخياليّة، لكنّه أيضاً مسلٍّ بشكل واضح وتكوّن للإنجيل الأوّلي جمهور واسع من القرّاء بين المسيحيّين.
تحديد تاريخ الأناجيل: لا تزال المسألة الحاسمة لتاريخ المصادر المتعلّقة بعيسى تكمن في خلفية هذه المناقشة. إذا بحثنا عن الجمعة العظيمة أيّام عيد الفصح في تلك الحقبة وقارنّاها بفترة نيابة بيلاطس البنطي المعروفة في يهودا (26-36م)، فسنتمكّن من تحديد موت يسوع حوالي عام 30 م أو قريباً منه، فكم من الوقت استغرقت مصادرنا بعد هذه الحقبة حتّى تمّ تأليفها؟ لا توجد تواريخ في الأناجيل نفسها، ولا توجد أدلّة داخليّة مباشرة حول زمن تأليفها. يتعيّن على المُؤرّخين مرّة أخرى الاعتماد على الوسائل غير المباشرة. في السّنة 70، في نهاية عصيان اليهود الفاشل، وبعد حوالي أربعين عاماً من موت يسوع، استولى الرّومان على مدينة أورشليم بعد حصار وحشيّ. أثناء المعركة من أجل أورشليم، أُضرِمت النّيران في هيكل هيرودس العظيم، الذي كان قد اكتمل أخيراً قبل ثماني سنوات فقط، وسُوِّي في النّهاية بالأرض. وهذا يعني نهاية عبادة اليهود القربانيّة لإلههم، والتي لم يكن من الممكن لقرون طويلة أن يؤدّيها إلّا الكهنة في الهيكل العظيم الموثّق بالكتابات المقدّسة. بكلّ المقاييس، كان حصار أورشليم وسقوطها وتدمير هيكلها حدثاً مأساوياً وصادماً في حياة اليهود، بما في ذلك الجيل الأوّل من أتباع عيسى.
إذن، هل ورد هذا الحدث الهامّ في الأناجيل؟ إذا كان ذلك كذلك، فقد يمكننا تحديد تاريخ هذه الأناجيل دون التباس بعد 70 للميلاد، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك -فلا يُتصوّر ألّا يُذكر مثل هذا الحدث في حياة شخص كان مصيره مرتبطاً صراحةً بمصير الهيكل- فمن المحتمل جداً أنّ مثل هذا العمل كان سيتمّ تأليفه قبل الحدث؛ أي قبل 70م. لم يرد أيّ ذكر في Q لتدمير الهيكل، وإذا انتقلنا إلى مرقس، الذي قُدّر بالفعل أنّه الأقدم بين الأناجيل الإزائيّة، فيبدو أنّ معظم النقّاد يعتقدون أنّ هناك بعض الأثر لأحداث 70م في مرقس الأصحاح 13، والتي تدّعي أنّها رؤية يسوع المروّعة لنهاية الزمان. وهكذا، فإنّ إنجيل مرقس مؤرَّخ عموماً حوالي 60-70 بعد الميلاد، مع هامش تحرّك كبير يعكس عدم اليقين في تقدير ذاك التّاريخ. وحيث إنّ كلّاً من متّى ولوقا، اللّذيْن لهما إصحاحات رؤيويّة (متّى 24: 1-31؛ لوقا 21: 5-28) موازية لإصحاحات مرقس، قد استخدما إنجيل مرقس كمصدر، يجب ترك فترة زمنيّة لهذا الأخير حتّى يصبح متداولاً. ومن ثمّ، فإنّ تاريخ متّى ولوقا يوضع عادة في 80-90 بعد الميلاد ويتمّ التعرّف على تدمير هيكل أورشليم القدس بطريقة أو بأخرى في صيغهم الفرديّة لنهاية الزّمان (6).
وماذا عن يُوحنّا؟ هل تمّ تأليف الإنجيل الرّابع بشكل مستقل عن الأناجيل الإزائيّة؟ ومتى تمّ تأليفه؟ إنّ إنجيل يُوحنّا هو مصدر معقّد جدّاً؛ فهو يُمثّل تأليفاً أدبياً مكتملاً بإبداع كبير (مع احتمال زيادة كبيرة في النهاية) -يصف يُوحنّا المعجزات والأحداث في حياة عيسى التي لم تذكرها الأناجيل الإزائيّة- وبتاريخيّة ملحّة في ذات الوقت: يبدو المُؤلّف على دراية واسعة بالتفاصيل السياسية والطبوغرافية لفلسطين وأورشليم عيسى أكثر من أيّ إنجيل من الأناجيل الثلاثة الأخرى. في الوقت نفسه، يُعدّ يُوحنّا مُؤلّفاً أكثر منه ناقلاً مقارنة بالآخرين. لعيسى يُوحنّا وجهة نظر مختلفة جدّاً مُبيّنة بلغة معقّدة للغاية وصور غريبة تماماً عن صورة المسيح الحكيم والعطوف كما رسمها، على سبيل المثال، كلّ من مرقس وQ. إنّ الرّأي المتّفق عليه هو التّالي: أوّلاً، أنّ يُوحنّا في جميع الاحتمالات كان يعرف الأناجيل الإزائيّة، لكنّه فضّل أن يسير في طريقه الخاصّ؛ وثانياً، أنّ يُوحنّا يُمثّل أيضاً في كثير من الحالات تقليداً لشاهد عيان مباشر على حياة عيسى.
أمّا بالنسبة إلى تحديد تاريخ العمل، فليس في إنجيل يُوحنّا أيّ فصل رؤيوي، وبالتّالي فليس هناك تنبّؤ بشكل قطعيّ بتدمير أورشليم. ومن خلال لاهوتيّته المعقّدة، اقتنع العديد من النقّاد بأنّ هذا الإنجيل كان متأخّراً جداً، وقد تعزّز هذا الحكم بالنسبة إلى الآخرين من خلال إشارات يُوحنّا الواضحة إلى طائفة موجودة من المسيحيّين الذين هم في خلاف مع مواطنيهم اليهود. وبناءً على هذه الأسس، فقد تمّ تحديد تاريخ إنجيل يُوحنّا حوالي 90-100م. لكنّ هذيْن المعياريْن، وهما رؤيا يسوع شديدة اللاهوتيّة ووجود توتّرات بين أتباع عيسى ومواطنيهم اليهود، موجودان بالفعل في بولس، الذي يمكن تحديد تاريخ رسائله بيقين مطلق إلى منتصف الخمسينيات من القرن الأوّل. لم تُؤثّر هذه الشّكوك كثيراً على التّاريخ المعهود لهذا الإنجيل، حيث لا يزال كثير من النّاس يعتقدون من أنّ تأليفه قد تمّ في بداية القرن الثاني.
بولس
كان بول، أو شاؤول، من يهود الشتات، أصله من طرسوس، في تركيا الحديثة، وُلِد حوالي عام 6 قبل الميلاد، وكان أكبر من عيسى بسنتيْن، ومات في روما، على الأرجح في عام 67 بعد الميلاد. بالرغم من أنّ بولس لم ير عيسى التاريخي أبداً؛ وذلك حسب روايته، فإنّه يظلّ شاهداً مبكّراً ومهمّاً على سيرة عيسى من حيث إنّ اسمه مرتبط بشكل حقيقيّ بسلسلة من الرّسائل التي يَتضمّنها العهد الجديد. وبالفعل، فهو الصوت الوحيد الذي لا جدال فيه في المدوّنة كلّها، وإدراج رسائله هناك يُظهر أنّ المسيحيّين الأوائل قد أخذوا هذا الصوت على محمل الجدّ. إنّ إضفاء القداسة على مجموعة مراسلات بولس لم تضمن المعلومات عن عيسى المنقولة هناك فحسب، بل ضمنت أيضاً، وهذا أكثر أهميّة، نظراً لأنّ هذه المعلومات متاحة بمزيد من التّفصيل في أماكن أخرى، فَهْمَ بولس لمعنى حياة يسوع وقبل كلّ شيء معنى وفاته. إذا كان للتمييز بين مسيح التّاريخ وعيسى التاريخيّ أيّ مصداقيّة، فإنّ لدينا إذاً أوّل لمحة عن كليهما في رسائل بولس.
يقوم بولس بأكثر من مجرّد تقديم معلومات متناثرة عن يسوع التاريخيّ، ورسم جريء لمسيح التّاريخ الناشئ؛ فالرسائل توفّر لنا صورة سيرة ذاتيّة قيّمة وفريدة من نوعها لواحد من أوائل أتباع يسوع ولمحة عن المعتقدات حول عيسى السائدة في بعض الأوساط في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الأوّل، من عشر إلى عشرين عاماً، ليس أكثر، بعد وفاته.
يجب الاعتراف مباشرة بأنّ الأدلّة فيما اعتقده بعض أتباع عيسى بشأنه بعد عقد أو نحو ذلك من وفاته هي أقوى بكثير ممّا كان معروفاً عن يسوع. تتعلّق رسائل بولس، في نهاية المطاف، بالمعتقدات والممارسات المسيحيّة وليس بعيسى في المقام الأوّل. ولكن يوجد شيء ما في هذا أيضاً: فبناءً على أدلّة رسائل بولس، لم تكن أحداث حياة عيسى أبداً موضع خلاف. ولتفسير ذلك، يجب على المُؤرّخ أن يختار بين أمريْن: اعتبار أنّ سيرة عيسى والأحداث التي مرّ بها في حياته لم تكن ذات أهمّية بالنسبة إلى المعتقد المسيحيّ أو اعتبار أنّه كان هناك معرفة وإجماع حول تفاصيل سيرة عيسى وتعاليمه، على الأقلّ فيما يتعلّق بتلك التفاصيل التي اعتُبِرت مهمّة. إذا كان التّوافق بين بولس والجماعات المسيحيّة التي يتراسل معها يبدو هو الأرجح بخصوص تفاصيل سيرة يسوع، فإنّنا ما زلنا بعيدين عن اكتشاف ماهية تلك التفاصيل، باستثناء بعض النّقاط.
إنّ هذه الاستثناءات القليلة مثيرة للاهتمام. أكّد بولس (رسالة كورنثوس الأولى، 11: 23-25) -وعلى ما يبدو، لم يعترض أحد على هذا التّأكيد- أنّ يسوع، في اللّيلة التي سبقت موته، قد تناول وجبة عشاء غير عاديّة مع أتباعه كشف أثناءها أنّ الخبز هو جسده، وأمر بتكرار طقوس الحدث: «اصنعوا هذا لذكري» (7).
تنكر الدّراسات الحديثة صحّة بعض الرّسائل التي تمّ جمعها باسم بولس في العهد الجديد. إنّ كلّاً من رسالة تسالونيكي 1، ورسالة كورنثوس 1و2، وسفر غلاطية وسفر رومية، وربّما فيلبي وفليمون، قد اعتُبِرت جميعها من عمل بولس نفسه، بينما أُثيرت الشّكوك حول تسالونيكي 2 وكولوسي وأفسس. أمّا الرّسالة إلى العبرانيّين والرسائل الرّاعويّة، اثنان منها لتيموتي وواحدة لتيتوس، فهي بالتّأكيد من يد شخص آخر. لقد أضفت الكنيسة المبكّرة القداسة على جميع هذه الرّسائل في العهد الجديد، وقد يكون ذلك على أساس أنّ كلّها «ذات علاقة ببولس» وإن لم تكن بالضرورة من بولس. ومهما كانت الوجاهة اللّاهوتية لهذا القرار، فهو ليس ذا نتيجة للمُؤرّخ: إنّ بولس الحقيقيّ هو وحده الذي سيفي بالغرض بوصفه شاهداً من الجيل الأوّل على عيسى.
المصادر الأدبيّة المسيحيّة مختصرة
وممّا تمّ تأكيده فيما ما يبدو في فترة مبكّرة جدّاً، لدينا إذن، من وجهة نظر صارمة، مصدران لحياة يسوع، هما إنجيل مرقس وQ المعاد بناؤه؛ ومن وجهة نظر أوسع، ينبغي أن نضيف يوحنّا، ولدينا كذلك ما يمكن استخلاصه من بولس، ولنا أيضاً المادّة «الجديدة» في متّى ولوقا؛ أي الأحداث والأقوال غير المشتقّة من مرقس أو Q. وأخيراً، ربّما توما أو أجزاء أخرى من الأبوكريفا (8).
يعتقد بعضهم أنّه من الممكن الاقتناع بالمصدريْن المبكّريْن. لقد باءت محاولات تفكيك إنجيل مرقس بفشل ذريع -لا يوجد مرقس أصلي UrMark توافقيّ- ولكن ظهر مؤخّراً ما يمكن أن يُطلق عليه اسم «أصل Q» UrQ. يتمّ تحقيق هذه الفرضيّة المزدوجة من خلال طرح مصدر وحيد، وهو عبارة عن مجموعة أصليّة لأقوال عيسى التي تكمن وراء كلّ من Q وتوما. لا شكّ أنّ تاريخ Q المبكّر بالضّرورة، والذي كان قبل متّى ولوقا وربمّا قبل مرقس أيضاً، قد مارس بلا شكّ نوعاً من «القوّة الجاذبة» على تأريخ توما. من المستحيل أن نقول بالضّبط ما ورد في هذه المجموعة الأولى المقترحة من أقوال يسوع، ولكن إذا قبلنا إعادة صياغة كلّ من Q وتوما، فسيتّضح تماماً كلّ ما لم يكن جزءاً من ذلك. في هذه الصورة المبكّرة لعيسى لم يكن هناك عقيدة أخرويّة، ولا سرد عاطفيّ، ولا قيامة أو تجلّ. كان عيسى وبكلّ بساطة معلّماً للحكمة، وما بقي هو تحديد طبيعة أو نوع ذلك المعلّم.
سجلّ محمّد
كما رأينا، فهناك قليل من الأدلّة المحسوسة والمادّية بشأن محمّد. لقد عاش محمّد في بيئة طبيعيّة غير ثابتة، حيث أقام السكّان المستقرّون في مبانٍ من الطّوب الطّينيّ -يقال إنّ الكعبة كانت المبنى الحجريّ الوحيد في مكّة، والذي غالباً ما دمّرته الفيضانات المفاجئة- أمّا البدو الرّحل، فقد تركوا وراءهم آثاراً قليلة، إن وجدت. يمكن القول إنّ علم آثار شبه الجزيرة العربيّة هو الحَفْرُ في الذّاكرة.
يَتكوّن ملفّ محمّد من مجموعتيْن من الوثائق؛ تَتمثّل المجموعة الأولى في عمل موحّد يُدعى القرآن، وهو عمل مقدّس عند المسلمين بوصفه كلمة الله التي نقلها على لسان نبيّه. وبصرف النّظر عن مصدره الأخير، بشريّ أو إلهيّ، فإنّ المسلمين وغير المسلمين على حدّ سواء، ينظرون إلى القرآن على أنّه مجموعة من الأقوال التي صدرت عن محمّد على مدار اثنيْن وعشرين عاماً حتّى وفاته سنة 632م (9). إنّ للقرآن أهمّيّة محوريّة بخصوص موضوعنا، فهو «المصدر الأساسيّ لسيرة محمّد». هكذا يبدأ «ألويس سبرينجر» كتابه عن محمّد: The Life and Teaching of Mohamad، وهو واحد من أوائل السّير الذّاتيّة النّقدية للنّبيّ في العصر الحديث، ولم يغيّر هذه الحقيقة أيّ دليل تمّ اكتشافه منذ ذلك الحين، أو أيّ حكم قُدِّم فيما بعد. أمّا المصدر الثّاني عن محمّد، مصدر أقلّ يقيناً من القرآن ولكن ليس أقلّ أهمّية منه، فهو سلسلة من المؤلّفات، أو في بعض الحالات، مجرّد شذرات من المعلومات، معظمها مستمدّ من سيرة محمّد الذّاتيّة التي ألّفها ابن إسحاق في بغداد، وهو أحد كتّاب السّيرة النّبويّة، توفّي حوالي 768م، أو مستمدّ من عمل للواقدي (ت 823) حول غزوات محمّد في شبه الجزيرة العربيّة.
الله أعلم: القرآن
فيما يتعلّق بعيسى، فإنّ أقرب مصدر يقودنا إلى الشّخص الحقيقيّ، حيث يمكننا سماع صوته، ربّما يكون مصدر الأقوال الذي يُدعى «Q». يمكننا أن نفعل الشيء ذاته مع «Q» الخاصّة بالمسلمين، والتي هي القرآن في هذه الحالة. لكنّ آيات القرآن، منفردة أو في سور كاملة، مثل مأثورات عيسى في Q، هي أقوال بدون سياق، تعبيرات بدون سياق تاريخي Sitz im Leben، أو كما أطلق عليها المسلمون، «أسباب النّزول». ولتوفير هذا السّياق، الذي سيمدّنا بالإطار السّردي لــــحياة محمّد، المعادل الإسلاميّ للأناجيل، يجب أن نَتحوّل إلى تقاليد السيرة الذّاتية الإسلاميّة. بيد أنّ القرآن ذاته يحتاج أوّلاً إلى دراسة أكثر دقّة.
تكوين القرآن الذي بين أيدينا
القرآن هو مجموعة من أقوال محمّد التي قيل إنّ الله قد ألهمها إيّاه، ويعود ظهوره إلى ما بعد «دعوة» محمّد إلى النّبوّة في مكّة، وعادة ما أُرْجِع تاريخه إلى عام 610، وقد استمرّ حتّى وفاته في عام 632 (10). وبمجرّد خروج الآيات من فم محمّد؛ تلقّفها فريق صغير من المسلمين بالحفظ والتلاوة، كشكل من أشكال العبادة، بتوجيه خاصّ من النّبيّ. وتستمرّ الرّواية التقليديّة بالقول إنّه بعد وقت قصير من وفاة محمّد، بدأ استرجاع أقواله الملهمة من الله وجمعها من ذكريات معاصريه ومن بعض ما كُتِب في ذلك المجتمع الذي بالكاد يفقه القراءة والكتابة. إنّ هذا العمل المبكّر لم يكن واضحاً لنا بشكل كامل، لكنّ الروايات أصرّت على أنّ الخليفة الثّالث عثمان (حكم 644-656)، قد كلّف لجنة، بعد حوالي عشرين سنة من وفاة محمّد، لإعداد نصّ مكتوب موحّد للقرآن (11)، كتاب هو في جوهره القرآن الحالي. تمّ جمع الآيات وتوزيعها إلى 114 سورة.
كيف يمكن لذلك أن يساعدنا؟
هناك إجماع شبه كامل على أنّ القرآن أصليّ، وأنّ النّصّ الذي بين أيدينا مصدره رجل واحد، هو محمّد. وقد لا يكون هذا النصّ كلّ ما قاله محمّد -في الواقع هناك أدلّة قاطعة على أنّ كلّ آياته ليست في القرآن الحالي- ولكن لا يوجد ما يشير إلى التّحريف أو التّلاعب، إلّا أنّ مصحفنا هذا هو نصّ مكتوب. لقد أحدث كتبة القرآن السّور، وقاموا بتجميعها، بل وتنظيمها ثمّ أعطوا لكلّ سورة اسماً، ثم رتّبوها بشكل تنازليّ حسب طول السورة (12).
بالطّريقة التي يقدّم بها القرآن نفسه، فإنّ الله عموماً هو الذي يتحدّث، إمّا بأسلوب التّهديد لجمهور الوثنيّين المكّيّين في بداية الوحي أو بأسلوب مهذّب إلى جماعة من «الطائعين» في المدينة في نهايته. إذا كان الأمر كذلك، فإنّ الله (أو محمّداً متحدّثاً نيابة عنه) مهتمّ بــــ «الطاعة» ولكنّه لا يهتمّ كثيراً بأيّ من الأمور المحلّية أو التّاريخ المعاصر. إنّ اهتمام القرآن بالماضي يتركّز بشكل كبير على التّاريخ المقدّس، وقصّة الخلق وتاريخ الأنبياء المختلفين من إبراهيم إلى يسوع الذين أُرسلوا للبشريّة كي يظلّوا على الصّراط المستقيم، لكنّه لم يخبرنا إلّا نادراً عن مكّة والمكّيّين، بل حتّى عن محمّد. لم يكن ذلك من اهتمامات القرآن ولا من المواضيع التي تطرّق إليها.
من أكثر الأشياء الملفتة في القرآن هو التّاريخ الذي لم يتمّ إعادة النّظر فيه أو تعديله. لا يوجد فيه أيّ تعبير واضح عن معاناة محمّد في مكّة، ولا انتقامه من قريش الذين سعوا لقتله، وربّما الأكثر غرابة هو عدم وجود شماتة المنتصر في ضوء النجاحات المتزايدة التّي حقّقتها جيوش المسلمين وانتشار الإسلام على نطاق واسع. وعلى عكس عيسى، عاش محمّد طويلاً بما يكفي حتّى يكون قيصراً مثل قسطنطين، ويفرض دين الإسلام على معظم سكّان شبه الجزيرة العربيّة ويصبح سيّداً لكومنولث إسلاميّ. وكان بإمكانه، لو أراد ذلك، أن يُدرج في القرآن خطباً تمدحه وتثني عليه على غرار ما فعله يوسابيوس بخصوص قسطنطين أوّل القياصرة الرّومانيّين الذين اعتنقوا المسيحيّة (Laudes Constantini: Eusebius). لقد تبنّى محمّد بسهولة دور قسطنطين، القسّ الإمبراطور، وقد كان مسكنه في مسجده بالمدينة، في بعض الجوانب على الأقلّ، القصر المقدّس sacrum palatium. لكنّ محمّد رفض أن يلعب دور يوسابيوس. إنّ سور القرآن المدنيّة لا ينقصها اليقين، لكنّها أيضاً ليست مليئة بمدح الذّات أو الثّناء. القرآن «ينتهي» -وهو مفهوم غير دقيق للغاية- بمثل ما «بدأ» به، حيث ركّزت نظرته على تاريخ الخلاص وليس على الأحداث المعاصرة في مكّة والمدينة التي يتوق المؤرّخ إلى سماعها.
ظرفيّة القرآن
لقد كان على أتباع محمّد أن يؤمنوا منذ البداية -لم يتوصّلوا، كما في حالة عيسى، إلى استنتاج لاحق- فما كانوا يسمعونه من النّبيّ كان كلام الله ذاته. وتماما مثلما تمّ نقله من مصدره الأصليّ، يبدو كلام الله مبهماً للغاية في تحديد الأماكن، ومشحوناً بشدّة بالملابسات، مع إشارات إلى أشخاص مجهولين وأماكن يُفترض أنّها معروفة لجمهوره وإلى الاعتراضات التي أثارها منتقدون معظمهم غير معروف.
هناك حقيقتان تحريريّتان تمّ فيهما محو الطّابع الظّرفي لما كان يُتلى. في الحالة الأولى، كان إصرار محمّد نفسه على حفظ تلاوات آياته على أنّها ترانيم طقسيّة، وسلسلة من الحِكم الخالدة شبيهة بما كان يُتلى في قدّاس كاثوليكي، ودون أيّ إشارة إلى الحدث اللّاهوتي الخطير الذي وضعها في مسارها. لقد محت الآيات، بفعل تلاوتها، تاريخ الكلمات. تمّ إجراء المحو الثّاني عن طريق كتبة القرآن الذي بين أيدينا حاليّاً. إنّهم هم الذين أعادوا تجميع «التّلاوات» الأصليّة في 114 سورة، وبذلك طمسوا حجم وشكل الوحي الأصلي للمسلمين. بعد ذلك، وفي إجراء أخير لطمس التّاريخ، أعاد كتبة القرآن تجميع السّور الجديدة، عموماً بطريقة ميكانيكية تماماً، كما لاحظنا، من السّور الطّوال إلى قصار السّور. كان تنازلهم الوحيد عن السّياق، وربّما كان عن مضض، هو إضافة العبارة المقتضبة «سورة مكّيّة» أو «سورة مدنيّة»، في رأس كلّ سورة.
ليس لأجزاء القرآن الحالي أيّ أهمّيّة دينيّة أو تاريخيّة على وجه الخصوص. لقد كانت نتاج النّسخ والأسباب الدّقيقة لتشكّلها وطولها وتسلسلها غير معروفة. وأصبحت الآيات هي الوحدة المهمّة الآن، يمكن الاستشهاد بأيّ منها أو إنتاجها بنفس التّأثير في سياق شرعيّ أو لاهوتيّ. إنّ القرآن صحيح وكامل في ذات الوقت.
لكن هناك استثناءٌ مهمّ لهذا التّسطيح للسّياق التاريخيّ. وفقاً لما جاء في الآية 106 من سورة البقرة، فقد نسخ الله آيات معيّنة من القرآن واستبدلها بآيات أخرى، بينما ترك الآيات المنسوخة في النّصّ بطريقة غير مبرّرة نسبيّاً. هذه النّظريّة الصّريحة للنّسخ غير معروفة للأناجيل، التي كان على مفسّريها اللّاحقين حلّ التّناقضات داخلها من خلال الموائمة بين الأناجيل الأربعة. لقد عرف المفسّرون المسلمون بالتّأكيد كيفية المواءمة بين النّصوص المتضاربة، لكنّ عمليّة نسخ بعض الآيات قد مثّلت تحدّياً استثنائيّاً، وفّر لهم القرآن المدوّن أدلّة قليلة لمعالجته. كان من الواضح وجوب نسخ آية سابقة بآية لاحقة، لكنّ القرآن لا يعطي أيّ إشارة أو تلميح إلى الآية التي تليها في هذا النّصّ المعاد ترتيبه بشكل أساسي. لذا كان على المسلمين بعد ذلك محاولة ترتيب زمنيّ.
وهكذا، فإنّ القرآن عالق في نظام مرجعيّته الذّاتية، غالباً ما يلعب فيه محمّد دوراً ليس أكثر من مجرّد ناقل متفرّج. نحن نعلم أنّ هذه ليست القصّة الكاملة. يوجد في القرآن سابق ولاحق، أوّل وآخر، أفكار أولى وثانية، تماماً مثل ما يجب أن يوجد في أيّ وثيقة تمّت صياغتها على مدار اثنين وعشرين عاماً. نحن نعلم أيضاً أنّ القرآن، وبالتأكيد القرآن المكّيّ، كان موجّهاً إلى تقليد دينيّ موجود بالفعل، والذي أصبح مرفوضاً في جزء ومعدّلاً في جزء آخر، ولكنّه مع ذلك يمثّل المعتقدات والممارسات الحالية لجمهور محمّد. نحن نعلم أنّ الأمر كان كذلك؛ مشكلتنا هي أنّنا لا نملك فكرة واضحة تماماً عن التّقاليد الدّينية قبل الإسلام في مكّة نظراً لأنّ ما لدينا من أساطيرها أو طقوسها أو قطعها الأثريّة، إن وُجد، ضئيل جدّاً.
إعادة ترتيب القرآن زمنيّاً
إذا كان المؤرّخ العلمانيّ يعتقد، كما ينبغي له، أنّ ما خرج من فم محمّد هو مُنتَج محمّد نفسه، فإنّ مدار القرآن كلّه حول محمّد، وهو سجلّ حقيقيّ لا مثيل لفكره الدّينيّ، وهو أيضاً وثيقة حيّة، بما أنّ الأحكام تصدر تباعاً على مدى اثنين وعشرين عاماً. لقد استمرّت مسيرة عيسى العلنيّة بالكاد عاميْن، بينما امتدّت مسيرة محمّد على مدى أكثر من عقديْن.
هذا ما يجب أن يكون عليه القرآن، لكن يصعب أن يكون على هذا النّحو في حالته الحاليّة. ومع ذلك، فإنّ إخراج القرآن من سياقه ليس بالأمر الذي لا يمكن معالجته تماماً، وقد كان لدى كلّ من المسلمين وغير المسلمين على حدّ سواء دوافع قويّة لإعادة مقدار من التّاريخ إلى القرآن من خلال محاولة تمييز التّرتيب الزّمني للوحي. كان هناك، كما رأينا، مسألة النّسخ، وهي محاولة تحديد الآية السابقة المنسوخة والآية اللّاحقة الناسخة. لكن كان لدى المسلمين دوافع تاريخيّة وقانونيّة أخرى لمحاولة إعادة صياغة القرآن. وبمجرّد أن بدأوا يهتمّون بحياة محمّد، فقد أخذوا على عاتقهم مهمّة مطابقة الآيات القرآنيّة بأحداث تذكّروها من حياة النّبيّ. أو ربّما كان العكس هو الصّحيح: فالآيات القرآنيّة، التي تكرّرت مراراً ومراراً، قد شجّعت التساؤل عمّا كان يحدث وراء الوحي بحدّ ذاته.
أخيراً، كان لا بدّ من تحليل ودراسة مسألة الوحي أيضاً. لقد شكّلت الآيات توجيهاً إلهياً، وكان من المهمّ أن يتمّ تلقّيها بالشكل الصحيح، ليس فقط على المستوى الفرديّ، بل أيضاً على المستوى الاجتماعي؛ أي جماعة من المؤمنين. وقد دفع هذا إلى البحث، عمّا أصبح يُطلق عليه «أسباب النّزول»، وإلى جمع حكايات وأحداث من السيرة، وكذلك البحث عن سياقات القرآن المفقودة التي تجعل مهمّة كلّ من الواعظ الدّيني والمُؤرّخ المسلم في غاية السهولة.
لذا، فقد اضطلع كلّ من المُؤرّخ المسلم والمُؤرّخ الغربيّ بمهمّة اكتشاف التّرتيب الزّمني لسور القرآن. وقد استندوا بدرجة أولى على أدلّة داخليّة: تغييرات في الأسلوب وفي النّبرة والجمهور، والتي تعكس تغيّر المسارات والتحدّيات والأهداف. لقد توصّل المسلمون وغير المسلمين على حدٍّ سواء إلى قوائمهم الزّمنية، والتي لم تختلف كثيراً. إنّ النتائج مقنعة، على الأقلّ في تصنيفاتها العامّة، وفي تمييزها السّور المكّية والسّور المدنيّة وتقسيمها للسورة المكّيّة، حيث تكون التغييرات أسرع وأكثر وضوحاً، إلى فترات مبكّرة ووسطى ومتأخّرة. لكنّ المشاكل لا تزال قائمة، وأبرزها مشكلة السّور المدمجة، حيث تُظهر الخطوط غير المنتظمة أنّ عدداً من الآيات ذات السياقات المختلفة قد تمّ تحويلها إلى سورة واحدة.
مأثورات السيرة
لكلّ الشّعوب ذاكرة، لكنّ هذه الذّاكرة تكون ثابتة بشكل خاصّ في المجتمعات الشفويّة التي لا تملك الكلمة المكتوبة لتسجيل أحداث الماضي وأطرافه الفاعلة. إنّهم يتذكّرون أشياء مهمّة أو مذهلة، الوفيّات لا الولادات، معجزات الطّبيعة أو الإنجازات. لكنّ سجلّات الذّاكرة لا تحمل أيّ تواريخ: وقعت الأحداث «منذ زمن بعيد» أو «أثناء المجاعة» أو «في عام الطّوفان».
كيف تذكّر المسلمون محمّداً؟
نحن على يقين من أنّ المسلمين كانت لديهم ذكريات عن محمّد. بالنسبة إلى كثير منهم بدأت هذه الذكريات بظهور محمّد إلى الوعي الجمعي في مكّة، وهو يعظ قريشاً ويدعوهم إلى الدّين الجديد، ثمّ في المدينة، حيث أصبح ومَن معه أكثر قوّة مع تعاظم سلطته ومكانته تدريجيّاً. وكان أتباعه قد تذكّروا أقوالَه، أو بالأحرى أقوال الله التي كرّروها وحفظوها. لكن ربّما كان تذكُّر أحداث حياة محمّد، مثل أحداث حياة عيسى، محدّداً بطبيعة موته، تلك الذّكرى قد وُلدت عندما ماتت الحقيقة. تمّ تضمين ذكريات حياة عيسى وأقواله في رواية بعد وقت قصير جداً من وفاته، عندما بدأ أتباعه في الوعظ بــــ«بشارة عيسى»، التي كانت في حقيقتها «البشارة بخصوص عيسى». أمّا بالنّسبة إلى المسلمين، فإنّ «البشرى» لم تكن بشرى محمّد، بل القرآن الذي يسمّي نفسه «بشرى» في الآية 89 من سورة النّحل: [وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ] و«بشرى» هي بالتّحديد «البشارة». إنّ ذكريات محمّد نفسه، من خطابه العاديّ، وأفعاله في المدينة قد طفت من خارج القرآن وانتشرت، خفية وبشكل تدريجيّ، في الأوساط الإسلاميّة.
من الصّعب جدّاً أن نعرف على وجه التّحديد متى بدأ تدوين تلك الذّكريات الشّخصيّة للرّجل وكذلك كلامه؛ لأنّ هناك فارقاً زمنيّاً بحوالي قرن أو أكثر بين القرآن وأولى تدوينات المسلمين المحفوظة. من السّهل التّخمين بالأسباب. لقد استخدم المسلمون العرب الأمّيّون رعاياهم الجدد المتعلّمين في سوريا ومصر والعراق ككتبة وحافظي سجلّات -بل وسمحوا لهم بالاحتفاظ بالسجلّات بلغاتهم المحلّيّة- في حين أنّ النّخبة المسلمة، التي فضّلت العيش في المراكز العربيّة فقط وليس وسط خصومها الأجانب في المدن القديمة في الشّرق الأوسط، قد انخرطت في نشاط أكثر إغراء يتمثّل في الغزو وأخذ الجزية. لقد استغرق العرب المسلمون قرناً من الزّمان لتعلّم الكتابة بسهولة، وربّما وقتاً أطول حتّى يحوّلوا خطّهم الأوّلي إلى أداة سهلة للكتابة.
ابن إسحاق
ظهر كتاب «المغازي» لابن إسحاق (ت 768م) سنة 750م تقريباً. لم تصلنا النسخة الأصليّة من الكتاب، لكن من الواضح أنّ العمل لم يهتمّ بسيرة محمّد فقط بل، ومن منظور إسلاميّ، هو «تاريخ عالميّ» واسع النّطاق. يبدو أنّ الأصل يحتوي على ثلاثة أقسام؛ الأوّل، «كتاب المبتدأ»، بدأ حرفيّاً بأخبار الخليقة، ثمّ تنقّل عبر تاريخ الأنبياء، البيْبليّ والعربي، إلى حيث كان يعتقد أنّ التّاريخ العربي قد بدأ. لقد حفظ لنا الطّبري (ت 923م) جانباً كبيراً منه ضمّنه في تاريخه. وقد بدا هذا القسم الأوّل، وفقاً لما يتماشى مع البيْبل وبالتّأكيد بمساعدة اليهود و/أو المسيحيّين، كمحاولة لإتمام التّاريخ المقدّس الكامن وراء السّور المكّيّة في القرآن، حيث ورد ذكر الأنبياء تجسيداً للطّابع الوَعظي والأخلاقي للقرآن.
أمّا القسم الثّاني، «كتاب المبعث»، فيبدأ بلمحة عامّة عن بداية تاريخ جنوب الجزيرة العربيّة -هناك صيغة أخرى قد تكون بدأت، كما تاريخ الطّبري الفارسيّ، بالتّاريخ المبكّر لإيران- ومادّة هذا القسم ربّما وصلتنا بسهولة من الحوليات السلطانيّة لواحدة أو لأخرى من تلك المجتمعات المُتعلّمة. ومن ثَمَّ ينتقل إلى «كتاب المغازي»، قلب المشروع الإسلامي الذي يبدأ مع «هجرة» محمّد من مكّة إلى المدينة، ويتمحور حول المغازي التي قادها محمّد، والتي وسّعت المستوطنات العربيّة.
وكما أشرنا إلى ذلك، فإنّ النسخة الأصليّة من عمل ابن إسحاق مفقودة. ربّما تمّ بالفعل سحبها ومُنع تداولها -في العالم الإسلامي في العصور الوسطى، ما يعني أنّها توقّفت عن الظّهور علناً و/أو تمّ إعادة نسخها -بصيغة ابن هشام (ت 833م) والتي سُمّيت بــــــــــــ«سيرة رسول الله»، وهذه هي المرّة الأولى التي يظهر فيها مثل هذا العنوان في هذا السياق. وسواء تمّ تحريرها أم لا، فقد أصبحت مادّة ابن إسحاق ومنهجه في كتابته لسيرة النّبيّ، وبسرعة المعالجة الرّسميّة، لحياة النبي وزمانه، ومن الممكن رؤية عمله في صيغ أقلّ تبايناً عند مؤرّخين آخرين.
المأثور من السّيرة
عندما يتعلّق الأمر بالكشف عن الكيفيّة التي نظّم بها المكّيّون والمجتمعات العربيّة الأخرى في تلك الفترة ذكرياتهم من أجل استحضارها، وتبليغها، وشرحها، نجد أنفسنا في مجال صعب. هناك القليل من الأدبيات السابقة التي يمكن الاسترشاد بها، ولكن يبدو أنّ الذّاكرة الجماعيّة لتلك المجتمعات العربيّة ما قبل التّدوين قد حُفِظت في شكل أنساب قبليّة، والتي تتعلّق كلّها بالذاكرة القبليّة وروابط القرابة، وكذلك في شكل القصص التي يبدو أنّ هدفها الأساسيّ كان التسلية والإرشاد بدلاً من مجرّد استحضار للماضي؛ وأخيراً، الغارات التي تخلّد ذكرى انتصارات القبيلة وشجاعتها خلال معاركها مع جيرانها. يبدو أنّ هذا الشّكل الأخير كان من أصل بدويّ ومن المحتمل أن يكون قد حُفِظ أكثر في بيئات حضريّة، حيث يعاود سكّان المدن الحنين إلى ماضيهم غير البعيد ليتفاخروا به. أمّا العرب المستقرّون مثل أولئك الذين يعيشون في مكّة والمدينة، فلم تكن الغارات جزءاً مهمّاً من حياتهم.
إذا كان هذا التّقييم صحيحاً، فإنّ الشّكل الأدبي العربي لما سُمّي بالسّيرة يجب أن يكون إبداعاً لاحقاً تمّ تجميعه معاً في المقام الأوّل من تلك العناصر الأوّليّة الأخرى والأكثر قِدَماً للذّاكرة الحيّة. يبدو الأمر كذلك في الصورة الرمزية لهذا النوع من الكتابة، وهو سيرة محمّد نفسه، حيث لم يكن هناك اهتمام كبير بعلم الأنساب؛ لأنّه لم يكن مهتمّاً بالحياة القبليّة في حدّ ذاتها (13). ومع ذلك، تظهر القصص والمغازي بشكل كبير في السيرة. أمّا تلك القصص، فتنقل حياة النّبيّ في مكّة عندما لم يكن هناك أيّ نشاط للغارات. وأمّا المغازي، فتبدأ من الغزوة الأولى، غزوة الغنيمة في بدر سنة 624 ميلاديّة وما بعدها إلى وفاة محمّد. قد يكون من السّهل التّذكير بالتّسلسل أو ترتيب بعثات محمّد خارج المدينة، ولكن بالنسبة إلى المسألة المكّيّة وكذلك الحوادث المعزولة في المدينة، فقد استخدم صنّاع سيرة محمّد الأولى القرآن، حيث حاولوا ربط آياته بأحداث، سواء كانت حقيقيّة أو مُتخيّلة، من حياة النّبيّ، وبعد ذلك تمّ سرد ذكريات الأحداث وربطها بعضها مع بعض بهذا الخيط الهزيل.
يُؤكّد تيّار معاصر من الدّراسات غير الإسلاميّة بأنّ السيرة هي نتاج بيئة متأخّرة كثيراً عن بيئة النّبيّ -بدأت مسيرة ابن إسحاق في المدينة، لكنّها انتهت في بغداد عاصمة الخلافة- ويبدو هذا ممكناً جدّاً. كان العرب المسلمون في العراق في أواخر القرن الثّامن محاطين بشعوب على دراية برواية السيرة، ومن بينهم المسيحيّون، الذين لا يزالون قَطْعاً وثيقي الصّلة بغالبية السّكّان، والذين استندوا في إيمانهم إلى مثل هذه الروايات حول السّير؛ أي الأناجيل. من الصّعب أن نَتصوّر أنّ النخبة المسلمة الجديدة، التي أظهرت أنّها على دراية بالفلسفة والعلوم اليونانيّة، لم تَتأثّر أيضاً بتلك النّصوص المسيحيّة الرّمزيّة لتشكيل مشروعها الجديد المُتمثّل في كتابة السيرة.
سيرة ابن هشام
تعكس كتابة ابن هشام للتّاريخ الملحميّ لابن إسحاق ردود فعل المؤرّخين تجاه نشأة سرد لأصول الإسلام، والذي طغت عليه بالفعل الأساطير والأكاذيب. ومثل المؤرّخين الآخرين، فقد حصل ابن هشام على تعليم تقليديّ؛ أي إنّه تخصّص في النّقل الدّقيق لمأثورات أو أقوال النّبيّ. لم يقتصر الأمر على أنّه اختصر سرد ابن إسحاق الأصليّ واختزله في سيرة للنّبيّ بحجم أكبر وأكثر تركيزاً، ولكنّه استعمل مِشرطاً حادّاً للتخلّص من الكثير من مادّة السيرة. لقد قام بحذف كثير من الأشعار، وكذلك ما بدا له على أنّه إقحامات يهوديّة أو مسيحيّة جاءت ممّن اعتنقوا الإسلام حديثاً. وفي السّياق نفسه، كان يعارض رواية القصص، على الرّغم من أنّه كان من الصّعب حذف كلّ هذه العناصر، لا سّيما تلك التي تتعلّق بسيرة محمّد في مكّة. ولتصحيح ذلك، حاول ربط أحداث تلك السيرة بأكبر قدر ممكن من معطيات القرآن. وكان لابن هشام هدف مختلف تماماً، لا علاقة له بالتّاريخ: أراد أن تكون السيرة نموذجاً يُحتذى به، ولذلك قام بحذف ما اعتبره لا يتناسب مع شخص رسول الله (14). هذا، إذن، هو أصل السّيرة الأساسيّ الذي يجب على المؤرّخ الذي جاء في عصور متأخّرة أن يرتكز عليه ويعمل في إطاره، سيرة ابن إسحاق بصيغة ابن هشام، وكلّ ما أمكن الحصول عليه من أصل السيرة مستخلص من الشّذرات والمختصرات المُضمّنة في كتابات اللّاحقين (15).
ما بعد ابن هشام
هؤلاء الكتّاب اللّاحقون هم بشكل أساسيّ الواقدي (ت 823)، وابن سعد (ت 843)، وأخيراً، وبشكل أبرز الطّبري (ت 923). لقد ألّف الواقدي، مستعيناً بابن إسحاق، كتاب المغازي الذي يكشف لنا بكلّ وضوح عمّا كان يشبه النواة الأصليّة لسيرة محمّد (16). وبعده كتب ابن سعد كذلك في السيرة مرتكزاً هو أيضاً على مادّة ابن إسحاق، فكان كتابه الطّبقات نوعاً من قاموس في تراجم الأعلام، والذي لم يرتّبه أبجدياً، ولكن على الطّبقات بدءاً بصحابة محمّد والتّابعين إلى زمن تدوين مصنّفه. وقد نهل من هذا المصنّف المحدِّثون والفقهاء والمفسّرون وكلّ من اهتمّ بما أُثِر عن النّبيّ. أمّا الطّبري فقد ألّف كتاباً ضخماً، وهو عبارة عن تسلسل كرونولوجيّ عبر تاريخ الإسلام بخلفيته الفارسيّة -وهي نفس خلفية الطّبري- حتّى عصره. تمثّل سيرة النّبيّ مرحلة طويلة ومثرية في هذا التّسلسل الزّمنيّ. لقد اعتمد الطّبري بشكل كبير على ابن إسحاق، وما هو مفيد لنا أنّ النسخة التي اعتمدها الطّبري مغايرة عن تلك التي كانت لدى ابن هشام.
البخاري و«الأحاديث النّبويّة»
مع البخاري (ت 870)، آخر مراجعنا، وهو مُؤلِّف، أو بطريقة أفضل، مدوّن المجموعة الشّهيرة من الأحاديث النّبويّة المسمّاة «الصحيح»، نكون قد خرجنا من تأليف السيرة من وجهة نظر تاريخيّة وأدخلناها في مجال فقهي. إنّ التشريع الإسلاميّ هو تحديداً تشريع مستوحى من التشريعات السابقة؛ ومع ذلك، فإنّه لم يقطع معها بل أثبتها. أساس كلّ التشريع الإسلاميّ هو القرآن، ولكن حيثما يكون القرآن صامتاً أو غير محدّد، فإنّ التشريع يلجأ أوّلاً وبشكل أساسيّ إلى سنّة النّبيّ. وهذه السنّة تتمحور أساساً حول أحداث أو أشخاص. هذه هي «الأحاديث النّبوية» الشّهيرة وذائعة الصيت، وهي مقتطفات تجسّد الأقوال أو الأفعال المنسوبة إلى محمّد والتي تشهد عليها سلسلة متّصلة من الأسانيد تعود إلى شهود عيان على سيرة النّبيّ. بدأ تجميع هذه الأحاديث النّبويّة وفرزها في القرن التّاسع، وهو موضوع سنعود إليه، وكتاب البخاري هو أشهر كتب الحديث، حيث تُعتبر جميع الأحاديث الواردة فيه صحيحة.
صحيح البخاري كتاب ألّفه فقيه لفائدة فقهاء يستنبطون تشريعاتهم من الأحاديث المضمّنة فيه. وكان ترتيب الأحاديث النّبويّة يخضع في كلّ مرّة إلى الغرض الذي من أجله سِيقت تلك الأحاديث؛ وذلك لتسهيل الرّجوع إليها، ولكنّ العمل لا يقتصر على الفقه فقط بل ينفتح بطريقة تثير اهتمام المُؤرّخ أيضاً. يحمل الفصل الأوّل عنوان «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم». ولكن بعد خمسة أحاديث حول كيفية نزول الوحي على محمّد، يبدأ الحديث عن مناقب الصحابة، حتّى وإن لم يُفرد البخاري فصلاً لذلك لكن يبدو وكأنّه فصل قائم بذاته. هؤلاء الصحابة هم بالطّبع شهود عيان على سيرة محمّد ويتمّ التّذكير تكراراً بمناقبهم لإثبات صدق شهاداتهم، ثمّ يلي ذلك مباشرة تسعة وعشرون باباً تغطّي، وفق ترتيب زمنيّ، أحداثاً في حياة محمّد. لم تُسرد تلك الأحاديث بشكل مسترسل -فالأحاديث النّبويّة ظلّت منفصلة بعضها عن بعض- ولكن ما أثّر عليها بشكل واضح هو اهتمام المُؤرّخ بالأحداث والتّسلسل الزّمني على حساب حاجة الفقيه للأحكام المماثلة السابقة.
عدم رضى المُؤرّخين الغربيّين
إذا كانت مادّة سيرة ابن إسحاق والنّسخة الكلاسيكيّة لمغازي الواقدي موثوقاً بها، فلأنّها تعتمد بالتّأكيد على ما حفظته ذاكرة معاصري محمّد (17). يبدو الشّكّ في ذلك المحفوظ صعباً، ولكنّ مشكلتنا تكمن في معرفة ما إذا كان ذلك مضمّناً في المادّة التي نتناولها. ولحلّ هذه المشكلة يجب أن نتساءل عن كيفية وأسباب انتشار هذه المادّة في الثلاثة أو الثلاثة أجيال ونصف بين محمّد وابن إسحاق. يمكن أن نرى مساريْن عامّيْن لذلك الانتشار، أوّلاً: مسار الأحاديث النّبويّة، حيث أمكن لهذه المادّة أن تنتقل بطريقة الكتابة أو المشافهة وبدوافع تشريعيّة أو تاريخيّة، وثانياً: مسار القصص التي تمّ تناقلها شفهياً في الأجيال الأولى للإسلام.
تحملنا الإمكانيّة الأولى إلى واحدة من المجالات الأكثر أهمّية وأشدّها جدلاً في التّاريخ الإسلامي. يتعلّق الجزء الأكبر من الأحاديث النّبويّة المحفوظة بالمسائل التشريعيّة، والتي يمكن الاستشهاد بها كحجّة قطعيّة. ومثال ذلك، معظم تلك الأحاديث التي تمّ جمعها في صحيح البخاري. لقد تمّ تصنيفها على أنّها «صحيحة» وذلك لأنّ المسلمين في القرن التّاسع بدأوا يشكّكون في صحّة العديد من هذه الأحاديث، فأخضعوها إلى فحص دقيق. وركّزوا في ذلك على سلسلة الأسانيد الواردة على رأس كلّ حديث، كما حرصوا على نزاهة كلّ راوٍ ومصداقيته. لقد أُعيد النّظر من جديد في الأحاديث من قبل العلماء الغربيّين في القرن التّاسع عشر، وخلصوا بعد التّمحيص إلى أنّ الأحاديث النّبويّة موضوعة في عدد كبير منها؛ وذلك لخدمة أهداف سياسيّة أو طائفية أو لدعم ما لم يكن في الواقع أكثر من تقليد لتشريعات محلّيّة. في البداية تعلّق الاستقصاء بالأحاديث التشّريعيّة، ولكن في الجزء الأوّل من القرن العشرين امتدّ ليشمل الأحاديث التاريخيّة، وهو مادّة سيرة ابن إسحاق، فكانت النّتائج كذلك سلبية. لا يزال تيّار قويّ في معظم الدّراسات الغربيّة، بما في ذلك الدّراسات الّتاريخيّة، يشكّك في الأحاديث. وفي نظر هؤلاء المشكّكين، فإنّ الأحاديث النّبويّة قد تمّ تداولها شفهيّاً لمدّة قرن ونصف بعد وفاة محمّد، وبذلك شهدت تحوّلات جوهريّة خلال تلك الفترة. إذا كانت مادّة السيرة هي الأحاديث، كما يعتقد دائماً، فإنّها كتاريخ مشكوك في مصداقيتها.
قصص وهب بن منبه
إذا كانت الأحاديث تثير شكوك المُؤرّخ، فالأمر ذاته ينسحب على عنصر آخر من السيرة ألا وهو القَصص. إنّ ما يقلق المُؤرّخ هو الإمكانيّة غير المستبعدة في أن يكون جميع ما حُفظ من سيرة محمّد مديناً إلى فنّ السّرد القصصي أكثر بكثير من أيّ ذاكرة تاريخيّة حقيقيّة. وفي هذا يُعدّ وهب بن منبه (ت 728م أو 732م) شخصيّة بالغة الأهمّية. وكانت عائلته، وهي من أصل فارسيّ، تسكن منذ فترة طويلة في اليمن، ووهب كذلك، وهو مسلم بالولادة، كان يعدّ من المختصّين في المسائل اليهوديّة - المسيحيّة- وقد اعتمدت مصادره في ذلك على اثنيْن من اليهود كانا قد اعتنقا الإسلام وتقاطعت حياتهما مع حياة النّبيّ. كتب وألقى دروساً عن تاريخ الأنبياء وتاريخ جنوب الجزيرة العربية، ويحتلّ هذان الموضوعان مكانة مهمّة في عمل ابن إسحاق، وله كتاب مفقود «كتاب المغازي»، وهو السّابق، إن لم يكن المصدر، لمُؤلّفات كلّ من ابن إسحاق والواقدي حول هذا الموضوع.
لاحقاً، سارع الرواة الأكثر وعياً إلى النّأي بأنفسهم عن وهب؛ لأنّه لم يكن محدِّثاً، ولا ناقلاً للحديث بالدقّة العالية المطلوبة، بل كان راوياً لأخبار غلب عليها طابع القصص الشّعبي الخرافي، وقد قام، شأنه شأن آخرين من جماعته، بتوسيع نطاق القرآن من خلال تقديم سياقات ممتعة ومعقولة في حياة محمّد لهذا التّنزيل أو ذاك. فما هو معقول ليس بالضرورة، صحيحاً، كما وضّحته مجموعة متنوّعة من المأثورات شبه اللّامحدودة في أيّ لحظة من حياة محمّد. لدينا مقتطفات من إحدى نسخ وهب للتّاريخ الإسلامي المبكّر، لكن من المحتمل أن يكون لدى كلّ من ابن إسحاق والواقدي نسخ كاملة أخرى من قصص الأنبياء وقصص محمّد، واستخدماها، وهو احتمال يلقي بظلال من الشكّ العميق على صحّة ما نقرأه في هذيْن المؤلَّفيْن الأخيريْن.
ما يتعلّق بالسّيرة
وهكذا، فإنّ السّير النّبويّة الموجودة تمثّل مشكلة منهجية حقيقيّة لأيّ شخص يحاول إعادة بناء سيرة نبيّ الإسلام. من الصّعب إنكار أنّ بعض الموادّ الموجودة في تلك السّير تستند إلى حقائق تاريخيّة، كما أنّه من غير المستبعد أنّ تكون الذّكريات الدّقيقة قد انتقلت شفهيّاً على مدى ثلاثة أو حتّى أربعة أجيال. ولكن ما يدعونا إلى التفكّر هو التّالي: مَن الذي نقلها وما الغرض من ذلك؟ لا يمكن أن يتحوّل أهل الجدل والقصّاص إلى مؤرّخين جيّدين، حتى -أو كما اتّضح على وجه الخصوص- عندما تُسرد رواياتهم بسلسلة طويلة ومذهلة من الأسانيد. سنعود إلى هذه المشاكل في سياق إعادة تشكيلنا لسيرة محمّد، ولكن منذ البداية، علينا أن نفهم أنّ القرآن هو أفضل دليل لدينا.
لكن ليس القرآن هو الدّليل الوحيد الذي بين أيدينا. لقد حاول جميع كتّاب سيرة محمّد المعاصرين الجمع بين المصدريْن المَوصوفيْن آنفاً، القرآن والمصادر السّردية. إنّ مأثورات السيرة، بصرف النّظر عن الشّكّ في مقاصدها، وعدم الإقناع في مَنهجيتها، وانعدام اليقين في تفاصيلها، فقد استُخدمت لتوفير إطار كرونولوجي -أو على الأقلّ متعاقب- يتمّ على أساسه ترتيب كلّ يمكن استخراجه من موادّ من القرآن. يمكن توثيق بعض هذا الإطار من التلميحات الشحيحة في القرآن، ولكن دائماً ما يكون لهذا علاقة بسيرة محمّد في المدينة. أمّا عن الفترة المكيّة من حياته، ودعوته إلى النّبوّة، وظروف خطابه المبكّر، وظهور معارضين له وردّ فعله تجاههم، والصعوبات التي تعرّض إليها، والتي أدّت في النّهاية إلى هجرته إلى المدينة، فإنّ القرآن لا يعطينا سوى قليل من الإرشادات أو قد لا يعطينا شيئاً من ذلك في كثير من الأحيان. وههنا إذن، في فترة التّشكّل الحاسم لسيرة محمّد ودعوته ومنشأ الإسلام الوليد، حيث يجب على المُؤرّخ أن يواجه مسألة المُوثوقيّة التاريخية لمصادر السيرة الأساسيّة وما يضيفه التّقليد الإسلامي بعدها، تماماً كما يفعل مع العهد الجديد.
قدماء علماء الإسلام (آباء الإسلام)
إلى جانب السّير المؤسّسة لمحمّد يوجد بحر من الموادّ الضعيفة والمضلّلة يشار إليها ببساطة باسم «المأثور الإسلامي»، وهي عبارة تتكرّر كثيراً في هذه الصّفحات. ما يشير إليه المصطلح الجامع هو الكمّ الهائل من الكتابات عن محمّد وعن القرآن التي وصلتنا منذ سنة 750 ميلاديّة وما تلاها. وهو يمثّل، في الحقيقة، المؤلّفين الذين يُطلق عليهم في المسيحيّة «آباء الكنيسة». يُعتَقد أنّ هذا المصطلح المسيحي «آباء الكنيسة» والسلطة المرتبطة بمُمثّليه قد انتهيَا مع يُوحنّا الدّمشقي (ت 754م) في الشّرق وغريغوريوس الكبير (ت 604م) في الغرب، لكنّ قدماء علماء الإسلام (آباء الإسلام) مسألة مختلفة. يتجسّد المأثور عن محمّد والقرآن، مثل نظيره المسيحيّ، في الأعمال الأدبية الكاملة مثل كاتب السيرة ابن هشام (ت 813م)، والمُؤرّخ الطّبري (ت 923م)، والمُفسّر مقاتل بن سليمان (ت 767م)، والمُحدّث البخاري (ت 870م)، لكنّ الكثير منه نشأ، كما رأينا، في تلك النُّتَفِ الصغيرة من الموادّ التي هي الحديث، والتي كان يعتقد أنّها تنقل أقوال السّلف الموثوق بها، وما كان يسمّيه المسلمون بــــــــــــ«السّلف» يمكن أن نطلق عليه «الآباء الرّسل» (18). على الرّغم من إدراج العديد من الأحاديث النّبويّة في الأعمال التي ذكرناها آنفا، فغالباً ما استمرّ تداول الكثير منها شفهياً، في شكل مأثورات فرديّة وبعد ذلك ظهرت كأقوال جديدة وموثوق بها للنّبيّ وكتابه، إلى أن جاء السّيوطي (ت 1505)؛ ذلك الموسوعي المصري بمُؤلّفاته الضخمة -أخبر أحد طلّابه أنّه حفظ مائة ألف حديث- والذي يشكّل في الحقيقة نهايات آباء الإسلام (19).
أفكار ثانويّة: العهد الجديد والقرآن
يعمل العهد الجديد في إطار معرفيّ مختلف عن الذي يعمل فيه القرآن. يتعامل المؤرّخ العقلاني مع القرآن انطلاقاً من مبدأ التحرّي والتّحقيق؛ فالصّوت الذي يسمعه من خلال النّصّ المنزّل هو بالأساس صوت محمّد. إنّ المسلمين الذين تكفّلوا بنقل النّص المنزّل، وربّما أوائل المؤمنين الذين وضعوا القرآن كنصّ، لم يكونوا يؤمنون بشيء كهذا. لقد سمعوا صوت الله كلّه بشكل فوريّ. قد تكون الأصوات صدرت على لسان محمّد، ولكنّه كان يتلفّظ بها فقط ولم يبتكرها.
أمّا في حالة عيسى، فإنّ المؤرّخ، سواء كان مسيحيّاً أم لا، يدرك منذ البداية أنّه يتعامل مع نصوص كتبها أناس بشر، تظهر أسماؤهم بالفعل على رأس النّصوص التي تشكّل العهد الجديد، وهذا ما لا نجده بالتّأكيد على رأس القرآن. يقوم مبدأ التحرّي والتّحقيق على أنّ النّصوص، ولا سيما الأناجيل، تروي تعاليم (وتصف أفعال) شخص بشريّ آخر، ألا وهو يسوع النّاصري. يضيف المسيحيّ مباشرة أنّ عيسى نفسه كان أيضاً ابن الله. وبالتّالي، فإنّ ما كان يخرج من شفتيْه هو كلام الله المنقول، ولكنّ الأمر لم يكن كذلك. إنّ كلام الربّ الذي سمعه موسى ونقله من سيناء أو كلام الله الذي تلفّظ به محمّد في مكّة والمدينة قد كان كلام الله، وإنّ ما خرج من شفتيْ عيسى كان خطاباً ثورياً جديداً، كلام إنسان-إله، صوتاً بشريّاً بجاذبيّة المقدّس.
[1] - ترجمة مقتطفة من كتاب عيسى ومحمد توازي المسارات، توازي السِّيَر، فرانسيس إدوارد بترز، ترجمة علي بن رجب، صدر عن دار مؤمنون بلاحدود.