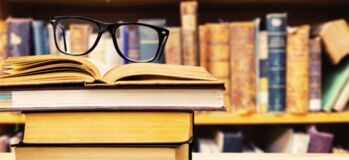الصوت الحيّ
فئة : ترجمات
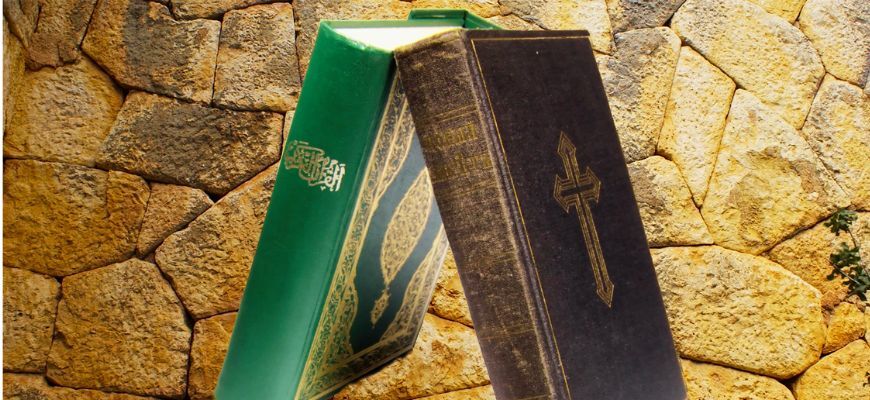
الصوت الحيّ[1]
تقدّم لنا المصادر المتوفّرة عيسى في أربع لوحات سرديّة تسمّى «البشارة»، والتي تشمل عظات يسوع ودروسه وحتّى محادثاته. أمّا بالنسبة إلى محمّد، فإنّ لدينا، من بين أشياء أخرى، ما يُعدّ نَسْخاً لأقواله التي تسمّى، بكلّ بساطة، «القرآن» (1). في كلتا الحالتيْن، يقودنا الاعتقاد بأننّا نسمع الصّوت الحيّ للطّرف الرّئيس: وفي إحدى الحالتيْن، فقد وقع ببساطة نَسخ ذاك الصّوت كما أشار إلى ذلك آخرون في الحالة الأخرى. فيا ترى هل هذا حقّاً هو الحال في عالم تمّ فيه وَضْعُ الخطاب المنقول؟
يسوع يتكلّم
لا تصف مصادرنا الأولى عيسى فحسب، بل تُظهره لنا في سياق درامي (2). إنّنا نراه يفعل، وكذلك نسمعه يتكلّم. إنّ خطاب عيسى في الأناجيل مضمّن في إطار سرديّ فضفاض وبسيط في بعض الأماكن، وهو على غاية من التّفصيل في أماكن أخرى، كما في روايات الألم، على سبيل المثال. لقد أراد مُؤلّفو الأناجيل إقناعنا بأنّ تلك كانت أقوال عيسى. إنّ أحاسيسنا في العصر الحديث بشأن الخطاب المنقول - ونحن نعتبر هذا الكلام دقيقاً في كلّ ما هو مضمّن بين علامتَي التّنصيص- تميل إلى تحويل هذه الأقوال، رمز عيسى، إلى كلماته بالتّحديد.
كلمات يسوع
علينا أن نتوقّف هنا. نحن نعيش مُحاطين بأجهزة لتسجيل الكلام ونقله، ولكن حتّى أكثر هذه الأجهزة بدائية، مثل stenography أو الكتابة السّريعة، كانت نادرة جداً في العالم القديم وغير موجودة في الحقول أو داخل الكُنُس، حيث تحدّث عيسى. وحسب شهادتهم الخاصّة، من الواضح أنّ المؤرّخين القدامى مثل ثيوسيديديز Thucydides وليفي Livy قد ألقوا خطابات للأشخاص المعنيّين في مؤلّفاتهم، وأنّ مثل هذه الخطابات يمكن التّفكير فيها، في أكثر لحظات اطمئناننا، على أنّها ربّما تمثّل الإحساس بما قد كان يمكن أن يُقال بالفعل في مناسبة معيّنة. لكن كلمات عيسى المكتوبة في الأناجيل الإزائيّة هي بشكل عامّ ليست خطابات - لا شكّ في أنّ إنجيل يوحنّا يقدّم عيسى، وهو يلقي خطابات طويلة والتي، كما يتّفق الجميع، هي عمل يوحنّا وليست أعمال عيسى، بل إنّ تعاليم عيسى ذاتها قد وقع نشرها بشكل عامّ على أنّها أمثال وحكم، وهي صيغ لا تُنسى تماماً، ويمكن حفظها بسهولة في ذلك المجتمع الذي لا يزال شفهياً للغاية. قد يكون أحد ما قد استطاع أن يحفظ جيداً، وانتهى هو أو آخرون إلى كتابة أقوال يسوع النّاصري.
لقد قَبِل النّقد التاريخي الحديث هذا الاحتمال وكرّس قدراً كبيراً من العمل البارع لمحاولات تحديد أيّ من الأقوال المأثورة التي يُحتَمَل أن تكون هي كلمات يسوع النّاصري المنشودة نفسها. سنعود في نهاية المطاف إلى هذا الجانب من أقوال عيسى، لكن نلاحظ هنا أنّ أحداً ما قد سبق وفعل ذلك بالضّبط، وقبل وقت طويل من بدء البحث الحديث.
اكتشاف Q
تجدر الإشارة إلى أنّه في القرن التّاسع عشر، وبمجرّد بدء طباعة الأناجيل بشكل شامل؛ أي جنباً إلى جنب، سرعان ما اتّضح خلال عمليّة المقارنة أنّ أكثر من مائتيْ آية، أو حواليْ ذلك كانت متطابقة في متّى ولوقا، ولكنّها لم تكن موجودة في إنجيل مرقس. وقد تمّ التأكّد بالفعل من أنّ مرقس كان أقدم من متّى أو لوقا وأنّهما، في الآيات التي اشتركا فيها مع مرقس، قد استخدما على الأرجح ذاك الإنجيل السّابق كمصدر. وبالتّالي، كان من المنطقي أنّ هذه الآيات التي تزيد عن مائتيْ آية المشتركة غير المرقسيّة يجب أن تمثّل مصدراً ثانياً متميزاً تماماً لمتّى ولوقا. وهذا ما يُعرف بالفرضيّة ذات المصدريْن Two Source Hypothesis، فبحلول نهاية القرن التّاسع عشر، بدأ هذا المصدر الافتراضي الثّاني نفسه يأخذ بالفعل نوعاً من الحياة الخاصّة به، وكان يُطلق عليه «Q».
وبمجرّد أن يصبح هذا الأمر واضحاً، فمن الممكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك، ونضيف إلى Q المعاد تشكيلها، تلك المقاطع التي تظهر في مرقس، ولكنّها موجودة في نسخة مختلفة تماماً في متّى ولوقا، مثل وعظ يوحنّا المعمدان (مرقس 1: 2- 6، 78 = Q 3: 2، 7-9، 16-17) أو إغراء يسوع في البريّة (مرقس 1: 1-13 = Q 4: 1-13). قد تكون هذه النّصوص قد أتت من مصدر ثالث، وهو 2Q الافتراضي للغاية، ولكنّ الأمر أكثر شَبَهاً بــــــــ«أوكهام» Ockham إذا اعتقدنا أنّ متّى ولوقا كانا يتْبعان ببساطة Q.
اختلاق Q
عند فحص آيات Q، أو عند التعرّف على وجود هذا المصدر الذي أصبح شيئاً فشيئاً حقيقة، تبيّن أنّ تلك الآيات كانت إلى حدّ ما لافتة للنّظر. أولاً، إنّ جميع آيات Q تقريباً التي تظهر في متّى ولوقا تتكوّن من خطابات أو أقوال منقولة (logoi). أمّا روايات يسوع، فهي قليلة. واستناداً إلى ما يمكننا فهمه، فإنّ بعض أتباع عيسى الأوائل قد سمعوا خطاباته بلغتهم الآرامية الأصليّة، ولكن نظراً لأنّ عدداً منهم كان يتقن اللّغتيْن، وهو أمر ليس نادراً في فلسطين اليهوديّة، فقد تمّ حِفظ تلك الخطابات وجمعها باللغة اليونانية (3). إنّ المتحدّثين باللغتيْن ليسوا بحاجة إلى «ترجمة» رسميّة، فإنّ ما سمعوه باللغة الآرامية تمكّنوا من التّعبير عنه على الفور باللّغة اليونانيّة، وربّما كان بطريقة لا تزال تحتفظ ببعض من النّكهة الآرامية الأصليّة. وسرعان ما ارتبطت هذه الخطابات التي تمّ تذكّرها بالكتابة في ذلك المجتمع شديد التّديّن. وينبغي أن يكون كلّ هذا قد حدث في الوقت نفسه الذي تشكّل فيه إنجيل مرقس، أو ربّما قبل ذلك؛ وبالتّأكيد قبل كتابة متّى ولوقا، والتي، كما رأينا، قد تمّ وضعها بشكل عام، ولكن ليس دائماً بشكل مقنع، في عام 80-90 بعد الميلاد.
Q ومرقس
في الفترة الأخيرة، أدّى ظهور مصدر الأقوال Q إلى إدخال معيار آخر للتّأريخ على هوامش الأناجيل الإزائيّة. لا تترك الأدلّة الدّاخلية أدنى شكّ في أنّ كلّاً من مرقس والمصدر Q المبني بناءً افتراضياً قد استخدمهما متّى ولوقا في كتابة إنجيليْهما. لا تظهر أيّ علامة من علامات معرفة مرقس بــــ Q المعاد بناؤه، ولا معرفة Q بمرقس. ومن ثمّ، ينبغي أن يمثّل مرقس وQ مصدريْن مستقلّيْن لحياة عيسى؛ وبالفعل، فهما أقدم المصادر التي لدينا. لكن أيّهما الأسبق؟ رسمياً، يبدو أنّ Q قد ظهر أوّلاً بما أنّ إنجيل مرقس السّردي قد أخذ مجموعة من أقوال عيسى شبيه بـــــ Q وقام بإدماجها في قسم «يسوع في الجليل». وهناك وقع تضمينها في إطار سرديّ أوّليّ بعضها مترابط مع بعض بأبسط أدوات ربط ممكنة: «التّالي»، «وبعد ذلك»، «فوراً». في النّصف الأوّل من إنجيل مرقس، ينتقل عيسى عشوائياً من مكان إلى آخر؛ والزّمن يمرّ في أجزاء غير محدّدة وغير واضحة. إنّ الإبداع الأدبي الحقيقي لمرقس هو رواية الآلام، ما يسمّى هنا «يسوع في أورشليم».
وبشكل صريح، لا يبدو Q أكثر قِدَماً من مرقس فحسب، حيث يظهر أيضاً في وقت سابق في ما كان يُطلَق على محتواه «غير المُتطوّر لاهوتياً»: إنّه لا يعرف شيئاً عن موت عيسى ولا عن انبعاثه من بين الموتى. أمّا بالنسبة لنا، فمن غير المعقول أن يكون الذين قاموا بجمع Q على علم بمثل هذه الأمور، ولا سيّما انبعاث يسوع، وتجاهلوها أو اختاروا عدم ذكرها. ومع ذلك، فهناك احتمالان آخران. فمن المحتمل أنّ هذه الأشياء لم تحدث أبداً، أو أنّها لم تحدث بعدُ في وقت جمعها. ولكن بغضّ النّظر عن سبب سهوهم، فإنّ غياب رواية الآلام والانبعاث قد تمّ اعتباره مُؤشّراً على التّاريخ المبكّر لــــ Q من قبل أولئك الذين شاركوا عن كثب في دراسة Q، وكذلك من قبل العديد من الباحثين في شأن عيسى على نطاق واسع.
نصّ Q
وفي حين كان من الضّروريّ تخيّل Q، فقد أصبح من الممكن الآن، بفضل الحساسيات الحديثة، قراءته في حالة إحيائه من جديد، أو ربّما بشكل أكثر دقّة، إعادة بنائه، وغالباً ما تتمّ طباعته كوثيقة قائمة بذاتها، ونحن مدعوون لتقدير ذلك. إنّ الآيات المستخرجة من متّى ولوقا مطبوعة بالتّرتيب (ومع التّرقيم) الموجود في إنجيل لوقا، حيث يُعتقد أنّ هذا الإنجيل يحافظ بشكل أفضل على التّسلسل الأصلي للمجموعة، وهو قرار لم يمنع محرّريها المعاصرين من التّلاعب بالتّرتيب ليتناسب مع رؤيتهم للمحتوى الأصلي. تمّ هنا اتّباع ممارسة التّرقيم الحالية: حيث وقع تسجيل الاقتباسات من Q وفقاً للفصول والآيات كما وردت في إنجيل لوقا.
عيسى ويوحنّا
لا تبدأ مقاطع Q في لوقا 3: 7 (= متّى 3: 7)، بعيسى ولكن بالحكم الذي أصدره يوحنّا المعمدان بصوت صارخ (3: 7-9) ضدّ «ذرّية الشّيطان» الضّالّين، ثم ينتقل يوحنّا إلى موضوع المسيح الذي سيأتي (3: 16-17). يوحنّا ليس المسيح بل هو، بالأحرى، شخص آخر غريب، أكثر جدارة منه ولكنّه سيكون قاضياً بنفس القدر من الصّرامة. يدخل عيسى المشهد بشكل هادئ نسبيّاً، ولم تكن معمودية يوحنّا له ممثّلة بشكل مؤكّد في Q (ربّما 3: 21-22). في المرّة الأولى التي يتوسّع فيها نصّ Q بشكل كامل عن عيسى، قيل إنّه «ممتلئ بالرّوح القدس»، الذي يوجّهه إلى البرّيّة، حيث يخضع للمغريات المألوفة (4: 1-13)، ثمّ يلي بعد ذلك سرد لمواعظ عيسى من سفح الجبل، أوّلاً التّطويبات والويلات، في صيغة لوقا (6: 20-26)، ثمّ النّصيحة بأن يحبّ المرء أعداءه وغير ذلك من التّعاليم الأخلاقية التي تتواصل حتّى نهاية الفصل السّادس من لوقا. نعود مع Q إلى ما هو ملموس في قصّة شفاء خادم قائد المئة الرّوماني (7: 1-10)، والتي تتعلّق بإيمان قائد المئة أكثر من علاقتها بالشّفاء المعجزة، الذي لا يكاد يحتلّ في القصّة سطراً واحداً (7: 10).
يظهر تلاميذ يوحنّا من جديد في (7: 18-20)، متسائلين نيابة عن يوحنّا عمّا إذا كان عيسى هو الشّخص المنتظر. ويطلب منهم عيسى إبلاغ يوحنّا بما شهدوه، فيقدّمون له موجزاً عن علاج يسوع للمرضى وطرده الأرواح الشرّيرة (7: 22-23). إنّه موجز، لكنّه شامل بما يكفي للإشارة إلى أنّ وراء مجموعة الأقوال الوافرة، هناك إدراك بأنّ هذا الواعظ كان أيضاً صانع معجزات. وعند مغادرتهم، يُثني عيسى على المعمدان (7: 24-28)، وقد يعقب ذاك الثّناء -ربّما تمّ إزاحة المقطع- بيان لبرنامج مهمّ يتمّ فيه رسم خطّ ثابت بين عيسى ويوحنّا: «إلى يوحنّا النّاموس والأنبياء. ومنذ ذلك الحين أُعلنت مملكة الربّ على أنّها البشرى والجميع يكافحون للدّخول إليها» (16: 16).
جيل شرّير
يُستأنف موضوع Q في نصّ لوقا (7: 31-35) بانتقاد عيسى «لهذا الجيل» الذي قال عن المعمدان إنّ به مسّاً وعن عيسى نفسه إنّه كان «أكولاً وشرّيباً، صديقاً 'لجامعي الضرائب والمخطئين»، ثمّ تأتي بعد ذلك (9: 57-62) نصيحة عيسى الصّارمة لأتباع المستقبل، وبعدها يعيّن لجنة موسّعة (10: 2-12) ويسدي إليها بعض النّصائح المفصّلة ثمّ يبعث عيسى معها الرّسالة: «إنّ ملكوت الربّ يقترب موعده».
يُدين عيسى في Q (10: 13-16) بشراسة مدينتيْ كورزين وبيت صيدا في الجليل لعدم استجابتهما للمعجزات التي أقامها فيهما، وهو أمر غير عادي يشير ربّما إلى البيئة المباشرة التي أنتجت المجموعة. يأتي بعد ذلك تأمّل يسوع في أبوّة الربّ وبنوّته (10: 21-22). وبعد أن لاحظ عيسى لأتباعه ما نالهم من شرف النّظر إليه (10: 23-24)، يعلّمهم كيفيّة الصّلاة إلى الربّ (11: 2-4) ويبيّن لهم كرم الأب للّذين يتوجّهون إليه بالدّعاء (11: 9-13). هناك مقطع طويل عن طرد الأرواح الشرّيرة (11: 14-26)، ولا سيّما ذلك الردّ على أولئك الذين يزعمون أنّ عيسى يطرد الأرواح بقوّة بعلزبول Beelzebul.
ثم يلتفت عيسى بعد ذلك إلى هذا «الجيل الشرّير» الذي يطلب آية (11: 16، 29- 32)، فيقدّم عيسى نفسه آية تماماً كما كان يونان لنينوى و«ملكة الجنوب» لسليمان. يقول: «لاحظوا، هنا شخص أعظم من يونان». بعد ذلك جاء دور الفرّيسيّين، الذين أدينوا بشدّة وبإسهاب بسبب نفاقهم (11: 39-52). وضمن هذا العقاب هناك تأمّل عيسى في الموت القاتل لأنبياء الله مع إشارة واضحة إلى نفسه، وسيدفع «هذا الجيل» ثمن كلّ ذلك، ونفس هذا الحكم القاسي موجّه تحديداً إلى أورشليم (13: 34-35).
تعاليم
إنّ الإصحاح 12 في لوقا هو في الغالب نصّ Q ويتضمّن في ظلّ تعاليمه الأخلاقية -«الحياة أفضل من الطّعام والجسد أفضل من اللّباس» (12: 23)- وإشارات عيسى إلى نفسه باللّقب المسياني «ابن الإنسان» (12: 8-10)) والتنّبؤ بأنّ أتباعه سيتعرّضون للاضطهاد «في المعابد» و«أمام الحكّام والسّلطات» (12: 11-12) (4). ويتواصل سرد التّعاليم في ذات السّياق في أغلب الفصول 13-17 و19: 12-26، باستخدام الكثير من التّشبيهات («ملكوت الله مثل...») والأمثال («أقام رجل عشاء كبيراً وأرسل العديد من الدّعوات...»). الجدير بالذّكر هو ذاك التّصحيح المأثور لتشريع موسى بشأن الطّلاق (16:18)، والذي سيعيد متّى ذكره في محاولة منه لتلطيفه (متّى 5: 32)، بالإضافة إلى فقرة طويلة عن نهاية العالم (17: 22-37)، حيث يشير عيسى مرّة أخرى إلى نفسه على أنّه «ابن الإنسان». كما تضمّن Q أيضاً تعيين عيسى رسمياً لأولئك -الاثنيْ عشر؟- المعيّنين للمشاركة في مأدبته و«الجلوس على كراسي العرش يحكمون أسباط إسرائيل الاثنيْ عشر» (22: 28-29). يندرج المقطع في لوقا ضمن تعليمات عيسى أثناء العشاء الأخير في المساء الذي يسبق موته، ولكنّ في متّى (19: 28)، فإنّ عيسى قد قال ذلك في وقت سابق، وهو في طريقه إلى أورشليم وكردّ فعل على بطرس.
النّظر من الدّاخل
مع متّى ولوقا، نحن في الوضع المناسب لأن نكون قادرين على ملاحظة ما فعله كلّ منهما بمصدره المرقسي وعلى توقّع السبب. كما يمكننا أن نلاحظ الاختزال وكذلك التّوسّع في التّحرير، وأيضاً التفسيرات وأحياناً التصويبات الواردة في نصّ الإنجيل القديم. ويمكننا تتبّع عملية التنقيح والصياغة من خلال ما لدينا من مرقس. ولكن في حالة Q الافتراضي، فإنّ لدينا نسختيْن مكتوبتيْن فقط؛ أي النّسختيْن اللّتيْن اختارهما لنا متّى ولوقا. نحن على دراية بما أسقطوه من مرقس، ما حذفوا من Q؟ من الواضح أنّ متّى ولوقا قد أعادا توزيع Q، ولذا قد يكون بوسعنا أن نفترض أنّ Q، الذي يعتقد العديد من النقّاد أنّه تركيبة أدبيّة له مقاصده الخاصّة، لم يكن سوى مجرّد تجميع (مثل تجميع Q الآخر الذي هو القرآن!). وهكذا لم يكن تسلسله مهماً وقد شعرَ الإنجيليّان بالحرّية في توزيع شخصياته في أيّ مكان يناسب الإطار السّردي الذي أخذوه -بل وعدّلوه أيضاً!- من مرقس.
يسوع في سياقه
إنّ مسار رواية مرقس، الذي يشبه، وقد يكون مستعاراً، ذاك الذي في كلّ من متّى ولوقا وفي الصيغة المختلفة نوعاً ما في يوحنّا، يوفّر سياقاً لما تمّ الاحتفاظ به على أنّه خطاب يسوع. أمّا في فصول الجليل من تلك الأناجيل -الوضع مختلف تماماً في روايات الآلام- فهناك انطباع متواتر بأنّ سياقاً عامّاً قد تمّ إنشاؤه، «صباح اليوم التّالي على ضفاف البحيرة» فيه تمّ تأطير أقوال يسوع (5). هذه الأقوال، إن كانت حقيقيّة، يجب أن يكون لها سياق سيرة محدّد بدقّة، Sitz im Leben لحكماء العهد الجديد، لكنّ الذين جمعوا نصوص Q لم يهتمّوا بالحفاظ عليها. ما يتمّ إعادة إنتاجه هناك هو «الأقوال» البسيطة، وما يُفترض ملاحظته هو أنّ أهمّية هذه الأقوال الأساسيّة تكمن في الكلمات نفسها، بعيداً تماماً عن السّياق. ويتأكّد هذا الافتراض عندما نفحص إعادة صياغة سياق متّى ولوقا لنفس الأقوال في إنجيليهما. هذا العمل يبدو سطحيّاً في أحسن الأحوال. لقد قام متّى على وجه الخصوص بتجميع «خطابات» عيسى في خمس وحدات كبيرة (5-7، 10، 11، 18، 24-25)، مع إشارة بسيطة إلى Sitz im Leben محدّد لكلّ واحدة منها. إنّ مرقس، الذي تلقّى أقواله الخاصّة في شكل مختلف عن شكل أقوال Q، قد عمل تقريباً بالطّريقة نفسها.
ما هو Q؟
ليس هناك أدنى شكّ في أنّ Q يقدّم، وربّما يمثّل أيضاً، وجهة نظر مبكّرة عن عيسى تختلف بشكل لافت عن صورة عيسى المعروضة في الأناجيل، حتى في أقدمها، وهو إنجيل مرقس. إذن ما هو هذا الشّيء Q الذي افتعلناه لأنفسنا؟ وإذا كان موجوداً حقّاً، كما يبدو شبه مؤكّد، فمن الذي ألّف أو جمع الأقوال التي يحتويها، ولأيّ غرض؟ إذا كان الأمر يخصّ الأتباع الحقيقيّين الأوائل لعيسى الحقيقي، فلماذا لم يذكروا حدث صلبه وقيامته؟ وكما لاحظنا، فإنّ Q بالنّسبة إلى بعض النقّاد المعاصرين ليس مجردّ مجموعة نصوص؛ فهم يؤكّدون أنّه كان عملاً أدبياً حقيقياً (مكتوباً)، والأكثر من ذلك، أنّه كان، مثل شقيقه، «إنجيل توما»، إنجيلاً حقيقياً -وبالفعل الشّكل الأصلي لــــ «البشارة». ومن وجهة النّظر هذه، فإنّ Q يمثّل البشارة الحقيقية لعيسى الحقيقي.
هل كان Q إنجيلاً؟
قد يكون Q بالفعل «إنجيلاً» بالمعنى الأصلي لتلك الكلمة. يبدو أنّ عيسى استخدم مصطلح «البشارة» كتسمية محدّدة لرسالته، والتي تتلخّص في أناجيلنا على أنّها «توبوا، إنّ ملكوت الله يقترب» ولكن من الواضح أنّها تشمل أيضاً تعاليم عيسى الواردة في تلك الأناجيل، غير أنّ المسيحيّين غيّروا معنى الكلمة. وكما يصف سفر أعمال الرّسل وكما توضّح أناجيلنا كذلك، فإنّ «البشارة» التي بشّر بها أتباعه منذ البداية، جاءت في جزء منها من عيسى، ولكنّها كانت تدور بشكل أساسيّ حول عيسى. وفي أعمق معانيها، كما في بولس، على سبيل المثال، كان يسوع هو البشارة. لا يمكن رؤية أيّ من هذيْن المَعْيَنيْن الأخيريْن في Q المعاد تشكيله، وفي الواقع، فإنّ الحدثيْن اللّذيْن جعلا عيسى أكثر من مجرّد معلّم، وهما موته وقيامته، لم يتمّ ذكرهما حتى في تلك المجموعة من أقوال عيسى.
Q وعيسى
لقد انتقلنا الآن إلى أبعد ممّا هو مجرّد سرد تاريخيّ إلى الأحكام الأساسيّة حول شخص عيسى ورسالته. إذا كان Q، كما يعتقد بعضهم، لا سيّما إذا كان مدعّماً ومكمّلاً بمصدر الأقوال الأخرى المسمّى إنجيل توما، يمثّل حقاً البشارة الحقيقية عن يسوع الحقيقي، فعندئذٍ لم يكن عيسى الحقيقيّ الأصلي على ما يبدو سوى واعظ ومعلّم من الجليل، ربّما على نموذج الحكيم السّاخر، كما قد يعتقد بعضهم، أو المزارع الثائر المغرور، كما تمّت الإشارة إليه. وفقاً لوجهة النّظر هذه، كان عيسى ثائراً ومزعجاً بدرجة كافية ليسبّب موته: فعيسى هذا، مثل يوحنّا المعمدان، لم يمت من أجل خطايا البشريّة، بل من أجل أقواله المُتطرّفة.
Q وموت عيسى
ما الذي ينبغي أن نفكّر فيه، إذن، بشأن الجهل الواضح لـــ Q بموت عيسى أو عدم الاهتمام به؟ إنّ أحد الحلول لهذا الانفصال الغريب بين Q وما نجده في الأناجيل القانونيّة، قد يكمن في آيات Q (= لوقا 11: 47-51) التي تنقل ملاحظات عيسى الغاضبة بخصوص موت الأنبياء وما بدا وكأنّه إحساس داخلي بأنّ موته سيكون على يد «هذا الجيل». إذن، قد يكون موت عيسى معروفاً لدى هذه المجموعة الأولى من أتباعه الذين جمعوا تعاليمه وحافظوا عليها بعناية. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المؤكّد أنّه لا يمثّل الموت المخلّص وحتّى الموت المنتصر الذي أشار إليه بولس رسميّاً، وهو الموت الذي بدوره قد أضاءته القيامة التي أعقبته. لا يزعجنا موت المسيح المفقود بشأن Q بقدر ما تزعجنا هذه القيامة المفقودة، الركيزة الأساسية لحركة ما بعد عيسى، والتي تثير بالطّبع أسئلة أخرى عميقة بنفس القدر حول هذه المجموعة من الأقوال.
Q كعمل أدبيّ
هناك قضايا أخرى أُثيرت من خلال فرضيّة أنّ هذه المجموعة الافتراضية من أقوال عيسى كانت عملاً أدبياً مكتملاً، وهي أسئلة تنشأ من كلّ من التركيبة في حدّ ذاتها، وممّا قُدّم لنا بشأن يسوع. بداية، نشير إلى أنّ Q لم يترك أيّ أثر أدبيّ على الإطلاق عدا شبح بقاياه في متّى ولوقا. كما لا يوجد دليل مستقلّ على أنّ مصدر هذه الأقوال، ناهيك عن إنجيل الأقوال، كان متداولاً بين المسيحيّين الأوائل. قد لا تكون هذه الحجّة من الصّمت قاتلة، لكنّ تساؤل عيسى المثير للقلق يظلّ بلا إجابة. لماذا يبدو Q مختلفاً تماماً عن بولس، الذي يعدّ مصدرنا الأوّل من بين مصادرنا المحفوظة عن عيسى؟ (6). لماذا يقتصر الاهتمام بكلمات عيسى بدلاً من الاهتمام بما فعله وما قاله وما حدث له؟ لماذا قد يُسقط مؤلّف أو مؤلّفو مثل هذا العمل كلّاً من حدثَي الموت والقيامة المذكوريْن في جميع رواياتنا الأخرى عن عيسى، ولا سيّما رواية مرقس؟ هل كان ذلك بسبب أنّهما لم يحدثا قطّ؟ إنّ بعض النّقّاد المعاصرين، إن لم يكن العديد منهم، على استعداد لتبنّي هذا الاستنتاج فيما يتعلّق بقيامة عيسى، لكنّ الأدلّة على موته بطريقة الإعدام من طرف الرّومان تبدو غير قابلة للجدل. إنّ ما يُقترح في كثير من الأحيان هو أنّ مؤلّفي Q كانوا على علم بصلب عيسى لكنّهم اختاروا عدم ذكره، إذ من المحتمل أن لم يكن له أهمّية بالنّسبة إليهم، بل أكثر من ذلك، أنّ الأمر كان يتعلّق بارتباك، حيرة كان من الأفضل نسيانها.
يتمثّل تفسير شائع حالياً لنشأة Q في أنّ الذين قاموا بتجميعه كانوا ملتزمين، إمّا بإعداد قدّاس لتعليم أتباع عيسى الأوائل أو، على الأرجح، بإعداد وثيقة تبشيريّة. وكما ذهب بعضهم إلى القول إنّ Q، كان بمثابة ما يمكن أن نطلق عليه «أحجية» أو «نشرة تعيين»؛ أي مجموعة من أقوال عيسى مُصَمّمة لتقدّم إلى كلّ مُهتَد حديثاً، قد يكون من غير اليهود، ما هو سهل التّناول، عيسى المعلّم بدون الرّسالة الأكثر «تعقيداً» مثل (1) مسيانية عيسى، (2) لاهوت الموت المخلّص، أو، يمكننا أن نضيف، (3) الوعد بالخلود الذي يضمنه انبعاث عيسى نفسه من القبر.
لا يمكن أن يكون كلّ هذا صحيحاً؛ إذ لا يوجد دافع واحد يفسّر تشكّل Q. لقد ركّزت أقوال Q كثيراً على الظّاهرة اليهوديّة المحلّية ليوحنّا المعمدان، الذي لن يعني شيئاً لغير اليهود، لكنّها لم تقل شيئاً عن المسيا. وكثيراً ما يتحدّث عيسى عن نفسه كذلك في Q على أنّه «ابن الإنسان»، وهو لقب مذهل مأخوذ من النّبي دانيال، وفي سياق أخرويّ. قام بعض النقّاد بحلّ هذه الحالات الشّاذّة من خلال الادّعاء بأنّ Q هو نفسه وثيقة مركّبة، وأنّ نواة الأقوال الأصليّة -الذي يُطلق عليها الآن اسم Q1- ربّما خضعت لتنقيحيْن لاحقيْن تمّ فيهما تغيير صورة يسوع.
بدأ النّقد التّحريري لإنجيل مرقس، دراسة التّنقيحات التّحريرية للنّصّ، في القرن التّاسع عشر. لكنّ هذا الأمر قد حدث في وقت متأخّر بالنّسبة إلى Q، إلّا أنّه يستند إلى المبدأ نفسه المطبّق على مرقس. باختصار، فإنّه يبحث عن وجود علامات داخليّة تشير إلى مقاصد التّأليف أو التّحرير. هذا هو ترتيب المادّة، بشرط أن نتمكّن من تحديد التّرتيب الأصلي لــــ Q قبل أن يعيد متّى ولوقا توزيع أجزائه لخدمة أغراضهما الخاصّة؛ أو إذا عرّت الوحدات التّركيبيّة التي رُتّبت فيها المادّة وجود حجّة مقترحة أو حالة مقدّمة من قبل ما سُمّي بشكل دقيق نسبيّاً «التّقارب المتعمّد للأقوال المستقلّة أصلاً».
مواضيع Q وعيسى
واستناداً إلى هذه المعايير، تبيّن أنّ عيسى Q، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بيوحنّا المعمدان، قد تمّ تقديمه من قبل مؤلّف أو مؤلّفي Q على أنّه كان يؤكّد، في دعواته للتّوبة والإصلاح الأخلاقي، على ثلاثة مواضيع رئيسة؛ الأوّل، هو ممّا لا شكّ فيه ذاك المتعلّق بالحساب القادم، وهو نفس الفكرة السّائدة التي تهيمن على الأناجيل الإزائيّة. جزء من هذا الحساب هو الانتقام الإلهي على سدوم بسبب الطّريقة التي تعاملت بها مع لوط. هذا يؤدي إلى استنتاج مفاده أنّ الشّيء ذاته سيحدث حتماً مع كورزين وبيت صيدا وحتّى أورشليم على الطّريقة التي عاملوا بها النّبي عيسى. أخيراً، هناك الموضوع القويّ والتّقليدي الذي يتواتر في كلّ من Q وأسفار البيبل من سفر التّثنية إلى سفر الملوك، وهو «مدار الخطيئة، والدّعوات النّبوية للتّوبة التي يتمّ تجاهلها، وعقاب من الله متبوعاً بدعوات متجدّدة للتّوبة مع التّهديدات بالحساب».
متى، أين، مَنْ؟
هذه، إذن، هي موضوعات يسوع التي يبدو أنّها كانت محلّ اهتمام كبير من قبل مؤلّفي Q والتي شكّلت، في نظرهم، «بشارة عيسى»، وهي بشارة، يجب الإقرار بذلك، تبدو حقّاً وكأنّها أخبار سيّئة جداً: خطيئة، وحساب، وانتقام إلهي. نعتقد أنّه قد تمّ جمع وترتيب كتابة أقوال عيسى تلك استناداً إلى إشاراتها الجغرافيّة والمعلومات المحلّية، في منطقة موطن عيسى في الجليل السّفلي، والمدن المحيطة ببحيرة الجليل وغربها، وربّما تمركزت في كفر ناحوم. وفي وقت مبكّر. في ظاهر الأمر، يبدو أنّ تأليف Q قد تمّ قبل أن يشعر أتباع عيسى بالوقع الكامل لعقيدة التّوبة والغفران التي كانت بارزة جداً عند بولس الذي جاء من عالم يهوديّ مختلف تماماً. وبناءً على ما يوجد وما لا موجود فيه، فقد يكون تجميع Q قد تمّ فعلاً من قبل أتباع عيسى الجليل في الثلاثينات، بعد وفاته.
جمهور Q
كانت هناك محاولات للتّدقيق جيّداً في نصّ Q قصد العثور على معالم حركة عيسى الأصليّة كما كانت موجودة في تلك البيئة الجليليّة في حياة عيسى وبعدها مباشرة. وقد تمّ العثور على «الرّحّل» و«المدمنين» و«المُتشدّدين» و«دعاة السّلام» في سطور Q وبينها، ولجميعهم ميل واضح نحو التّبشير بين مواطنيهم اليهود. وقد تحوّل مصطلح «الرّحّل» منذ ذلك الحين، بشكل واضح إلى «مُتسوّلين» و«دون مأوى» في بعض الأوساط، وتحوّل يسوع، بإيماءة أدبيّة مستبعدة نوعاً ما إلى هلّاس [وصف للشّخص متكرّر الكذب (المترجم)]، إلى واعظ من النّوع السّاخر مع موكب من أتباع غير مرغوب فيهم عمْداً.
في مرحلة ما، ربّما مع ظهور إنجيل مرقس، لا بدّ أنّ أتباع عيسى قد توقّفوا عن استخدام Q والتفتوا إلى الأناجيل الكاملة كما نعرفها. لقد استمرّ وجود نصّ Q لفترة طويلة بما يكفي لاستخدامه من قبل متّى ولوقا لأغراضهما اللّاهوتية المختلفة تماماً. هناك مجموعات أخرى، مثل الطّوائف التي تفتخر ب Q الخاصّ بها والمسمّى «إنجيل توما»، قد تكون تداولت ذلك لفترة معيّنة. لكنّ Q لم يستمرّ في التّواجد كشهادة منفصلة ومستقلّة لعيسى، على ما كان عليه فيما يبدو سابقاً. هل عفا عليه الزّمن ببساطة بظهور الأناجيل السّردية أم إنّه استُبدِل بما تبيّن من أنّ عيسى أكثر من كونه واعظاً جليلياً سيِّئ المزاج؟
هل كان محمّد يتحدّث أم يغنّي؟
لقد أَطلَق على Q المسلمين مصادفة (صدفة) اسم «القرآن». وتعني الكلمة العربية «التّلاوة»، وهو اسم يصف به العمل نفسه (يونس: 15، الزُمر: 28، فُصّلت: 3). وهذا ملائم جدّاً. إنّ القرآن الذي تمّ جمعه قد بدأ كتلاوة شفويّة فرديّة من جانب محمّد، وهذه التّلاوة المستمرّة هي التي حافظت على بقائه إلى اليوم، إضافة إلى كونه كتاباً مطبوعاً (وقبل ذلك كنسخ مخطوطة في كثير من الأحيان)؛ لأنّ تلاوة القرآن هي من أجلّ مظاهر التّقوى عند المسلمين.
Q والقرآن
إنّ العمليْن، Q المسيحيّين وقرآن المسلمين، هما مجموعة من أقوال أشخاص مؤثّرين ومقدَّسين يوجّهون جماعات المؤمنين في جميع أنحاء العالم مؤكّدين أنّ هذه الأقوال كانت فعلاً كلمات الله. وقد بدأت تلك الأقوال الواردة في كلّ من العمليْن كأداء شفهيّ، تمّ نقلها إلى جمهور بالكاد كان يتخيّل تبِعات ما كان يسمعه. كانت أقوال عيسى التي تمّ جمعها في Q مبعثرة هنا وهناك في رواية إنجيل متّى ولوقا، وسرعان ما تلاشى Q، إن وُجد فعلاً، من الوجود كعمل مستقلّ. في المقابل، يبدو أنّ «تلاوات» القرآن قد اكتسبت منذ البداية منزلة الكتاب المقدّس. إنّ ناقل هذه التّلاوات هو الذي كان يقنع سامعيه بأنّ الكلمات التي كانوا يسمعونها لم تكن كلماته، بل هي كلمات الله.
إنّ أوّل صوت يُسمع في Q هو صوت يوحنّا المعمدان (= لوقا 3: 7)، وهو خطاب منقول، ونحن نسمعه من خلال سمْع شخص آخر: «لذلك اعتاد يوحنّا أن يقول للجموع الذين يخرجون لسماعه... أنتم يا بذرة إبليس!» لم يدخل عيسى إلّا بعد يوحنّا، فجأة وبدون مقدّمة (= لوقا 4: 1). إذا حاولنا فتح القرآن في بدايته، فلا يمكننا أن نعثر على ذلك. وكما سبق أن أشرنا، فإنّ الذي قام بتجميع الأقوال في القرآن قد جمع العديد منها، ثم رتّب الوحدات الجديدة، السّور، بترتيب يصعب فهمه، وإن بدا ترتيباً من الأطول إلى الأقصر. إنّ الكتابات اليهوديّة والمسيحيّة المقدّسة تقدّم نفسها في شكل التّاريخ الشّامل، وبالتالي تكون لها بداية ونهاية. أمّا القرآن الذي، بدون بداية أو نهاية حقيقيّة، فهو نوع من شريط موبيوس Mًbius الذي يدور أبد الدّهر.
محمّد نبيّ وشاعر
لا يقدّم القرآن محمّداً في أيّ مكان، فلا هو ولا نصوص السيرة التي لدينا تضمّنت أيّ شكل من أشكال الخطاب التّمهيدي يشرح فيه النّبيّ للمكّيّين تجربة الوحي الخارقة التي مرّ بها واستعداده لما كان سيتلوه عليهم. ربّما لم يكن محمّد بحاجة لشرح ما يقوم به. قد يكون ما فعله هو مجرّد إخبار سامعيه. وبناءً على ما اعتُبرت أنّها السّور المكّية الأولى، فقد تحدّث محمّد منذ البداية كنبيّ، هذا إذا فهمنا أنّ مصطلح النّبيّ بمعناه الواسع هو شخص ما ينطق باسم الله. كيف يتسنّى لجمهوره أن يعرف ذلك ما دام لا يوجد شيء في القرآن، ولا حتّى في مأثور السيرة، يصف بداية خدمة محمّد العامّة؟
وبصرف النّظر عن السّور التي حدّدها العلماء الغربيّون أو علماء الإسلام التّقليديّون كأولى سور القرآن (أي سورة العلق وسورة المدّثّر)، فمن الواضح أنّها ليست الأولى بالمعنى المطلق: فكلّ شيء يوحي، حتّى في السّور المبكّرة، بأنّ شيئاً ما قد سبق فعلاً. ومن ثَمّ لا يمكننا إلّا أن نتَصوّر فقط، طريقة بدايات مهمّة محمّد، أو كيفيّة تقبّلِ وفَهْمِ المكّيّين الأوائل لهذا الرّجل المعروف بينهم، يسمعونه الآن وهو في نضجه الكامل، يرفع صوته بهذا الأسلوب الجديد. وبما أنّه لا يوجد ما يشير إلى أنّ محمّداً قد حاول منذ البداية شرح دعوته وتوضيح نتائجها، فليس بإمكاننا إلّا أن نستنتج أنّ كلّ ذلك كان شيئاً مألوفاً بالفعل عند المكّيين لما اكتسبوه من خبرة، وهو إذن أمر لا يتطلّب أيّ تفسير.
إنّ شكوكنا هذه يؤيّدها القرآن؛ إذ إنّ الادعاءات القائلة إنّ محمّداً كان شاعراً أو كاهناً وشخصاً غير عادي ولكنّه مألوف، منتشرة في الآيات المبكّرة من القرآن، بل تتوسّع ويتردّد صداها في مأثور السّيرة. تشير الأدلّة الشحيحة التي بين أيدينا إلى أنّ الصّفتيْن، الشّاعر والكاهن، لم تكونا متطابقتيْن دائماً في العربية القديمة، ولكن لا يوجد شيء في القرآن يشير إلى أنّ المكّيّين قد قاموا بالتّمييز الجيّد عندما يتعلّق الأمر بمحمّد. كان هناك شيء ما يتعلّق بأسلوب أقواله -القَسَم المتكرّر، وتواتر القافية أو السّجع، والمقاطع ذات الطّابع الانفعالي، واللّغة المميّزة جدّاً، والتّعبيرات الغامضة في كثير من الأحيان. وربّما كان هناك أيضاً شيء يتعلّق بسلوكه الشّخصي -إذ يذكّرهم النّداء في سورة المدّثّر «يا أيّها المدّثّر!»، بذلك النوع المشهور من النّاس، ذاك الذي به مسّ يصرخ وينادي دائماً بين العموم، بإلهام من قوّة عُليا. قضى محمّد بعد ذلك وقتاً طويلاً في محاولة لتصحيح هذا الانطباع (آية 29-30 من سورة الطّور... إلخ)، وهو ما توصّل إليه في النّهاية، لكنّ شخصيته كشاعر مؤثّر هي التي استحوذت في البداية على انتباه المكّيّين، ثمّ أصبح النّاس بعد ذلك ولأوّل مرّة، يجتمعون إليه ويُصغون إلى ما يقول.
يلفت أسلوب تلك السّور المبكّرة وكذلك وصف محمّد بالشّاعر انتباهنا عمّا كان عليه محمّد. نقرأ الآن ما قاله، لكن في السّياق الأصلي لم يكن محمّد يكتب، بل كان يتكلّم، أو إذا أخذنا على محمل الجدّ أدلّة النّصّ ورأي معاصريه، فإنّ محمّداً كان، على طريقة الكهنة، يغنّي أو يُنشد. بدأنا الآن نقف على أرضية صلبة. لا نحتاج إلى الإفراط في تحديد الحالة، ولكن بفضل تحليل ملحمة هوميروس وما يماثلها، حتّى في الشّعر الجاهلي، فنحن نعرف الكثير عن هؤلاء الشّعراء المغنّين؛ إذ كانوا، في الوقت ذاته، يؤلّفون وينشدون الأشعار، ومرّة أخرى علينا أن نميّز بين التّأليف الشّفوي والنّقل الشّفوي. فالقرآن المكّيّ يشير بوضوح إلى كلا الأمرين، لكنّهما مشكلتان منفصلتان، ونحن هنا معنيّون فقط بالتّأليف الشّفوي أوّلاً.
الوحي بوصفه تأليفاً شفويًّا
نحن الآن على مسار تأليف القرآن، ولكن ليس القرآن الذي بين أيدينا، الذي يسمّيه المسلمون المصحف (7)، والذي هو نتاج عمليّة التّحرير، بل الأقوال الأصليّة التي تمّ جمعها في القرآن. والقرآن في حدّ ذاته ليس له بناء، أو بالأحرى، فإنّ البناء الذي يظهر في ترتيب السّور، وإن لا يوجد وضوح كاف بشأن ذلك، أو حتّى بشكل أكثر غموضاً، في تأليف السّور الحالية انطلاقاً من أصغر وحدات «التّلاوة»، ليس نتيجة مقاصد المؤلّف بقدر ما هو نتيجة مقاصد محرّري القرآن المجهولين. لذا، ومن وجهة نظرنا، فكلّ ما كان يقصده محمّد يكمن فقط في أقواله الأصليّة، تلك الأقوال التي يمكننا تخليصها من القوالب التي وردت بها في المصحف حتّى نعيدها إلى معانيها الأصليّة.
عندما نتأمّل جيّداً، نرى جليًّا أنّ السّور المكّية المبكّرة، والتي هي أقرب إلى كونها وحدات تأليف أصليّة من السّور الطّوال التي تليها، تُعرّي جميع مؤشّرات التّأليف الشّفوي: نظام قافية ملحوظ، ولافت للنّظر؛ وأنماط إيقاعيّة مكثّفة، وجمل قصيرة، ومواضيع ذات الصّيغ المتكرّرة. علاوة على ذلك، فإنّ Sitz im Leben المفترض لهذه السّور يتوافق مع ظروف التّأليف الشّفوي: أوّلاً، على الرّغم من أنّ مجتمع المشافهة ذاك قد يكون عرف الكتابة، إلّا أنّ التّأليف الشّفوي لا يزال الشّكل المتداول للتّعبير. إنّ ظروف الدّعوة تسير في الاتّجاه نفسه: فالسّور المكّيّة قد شكّلت رسالة متكاملة موجّهة إلى عموم المجتمع تمّ إبلاغها للنّاس. وتجدر الإشارة مرّة أخرى إلى أنّ الجمهور المتلقّي قد لاحظ التّشابه الواضح مع ما كان يسمعه من المؤلّفات الشّفويّة للشّعراء والكهنة في ذلك المجتمع.
هناك أدلّة أخرى تشير إلى أنّ السّور المكّيّة كانت تبثّ مشاهد مباشرة. فكثير من المقاطع في القرآن مثل تصوير يوم الحساب في سورة الصّافّات (50-61) وسورة ق (20-26)، يصعب متابعتها ما لم نتخيّلها كمشاهد، حيث وحدها الحركات والإشارات والنّغمات الصّوتيّة قادرة على إيصال تلك المشاهد وتوضيحها للنّاس، وهذا ما لا يقدر على توضيحه النّصّ المكتوب الذي لا يحدّد المتحدِّث ولا المتحدّث عنه. يمكن أن نستنتج من هذا أنّنا هنا أمام أقوال شفويّة، لا أحد يشكّ في ذلك، لكنّ المنطق قد يؤدّي إلى استنتاج أكثر عمقاً وراديكاليّة، مفاده أنّ محمّداً كان ينتمي إلى تقليد من الشّعر الشّفوي كان يُؤَلّف ويُنشَد في ذات الوقت: فالغناء والأداء والتّأليف كلّها أفعال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتّقليد الشّفوي. وعلاوة على ذلك، فغالباً ما يتمّ تحقيقها عن طريق «الإلهام»، بمساعدة قوّة عُليا.
من الممكن أن نذهب أبعد من ذلك. وكما هو الحال مع الأشعار الشّفويّة الأخرى التي تمّ تدارسها، فمن الصّعب أن نتخيّل أنّ «تراتيل» محمّد لم تُنشَد أكثر من مرّة، وبطريقة الأداء الشّفويّ، بشكل مختلف نوعاً ما في كلّ مناسبة جديدة. وهكذا، كما سنرى، فإنّ العديد من السّور المكّية المحفوظة لدينا، بغض النّظر عن اهتمامات التّحرير الأخرى، لم تكن سوى أداء واحد للوحي، بيد أنّ هذا لم يكن الانطباع الذي تعطيه لنا صيغة القرآن التي لدينا. فمن الواضح أنّنا نتعامل هنا مع نصّ مُثبَت، وينبغي أن يكون ذاك التّثبيت قد حدث في وقت مبكّر. وهكذا، فإنّنا أمام فرق جوهريٍّ بين محمّد والشّاعر الشّفويّ. ومهما كانت أوجه التّشابه في الأسلوب والمادّة، فإنّ بعض جمهور محمّد على الأقلّ بات مقتنعاً بأنّ ما سمعه ليس قول شاعر، بل هو كلام الله.
الهدف المنشود
إذا أخذنا بعين الاعتبار صحّة مضامينها، فقد كان الهدف من السّور التي ظهرت في مكّة لجمهور من الوثنيّين هو تغيير العبادة من الشّرك إلى التّوحيد الصّارم، وكان الأسلوب المتّبع لتحقيق ذلك هو الوعظ. والسّور المكّيّة في حدّ ذاتها هي رسالة موجّهة إلى المجتمع ككلّ (أمّا شكلها البارز فهو الجزرة والعصا)، تمّ إيصالها إلى عموم النّاس. لكن لم يقع تبليغ هذا الوعظ المخصوص بطريقة القراءة أو الكلام، بل كان تلاوة وإنشاداً؛ أي بالطّريقة والصّورة التي أرادها الله (سورة القيامة، آية 18: فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه). أمّا مَن كان يؤدّي مثل هذا الكلام للنّاس، فقد عُرّف بأنّه إمّا كاهن أو شاعر. ومهما كان الأمر، فقد كان لأقوال القرآن أسلوب يختلف اختلافاً كبيراً عن الخطاب العاديّ واللّغة العاديّة والسّلوك العادي. وينبغي أن تكون هناك أيضاً إيماءات وحركات: وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإنّ العديد من المشاهد الدرامية ليوم الحساب -المخلص من جانب والظّالم من الجانب الآخر (سورة ق: 20-26 وسورة الصّافّات: 50-56، على سبيل المثال)- ستكون غير مفهومة بدون تحديد تلك الإيماءات والحركات أو ربّما التّغييرات التي تطرأ على مستوى الصّوت.
كيفيّة أداء الشّاعر لشعره
إنّ كلّ ما نعرفه عن الشّعر والشّعراء في مجتمع يقوم على المشافهة مثل الذي في مكّة زمن النّبي -وعن الثّقافة الإسلامية لفترة طويلة بعد ذلك- يشير إلى أنّ الأداء نادرًا ما كان مرتجلاً بشكل كامل، وأنّ الشّاعر، الماهر والفنّان، كان يختلي بنفسه ويقضي وقتاً طويلاً ويبذل جهداً كبيراً لصياغة عمله قبل أدائه في الأماكن العامّة، حتّى إنّنا قد نكون تلقّينا نظرة ضيّقة عن محمّد أثناء عمله (مع الله!) في سورة المزّمّل (الآيات 1-8، مع إقحام لاحق للآيتيْن 3-4). لكن ما كان يؤدّيه الشّاعر كعمل نهائيّ في الأماكن العامّة لم يكن تماماً ما قام بتأليفه على انفراد: فالشّعر المؤدَّى شفويّاً أيّاً كان نوعه، يعطي مؤشّرات على ردّ فعل الجمهور تجاه ذاك العمل أثناء أداء الشّاعر له، حيث يكون في النّهاية، عملاً ناتجاً عن عامليْن اثنيْن؛ التّحضير المسبق، وردّ فعل الجمهور المباشر، ولنا أن نتصوّر هذا الارتجال حتّى وإن كان المضمون يجسّد كلام الله.
إنّ للقرآن معرفة جيّدة بردّ فعل الجمهور. وكما رأينا، هناك تفسيرات فوريّة -مُمَثّلة في قوله «وما أدراك ما هية...؟»- والتي من الواضح أنّها من وحي ردّ فعل الجمهور (سورة القارعة: 9-11)، أو قد تكون في هذه الحالات، في غياب منه. كما توجد إجابات مباشرة لكلّ من الأسئلة والانتقادات (سورة البقرة: آية 135... إلخ). وأخيراً، كان هناك اتّهام بأنّ «الوحي» كان مرتجلاً إلى حدّ ما، وأنّ محمّداً كان يؤلّفه تباعاً («بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ»، سورة الأنبياء)، («أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ»، سورة الطّور). لا، لقد كان يتلو فقط ما أتاه من ربّه («وَإِذا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلّا ما يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قُلْ لَوْ شاءَ اللهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْراكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ»، سورة يونس). ومع ذلك، لم يكن من الضّروري أن تحدث كلّ هذه الرّدود مع الأداء الأصلي؛ لأنّ مثل ذاك الأداء كان بالتّأكيد وبالضّرورة، في حالة القرآن خاصّة، مكرّراً، وكانت هناك فرصة للشّاعر، أو النّبيّ، أن يُجري عليه تعديلات.
الذّكر المحفوظ
لقد اقتنع بعض المكّيّين فأصبحوا مسلمين. وهكذا بدأ الجزء التّالي من مرحلة القرآن. والقرآن نفسه لا يخبرنا الكثير عن ترديد المسلمين له؛ إذ كانت تعليمات الله حول تلاوة القرآن موجّهة إلى النّبي بالذّات، كما ورد ذلك في سورة القيامة، الآية 16: «لا تحرّك به لسانك لتعجل به» -ولم يكن موجّهاً إلى مسلمي مكّة، على الرّغم من أنّ هؤلاء قد طبّقوا هذه التّوجيهات بشكل طبيعيّ. لكن ما يبدو مؤكداً هو أنّ القرآن قد تمّ حفظه منذ وقت مبكّر جداً ومن المحتمل أن يكون في نوع من الإطار اللّيتورجي، ومن الواضح أنّه ليس في نفس الإطار الذي تلا فيه محمّد القرآن في الأصل: لقد كان المسلمون يردّدون القرآن، ولم يكونوا منشئيه. لم يكن هذا مجتمعاً حديث عهد بالكهنة: إذ لم يكن المسلمون على دراية ببقيّة اللّغات على غرار المسيحيّين الأوائل الذين تلقّوا «مواهب الرّوح القدس»، بل كانوا يردّدون ما أصبح الآن نصاً. كما أنّهم لم يكونوا عرباً رواة لهم الكفاءة والمهارات العالية لنقل شعر الآخرين. يبدو أنّهم كانوا يردّدون القرآن كشكل من أشكال العبادة، وهو الذي لم يكن سوى أقوال وردت على لسان محمّد، ولكنّها الآن بالنّسبة إليهم مقدّسة: لقد أصبحت أقوال محمّد صلاة المسلمين.
إذا كان هذا الافتراض صحيحاً، فيجب أن نتصوّر أيضاً أنّ محمّداً كان يوجّه عمليّة الحفظ. فهو الذي كان عليه أن يختار من بين ترتيله المتكرّر لسورة معيّنة، الصّيغة التي ستصبح الآن ليتورجية، والتي من شأنها أن تشكّل صلاة المسلمين. إذا كان محمّد قد قام فعلاً بتشكيل أو تأليف وحيه في تلاواته، كما تمّت الإشارة إلى ذلك، فإنّ مجال الاختلافات فيها سيكون أضيق ممّا لو كان ذاك الوحي مرتجلاً، بعبارة أخرى، إذا قام بتبليغ تلك التّلاوات في ذات الوقت الذي نزلت عليه. ولكن لا تزال هناك خيارات يتعيّن القيام بها، وبهذا المعنى الأساسي، كان محمّد أوّل محرّر للقرآن. هو الذي اختار الآيات، وربّما عدّلها، أو حتّى أعاد صياغتها للحفظ، وهو الذي وجّه عمليّة الحفظ ذاتها. لقد كانت التّلاوة في العربيّة، مع ذلك، أسلوباً غير مألوف، نوعاً من الخطاب الفنّي الذي كان من اختصاص الشّعراء وليس لهجة المكّيّين المتداولة.
وهكذا لم يتمّ تناول «التّلاوة» من قبل رواة محترفين، ناقلين مُدرَّبين للنّصوص الشّعرية، ولكن من قبل «المُسلمين» أنفسهم، المؤمنين البسطاء الذين لا يمتلكون التّأهيل ولا المهارة المهنية لإعادة صياغة هذا النّصّ بالذّات. لا يسعنا إلّا أن نتخيّلهم يردّدون التّلاوات مع محمّد أو بشكل أفضل بعد محمّد مهتدين بهديه. أصبحت التّلاوة بالنّسبة إليهم إعلاناً عاماً عن ثقتهم في الله وفي رسالته، وفي الوقت نفسه صلاة وعبادة.
ينبغي ألّا تكون عمليّة الحفظ ذاتها صعبة في مجتمع مكّة الذي لا يزال قائماً على المشافهة. كانت الأساليب نفسها التي ساعدت الشّاعر في تأليفه -تكرار القافية والإيقاع والصّياغة اللّغوية- مفيدة أيضاً للمؤمنين في حفظهم لما كان يُتلى على مسامعهم. ولم يتمّ، على ما يبدو، حذف أيّ شيء. إنّ كلّ الحوار الأصلي الذي وجّهه الله إلى محمّد تكرّر بأمانة، تماماً مثلما وقع ترديده في الأصل. لم يكونوا يقلّدون النّبيّ، بل كانوا يردّدون كلام الله. وهكذا، فإنّ مسألة التّلاوة لم تكن مهيّأة للحفظ فحسب، بل تترسّخ الآن.
حكواتي
هل كان محمّد حينها شاعراً أم كاهناً كما كان يظنّ بعضٌ مِن سامعيه؟ هل ألّف وأدّى بالطّرائق نفسها التي اتّبعتها الوجوه المألوفة في الحرم المكّي؟ إنّ التّمييز في العصور الوسطى والحديثة بين أسلوب الشّاعر والكاهن، وبينهما وبين القرآن، هو إلى حدّ ما خارج الموضوع. لقد كان ممّن استمع إلى محمّد على معرفة بمثل هذه المسائل أكثر بكثير ممّا نعرفه نحن، ويعتقدون قطعاً أنّه قد أدّى الدّور، وكانت لديهم علاوة على ذلك آراؤهم الخاصّة عن كيفية عمله. لم يتطلّب الأمر قدراً كبيراً من الخبرة للتّعرّف عليه كشاعر. ما كان يخرج من شفتيه هو الشّعر بكلّ المقاييس: مجموعة مميّزة من القَسَم التي تبدأ أو تظهر في السّور المبكّرة، أسْطُر شعريّة قصيرة مقفّاة، مرتّلة ترتيلاً، وذات محتوى انفعالي للغاية. كما أنّ طريقة أدائه لها، والتي ليس لنا معرفة جيّدة عنها، ربّما تشير هي أيضاً إلى أنّه شاعر. وقد خلُص مستمعوه إلى الاستنتاج المناسب، وهو أنّ هذه كانت «أساطير الأوّلين»، ولا بدّ أنّه قد تلقّى شعره من شخص آخر، وحتّى ما كان «يتلوه» إنّما اكتتبه وكان يُملى عليه، كما ورد ذلك في سورة الفرقان (4-5): «وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلّا إِفْكٌ افْتَراهُ وَأَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاؤُوا ظُلْماً وَزُوراً * وَقالُوا أَساطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً».
هناك مسألة أكبر على المحكّ. إذا كان محمّد يؤلّف ضمن لغة ثابتة، فهل كان يؤلّف أيضاً ضمن تقليد ثابت؛ أي هل كان، مثل الشّعراء الشّفويّين الآخرين المعروفين، يعمل بأشكال جديدة على مواضيع تقليديّة، وبالتّالي مألوفة؟ فمن خلال ظهوره اللّافت، كان محمّد مبتكِراً جيّداً: كانت رسالته هي رسالة الله، وليست رسالته، ولا من استنباطه، وفي واقع الأمر، نحن لا نعرف أيّ شخص آخر في ذلك المكان أو تلك الفترة -شاعراً كان أو كاهناً أو غير ذلك- كان يفعل ما فعله. أمّا بالنسبة إلى بعض مستمعي محمّد على الأقلّ، الذين يفقهون ما يسمعونه، فقد كان محمّد يردّد ببساطة «أساطير الأوّلين» (آية 5، سورة الفرقان)، ولكن بالنّسبة لنا، نحن الذين يعرفون المزيد عن تأليف الشّعر الشّفوي، فقد كان، باستخدام مصطلحات هوميروس، «قصص مغنّي». وإذا كان التّوصيف صحيحاً، فإنّ محمّد مكّة يتناسب جيّداً مع تقليد الشّاعر الشّفوي، فنّان ماهر يعيد صياغة المواضيع المألوفة بأسلوب مألوف، وإن كان أسلوباً صعباً في حدّ ذاته.
أنكر محمّد ذاك الاتّهام، وينبغي علينا أن نسلّم بذلك: إنّ مواضيع ما كان يتلوه لا علاقة لها بتلك المواضيع النّمطية التي تظهر عند الشّعراء المعاصرين. واحد من أهمّ أطر مواضيع القرآن الرئيسة هو في الحقيقة الإطار البيْبلي للنبوّة والأنبياء: فآدم وإبراهيم، نوح وموسى، داود وسليمان، من بين كثيرين آخرين، يسرحون ويمرحون بين آيات السُّوَر حاملين معهم قيمهم ولغاتهم. واستناداً إلى استجابة جمهور السّامعين كما يبيّن القرآن نفسه ذلك، كانت المواضيع البيْبلية مفهومة، وإن لم تكن دائماً مألوفة بشكل تامّ عند المكّيين الذين كانوا يسمعون عن هذه الأمور، وعلى ما يبدو لم تكن تلك هي المرّة الأولى.
قصص وحكايات
ليس من الصّعب التحقّق من وجود بعض الأشكال الأدبيّة في القرآن، لكن وبمجرّد تمييزها، ينبغي أن نحاول ربطها بمقاصد النّبيّ. فقد كان هدفه الأوّل واضحاً إلى حدّ ما، ألا وهو جذب انتباه سامعيه. ومن الواضح أيضاً أنّ مجموعات القَسَم اللّافتة للنّظر التي تتصدّر العديد من السّور المبكّرة، وكذلك المشاهد المتكرّرة التي تصوّر الآخرة، والتي تبدأ بعبارة «وإذا...» كانت كلّها موجّهة تقريباً إلى ذات الهدف. ومع ذلك، فإنّ المقاطع التي تصوّر يوم الحساب لها وظيفة أخرى: فهي تبدأ أيضاً في تشكيل سلوك السّامعين ووعيهم وفقاً للأخلاق الجديدة، لا سيّما إذا تعلّق الأمر بنقل مشاهد حيّة من الآخرة تصوّر النّاس يقودهم قدرهم إلى الجنّة ونعيمها أو إلى جهنّم وعذابها (سورة ص: 55-64، سورة المعارج: 15-44).
وكما تكشّف الوحي شيئاً فشيئاً، تكشّف نطاق التّعليمات أيضاً. أمثلة مأخوذة من التّاريخ المقدّس، من تاريخ الله، تحلّ تدريجيّاً محلّ وعيد الآخرة ووعودها. أمثلة بيبليّة وعربيّة على العقاب الإلهيّ، ليست ضدّ الفجور بقدر ما هي ضدّ الكفر، تُعرض في البداية على السّامعين بمجرّد التّلميح ثمّ بشكل أكثر تفصيلاً بعد ذلك، مثل قصص الخلاص (8)، إمّا لأنّ التّلميحات لم تكن ناجعة أو ربّما بسبب اهتمام جمهور السّامعين الواضح بهذا النّهج الجديد لرسالة محمّد المستند إلى السّرد التّاريخي.
مرجعيّة محمّد الدّينيّة
من أين أتت هذه المعلومات إن لم تكن من عند الله؟ سيتمّ تناول هذا السّؤال على نطاق أوسع لاحقاً (9)، ولكنّ المسألة هنا تتعلّق بمحمّد نفسه. يصرّ المسلم على أنّ القرآن ليس من عند محمّد، بل من عند الله. دعونا إذن نطرح السّؤال بشكل مختلف بعض الشّيء. أين تلقّى جمهور النّبيّ، الذي كان جمهوراً وثنيّاً على ما يبدو، فهماً يتناسب مع فهمه؟ قد يكون لدى الشّعراء الجاهليّين، كما يرى كثيرون، بعض الإلمام بالأفكار البيْبليّة، لكنّهم بالتّأكيد لا يعرفون شيئاً عن القصص البيْبليّة التي كانت فيما يبدو مألوفة عند محمّد وجمهوره. إنّ إلقاء نظرة سريعة على مادّة التوراة والإنجيل المذكورة في القرآن يكشف أنّ مؤلّفها لم يتعرّض بشكل مباشر أو غير مباشر للنّصوص المقدّسة نفسها، بل بالأحرى، بطريقة أو بأخرى -ونحن ببساطة لا نملك المعلومات الكافية لنقول بدقّة كيف ذلك- لم يتعرّض إلى ما يسمّيه اليهود المدراش، الذي هو إعادة سرد محتويات الكتابات المقدّسة التي غالباً ما تكون منمّقة بتفاصيل غريبة لإنارة سبيل الجمهور أو هدايته أو إمتاعه (10).
ليس لدينا أمثلة محفوظة من أدبيّات المدراش اليهوديّة في جزيرة العرب في تلك الحقبة، ولكن كان هناك يهود في كلّ من جنوب شبه الجزيرة العربية وفي الواحات الممتدّة في سلسلة من المدينة باتّجاه الشّمال، ويبدو على الأرجح أنّ معرفتهم بالكتابات المقدّسة، وبالتّالي فهم محمّد نفسه لها، لم تكن معرفة بنصّ مدراشيّ أدبيّ مكتوب بقدر ما هي معرفة بمدراش منقول شفويّاً. إنّ ما لدينا في أجزاء واسعة من القرآن ليس أقلّ من الأجزاء المتناثرة لمدراش من القرن السّابع عن البيْبل.
وينطبق الشّيء ذاته على مادّة الإنجيل في الكتابات الإسلاميّة المقدّسة. إنّ قصص القرآن عن يسوع ومريم، التي تُروى أو يُشار إليها بشكل تلميحي (على سبيل المثال، سورة مريم: 16-23، سورة آل عمران: 35-44)، تجد مباشرة أوجه التّشابه بينها في الأناجيل الأبوكريفيّة وليس في النّصوص القانونيّة. نحن نعرف مقداراً أقلّ عن الأبُوكْريفا، والأدب الشّعبي المسيحي الشّرقي بشأن عيسى بشكل عامّ، ممّا نعرفه عن المدراشيم اليهوديّة، إلّا أنّ روايات عيسى في القرآن تحتوي على بعض العناصر الهامشيّة والأسطوريّة بشكل واضح مقارنة بمعتقدات الكنيسة العظمى. قيل في القرآن إنّ عيسى لم يمت على الصّليب، ولكن «شُبّه لهم» (سورة النّساء: 156-59)، ومَن صُلِب هو ضحيّة بديلة وفقاً لمعظم مفسّري القرآن. وحسب قراءة المسلمين للقرآن، فإنّ عيسى، النّبيّ البشريّ، قد رفعه الله عنده (سورة آل عمران: 55) وسيعود ليعاني موته مثل البشر في آخر الزّمان، ربّما مثل المهدي الذي يلعب دوراً يشبه دور المسيح في العالم الأخروي الإسلامي.
الكاهن
لقد أربك محمّد معاصريه. وعلى الرّغم من أنّ محمّداً المألوف عندهم كان يلعب أو يؤدّي دور الشّاعر، إلا أنّهم كانوا يعلمون أنّه لم يتربَّ على قول الشّعر مطلقاً، وأنّه لم يكن ينتمي إلى فئة الشّعراء. في بلاد العرب وُلد الشّعراء وفي ذات الوقت صُقلت فيها مواهبهم. لكن كان للمكّيّين رأيهم؛ إذ اعتقدوا أنّ محمّداً لابدّ أن يكون شاعراً به مسّ من الجنّ أو مُلهَماً من الجنّ (سورة الأنبياء: آية 5، وما يليها)، أو قد يكون كاهناً (سورة الطّور: آية 29، سورة الحاقّة: آية 42). لقد كانت لديهم أدلّه ملموسة على ذلك على مرأى ومسمع منهم. وبالنسبة لنا، فإنّ هذا الانطباع يعزّزه ما يبدو أنّه مأثورات إسلامية قديمة عن النّبي. فقد ذكروا أنّ محمّداً قال لزوجته خديجة بشأن آياته: «إنّي أسمع صوتاً وأرى ضوءاً، لقد خشيت أن أكون كاهناً!». تُظهر الرّوايات محمّداً وقد بدا خائفاً جداً من تجربة شيطانيّة لدرجة أنّه فكّر في الانتحار! علينا أن نمنح بعض المصداقية لهذه القصّة من المستبعد جدّاً اختلاقها من قبل مأثور مسلم ورع.
وبفضل كلّ من الكاهن والشّاعر أصبح متاحاً الوصول إلى ما سمّاه العرب بالغيب (سورة الأنعام، آية 59، سورة ال عمران، آية 44)، «عالم الغيب» عالم غير مرئيّ خارق للطّبيعة. وكلاهما كان مألوفاً للجنّ، والجنّيّ في العقليّة العربية له علاقة بعالم الأرواح (11)، وكان كلّ من الشّاعر والكاهن، في بعض الأحيان، مجنوناً أو، يمكن القول إنّه كان مُلهماً أو به مسّ، على الرغم من أنّ ذوق العربي أقرب إلى المعنى الأخير. أعطى الجنّ للشّاعر المهارة في سرد حكايات الشجاعة القبلية في الحرب أو الحزن في الحبّ؛ الشّاعر هو لسان حال القبيلة وذاكرتها، «ذاكرة العرب»، كما يُطلق عليه. كان الكاهن يمتلك مواهب خاصّة جعلته مستشار القبيلة للحكم في المسائل الصّغيرة والكبيرة. وكلا الشّاعر والكاهن معروف من خلال خطابه، سجع الكاهن وقصيدة الشّاعر.
إنّ سجع القرآن يشبه قليلاً موازين الشّعر التي بُنيت عليها القصيدة العربية القديمة، لكن هل يمتلك خصائص سجع الكهّان؟ يجيب المأثور الأدبيّ الإسلامي اللّاحق بالنّفي؛ لأنّ الاعتراف بحقيقة أنّ القرآن هو شكل من أشكال السّجع يقود إلى تأكيد الاتّهام بأنّ محمداً كان كاهناً. والأكثر من ذلك، كان هؤلاء النّقاد أنفسهم حذرين جدّاً بشأن تعريف السّجع، حيث لا يمكن لأسلوب القرآن أن يكون كذلك. وبالفعل، إذا تمّ ترك التّعريف فضفاضاً على أنّه الكلام المقفّى وهو توافق فواصل الجمل في الحرف الأخير، والذي يميل إلى الغموض والإبهام، فإنّ القرآن يناسب النّموذج تماماً. لكن فقط لبعض الوقت. ففي المدينة، بدأ دور الكاهن المتحفّظ يختفي خلف الدّور الجديد للنّبيّ الواعظ.
ولكن ليس قبل أن تغيّر هويّة محمّد ككاهن حياته ومسار التّاريخ البشري. في عام 622 م، بعد اثني عشر عاماً من «تلاوة» رسالته علناً في الحرم المكّي المعمور، وبينما كانت الأوساط المكّيّة تبذل جهوداً لاغتياله، هاجر محمّد -هجرته الشّهيرة- إلى واحة المدينة استجابة لدعوة أهلها هناك. كان أهل المدينة على شفا حرب أهليّة واعتقدوا أنّ هذا المكّيّ، الذي نعتبره في هذه المرحلة مجرّد داعي الله المزعج والمثير للمشاكل، كان الشّخص الذي سيحلّ مشاكلهم السياسية والاجتماعية. إنّ الدّعوة إلى المدينة لا تبدو مع ذلك غريبة إلّا إذا اقتنعنا، كما سيقنعنا التّقليد الإسلامي، أنّه لا يمكن بأي طريقة من الطرائق الخلط بين محمّد والكاهن. قد يكون لعبارة «رسول الله» صوت واحد في أذنَي النّبيّ، ولكن بالتّأكيد كان لها صوت آخر بالنّسبة إلى أهل المدينة. لقد نطقوا كلمة «نبيّ» رمز القوّة والفعل، وكانوا مستعدّين إلى درجة عالية للمجازفة مع هذا الشّخص بالذات.
القرآن المُعجِز
نشعر بالقلق والحيرة من محمّد والقرآن، مثلما شعر بذلك المكّيون في القرن السّابع الذين سمعوا القرآن لأوّل مرّة مباشرة من محمّد. لا نعرف من أين تعلّم هذا التّاجر المكّي الصّغير قول الشّعر. لم يكن في ذلك حتماً أيّ مشكلة بالنسبة إلى المأثور الإسلامي، ولذا لم يُقدّم أيّ تفسير. كان كلّ من محتوى القرآن وأسلوبه -لغته ومجازاته واستعاراته- من عند الله، ومن ثَمَّ، خلُص المسلمون على نحو صائب، إلى أنّ القرآن معجزة في ذاته، وبالتّالي لا يضاهيه حرفيّاً وأدبياً أيّ كلام.
إنّ محمّداً (أو الله المتحدّث عبره) قد أكّد ذلك كثيراً في ردّه على منتقديه: (سورة البقرة، آية 23: «وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمّا نَزَّلْنا عَلَى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ»... إلخ)! وإذا كانت المعجزة حدثاً ليس له أسباب طبيعيّة، فإنّ القرآن هو بالفعل معجزة. وسواء كان «سحر اللّغة الرّائع» هو الذي جعل ذلك ممكناً، كما اعتقد أحد النقّاد في أوائل القرن التّاسع عشر، أو كان مجرّد عمل من أعمال الله، فلم تكن هناك طريقة منطقية يمكن من خلالها لمكيٍّ أمّيٍّ أن ينتج شعراً بتلك الرّوعة مثلما نجده في القرآن -مع أنّ مسألة أمّية محمّد غير ذات أهمّية، فمعظم الشّعراء الشّفويّين، وبالتّأكيد هم الأفضل، كانوا أمّيّين. ومثل ترنيمة كيدمون Caedmon في حكاية بيد Bede (12)، يظهر أنّ إنشاد محمّد قد جاء من مكان آخر.
أفكار ثانويّة: Q والحديث
من الأشياء الغريبة، والتي نرى منها أمثلة كثيرة، تسمية مجموعة «أقوال» عيسى تلك التي استخلصها علماء القرن التّاسع عشر من إنجيليْ متّى ولوقا بــــــــ«Q». ويكمن الفضول في حقيقة أنّ «كتاب Q» الآخر، المشهور جدّاً؛ ذلك الكتاب المقدّس الإسلامي المسمّى القرآن، ليس أكثر أو أقلّ من مجموعة متشابهة من أقوال محمّد (13). أو بالأحرى الأقوال التي جاء بها محمّد لأنّه، وفقاً للنظرة الإسلاميّة، قد كرّر ما سمعه من الله فقط.
لا يمكن لأيّ من المجموعتين أن تدّعي الاكتمال. هناك العديد من agrapha logia لعيسى (أقوال عيسى التي لا توجد في الأناجيل القانونيّة [المترجم]) غير موجودة في Q، ولا حتّى في لوقا أو يوحنّا، ولكنّها موثّقة في المأثور المسيحيّ، سواء (1) كانت مضمّنة في إنجيل أبوكريفيّ، (2) أو ظهرت في مجموعات أخرى من الأقوال كما في إنجيل توما المزعوم، أو (3) ذُكِرت عَرَضاً في مجموعة متنوّعة من الأعمال، بما في ذلك بعض المؤلّفين المسلمين، الذين كانوا يعتبرون عيسى نبياً مهماً قبل الإسلام. إنّ معظم أقوال محمّد التي ورد ذكرها تَحدُث في الواقع خارج القرآن. لقد تمّ تضمينها في سيره الذّاتية، تماماً مثل سيرة عيسى الذّاتية في الأناجيل، وعدد كبير منها محفوظ في شكل أحاديث، وقد تناقل معاصرو محمّد ما سمعوا من أقواله وما شاهدوا من أفعاله.
الأحاديث النّبويّة هي في حدّ ذاتها نصوص قانونيّة مقدّسة بالنّسبة إلى المسلمين من حيث إنّها لا تمثّل أفكار الله بشكل مباشر كما يفعل القول القرآني، بل هي بالأحرى أفكار محمّد. ومع ذلك، كان محمّد هو المسلم المثالي وأفضل ترجمان لإرادة الله. ولذلك، فإنّ أقواله محفوظة في شكل أحاديث ويُحتجّ بها بالتّساوي مع القرآن لتحديد واجبات المسلم في إيمانه وكيفيّة تصرّفه. يزعم كلّ من القرآن والحديث إعادة نَسْخٍ لما جاء على لسان محمّد، ومع ذلك لا يوجد خلط بينهما. هناك فرق عميق بين الأسلوب «السّامي والرّفيع» للقرآن والنّثر العادي واليومي للحديث. حتّى سور القرآن المدنيّة، والتي تمّ تأليفها بنمط لغويّ أقلّ شعريّة من السّور المكّيّة التي سبقتها، فإنّها تمثّل عالماً مختلفاً في النّبرة والأسلوب من فنون التّعليم العادي والرّواية الركيكة للأحاديث النّبويّة.
[1] - ترجمة مقتطفة من كتاب عيسى ومحمد توازي المسارات، توازي السِّيَر، فرانسيس إدوارد بترز، ترجمة علي بن رجب، صدر عن دار مؤمنون بلاحدود.