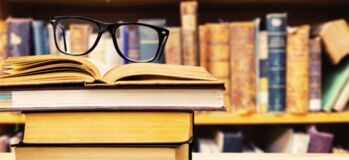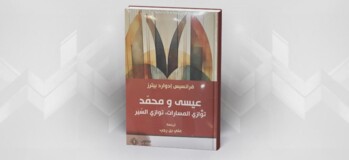محمّد في المدينة
فئة : ترجمات

محمّد في المدينة
في أوائل عشرينيات القرن السّادس الميلادي، بعد عشر سنوات من الدّعوة العلنيّة في مكّة، لم يكن المستقبل مشرقاً لرسالة الإسلام ولا لرسول الإسلام. ماتت خديجة زوجة محمّد، ومات حامي عشيرته أبو طالب، وأظهرت القبائل والقرى المحيطة التي عرض عليها محمّد نفسه القليل من الاهتمام برسالته، ولم يناصروه خشية معاداة قريش. جاء الخلاص، كما رأينا، بطريقة غير متوقّعة من مصدر مفاجئ تماماً. كان من بين أولئك الذين أتوا إلى مكّة للمشاركة في الأسواق التّجارية بعض الرّجال من المدينة، وهي واحة على بعد 275 ميلاً شمال شرق مكّة على أرض وعرة. لقد استمعوا إلى النّبيّ أكثر من مرّة وانبهروا به. لقد كانوا على استعداد «للاستسلام»، لكن كانت لديهم فكرة أخرى. كانت القبيلتان العربيتان الرّئيستان في الواحة والشّركاء اليهود المرتبطون بهما عالقين في حرب أهلية مدمّرة لأكثر من عقد من الزّمان. أدّى انعدام الثّقة والعنف إلى تحويل الواحة إلى معسكر مسلّح، وكانت كلّ عائلة موسّعة تعيش محصّنة بشدّة داخل مزارعها. كان يُعتقد أنّ محمّداً، بصفته رجلاً مقدّساً معترفاً به، يمكنه أن يضطلع بإحدى المهامّ التّقليدية لمثل هؤلاء العرب أصحاب الكاريزما، وأن يتوسّط في حلّ النّزاعات التي دمّرت واحة زراعية مزدهرة.
اتفاقيات المدينة [دستور المدينة]
وافق معظم سكّان الواحة على الاقتراح، وفي عام 622 أكمل محمّد وأتباعه المسلمون «الهجرة» التدريجية السرّية من مكّة إلى المدينة، وهو حدث اعتقد المسلمون لاحقاً أنّه من الأهمّية بمكان لدرجة أنّهم استخدموه تأريخاً لبدء العصر الإسلامي أو «الهجري» (6). انضمّ أيضاً بعض أتباعه الذين تمّ إرسالهم في وقت سابق إلى الحبشة المسيحيّة هرباً من بطش قريش إلى المجتمع في المدينة. وبروح المصالحة، أو اليأس، الذي شجّع الدّعوة إلى المدينة، تمّ وضع ما يمكن أن يسمّى «اتفاقيات المدينة» [دستور المدينة]. إنّها وثيقة متعدّدة الأجزاء -ربّما أضيفت بعض البنود لاحقاً- وقد شكّلت جميع سكّان المدينة -مسلمين ووثنيّين ويهود- في أمّة واحدة (7). اتّفقت جميع الأطراف على قبول إدارة محمّد نهائياً لشؤون الواحة.
كانت هناك مشاكل بالتّأكيد. كان لا بدّ من دمج أتباع محمّد المكّيّين، «المهاجرون» كما أطلق عليهم التّاريخ، ومن دعمهم داخل مجتمع الواحة الضّيّق، ويهود المدينة - لم يكن هناك فيما يبدو يهود في مكّة- الذين كانوا مصطفّين إلى جانبَي الصّراع العربي على الواحة، وكانت لديهم مخاوف بشأن هذا «النّبيّ» الجديد الذي أصبح الآن صاحب السّيادة عليهم، والذي كانت رسالته وممارساته التي واصل الجهر بها في القرآن الذي جاء به، تشبه رسالتهم وممارساتهم بشكل غريب.
قرآن المدينة
وفي تشبّثنا بالنّصوص المكتوبة، يجب أن نذكّر أنفسنا باستمرار أنّه عندما يتعلّق الأمر بالقرآن، لا يمكن أن يكون هناك سؤال عن «أصل». إنّ أصل القرآن هو التلاوة أو الأداء الذي اختار محمّد أن يحفظه أتباعه، والذي من المستبعد تماماً أن يكون قد نطق به للمرّة الأولى. وبالتّالي، فإنّ «الأصل» في قرآننا هو السّورة المكتملة التي حرّرها محمّد أو أيّ شخص آخر، والتي تمّ تثبيتها بعد ذلك عن طريق الذّاكرة الجماعية. في كلتا الحالتين، لم يكن هناك أيّ قلق للحفاظ على ما قد نعتقد أنّه الوحي الأصلي أي الكلمات الأولى (والوحيدة) التي تصدُر من فم النّبيّ حول موضوع معيّن. كما رأينا، فإنّ هذا المفهوم، على الرّغم من كونه حجر الزاوية للعقيدة من الناحية اللّاهوتية -القرآن هو كلمة الله الثّابتة التي لا تتغيّر- يتحدّى كلّ تقاليد الشّعر وأداءه الشّفوي. إنّ قرآننا، مثل الإلياذة، منتج ثابت جاء في أعقاب مسار معقّد وسلس.
أمّا إذا كان القرآن عبارة عن مجموعة من القصائد الشفويّة؛ أي القصائد المرتجلة، فهو ليس الإلياذة: فالقرآن بالنّسبة إلى مَن نطق به ومَن حفظه هو كلام الله. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الخطاب الذي يخرج من فم النّبي كان يردّد ويرتّل بعناية فائقة من قِبل المؤمنين في إطار ليتورجيّ كما سنرى، مع افتراض أنّه كان إشرافاً مباشراً من النّبيّ. ولكن مع التّحوّل في مسيرة محمّد المهنية في المدينة، أصبحت السّور أطول وتقرب أكثر إلى النّثر. ولأنّ هذه السّور قد فقدت الأدوات التي تحفّز سرعة الحفظ والتذكّر كالقافية والسّجع، فقد أصبح من الصّعب على الجميع حفظها وتكرارها بالدقّة المطلوبة. ومن ثمّ، فإنّ الأمر يدعو، بشكل ملحّ، إلى وجود نصّ مكتوب يكون أكثر ثباتاً واستقراراً. إذن، هل كان محمّد في المدينة يحرّر أو يُملي نصّاً لا يستطيع قراءته بنفسه؟ هل بدأ بعد ذلك إدخال أو ربّما إضافة السّور المكّية القصيرة إلى نهاية سور المدينة التي تمّ إملاؤها؟
لدينا من الدّراية بانتقال الأدب من المشافهة إلى الكتابة، حتى في العصر الحديث، ما يكفي لنفهم أنّه عندما يؤدّي شاعر أو قاصّ أيّ أداء شفويّ أو في حضور شخص يتعهّد بنقل هذا الأداء من المشافهة إلى الكتابة، فسوف تحدث تغييرات كبيرة، تغييرات نابعة من كلّ من إحساس المؤدّي (التّغيير السّريع والإيقاع والتَّروي والتّركيز) المرتبط بالرّغبة في التّأثير، ومن استعداد الكاتب «لتحسين» ما يسمعه. إذا كانت التّلاوات قد كُتبت بالفعل مثلما أدّاها محمّد، كما أخبرنا المأثور بذلك، وباختصار، حتّى مثلما كان «يتلوها»، فإنّ ذات الظّروف قد تحدث. وربّما حدثت بالفعل. ولنا مثال على ذلك في قصّة عبد الله بن أبي سرح، أحد كتبة الوحي الذي طلب منه النّبيّ «تحسين» نهاية آيتيْن، إحداهما في سورة النّساء آية: 148 والأخرى غير معلومة، بل تجرّأ أيضاً أن أنهى بعبارة من عنده آية كان النّبي يمليها عليه، وهي الآية 14 من سورة المؤمنون، والتي ورد أنّ محمّداً قد أكّد فعلاً تلك العبارة بقوله: «اكتبها فهكذا نزلت!».
لكنّ القرآن في حدّ ذاته يجعلنا ننظر إليه بشكل مختلف. نلاحظ تغيّراً ملحوظاً في السّور بعد أن تمّ ترتيبها ترتيباً زمنيّاً تقريبيّاً. إنّ السّور المدنيّة مختلفة تماماً عن السّور المكّية. فالعاطفة الجيّاشة والصّور الوجدانيّة الوافرة والقوافي والإيقاعات القويّة للشّعر المكّي، كلّها اتّخذت في المدينة، علاوة على الطّول، شكلاً أكثر تعليميّة ونثريّة. يختفي الأسلوب الشّعري الرّفيع للسّور المكّيّة بقوافيها وسجعها. لقد أفسح خطاب الحماسة الشّديد للقصائد الأولى -يمكننا أن نسمّيها أغاني، كما رأينا- الطّريق لخطاب أقلّ حماساً ولنبرة عاطفية ضعيفة.
تدوين القرآن؟
يُفسَّر التّغيير من خلال دعوة النّبيّ في المدينة جمهوراً جديداً من المؤمنين الذين كانوا بحاجة إلى المزيد من التّوجيه والتّرغيب الأكثر تداولاً في العقيدة الجديدة بدلاً من التّحذير الملحّ للتّخلّي عن عبادة الأصنام والدّعوة إلى عبادة الله وحده. إنّ تغيير الجمهور، وبالتّالي المقاصد، من مكّة إلى المدينة أمر هامّ ومؤكّد، لكن ألا يمكن كذلك التّفكير بأنّ محمّداً ربّما وجد كاتباً في المدينة؟ تُظهر سور المدينة بالفعل بعض علامات النّصّ المُمْلَى، في ظروف لم يعد باستطاعة النّبيّ أن يتلو فيها بالأسلوب الشّعري السّابق، ولكن كان عليه الآن أن يُمْلي بتأنٍّ وبوضوح كافٍ، حتّى يتسنّى لناسخ غير مؤهّل أن يتمكّن من ذلك ويدوّنه. إنّه الرّجل نفسه الذي يحمل الرّسالة نفسها -لم يكن هناك محمّدان- ولكنّ الذي كان «يتلو» سابقاً هناك، قد أصبح «يُملي» الآن.
إنّ هذا الاحتمال مبنيّ أساساً على معايير أسلوبية؛ وبشكل أكثر دقّة، هو بناء يهدف إلى تفسير تغيير ملحوظ في الأساليب ضمن نفس المجموعة، وهو مدعوم في جزء منه بالمأثور الإسلامي القائل إنّ أجزاء من القرآن قد دُوّنت في حياة النّبيّ، لكنّه لا يشير إلى أنّ هذا قد حدث في المدينة فقط. كما لا توجد أيّ إشارة إلى مثل هذا الإملاء في القرآن نفسه. إنّه تفسير معقول للتّغيير في الأسلوب -فدراسة الإسلام المبكّر تقوم على مثل هذه التصوّرات، سواء تعلّق الأمر بمسلمين في العصور الوسطى أو معاصرين غير مسلمين- لكنّ فرضيّة الإملاء مستبعدة الوقوع: استحالة وجود كاتب محترف بين مزارعي التّمور في المدينة.
قد يكون تصوّرنا لعمليّة النّسخ القرآني صحيحاً، وأنّ القرآن الحالي يعطي إشارات في تنوّعاته الأسلوبية لتحويل النّصّ الشفوي إلى نصّ مكتوب، ولكن تحديد الزّمان والمكان -المدينة في حياة النّبيّ- يكاد يكون خاطئاً تماماً. كلّ ما نعرفه عن ذلك الزّمان والمكان يجعل من المستبعد جداً أن يكون هناك في المدينة وفي حياة محمّد كاتب مؤهّل بما يكفي لتدوين السّور التي تمّ إملاؤها. إنّ إدراج السّور المكّيّة الشفوّية والمحفوظة في نصّ مكتوب للوحي اللّاحق، الذي تمّت تجزئته الآن، بشكل اصطناعيّ أو ميكانيكي، إلى سور مثل السّور السّابقة، يجب أن يكون ذاك الإدراج قد حدث لاحقاً، ربّما في عهد الخليفة عثمان حوالي 650، إذا أعطينا مصداقية لمأثور المسلمين حول هذا الموضوع.
سواء تمّ تدوين القرآن لأوّل مرّة في عهد عثمان أو في تاريخ لاحق، فإنّ كلا السّيناريوهيْن يستبعدان الإملاء المزعوم لسور محمّد المدنية؛ لقد قاموا بإزالة العملية من فم محمّد ووضعوها في أيدي الكتبة المحبّرة مثل soferim الكتبة الذين اشتغلوا على نصّ البيبل المكتوب في الهيكل الثّاني والقرون التّالية. وبناء على هذه الفرضية، فقد كان هؤلاء الكتبة اللّاحقون هم مَنْ قاموا بتأليف سور المدينة ممّا تذكّروه من محمّد في شيء يقارب أسلوب النّبيّ وإملاءه.
محمّد ويهود المدينة
يُشار أحياناً إلى يهود المدينة -على ما يبدو لم يكن هناك يهود يعيشون في مكّة- لبيان احتمال وجود كتبة هناك. وفقاً للمأثور الإسلامي، فقد كان ليهود المدينة «كتاب» -ينبغي أن نفكّر بأنّه الكتاب- الذي شهده محمّد (قرأه؟) واتّهم اليهود بتحريفه. ربّما حصُل مثل هذا النّقاش بالفعل، ولكن إذا كان كذلك، فإنّ الأمر يتعلّق بــــ «الكتاب»؛ أي الكتاب المقدّس، وليس الكتاب العبري الذي لم يستطع اليهود المحلّيّون ولا محمّد قراءته. وإذا كان هناك «أحبار» في المدينة، كما يقال أحياناً، فإنّ الاحتمال الطّبيعي هو أنّهم يعرفون القراءة والكتابة، لكن لا يوجد أيّ أثر معاصر لوجود مثل هؤلاء الأحبار في أيّ مكان خارج اليمن ولا أثر لأيّ شيء قد يكون قرأوه بالعبرية أو العربية. يسهل تصديق وجود كتاب يهوديّ حقيقيّ في المدينة بدلاً من الاعتقاد بوجود أيّ شخص كان يقرأ ذاك الكتاب هناك.
مع اقتناعه الصّادق الذي لا شكّ فيه بأنّه وقف في صفّ إبراهيم وموسى، قد يكون محمّد توقّع أنّ يهود المدينة وتوراتهم سيقبلون ادّعاءاته النّبوية عن طيب خاطر مثلما قبلوا مسؤوليّته السّياسية الجديدة. لم يفعلوا ذلك وكان رفضهم سريعاً. وعلى الرّغم من أنّ تفاصيل ما حدث بينهما لم تصلنا، إلّا أنّ القرآن يعكس بشكل لا لبس فيه ردّ فعل محمّد على رفض اليهود للإسلام (8). لقد تغيّرت بعض الممارسات الإسلاميّة: إذ لم يعد المسلمون يتّجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس كما فعل جميع اليهود، بل أصبحوا من الآن فصاعداً يتّجهون في صلواتهم نحو الكعبة العربية في مكّة (سورة البقرة: 142-150). علاوة على ذلك، فإنّ لهجة القرآن تزداد ازدراء بشكل ملحوظ في إشاراتها، إن لم تكن إلى «بني إسرائيل» القدامى الذين لا يزالون محلّ احترام وتقدير، فبالتّأكيد إلى «اليهود» المعاصرين المتّهمين بالتّضليل الدّيني، مثل تحريف الكتاب المقدس للكذب على محمّد، والأهمّ من ذلك، الخيانة السّياسية. كان محمّد مقتنعاً بأنّ يهود المدينة كانوا يتواصلون عبر قنوات سرّية مع أعدائه قريش في مكّة، ويتشاورون للإطاحة به وتدميره. فالتّهمة ليست مستحيلة ولا غير قابلة للتّصديق، وآثارها واضحة: إذ إنّ محمّداً، وعلى مدار العقد التّالي، قام بطرد القبائل اليهودية أوّلاً من ممتلكاتهم في المدينة، ما أدّى على المدى الطويل إلى حلّ مشكلة إفلاس المهاجرين (سورة الأحزاب: 26-27) ومن ثمَّ نفاهم وأخيراً دمّر مَنْ تبقّى هناك.
أثّر موقف محمّد تجاه يهود المدينة على سياسته ولكن ليس على عقيدته. استمرّ القرآن في الدّعوة إلى الإسلام بوصفه الخليفة والوارث الطّبيعيّ لكلّ من اليهوديّة والمسيحيّة. كان إبراهيم، الذي لم يكن من بني إسرائيل ولا يهوديّاً في نظر محمّد (سورة آل عمران آية: 67)، وموسى لا يزالان في أعلى مراتب الأنبياء، ولم ينقطع اليهود أبداً عن صفتهم، مثل المسيحيّين، «أهل الكتاب»، من كونهم أوّل المتلقّين لوحي حقيقيّ، وبالتّالي فهم جديرون بالحصول على معاملة خاصّة تحت السّيادة الإسلامية. أمّا المشركون، فقد كانوا مهدّدين بالموت أينما كانوا ما لم يعتنقوا الإسلام. ما كان على اليهود والمسيحيّين، إلّا أن يعلنوا عن ولائهم السّياسي؛ وعلى غرار ذلك، سُمح لهم بالاستمرار في معتقداتهم الدينية المحرّفة، كما ستسمّى من هنا فصاعداً، ولكنّها تبقى حقيقيّة بلا شكّ (التّوبة: آية 29، محمّد: آية 4).
بئر بدر
قبل أن يكون هناك ولاء سياسي، كان لا بدّ من أن يكون هناك غزو. وقد اتّخذت هذه الخطوة الخطيرة والجريئة بعد عاميْن من الهجرة -لم يسمح الله للمسلمين بحمل السّلاح ضدّ الظّلم والاضطهاد إلّا خلال الأيّام الأخيرة العسيرة في مكّة. ولم تكن بهدف الغزو، بل للانتقام وربّما من اليأس. في عام 624 قاد محمّد المهاجرين المكّيّين، الذين لم يكونوا جميعاً متحمّسين للمغامرة («كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ» سورة الأنفال، آية 5)، إلى نصب كمين لقافلة قريش العائدة في تجارة من الشّمال ووقع اللّقاء في نقطة ماء تسمّى بئر بدر (9). من الواضح أنّ الكمين كان عملاً جريئاً وعدائيّاً ضدّ قريش، ولكن ربّما كان الهدف منه أيضاً تحسين الوضع الاقتصادي الصّعب للمهاجرين في المدينة: إذ لا يستطيع أيّ إنسان في ذاك المجتمع المهمّش أن يستقبل ببساطة مائة أو نحو ذلك من الضّيوف المعوزين لإقامة غير محدودة. مهما كانت دوافعها، فقد كانت المغامرة نجاحاً غير متوقّع، رغم كلّ الصّعاب وتركت انطباعاً كبيراً لدى أهل المدينة الذين من المعتقد أنّ عيونهم كانت متّجهة إلى الغنائم (10).
كانت غزوة بدر نقطة التّحوّل في حياة النّبيّ الدرامية، كما أنّها غيّرت مصير الإسلام. لقد كسب محمّد، صاحب الدّعوة في مكّة، القليل من الأتباع وأثار عداوة شبه قاتلة هناك. أمّا محمّد المدينة، الذي لا يزال دائم التّفكير في مكّة وقريش، فقد بقي بصفة الرّجل الفقير صاحب أجندة نبوّية، رغم أنّه أصبح الحاكم الفعلي لمدينة الواحات. لكنّ غزوة بدر أنارت له سبيلاً جديداً. هل تأثّر أهل المدينة الوثنيّون بلاهوت بدر -من الواضح أنّ الله كان إلى جانب المسلمين، حسب زعم القرآن («وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» سورة آل عمران: آية 123، «إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ * وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَما النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» سورة الأنفال: 9-10)- أم تأثّروا بحجم الغنائم وسهولة الحصول عليها؟ وهل بدأت تباشير التّحوّل تلوح في الآفاق؟
ردّ فعل فاشل
أثارت غزوة بدر غضب قريش في مكّة. كان هناك هجومان انتقاميّان على المدينة، لكنّهما مُنيا بالفشل. كان الأوّل اعتداءً خطيراً على الواحة، حيث أُصِيب النّبيّ (سورة آل عمران: 102-179) (11). أمّا الهجوم الثّاني، فقد كان حصاراً غير ذي جدوى (سورة الأحزاب: 9-25) (12). لم يكن عرب الحضر معتادين على الحرب -كان الشّرف للبدو وحدهم في خوض المعارك- لكن يبدو أنّ قريشاً تخونها الإرادة عندما يتعلّق الأمر بمحمّد. وفي جميع الأحوال، لم تكن لديهم عزيمة محمّد الحديديّة، ولم يكن مفاجئاً أن أوقف محمّد والمسلمون معه في عام 630م موجة غزواتهم المتعاقبة للقبائل العربية، عندما قبلت مكّة الخضوع السّلمي (13). ولعلّ الأمر الأكثر إثارة للدّهشة هو أنّ النّبيّ أدار ظهره لمسقط رأسه وكعبته «بيت الله»، أحد أقدس الأماكن على وجه الأرض، وعاد إلى المدينة ليحكم من هناك بدلاً من مكّة، تماماً كما سيفعل خلفاؤه من بعده (14).
زوجات النّبيّ
لا القرآن، الذي غالباً ما تكون نظرته أكثر شموليّة، ولا حتّى السّيرة، التي تُعتبر «غزوات النّبيّ» مبدأ ترتيبها، يخبرنا عن المزيد من حياة محمّد الخاصّة أو الشّخصية. من ناحية أخرى، تفيض الأحاديث النّبوّية بالتّفاصيل الأكثر ظرفيّة: الذّكريات والأساطير والشّائعات، وقد يكون بعضها صحيحاً. أصبح كلّ ذلك أساساً لتشكيل أخلاقيّات المسلمين ونمط حياتهم على غرار سلوك محمّد نفسه. كان على السّيرة النّبويّة المتأخّرة، سواء تلك التي كُتبت في العصور الوسطى أو الحديثة، كتّابها مسلمون أو غير مسلمين، أن تعتمد بالضّرورة، وبدون تمحيص، كلّما تعلّق الأمر بحياة محمّد الخاصّة، على تلك المأثورات النّبوية التي سهُل على مؤلّفي السّيرة الكلاسيكيّين تجاهلها وحذفها أكثر من أولئك الذين جاؤوا بعدهم.
ومع ذلك، هناك لحظات مشوبة بالأزمات عندما نتعمّق في القرآن، ومعظم هذه اللّحظات تتعلّق بزوجات محمّد. لقد كان هؤلاء النسوة، بالطّبع، مادّة خصبة للجدل المسيحيّ: كان العدد الهائل منهنّ شاهداً واضحاً على بذخ محمّد الذي لا حدود له، كما كانت حقيقة الزواج في حدّ ذاتها بالنسبة إلى أولئك المسيحيّين الذين كانوا ممتنعين عن الزواج. قد يكون عددهنّ أزعج كذلك بعضاً من معاصري محمّد. لقد سمح القرآن للرّجل المسلم أن يتزوّج تحديداً أربع نسوة، وإن كان ذلك بشروط («وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامَى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلّا تَعُولُوا»، سورة النّساء: آية 3) (15). لكن كان لمحمّد بالتّأكيد أكثر من أربع زوجات، وهذا الأمر قد أزعج بعض أهل المدينة منذ أن أصبح وحياً: وإن وافقت السّيّدات هوى النّبي، فقد يكون له ما يشاء من الزّوجات، («وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ»، سورة الأحزاب: آية 50) (16).
كان هناك حدثان محدّدان سبّبا إحراجاً كبيراً للنّبيّ؛ تمثّل الأوّل في زواجه المخطّط له في المدينة من زينب، زوجة زيد، وهو عبد أعتقه محمّد ثم تبنّاه. ونظراً إلى أنّ التبنّي كان ينبغي أن يخلق رابطة دم، فإنّ زواج محمّد من زينب، بعد أن طلّقها زيد، كان انتهاكاً لحرمة هذه القرابة. لقد كان الطّلاق البائن والزّواج ثانية عملاً غير مقبول على جميع الأصعدة، وحتّى يستقيم الأمر حاولت الرّوايات اللّاحقة تبرير ذلك بعدم ملاءمة زيد وزينب بعضهما بعضاً. وفي النّهاية تدخّل الوحي لإنهاء المسألة. طلب القرآن من أهل المدينة أن يهتمّوا بشؤونهم الخاصّة، ومن محمّد أن يحتفظ بزينب («وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ ما اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمّا قَضَى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً»، سورة الأحزاب، آية: 36-37)، ثم شرع القرآن بعد ذلك مباشرة في إلغاء محرّمات الزّواج من زوجات الأبناء بالتبنّي.
أمّا الحدث الثّاني، فيتعلّق بعائشة زوجة محمّد، ابنة أبي بكر، وهو مِن أوائل مَن أسلموا وكانت لهم مكانة خاصّة. كانت عائشة مخطوبة في مكّة، وهي في السّادسة من عمرها وتمّ زواجها في المدينة عندما بلغت التّاسعة. يشعر النّقّاد المعاصرون هنا بالانزعاج من عمر الفتاة أكثر من أسلافهم في العصور الوسطى وأكثر بكثير من الرّواة المسلمين، الذين لم ينزعجوا على الإطلاق. في العديد من المجتمعات، يمكن عقد الزّواج -وعلى هذا النّحو كانت العقود- في أيّ وقت من قِبل الأطراف الرّئيسة، ويتمّ التّحدّث عن أزواج المستقبل من أيّ من الجنسيْن في وقت مبكّر جدّاً، وأحياناً، وهم لا يزالون في الأرحام. وفي العديد من المجتمعات أيضاً، يكون سنّ البلوغ الفعليّ هو سنّ الموافقة على الزواج. نفترض أنّ عائشة قد أصبحت بالغاً في سنّ التّاسعة، فهذا أمر غير عادي إطلاقاً، والأمر ذاته ينسحب على مريم والدة عيسى -التّي تمّت خطبتها، وهي في سنّ العاشرة؟- ربّما كانت في الثّانية عشرة من عمرها، عندما أُعْلِن عن حَمْلها.
إنّ مسألة عائشة المُعلق عليها في القرآن -اسمها ليس مذكوراً كذلك- ليس لها علاقة بعمرها الذي لا يأتي إلا بفضيحة انتشرت بين المؤمنين ووبّخهم القرآن عنها مطولاً (24: 11-20) دون الخوض في التفاصيل. يتمّ توفير التفاصيل من خلال مأثور السيرة، كما ذكرت عائشة نفسها (17). تمّ الاستيلاء على عائشة في إحدى غارات النبي. عند العودة، انفصلت عن طريق الخطأ عن المجموعة الرئيسة، واكتشفها أحد الجنود الآخرين الذي رافقها إلى المدينة المنورة. عندما وصلا متأخّريْن معاً بدأ القيل والقال. عندما سُئلت عائشة، أقسمت للنبي أنّه لم يحدث شيء غير مرغوب فيه، لكنّ المسألة لم تنته إلّا بعد أن تمّت تبرئتها في القرآن (آية 11 من سورة النور). وفي التذييل، شدّد القرآن من قواعد إعطاء الدليل.
تأسيس الإسلام
منذ غزوة بدر حتى وفاته عام 632، عمل محمّد على تنفيذ مشروعيْن رئيسيْن؛ أوّلهما إرساء الثقافة الدينية للإسلام من خلال الوحي القرآني وتعاليمه وتوجيهاته الشّخصية، وثانيهما بناء وتوطيد مجتمع المسلمين، ورسم ثقافة سياسيّة. نجد هذيْن المشروعيْن منفصليْن نسبيًّا في مصادرنا. إنّ سور القرآن المدنيّة مكرّسة بالكامل للمشروع الأوّل؛ فلا تجد فيها إلّا صدى خافتاً لأهوال الحرب وضغوط المغامرات العسكريّة للمسلمين. بالنّسبة إلى المشروع الثّاني، علينا أن نلجأ إلى المصادر الأدبية اللّاحقة، سيرة النّبيّ المتداولة والنّوع الأدبي الذي يتغنّى بما يُسمّى «الغزوات». قد نهتمّ بأمور أخرى، لكن بالنّسبة إلى المؤرّخين المسلمين، فإنّ هذه «الغزوات» كانت في واقع الأمر الموضوع الرّئيس لسيرة محمّد في المدينة.
لقد بدأت عبادات الإسلام تُمارس علناً في المدينة بالتّأكيد: إنّ الصّلاة التي كانت سرّيّة في غالب الأحيان في مكّة أصبحت الآن الصّلاة المفروضة يوميّاً، بما في ذلك صلاة الظّهر يوم الجمعة، عندما يحتشد المجتمع بأكمله في فناء محمّد -النّموذج الأوّلي للمسجد لاحقاً- لسماع تعاليمه ووعظه (18)، مثل الزّكاة لمساعدة المحتاجين (9 :29)، والصّيام خلال الشّهر القمري رمضان (2: 185)، ولاحقا، الحجّ أو طقوس الحجّ إلى الأماكن المقدّسة في مكّة وما حولها، تلك الطّقوس التي أدّاها محمد كمسلم مرّة واحدة قبل وفاته مباشرة (2: 196-199، 22: 27-32). كانت طقوساً قائمة منذ مدّة طويلة في مكّة قبل الإسلام، ثمّ واصل المسلمون ممارستها (19). في غضون ذلك، استمرّ القرآن في الإجابة عن الأسئلة وإزالة الرّيبة وحلّ النّزاعات بحسم شديد.
الخضوع والاستسلام
كان المسلمون في المدينة «مجتمع قتال» -عبارة استخدمت لوصف مسيحييّ إسبانيا خلال فترة الاسترداد Reconquista-. على مدى الثّماني سنوات من حياة محمّد بعد غزوة بدر، كانت الغزوات غير المبرّرة شبه مستمرّة. وتكاد تكون ناجحة دائماً. طُلِب من مناطق الحضر المجاورة الخضوع والاستسلام. وبالنّسبة إلى المشركين، فقد كان الخضوع دينياً وسياسيّاً على حدّ سواء: كان عليهم إمّا أن يقبلوا بسيادة الإسلام والمسلمين الذين يواجهونهم، أو أن يُدمَّروا. وبمجرّد دخولهم إلى الإسلام وأصبحوا بالتّالي مسلمين، فعليهم دفع الزّكاة إلى بيت مال المسلمين في المدينة. أمّا إذا كانوا يهوداً أو مسيحيّين فعليهم، كما سبق أن أشرنا، ألّا يقبلوا إلا بالسّيادة السّياسية الإسلامية، وبالطّبع مع دفع الجزية.
إمبراطورية إسلامية Imperium Islamicum
في مثل هذه الظروف، نادراً ما سمعنا عن زراعة النّخيل في المدينة، ومن الواضح أنّه لم يكن هناك وقت كاف لذلك. أصبحت الواحة مدينة إمبراطورية، وإذا كانت الإمبراطورية الإسلامية لا تزال، خلال حياة محمّد، محصورة في شبه الجزيرة العربية والمناطق الجنوبية لما يعرف اليوم بالأردن، فإنّها سرعان ما تجاوزت تلك الحدود بشكل مذهل. وسواء قصد النّبيّ ذلك أم لا، ويبدو أنّه لم يقصد ذلك، فإنّه لم يبْنِ فقط مجرّد كنيسة (مستخدمين مصطلحات أكثر حداثة) ولكن بنى أيضاً دولة، وترأّس كلّاً منهما دون منافسة من مُدّعٍ أو كاهن. لقد كان على المسيحيّين الأحرار تزوير وثيقة لتمرير السلطة الدنيوية من يد الإمبراطور إلى أيدي البابا، لكنّ المسلمين لم يكونوا بحاجة إلى مثل ذلك. ففي هذا السّياق، كان محمّد هو قسطنطين وهو سيلفستر، وهو إمبراطور وبابا لم يكن بحاجة إلى سيْفيْن، ولكن فقط إلى السّيف ذي الحدّيْن الذي صنعه بنفسه.
وفاة محمّد
توفّي محمّد عام 632، ووفقاً لرواية زوجته عائشة، فقد كان موته في المدينة في بيتها وفي حضنها (20). كان في أوج قوّته الرّوحية والسّياسية، وعلى الرّغم من أنّه قد بلغ من العمر اثنيْن وستّين عاماً وفقاً للتّسلسل الزّمني التّقليدي، إلّا أنّه قد يكون أصغر من ذلك بقليل. أصابه مرض غير محدّد مات على إثره بعد أسبوعيْن. لذا، فإنّ موته، رغم أنّه غير متوقّع، لم يكن مفاجئاً، تمّ دفنه في حرمه الخاصّ بالمدينة.