مفهوم الإنسان بين الميتافيزيقي والسياسي من خلال (نظرية الإنسان عند الفارابي)
فئة : قراءات في كتب
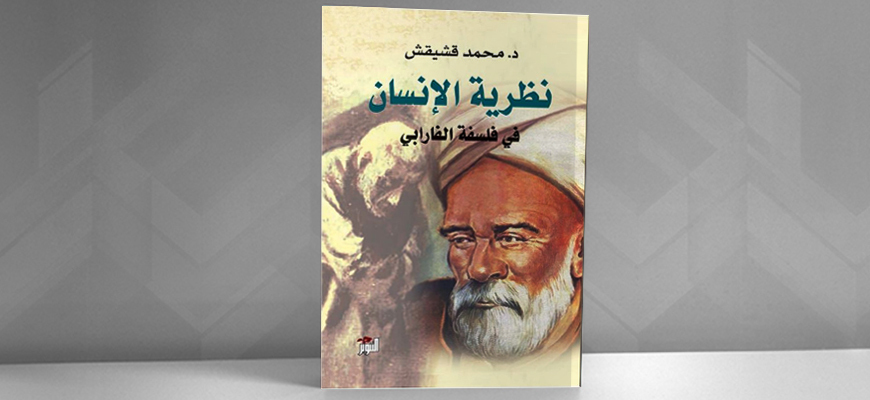
مفهوم الإنسان بين الميتافيزيقي والسياسي
من خلال (نظرية الإنسان عند الفارابي)([1])
1- مقدمة:
يعالج كتاب (نظرية الإنسان عند الفارابي)، لصاحبه قشيقش محمد (دار النشر: التنوير، سنة 2011م، عدد صفحاته 512)، موضوعاً مركزياً يتعلّق بالإنسان، من حيث هو كائن ميتافيزيقيّ من جهة، وسياسي أو مدني من جهة ثانية. وتتحدّد قوّة هذا الموضوع من خلال امتدادِه في مجالات متعدّدة، وارتباطه بحقلٍ مفاهيميّ متعدّد الأطراف. فهو ذو صلة بالملّة والفلسفة، وبالسياسي والأخلاقي، وبالذاتي والعرضي. لكن الأمر، على الرغم من هذا التنوّع الموضوعاتي، يتعلق، في هذا الكتاب، بـ (الوجود الإنساني) ومحدداته، أو مبادئ هذا الوجود؛ فما مسالك بناء هذا الوجود؟ وما الوضعيّات المحدّدة له؟ فإذا كان الإنسان متميزاً بمرتبته عن باقي الموجودات الأخرى، فهل هذا ما يحرّك وجوده من أجل تحقيق إنسانيّته، ومن ثمّ سعادته؟ وهل تحقيق إنسانيّة هذا الكائن تستدعي وجود مجتمع فاضل، لا فاسد، وأخلاق فاضلة في التدبير السياسي والمجتمعي...؟
2- الإنسان قضيةً ميتافيزيقيةً:
إنّ أول استفهام يُثار: بأيّ معنى يمكن أن نتكلّم عن (نظرية الإنسان في فلسفة الفارابي)؟ فعلى المستوى الإبستمولوجي، يُعدّ مفهوم النظرية ذا دلالة خاصّة، فهو ملتصقٌ أكثر بالمجال العلمي كبناء مفاهيميّ للموضوع المدروس. إلا أنّ لصاحب الكتاب مبـرراتٍ منهجية في اعـتماده أرضيّة أو منطلقاً في التحـليل ممثّلاً في البيولوجيا والسيكولوجيا، في مقابل الميتافيزيقا. وغرضه من ذلك إمكانية البحث عن طريـق للإلمام بمضامين فلسفـة (المعلم الثاني) حول الإنسان، دون السقوط في التجزيء والاختزال. وفي هذا السياق، ينتقد الدراسات التي اهتمّـت بهذا المـوضوع، لكونها اقتصرت على مكـونات جـزئية لهذا الكـائـن: إمّا على الجانب الأخلاقي، أو السياسي، أو قوى الـنفـس؛ أي أنها لم تعالج قضايا السياسة، والأخلاق، والمجتمع، في ارتبـاطها وتداخلها؛ بـل في انعزال بعضها عن بعض. والموجه للقراءات التجزيئية، القابلة للنقد والتجاوز، كون الفارابي لم يحدِّد مبحثاً خاصّاً بالإنسان. يقول صاحب الكتاب: «لم يفرد قولاً مفرداً مستقلاً وشاملاً للإنسان في نصّ مستقلّ، كما فعل ذلك في موضوع المنطق، وموضوع تصنيف العلوم. فالإنسان حاضر بصفته موضوع فلسفته وغايتها، وغائب في آن واحد»[2].
لمفهوم الإنسان، حسب النص السابق، وضعية قلقة، فهو حاضر وغائب في الوقت ذاته؛ فهو حاضر كموضوع للتفكير والنظر، وغائب لكون هذا الموضوع لم يحتلّ إطاراً خاصّاً به، ومن ثمّ قولاً نظرياً متكاملاً؛ لأن حضوره مُجزّأ وممتدّ ما بين محاور التفكير الفلسفي من معرفة، وقيم، ووجود، فما المسلك الممكن لبناء نظرية محدّدة حول الإنسان؟ أهذا المسلك حاضر في متن المعلم الثاني، أم أنّه من صناعة الكاتب؟
يبدو أنّ متن المعلم الثاني ذو توجهات متعدّدة، فهو قولٌ يتناول قضايا ذات ارتباط بتاريخ الفلسفة من جهة، والقول الديني من جهة ثانية. وهذا ما يحدّده صاحب الكتاب بالأرضية المزدوجة لفكر الفارابي، والمتمثّلة في القولين الفلسفي والديني. وقد يمكن اعتبار هذا الوضع المزدوج ممتدّاً في ثنايا الفكر الفلسفي الإسلامي عامّة، والُمعبّر عنه بإشكالية العلاقة بين الدين والفلسفة؛ لأن فعل التفلسف الوسطوي يستدعي من صاحبه الانخراط في قضايا الدين والعقيدة، ومن هنا، يُثار سؤال عام: هل هذا الانخراط هو ما وجّه الفكر الفلسفي الإسلامي إلى تغليب القضايا السياسية على العلمية؟ هذا السؤال العام يرتبط، في سياق مبحث الإنسان، بموضوعي الغاية والوجود؛ ما الغاية القصوى من الوجود الإنساني؟ وما سبيل الإنسان لبلوغ هذه الغاية؟
للإحاطة بمبحث الإنسان، عمل الكاتب على بيان المنطق الناظم الذي يجمع مباحث الفارابي حول هذا الموضوع، وتطلّب هذا تقديماً، ونقداً لمناهج الدارسين في تناولهم إشكالية الإنسان في فكر المعلم الثاني. وذلك بالانطلاق من الأطروحة التالية، والمحدّدة في تصنيف الإنسان، من حيث هو موضوع سياسي، أو من حيث هو موضوع أخلاقي.
أولاً: هناك أطروحة محسن مهدي القائلة: إنّ آراء الفارابي حول الإنسان مُتضمَّنة في فلسفته السياسية، واستدعت العلم النظري (السيكولوجيا والبيولوجيا) لإثباث نتائجها؛ «ولهذا صارت الفلسفة النظرية تابعة للعملية، ولاحقة لها، وليست مؤسّسة لها»[3].
ثانياً: أطروحة ليوشتراوس: وتتمثّل في كون فلسفة الفارابي في الإنسان مؤسّسة على الوحي في علاقته بفلسفة أفلاطون، والجمع بينهما، مجسّداً فلسفة سياسية موضوعها الإنسان. وهي، في عمقها، تعديل لفلسفة أفلاطون.
ثالثاً: أطروحة (روزنتال)، التي ترى أنّ فلسفة الفارابي في الإنسان تركيبٌ لفلسفات أفلاطون، وأرسطو، وأفلوطين، والملّة، وهي فلسفة مرتبطة بالميتافيزيقا والفيزياء.
والأطروحة التي يدافع عنها الباحث، وهي المحدّدة في النص الآتي: «نظرية الفارابي في الإنسان هي التي عرضها ليسفي فلسفته السياسية فحسب؛ بل في فلسفته العملية، بشقيها السياسية والأخلاقية، وفي فلسفته النظرية (وأساساً، العلم الإلهي، والسيكولوجيا، والبيولوجيا)، فلسفة هي، في مجملها، حاصل التوفيق بين الفلسفة والدين، كما أنّ فلسفة الفارابي العملية قد تأسست على مبادئ ونتائج الفلسفة النظرية (الفيزياء والعلم الإلهي). من هذا الأساس استمدّت قيمتها وحدودها. وهي الفلسفة التي شيّدها من خلال عمل تركيبي إبداعي كان ينتصر فيه كلّ مرّة لحلٍّ أو منحى من النظر الذي يلائم قصده في الموضوع المحدد الذي ينظر فيه؛ لذلك لم يكن في مواقفه في الموضوع المحدّد، أو ذاك، تابعاً لأفلاطون، ولا لأرسطو، ولا لأفلوطين، تبعية مطلقة؛ بل كان قارئاً حذراً، ومؤولاً لآراء الفلاسفة، بحسب الحاجة، والغاية التي كان يرومها، فكان بفعله هذا في المتن أشبه بفعل الحائك أو النساج في النسيج»[4].
يعمل الكاتب على تناول متن الفارابي، من خلال نظرة كلية مجملة، أو من منظور نسقي، فهو لا يتّخذ من الموقف الاختزالي منهجه، سواء أكان في المباحث العلمية، أم النظرية، مؤكّداً، في الوقت ذاته، أن أساس فلسفة الإنسان عند الفارابي هو النسق النظري الميتافيزيقي، وأنّ العملي مؤسّس على نتائج المبـاحث النظـرية؛ أي على نتـائج الفيـزياء، والبيـولوجيـا، والعلم الإلـهي. لـهذا أتى الخطاب السياسي الأخلاقي -العملي متبلوراً وموجهاً بما تمّ التوصل إليه في المباحث النظرية. هذا البناء المعرفي لمفهوم الإنسان بين النظري والعملي فرض على الباحث منهجاً محدّداً ذا طابع تحليلي-تركيبي، ومقارن، ونقدي؛ لأن هذا القول الخاص بالإنسان، عند الفارابي، ذو امتدادات يونانية واجتماعية، ومن ثمّ دينية.
3- مضامين الكتاب:
يتحدّد مضمون الكتاب من خلال بعدين: الموضوع والغاية. وهذا ما شكّل أرضية لترتيب وتنظيم محاور الكتاب؛ لأن نظرية الفارابي في الإنسان متميّزة بالنسقية والشمولية... وجاء المُؤلَّف متبلوراً، من خلال المحاور الآتية:
الباب الأوّل: يتكوّن من أبعاد الإنسان الإلهيّة، والسيكولوجية، والبيولوجية، كمكونات أساسية للعلم النظري، وأساس العلم المدني (الأخلاق والسياسة)؛ ولهذا، الإنسان، في الباب الأوّل، هو موضوع العلم النظري. إلا أنه ليس هناك فصل بين العلم النظري والعملي؛ بل تداخل بينهما.
ويستنتج صاحب الكتاب من هذا تعريفاً محدداً للإنسان، كونه ذا طبيعةٍ مشتركة ومعقدة، فهو: «ذو أبعاد مختلفة متداخلة (منها البيولوجي، والاجتماعي، والأخلاقي، السياسي الاقتصادي والمعرفي»[5].
فما مبرّر الحديث عن الإنسان، بدءاً من القول الميتافيزيقي إلى المدني-السياسي؟ وما وضعية الإنسان ضمن هذا التداخل بين المعرفي؟
إنّ مبرّر القول بالتأسيس الميتافيزيقي، مع الفارابي، هو البدء بالفحص في مبادئ الموجودات مدخلاً لتناول سياسة المدينة، أو الاجتماعات المدنية، وهو انتقال من موضوعات العلم الإلهي إلى موضوعات العلم المدني. أما المبرّر الثاني لهذا، والمتعلّق بإشكاليّة الموضوع، فهو واحد بالنسبة إلى العلمين الإلهي-النظري والمدني-العملي، ومن ثمّ فهو حاضر في جميع العلوم، بما هو مبدؤها، والغاية منها.
و في هذا الباب، يبرز الكاتب مسألة أساسية ما زالت مصدر إشكال متعلّقة بمنزلة القول السياسي في متن المعلم الثاني. مؤكّداً أنّ الفارابي اتبع منهجاً محدداً هو التناول السياسي لقضايا ميتافيزيقية، والباعث إلى هذا المنهج، في نظر محمد قشيقش، الدرس السقراطي-الأفلاطوني، الذي يعكس مكانة العامّة والخاصة في المجتمع، وعلاقة الفعل الفلسفي بهذين النمطين من الوعي؛ فإذا كان تصوّر أفلاطون يدعو إلى أرستقراطية التفلسف؛ فإنّ سقراط كان يعمل على جعل فعل التفلسف متداولاً في الشارع. واستراتيجيّة الفارابي الداعية إلى التشريع لممارسة التفلسف كانت في مواجهة مع خصوصية معيّنة ممثّلة في حضور الخطاب الديني في المجتمع العربي الإسلامي. ولهذا، الدعوة إلى التفلسف استدعت انفتاحاً على العامّة، وذلك من خلال إعادة ترتيب العلاقة بين الملّة والفلسفة؛ لأنّ القول الديني موجّه إلى العامة والخاصة؛ لهذا جاء حديث الفارابي عن الإنسان يتضمّن جدل السياسي والميتافيزيقي، وأساس هذا هو جدل العلاقة بين العلمين الإلهي والمدني. والتحديد النظري لموضوعات العلم الإلهي هو مقدّمة للنظر في موضوعات العلم المدني.
وهذا التمفصل بين الميتافيزيقي والمدني، في جانبه الأوّل، تحديد للمطالب الإنسانية، أو الغاية من الوجود الإنساني عامّةً، وفي جانبه المدني تحديد للطريق الذي من خلاله يمكن بلوغ الغاية القصوى من هذا الوجود؛ فهل الكتاب إجابة عن هذين البعدين أو الإشكالين؟ وما الغاية من الوجود الإنساني؟ وما الطريق لتحديد هذه الغاية؟ فهل هذه الإشكالات هي ما حرّك فكر الفارابي إلى الانفتاح على أهم قضية أساسية، وهي البعد الأخلاقي، ومن ثمّ مبحث السعادة؟ فهل تحقيق هذه الغاية (السعادة) من الوجود الإنساني يتطلّب إعادة ترتيب رابطة الفرد بالمجتمع، وبذاته؟
إنّ هذه الاستفهامات، عمل صاحب الكتاب على تناولها من خلال البابين الثاني والثالث.
الباب الثاني: في هذا الباب، تمّ التركيز على مبحث أساسيّ في فكر المعلم الثاني، وهو مبحث الأخلاق، الذي تناول، في فصوله الستة، عرضاً وتحليلاً للغاية من الوجود الإنساني (الفرد)، بما هو خير. إضافة إلى الوضعيّات التي تكون بها السعادة ممكنةً، والمحدّدة في الفضائل الأربع: (الخلقيّة، والنظرية، والفكرية، والصنائع العلمية وممارستها)؛ لأنّ الغاية من الوجود الإنساني هي العلم والمعرفة بهذه الوضعيات المؤدية والموصلة إلى السعادة؛ ومن هنا، يُثار الإشكال الآتي: هل مبدأ سعادة الإنسان محايث له أم مفارق؟ وما مكانة العقل الفعال، أَيعمل على إرساء مبدأ المحايثة، أم يعمل على تقويضه وإبعاده لصالح المفارقة؟
الباب الثالث: وهو محدّد، في فصوله الأربعة، في بعدين أساسيين: السياسي والاجتماعي في الإنسان. وهذا، ضمنياً، تناولٌ للغاية من الوجود الإنساني، باعتباره خيراً جماعياً وليس فردياً. والمكوّن الجماعي، أو الاجتماعي، هو تناول للعلاقة بين الأخلاق والسياسة، من خلال النظر في أجناس الاجتماعات المدنية وأنواعها، وترتيبها، وأفضلها. وهذا ما يشكّل أساس تصنيف المدن المضادة للمدينة الفاضلة؛ فالأولى مدن مريضة فَقَدَ فيها الإنسان إنسانيته، والثانية-الفاضلة هي فضاءات لتحقيق إنسانية الإنسان، وطبيعة هذا المرض السائد في المدن المضادة للمدينة الفاضلةهو مرض في الفكر، وهو ما استدعى تغييراً في الآراء والمعارف، بإعادة النظر فيما هو سائد منها، وتصويبه نحو الأفضل والأحسن.
إنّ مبحث الإنسان في عمقه بحث في قيمة الفلسفة السياسية والأخلاقية، إلا أنّ منزلة الإنسان ومكانته أُثيرت في سياق وجودي: هل مكانته ذات دلالة مفارقة أو محايثة. وتحدّدت هذه المنزلة من خلال مستويين؛ الأول فحص مبادئ الموجودات للوقوف على الجهات التي كانت بها علل الموجودات، بما فيها الإنسان؛ لبيان الغاية من وجودها. أمّا المستوى الثاني، فهو الوقوف على مرتبة الإنسان في الوجود، ونتج عن هذا تحديدٌ للإنسان من خلال صورتين:
- صورته في موضوعات العلم الإلهي.
- صورته في موضوعات العلم المدني.
وأهم هذه المبادئ المحدّدة للإنسان العقل الفعال الداعي إلى كمال الإنسان، وهو مكمّل لعمل الأجسام السماوية، ومكمّل لعمل النفس؛ ولهذا الإنسان جسم مكوّن من مادة وصورة؛ أي من جانب مفارق، وآخر محايث.
وما ينبغي تأكيده أنّ الطبيعة الإنسانية تتحدّد من خلال فحص موضوعات العلم الإلهي، وموضوعات العلم المدني. ونتج عن هذا أنّ مكانة الإنسان متميّزة عن باقي الكائنات الأخرى، من خلال حضور الإرادة والاختيار، وبهذين الفعلين يمكن للإنسان أن يجمع بين الممارسة الأخلاقية والسياسية. إلا أنّ هذا مشروط بالاستعدادات الذهنية والبدنية. يقول الأستاذ محمد قشيقش: «من خلال النظر في هذه الموضوعات، تحدّدت رتبة الإنسان في الوجود، فكان من بين الأجناس الستة المكوّنة للعالم: الجسم السماوي، والحيوان الناطق، والحيوان غير الناطق، والنبات، والجسم المعدني، والأسطقسات الأربع، والجملة المجتمعة من هذه الأجناس الستة هي العالم»[6].
إن البحث عن مكانة الإنسان في الوجود يُثير استفهاماً أساسياً حول مرتبة الإنسان بين المفارقة والمحايثة، ومن ثمّ مكانة العالم: هل بالمرتبة المتميزة للإنسان عن باقي الكائنات يتحدّد العالم؟ وهل لهذه المكانة الوجودية للإنسان يُعطى معنى للعالم، ويتحدّد وجوده؟
فإذا كان الإنسان يتحدّد من خلال مكوّنه الإلهي والمدني (المفارقة والمحايثة)، فإنّ العالم، أيضاً، مكوّن من أجسام سماوية، وغير سماوية، وأعلاها الإنسان بحمولته الجامعة بين ما هو فيزيائي –طبيعي وآخر روحي-إلهي، إلا أنه أسمى بقوّته الناطقة؛ أي سيكولوجيته.
لذا، الإنسان حامل لتشكّلين أو بعدين؛ النقص والكمال. والأفق الفلسفي للفارابي ينتصر لفكرة التعقُّل طريقاً للكمال والاستكمال، ومسلكاً لتجاوز النقص. والغرض من ذلك الوصول إلى مرتبة العقل الفعال؛ حيث إمكانية تحقّق السعادة الكاملة: فهل إنسانية الإنسان مشروطة بحدٍّ معيّن؟ وهل هذا التحقُّق هو تماهٍ بالموجودات المفارقة من أجل البناء المستمر للقوّة الناطقة؟
إنّ انتصار الفارابي لإنسانيّة الإنسان انتصارٌ للقوة الناطقة، ولفعل التعقُّل. لكن هذا ليس انتصاراً للبعد الميتافيزيقي للإنسان (المفارقة)، وإبعاداً للمحايثة أو للجسماني؛ بل إعلاء من شأنهما عبر الأفعال الفكرية. يلخّص صاحب الكتاب هذا الأفق الفكري للفارابي قائلاً: "يسمو الإنسان بالقوة الناطقة، عندما تصير عقلاً، بالفعل، إلى أشرف، وأكمل، وأفضل، رتبة، دون طمس طبيعته الخاصّة. بهذا انتصر الفارابي للتصوّر الأرسطي، وتوارى، بذلك الموقف الصوفي والأفلوطيني، الذي قد يُوحي به ظاهر الموقف الأوّل، فبفعل عقله يصير إلى أقرب رتبة من العقل الفعّال، ويصير عقلاً بذاته، ومعقولاً بذاته، بعد أن لم يكن كذلك، ويصير إلهياً بعد أن كان هيولانياً؛ لهذا كانت الإنسانية فيه بالقوّة مضمرة في قوّته الناطقة، والعقل الفعال يصيرها فيه بالفعل"[7].
إنّ الانتصار للقوّة الناطقة، في بناء الوجود الإنساني، هو ما يمنح مكانة وسلطة لهذا الوجود بيولوجياً وأنطولوجياً. ويتجسّد هذا من خلال مرتبة الإنسان الجامعة ما بين الوجه الروحي والجسماني.
وبهذا البناء الفكري المؤسَّس على فعل التعقُّل، يتحقّق ما يسمّيه الكاتب إنسانيّة الإنسان؛ فكيف يمكن أن ننتقل من الحديث عن الوجود الإنساني، كقضيّة ميتافيزيقيّة محدّدة في ما هو عقلي-صوري، إلى فعلٍ وجودي أكثر قوّة، ممثّل في إنسانية الإنسان؟ فهل هذا يضعنا أمام نزعة إنسانية تعطي العالم معنى ودلالة مشروطة بهذا الوجود الإنساني، وتجعل من هذا الأخير أصلاً ضامناً للعالم ووجوده؟
فما يؤكّده الفارابي أنّ مرتبةَ الإنسان الممتدّة ما بين المادي والروحي هي بفعل التعقل المؤدي إلى الاتصال بالعقل الفعّال، ومقاصد هذا التعقل ذات أهمية وجودية، فبها تتحقّق وتتجسّد إنسانية هذا الكائن العاقل، أو يتمّ إخراجها من وجودها الخفي إلى الظاهر، عبر التعقُّل المستمرّ للعقل بذاته وغيره، وصولاً إلى الاتصال بالعقل الفعّال.
ينتج عن هذا فكرة أساسية محدّدة لماهيّة فلسفة الفارابي، وممثلة في النفوذ النظري على العملي، لكن مكانة القول السياسي والأخلاقي في هذا المتن دفعته إلى إعطاء أهميّة للعلمي؛ أي للعلم المدني في توجيه النظري. وهذا الأفقهو ما يبرّر القولإنّ فلسفة الفارابي سياسية؛ لأنّ من شروط سعادة المجتمع، ووحدته، وأفضليته، وجود حاكم أو رئيس عارف وعالم بأمور التدبير السياسي والاجتماعي. وهذا ما يؤدي إلى إثارة السؤال الآتي، حول مكانة العلم المدني، وعلاقته بمعرفة الوجود؛ هل الفارابي عمل على بناء علم الوجود المدني؟ وهل بهذا العلم تتحدّد مراتب الوعي- الاعتقادات، والمدن، والمجتمعات، والفضائل؟
في فلسفة الفارابي حول الإنسان، يتمّ الإعلاء من شأن العلم المدني، ففي كتاب (الملة)، تُعدُّ موضوعات هذا العلم موضوعات العلم الإلهي والعلم الطبيعي نفسها؛ لأنّ هذا يؤدي إلى معرفة بناء مدني للوجود، وهذه المعرفة تستدعي الفهم الميتافيزيقي أولاً؛ لأنّ التصوّر المدني للوجود هو تناولٌ للموجودات كمراتب، وأساسه الوجود ذاته كواجب.
ولذا، التصور المدني للوجود استكمالٌ للتصور الميتافيزيقي، والغرض هو الإحاطة المعرفية بالوجود عامة؛ ولهذا انتقل الفارابي من الفهم الميتافيزيقي للوجود إلى الفهم السياسي-المدني له. ينتج عن هذا أنّ هناك لحظتين مهمّتين في الوجود:
الأولى: متعلّقة بالعلم الإلهي: العلم العام بالوجود.
الثانية: تتحدّد في الفهم المدني؛ أي وضع سياسة وجود خاصة بالمدينة الفاضلة.
إنّ أوضاع العلم المدني طريقٌ لتحديد مراتب الأشياء، والحقائق، والموجودات؛ ومن خلال هذا العلم الخاص بالإنسان والمجتمع، يتم الوقوف على قضيتين أساسيتين:
1- تعريف السعادة، والأفعال، والأخلاق، التي ينبغي أن تنتشر في المدن من أجل التمييز بين الفاضل والفاسد.
2- ترتيب الأفعال الفاضلة في الأمم والمدن، مع تحديد أصناف المهن غير الفاضلة. ولهذا، العلم المدني طريقٌ لتحقيق غاية أسمى هي السعادة. وهذه الأخيرة هي الغاية والهدف, يقول الفارابي في كتاب (تحصيل السعادة): »وإنّ فطرة كلّ إنسان أن يكون مرتبطاً فيما ينبغي أن يسعى له كإنسان، أو ناس غيره. وكلّ إنسان من الناس بهذه الحال، وأنّه، كذلك، يحتاج كلُّ إنسان، فيما له أن يبلغ هذا الكمال، إلى مجاورة ناس آخرين، واجتماعه معهم. وكذلك في الفطرة الطبيعية لهذا الحيوان أن يأوي ويسكن مجاوراً لمن هو في نوعه؛ فلذلك يُسمّى الحيوان الإنسي، والحيوان المدني. فيحصل، هاهنا، علم آخر، ونظر آخر، يفحص عن هذه المبادئ العقلية، وعن الأفعال والملكات التي بها يسعى الإنسان نحو هذا الكمال، فيحصل من ذلك العلم الإنساني، والعلم المدني[8]. فما ينبغي تأكيده قول الفارابي بالعلم الإنساني والعلم المدني، والحيوان الإنسي والحيوان المدني؛ فهل نحن أمام جهاز مفاهيمي ينتصر من خلاله الفارابي للعلم المدني على العلم الإنساني، وللحيوان المدني على الحيوان الإنسي؟
إنّ هذه المفاهيم تشتغل وفق رابطة إشكالية محددة أساسها علاقة الفرد بالمجتمع؛ وذلك من خلال السؤال الآتي: أنحن أمام نزعة فردية أم جمعانية؟ وهل الفارابي ينتصر للجمعاني مقابل الفرداني، كما هو الأمر مع أفلاطون[9]؟
يعمل الفارابي على إمكانيّة الجمع بين العلم الإنساني والمدني؛ فالأول هو الطريق المؤدي إلى الكمال النظري، وهو خاص بالحكماء الذين تتحوّل مكانتهم إلى أشخاص ذوي وجود متبرّئ من المادة. والعلم الإنساني، عنده، هو علم التوازن الأسمى، وفيه تتحقّق الوحدة بين المعرفة والوجود[10]. أمّا العلم المدني، فهو علم بالسعادة القصوى، التي تتحقّق عبر الاجتماع الممكن بين أهل المدن، وهي مشروطة بانتشار الأفعال الخيّرة، عن إرادة واختيار[11]. والعمل وفق هذه الأفعال الخيّرة المؤدية إلى السعادة الفردية والجماعية، مشروطة بوجود حكمة فلسفية، أو الفيلسوف الحق، لا فيلسوف الزور، وحكمته محددة بتحصيله للعلوم النظرية، وامتلاكه القدرة على استخدامها وتوظيفها؛ ذاك هو الفيلسوف الكامل، والرئيس على الإطلاق[12].
خاتمة:
إنّ العودة إلى مفهوم الإنسان تضعنا أمام مسألة أساسية، وهي أنّ لكل مرحلة تاريخية تصوّرها للإنسان؛ لأنّ الأمر يتعلق بحقلٍ تتداخل فيه وضعيات معرفية متعددة: دينية، سياسية، علمية... ومفهوم الإنسان عند الفارابي تجسيدٌ لواقع مأزوم سياسياً واجتماعياً؛ لهذا كانت عودة الفارابي إلى الأخلاق الفاضلة، ومن أجل تقويم الآراء والمعتقدات السائدة وتصحيحها، منتصراً في ذلك للمعرفة والعلم في تدبير الوجود الإنساني؛ لأنّ الاجتماع والتعاون أصل السعادة؛ ولهذا يكون الفارابي رافضاً المنحى الصوفي القائل بإمكانية الفرد وحده تحقيق كماله في عزلته.
والكتاب الذي بين أيدينا يعدُّ مساهمة قوية في فعل التدريس الفلسفي، بتقريب فكر تراثي بمنظور حداثي راهن. وذلك من خلال تقديم صاحب الكتاب نظرة مكتملة عن فكر الفارابي، وتصوّره للإنسان والمجتمع، ولفعل التدبير السياسي... مستعيناً في ذلك بخبرته البيداغوجية في التدريس. ففي إنجازه الموضوع، كان يستحضر القارئ المفترض، بالعمل على تقريب مسالك النظر التي يتداخل فيها الميتافيزيقي بالمدني، والإيديولوجي بالمعرفي، والتاريخي بالسياسي.
[1] قشيقش، محمد، نظرية الإنسان في فلسفة الفارابي، التنوير، بيروت/ لبنان، 2011م
[2] المصدر نفسه، ص 6
[3] المصدر نفسه، ص 09
[4] المصدر نفسه، ص 10
[5] المصدر نفسه، ص 21
[6] المصدر نفسه، ص 29
[7] المصدر نفسه، ص ص 35-36
[8] الفارابي، تحصيل السعادة، دار الأندلس، بيروت، 1981م، ص 60
[9] إنّ هذا الإشكال المتعلق بالنزعة الفردية والجماعية يرتبط، في تاريخ الفلسفة، بعلاقة سقراط بأفلاطون؛ فممارسة سقراط كانت ممتلئة بتجارب مخالفة لما هو سائد (نقد النظم السياسية، وتعليم الشباب أفكاراً مخالفة لما هو سائد، والانفتاح على آراء دينية مخالفة)، فهذه الوضعيات أو الممارسات لا تستقيم ودولة أفلاطون. ويتبيّن هذا من خلال انتصار أفلاطون لفكرة الحق المتعالي على الطبيعة الإنسانية.
احتقر أفلاطون الآراء السائدة، واعتقادات الناس، مبعداً أيّة حرية في التفكير والاعتقادات. نتج من هذا محاربة للحرية الفردية، بتأكيد ضرورة انضباط الفرد للجماعة والقوانين، ومن ثمّ المدينة، نتج من هذا-كما يقول جورج سارتون- إبعاد أفلاطون للنزعة الإنسانية وللفردانية، من أجل المدينة، وهذا، في عمقه، خيانة لموقف أستاذه سقراط؛ بل قتل رمزي له، كما يرى ميشيل مايير(Michel Mayer)؛ لأن سقراط، كما يرى جورج سارتون كان ديمقراطياً مؤمناً بالنزعة الفردية.
انظر:
- سارتون، ج، تاريخ العلم، الجزء 3، ص 50
- Mayer (M). De la problématologie.
[10] محجوب، محمد، الفلسفة السياسية عند الفارابي، أوضاع العلم المدني، دراسات عربية، ع7، أيار/مايو 1985م، ص ص 24-25
[11] قشيقش، محمد، نظرية الإنسان، ص 137
[12] المصدر نفسه، ص 425






