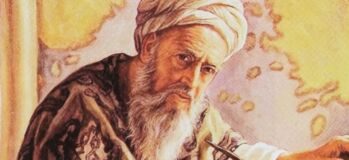مفهوم الفلسفة في الإسلام
فئة : ترجمات

مفهوم الفلسفة في الإسلام
أوليفر ليمان
حقوق النشر © 1998، روتليدج
ترجمة: فريق العمل
لا يوجد تعريف متفق عليه عمومًا لما تشكله الفلسفة الإسلامية، وسيتم استخدام المصطلح هنا للإشارة إلى نوع الفلسفة التي نشأت في إطار الثقافة الإسلامية. هناك عدة تيارات رئيسة في الفلسفة الإسلامية. تتبع الفلسفة المشائية (المشيئية) بشكل عام التقليد اليوناني، بينما يستخدم التصوف مبدأ المعرفة الصوفية كفكرة رئيسة. قد يجادل البعض بأن الفلسفة الإسلامية لم تفقد أبدًا تركيزها على القرآن والنصوص الإسلامية المهمة الأخرى، وأنها سعت عبر تاريخها إلى فهم جوهر حقائق كل من الكتاب المقدس والعالم المخلوق. لم يكن تراجع الفلسفة المشائية في العالم الإسلامي يعني تراجع الفلسفة ككل، بل استمرت في الازدهار والتطور بأشكال أخرى. على الرغم من أنه يُجادل أحيانًا بأن الفلسفة ليست نشاطًا مناسبًا للمسلمين، نظرًا لأنهم يمتلكون بالفعل دليلًا مثاليًا للعمل والمعرفة في القرآن، إلا أن هناك أسبابًا وجيهة للاعتقاد بأن الفلسفة الإسلامية ليست مرفوضة جوهريًّا على أساس ديني.
- طبيعة الفلسفة الإسلامية وأصولها
- الفلسفة (الفلسفة) والحكمة (الحكمة)
- الهرطقة وتراجع الفلسفة المشائية
- العقل والوحي
1. طبيعة الفلسفة الإسلامية وأصولها
من السمات المثيرة للاهتمام في الفلسفة الإسلامية أن هناك خلافًا حول ما هي بالفعل. هل هي في الأساس نوع الفلسفة التي ينتجها المسلمون؟ هذا غير مُرضٍ؛ لأن العديد من المسلمين الذين يعملون كفلاسفة لا يتعاملون مع القضايا الإسلامية في عملهم الفلسفي. أيضًا، هناك العديد من الفلاسفة الذين ليسوا مسلمين، ومع ذلك فإن عملهم يقع بوضوح في مجال الفلسفة الإسلامية. هل يمكننا تسمية "الفلسفة الإسلامية" بالفلسفة المكتوبة بالعربية؟ بالتأكيد لا؛ لأن جزءًا كبيرًا من الفلسفة الإسلامية، وربما معظمها، مكتوب بلغات أخرى، خاصة الفارسية. إذن، هل الفلسفة الإسلامية هي الفلسفة التي تدرس السمات المفاهيمية للقضايا الإسلامية تحديدًا؟ ليس بالضرورة؛ لأن هناك العديد من المفكرين الذين يعدّ عملهم في المنطق والنحو، على سبيل المثال، جزءًا من الفلسفة الإسلامية، على الرغم من عدم وجود صلة دينية مباشرة في عملهم. حاول بعض المعلقين تطوير أجندة مركزية يجب أن يشاركها كل من يمكن تسميته فيلسوفًا إسلاميًّا، ثم واجهوا صعوبة في جعل كل شيء في الفلسفة الإسلامية يتناسب مع هذا الإطار، وهي مهمة تميل في النهاية إلى الفشل (ليمان 1980). ربما أفضل طريقة لتحديد طبيعة الفلسفة الإسلامية هي القول إنها تقليد الفلسفة الذي نشأ من الثقافة الإسلامية، مع فهم المصطلح الأخير بأوسع معانيه.
متى بدأت الفلسفة الإسلامية؟ هذا أيضًا سؤال تصعب الإجابة عنه؛ لأنه منذ السنوات الأولى للإسلام، نشأت مجموعة متنوعة من المشكلات القانونية واللاهوتية التي تعد فلسفية بوضوح، أو على الأقل تستخدم الحجج الفلسفية في توضيحها. على سبيل المثال، كانت هناك مناقشات حامية حول قبول اللغة الأنثروبومورفية (التشبيهية) لوصف الإله، وحول أدوار الإرادة الحرة والتقدير في حياة البشر. بدأت الفلسفة بمعناها الكامل في القرن الثالث للهجرة. (كانت الهجرة في عام 622 م، عندما انتقل النبي محمد إلى المدينة المنورة وأقام هناك مجتمعًا سياسيًّا؛ وهي السنة الأولى وفقًا للتقويم الإسلامي، وتمثلت بـ 1 هـ).
أدى تفوق العباسيين على الأمويين إلى انتقال الإمبراطورية الإسلامية شرقًا، مع انتقال العاصمة من دمشق إلى بغداد. بحلول هذا الوقت أيضًا، سيطر الإسلام على مناطق مثل مصر وسوريا وبلاد فارس، وهي أماكن كانت غارقة تمامًا في الثقافة اليونانية. سعى الحكام الجدد إلى تطبيق المعرفة الموجودة في الإمبراطورية لأغراضهم الخاصة. كانت الكثير من هذه المعرفة عملية للغاية، حيث استندت إلى الطب والتنجيم وعلم الفلك والرياضيات والهندسة. أسس الخليفة المأمون في بغداد "بيت الحكمة" في عام 217 هـ / 832 م، والذي خدم كمرصد، والأهم من ذلك، كمكتبة ومركز لترجمة النصوص اليونانية إلى العربية. كان العديد من المترجمين من المسيحيين، الذين ترجموا النصوص أولاً من اليونانية إلى السريانية، ثم إلى العربية (انظر الفلسفة اليونانية: تأثيرها على الفلسفة الإسلامية). بالإضافة إلى تأثير العديد من الترجمات للنصوص اليونانية، كان هناك أيضًا نقل مهم للأدب الهندي والفارسي إلى العربية، مما أثر بلا شك على تطور الفلسفة الإسلامية.
لا ينبغي الاعتقاد بأن هذه الترجمات كانت غير مثيرة للجدل. تساءل العديد من المسلمين عن ضرورة دراسة الفلسفة من الأساس. فالإسلام يقدم نموذجًا عمليًّا ونظريًّا كاملاً لطبيعة الواقع، وغالبًا ما بدت "العلوم الأولى" لليونانيين غير ضرورية وحتى معارضة للإسلام. لم يكن لدى المسلمين القرآن فقط لمساعدتهم في تنظيم حياتهم واستفساراتهم النظرية، بل كان لديهم أيضًا الحديث، الأقوال التقليدية للنبي والخلفاء الراشدين (خلفائه وأصحابه المباشرين)، والسنة، ممارسات المجتمع. كان هناك أيضًا نظام الفقه، القانون الإسلامي، الذي ناقش مشكلات محددة تتعلق بكيفية سلوك المسلمين، وعلم النحو، الذي شرح كيفية فهم اللغة العربية. كان هناك أيضًا بحلول هذا الوقت نظام متطور للكلام، اللاهوت، الذي تعامل مع المقاطع الأقل وضوحًا في القرآن، وسعى إلى الوحدة المفاهيمية في الصعوبات الظاهرة الناشئة عن مجموعات النصوص القانونية المختلفة (انظر اللاهوت الإسلامي). ما الحاجة إذن لنوع الفلسفة الموجودة في اليونانية، التي نشأت مع غير المسلمين وتم نقلها في البداية إلى العربية بواسطة غير المسلمين؟
لم يكن هذا الأمر مثيرًا للجدل لولا أن الفلسفة بدت معادية للإسلام في العديد من النقاط. كانت الفلسفة التي تم نقلها إلى العربية في هذا الوقت متأثرة بشدة بالأفلاطونية الحديثة (انظر الأفلاطونية الحديثة في الفلسفة الإسلامية)؛ وتميل إلى الاتفاق مع أرسطو (§16) على أن العالم أزلي، وأن هناك تسلسلًا هرميًا للوجود مع العقل في القمة وعالم التكوين والفساد في القاع، وقدمت نظامًا أخلاقيًّا زاهدًا إلى حد ما (انظر الأفلاطونية الحديثة §3). الأهم من ذلك كان معيار الصحة الذي استخدمه الفلاسفة. استند هذا إلى العقل، بدلاً من الوحي، مما أثار بشكل طبيعي تساؤلات حول أهمية الوحي الديني. وهكذا أصبحت الفلسفة تُنظر إليها ليس كصياغة بديلة للحقائق الدينية، ولكن كنظام فكري منافس، يتطلب معارضة من الإسلام. كان على المسلمين الذين عملوا كفلاسفة أن يبرروا أنفسهم، وقد فعلوا ذلك بعدة طرائق.
أول فيلسوف عربي، الكندي، كان يميل إلى القول إنه لا يوجد تناقض أساسي بين الإسلام والفلسفة، تمامًا كما لا يوجد تناقض أساسي بين أفلاطون وأرسطو. تساعد الفلسفة المسلم على فهم الحقيقة باستخدام تقنيات مختلفة عن تلك المقدمة مباشرة من خلال الإسلام. ومع ذلك، بمجرد أن أصبحت الفلسفة أكثر رسوخًا، تمكنت من قطع الصلة بالدين تمامًا، كما نرى من الفارابي فصاعدًا. عندئذٍ يُنظر إلى الدين على أنه يمثل الطريق إلى الحقيقة المتاح للمؤمن البسيط وغير المتطور؛ عند مقارنته بالفلسفة، يُنظر إليه على أنه نسخة من الحقيقة، وإن كانت ربما ذات جودة مفاهيمية أضعف. المدافع الأكثر تصميماً عن هذا الرأي هو بلا شك ابن رشد (أفيرويس)، الذي انتهى معه هذا الشكل من الفلسفة إلى حد كبير في القرن السادس الهجري (القرن الثاني عشر الميلادي).
2. الفلسفة (الفلسفة) والحكمة (الحكمة)
اكتسبت الفلسفة المشائية في العالم الإسلامي أهمية كبيرة لفترة محدودة إلى حد ما، من القرن الثالث إلى السادس الهجري (التاسع إلى الثاني عشر الميلادي). في بعض الأحيان، تم التأكيد على تميز هذا الشكل من التفكير عن المنهجيات الإسلامية التقليدية باستخدام مصطلح "الفلسفة"، وهو مصطلح جديد في العربية صُمم لتمثيل الكلمة اليونانية "فلسفة". ومع ذلك، غالبًا ما تم استخدام المصطلح العربي المألوف "الحكمة". تعني "الحكمة" "الحكمة"، ولها معنى أوسع بكثير من "الفلسفة". يمكن تصنيف الكثير من الكلام (اللاهوت) على أنه حكمة، كما هو الحال مع التصوف أو الصوفية (انظر الفلسفة الصوفية في الإسلام §1). في حين أن الكثير من الفلسفة يُعرَّف على أنه معرفة الموجودات، فإن المفاهيم الأوسع للمجال تميل إلى استخدام مصطلح "الحكمة". أطلق السهروردي، مبتكر الفلسفة الإشراقية، عليها اسم "حكمة الإشراق"، وهو العنوان الذي تبناه لاحقًا ملا صدرا، وغالبًا ما يُترجم في الإنجليزية إلى "الثيوصوفيا" (انظر الفلسفة الإشراقية؛ الثيوصوفيا). يتضمن هذا النوع من الفلسفة دراسة الواقع الذي يحول الروح ولا ينفصل أبدًا عن النقاء الروحي والقداسة الدينية.
تمتلك الفلسفة كـ "حكمة" ميزة الإشارة إلى مجموعة واسعة من القضايا المفاهيمية داخل الإسلام. يمكن للفلسفة بعد ذلك التعامل مع الجوانب الظاهرية للوحي القرآني والأبعاد الباطنية التي تقع في قلب الدين. غالبًا ما يُنظر إلى كل من القرآن والكون على أنهما جوانب من الوحي الإلهي التي تتطلب التفسير، وللفلسفة بمعناها الأوسع دور حيوي هنا. يميل المعلقون الغربيون إلى المبالغة في التأكيد على الخلفية اليونانية للفلسفة الإسلامية، ومع ذلك كتب معظم الفلاسفة الإسلاميين الكبار بشكل موسع عن القرآن ورأوا دور الفلسفة يكمن بشكل أساسي في التحقيق التأويلي للنصوص المقدسة. هذا هو الحال خاصة مع الفلاسفة في بلاد فارس والهند، الذين استمروا في التقليد الفلسفي بعد أن انتهى إلى حد كبير في شكله المشائي. الفلسفة الإسلامية هي إذن في الأساس "فلسفة نبوية"؛ لأنها تستند إلى تفسير نص مقدس هو نتيجة الوحي. إنها تتعامل مع البشر وكمالهم، مع الواحد أو الوجود الخالص، ودرجات التسلسل الهرمي الكوني، مع الكون والعودة النهائية لكل الأشياء إلى الله. جانب مهم من هذا الرأي هو أنه لا ينظر إلى الفلسفة الإسلامية على أنها ظاهرة عابرة، ولكن كتقليد مستمر في العالم الإسلامي، ليس كشيء مستورد إلى حد كبير من ثقافة غريبة، ولكن كجانب أساسي من الحضارة الإسلامية.
مثال جيد على هذا المفهوم الأوسع للفلسفة يكمن في الجدل حول "الفلسفة الشرقية" (الحكمة المشرقية) لابن سينا (أفيسينا). يُعرف ابن سينا بأنه مبتكر نظام فلسفي مشائي، وهو النظام الذي اكتسب أهمية كبيرة في كل من الفلسفة الإسلامية والغربية. يتعامل كتابه "منطق المشرقيين" إلى حد كبير مع الاختلافات المنطقية بينه وبين أرسطو، ولكنه يشمل أيضًا إشارة إلى أعمال أخرى له يدعي فيها أنه سار في اتجاه مختلف تمامًا عن اتجاه المفكرين المشائين (المشائيين). هذا الكتاب غير موجود؛ ربما يكون "المنطق" هو الجزء الأول منه. من خلال ما نجده في أعماله الباقية، يمكن بناء صورة لـ "الفلسفة الشرقية". يصبح الكون الأرسطي متحولًا، يرتبط العقل بالعقل، يصبح الكون الخارجي داخليًّا، تصبح الحقائق رموزًا وتصبح الفلسفة نفسها نوعًا من المعرفة (غنوص) أو الحكمة (صوفيا). الهدف من الفلسفة ليس فقط المعرفة النظرية لجواهر وأعراض الكون، ولكن أيضًا تجربة حضورها وتحققها بطريقة تمكن الروح من تحرير نفسها من قيود الكون. لا يتم تجربة الكون كشيء خارجي يجب فهمه، ولكن كسلسلة من المراحل على طول مسار يسير فيه المرء. لعب مفهوم هذه "الفلسفة الشرقية" دورًا مهمًا في تطوير الأشكال المستقبلية للفلسفة الإشراقية والصوفية التي لا تسعى فقط إلى فهم الكون بعقلانية، ولكن أيضًا تحليل الدهشة التي نشعر بها عندما نتأمل في السر الإلهي لهذا الكون.
ميزة رؤية الفلسفة الإسلامية على نطاق واسع كـ "حكمة" بدلاً من "الفلسفة" الأضيق هي أنها تتجنب خطر اعتبارها في الغالب شكلاً غير أصلي ومنقولًا من الفكر. غالبًا ما كان هذا هو شكل التفسير المفضل لدى المعلقين الغربيين، الذين يهتمون بمعرفة كيف تصل الأفكار اليونانية الأصلية (وأحيانًا الهندية والفارسية) إلى العالم الإسلامي ثم تشكل جزءًا من أنظمة فلسفية بديلة. لا شك أن جزءًا مهمًا من الفلسفة الإسلامية يتبع هذا المسار، ودراسته ربما تكون جزءًا من تاريخ الأفكار أكثر من كونها جزءًا من الفلسفة. ومع ذلك، لا ينبغي نسيان أن الجزء الأكبر من الفلسفة الإسلامية لا يتعامل مع اهتمامات الفلسفة المشائية ككل، ولكنه موجه بقوة إلى القضايا التي تنشأ في سياق المنظور الإسلامي لطبيعة الواقع. قد تدخل الفلسفة المشائية، "الفلسفة"، في هذه العملية، لكنها بعيدة كل البعد عن التطبيق غير النقدي للأفكار اليونانية على القضايا الإسلامية. على الرغم من أن المبادئ المركزية للفلسفة لها أصلها في الفلسفة اليونانية، إلا أنها تحولت وتطورت بشكل جذري داخل الفلسفة الإسلامية لدرجة أنه لا يوجد مبرر للاعتقاد بأن الأخيرة هي مجرد نتيجة لنقل الأفكار من خارج الإسلام.
3. الهرطقة وتراجع الفلسفة المشائية
قام الغزالي بهجوم مؤثر للغاية على دور الفلسفة كجزء من الإسلام في كتابه "تهافت الفلاسفة". وفقًا للغزالي، يقدم الفلاسفة المشائيون (كان يفكر تحديدًا في ابن سينا) كحقائق أطروحات غالبًا ما تكون إما هرطقة (كفر) أو بدعة (بدعة). ربما كان من المتوقع أن يذهب إلى القول بأن هذه الأطروحات الفلسفية غير مقبولة على هذه الأسس وحدها، لكنه لم يفعل ذلك. بدلاً من ذلك، انتقد الغزالي هذه الأطروحات لأنه، كما يجادل، لا تتبع من الحجج التي يقدمها الفلاسفة أنفسهم. هذه الحجج ضعيفة فلسفيًا، وبالتالي لا يجب قبولها. النتيجة السعيدة لفشل هذه الحجج هي أن مبادئ الإسلام تُرى قائمة على مبادئ عقلانية صلبة، على الأقل بمعنى أن نقيضها غير صحيح. على الرغم من أن الغزالي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه العدو اللدود للفلسفة، إلا أنه من الواضح عند فحص العديد من نصوصه عن كثب أنه يبدو أنه يلتزم بالعديد من المبادئ الرئيسة لفكر ابن سينا. أيضًا، في اشتراك مع العديد من خصوم الفلسفة الآخرين، كان لديه تقدير كبير للمنطق (الذي كان يُنظر إليه على أنه أداة للفلسفة بدلاً من كونه جزءًا منها) وأصرّ على تطبيق المنطق على التفكير المنظم حول الدين. ذهب بعض معارضي الفلسفة مثل ابن تيمية إلى حد انتقاد المنطق نفسه، ولكن بشكل عام مع تراجع التقليد المشائي للفلسفة في العالم الإسلامي السني، دخل مع ذلك مجالات أخرى من الحياة الإسلامية، مثل اللاهوت والفقه، واستمر في التأثير حتى تم إحياؤه في القرن الماضي كجزء من النهضة الإسلامية (النهضة) (انظر الفلسفة الإسلامية الحديثة §1).
استمرت الفلسفة في العالم الشيعي بسهولة أكبر بكثير، وكان هناك تقليد مستمر من الاحترام للفلسفة في بلاد فارس وغيرها من المجتمعات الشيعية حتى اليوم. يميل المسلمون السنة إلى قبول أن باب الاجتهاد (الحكم المستقل) قد أغلق الآن، ويجب علينا حل أي صعوبات نظرية وعملية من خلال الرجوع إلى سلسلة من النصوص القانونية وإجماع المجتمع. يستأنف المسلمون الشيعة أيضًا سلطة الأئمة، وخاصة في حالة بعض الشيعة بالإمام "المخفي" أو الثاني عشر، بوصفه في خط النسب الديني المستمر من النبي ومن صهره الإمام علي. نظرًا لأن أسس السلطة الدينية أكثر مرونة بالنسبة للشيعة، فإنها تميل إلى أن تكون أكثر تقبلاً للفلسفة مما هو الحال مع السنة. التعريفات القانونية لما يشكل الهرطقة والكفر تكون أحيانًا أكثر مرونة (كما هو الحال مع الإسماعيليين، على سبيل المثال)، والانفتاح على تنوع الأفكار والمناهج قد ميز العديد من المجتمعات والبلدان الشيعية. بينما تراجعت الفلسفة المشائية تراجعًا حادًّا في العالم السني بعد القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي، استمرت كجزء من مجموعة متنوعة من المناهج الفلسفية في العالم الشيعي، إما بمفردها أو ممزوجة بعناصر من الفلسفة الإشراقية (الإشراقية)، وتطورت إلى أنظمة نظرية أكثر تعقيدًا. بالطبع، استمرت الفلسفة في الازدهار في كل من العالمين السني والشيعي بمعنى الفلسفة الصوفية أو التصوف، والتي كانت جانبًا ثابتًا من الفلسفة الإسلامية طوال حياتها.
4. العقل والوحي
يأخذ العديد من المعلقين الغربيين على الفلسفة الإسلامية الصراع بين العقل والوحي كقضيتها المركزية. غالبًا ما يتم تمثيل هذا على أنه الصراع بين أثينا والقدس، أو بين الفلسفة والدين. بينما هذا تبسيط مفرط ليكون وصفًا دقيقًا، إلا أنه يثير قضية مهمة نوقشت منذ بداية الفلسفة الإسلامية وما زالت قضية حية اليوم في العالم الإسلامي. إذا كان الوحي يخبر المؤمنين بكل ما يحتاجون إلى معرفته، فلماذا نزعج أنفسنا باستكشاف نفس الموضوعات بالعقل؟ هناك عدد من الإجابات عن هذا السؤال. أولاً وقبل كل شيء، يتحدث القرآن نفسه ليس فقط إلى المسلمين، ولكن إلى كل من يستطيع قراءته وفهمه. يحث باستمرار القارئ على التفكير بعقلانية في الأدلة على الإسلام، وبالتالي يضع قيمة عالية على العقل (ليمان 1985). هذا لا يعني أنه لا يوجد دور للإيمان، ولا أن الإيمان لن يكون ضروريًّا في مرحلة ما للاقتراب من الله، لكن القرآن يقدم مؤشرات عقلانية على صحة ما يدعو إليه من حيث العلامات والبراهين. هذا بالتأكيد ليس حجة للتحقيق الحر بالمعنى الحديث للمصطلح، لكنه نهج يضع قيمة عالية على مفهوم العقل المستقل، الذي قد يُنظر إليه أيضًا على أنه متعاطف مع ممارسة الفلسفة نفسها.
وفقًا للإسلام، النبي محمد هو آخر نبي. وهذا يعني أنه من ذلك الوقت فصاعدًا، لا يمكن لأيّ رسول أن يدعي سلطة إلهية. نحن نعتمد على التفسير الصحيح للآيات (العلامات) في كل من القرآن وفي الكون. يعني انتهاء النبوة أن الله يتوقع من البشر استخدام عقولهم للسعي لفهم طبيعة الواقع، وإن كان العقل الذي يسترشد بمبادئ الإسلام. كما يقول القرآن: "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ" (سورة فصلت: 53). ليس كما لو كان هناك تنافس بين النبوة والفلسفة، لأن الأخيرة يجب أن تُرى على أنها تكمل وتشرح الأولى. هناك إذن أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه لا يوجد تناقض أساسي بين السعي وراء العقل والسعي وراء الدين، على الأقل ليس في الإسلام.
انظر أيضًا: علم الجمال في الفلسفة الإسلامية؛ الأرسطية في الفلسفة الإسلامية؛ السببية والضرورة في الفكر الإسلامي؛ نظرية المعرفة في الفلسفة الإسلامية؛ الأخلاق في الفلسفة الإسلامية؛ الإيمان؛ الفلسفة الهلنستية؛ الفلسفة الإشراقية؛ الأصولية الإسلامية؛ اللاهوت الإسلامي؛ المنطق في الفلسفة الإسلامية؛ المعنى في الفلسفة الإسلامية؛ الفلسفة الإسلامية الحديثة؛ الفلسفة الصوفية في الإسلام؛ الأفلاطونية الحديثة؛ فلسفة القانون الإسلامي؛ العلم في الفلسفة الإسلامية؛ الأفلاطونية في الفلسفة الإسلامية؛ الفلسفة السياسية في الإسلام الكلاسيكي؛ الوحي؛ الفلسفة اليونانية: تأثيرها على الفلسفة الإسلامية
المراجع ومزيد من القراءة
Akhtar, S. (1995) "The Possibility of a Philosophy of Islam," in S. H. Nasr and O. Leaman (eds.), The History of Islamic Philosophy, London: Routledge, pp. 1162–1169. (دفاع عن الرأي القائل إن هناك مجالًا للفلسفة في سياق إسلامي.)
Corbin, H. (1993) History of Islamic Philosophy, trans. L. Sherrard, London: Kegan Paul International. (دفاع مهم جدًا عن أهمية التصوف والفكر الفارسي كجوانب رئيسة في الفلسفة الإسلامية.)
الغزالي (1095) تهافت الفلاسفة، في S. Van Den Bergh (trans.), Averroes' Tahafut al-Tahafut, London: Luzac, 1978. (الهجوم الكلاسيكي على الفلسفة المشائية في الإسلام.)
Leaman, O. (1980) "Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake?" International Journal of Middle Eastern Studies, 12, pp. 525–538. (نقد للرأي القائل بأن كل الفلسفة الإسلامية تدور حول قضية العقل مقابل الوحي.)
Leaman, O. (1985) "Introduction," in O. Leaman (ed.), An Introduction to Medieval Islamic Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1–21. (شرح للعلاقة بين الإسلام والعقلانية.)
Leaman, O. (1992) "Philosophy vs. Mysticism: An Islamic Controversy," in M. McGhee (ed.), Philosophy, Religion and the Spiritual Life, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 177–188. (مناقشة لطريقتين مختلفتين لتفسير الفلسفة الإسلامية.)
Leaman, O. (1996a) "Introduction," in S. H. Nasr and O. Leaman (eds.), History of Islamic Philosophy, London: Routledge, pp. 1–10. (توضيح للتعريفات المختلفة للفلسفة الإسلامية.)
Leaman, O. (1996b) "Orientalism and Islamic Philosophy," in S. H. Nasr and O. Leaman (eds.), History of Islamic Philosophy, London: Routledge, pp. 1143–1148. (نقد للنهج الغربي للفلسفة الإسلامية.)
Nasr, S. H. (1996c) "Introduction," in S. H. Nasr and O. Leaman (eds.), History of Islamic Philosophy, London: Routledge, pp. 11–18. (كما أن نصر قد أنتج أيضًا عددًا من الفصول المهمة في هذا العمل، بما في ذلك: "The Meaning and Concept of Philosophy in Islam," pp. 21–26؛ "The Qur'an and Hadith as Source and Inspiration of Islamic Philosophy," pp. 27–39؛ و"Ibn Sina's 'Oriental Philosophy'," pp. 247–252.)