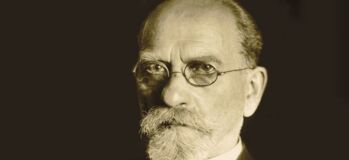العقلانية النقدية لكارل بوبر (1902-1994)
فئة : ترجمات
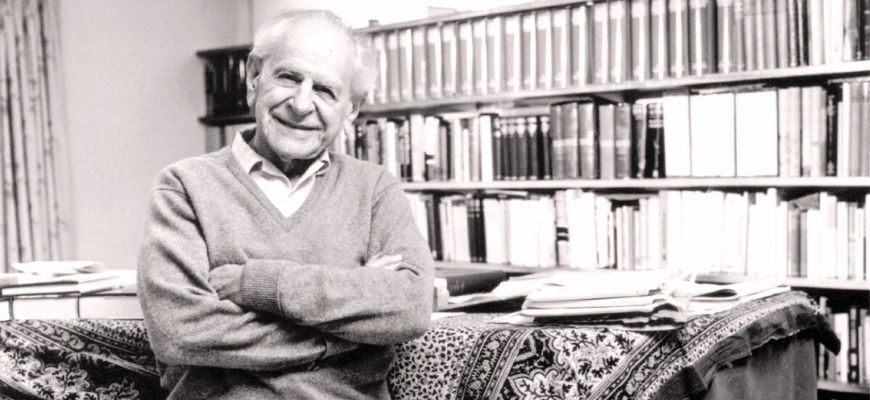
العقلانية النقدية لكارل بوبر (1902-1994)*
ملخص:
دافع الإبستيمولوجي والفيلسوف النمساوي البريطاني كارل ريموند بوبر عن عقلانية نقدية بديلة للعقلانية الفلسفية الحديثة التي كان مآلها الإخفاق، وأسس هذه العقلانية على فكرة لامعصومية الإنسان بما هي خاصية هذا الأخير الذي، وإن كان قاصرًا عن اليقين، يملك القدرة على اكتشاف أخطائه وتصويبها في سيرورة اقتراب لامتناهية من الحقيقة. وفي اتساق تام مع هذا الأساس النقدي، توخى الفيلسوف إقامة معيار حاسم للفصل بين العلم وما سواه من الأفكار والمعارف، فأسسه على مفهوم القابلية للإبطال أو القابلية للتفنيد؛ الذي يتعين التمييز فيه بين مستويين: فمن خلال مستوى صوري لمعيار القابلية للإبطال، يطعن بوبر في علمية كل نظرية غير قابلة للخضوع لمحك تجريبي، ومن خلال مستوى منهجي لهذا المعيار، يعترض على كل نظرية تدعي العلمية وتعتمد حيلا للتمنيع ضد الإبطال والنقد. على أن مطمح بوبر لا يقف في حدود اقتراح معيار للفصل بين العلم واللاعلم، مادام أنه يعتقد أن المعيار الذي يقترحه بمثابة المفتاح لجل الإشكالات الكبرى في فلسفة العلم وفي مقدمتها إشكال الاستقراء.
النص المترجم:
المنهج والعقلانية
ولد كارل ريموند بوبر Karl Raimand Popper بفيينا، حيث درس الرياضيات، والفيزياء، والفلسفة، وتابع محاضرات هانز هان Hans Hahn، وموريتز شليك Moritz Schlick، وعالم النفس كارل بولر Karl Bülhler؛ الذي هيأ تحت إشرافه أطروحته في الدكتوراه حول منهج علم النفس المعرفي[1]. وكان له اتصال، بعد ذلك، بأعضاء حلقة شليك بإيعاز من هاينريش جومبيرز Heinrich Gomperz[2]. وفي هذه المرحلة، نشر كتابه الرئيس "منطق الكشف العلمي" Logik der forschung، الذي ظهر بفيينا سنة 1934، ضمن السلسلة التي كان يديرها موريتز شليك وفيليب فرانك Philip Frank[3]. وأجبر صعود النازية كارل بوبر على الهجرة إلى نيوزيلاندا سنة 1937. وهناك حرر مؤلّفَيْه في الفلسفة الاجتماعية "المجتمع المفتوح وأعداؤه" La société ouverte et ses ennemis، و"بؤس التاريخانية" Misère de l’historicisme، ثم عاد إلى لندن (حيث سبق له أن مكث عامي 1935-1936)، وحصل على كرسي المنطق ومناهج العلوم في "معهد لندن للاقتصاد" London School of Ecnomics، وهو المنصب الذي شغله إلى نهاية حياته[4].
ومن بين الباحثين الذي سنتطرق إليهم لاحقا، نذكر بول فيراباند Paul Feyerabend وإمري لاكاتوش Imre Lakatos، اللذين نشآ في أحضان العقلانية النقدية، لكنهما سرعان ما اتخذا مسافة عن بوبر. أما غاستون باشلار Gaston Bachelard وتوماس كون Thomas Khun، فقد بلورا أفكارهما بصورة مستقلة عنه. وعلى غرار حلقة فيينا ومقارنة مع هؤلاء، لم يستخدم كارل بوبر تاريخ العلم في أفكاره الإبستيمولوجية إلا لماما.
يقترح بوبر مقاربة منهجية للعلم تتوافق مع ما يتصوره طابعا نقديا لهذا الميدان، والتي تقوم بدورها على نظرية في العقلانية. وأحد أهداف بوبر الرئيسية يكمن في إقامة معيار "للفصل" critère de « démarcation »، من شأنه أن يَخُطَّ حدا فاصلا بين المجال العلمي والمجال الذي ليس كذلك. وقد أكد، في كتاب "منطق الكشف العلمي"، إمكانية إقامة معيار الفصل على مفهوم القابلية للإبطال falsifiabilité أو بتعبير أفضل، على القابلية للتفنيد réfutabilité. ولم يُدْمِج فكرة التقدم في المعيار الذي اقترحه إلا لاحقا (في كتاب "فروض تخمينية واختبارات تفنيدية" Conjectures et Réfutations).
وسنتناول أسس نظرية بوبر في العقلانية انطلاقا من مقال "في مصادر المعرفة والجهل" Des sources de la connaissance et de l’ignorance (الذي نشر كتصدير لكتاب "فروض تخمينية واختبارات تفنيدية"). ويعرض بوبر، في هذا المقال، تاريخ ما يراه اتجاها كبيرا في الرشد الإبستيمولوجي بدأ مع عصر النهضة. وهذا الاتجاه كانت تحركه فكرة أن كل فرد قادر على التمييز بين الصحيح والخاطئ، وعلى بلوغ المعرفة اعتمادا على وسائله الخاصة. فالتياران الإبستيمولوجيان الكلاسيكيان البارزان، اللذان اعتبرا ملكة الحواس أو قدرات العقل ملكة معرفية أساسية، اشتركا في ذات النزعة التفاؤلية، التي تؤكد أن كل فرد بإمكانه تحصيل المعرفة، وانتقاد كل مؤسسة أو سلطة بهذا الشأن، سواء كانت من طبيعة سياسية (ذات صلة بالدولة) أو دينية. ويضيف بوبر أن اتجاه الرشد الإبستيمولوجي هذا ساهم أيضا في انبثاق قيم من قبيل حقوق الشخص وحرية الرأي.
إن هذه النزعة التفاؤلية الإبستيمولوجية لم تكن لها، مع ذلك، نتائج إيجابية فقط، بالنظر لتصور الحقيقة الملازم لها. فهذا التصور، الذي يطلق عليه بوبر، تسمية نظرية الحقيقة الجلية théorie de la vérité manifeste، تدافع عن أن الحقيقة تنكشف وفق منطق البداهة، وبأنها تفرض نفسها على أيٍّ كان ذي حواس وعقل. فكيف نفسر إذن أن الحقيقة ليست في متناول الجميع؟ إن جهل الحقيقة ينبغي أن يُفهم حصرا، ضمن هذا المنظور، كرفض للقبول بالبداهة، وذلك كسيرورة تحجُب ما ينكشف، بصورة واعية أو غير واعية. فالوجه الآخر من العملة بالنسبة إلى فكرة الحقيقة الجلية، وهو أن الجهل إنما يعود إلى سوء الطوية، كانت له، في نظر بوبر، نتائج وخيمة مرتبطة بالتعصب أو التزمت fanatisme، وبما يمكن تسميته بالإيديولوجيا.
وفي مقابل نظرية الحقيقة الجلية، ينطلق بوبر من مبدأ أن الإنسان يرتكب الأخطاء. فالإنسان حيوان ضال، ونظرياته في العقلانية، كما نظرياته السياسية، ونظرياته العلمية هي محاولات يشوبها الخطأ يتوخى منها التغلب على ضلاله. فنزعة القابلية للخطأ faillibilisme، والتي هي نظرية في العقلانية بطعم سقراطي، ستنادي إذن بمقاربة منهجية في البحث عن الخطأ والعمل على استبعاده.
فبدل الانطلاق من مبدأ أننا نستطيع معرفة الحقيقة، لِننطلق من مبدأ أننا نستطيع اكتشاف الخطأ، وبأننا نستطيع قبوله ومحاولة استبعاده. فالمعرفة النقدية يتعين عليها أن تستند حصرا على هذه الأفكار الثلاث. والأمر يتعلق آنئذ ببلورة منهج من شأنه ضمانُ الخاصية النقدية لمعارفنا، وإكسابُها، من خلال ذلك نفسه، طابعَها العلمي. فنظرية بوبر في العقلانية تقدم نفسها في صورة نزعة القابلية للخطأ، ومقاربته المنهجية تحت راية القابلية للتفنيد réfutabilité. والخاصية النقدية للعلم تكمن في استخدام نظرية ما إلى حين بروز دليل مخالف، مع طلب هذا الدليل المخالف. والفكرة في حد ذاتها يمكن أن تبدو غريبة، مادام أن أولئك الذين يتحملون عناء اقتراح نظريات علمية، يفترضون أنهم على حق فيما يقترحونه أو يدفعون به.
ويقارب بوبر فكرة العِلمية scientificité بواسطة نظرية في المنهج قادرة على حل إشكال الفصل بين العلم واللاعلم. ويضيف أن الحل الذي يقترحه هو بمثابة المفتاح بالنسبة لجل الإشكالات الكبرى في فلسفة العلم[5]. فما الذي نجنيه من معيار الفصل؟ أولا، تحديد لمفهوم العلمية، وفي المقام الثاني، منهج في التقييم النقدي للنظريات العلمية. وإضافة إلى ذلك، من خلال اقتراح معيار القابلية للتفنيد كمعيار للفصل، توخى بوبر، في الوقت نفسه، تقديم حل لإشكال الاستقراء، ومعارضة كل صورة من صور النزعة التجريبية تتبنى مقاربة منهجية علمية ذات منزع استقرائي.
إن معيار الفصل الذي يقترحه بوبر، من زاوية النزعة التجريبية المنطقية، تكمن أهميته في أنه يقترح توصيفا للعلم الإمبريقي، مع إرادة أن يكون بمثابة نقد لهذه النزعة التجريبية المنطقية. ولنسجل أن بوبر حاول التصدي، في الحركة عينها، لفكرتين متمايزتين وهما سؤال القيمة الإمبريقية لنظرية ما، وسؤال خاصيتها النقدية. فهناك تداخل معين في مشروع بوبر، الذي ينشد، في الوقت نفسه، استبعاد النظريات غير القابلة للخضوع للمحك الإمبريقي من مجال العلم، واستبعاد النظريات (إمبريقية أو غير ذلك) المتمنعة أو المحصنة إزاء النقد.
إن النظريات التي يستهدفها بوبر، في الحالة الأخيرة، هي التحليل النفسي الفرويدي والماركسية، اللتان ينفي عنهما صفة العلم. إذ إنه يؤاخذ هاتين النظريتين بكونهما تتضمنان "استراتيجيات مواضعاتية" تتيح لهما الإفلات من كل نقد. وتقدم هاتان النظريتان بالنسبة لبوبر نموذجا للنتائج الوخيمة لنظرية مؤامرة الجهل conspiration de l’ignorance، لأنها تتضمن كجزء مندمج منها، تفسيرا لواقعة أن الذي يقوم بالنقد، يقاوم الاعتراف بالحقيقة، هذا التفسير الذي يقوم إما على استعدادات الناقد الجنسية أو على وضعه السوسيواقتصادي.
ومن خلال اقتراح القابلية للتفنيد معيارا للفصل، يحاول بوبر الطعن في كل نظرية غير قابلة للخضوع لمحك تجريبي (بالاعتماد على مفهوم صوري للقابلية للإبطال)، وفي كل نظرية تتضمن حيلا للتمنيع إزاء النقد (بالاستناد على مفهوم منهجي للقابلية للتفنيد). بيد أن هذا الأخير يبدو ذا أهمية بالنسبة إلى إشكال تقييم النظريات العلمية، في حين أن المفهوم الصوري يعوزه نسبيا الطابع الإجرائي. وهذا يضاف إليه أن المفهوم المنهجي، الذي سنعمل على تحليله أدناه، ليس من شأنه تقديم تعريف لمفهوم العلمية.
قابلية النظريات العلمية للتفنيد
المفهوم الصوري
في المعنى الصوري للفظ، نظرية ما قابلة للتفنيد إذا كانت لها منطوقات قاعدية من شأنها أن تُستخدم لتفنيدها، وبنية قاعدية تربط هذه المسلمات بالمنطوقات القاعدية. وبهذا المعنى، فقابلية نظرية ما للتفنيد هي خاصية بنيوية للغة النظريات العلمية (مادام أن الأمر يتعلق حصرا بمنطوقات يمكننا توقع حقيقتها أو خطئها). ومن هذه الزاوية، يتموضع بوبر على المستوى نفسه مع النزعة التجريبية المنطقية. فالمفهوم الصوري للقابلية للتفنيد هو مفهوم استنباطي. إنه يتأسس على العلاقة المنطقية القائمة بين القوانين أو المسلمات النظرية لنظرية ما وبين المنطوقات القاعدية التي يمكنها أن تُستخدم في عملية تفنيد لهذه النظرية. فإذا ما أشرنا إلى مجموع المسلمات النظرية لنظرية ما بـ T، ولنتيجة تجريبية معينة مقبولة كـ "إبطال محتمل" لها بـ O، واستخدمنا الرمز الميتامنطقي ⊢ للإشارة إلى العلاقة المنطقية المتعلقة بالاشتقاق، فيمكننا أن نتمثل، على المستوى المنطقي، تفنيد T بواسطة O من خلال الاستدلال الاستنباطي الذي يحمل اسم "النمط النافي" modus tollens:
T ⊃ O, ¬O} ⊢ ¬T}
ففي إطار منطق المحمولات من النمط الأول، يمكن أن نتمثل قانونا علميا بوصفه منطوقا كونيا (صيغته الأكثر بساطة هي ∀x Px)، ونتيجة ملاحظاتية باعتبارها منطوقا جزئيًّا (صيغتها الأبسط هي Pa). وتفنيد المسلمة النظرية بواسطة نتيجة تجريبية يأخذ إذن الصورة الآتية:
{∀x Px , ¬Pa} ⊢ ¬∀x Px
وبكيفية مماثلة، يمكن تصور سيرورة المصادقة confirmation على نظرية ما على منوال الخطاطتين الآتيتين
{T ⊃ O, O} ⊢ T ; {Pa1, Pa2, Pa3, … , Pan} ⊢ ∀x Px
اللتين تشكلان صورتين نموذجيتين من الاستدلال الاستنباطي الذي يفتقر للصلاحية.
يقترح بوبر منطقا للعلوم ذي طابع استنباطي صارم، مستبعدا كل إشكالية للمصادقة، وأيضا كل استعانة إبستيمولوجية بالمفهوم المنطقي للاحتمال، الذي من شأنه أن يستخدم كدرجة من المصادقة. ويؤكد أن حساب الاحتمالات ليس له مكان في فلسفة العلوم، أما بشأن مفهوم الاحتمال المنطقي الذي يحظى كثيرا باهتمام التجريبيين المناطقة، فكل النظريات لها الدرجة صفر من الاحتمال[6]. وفيما يتعلق بمفهوم الاحتمال في العلم، فإنه يدفع بمفهوم النزوع، الذي لن يحظى بالاهتمام، وإلا من أجل القول إنه موضوع انتقادات جدية[7].
ومن خلال استحضار مسألة اللاتماثل بين المصادقة والتفنيد، يدّعي بوبر أنه قام بواسطة القضية السالبة، على هذا النحو، بحل إشكال الاستقراء الذي ارتبط باسم دفيد هيوم David Hume[8].
وليس من غير المجدي التذكير بأن إشكال الاستقراء (الذي لم يفصله هيوم، بجلاء، عن إشكال السببية) لا يتعلق بسؤال معرفة ما إذا كانت الاستدلالات الاستقرائية قائمة، بل بسؤال معرفة ما إذا كانت مُعللة. لنستحضر صورتين من صور الاستدلال الاستقرائي كانت معلومتين زمن هيوم:
- Pa1 ˄ Pa2 ˄ Pa3 ˄ … Pan ⊢inductif P (an + 1)
- Pa1 ˄ Pa2 ˄ Pa3 ˄ … Pan ⊢inductif ∀x (Px)
لنسجل بالمناسبة أن الوصف المدرسي للاستدلال الاستقرائي، كانتقال من الخاص singulier (أو الجزئي particulier) إلى العام، خاطئ، كما تبرز ذلك الصورة الأولى من الاستدلال أعلاه.
والتحليل الذي قام به هيوم للاستدلال الاستقرائي مطابق قي كل تفاصيله للتحليل الذي قام به المنطق الحديث: الاستدلالات الاستقرائية هي بالضبط تلك التي تُفَخِّمُ المضمون (يقال راهنا: حيث توجد نماذج للمقدمات ليس نماذج للنتيجة). أما بخصوص حكم هيوم فهو شهير جدًّا: وحدها الاستدلالات التي لا تفخم المضمون، بمعنى الاستدلالات ذات الصلاحية، أساس الاعتقادات المعللة. ولنسجل أن إشكال الاستقراء بالمعنى الذي نجده لدى هيوم لا يطرح بالنسبة للرياضيات. فهنالك بديهيا الكثير من الاستقراء في الرياضيات وفي المنطق. فعلى مستوى المفاهيم، ما علينا إلا النظر في التعريف المتداول للأعداد الطبيعية الذي يعود إلى بيانو Peano، والذي ينطوي على مبدأ للاستقراء:
∀ P [P (O) ˄ ∀ ((P(x) ⊃ P (x + 1))] ⊢ ∀x (Px)
والدلائل القائمة على الاستقراء بشأن الأعداد الطبيعية هي ذات صلاحية، نظرا لكونها تتعلق بكيانات صورية محددة بواسطة مبدأ التكرار- وهو ما لا ينطبق على الموضوعات التجريبية. ولنشر أيضا إلى أن المقدمة الثانية في الدلائل على صورة
P (O) ˄ ∀ x ((P(x) ⊃ P (x + 1)) ⊢ ∀x (P(x)
هي منطوق كوني. والحال أن الكونية، في التحليل الذي يقوم به هيوم لهذا المفهوم، لا يمكن أن تجد مصدرها أبدا في التجربة[9]. وهذا يعني أن الإشكال الذي أثاره هيوم لا يطرح إلا في السياق، حيث الاستدلال بواسطة الاستقراء ينصب على موضوعات إمبريقية، مادام أن الاعتقاد في المقدمة الثانية يعوزه التبرير. ومهما يكن، ففي سياق التعليل حيث يُمَوْضِعُ بوبر مقاربته المنهجية، فقد كان محقا في الإعلان بأن كل نهج استقرائي يفتقر للصلاحية وغير مرحب به؛ لكنه يمكنه بصعوبة ادعاء حل أي شيء من الأشياء.
فإذا كان المعيار الذي يقترحه بوبر كمعيار للفصل مطابقا للمفهوم الصوري للقابلية للتكذيب، فإن هذا المعيار وُلد ميتا إن صح القول، وذلك بسبب الاعتبارات التي سبق لبيير دوهيم Pierre Duhem أن بلورها بخصوص إخضاع الفرضيات للمحك الإمبريقي في العلم[10]. فقد أوضح دوهيم أن الترابط المنطقي المتبادل للفرضيات في العلم، يجعل إخضاع فرضية متصورة بصورة معزولة على محك الاختبار، مستحيلا. فإذا ما أشرنا إلى الفرضية النظرية التي يجب أن تكون موضوع اختبار تجريبي بـ T، وبـ HA إلى مجموع الفرضيات المساعدة التي هي ضرورية من أجل أن تفضي هذه الفرضية إلى تنبؤات ملاحظاتية O، فإن أطروحة دوهيم تجبرنا على تعويض الخطاطة المنطقية: T ⊃ O, ¬O} ⊢ ¬T} بواسطة الخطاطة:
{(T ˄ HA) O, ¬O} ⊢ ¬ (T ˄ HA)
فالتكافؤ المنطقي بين صورتي المنطوق ¬ (T ˅ HA) والمنطوق ¬ (T ˄ ¬HA) يشير بالفعل إلى عدم وجود سبب منطقي للقول، في حالة النتيجة التجريبية السلبية، بأن الفرضية النظرية المستهدفة، وليس الفرضيات المساعدة، هي التي جرى تفنيدها. فخطاطة المفهوم الصوري للقابلية للتفنيد التي خضعت للمراجعة، وكذلك واقعة أن الفرضيات المتعددة لنظرية معطاة تتخذ بنية الشبكة، تبرزان، فضلا عن ذلك، بأن تمنيع فرضية نظرية إزاء نتيجة تجريبية سلبية، يظل دائما ممكنا؛ وبأنه، في الحدود القصوى، كل فرضيات نظرية علمية قد يتوجب اعتبار أنها فُنِّدَتْ جملةً، إذا ما وجد شيء كهذا.
وهذه النزعة الكُلانية holisme التي يدافع عنها دوهيم، لها أبعاد منهجية سنعود إليها لاحقا. ومن أجل أن نظل على المستوى الصوري الصرف، لِنُشِرْ إلى أن المنطوقات التي لها الصورة المنطقية لمنطوق كوني، هي وحدها التي تقبل التفنيد بالمعنى الصوري للفظ. وإذن كل منطوقات العلم التي لها الصورة المنطقية لمنطوق وجودي existentiel (على سبيل المثال، تلك التي تؤكد وجود خاصية فيزيائية أو كيان فيزيائي) لا تستجيب لمعيار الفصل، ويجب اعتبارها نتيجة لذلك غير علمية.
لنقيم المفهوم الصوري للقابلية للتفنيد باعتباره معيارا للفصل بين العلم واللاعلم. فبصورة مستقلة عن واقعة أن هذا المعيار يفترض مفهوما خاصا للنظرية (متصورة كمجموع من المنطوقات) والذي كان موضوعا للعديد من الانتقادات، فإن إرادة الحكم على علمية نظرية ما على الأساس الحصري لبنيتها التركيبية syntaxique من شأنه أن يفضي بنا إلى إفراطات دائرة فيينا في مرحلتها الجذرية. أضف إلى ذلك أن مقاربة تركيبية كهذه تبدو غير متسقة مع الشق الثاني من السؤال، الذي هو الشق المتعلق بالطابع الإمبريقي أو إمبريقية النظريات التي انصب عليها نظر بوبر. ففي منظور مقاربة صورية، إمبريقية نظرية ما تكمن في نمط التأويل الذي تتميز به، وتمثل إذن، مفهوما دلاليا. ويضاف إلى ذلك أن بوبر نفسه يقر بعدم كفاية المقاربة الصورية. فقد كتب في مؤلفه "المعرفة الموضوعية" La connaissance objective، مستحضرا الحل الذي اقترحه لإشكال الفصل سنة 1934: "لقد أدركت بسرعة أن إشكال الفصل والحل الذي تقدمت به [...] ظلا صوريين وغير واقعيين قليلا: فبالإمكان دائما تلافي عمليات التفنيد الإمبريقية، إذ كان على الدوام ممكنا "تمنيع" أي نظرية ضد النقد"[11].
وبالمقابل، دفع بوبر بمفهوم منهجي للتكذيب: "وهكذا أفضى بنا الأمر إلى فكرة القواعد المنهجية، وإلى فكرة الأهمية القصوى للنهج النقدي؛ ويتعلق الأمر بنهج يتلافى استراتيجية تمنيع نظرياتنا ضد التفنيد"[12].
وندرك، منذ الآن، أن هذه المقاربة المنهجية ستكون في صراع مع ما يعرف بالنزعة المواضعاتية في العلم.
المفهوم المنهجي
تنطوي فكرة القابلية للتفنيد على جوانب منهجية تتجاوز البعد الصوري الخالص، وهي أساسية بالنسبة إليه. وهذه الجوانب المنهجية تتمثل في تصور القابلية للتكذيب الإمبريقي ليس كخاصية ملازمة للنظريات العلمية، بل كنتيجة لمقاربة منهجية تكمن في جعلها قابلة للتفنيد، وهذا يعني أن النظريات العلمية ليست قابلة للتفنيد في ذاتها (وهو ما يعني التصريح بإفلاس المفهوم الصوري)، بل يدخل في إطار المحافظة على الطابع النقدي للعلم، تطوير مقاربة منهجية علمية تجعلها قابلة للتفنيد.
لقد رأينا أعلاه أنه في حالة عدم اتساق فرضية نظرية ∀x Px مع نتيجة تجريبية ¬Pa، لا شيء، على المستوى المنطقي الصرف، يجبر العالم على التخلي عن النظرية وليس عن النتيجة التجريبية. ويعلمنا المنطق الاستنباطي أيضا أن
{∀x Px, ¬Pa} ├ ¬¬ Pa
وهذا يعني عدم وجود أي سبب من مستوى منطقي للتخلي عن النظرية عوض النتيجة التجريبية السلبية. فالحافز لا يمكن أن يأتي إلا من قرار أو إرادة، من طبيعة منهجية، لإعطاء الأولوية والأسبقية للنتيجة التجريبية ¬Pa على الفرضية النظرية ∀x Px.
ما هي الحجج، التي هي من مستوى منطقي أو إبستيمولوجي، التي من شأنها أن تؤكد أن النظرية يجب أن تعد مُفَنّدةً؟
لنشر أولا إلى أن نزعة وضعية متجاوزة وحدها، هي التي من شأنها أن تمنح أولوية إبستيمية لوقائع التجربة؛ لأن هذه الأخيرة تشارك في الطابع الفرضي للنظرية. فتصور التجربة الخاضعة للمراقبة، تستتبع غالبا استخدام النظريات (التي لها وضع الفرضيات) في سيرورة التجريب نفسها. وسنعمل لاحقا على مناقشة الطابع النظري القوي لنتائج الملاحظة. فهذا المفهوم، الذي وضعه فايرابند في الواجهة، لكنه معلوم لدى الجميع بسبب مضمونه الحدسي، يحيل على فكرة أن الملاحظة العلمية لا تكتسي دلالتها إلا على ضوء إضاءة نظرية. فقد كان باشلار يقول، مستخدما معجمه الخاص، بأن أدوات القياس الحديثة هي بمثابة "نظريات مجسدة في مادة" « théories matérialisées ». والحجة نفسها يمكن الدفع بها فيما يخص القياس[13]. فالنتائج التجريبية تجمع بمساعدة مناهج القياس التي تفترض في الأغلب صلاحية نظريات معينة، بحيث أن الوضع الفرضي لهذه الأخيرة يجري نقله إلى النتائج التجريبية المحصل عليها، ووضعها الإمبريقي يجري وضعه موضع سؤال[14].
لنشر أيضا إلى شرط القابلية لإعادة الإنتاج بالنسبة لكل نتيجة تجريبية ذات دلالة (بما في ذلك الاندماج البارد). ولسبب أقوى، وحدها النتائج التجريبية القابلة لإعادة الإنتاج يمكنها أن تستخدم كأدوات للتفنيد[15]. والحال أن القابلية لإعادة الإنتاج تتطلب مبدأ استقرائيا يسير عكس كل مقاربة منهجية استنباطية خالصة بالنسبة للعلم. بيد أن الذي يرفض كل مبدأ استقرائي قد يكون بوسعه اختيار اعتبار شرط القابلية لإعادة الإنتاج للواقعة التجريبية فرضية علمية. وهذا يعني إذن القول إن النتيجة التجريبية السلبية، في الخطاطة الصورية لسيرورة التفنيد، مثلها مثل المنطوق النظري المفترض تفنيده، لها الوضع الإبستيمولوجي للفرضية. ويمكننا تصور وضع فرضية القابلية لإعادة الإنتاج للنتيجة التجريبية السلبية على المحك، ونتائج هذا الاختبار أو الوضع على المحك ستقوم بالمقابل على فرضية قابليتها لإعادة الإنتاج. وهكذا، فزاوية النظر المنهجية الاستنباطية حصرا التي يدافع عنها بوبر تفضي إلى تقهقر إلى ما لا نهاية.
أمام هذه الاعتبارات، المقاربة المنهجية لبوبر، يجب عليها ليس فقط القبول بالطابع الفرضي للمنطوقات التي يمكنها أن تستخدم كأدوات للتفنيد (المنطوقات القاعدية لبوبر)، بل يجب عليها أيضا القبول بطابعها المواضعاتي. فالمعيار المنهجي للتفنيد (باعتباره معيارا للفصل) يقتضي الاتفاق، كاختيار منهجي، على مجموع من النتائج التجريبية الأساسية (منطوقات قاعدية) التي من شأنها أن تكون آليات محتملة للإبطال. وهذا يعني أنه يتعين، في إخضاع الفرضية النظرية للاختبار، إعداد قائمة من الاختبارات الأساسية التي تشكل القاعدة التجريبية للنظرية، وإضافة إلى ذلك، التمسك بإرادة اعتبار الفرضية المعنية مفندة إذا ما فندت بهذه الاختبارات الأساسية.
إن بوبر إذن ملزم بتحديد ما يكونه بالضبط الطابع الملائم ad hoc لفرضية مساعدة، وبالموازاة مع ذلك، يجد نفسه مجبرا على البرهنة على وجود التجارب الحاسمة في العلم. كما أن الرد على حجة دوهيم المتعلقة باستحالة إخضاع فرضية منظورا إليها بصورة معزولة لاختبار تجريبي، يجعل النزعة التفنيدية لبوبر مجبرة على بلورة مناهج تتيح عزل فرضية نظرية في سياق "محاولة جدية للتفنيد". لكن المدرسة البوبرية، يا للأسف، لم تنجح قط في بلورة هذا المفهوم[16]. وهذا ما ينطبق أيضا على المحاولات العقيمة لتدقيق ما يشكل الطابع الملائم لفرضية معينة أو الطابع الحاسم لتجربة ما.
فكرة الدُّنُو من الحقيقة vérisimilitude
أمام إخفاق النزعة التفنيدية المنهجية، توخى بوبر إدماج فكرة التقدم في التحديد المفاهيمي لما يكونه العلم. وهذا يعني أن معيارًا صوريًّا للتقدم من شأنه أن يكون مرشحا للعب دور معيار الفصل. وقد بادر بوبر بنحت لفظ الدُّنُو من الحقيقة للإشارة إلى مفهوم صوري للتقدم يغطي الفكرة الحدسية المتعلقة بالاقتراب التدريجي من الحقيقة، أو أيضا، إلى مفهوم الحقيقة من حيث كونه فكرة حد أو نهاية.
ويستند بوبر على السيمانطيقا الصورية من أجل تحديد مفهومين قاعديين، الأول مفهوم مضمون حقيقة نظرية ما، والثاني مفهوم مضمون خطئها. لتكن L لغة صورية، وs تأويلا لـ L (التأويل المنشود)، وA نظرية مُصَوْرَنَة axiomatisée (متماسكة) مصاغة بواسطة اللغة L. يمكن أن نعرف الحقيقة (الصحيح في L انطلاقا من s) بالمعنى يعطيه إياه تارسكي Tarski. ولنطابق المضمون الإخباري لـ L بمجموع منطوقات L (بمعنى مجموع صيغ L التي هي صحيحة أو خاطئة). وفي علاقة بالنموذج s (جزء الواقع الذي تغطيه L)، اللغة L مساوية لاتحاد مجموع المنطوقات الصحيحة في s (المشار إليه بـ V)، ومجموع منطوقاته الخاطئة في s (المشار إليه بـ F)، وهذا يعني أن لدينا:
L = V U F.
لنسجل:
TA: مجموع مبرهنات A.
TA¬: مجموع سوالب مبرهنات A، بمعنى مجموع المنطوقات التي تناقض A.
(يمكننا التغاضي عن المنطوقات غير المحسومة من A، وهذا التبسيط ليس له وقع على النتائج).
سنحصل سريعا على التقاطعات الآتية:
TAV: مجموع (TA ∩ V) مبرهنات النظرية A التي هي خاطئة في إطار s؛
TAF: مجموع (TA ∩ F) مبرهنات النظرية A التي هي خاطئة في إطار s؛
¬ TAV: مجموع (¬TA ∩ V) المنطوقات التي تناقض A التي هي صحيحة في إطار s؛
¬ TAF: مجموع (¬TA ∩ F) المنطوقات التي تناقض A التي هي صحيحة في إطار s.
ويمكن أن نطابق نجاحات النظرية A مع مجموع TAV U ¬TAF، وإخفاقات النظرية مع مجموع TAF U ¬TAV. و IAV و IAF يمكنها أن تؤول إيجابا أو سلبا. فبكيفية موجبة IAV تمثل الحقائق التي لا تتيح النظرية مناقضتها، و IAF تمثل الأخطاء التي لا تتيح النظرية تأكيدها. وبكيفية سلبية، تمثل IAV الحقائق التي لا تتيح النظرية تأكيدها، وتمثل IAF الأخطاء التي لا تتيح النظرية مناقضتها. وللحصول على النتيجة المتوخاة، يمكننا صرف النظر عن المنطوقات غير المحسومة من A.
ويمكن أن نطابق مضمون حقيقة النظرية مع المجموع IAV، ومضمون خطأ النظرية مع المجموع TAF. وبافتراض أن مضمون حقيقة وخطأ نظرية معطاة قابل للقياس، يعرف بوبر درجة الدنو من الحقيقة Vs (A) للنظرية A بالكيفية الآتية:
Vs (A) = TAV - TAF
ولبيان أن التعريف المقترح لدرجة الاقتراب من الحقيقة ملائم، يصوغ بوبر شرطين اثنين للملاءمة:
- درجة الدنو من الحقيقة بالنسبة لنظرية معطاة ترتفع إذا ما كان مضمون حقيقتها يرتفع ومضمون خطئها لا يرتفع؛
- درجة الدنو من الحقيقة بالنسبة لنظرية معطاة ترتفع إذا كان مضمون خطئها ينخفض ومضمون حقيقتها لا ينخفض.
وهذان الشرطان يتوافقان والفكرة الحدسية المتعلقة بدنو متدرج من الحقيقة، الذي لا يتعلق الأمر هنا ببناء التعبير الصوري له. فالأمر يتعلق بالنسبة لبوبر إذن بإقامة الدليل على أن تعريفه يستوفي شرطي الملاءمة. وما هو ملفت للانتباه هنا ليس استخدام الدليل (الذي هو بالغ البساطة)، بل هو اعتماد بوبر هنا على المناهج السيمانطيقية الصورية للتجريبية المنطقية (تلك المناهج التي طالما قام بنقدها).
إذا افترضنا نظريتين A وB تشتركان معا في اللغة L، وفي التأويل نفسه s، فإن الفكرة الصورية للتقدم، وفق تعريف بوبر، بمثابة دُنو أو اقتراب من الحقيقة أكبرُ نسبيا. فالنظرية B تشكل تقدما على النظرية A إذا كانت B لها درجة دنو من الحقيقة أكبر من A:
Vs (B) > Vs (A)
وهذا يعني: {TAV - TAF} Ì {TBV – TBF}.
ويمكن البرهنة على أن هذه الفكرة الصورية للتقدم تستوفي الشرط الآتي:
((TAV Ì TBV) Ù (TBF Í TAF)) Ú ((TAV Í TBV) Ù (TBF Ì TAF))[17]
وهذه الصيغة الأخيرة تعبر بكيفية صورية عن الفكرة الحدسية للتقدم باعتباره زيادة نسبية في درجة الدنّو من الحقيقة: مضمون الحقيقة يرتفع، في حين أن مضمون الخطأ لا يرتفع، أو مضمون الحقيقة لا ينخفض، بينما مضمون الخطأ ينخفض.
ويمكن أن ننتقد الكثير من المفترضات المسبقة لهذه المقاربة، منها مفترض قابلية النظريتان A وB للمقايسة (A وB لهما تأويل مشترك).
وهناك نقد مهم يتعلق بالجانب الكيفي الخالص لنظرية بوبر: لا وجود لأي وسيلة لقياس مضمون حقيقة ومضمون خطأ نظرية معطاة، بالشكل الذي يجعل أن فكرتي الدنو من الحقيقة والتقدم النظري تظلان تعريفين ميتامنطقيين خالصين.
والنقد الأكثر جدية نقد داخلي[18]. فحتى لو قبلنا بالمفترضات المسبقة، يمكننا البرهنة على أن التعريف الصوري الذي يقترحه بوبر لفكرة التقدم لا يتوافق مع نظريته في العقلانية. ويمكن بيان أن المعيار الصوري للتقدم
((TAV Ì TBV) Ù (TBF Í TAF)) Ú ((TAV Í TBV) Ù (TBF Ì TAF))
مساو منطقيا لـ:
(TA ¹ TB) É ((TAV Í TBV) Ù (TBF = Æ))
والحال أن مبدأ القابلية للخطأ يعلمنا أن نظرياتنا ليست أبدا خالية تماما من الخطأ، وهذا يعني أن لدينا: TBF ¹ Æ، والتعريف الكيفي الذي يقترحه بوبر للدنو من الحقيقة ليس تعريفا ميتافيزيقيا (بالمعنى الذي تكون به مضامين حقيقة وخطأ نظرية ما من المتعذر معرفتها) فقط، بل أيضا يناقض نظريته في العقلانية.
وإضافة إلى ذلك، لا يتوافق تعريفه مع المقاربة المنهجية للتفنيد. إذ يمكن بيان أننا يمكن أن نحصل على Vs (B) > Vs (A)، في حين أن النظرية B جرى تفنيدها في الواقع، بينما النظرية A تم تعزيزها (صمدت أمام محاولات تفنيدها). ويمكن أن تكون النظرية B منطوية بالفعل على خطأ أقل من A، لكننا وقفنا تجريبيا على خطأ أكبر في B مقارنة بـ A[19].
ويمكن أن نحاول مزاوجة الميتافيزيقا الواقعية للدنو من الحقيقة مع المقاربة المنهجية للتفنيد، وذلك بإضافة مبدأ استقراء إليها- وهذا ما حاول لاكاتوش إقناع بوبر به بدون جدوى. فمن خلال استبعاد الخطأ، يمكننا أن نأمل في بلوغ الحقيقة (كغياب للخطأ) في نهاية المطاف، لكن المطاف لا متناه.
ففي غياب مراجعة للفكرة الواقعية للحقيقة الملازمة للخطاب بشأن الدنو من الحقيقة، فإن النزعة التفنيدية تفضي بنا إلى الصورة المؤسفة لتطور النظريات العلمية كتعاقب ممتد من النظريات الخاطئة. وبينما الإشكالية الداخلية للمقاربة المنهجية لبوبر تواجه بالفعل صعوبات خطيرة، تنضاف انتقادات صادرة عن تاريخ العلوم لبيان أن أ) العلم في تطوره التاريخي لم يطبق النزعة الإبطالية المنهجية لبوبر؛ ب) وحتى لو اعتمد العلم النزعة الإبطالية المنهجية لبوبر، فإنه لن يتمكن من التطور. وهذا النقد سلطت عليه الضوء كتب توماس كون وبول فايرابند.
* العنوان الأصلي للنص المترجم:
Le rationalisme critique. Karl Popper (1902-1994) ونشر كفصل في كتاب:
Histoire comparée de la philosophie des sciences, volume II (L’empirisme logique en débat), Presse de l’université de Laval, Canada, 2010, p. 61-76
[1]- Popper, K., 1928
ومن أجل دراسة مستفيضة لسنوات تكوين بوبر، ينظر:
Hacohen, M., 2000
[2]- بوبر لم يُستضف من طرف شليك Schlick لحضور اجتماعات حلقة فيينا، وخلف لديه ذلك أسى عميقا. لكنه شارك في "منتدى الرياضيات" لكارل مانجر Karl Menger.
[3]- Popper, K., 1934 (1973).
والترجمة الفرنسية استندت على الترجمة الإنجليزية، لكنها لم تُعِد النظر في عنوان "منطق الاكتشاف العلمي" Logique de la découverte scientifique، وهو أمر يؤسف له. ففضلا عن أن البحث والاكتشاف أمران مختلفان، فإن بوبر يتموضع عن قصد في سياق التبرير، وليس في سياق الاكتشاف.
[4]- من أجل سيرة ذاتية فكرية، ينظر:
Popper, K., 1974 (1981).
[5]- Popper, K., 1963 (1985), 72
[6]- المؤلف الكلاسيكي بهذا الشأن هو:
Carnap, R., 1950
[7]- ينظر:
Popper, K., 1990 (1992).
[8]- هناك صياغة تعود إلى بليز باسكال Blaise Pascal، في رسالته إلى المبجل الأب نويل: "ذلك أنه، من أجل جعل فرضية ما بديهية، لا يكفي أن تأتي كل الظواهر موافقة لها، وبدل ذلك، إذا ترتب عنها شيء مخالف لظاهرة ما، فهذا كاف للتثبت من خطئها".
(Œuvres, publiéés avec des instructions et des notices par Henri Massis, Paris, Cités des livres, V. 5, 1926, 82.)
[9]- وهذا ينطبق أيضا على مفهوم الضرورة: التجربة لا يستفاد منها غير العرضي contingent. وقد سار كانط عكس تحليل هيوم من أجل تعريف القبلي a priori بوصفه ما له خاصية الكونية والضرورة.
[10]- ينظر:
Duhem, P., 1906, (1981), chap. VI, § II.
("في أن تجربة في الفيزياء لا يمكنها أبدا الحكم على فرضية معزولة، بل فقط على مجموع نظري") وقد تبنى كوين Quine وجهة نظر دوهيم (في مقابل Hertz, H., 1894) من أجل الدفع بأطروحة محدودية الإثبات الإمبريقي لفرضيات نظرية كهذه، حيث العديد من الفرضيات التحليلية المختلفة يمكنها أن تحكم علاقة الفرضية بالمعطى الملاحظ.
[11]- Popper, K., 1972 (1991), 77
[12]- Ibid., 78
[13]- هذا المفهوم المتعلق بإجراء القياس "المحكوم بالنظرية"، المطبق على الدوال الرياضية التي تدخل في التمثيل المجموعاتي لنظرية ما، قاد إلى المعيار الأصلي لـ "لدالة النظرية بالنسبة لنظرية معطاة" المقترح من لدن سنيد J. D. Sneed (1971).
[14]- أخذ الاتجاه البنيوي لحسابه الخاص الإشكالية الشهيرة للإمبريقيين المناطقة المتعلقة بالحدود النظرية في العلم.
[15]- عقّب ماخ Mach، على أولئك الذين أرادوا إقامة تقابل بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية انطلاقا من أن الواقعة التاريخية لا تحدث إلا مرة واحدة، بالقول: "الطبيعة أيضا لا تحدث إلا مرة واحدة".
[16]- من أجل نقد مفصل نسبيا للمقاربة المنهجية لبوبر، ينظر:
Grünbaum, A., 1976a, 1976b, 1976c, et 1976d.
[17]- ينظر:
Scheibe, E., 1976, 553-554
[18]- نحيل هنا على:
Tichý, P., 1974
وأيضا:
Miller, D., 1974
وكذلك:
Harris, J. H., 1974
[19]- من أجل معالجة أحدث للموضوع، ينظر:
Niiniluoto, I., 1998