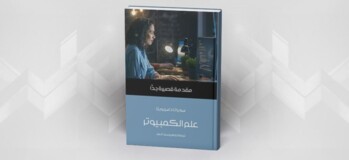عندما تقرأ الروبوتات الكتب
فئة : ترجمات

عندما تقرأ الروبوتات الكتب[1]:
الذكاء الاصطناعي يميط اللثام عن أبعاد جديدة في النصوص الأدبية الكلاسيكية،
وعدم مواكبته قد تهدد مكانة منظري الأدب
إندرجيت ماني[2]
ترجمة: رفيدة جمال ثابت
من أين تأتي الساحرات؟ وما القواسم المشتركة بين مواطن ظهورهن؟ بينما كان عالما الفولكلور، تيموثي تانجريليني Timothy Tangherlini وبيتر بردويل Peter Broadwell، من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، يتصفحان مجموعة كبيرة من الحكايات الشعبية الدنماركية، اعتزما البحث عن الإجابة. وباستخدام فهرس جغرافي وما يقرب من 30,000 قصة، طورا أداة تدعى »ويتش هنتر« أو »صياد الساحرات«، وهي خريطة تفاعلية »جيو دلالية«، تسلط الضوء على بؤر السحر والشعوذة في الدنمارك.
استخدمت الأداة تقنيات الذكاء الاصطناعي واكتشفت مجموعة من الأفكار المدهشة. على سبيل المثال، وجد الباحثان أن السحر الأسود يُمارس غالبًا بالقرب من الأديرة الكاثوليكية، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أن المواقع الكاثوليكية في الدنمارك وصمت بارتباطها بالشيطان بعد الإصلاح البروتستانتي إبان القرن السادس عشر. ومن خلال تتبع المسافة والاتجاه المرتبطين بالسحر بالنسبة لموقع الراوي، أظهرت الأداة كذلك أن الساحرات يتمركزن عادة داخل المجتمع المحلي؛ أي أقرب إلى موطن الراوي مقارنة بأنواع التهديدات الأخرى. وكتب الباحثان: »تشكل الساحرات واللصوص تهديدًا للاستقرار الاقتصادي للمجتمع. ورغم أن الساحرات يمثلن خطرًا داخليًا، فإن اللصوص عادة يعيشون بعيدًا عن القرية الموصوفة بدقة، غالبًا في الغابات أو الأحراش أو البراري... ويبدو أنه أينما أتجه المرء أو ابتعد، لا مهرب من مواجهة ساحرة«.
يطرح علم الفولكلور الحاسوبي تساؤلًا مهمًّا: ما الذي يمكن للخوارزميات أن تكشفه عن القصص التي نحب قراءتها؟ وتبدو الإجابات المقترحة وكأنها تثير مزيدًا من التساؤلات عوضًا عن تقديم أجوبة قاطعة، لا سيما مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. هل من الممكن حقًا تقسيم الأدب إلى عناصر قابلة للتصنيف والتحليل بوصفها معلومات، أم إن تجربة القراءة تنطوي على جانب يتعذر اختزاله أو تبسيطه؟ هل بوسع الذكاء الاصطناعي تعزيز التفسير الأدبي أم سيُغيّر جذريًّا طبيعة النقد الأدبي؟ وهل بإمكان الخوارزميات استنباط المعنى من الكتب كما يفعل البشر، أو حتى ابتكار نصوص أدبية بمعزل عن التدخل البشري؟
العلاقة بين علم الحاسوب ودراسة الأدب ليست ببعيدة كما قد يتصور بعض الناس. ومعظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة تعتمد على أساليب معقدة لاكتشاف الأنماط، وغالبًا ما تتطلب إنشاء علامات أو تصنيفات لمجموعات البيانات الضخمة استنادًا إلى الهياكل التي تنبثق من هذه البيانات. وبالمثل، ظل التركيز على شكل العمل الأدبي وبنيته يشكل جوهر مجال الدراسات الأدبية لفترة طويلة. فنجد أن البنيوية تميل إلى استخدام قراءات دقيقة – وأحيانًا مجهرية – لفهم كيفية عمل النصوص، وكأنها نظام مغلق. ويُعرف هذا النهج عمومًا بأنه نمط "شكلي" من التفسيرات الأدبية، على عكس الأساليب التاريخية أو السياقية الأخرى للقراءة.
لقد أدى التحول الثقافي في الدراسات الأدبية منذ السبعينيات، والمرتكز على الفهم ما بعد الحداثي للعلاقة بين مفهوم السلطة والسرد، إلى ابتعاد هذا المجال عن الأساليب المنهجية شبه الميكانيكية في تحليل النصوص. ورغم أن الذكاء الاصطناعي لا يزال يولي اهتمامًا بالأنماط الشكلية، فإنه قد يُسهم كذلك في تحليل الجوانب الأساسية للسرد، مثل الزمان والمكان والشخصيات والحبكة.
لنأخذ على سبيل المثال الجملة الافتتاحية لرواية »مئة عام من العزلة« (1967) لجابرييل جارسيا ماركيز: «بعد سنوات طويلة، وعندما كان يواجه فصيلة الإعدام، تذكر الكولونيل أوريليانو بوينديا تلك الظهيرة البعيدة عندما اصطحبه والده لاكتشاف الثلج». إن الطريقة المعقدة التي يعبر بها ماركيز عن مرور الزمن تُعد من السمات الجوهرية في الرواية الحديثة. الزمن الذي يتناسب مع عبارة «بعد سنوات طويلة» يشمل لحظة «المواجهة» المصيرية لفصيلة الإعدام، والمتزامنة -بدورها- مع التذكر النهائي الذي يحدث بعد سنوات طويلة من «تلك الظهيرة البعيدة». يرسم ماركيز في جملة واحدة صورة للأحداث في الحاضر العابر، وذكريات الماضي، ورؤى المستقبل.
وفقًا للعديد من الدراسات النفسية، عند قراءة مثل هذه القصص، فإننا ننشئ في أذهاننا خطوطًا زمنية، ونتصور الأحداث ونحدد ترتيبها الزمني، سواء أكانت سابقة أو لاحقة أو وقعت بالتزامن مع بعضها بعضًا، ونقدر كذلك الفواصل الزمنية بينها. وبالمثل، تمكنت أنظمة الذكاء الاصطناعي من تعلم بناء خطوط زمنية لمجموعة متنوعة من النصوص السردية بلغات مختلفة، بما في ذلك الأخبار والحكايات الخرافية والقصص القصيرة وسرديات المرض.
في معظم الحالات، يستخدم هذا التحليل ما يُعرف باسم »التعلم الآلي الخاضع للإشراف«؛ إذ تتدرب الخوارزميات من خلال مجموعات من النصوص مصنفة بعناية ودقة بأيد بشرية. ويمكن تمثيل الأطر الزمنية في السرد باستخدام المعيار الشائع للتعليقات التوضيحية TimeML (والذي أسهمت في تطويره). وبمجرد وضع تعليقات توضيحية على مجموعة نصوص (أو مجموعة ضخمة منها) وإدخالها في برنامج الذكاء الاصطناعي، يتعلم النظام القواعد التي تتيح له تحديد الخط الزمني بدقة في نصوص جديدة أخرى، بما في ذلك الفقرة السابقة من رواية ماركيز. تستطيع أيضًا أداة TimeML قياس إيقاع السرد أو وتيرته، من خلال تحليل العلاقة بين الأحداث في النص والفواصل الزمنية بينها.
يُعدّ وجود »المنعرجات السردية« في الرواية إحدى الأفكار اللافتة التي برزت بفضل هذا النوع من التحليل. ويتجلى ذلك في مقطع من رواية »جان سانتويل« (1952) لمارسيل بروست والمنشورة بعد وفاته، والتي سبقت تحفته العظيمة »البحث عن الزمن المفقود« (1913-1927):
»أحيانًا، عندما يمر أمام الفندق، كان يتذكر الأيام الممطرة عندما كان يُحضر مربيته لهذا المكان في رحلة مقدسة. لكنه كان يتذكرها من دون الشعور بالحزن الذي ظن حينذاك أنه سيعتريه يومًا حين يدرك أنه لم يعد يحبها«.
يتأرجح السرد هنا بين قطبين، كما لاحظ الناقد البنيوي الفرنسي جيرار جينيت Gérard Genette في كتابه »الخطاب السردي« (1983) بين »الآن« الذي يمثل لحظة التذكر الحالية عند مروره أمام الفندق، وبين »حينذاك« المتعلقة بالذكريات المسترجعة، بما في ذلك تلك الأيام الممطرة مع مربيته.
وعلى الرغم من أن مخططات التعليقات التوضيحية التي يستعين بها الذكاء الاصطناعي متعددة الاستخدامات ومعبرة، فإنها ليست معصومة من الخطأ. وبسبب التكلفة الباهظة لوضع التعليقات التوضيحية على النصوص الطويلة، التي تصل إلى حجم الكتب، تظل كفاءة الخوارزميات محدودة بكمية البيانات المتاحة لتدريبها. وحتى لو أضحت هذه العملية أقل تكلفة، فإن أنظمة التعلم الآلي تميل إلى التفوق في السرد البسيط وربط الأحداث المتقاربة داخل النص. وقد ترتبك الخوارزميات عند معالجة السرديات الوصفية التمهيدية، كما يتضح في هذه الجملة من نوفيلا »ساراسين« (1831) للكاتب أونوريه دي بلزاك، فمن المفترض أن الحالات الأربع الموصوفة تتداخل فيما بينها:
»بدت معالم الأشجار، المكسوة بالثلج جزئيًا، غير واضحة ومن خلفها مشهد رمادي شكلته سماء ملبدة بالغيوم، لم يفلح ضوء القمر في إنارتها«.
كما أن نقد الذكاء الاصطناعي مرتبط بدقة المُصنفين البشريين، الذين يتعين عليهم قراءة النصوص التدريبية بدقة وعناية قبل أن تبدأ الخوارزميات في تنفيذ المهام. وتشير التجارب إلى أن القُراء يميلون إلى استغراق وقت أطول في معالجة الأحداث البعيدة زمنيًّا أو التي تفصل بينها فترات زمنية (مثل بعد يوم). وتفتح هذه المعالجة مجالًا للخطأ، لكن يمكن تقليله من خلال تزويد المستخدمين بإرشادات تعليق موحدة. كما يواجه القراء صعوبة في تصور الحالات الزمنية المعقدة، مثل تلك الموصوفة في رواية »أحلام أينشتاين« (1992) للكاتب آلان لايتمان Alan Lightman:
»للزمن ثلاثة أبعاد في هذا العالم، شأنه شأن المكان … كل مستقبل يتحرك في اتجاه زمني مختلف. وكل مستقبل منهم حقيقي. وفي كل لحظة يُتخذ فيها قرار، سواء أكان زيارة امرأة في فرايبورغ أو شراء معطف جديد، ينقسم العالم إلى ثلاثة عوالم، جميعها تضم نفس البشر، ولكن مصائرهم تختلف. في الزمن، ثمة عدد لا نهائي من العوالم«.
قد يكون رصد الأنماط الزمنية ممتعًا ومفيدًا، بيد أن الأدب أكثر من مجرد مجموع المعلومات الكامنة في أنماطه. بالطبع، هناك جوانب فينومينولوجية في السرد القصصي تظل مستعصية على الوصف والتعبير، بما في ذلك العمل الأدبي في مجمله. ومع ذلك، فإن تفسير الأدب يعتمد غالبًا على عملية استدلالية. فهو يتطلب غربلة ومقارنة أجزاء من المعلومات المتعلقة ببنية الأدب وسياقه؛ من النص نفسه، وخلفيته التاريخية والثقافية، وسير المؤلفين، والمراجعات النقدية، وردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجارب القراء السابقة. كل ذلك يمثل بيانات يمكن استخراجها واستغلالها بكفاءة.
في رأيي، ليس من المستحيل أن أتصور أن الآلة قد تتمكن يومًا من محاكاة المشاعر التي تراودنا عند قراءة القصص. في الوقت الراهن، لا تزال أنظمة الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى البراعة لفهم أحد العناصر الأساسية في الكيفية التي يستنبط البشر بواسطتها المعنى من النصوص ألا وهو القدرة على تمييز السياق الذي تنبثق منه العبارات. غير أنها تشهد تحسنًا، إذ تبرز أنظمة الاكتشاف التلقائي للمشاعر والسخرية بعض الروابط الخفية الكامنة تحت سطح النصوص. وفي الوقت نفسه، شرعت أيضًا الروبوتات الاجتماعية في تحسين ذكائها العاطفي.
مثل العديد من متخصصي الذكاء الاصطناعي، تحمل رؤيتي طابعًا فلسفيًا وظائفيًا؛ فأنا أعتقد أن الحالة المعرفية، كتلك النابعة من القراءة، لا ينبغي تعريفها بناءً على مكوناتها الآلية أو البيولوجية، بل بناءً على طريقة أدائها في علاقتها بالمدخلات والمخرجات والحالات المعرفية الأخرى. (يشمل معارضو الوظائفية علماء السلوك، الذين يؤكدون أن الحالات الذهنية ما هي إلا استعدادات للسلوك بطرائق معينة؛ وأنصار نظرية تماثل العقل والدماغ، الذين يجادلون أن الحالات الذهنية متطابقة مع حالات عصبية محددة، ومرتبطة بأجهزة بيولوجية معينة).
من المنظور الوظائفي، يمكن القول إن الآلات «تختبر» بعض الحالات الإدراكية الأساسية. فعبارة «فهمت سيري طلبي»، بالنسبة إلى جهاز الآيفون، تعني أن سيري عالجت طلبي لتحقيق نتيجة وظائفية مرغوبة. وبالمثل، فإن عبارة «النظام يفهم العلاقات الزمنية»، في سياق خوارزمية لتحليل النصوص، تشير ببساطة إلى أنه استوعب وأنتج خطًا زمنيًّا وظائفيًّا يماثل ما ينتجه البشر. كما تتيح النظرة الوظائفية مقارنة التجارب الكيفية أو الكيفيات المحسوسة «qualia». لديّ تجربتي الشخصية في ترجمة آخر قصيدة هايكو كتبها ماتسو باشو Matsuo Bashō، الشاعر الياباني الذي عاش في القرن السابع عشر:
سقيم في رحلة- بين الحقول الجافة تهيم الأحلام.
وعلى الرغم من أن تجربتي في قراءة هذه السطور ذاتية ومختلفة عن تجربة القراء الآخرين، فإنه يمكن مقارنتها بتجربتك - أو حتى بتجربة الكمبيوتر - من خلال اختبارات تجريبية تقيس مدى التشابه في ردود أفعالنا.
قد يبدو هذا النوع من التحليل التجريبي غريبًا على ذوق قارئ الأدب الروائي أو الشعر. فالخوارزميات ما زالت بعيدة كل البعد عن محاكاة القدرات البشرية في إنتاج مختلف أنواع المخرجات الوظيفية عند استيعاب النصوص. ولكن إذا تعذرت مقارنة التأثيرات المختلفة لتجارب القراءة الذاتية، لما كان من المجدي الحديث عن تجاوب الناس مع الأدب، سواء أكان ذلك بين الكاتب والقارئ أو بين مجموعة من القراء المختلفين. إلا أن هذا ما يقوم به الأدب تحديدًا. وسواء أعجبنا ذلك أم لا، فإن تقسيم النصوص إلى أجزاء قابلة للمقارنة أصبح جزءًا لا يتجزأ من أدواتنا النقدية. ومع تقدم البحث في مجال الذكاء الاصطناعي، يبدو أن هذا النوع من التحليل الوظائفي الحاسوبي سيغدو أكثر أهمية.
قد تواجه الخوارزميات تحديات في فهم السياق، لكنها تبرع في تمحيص كميات هائلة من البيانات. وهذا ما يجعلها مناسبة تمامًا لـ »القراءة البعيدة«، كما يسميها فرانكو مورتي Franco Moretti خلال عمله في مختبر الأدب في جامعة ستانفورد؛ ومعناها التحليل الأدبي الشامل لمئات أو حتى آلاف النصوص من منظور كلي. ومن خلال معالجة هذه البيانات الضخمة، يأمل مورتي وأتباعه في اكتشاف جوانب من الأدب خفية على الدارسين الذين يكتفون بقراءة النصوص.
يُعد الحوار بين الشخصيات أحد المجالات التي أثبتت فيها المنهجيات الحاسوبية تفوقًا على ادعاءات دارسي الأدب، حتى أولئك ذوي الميول العلمية. في كتابه »أطلس الرواية الأوروبية« (1999)، زعم مورتي أن البيئة الحضرية الصاخبة في عديد من روايات القرن التاسع عشر تميل إلى احتواء مزيد من الشخصيات، لكنها تشمل حوارات أقل، مقارنة بالروايات التي تدور أحداثها داخل الأسرة في القرى أو الريف. وقد قرر فريق من علماء اللغويات الحاسوبية ودارسو الأدب في جامعة كولومبيا بالتحقق من صحة هذه الفرضية، باستخدام برامج تقوم ببناء شبكة اجتماعية للمحادثات استنادًا إلى مجموعة تضم 60 رواية من القرن التاسع عشر.
حللت البرامج كل جملة من حيث تركيبها النحوي، وبحثت عن إشارات إلى الأشخاص المشاركين في الحوار. كما حددت مقاطع الاقتباس ونسبتها إلى المتحدثين، ما مكن النظام من التعرف بدقة على الأطراف المشاركة في الحديث. ورغم أن نظرية مورتي توقعت علاقة عكسية بين حجم الحوار وعدد الشخصيات، فإن الباحثين لم يجدوا تأثيرًا إحصائيًّا ملحوظًا. عوضًا عن ذلك، تبينوا أن الصوت السردي، كالسرد بضميري المتكلم أو الغائب، كان أكثر أهمية من البيئة الحضرية أو الريفية.
تمثل الشخصيات مجالًا آخر يزخر بإمكانيات الفحص التجريبي. يمتلك القراء عادة حدسًا قويًّا تجاه الشخصيات الخيالية. فنحن ندرك بصمة المؤلف الفريدة، ونتعرف على الشخصيات الديكنزية أو الكافكاوية على سبيل المثال. كما نستنبط أن الشخصيات تنتمي إلى فئات وظيفية معينة في مختلف الأعمال الأدبية. مثلًا، من الواضح أن شخصية شريرة مثل اللورد فولدمورت يشبه الكونت دراكولا أكثر مما يشبه خصمه البطل هاري بوتر.
استعان ديفيد بامن David Bamman، عالم اللغويات الحاسوبية الذي يعمل الآن في جامعة كاليفورنيا ببيركلي، وزملاؤه، بقاعدة بيانات ضمت أكثر من 15 ألف رواية لإنتاج نموذج إحصائي بايزي يمكنه التنبؤ بأنواع مختلفة من الشخصيات. واستخدموا خصائص مثل الأفعال التي تؤديها الشخصية وسماتها والأشياء التي تمتلكها. وتمكن النظام من تحديد الحالات التي تكون فيها شخصيتان للمؤلف نفسه أكثر تشابهًا مقارنة بشخصية أخرى لمؤلف آخر. وقد أظهر النظام أن ويكهام في رواية جين أوستن »كبرياء وهوى« (1813) يشبه ويلوبي في روايتها »عقل وعاطفة« (1811)، أكثر من تشابههما مع السيد روتشستر في رواية »جين آير« (1847) لشارلوت برونتي.
يمكن للكمبيوتر أيضًا التعرف على الفروقات الدقيقة بين الشخصيات الرئيسة للمؤلف نفسه، على سبيل المثال، في كونها أكثر عمقاً في التفكير. على سبيل المثال، يشير النظام إلى أن إليزابيث بينيت في »كبرياء وهوى«، إحدى أشهر شخصيات أوستن، تشبه إلينور داشوود في »عقل وعاطفة«، أكثر من تشابه أي من الشخصيتين مع والدة إليزابيث الغبية والمهووسة بالزواج السيدة بينيت. ورغم صعوبة شرح الآليات الكامنة وراء هذه البديهيات البحثية، فإن الكمبيوتر ينجح بسهولة في التعرف عليها واختبارها.
كما أصبحت الخوارزميات ماهرة في تحليل العلاقات المعقدة بين الشخصيات. على سبيل المثال، طور عالم الكمبيوتر موهيت إيير Mohit Iyyer وزملاؤه في جامعة ميريلاند نظامًا قادرًا على تتبع المسار الصحيح للعلاقة بين آرثر ولوسي في رواية »دراكولا« (1897) لبرام ستوكر، والتي تبدأ بالحب وتنتهي بالقتل. ويمكن لهذا النظام اكتشاف العديد من المسارات الأخرى من قاعدة بيانات تضم أكثر من 1300 رواية، وهي استنتاجات قد يستغرق باحثو الأدب وقتًا طويلًا لاكتشافها.
ليس من الصعب تصور سيناريو قريب المدى يُمكن فيه تتبع شخصيات مثل روبن هود عبر الزمن في النصوص المختلفة. فيظهر في البداية مجرمًا شرسًا معادٍ للكنيسة، يسرق الأغنياء ليساعد الفقراء، ثم يتحول في نسخة القرن التاسع عشر إلى بطل شعبي يقاتل النبلاء النورمان، لينتهي به المطاف ثعلبًا في فيلم من أفلام ديزني. بالنسبة إلى الباحثين الذين يهتمون بالتحولات الثقافية في الدراسات الأدبية، فإن تفاصيل تحول روبن هود عبر الزمن تطرح رؤى عميقة حول الصراع الطبقي، وتداخل الأدب مع السلطة، وقيود الترفيه الجماهيري وضغوطه.
في عام 1928، نشر الناقد البنيوي الروسي فلاديمير بروب Vladimir Propp قائمة تضم 31 نمطًا سرديًا أو »وظيفة«، تمثل الأنماط الأساسية التي تستند إليها الحكايات الشعبية الروسية الشائعة. وفي الوظيفة السردية »الشر«، على سبيل المثال، يختطف الشرير شخصًا، بينما في »تلقي مساعد سحري«، تضع الشخصية نفسها تحت تصرف البطل.
هل بوسع الذكاء الاصطناعي اليوم إنشاء وتطوير وظائف السرد التي وضعها بروب؟ في أطروحته في مجال الذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بنى عالم الكمبيوتر مارك فينلايسون Mark Finlayson نظامًا استند إلى ترجمة إنجليزية مشفوعة بالشروحات لنصوص بروب الروسية. واكتشف عدة هياكل سردية جديدة، فوجد -مثلًا- أن الاختطاف والاحتجاز والتعذيب يعد من سمات الشر البروبي.
قبل ظهور هذا النوع من التحليل، كان العثور على أشكال الفولكلور ودراسته يستغرقان سنوات من القراءة الدقيقة والتحليل العميق. ورغم أن البنيوية لم تعد رائجة بين دارسي الأدب، فإن التطبيقات الحاسوبية لهذه الأفكار أفضت إلى نتائج مدهشة. وباستخدام وظائف بروب السردية، طور فريق من الباحثين في الذكاء الاصطناعي في جامعة كومبلوتنس بمدريد نظامًا يُعرف باسم »بروبر رايتر« «PropperWriter»، والذي يولد تلقائيًا حكايات خرافية روسية. ورغم أن النتائج لا تزال بدائية، فإنها مثيرة للاهتمام:
منذ زمن بعيد، عاشت أميرة. نُهيت الأميرة عن مغادرة القصر. خرجت الأميرة. سمعت الأميرة عن اللبؤة. اللبؤة أخافت الأميرة. اللبؤة اختطفت الأميرة. غادر الفارس. تصارع الفارس مع اللبؤة. انتصر الفارس. حل الفارس مشكلة الأميرة. عاد الفارس. تلقى الفارس كنزًا كبيرًا.
وقد وسع الفريق الأداة منذ ذلك الحين لإنشاء خطوط درامية للمسرح الموسيقي، بما في ذلك »ما وراء السور«، وهي أول مسرحية موسيقية من ابتكار الكمبيوتر، واستمر عرضها عدة أسابيع في مسرح الفنون بلندن هذا العام.
تطرح هذه التجارب احتمالية مثيرة للاهتمام وهي أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تصير قادرة على الإبداع الأدبي في المستقبل. قبل عدة سنوات، قام مارك كافازا Marc Cavazza وزملاؤه في جامعة تيسايد في ميدلزبره ببناء نظام سرد قصص تفاعلي يغمر المستخدم في الواقع الافتراضي، باستخدام مقتطفات من رواية جوستاف فلوبير »مدام بوڤاري« (1857)، وتولى المستخدمون دور إحدى الشخصيات وتفاعلوا مع إيما بوڤاري للتأثير على مجريات الحبكة. وأنشأ المطورون قائمة بمشاعر الشخصية بناءً على الدراسات الأولية التي أجراها فلوبير في الرواية.
في أحد المسارات داخل النظام، وعندما تستمر علاقتها الغرامية لفترة طويلة، لا تكترث إيما للمخاطر المرتبطة بالخيانة، وتتأثر أيضًا بسطوة رودولف عليها. وتُعدّ هذه الحالات شروطًا مسبقة للتعبير عن مشاعرها لرودولف، ما يدفعها لأن تخبره: »هناك أوقات أشتاق لرؤيتك مجددًا«. في هذه اللحظة يمكن للمستخدم (الذي يؤدي دور رودولف) أن يرد ويقول: »سأتركك ولن أراك مرة أخرى«. هذا الرد سيثير غضب إيما ويفضي إلى سلسلة من الأحداث، بما في ذلك الندم على الوقوع في حب رودولف، واكتشاف السعادة في الحياة العائلية (وهي نتيجة لم تكن لتروق لفلوبير لو كان على قيد الحياة). وفي حالات أخرى، انتهى الأمر بالمستخدمين بتقليص القصة بصورة كبيرة عبر تقديم مدخلات عاطفية مفرطة إلى شخصية إيما التي كانت بالفعل مشحونة عاطفيًا.
في الآونة الأخيرة، ركز الباحثون على تطوير مسلسلات طبيّة بأسلوب الرسوم المتحركة، تتضمن شخصيات افتراضية مثل الأطباء والمرضى وطاقم التمريض. ويمكن للمشاركين تحديد علاقات اجتماعية معينة بين الشخصيات، مثل العداء الشديد بين شخصيتين. هذه الخيارات تؤدي إلى أحداث سردية غير متوقعة، مثل انتشار الشائعات المغرضة، ما يخلق حلقة يمكن للمستخدمين مشاهدتها.
ليس بالضرورة أن يكون هناك صراع بين تحليل البيانات الحاسوبي والتفسير الأدبي »التقليدي« يفوز فيه أحدهما. لقد بدأت التكنولوجيا الرقمية في طمس الحدود الفاصلة بين المبدعين والنقاد. وبالمثل، ينبغي على نقاد الأدب توظيف خبراتهم الواسعة بشكل مبتكر في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، كما فعل بردويل وتانجريليني في أداة »ويتش هنتر«. ومن دون مساعدة الخوارزميات، سيواجه الباحثون صعوبة بالغة في الوصول إلى هذه النتائج المدهشة، لا سيما مع تزايد حجم الكتابة وتنوع أشكالها عبر الإنترنت.
من المرجح في المستقبل أن يتفوق الباحثون الذين يستعينون بأدوات المساعدة الرقمية على غيرهم، ما يثري ثقافتنا الأدبية ويوسع نطاق الأسئلة المطروحة. أما الرافضون لاستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي فسيضطرون إلى الاكتفاء بما تمنحه الاكتشافات المحدودة والقليلة من متع. وفي حين أن النقاد ومراجعي الكتب سيظلون جزءًا لا يتجزأ من الحياة الثقافية العامة، فإن منظري الأدب الذين لا يتقبلون الذكاء الاصطناعي سيفقدون أهميتهم ويتضاءل دورهم مع مرور الوقت، مثل أمناء المكتبات الذين اعتادوا استخدام بطاقات الفهرسة للبحث عن المعلومات.Bottom of Form
[1] - رابط المقال:
https://aeon.co/essays/how-ai-is-revolutionising-the-role-of-the-literary-critic
[2] - إندرجيت ماني Inderjeet Mani هو عالم لغويات حاسوبية مقيم في تايلاند. شغل سابقًا منصب أستاذ مشارك متقاعد في قسم اللغويات بجامعة جورجتاون، وكان أيضًا عالمًا رئيسا سابقًا في مختبرات ياهو. صدرت له عدة مؤلفات منها "اللحظة المتخيلة" (2010) و»النمذجة الحاسوبية للسرد« (2012). كما نشر العديد من الأبحاث الأكاديمية والقصص القصيرة.