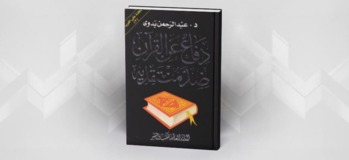فجر جديد: الآثار والتراث
فئة : ترجمات
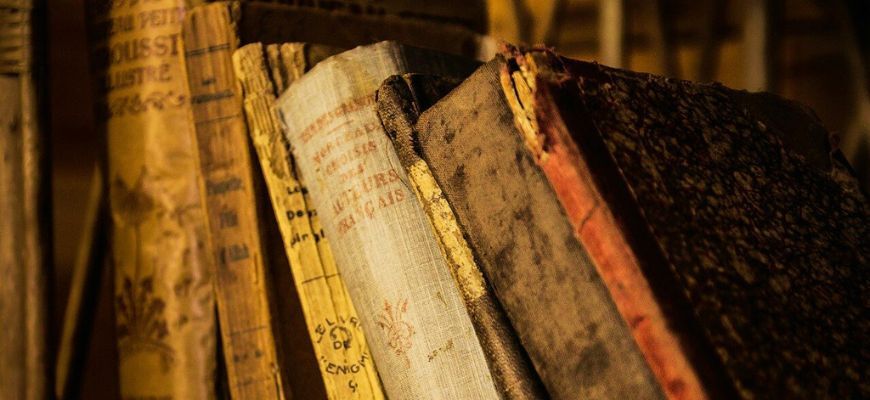
فجر جديد: الآثار والتراث[1]
مات عيسى في أورشليم في الرابعة والثلاثين من عمره، ضحيّة إعدام مُهين على يد مضطهدي يهودا الأجانب. محمّد، الذي نجا في وقت سابق من تهديد بالقتل من أعداء مألوفين لديه، مات في سريره في المدينة لأسباب طبيعيّة عن عمر يناهز الثّانية والستّين، كما ذُكر، ولكن من المرجّح جدّاً أنّه كان في الخمسينيات من عمره. التّماثل الوحيد بين الرّجليْن هو أنّهما بدأا حياتهما العامّة في نفس العمر تقريباً، في بداية الثلاثين من عمرهما. لم تدم حياة عيسى العامّة سوى سنتيْن أو ثلاث، بينما امتدّت حياة محمّد أكثر من اثنيْن وعشرين أو ثلاثة وعشرين عاماً.
ما بعد عيسى
تُنهي أناجيل العهد الجديد، التي هي مصدرنا الرّئيس لحياة عيسى، روايتها عنه في أورشليم بإنزال جثّته عن الصّليب الذي مات عليه ووضْعها في حُجرة قبر قريبة محفورة في الصّخر. تمّ دحرجة حجر كبير عند المدخل لحماية الجسم من عبث النّاس والحيوانات، وربّما فقط من لصوص القبور بدافع نواياهم السّياسيّة أو اللّاهوتيّة. يقدّم متّى هذه الفكرة تحديداً. يذهب الكهنة والفرّيسيّون إلى بيلاطس ويطلبون حارساً للقبر لمنع أتباع عيسى من سرقة الجسد بدعوى أنّه «سيقوم من بين الأموات» (27: 62-66). هناك متابعة سرديّة في (28: 11-14). يخبرنا متّى أنّه عندما يُكتشف القبر الفارغ، يقوم نفس الكهنة برشوة الحارس الرّوماني ليخبروا بيلاطس أنّ هذا ما حدث بالضّبط. لقد فعلوا ذلك، ثمّ نصِل إلى النّقطة المركزيّة في رواية متّى وفي ذات الوقت مع الحصول على لمحة خاطفة عن ردّ الفعل اليهودي المعاصر تجاه عيسى. يخبرنا المؤلّف أنّ «القصّة أصبحت شائعة على نطاق واسع في الأوساط اليهودية حتّى يومنا هذا» (28 :15).
لم تكن النهاية القصيرة جدّاً وغير الموفّقة تماماً لمسيرة يسوع النّاصري، الجليليّ المتجوّل صاحب الشّخصيّة الفذّة الذي ادّعى أنّه «ابن الإنسان» المسياني حسب سِفر دانيال. لقد تمكّن من تحريك بعض المياه المحلّية الرّاكدة وحتّى أنّه جعل قليلها يتدفّق في أورشليم. كما تمكّن من جلب بعض الأتباع، ليس كثيراً على ما يبدو، وخلق أيضاً أعداء في مناصب عليا لسبب غير مفهوم، وكانوا هم الذين قتلوه. مات الزّعيم وتفرّق أتباعه، على الرّغم من أنّه لم يتمّ القبض على أيّ منهم أو ملاحقته في هذه المرحلة. لكن في يوم الأحد بعد إعدام عيسى في جمعة عيد الفصح، بدأت قصّة جديدة تنتشر، أو هكذا تخبرنا روايات الإنجيل: لقد قام يسوع النّاصري من بين الأموات!
في هذه المرحلة، حيث يصبح أتباع يسوع أكثر التزاماً، يفقد المؤرّخ المعاصر السّيطرة على قصّة عيسى: المسيح القائم من بين الأموات ليس موضوعاً مناسباً أو حتّى تحقيقاً تاريخيّاً مُجدياً. ولكن توجد بالفعل مادّة تاريخيّة هنا، لا سيّما في طبيعة البناء والعرض النّاجح تماماً لدعوى أتباع عيسى الحاسمة حول قيامته.
القبر الفارغ
إذا رسمنا خطّاً خلال الإنجيليْن الإزائييْن الآخريْن إلى النّقطة التي يبدو أنّ الصّيغة الأصلية من إنجيل مرقُس تنتهي أو تنقطع عندها (مرقس 16: 8 = متّى 28: 8؛ لوقا 24: 9)، فستبقى لدينا حقيقة متّفق عليها بالإجماع، وهي حقيقة قبر عيسى الفارغ ومعضلة التّفاصيل للحجر الكبير الذي كان ينبغي استخدامه لإغلاق القبر. يمكننا أن نفترض أنّه عندما رُويت هذه القصّة لأوّل مرّة، كان الجميع على علم بأنّ القبر الفارغ قد تمّ اكتشافه يوم الأحد عند الفجر -ومرّة أخرى هناك اتّفاق بالإجماع على هذه التّفاصيل- من قِبل النّساء اللّائي كنّ ذاهبات على الأغلب لإتمام الخدمة الرّسمية لغسيل الجثّة، ودهنها بزيوت عطريّة وأطياب (1). ولو كان الجميع يعلمون أنّ النّساء كنّ أوّل الواصلات إلى مكان الحادث، لكان إغلاق القبر مشكلة، ربمّا لا يمثّل ذلك مشكلة بالنّسبة إلى أتباع عيسى الذّكور إذا كانوا أوّل الواصلين، ولكن بالتّأكيد بالنّسبة إلى النّساء.
تمّ حلّ المعضلة بطريقة خارقة للطّبيعة؛ لا يقول مرقس بالضّبط كيف ذلك، ولكن عندما وصلت النّساء، كان القبر مفتوحاً، وكان هناك شابٌّ يرتدي حلّة بيضاء، ملاك في هيئة إنسان، أخبرهنّ أنّ يسوع قد قام ومضى إلى الجليل (16: 5). يحرص مرقس خاصّة على التّأكيد بأنّ القبر فارغ. مَن الذي أزال الحجر الكبير؟ متّى هو الوحيد الذي يُورد ما قاله الشّابّ صاحب الحلّة البيضاء: «كان هناك زلزال عظيم. نزل ملاك الرّبّ من السّماء ودحرج الحجر وجلس عليه» (28: 2).
وهكذا إذن، يتّفق الشّهود على أنّ بعض النّساء من أتباع يسوع هنّ اللّائي اكتشفن قبر عيسى الفارغ يوم الأحد خارج أسوار أورشليم. وتمّ الاتّفاق أيضاً على أنّ واحدة من بينهنّ كانت مريم المجدليّة، وهي في الحقيقة، كبيرتهنّ، وهي الوحيدة التي تمّ إثباتها في جميع الرّوايات، ومريم من مجدل، وهي قرية صيد سمك في الجليل، «التي أخرج منها عيسى سبعة شياطين» (مرقس 16: 9) (2).
تتّفق الأناجيل الأربعة على أنّ مريم المجدلية، مع المرأتيْن الأخرييْن اللّتيْن وقفتا بجانب الصّليب إلى النّهاية، هنّ اللّائي ذهبن إلى القبر صباح يوم الأحد (3). وجدن الحجر قد دُحرج من مدخل القبر والحجرة فارغة. استقبلهنّ ملاك الرّبّ، وهو نفسه الذي، وفقاً لمتّى، دحرج الحجر. أخبرهنّ بأنّ عيسى قد قام من بين الأموات وعاد إلى الجليل، فلا داعي للخوف. وأمرهنّ بالذّهاب وإخبار التّلاميذ «أخبرن التّلاميذ» (متّى 28: 7؛ لوقا 24: 9). يشكّك الرّسل في القصّة (لوقا 24: 10-11)، لكن في النّهاية سيذهب بطرس، وربّما يوحنّا للتّحقّق من الأمر(20: 3). اكتشفوا أنّ القبر فارغ بالفعل. يحتوي الإنجيل الرّابع على رواية عرضية (يوحنّا 20: 1-10). دخل الرّجلان القبر، يتقدّمهما بطرس بصورة جليّة، ووجدا الكفن المهمل ملقى هناك، ثمّ غادرا المكان ولكنّ مريم المجدلية بقيت في البستان. ظهر لها عيسى فجأة. في البداية ظنّت أنّه البستاني، ولكن عندما تعرّفت عليه وحاولت احتضانه، قيل لها بشيء من الغموض: «لا تلمسيني لأنّي لم أصعد بعد إلى الأب» (يوحنّا 20: 11-18) (4)، ثمّ يطلب منها أن تذهب وتخبر تلاميذه أنّه «صاعد إلى أبي وأبيكم، إلى إلهي وإلهكم».
هذه هي الرّوايات مُختصرةً لما حفظته من أحداث وقعت مباشرة بعد صلب عيسى. عندما ننظر عن كثب إلى الأدلّة، نلاحظ أنّه في حالة الاستغناء عن الملاك، تكون الشّهادة واضحة نسبياً: تكتشف بعض النّساء من أتباع عيسى، قبيل فجر يوم الأحد، وبعد حوالي أربعين ساعة من دفنه، أنّ قبر عيسى فارغ. يُستبعَد أن يكون هذا القدر من المعلومات، الذي كان من السّهل التحقّق منه، قدّ تمّ اختلاقه. وتُضاف معلومات أخرى من الشّابّ الملائكي الجالس أو الواقف داخل القبر: «لقد قام. هو ليس هنا» (مرقس 16: 6). يقول المُؤرّخ: توقّف! يمكن التّسليم بأنّه لم يكن هناك؛ أمّا أن يكون قد قام من بين الأموات فتلك مسألة مختلفة تماماً.
روايات القيامة
من بين مصادرنا الأربعة الرّئيسة عن عيسى، يبدو أنّ أحدها، وهو مصدر الأقوال Q، غير مدرك -أو يتجاهل- كلّاً من موت وقيامة عيسى، في حين أنّ مصدراً آخر، وهو إنجيل مرقس، يعرف عن القبر الفارغ، ولكنّه يبدو شبه متغافل عن روايات قيامة عيسى (5). ولكن، وكما رأينا، لم يكن الأمر كذلك تماماً. يقول (مرقس 16: 7) إنّ ذاك «الشّابّ... يرتدي حلّة بيضاء، ويجلس على يمين مكان الدّفن يقول للنّساء المؤمنات اللّاتي وجدن قبر عيسى مفتوحاً وفارغاً في صباح ذلك اليوم الأحد، لقد قام. هو ليس هنا... اذهبن وقلن لتلاميذه ولبطرس، إنّه يسبقكم إلى الجليل. هناك ترونه، كما قال لكم». لكنّ القصّة تنتهي عند هذا الحدّ في صيغة مرقس الأصلية: نحن لم نُؤخَذ إلى الجليل؛ نحن لم نشهد قيامة عيسى. المصدر الوحيد الذي ذكر قيامة عيسى من القبر هو يوحنّا، الذي يروي، كما رأينا للتّو، أنّ عيسى قد ظهر لمريم المجدليّة في بستان الدّفن، حتّى قبل أن يقدّم نفسه إلى الاثنيْ عشر.
بولس
إنّ مصدرنا الرّابع، بولس -ومؤلفّي جميع الوثائق الأخرى في العهد الجديد بالتّأكيد- يَعتبر قيامة يسوع النّاصري من بين الأموات أمراً مفروغاً منه. كتب بولس، الذي يُعدّ تقريباً أقدم مصادرنا عن عيسى وحركته، إلى زملائه المؤمنين في كورنثوس في أواخر خمسينيات القرن الأوّل وحتّى قبل ذلك، بشأن ما نقله إليهم؛ أي «المأثور الذي تلقّيته... لقد دُفن [يسوع] وقام في اليوم الثّالث وفقاً للكتابات المقدّسة» (1 كورنثوس 15: 4). إنّ هذا المأثور هو في حقيقته تأكيد وليس سرداً وصفياً، كما أنّه يشبه تماماً ما قاله ملاك الرّبّ للنّساء عند القبر.
لكنّ بولس لم ينته بعد. كان الإيمان بقيامة عيسى هو حجر الزّاوية للإيمان الجديد. يقول بولس للمؤمنين إنّه بدون القيامة تكون «موعظتي باطلة وإيمانكم باطلاً» (1 كورنثوس 15: 17). يجب التحقّق من هذا الحدث المهمّ، وبالنّسبة إلى بولس وأيّ شخص آخر، فقد تمّ إثبات حقيقة قيامة عيسى من بين الأموات بشكل قاطع من خلال ظهوره لعدد من النّاس بعد الصّلب وما بعد الدّفن. وفقاً لبولس، ويجب أن نفترض أنّه كان يكرّر ما أصبح في ذلك الوقت صيغة مسيحيّة، فقد ظهر عيسى القائم من بين الأموات «لصفا [بطرس] ثمّ للاثنيْ عشر»، وكذلك للشّهود الآخرين -لا ذكر لمريم المجدلية هنا- ثمّ ظهر «لأكثر من خمسمائة من الإخوة في الوقت نفسه، ما زال معظمهم على قيد الحياة، وتوفّي بعض منهم، ثم ظهر ليعقوب ثم لجميع الرّسل» (1 كورنثوس 15: 3-8).
تُختتم هذه المجموعة من الشّهادات غريبة التّركيب بملاحظة مميّزة لا تضيف شيئاً إلى ثقتنا (الحديثة): «أخيراً»، يقول بولس، «لقد ظهر لي أيضاً» (15: 9). من خلال شهادته الخاصّة، فإنّ بولس، الذي لم يسبق له أن التقى عيسى أو رآه مباشرة، حصلت معه «تجربة» شخصية جداً في طريق العودة إلى دمشق (غلاطية 1: 15-16). وقد وصف لوقا هذه التّجربة ثلاث مرّات، في أعمال الرّسل 9: 3-9، 22: 6-11، 26: 12-18، وفي كلّ مرّة على أنّها لقاء سمعيّ/ شفهيّ. بولس يستمع إلى عيسى ويتحدّث معه. دون أن يراه على ما يبدو. هل هذه هي اللّحظة التي «ظهر» فيها عيسى لبولس؟ مهما كانت الظّروف، فإنّ هذا اللقاء هو على الأرجح أساس سلطة بولس «الرّسول»: «لم يعلّمني إيّاه (الإنجيل) أحد... تلقّيته بوحي عيسى المسيح» (غلاطية 1: 12).
بصرف النّظر عن «تجربته» الخاصّة، يبدو أنّ ظهور «مأثور» بولس فيما يتعلّق بالقيامة يعود إلى وقت مبكّر، على الأرجح إلى أوّل لقاء له لمدّة أسبوعين مع بطرس ويعقوب في أورشليم (غلاطيّة 1: 18-19)، والذي ربّما حدث هو أيضاً في وقت مبكّر مع بداية سنة 37م. كما أنّ الصّياغة في افتتاحية رسالة رومية (1: 4)، التي تقول: «إنّه [يسوع] أُعلِن ابن الله بفعل القوّة التي بعثته من بين الأموات» هي على الأرجح مبكّرة كذلك.
شكوك
إذا كانت قيامة عيسى هي حجر الزاوية في الحركة المسيحية الجديدة «جديدة»، الجديدة بمعنى أنّها لم تكن جزءاً من «بشارة» عيسى، فلماذا لم يتمّ ذكرها في Q وتمّ تضمينها بطريقة غير مؤكّدة كفكرة عابرة في مرقس؟ يتمثّل الحلّ الأكثر بساطة في أنّ Q قد تمّ جمعه أو تأليفه كوثيقة -مهما كان هدفها- لكلمات عيسى، ربّما في حياته، أو ربّما بعد وفاته مباشرة، حيث يبدو أنّ انعكاس هذا الحدث قد كان ضعيفاً في المجموعة، وبالتّأكيد قبل أن تبدأ قصص القيامة في الانتشار. يعرض إنجيل مرقس مشكلة أكثر صعوبة. يتعلّق الأمر بتأليفٍ كان أحد أهدافه، وربّما هدفه الرّئيس، في ظاهره شرح موت عيسى بالإعدام. وهو يعرض ذلك بالتّفصيل، في حين يذكر حقيقة قيامته بشكل عابر تقريباً (16: 7)، يبدو أنّه يتجاهل أهمّية وجود الشّهود، هذا الوجود الذي يُعدّ محوريّاً في بولس، لإثبات أنّ قيامة عيسى قد حدثت فعلاً.
وكما ذكرنا سابقاً، فإنّ تحديد تاريخ مرقس، وهو أقدم الأناجيل، يتوقّف فقط على إمكانية إيجاد إشارة مقنعة إلى حصار أورشليم وتدميرها في الإصحاح 13 من هذا الإنجيل. بالنّسبة إلى القلّة الذين لم يتمكّنوا من العثور على ذلك هناك، وجب حتماً إرجاع تاريخ مرقس إلى ما قبل عام 70 بعد الميلاد، مع أنّ التّحديد الدّقيق لذلك لا يزال سؤالاً مفتوحاً. لذلك، ونظراً لعدم وجود خطاب للقيامة، فمن الممكن تصوّر أنّ مرقس كان قد كُتب قبل بولس، في زمان ومكان حيث كان صلب المسيح هو المسألة المحوريّة. التّفسير البديل هو الإبقاء على التّاريخ التّقليدي حوالي 70 ميلادي والاعتقاد بالأحرى في أنّ النّهاية الأصليّة، مع ظهور القيامة التي تمّ التنبّؤ به بالفعل في 16: 7، قد ضاعت في إنجيل مرقس -وهذا من شأنه أن يفسّر الغرابة النّحوية للآية 8- وأنّ شخصاً ما حاول بعد ذلك تدارك ما ضاع بإضافة ما يسمّى ملحق مرقس (الآيات 9-20)، وهو في الأساس نفس رواية متّى لما بعد القيامة (متّى 28: 8-20).
تكشف الأناجيل الإزائية الثّلاثة عن خصائص غريبة تسبق رسائل بولس، كما أنّ لها معرفة أيضاً بقصّة عيسى -ويُظهر بولس معرفته بذلك أيضاً، على الرّغم من أنّه لا يُبدِي استعداداً لروايتها- لكنّ فهم تلك الأناجيل لعيسى هو في الأساس مسياني. عيسى هو المسيَّا اليهودي، كما ثبت من خلال إتمامه لجميع النّبوّات البيْبليّة المتعلّقة بالممسوح. وعلى الرّغم من أنّ الرّأي السّائد هو أنّ الأناجيل كانت قد كُتِبت بعد رسائل بولس في خمسينيات القرن الأوّل، إلّا أنّها ليست وثائق بُولسيّة إطلاقاً. تشترك الأناجيل في القليل جداً من اهتمامات بولس اللّاهوتية والكنسيّة. هل يمكن أن يكون كلّ من إنجيل متّى ولوقا قد وُجدا أيضاً قبل رسائل بولس؟ الشّيء الوحيد المؤكّد بشأن تأريخ متّى ولوقا هو أنّهما متأخّران عن مرقس. وإذا اعتقدنا أنّ التّدمير الرّوماني لأورشليم أوضح فيهما ممّا هو عليه في مرقس -غالباً ما يُستشهد بلوقا 20: 21 كدليل- فعلينا أن نتذكّر أنّ المجلّد الثّاني من عمل لوقا، وهو سفر أعمال الرّسل، يعود تأليفه إلى حوالي عام 60 بعد الميلاد. إذا كان هذا هو التّاريخ الأقرب للانتهاء من كتابة سفر أعمال الرّسل، فلا بدّ أنّ إنجيل لوقا قد كُتِب قبل ذلك، ربّما في أواخر خمسينيات القرن الأوّل، وعلى ما يبدو قبل أن تكون رسائل بولس متداولة بشكل عامّ.
الشّهود
تخبرنا الأناجيل الأربعة للعهد الجديد بما حدث بعد الصّلب، على الرّغم من أنّها، كوثائق، تبدو جميعها موضوعاً لبعض التّأمّلات؛ أي إنّه ربّما تمّت إضافة أجزاء من النصّ في نهاياتها (6). وهذه الإضافات ليست ملموسة على وجه الخصوص في متّى (28: 16-20) ولا في لوقا (24: 44-53)، ولكن في كلتا الحالتين، يرتبط ظهور عيسى المتكرّر بتعليماته إلى الرّسل في الذّهاب لنشر البشارة، التي لم تعد مجرّد تعليمه الخاصّ بل من الآن فصاعداً هي مدلول موته وقيامته، وكذلك «لتلمذة جميع الأمم».
أفكار ملحقة
فيما يتعلّق بمرقس، لدينا، كما أشرنا سابقاً، ملحق كامل (16: 9-20) مرفق بالنصّ، والذي لا يمكننا التأكّد من أنّه استكمال شبه معاصر لنصّ مقطوع أو إضافة لاحقة إلى نصّ قيد التّداول بالفعل. ولكن في هذه الحالة الأخيرة، فإنّ ملحق إنجيل يوحنّا (21: 1-25) يجعلنا، بعد استنتاجه القطعي للغاية في 20: 30-31، متأكّدين من أنّنا نتعامل مع إضافةٍ إلى إنجيل مكتمل أصلاً. ومع ذلك، فهي ليست مجرّد إضافة بقدر ما هي استكمال. يعيد يوحنّا سرد قصّة الرّسل الذين قاموا بذلك الصّيد العجائبيّ في بحيرة طبريا ليلاً. أمّا في لوقا، فيتمّ وضع القصّة نفسها في وقت مبكّر من نشاط عيسى التبشيري لدعوة هؤلاء الصيّادين أن يكونوا تلاميذه المختارين؛ وفي يوحنّا، تُستخدم هذه القصّة للظّهور المعجز للمسيح القائم من بين الأموات -وبشكل أدقّ، الظّهور الثّالث لتلاميذه بعد قيامته- ومن ثَمَّ يشارك عيسى أيضاً في وجبة سمك مع الرّسل.
لكنّ رواية يوحنّا لا تنتهي، حيث ينتهي لوقا. تتابع أحداثها في (15-25)، «عندما انتهوا من وجبة الصباح»، مع التّركيز الآن على بطرس، الذي يمكّنه يسوع -«أطعم خرافي»- عندئذ يتنبّأ بموت بطرس، والذي من المحتمل أن يكون قد حدث في روما في منتصف ستّينيات القرن الأوّل أو أواخرها، ثم يلجأ عيسى إلى «التّلميذ الذي أحبّه يسوع» (21: 20)، والذي عُرّف فيما بعد (آية 24) بأنّه كاتب الإنجيل. يقول عيسى بشكل غامض: «سيبقى حتّى آتي» (آية 22). لقد مدّد المأثور المسيحي في حياة يوحنّا هذا إلى أقصى حدّ ممكن، ولكن عندما مات في أفسس، حوالي عام 100 بعد الميلاد، قيل إنّ الربّ لم يأت بعد.
التّحقّق
يبدو أنّ هذه الرّوايات المتنوّعة والمشوّشة جدّاً حول ظهور عيسى بعد موته -يشير بعضها إلى أورشليم، وبعضها الآخر إلى الجليل- لها هدفان في الأناجيل؛ الأوّل هو التّحقّق من أنّ عيسى قد قام بالفعل، ولكن ليس كشبح أو طيْف، ولا مجرّد انبعاث. تتميّز مشاهد التّعرّف بطابع غريب: يبدو أنّ الشّهود في صراع مع أوجه التّشابه والاختلاف فيما رأوه. لقد لاحظنا للتّوّ أنّ عيسى حذّر مريم المجدلية، التي واجهت صعوبة في التّعرّف عليه، ألّا تلمسه؛ لأنّه «لم يصعد بعد إلى الأب». كما لم يتعرّف عليه أيضاً تلميذان التقاهما صدفة في طريقهما إلى عمواس، ولكن سرعان ما جلس عيسى نفسه لتناول وجبة معهما (لوقا 24: 13-35). في مناسبة أخرى، يبدو أنّ عيسى قد مرّ من باب مغلق لينضمّ إلى الرّسل (يوحنّا 20: 26). إنّه يأكل معهم -يبدو أنّ الأكل هو ضمان للجسد الحقيقي- ويدعو توما المتشكّك، الذي لم يكن معهم في مناسبة سابقة، أن يلمس جروحه (يوحنّا 20: 27).
التّمكين والتّفويض
إنّ نصوص ما بعد القيامة مهتمّة، بنفس القدر أو ربّما أكثر، بمشروع آخر: التّحقّق من سلطة الرّسل ومهمّتهم. «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم»، يردّد عيسى جادّاً، «وعمّدوهم باسم الأب والابن والرّوح القدس... نعم، وأنا معكم دائماً، حتى نهاية العالم» (متى 28: 18-20). يعِد عيسى في ملحق مرقس: «مَن آمن واعتمد خلُص»، «من لا يؤمن يُدان، سترافق هذه الآيات المؤمنين يطردون الشياطين باسمي، ويتكلّمون بألسنة جديدة، يحملون الحيّات وإذا شربوا شيئاً مميتاً لا يضرّهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون» (مرقس 16: 15-18).
من الواضح إذن، أنّ الجماعات التي وقفت وراء الأناجيل تعتقد أنّ الاثنيْ عشر، وربّما الآخرين أيضاً، قد كلّفهم يسوع بنقل رسالته ليس فقط إلى إخوتهم اليهود ولكن إلى «جميع الأمم». كانت تلك «الأمم»، تحت نفس الاسم (اليونانية ethne اللّاتينية gentes). أمّا «Gentiles» المألوفة أو goyyim، فهي كلّ أولئك الذين لم يكونوا يهوداً. لكن ما نشهده غير ذلك. تُظهر أعمال الرّسل المؤمنين الأوائل، وهم يبشّرون بعيسى المنبعث من بين الأموات داخل المعابد اليهودية لشتات شرق البحر الأبيض المتوسّط (أعمال الرّسل 13: 26، 43، 48، ... إلخ)، حيث شكّل غير اليهود في تلك الحقبة جمهوراً صغيراً ولكن مُرحّباً به من الأطراف المعنيّة، وأحياناً في المحافل العامّة غير اليهودية (أعمال الرّسل 17: 17، 19: 9-10).
كانت المهمّة إلى غير اليهود في حدّ ذاتها مهمّة معقّدة وصعبة للغاية. ترك بولس ورفيقه برنابا انطباعاً قوياً إلى حدّ ما لدى العديد من جمهورهما من غير اليهود، قويّاً بما يكفي، في كلّ الأحوال، لجعل اليهود المحلّيّين غير مرتاحين. أجاب بولس بأنّ لديه فعلاً مهمّة إلهيّة محدّدة تكون «نوراً للأمم». كان عليه أن يعلن البشارة لليهود أوّلاً، بالطّبع، «ولكن بما أنّكم ترفضونها، فإنّنا ننتقل الآن إلى غير اليهود» (أعمال الرّسل 13: 46-47). لم تكن هذه لمسة ثقافية عابرة في بلدة بمقاطعة الأناضول. لقد ظهرت المسألة في وقت سابق عندما ارتبط بطرس، الذي كان بالتّأكيد الشّخص الأكثر موثوقية من بين الاثنيْ عشر، أوّلاً بقائد مائة روماني وعائلته، ثمّ قام بتعميدهم (أعمال الرّسل 10: 48). استاء الرّسل الآخرون في أورشليم من هذا الانتهاك لتشريعات الطّهارة اليهوديّة. لقد تمكّن بطرس من تهدئتهم (11: 18)، ولكنّ أنشطة بولس أثارت المسألة من جديد. هل يمكن للمرء أن يكون من أتباع عيسى دون أن يكون يهودياً؟ دون أن يتمّ ختانه؟
لقد تمّت الإجابة عن السّؤال بطريقة براغماتية ودون اقتناع كبير؛ وذلك في اجتماع الجمعية الأمّ في أورشليم، ربّما كان في عام 49 بعد الميلاد. وتقرّر أن يستمرّ الوعظ والتّعميد بين غير اليهود، الذين كان عليهم فقط مراعاة بعض القواعد الأساسية -تجنّب اللّحوم غير الحلال، والتي من شأنها أن تسمح لمعتنقي الدين الجدد من غير اليهود بالمشاركة في الوجبات الجماعيّة التي يُفترض أنّها لا تزال كوشير (حلال) مع إخوتهم اليهود، والامتناع عن مختلف الممارسات الجنسية، وإن لم يتمّ تحديدها، الشّائعة بين غير اليهود (أعمال الرّسل 15). وسواء تمّ مراعاتها أو تجاهلها، فإنّه لم يتمّ ذكر هذه الأحكام مرّة أخرى واستمرّت مهمّة بولس للأمم بحيوّية جديدة ونجاح متزايد.
السّؤال المطروح، إذن، هو ما إذا كان عيسى نفسه قد كُلّف، أو حتّى فكّر، بمهمّة للأمم كما تمّ تصويره في ظهوره بعد القيامة. هل حقّاً قال عيسى: «اذهبوا إذن إلى جميع الأمم واجعلوهم تلاميذي...» (متى 28: 19)؟ إلّا أنّ المأثورات حول سيرته مختلفة تماماً. في وقت ما، أوصى عيسى الاثنيْ عشر قائلاً لهم تحديداً: «لا تسلكوا الطّريق إلى أراضي الأمم.... ولكن اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضّالّة» (متّى 10: 5-6)، وفي مناسبة أخرى، عندما وقفت أمامه امرأة من غير اليهود من تلك التّخوم تتوسّل الشّفاء، أشار عيسى: «لقد أُرْسِلتُ إلى الخراف الضّالة في بيت إسرائيل ولهم وحدهم» (متّى 15: 24)، غير أنّه وافق في النّهاية على طلبها وطهّر ابنتها وشفاها.
كما يكشف خطاب عيسى أيضاً عن تشريعات الطّهارة في التّوراة. لم يكن صارماً في التزامه بها مثلما كان الفرّيسيّون المعاصرون له (مرقس 2: 15-28)، وتشهد الأناجيل أنّه فكّر في بعض التّعديلات، فإنْ لم يكن في قوانين الطّهارة نفسها ففي الطّريقة التي توجّب على اليهود أن يفهموا بها تلك التّشريعات. يقول عيسى: «لا شيء يدخل الإنسان من الخارج يمكن أن ينجّسه؛ لأنّه لا يدخل في قلبه بل إلى معدته» (مرقس 7: 18). لكنّ الشّيء المريب هو الاستنتاج الذي توصّل إليه مرقس مباشرة بعد ذلك: «وبقوله هذا، فقد أعلن عيسى أنّ جميع الأطعمة طاهرة» (7: 19). هذه الملاحظة لا تتناقض فقط مع سلوك يسوع نفسه، بل مع الدّليل الواضح على أن لا أحد من أتباعه اعتقد أنّه فعل شيئاً من هذا القبيل.
في سفر أعمال الرّسل، بطرس الذي يصرخ إلى الله، «لم آكل قطّ شيئاً نجساً!» (10: 14)، قد طمأنته رؤيا من السّماء تُجيز له بمخالطة غير اليهود، حتّى مع مَن يخشى الله مثل كرنيليوس (10: 28). وفي وقت لاحق اتّهمه رفقاؤه المسيحيّون علانية بالتّجاوز: «لقد زرت رجالاً غير مختونين وجلست معهم حول المائدة» (11: 3). وقد واجه بولس أيضاً، كما رأينا، الشّكل نفسه من المعارضة من أتباع عيسى الحاضرين. إذن، يبدو أنّه من المستبعد جداً أن يكون عيسى قد اعتقد أنّ رسالته موجّهة إلى الأمم أو أنّه أمر أتباعه بنقلها إلى أيّ شخص ما عدا اليهود.
النهاية
يُنهي يوحنّا إنجيله بزخرفة أدبية: «لقد أجرى يسوع العديد من المعجزات الأخرى بحضور الرّسل والتّلاميذ، والتي لم تكتب في هذا السّفر. وأمّا هذه فقد كُتبت لتؤمنوا أنّ يسوع هو المسيح ابن الله، ولتكون لكم بفضل إيمانكم حياة باسمه» (20: 30-31) (7).
لكنّ مرقس ومن بعده لوقا، بحثا في مكان آخر لكتابة نهاية لتاريخيّة عيسى. يقول ملحق مرقس (16: 19) «وبعد أن كلّمهم الربّ عيسى، صعد إلى السّماء وجلس عن يمين الله». ويكتب لوقا: «ثمّ قادهم إلى بيت عنيا، ورفع يديه وباركهم. وبينما كان يباركهم انفصل عنهم وصعد إلى السّماء» (24: 50-51) (8)، بيد أنّ تلك الرّحلة الأخيرة إلى بيت عنيا هي رحلة أخرى يجب على المؤرّخ أن يرفض القيام بها.
محمّد، الإرث
تنتهي قصّة عيسى بمحاولة المؤرّخ، دون نجاح كبير، شقّ طريقه عبر ستّ، وربّما ثمان رقع سرديّة مختلفة عن الأحداث التي أعقبت موت عيسى ودفنه. ولكنّ توثيق نهاية محمّد مختلف تماماً. من الواضح تماماً أنّ القرآن بقي صامتاً في فترة غير معلومة قبل وفاة النّبي، وأنّ رواية السّيرة الذّاتية عن وفاة محمّد، المستمدّة من زوجته عائشة، ساكنة وخالية نسبياً من أيّ جدل يُذكر (9).
نبيّ من دون معجزات
لم يكن لمحمّد أيّ مطالب معيّنة أو شخصية لذاته، كان الهدف هو الرّسالة وليس الرّسول. ومن المؤكّد أنّ مرجعيّة الرّسول كانت تحت المحكّ، فقد واجه محمّد صعوبة في التّموضع على نطاق الشّخصيات المميّزة المعهودة لدى جمهوره. لقد صُنّف، وبشيء من التّبرير، ضمن الشّعراء والكهّان المألوفين. وقد دعا إلى نموذج مختلف، وهو نموذج (نبيّ، رسول) من الصّنف العربي المألوف مثل هود (سورة الأعراف: 65-72، إلخ) أو صالح (سورة الأعراف: 73-79، ... إلخ) أو، كما فضّل محمّد، نموذج أنبياء البيبل الذين قد يكونون أقلّ شهرة، والذين يتمّ الاستشهاد بهم كثيراً ومطوّلاً في القرآن: فقد أُفردت لهم سورة كاملة، وهي سورة الأنبياء.
إنّ إحدى السّمات الشّائعة في قصص الأنبياء في القرآن هي المعجزات التي قاموا بها كدلائل على دعوتهم. وقد صنع كلّ من موسى وعيسى مثل هذه «الآيات» (10)، ولذلك فلا عجب أنّ جمهور محمّد قد انتظر مثل هذه «الآيات» من النّبيّ الذي وقف أمامهم في الحرم («وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»، سورة الأنعام: آية 37، «وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ»، سورة الرّعد، آية: 7، «بَلْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ»، سورة الأنبياء، آية: 5). رفض محمّد رفضاً قاطعاً القيام بما تسمّيه الأناجيل «أعمال القوّة». كان القرآن هو المعجزة الوحيدة الملزمة لإثبات أنّه رسول الله، وأصبح هذا المفهوم متأصّلاً لدرجة أنّ آيات القرآن قد انتهى بها الأمر إلى أن تُسمّى هي ذاتها «آيات» (انظر الآية الأولى من سورة النّور: «سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»، والآية الثّانية من سورة لقمان: «تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ».
ليس هناك من سبب، إذن، يجعلنا نحن أو من عاصره نتوقّع أن تُتوّج مسيرة محمّد بأيّ إثبات إلهي. لم يدّع أنّه يعمل كمهدي أخروي؛ وبالطّبع، لا تظهر مثل هذه الشّخصيّة المسيانية في أيّ مكان في مختلف سيناريوهات القرآن الأخرويّة (11). ولم يطلب محمّد معجزة لإصلاح الضّرر النّاجم عن نهاية مأساويّة: لقد مات نتيجة أسباب طبيعيّة، وهو في أوج عطائه ما يبيّن أنّها كانت مسيرة ناجحة كنبيّ ورجل دولة.
معجزة بئر بدر
إذا كانت هناك معجزة في حياة النّبيّ، فقد حدثت في وقت سابق. يميل المأثور الإسلامي إلى اعتبار الهروب الآمن لمحمّد من مكّة معجزة، وقد يكون الأمر كذلك. ولكنّ الحدث الذي يدفع أكثر إلى أن يكون معجزة هو ما وقع في بئر بدر بعد عامين من وصول النّبيّ المحفوف بالمخاطر إلى المدينة. لقد تمّ استقدامه إلى الواحة لحلّ الصّراع الأهلي المتزايد. ولكنّ وصوله أثار صراعاً جديداً بينه وبين يهود المدينة الذين، على ما يبدو، كانوا يعيشون في سلام نسبي، رغم أنّهم كانوا متحالفين مع القبائل العربية المهيمنة هناك. قد تكون هناك مشاكل أخرى أيضاً، مثل إدماج «المهاجرين» المكّيّين الجدد وعائلاتهم في النّشاط الاقتصادي محدود الإمكانيات في تلك المستوطنة الزّراعية.
إثر وصوله مباشرة تعامل محمّد بشدّة مع اليهود المُنكِرين له كما رأينا. كان بعض عرب المدينة غير مرتاحين لمعاملة حلفائهم اليهود، لكن إذا كانوا يعتزمون اتّخاذ إجراء ضدّ محمّد، وهو أمر يبدو مستبعد الوقوع، فسرعان ما واجهوا حدثاً آخر أكثر ضراوة. قد يكون هجوم محمّد ونهب القافلة المكّيّة في عودتها عبر بئر بدر يهدف إلى معالجة الضّائقة المالية للمهاجرين، ولكنّها كانت ذريعة لشنّ الحرب على مزارعي التّمور المسالمين في المدينة. دقّت نواقيس الحرب، واتّضح أنّ المكّيّين لا يتمتّعون بروح القتال مثل التي عند أهل المدينة وليس عندهم القدرة على القتال أصلاً.
كان بإمكان بئر بدر أن يتسبّب في كارثة لكلّ من محمّد وأهل المدينة، ولكن اتّضح أنّه طالع خير عليهم؛ ذلك الانتصار غير المتوقّع والمربح، والذي بدا وكأنّه مغامرة غير محمودة العواقب لم يكن عملاً مهدوراً بالنّسبة إلى أهل المدينة. أخبر محمّد كلّ السّامعين بأنّ ذلك كان نصر الله الحتميّ رغم المصاعب الجمّة («وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللهُ وَلِيُّهُما وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ * وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ * بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ * وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَما النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ» سورة آل عمران: 121-127). لا يمكننا أن نقول إلى أيّ مدى تأثّر مزارعو واحة المدينة بالحجّة اللّاهوتية، لكن لا يمكن إهمال النّتائج أو إنكارها. هجر المهاجرون الفقر إلى غير رجعة وأصبحوا أغنياء في هذه الواحة.
بدأت حظوظ محمّد تتغيّر مباشرة بعد بئر بدر. دخل سكّان المدينة الإسلام -لم يكن النّبيّ على يقين دائماً من صدق ما يسمّيه القرآن «المنافقين» («وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لاتَّبَعْناكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ * الَّذِينَ قالُوا لإِخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» سورة آل عمران: 167-168، ... إلخ)- وانضمّوا إلى ما أصبح غارات سنويّة ضدّ رقعة آخذة في الاتّساع من المناطق المجاورة. لقد عُدّت ثمار ذلك غنائم من أولئك الحمقى الذين أبدوا مقاومة كبيرة وجزية من أولئك الذين كانوا أكثر حكمة لقراءة الكتابة الجديدة على الرّمال العربية. لقد كان انتصاراً عظيماً لرجل جاء، منذ وقت قريب، يتوسّل للحصول على اللّجوء.
وفاة النّبيّ
توفّي محمّد بمرض غير محدّد في عام 632م، عن عمر يناهز الثّانية والسّتين وفقاً للتّسلسل الزّمني التّقليدي، ولكنّه كان أصغر من ذلك بقليل حسب تقديراتنا الخاصّة. لقد كان مريضاً لفترة من الزّمن، لذلك لم تكن وفاته مفاجِئة. ومع ذلك، فقد أبدى صحابته في العقيدة والحرب بعض الاندهاش؛ بيد أنّ الأمر الذي قد يكون أكثر إثارة للدّهشة بالنّسبة لنا هو أنّه لم ينصّ إطلاقاً على أيّ خليفة بعده. يصف القرآن محمّداً بأنّه خاتم النّبيّين («ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً»، سورة الأحزاب: آية 40)؛ وبهذا المفهوم لا يمكن أن يكون هناك خليفة، ولا للمسلمين كذلك (12). لكنّ هذا «المنذر» صاحب الشّخصيّة المميّزة كان كذلك على رأس مجتمع سياسي أنشأه هو والقرآن، ومع ذلك لم يتّخذ أيّ خطوة للإشارة إلى مَن يجب أن يحكم بعده أو إلى كيفيّة الحكم. تُركت لأصحابه الإجابة عن هذيْن السّؤاليْن بقدر المستطاع (13).
وكما رأينا، فقد طالب المكّيّون محمّداً أن يأتيهم بمعجزات («وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً * أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً» سورة الإسراء: 90-92). لكنّه رفض. وأصرّ على أنّه لم يكن سوى بشر فانٍ («قُلْ إِنَّما أَنا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ» سورة الكهف: 110). يواصل المأثور الإسلامي في التّأكيد على موته، لا سيّما في مواجهة ما يعتبره المسلمون ادّعاءات مسيحية غريبة عن ألوهية عيسى، الذي كان نبياً فانياً كما يصرّ القرآن («إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ»، سورة آل عمران: 59) مثلما يقرّ بذلك المسلمون أيضاً. ومع ذلك، أصبح لمحمّد بمرور الزّمن مكانة غير عاديّة؛ فمحمّد الذي لم تكن له معجزة واحدة في السّابق قد حظِي بالعديد من المعجزات في الأحاديث النّبويّة التي تملأ صفحات صحيح البخاري، وأنّ ذاك البشر الفاني الذي علّمه ربّه التّصدّى لفكرة («تَرْقَى فِي السَّماءِ»، سورة الإسراء: 93))، قد صعد إلى السّماء مثلما كان يُعتقد أنّ عيسى قام بذلك بالتّأكيد، إلّا أنّ عيسى ظلّ هناك حتى عودته الثّانية البعيدة، وعاد محمّد من السّماء إلى مكّة وإلى مسيرته النّبوية في ذات اللّيلة التي بدأت فيها رحلته.
رجل معصوم من الخطأ
قد يستمرّ المسلمون التّقليديّون دون جدوى في مقاومة الاحتفال السّنوي بعيد ميلاد النّبيّ (14)، لكنّ علماء الشّريعة المسلمين أكّدوا، دون تردّد، أنّ محمّداً معصوم من الخطأ. إذا كانت عذرية مريم قد انتشرت سابقاً بشكل ملحوظ بين المسيحيّين، فإنّ الشّيء ذاته ينطبق على عصمة النّبيّ من الخطأ التي انتشرت لاحقاً بشكل لافت جدّاً بين المسلمين. وعلى الرّغم من أنّ العديد من المؤشّرات تفيد عكس ذلك، ومن بينها إشارة القرآن ــــ«ووجدك ضالّاً فهدى؟» (سورة الضّحى: 7) (15) - فإنّ محمّداً قد شارك قبل دعوته إلى النّبوّة في الطّقوس العادية في مكّة، بما في ذلك العبادات التي كانت تُمارس في الكعبة وحولها، وعلى وجه التّحديد ذلك المجمع الذي يُسمّى الحجّ والعمرة، والذي ستنأى به التّقاليد الإسلامية المتعاقبة عن كلّ تلك الممارسات المشوبة بالوثنيّة. ويظهر هذا المفهوم لأوّل مرّة كعقيدة في ما يسمّى بالفقه الأكبر، وهو كتاب في العقيدة الإسلامية من القرن العاشر تنصّ المادّة الثّامنة منه على أنّ «الأنبياء منزّهون عن الصّغائر والكبائر، والكفر والقبائح، وقد كانت منهم زلّات وخطيئات». وتضيف المادّة التّاسعة: «ومحمّد نبيّه وعبده ورسوله وصفّيّه ونقّيّه ولم يعبد الصّنم ولم يشرك بالله تعالى طرفة عين قطّ، ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط» (16).
«أسوة حسنة»
إنّ التحرّر من كلّ خطيئة وامتلاك كلّ فضيلة لَخطوةٌ سهلة، فسرعان ما أصبح النّبيّ ينعم بمثل هذه المنزلة. لم يكن محمّد الرّجل الكوني المثالي للباطنية الإسلامية فحسب، بل كان أيضاً تجسيداً بشرياً لــــ«الخضوع» الكامل، والمسلم بامتياز -الله نفسه يشير إلى نبيّه في القرآن على أنّه «أسوة حسنة» («لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً»، سورة الأحزاب: 21)- وهو بهذه الصّفة، نموذج للسّلوك البشري، وخاصّة المسلم.
شأنه شأن إخوته في الدّين السّماوي، يستمدّ المسلم من كلمة الله المُنَزَّلَة المبادئَ العامّة للأخلاق وكذلك التّوجيهات والتّعليمات التفصيليّة حول السّلوك. القرآن موجّه في المقام الأوّل إلى البشرية جمعاء، داعياً إيّاها إلى الخير والعدل والإنصاف والاستقامة على وجه الخصوص. كانت رسالة القرآن المكّي موجّهة تحديداً إلى جميع الرّاغبين في الاستماع إليها، ولكن مع تقدّم الرّسالة والمهمّة، تمّ توجيه تعليمات القرآن بشكل متزايد، دون أيّ تغيير رسميّ في الوجهة، إلى المسلمين الذين يشكّلون المجتمع. ومن ثَمَّ، فإنّ القرآن هو «الهداية» -توصيف ذاتي متكرّر- للبشرية جمعاء، وبصورة أدقّ، دليل سلوك للمؤمن المسلم.
الأحاديث النّبويّة
محمّد نفسه مُخْتَفٍ بشكل جيّد وراء القرآن الذي نقله عن ربّه، غير أنّ القرآن لا يذكر محمّداً إلّا من حين لآخر. ولكن لا يوجد مثل هذا التحفّظ خارج القرآن. كان هناك عدد هائل من الأحاديث النّبوية المتداولة في وقت مبكّر، والتي زعمت أنّها قدّمت تعليمات النّبيّ الأخلاقية في كلّ المواضيع التي يمكن تصوّرها ونقلت، علاوة على ذلك، مشاهد حيّة حول محمّد في الصّلاة وأثناء الأكل وفي الأسرة، كزوج وأب وقاض ورجل دولة وكإستراتيجي عسكري. تمّ عرض كلّ من محمّد الإنسان العادي ومحمّد النّبي بشكل كامل في الأحاديث. وعلى الرّغم من وجود بعض التّفاصيل الشّخصية في المأثور الكلاسيكي للسّيرة، إلّا أنّ الكتابات التي صوّرت محمّداً حيّاً لحماً ودماً تنتمي إلى شكل أدبي إسلامي مختلف نوعاً ما. هذه الكتابات، التي يطلق عليها إمّا «دلائل النّبوّة» أو «الصّفات الحميدة (للنّبيّ)»، هي في الأساس مجموعات من الحكايات، وعلى هذا النّحو فهي أقرب إلى سيرة القدّيسين منها إلى السّيرة الذّاتية. وكما الأناجيل الأبوكريفيّة في المأثور المسيحيّ، فإنّ تلك الأعمال تقدّم موضوع السّيرة بطريقة ما، لكنّ اهتمامها الرّئيس ينصبّ على شخصيّة النّبيّ وسلوكه ومظهره ومعجزاته. يعود أقدم مثال لهذا الشّكل الأدبي إلى أواخر القرن التّاسع الميلادي، وعلى الرّغم من أنّ له تاريخاً طويلاً في الإسلام، إلّا أنّ معظم الأعمال اللّاحقة تتوسّع وتُسهب في بلورة الصّور الأولى المشرقة لصفات نبيّ الإسلام البشريّة وصفاته التي تفوق البشريّة.
أدب النّبيّ
وهكذا إذن، تقدّم المأثورات صورة مجسّدة بالكامل للنّبيّ، وإن كانت متناقضة في بعض الأحيان، وقد استُعملت منذ نشأتها في القرن الثّامن وحتى الوقت الحاضر كنموذج ومعيار لحياة المسلم المثاليّة. ولم يكن ذلك في مسائل الخيار الأخلاقي فقط. فقد عرضت الأحاديث قائمة واسعة ومتنوّعة من السّلوك الاجتماعي المفضّل، ومن الأدب بدلاً من الأخلاق، وقد تمّ دمج مفهوم الأدب لاحقاً في التّفكير الأخلاقي الإسلامي بشكل عامّ. في البداية، كان مصطلح الأدب في المجتمع القبلي هو التشدّد والمحافظة: فالسّلوك المناسب هو السّلوك التّقليدي وهو «السّلوك العُرفي»، ولم يكن الأدب على مسافة بعيدة من السّنّة. ومثلما حدث مع السنّة، فقد أحدث «تنزيل» القرآن ثورة في الأدب. ولم يعد السّلوك القبلي كافياً، أمّا في الإسلام، فقد أصبح أدب محمّد هو المُعتمَد الوحيد.
تمّ نقل هذا الأدب النّبويّ إلى الأجيال اللّاحقة من المسلمين من خلال مجموعة كبيرة من الأحاديث التي تشهد على أقوال محمّد وأفعاله. العديد من هذه الأقوال لها علاقة بما يسمّيه اليهود الهلاخاه Halakha أو السّلوك المنظّم: فهي تعرض التّشريعات الإلزاميّة في المسائل الأخلاقية، وبالتّالي فقد تمّ دمجها في أسس الشّريعة الإسلامية. ولكنّ عدداً كبيراً منها لا يتعدّى كونه مجرّد «أحاديث الطّاولة» للنّبيّ، أو بطريقة أفضل، محادثات داخليّة، بما أنّ معظمها وصل إلينا عن طريق زوجته عائشة. وفي هذه الأقوال، وفي عديد الحكايات التي تمّ تناقلها من خلال الأحاديث، أصبح للإسلام صورة مفصّلة لأدب النّبيّ.
إنّ الخطوط العريضة لنمط حياة عيسى في الأناجيل مقيّدة بقِصَر المدّة التي عاشها عيسى، وبحرص الإنجيليّين على الاعتناء بالرّسالة، وأخيراً، بحقيقة إدراك المؤمنين أنّ عيسى كان، بالنّهاية، ابن الله. وفي المقابل، كانت بشريّة محمّد مرئية للجميع، وقد ظلّ علاوة على ذلك في دائرة الأضواء لمدّة اثنيْن وعشرين عاماً في أكثر الظّروف تنوّعاً. ورغم أنّ الرّوايات المتعلّقة بمحمّد مشكوك في صحّتها، فهي مع ذلك شاملة وغزيرة، وهي شاملة بما يكفي، في جميع الحالات، لتزويد المؤمن بنموذج معقّد وموسّع في ذات الوقت لطريقة عيش المسلم.
إحدى نتائج هذا الكمّ الهائل من المعلومات حول الأدب الخاصّ بالنّبيّ هي أنّ لدى السّلوك الإسلامي، بالإضافة إلى نظام أخلاقيّ داخليّ وقوانين مُوجِّهة للسّلوك، حسّاً بنمط عيش معيّن غير موجود مباشرة في أيّ من اليهودية أو المسيحية، حيث تفضّل كلتاهما نماذج الزّهّاد، مثل القدّيس فرنسيس الأسيزي -الذي ثبت أنّ اعتماده على أدب عيسى غير قابل للاستمرار- أو أحد حاخامات أوروبا الشّرقية الذين يقفون وراء الحركة الحسيدية. إنّ نمط العيش الإسلامي هذا تعزّزه نفسيّاً، وبلا شكّ، رواسب العروبة الرّاسخة في أعماق الهويّة الإسلامية، لكنّ انتشار الأدب النّبويّ حقيقيّ وواضح تماماً في المجتمع المسلم الذّكوري على الدّوام. إنّه ظاهر وجليّ في كلّ المجالات، من اللّباس والطّعام إلى طريقة الصّلاة، ولا سيما صلاة الجمعة الجماعية التي من الواضح أنّها تمرين مشترك يتمّ القيام به في تناغم رائع جدّاً، وهي في الوقت ذاته ودون شكّ، علاقة فرديّة، تكاد تكون حميميّة، بين المصلّي وربّه.
محمّد الإنسان
يمكن للمؤرّخ أن يقوم بتقييمه الخاصّ. كان محمّد، في ظاهر الأمر، عبقرياً دينياً وسياسياً من حيث إنّه شكّل على حدّ سواء، بمفرده كما يسمح التّاريخ بذلك لأيّ فرد، ثقافة دينيّة أو مجتمعاً سياسياً، وكلاهما على نطاق واسع، واللّذيْن لم يستمرّا قائميْن حتّى اليوم فحسب، بل بقيا ضرورييْن ومتنامييْن. وبقيت بصمة شخصيّة محمّد مرسومة عليهما. غالباً ما اختفى عيسى المسالم وراء مسيحيّة متشدّدة للغاية، لكنّ محمّداً المتشدّد والمتّسم بالمرونة لا يزال على رأس الإسلام، ولا زالت شخصيّته القويّة جدّاً والمنضبطة في الوقت ذاته، وورعه الخاصّ ومثابرته البطوليّة في صميم الشّخصية الإسلامية.
إذا ألقينا نظرة فاحصة، ستظهر لنا شخصيّة متميّزة ومعقّدة، رجل ليس شيطان الجدل المسيحيّ ولا قدّيس القدّيسين المسلمين. من النّاحية السّياسية، كان محمّد قاسياً لا يعرف الهوادة؛ براغماتياً أكثر منه أيْديولوجيّاً، ولكنّه صارم بشأن قيم الإسلام الجوهريّة؛ لوّاماً ومتسامحاً بنفس القدر؛ صاحب التّقوى ونقيضها؛ اشتهر بزواجه من نفس المرأة لمدّة أربعة وعشرين عاماً: إنّها أمّ جميع أبنائه وبناته الباقين على قيد الحياة في مجتمع يقوم على توريث الذّكور قبل كلّ شيء. لقد كان مسرفاً في أشياء قليلة، شديد القناعة، وكان كريماً دائم الكرم.
هناك الكثير من الأدلّة حول محمّد: «المأثورات النّبويّة» هي بحر لا حدود له من المعلومات، وكلّها تدّعي أنّها جاءت من شهود عيان موثوق بهم، ولكنّ الكثير منها، إن لم يكن معظمها، مُختَلَق بلا شكّ. ويجوز للطّرف المهتمّ بالأمر أن يرسم أيّ صورة تناسب الحدث أو تتماشى مع قناعته الخاصّة. ربّما كان الأمر كذلك منذ البداية وسوف يظلّ كذلك بلا شكّ طالما ظلّ ذاك الصّرح العجيب الذي بناه قائماً.
أفكار ثانوية: صور من السيرة
إنّ شخصية عيسى محدّدة بوضوح في المسيحيّة أكثر من شخصية محمّد في الإسلام، ليس لأنّ الأدلّة على وجود عيسى أفضل أو أكثر وفرة أو تفصيلاً، بل بسبب التّقاليد الفنّية للثّقافات التي ينتمي إليها كلّ منهما. مع انفصال أتباعه عن اليهودية التي نشأ منها، نجا عيسى من قيود تحريم الأيقونات اليهودي (17). ومع انتشار المسيحيّة، أصبحت صورة عيسى، «صورة الله غير المرئي»، كما سماه بولس (كولوسي 1: 15)، إحدى الصّور المهيمنة في تقليد الفنّ التّشكيلي اليوناني الرّوماني. أصبح عيسى المُتوَّج، البانتوكراتور، ويسوع المصلوب صوراً نموذجية معروضة إلى ما لا نهاية في الرّوحانيات الشّرقية والغربية على حدّ سواء، في حين جلس «يسوع اليومي» للخدمة الجليلية ووعظ وشفى وبارك من خلال صور لا حصر لها في عدد لا يحصى من الكنائس، ثمّ في كتب كثيرة لا تُعَدّ، في جميع أنحاء العالم المسيحي.
بالإضافة إلى الإمتاع والتّثقيف اللّذيْن يمنحهما تصوّر المشاهد الأدبيّة المألوفة، كانت هناك أيضاً، ولا سيما في الكنائس الشّرقية، رسالة لاهوتية نقلتها هذه الصّور: كان المؤمنون في حضرة المسيح الإله-الانسان، والمقدّس، وبطريقة أكثر إقناعاً المسيح الإنسان. تظهر هذه الرّسالة ذاتها في الصور الغربية لعيسى، فقط وبشكل عامّ في صور عيسى قائماً من بين الأموات أو صاعداً إلى السّماء. عندما تكون الصّورة هي صورة عيسى الخادم والمتواضع، تكون الرّسالة مؤثّرة أكثر -صورة عيسى المتواضع، والحنون والواعظ الطّيّب- أو تكون أكثر وجدانيّة في مرحلة لاحقة.
بعد اعتناق قسطنطين للمسيحيّة، انتقلت صور عيسى والقدّيسين المسيحيّين بسهولة إلى مجال الفنّ الدّيني. تطوّر هذا الفنّ في الإمبراطوريّة الرومانية الشّرقية إلى الشّكل التّقليدي والثّابت والهيراطيقي. ومن ثَمَّ، كانت صورة عيسى تميل إلى أن تكون كما هي، عيسى الذي كان «منعزلاً وخالداً»، مثلما تمّ وصفه (18). ومع ذلك فقد انتقلت الموضوعات الدّينية هي الأخرى في الغرب إلى تقليد فنّي أكثر مدنيّة يَسْعَد بمعالجة موضوعات العهد الجديد بشكل عامّ، وعيسى على وجه الخصوص بطريقة أكثر واقعية وذاتيّة، بل وأكثر جرأة.
لم تمرّ واحدة من صور عيسى واسعة الانتشار دون تعليق وأحياناً معارضة قويّة من المسيحيّين، لا سيما في الشّرق. اعتبر العديد من اللّاهوتيين تكريم الصّور وتقديسها كفراً، مثلما اعتبر ذلك لاحقاً بعض الإصلاحيّين البروتستانت في الغرب. في دفاعه عن استخدام الصّور الدّينية ومقاومته للّذين يرفضون أيقونات القرن الثّامن المسيحيّة، أطلق يوحنّا الدّمشقي على هذه الصّور اسم «كتب للأمّيّين»؛ إذ اعتبر أنّها لا تختلف عن الكتابات المقدّسة سوى أنّها تصوّر بالخطوط والألوان ما رسمه البيبل بالكلمات (19). كان للإسلام أيضاً أمّيّون، لكنّهم لم يكونوا بحاجة إلى كتب، سواء كانت مكتوبة أو مرسومة؛ لأنّ كتابهم المقدّس كان -وحتّى في عصر الطّباعة، لا يزال وعلى نطاق واسع- «تلاوة».
لكن كان هناك أكثر من ذلك في تلك الأعمال. يشترك الإسلام مع اليهودية، أو ربّما أخذ ذلك عنها، في كراهية الصورة المنحوتة. كان الله، مثل يهوه، رمز الألوهيّة في البداية، لذلك لم تكن هناك أبداً حاجة إلى تمثيله. ربّما سعى الفنّانون الغربيون الأكثر جرأة إلى تصوير الثّالوث دون أن يعيروا للنّجاح اهتماماً بالغاً (20)؛ في حين كان على نظرائهم المسلمين أن يكتفوا بنقش اسم الله ببراعة، وهي خطوة لا يزال اليهود التقليديون ينفرون منها.
يمتدّ الحظر الإسلامي للتصوير في أشدّ حالاته ليشمل جميع أشكال التّجسيد البشري. ونتيجة لذلك، فضّل المسلمون منذ البداية الزّخرفة على التصوير، وقد ابتكروا للزّخرفة مخزوناً مذهلاً من الأشكال الهندسية ورسوم نباتات وأزهار، وعلى الأخصّ، مجموعة الخطوط لتزيين الجدران الخارجية والدّاخلية لمبانيهم العامّة والخاصّة، فضلاً عن التّذييلات والهوامش وحتى صفحات كتبهم المنمّقة بالكامل.
كان الفنّ غير التّمثيلي هو الأنسب للفقه الإسلامي، ولقد تمّ إنشاءُ الكثير من فنّ التّصوير تحت رعاية المسلمين، يكون بشكل عامّ كرسومات للكُتُب وغالباً ما يكون برعاية ذوي السلطان. كثيرة هي المشاهد المليئة بالأشكال البشرية في أوقات وأماكن مختلفة في دار الإسلام. كما تمّ كذلك تصوير الثّيمات الدّينية، بما في ذلك حوادث من سيرة النّبيّ. حظيت «رحلة الإسراء والمعراج اللّيليّة» لمحمّد، في سياقها المكّيّ أوّلاً ثمّ الكوني، بتقدير خاصّ. ولقد تمّ تمثيل النّبيّ بالفعل في هذه الشّارات، مكشوف الملامح كلّها أحياناً وغالباً محجوباً بهالة من الظُّلمة (21).
غير أنّ هذه الرّسومات لم تكن للاستهلاك العامّ، بل كانت الممتلكات الثّمينة للأثرياء الذين يتذوّقون مثل هذا الفنّ. كان من السّهل على المسلمين العاديّين أن يتخيّلوا صورة النّبيّ. ولقد ساعدهم على ذلك، ليس القرآن بالتّأكيد، حيث لم يكن محمّد سوى مُتَلَقٍّ عرضيّ -وبدون اسم-، ولكن أدب الفضيلة والموعظة الذي بدأ يظهر بعد وفاة محمّد. حاول المسلمون الأوائل، مثل الأجيال الأولى من المسيحيّين الذين أنتجوا الأناجيل الأبوكريفيّة بنفس الدّافع، سدّ الثّغرات فيما تذكّروه من سيرة نبيّ الإسلام، بما في ذلك مظهره الجسدي وسلوكه اليومي.
إنّ الاسم العربي الذي أُطلق لاحقاً على هذه الجهود الأدبية هو الحِلْية، حرفيّاً «الزّينة». كان في الأصل وصفاً أدبياً للسّمات الجسدية والنّفسية والرّوحية للنّبيّ. وقد تمّ نقل هذه الموادّ لأوّل مرة في شكل أحاديث وروايات شهود عيان افتراضيّين من معاصري محمّد، وغالباً ما تمّ تناقلها شفويّاً في شكل أخبار منفصلة. وفي حين تقيّد كتّاب سيرة النّبي التّقليديون بشكل وثيق إلى حدّ ما بالأحداث التي وقعت في حياته، فإنّ الأحاديث التي اهتمّت بأدقّ تفاصيل شخصية محمّد، مثل الوجه والشّكل والأخلاق، قد انتهى بها الأمر إلى تجميعها في جنس أدبيّ مستقلّ يتّسم بسعة الخيال يسمّى «قصص الأنبياء» أو إذا كان يتمحور حصرياً حول محمّد، فيسمّى «سيرة النّبي».
كان ذاك أدباً شعبيّاً وغالباً ما كان في شكل تلاوة أكثر منه قراءة. وفي أيّ من الشّكليْن، فقد قدّم للمؤمن العادي على الأقلّ صورة شفويّة لوجه النّبي وشكله، وإن كان ذلك بعبارات فضفاضة أكثر منها دقيقة (22).
قد تكون الصّيغ المختصرة من هذه النّصوص الوصفية/المدحيّة قد حُمِلت في وقت سابق على أنّها عمل من أعمال التّقوى أو كتعويذة، لكنّها تطوّرت إلى فنّ التصوير الفعلي في نهاية القرن السّابع عشر، عندما بدأ الخطّاط العثماني حافظ عثمان (ت 1698) في اقتطاع نصوص وإرفاقها برسم جذّاب وسرعان ما أصبح هذا الفنّان رائداً في ميدانه. وهكذا نشأت الحلية التّركية، وهي صورة أدبية للنّبي صِيغت بطريقة النّقش التّشكيلي، وأيقونة خطّية يمكن أن تزيّن أيّ سطح ويتمّ تعليقها على الجدران التّركية تماماً بالطّريقة التي يمكن للمسيحي أن يرسم بها صورة يسوع الرّاعي الصّالح (23).
في العالم المسيحيّ، كانت صور عيسى الكبيرة مع صورة عيسى المصلوب مرسومة أو مجسّمة في شكل كالصّليب، تزيّن جدران الكاتدرائيات والكنائس وأماكن الصّلاة والخطب كما انتقلت من يد إلى أخرى على العملات المعدنية والميداليات والسُبُحات. وظهرت كذلك على صفحات أولى طبعات العهد الجديد، وانتهى بها الأمر معلّقة على جدران المطابخ وغرف النّوم كتَذكَارٍ ديني. وكما هو واضح حتى للعين عديمة الخبرة، فإنّ تشابه وجه عيسى في التّقليد الأوروبي، بعد فترة أوّلية من الشكّ، يستقرّ في صورة متناسقة بشكل ملحوظ عبر القرون (24). وبما أنّ فنّ التّصوير الغربي كان واقعياً على امتداد فترة طويلة في مقاصده وأدائه، فقد اعتُبرت الصّورة على أنّها «الحقيقيّة» أو، في سياقنا، عيسى التّاريخي (25).
بالنّسبة إلى المسيحيّين، فإنّ عيسى، الذي جسّدته لهم ذخيرة من الصّور حرفياً من المهد إلى اللّحد، هو شبيه بنجم سينمائي في شريط كامل، كل سمة منه محفورة في الذّاكرة البصرية المشتركة للجمهور. أمّا صورة محمّد، فتشبه إلى حدّ كبير صورة مقدّم إذاعيّ، صوت مسموع من بعيد لا يمكن لأحد أن يتخيّل سماته إلّا لنفسه. يجب على المسلمين أن يتمثّلوا النّبي بشكل فردي على أنّه الصّوت من خلْف القرآن، أو كشخصية تنبثق من بين سطور السّيرة أو كملامح ملموسة غالباً ما تكون عامّة -«لا هو بالطّويل جداً ولا بالقصير جداً»- وتكون دائماً موصوفة ولم تكن أبداً مجسّمة في لوحات فنّية أو في شيء من هذا القبيل.
[1] - الترجمة مقتطفة من كتاب: عيسى ومحمد: المسارات، توازي السِّيَر، فرانسيس إدوارد بترز، صدر عن دار مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع.