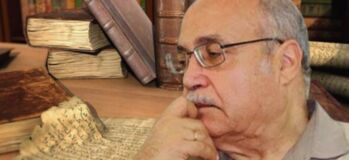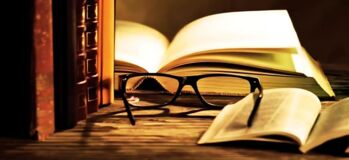كيف تحولت العقيدة من محرك للحضارة إلى مُخَدِّر للجماهير؟
فئة : مقالات

كيف تحولت العقيدة من محرك للحضارة إلى مُخَدِّر للجماهير؟
يقول ماركس قولته الشهيرة: "الدين أفيون الشعوب". وكلّ منا يردّدها في سرّه: "هو حتمًا يتحدّث عن المسيحية الكاثوليكية في عصره". وبالفعل، كان الإسلام هو الاستثناء الأكبر لتلك المقولة؛ فبفضله انطلق العرب من رعاة للغنم والإبل إلى قادة فتوحات وأصحاب إبداع فكري وعلمي هزّا العالم. لكنّ المفارقة المأساوية هي أن تمرّ القرون، لتصبح ممارستنا نحن للدين اليومَ هي الأشبه حتمًا بـ"أفيون الشعوب". كيف تحوّل الدين من طاقة دافعة للبناء والحضارة إلى طقوسٍ مُخَدِّرة للهروب من مواجهة الواقع؟ كيف استبدلنا "عقيدة التحدي" التي بنت الحضارة، بـ "عقيدة الاستسلام" التي تبرر التخلف؟
نحن معتادون على إلقاء اللوم على الاستعمار في انحطاطنا. لكن الحقيقة المرة هي: الاستعمار لم يُسقط حضارتنا، بل وجدها غائبة. لم يهزمنا، بل وجدنا مهزومين. فنابليون دخل مصر دون مقاومة حقيقية، والقوى الاستعمارية وجدت أممًا مشلولة التفكير، موتى سريريًّا، عاجزة عن الإبداع أو حتى الدفاع عن نفسها. المشكلة إذن ليست في عدوّ خارجي، بل في موت داخلي. الجواب لا يكمن في الدين نفسه، بل في تحوّل جذري في فهمنا نحن له. لقد استبدلنا "دين القوانين" الذي يأمر بالأخذ بالأسباب، بـ"دين الطقوس" الذي ينتظر المعجزات. واستبدلنا "دين العمران" الذي يجعل العمل عبادة، بـ"دين الهوية" الذي يهتم بالمظهر ويغفل الجوهر.
هذا التحول الخفي هو ما سرق منا قوة الحضارة... وفهمه هو بداية استعادتها.
ما فات الآخرين: الجذر العقدي للأزمة الحضارية
لقد شخّص كثير من المصلحين أعراض انحطاطنا بدقة - من تخلف تقني وتبعية ثقافية - لكن قليلون من حفروا إلى الجذر العقدي لهذه الأعراض. فقد بقيت تحليلاتهم تدور في فلك الاجتماعي والسياسي، دون أن تسأل: ما المفاهيم العقدية التي أنتجت هذه الأعراض؟ فهم - مثلاً - حللوا التخلف الاقتصادي، لكنهم لم يحللوا مفهوم القضاء والقدر الذي شلّ الإرادة. وناقشوا انفصال الأخلاق عن العمل، لكنهم لم يناقشوا مفهوم الشفاعة الذي قتل الحافز. ولهذا بقيت مشاريع الإصلاح سطحية؛ لأنها لم تصل إلى العطب الأساسي: المفاهيم التي تشكّل وعي الأمة وتوجه إرادتها. فالنهضة لا تبدأ بمصنع أو جامعة فحسب، بل تبدأ بإصلاح مفهوم النية، وتصحيح فهم القدر، وتحرير معنى العبادة من الطقوس إلى الحياة. وهذا هو بالضبط ما قدّمه المسلمون الأوائل، وهو ما يجب أن نستعيده اليوم.
العقيدة تحدد ملامح الحضارة
العقيدة ليست مجرد شعائر فردية، بل هي التي تحدد ملامح الفعل الحضاري. فمتى ارتبط الإيمان بالعلم والعمل، انطلقت الحضارة، ومتى تحوّل الدين إلى طقوس وشعوذة، تعطّل العقل وتوقّف الإبداع. لذلك لم تنتج المجتمعات الوثنية، على وفرة طقوسها، عدالة اجتماعية حقيقية ولا عمرانًا يحترم الإنسان. بينما كان الإسلام، منذ بدايته، يربط بين صدق عمل القلب في عالم الغيب، وعمل الجوارح في عالم الشهادة، فجعل العلم عبادة والعمل جزءًا من الإيمان، فانبثق منه فعل حضاري متكامل.
العقيدة الطقوسية لا تُنتج حضارة
كان المجتمع الإغريقي القديم مجتمعًا وثنيًا يفسّر إشكالياته على أنها غضب من آلهة متقلبة المزاج. وكان الحلّ في نظره تقديم القرابين وإقامة الطقوس لترضى الآلهة، لا البحث عن القوانين التي تحكم الكون. ولهذا لم تنتج تلك العقيدة الطقوسية عدالة اجتماعية شاملة ولا فعلاً حضاريًا متماسكًا.
وبينما تاهت الحضارات الوثنية والطقوسية بين آلهة متقلّبة أو شعائر جامدة، جاء الإسلام بدين التوحيد الحق، ليؤكد أن الله يتجلى في قوانينه المحكمة في عالم الغيب وعالم الشهادة، وأن امتثالها هو الطريق إلى الفعل الحضاري الراشد.
العقيدة الصحيحة أنتجت حضارة المسلمين الأوائل
لم تنطلق الحضارة الإسلامية في أصلها من عقل مادي ولا من طقوس جامدة، بل من عقيدة التوحيد التي تجعل كل عمل عبادة إذا أُخلصت فيه النية لله. فالعبادة شملت تقوى الله في المعاملات والعلاقات الاجتماعية، والعدل في الحكم، وإتقان العمل، وإبداع العلم والمعرفة.
تدبّر القرآن منطلق الفعل الحضاري
لقد تدبّر المسلمون الأوائل القرآن، فامتثلوا لأول أمر في الوحي: "اقرأ"، ورأوا في قوله: "وعلّم آدم الأسماء كلها" أن الخلافة في الأرض لا تكون إلا بالعلم. وفهموا أن معنى: "ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها" هو تفعيلها في حياتهم: رحمة، وعدل، وحكمة، وعلم. وهكذا أيقنوا أن قوانين الله تتجلى في الكون والتاريخ بقوانين محكمة عادلة، لا تحابي أحدًا، وأن امتثالها هو جوهر العبادة.
الفتوحات الإسلامية
ولعل أعظم ما جسّد هذا المنهج هو الفتوحات الإسلامية. لم يكتف المسلمون الأوائل بالدعاء للنصر، وهم في بيوتهم، بل عملوا في عالم الشهادة بكل ما أوتوا من قوة: درسوا جغرافية البلدان، وضعوا الخطط العسكرية، نظموا الجيوش، أعدوا العتاد، وتعلموا فنون القتال. وفي الوقت نفسه عملوا في عالم الغيب: توكلوا على الله، أخلصوا النية لنشر العدل، واستعانوا بالصبر والصلاة. فكانت النتيجة فتح نصف المعمورة في أقلّ من قرن واحد - إنجاز لا يُفسر بالأسباب المادية وحدها، ولا بالدعاء المجرد، بل بالجمع بين العالمين.
الاجتهاد: أعظم إنجاز حضاري
إلى جانب الفتوحات التي وسّعت رقعة الأمة، أبدع المسلمون الأوائل إنجازًا حضاريًا فريدًا: علم الاجتهاد والاستنباط.
لم يكن هذا العلم مجرد ترف فكري، بل جهازًا عقليًّا متكاملاً مكّن الأمة من قراءة النصوص في ضوء الواقع، ومواجهة المستجدات بمنهجية رصينة. فحين واجه الفقهاء قضايا لم يرد بشأنها نص صريح في القرآن أو السنة، لم يقفوا عاجزين، بل ابتكروا أدوات عقلية غير مسبوقة: القياس لإلحاق الفروع بالأصول، والاستحسان لمراعاة الظروف الخاصة، والمصالح المرسلة لتحقيق المصلحة العامة.
ثم تُوِّج هذا التطور بإبداع نظرية المقاصد، التي حوّلت الفقه من مجموعة أحكام متناثرة إلى منظومة متماسكة لها أهداف كبرى تحكم تفاصيلها. وهكذا صار الاجتهاد المحرك الداخلي للحضارة الإسلامية: يحفظ الثابت ويستجيب للمتغير، يربط الوحي بالعقل، ويحوّل الدين إلى مشروع حيّ قادر على النمو والتكيف.
ولم يكن الاجتهاد غاية في ذاته، بل وسيلة لضمان العدل - ذلك المبدأ الذي أكد ابن خلدون أنه "أساس العمران". فمن خلال المقاصد تبيّن أن غاية الدين ليست الطقوس في ذاتها، بل حفظ كرامة الإنسان وإعمار الأرض بالعدل. هذا الفهم العميق هو ما منح الحضارة الإسلامية مرونتها الاستثنائية وقدرتها على التجدد عبر القرون.
العلم والعمل عبادة لإعمار الأرض
لقد فهم المسلمون الأوائل أن العلم والعمل جزءٌ من العبادة، وأن إعمار الأرض هو من صميم الخلافة عن الله. فكان الطب والفلك والهندسة والاقتصاد وسائل لابتغاء مرضاته، كما كان البحث العلمي عندهم جهادًا في سبيل كشف سننه. ولم يكن غريبًا أن يبرز منهم علماء حملوا مشعل الحضارة الإنسانية: جابر بن حيان رأى في الكيمياء تجلّيًا لنظام الله في المادة، والخوارزمي في الرياضيات نظامه في الكون، وابن الهيثم في الضوء منهجه في الكشف، وابن سينا في الطب حكمة الله في الجسد والروح، وابن خلدون في العمران سننه في التاريخ. بالنسبة لهم، البحث العلمي كان عبادة، والاكتشاف جهادًا؛ لأنهم كانوا يكتشفون تجليات الله في خلقه. هكذا صار الاكتشاف العلمي عبادة، والإبداع المعرفي سبيلًا لإقامة العدل، فانبثق من هذا الفهم فعلٌ حضاري متكامل. وحين فرّطنا في هذه العلوم وأتقنها غيرنا، فقدت الأمّة زمام المبادرة وغابت سيادتنا على كل الأصعدة.
نقطة التحول المأساوية
لكن مع سقوط الخلافة العباسية، انقطع هذا الفهم العميق لتجلي الله في قوانينه، وتسرب للأمة الإسلامية فهم يشبه الفهم الإغريقي الطقوسي. لن أخوض في تفاصيل التحول تاريخيًا، فليس ذلك الغاية من هذا النص. المهم أن الدين تحول إلى التركيز على استجداء المعجزات وطلب تعطيل القوانين، بدلاً من فهمها وتفعيلها. فتحولنا من "دين القوانين" إلى "دين الطقوس"، ومن علماء يكتشفون تجليات الله إلى متسولي معجزات. والنتيجة كانت تراجعًا حضاريًا مستمرًّا، بينما الأمم الأخرى تطبق قوانين الله – دون أن تعرفه – فتنجح وتتقدم.
مظاهر الانحطاط الحضاري (شواهد تاريخية وفكرية)
- وقف الاجتهاد: سدّ باب التفكير الحر والاجتهاد الفقهي، فأُستبدل العقل بالنقل الحرفي الجامد.
- انتشار الفكر القدري: الاعتقاد أن كل شيء مكتوب مسبقًا، وأن لا جدوى من العمل أو التخطيط، وهو ما رسّخ التواكل.
- انتشار الشعوذة والطقوسية: اللجوء إلى الدجالين والمعالجين بالتمائم بدل البحث العلمي والطب.
- انحسار دور المرأة في المجتمع: تقليص مشاركتها في التعليم والعمل والإنتاج المعرفيّ والتربويّ، وحبسها في أدوارٍ شكليّة؛ ففقد المجتمع نصف طاقته.
- رفض الطباعة: مثل قرار السلطان سليم الأول بمنع الطباعة، مما أوقف تداول المعرفة وحاصر الأفكار.
- انشغال الناس عن قيمة الوقت: إهدار الوقت أصبح عادة، وغاب التخطيط طويل الأمد.
- انفصال الأخلاق عن العمل: تراجع مبدأ الإخلاص والنية الصادقة، وصار العمل دنيويًا بلا بعد تعبدي.
الفهم القدري السلبي
من أبرز مظاهر الانحطاط الحضاري في الأمة الإسلامية انتشار الفهم القدري السلبي. فبدل أن يكون الإيمان بالقدر باعثًا على الطمأنينة بعد بذل الجهد، تحوّل إلى حجّة لترك العمل: "كل شيء مكتوب"، "لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا". حتى صارت الكوارث والأوبئة والفقر تُستقبل بالاستسلام بدل التخطيط والوقاية.
وقد نبه العلماء إلى خطورة هذا الفهم، مثل رسالة الوقاية من الطاعون للشيخ محمد بيرم الثاني في تونس، حين واجه انتشار الوباء بدعوة الناس إلى الأخذ بالأسباب الطبية والوقائية، بينما كان عموم الناس يرون الطاعون "قدرًا محتومًا" لا فائدة من مقاومته.
هذا التحوّل من دين القوانين إلى دين الطقوس هو الذي عطّل الفعل الحضاري؛ فغابت المبادرة، وعَمّ التواكل، وضاعت قيمة التخطيط والعمل. وهنا كانت القدرية النقطة الفاصلة بين حضارة تبني المستقبل وأمة تستهلك التاريخ.
مظاهر ضياع قيمة الوقت
هذا الفهم القدري السلبي انسحب مباشرة على قيمة الوقت. فإذا كان كل شيء مكتوبًا، فلا معنى للاستثمار في الزمن أو التخطيط بعيد المدى. فظهر:
- عادة إهدار الوقت في المقاهي والبطالة المقنّعة.
- غياب المشاريع بعيدة المدى، والاكتفاء بردود أفعال آنية.
- ضعف الاهتمام بالانضباط الزمني (في العمل، التعليم، الإدارة).
- تراجع ثقافة "الموعد" والدقة، حتى صار التأخر عادة اجتماعية مقبولة.
- انقطاع المشاريع العلمية الكبرى التي تتطلب أجيالًا متعاقبة.
وهكذا تلاشى إدراك أن الوقت هو رأس مال الحضارة، بينما المسلمون الأوائل فهموا أن "العُمر" هو الوعاء الحقيقي للعمل والنية، وأن التفريط في الزمن هو التفريط في معنى العبودية ذاته.
انفصال الأخلاق عن العمل
تحول الدين إلى مجرد شعائر منفصلة عن السلوك المهني. فأصبح المسلم يصلي ويصوم، لكنه يغش في التجارة ويهمل في العمل ويخل بالمواعيد. كأن الأخلاق محصورة في المسجد، والعمل مساحة "دنيوية" لا علاقة للدين بها. هذا الانفصال دمّر مفهوم الإتقان كعبادة، وحوّل العمل من رسالة إلى مجرد وسيلة للكسب.
الاعتماد على الشفاعة بلا عمل
انتشر مفهوم خاطئ للشفاعة، حيث يعتقد البعض أن مجرد الانتماء للإسلام يضمن النجاة، بغض النظر عن العمل والإنتاج. "أنا مسلم، والرسول سيشفع لي" - هكذا تحول الدين من برنامج عمل إلى بطاقة هوية، ومن مسؤولية حضارية إلى أمنية سلبية. النتيجة: شعوب تنتظر الشفاعة بدلاً من العمل للاستحقاق. لكن الله يقول بوضوح: "من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه" [البقرة: 255] - فالشفاعة ليست حقًّا مكتسبًا، بل رحمة مشروطة.
وهكذا أصبحنا نمارس دينًا يجعلنا نأتي للحياة كأننا في قاعة انتظار للجنة - ننتظر الموت حتى ندخل الجنة، وحتى إن كانت لنا أعمال سيئة فما هي إلا أياماً معدودة في النار ثم يأتينا المنقذ بالشفاعة، كما قال بنو إسرائيل: وقالوا لن ندخل النار إلا أياما معدودة. هكذا تحولت الحياة من مهمة حضارية إلى مجرد... انتظار.
ليس الأمر مجرد "فهم خاطئ"، بل عطب حضاري عميق عطل الأمة قرونًا. وكل هذه المظاهر من التواكل القدري إلى انتظار الشفاعة، ومن إهدار الوقت إلى انفصال الأخلاق عن العمل، تعود إلى جذر واحد: تحولنا من "دين القوانين" الذي يأمر بعبادة الله بالمعرفة به والاستجابة لأوامره والعمل بسننه، إلى "دين الطقوس" الذي يفصل النتائج عن العمل وينتظر المعجزات. ومن هنا بدأ الانحدار الحضاري، حين انطفأت روح الفعل وحلّت محلها طقوس الانتظار.
اللحظة التاريخية: إرادة التغيير
بعد قرونٍ من السبات الحضاري، نعيش اليوم لحظة فارقة في تاريخ الأمة: لحظة يتجدد فيها الفكر النقدي المنطلق من الإيمان، فيعيد وصل العقيدة بالفعل، والعبادة بالعمل. لحظة التحرر من قوالب التفكير القديم الذي برهن الواقع أنه لا ينسجم مع عقيدة التوحيد.
ويقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًۭٔا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾.
إنها لحظة اتّباع ما أنزل الله حقًّا، بتدبّره والعمل به. لحظة إدراكٍ بأن القضاء والقدر ليسا ذريعة للعجز، بل دعوة للأخذ بالأسباب، وأن العبادة ليست طقوسًا جامدة، بل سلوكًا ومعاملةً وإتقانًا.
وقانون التغيير الإلهي واضح لا استثناء فيه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾
فالتغيير يبدأ من الداخل، من وعي الفرد ونيته، فإذا صدقت الإرادة نزل العون من الله. والمعجزة الحقيقية ليست فيما ننتظر أن يأتي من الخارج، بل فيما يبدأ من أعماق النفس.
إنها اللحظة التي نستعيد فيها التفكير النقدي النابع من الإيمان، لنقيم نهضة حضارية جوهرها المعرفة وغايتها الدعوة إلى الله؛ لحظة الالتحاق بقطار الحضارة، مستضيئين بقيم دين الإسلام.
أضع بين يديك هذا النص، لا أراه نهاية، بل بداية لنقاش أوسع. لعلّك تفتح به حوارًا عن مفاهيم محورية نحتاج أن نعيد النظر فيها كمجتمع.
يقول النبي ﷺ: «بلّغوا عني ولو آية». فحين تُسهم في تغيير فهم شخص واحد فقط، فتيقّن أن ذلك الأثر الصالح سيكون في ميزان حسناتك. ويقول الله تعالى: "إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين"] يس: 11-12[