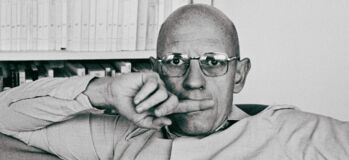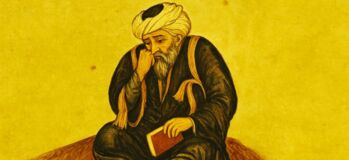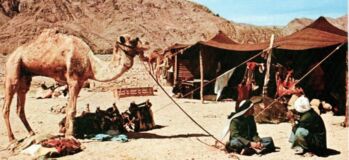ما وراء النظريات الخارجية: المسلمون، العصبيّة، وجهاد رمضان
فئة : ترجمات

ما وراء النظريات الخارجية: المسلمون، العصبيّة، وجهاد رمضان[1]
سوزان كارلاند
أنيسة باكلي
الملخص:
غالبًا ما أخطأت سوسيولوجيا الدين في تناولها للإسلام والمسلمين؛ إذ فرضت أطرًا نظرية خارجية لا تصلح لهذا الغرض، وأغفلت نظريات مكوِّنة قائمة بالفعل تفسر التجربة الإسلامية بصدق أكبر، كما خصصت عددًا أقل من الدراسات نسبيًّا للإسلام والمسلمين. تسعى هذه الورقة لتقديم مساهمة بسيطة لمعالجة هذه القضايا، من خلال دراسة الحياة الدينية للمسلمين العاديين في مدينة ملبورن خلال شهر رمضان، بالاعتماد على نظريات وضعها ابن خلدون. ومن خلال توسيع مفهوم “العصبية” الذي طرحه ابن خلدون، تستكشف هذه الورقة ولأول مرة الأدوار المتداخلة للمشقة والإسلام في توليد إحساس مغذٍّ بالتماسك المجتمعي. وقد أُجري البحث من خلال يوميات مجهولة الهوية احتفظ بها المشاركون على مدى فترة ممتدة، ما وفر رؤى غير مسبوقة وجديدة حول حياتهم. وتشير النتائج إلى أن التحديات الجسدية والروحية التي يفرضها رمضان، إلى جانب تأثير الإسلام “العابر للحدود الوطنية”، تسهم في تكوين العصبيّة. وتؤكد الورقة أن الأدوات السوسيولوجية المستخدمة في فهم المسلمين غالبًا ما تكون خارجية وغير مناسبة، وتوسع بالتالي من نطاق نظريات ابن خلدون التي طُرحت قبل 600 عام، وخاصة “العصبية”، وتعيد تطبيقها بأساليب جديدة لشرح تجربة المسلم المعاصر في رمضان.
المقدمة
ما الذي يعنيه أن ننظر سوسيولوجيًّا إلى الممارسات الدينية ومواقف المسلمين العاديين بطريقة تتماشى مع إيمانهم وذواتهم؟ وربما الأهم من ذلك: لماذا يهمنا هذا؟
بوجه عام، ليس من النادر أن يُتحدَّث عن المسلمين دون التحدث معهم (سعيد، 2003)، وأن تغيب وجهات نظرهم عن النقاشات المتعلقة بهم وبإيمانهم (إسبوزيتو ومغاهد، 2007؛ كارلاند، 2017). وغالبًا ما يكون هذا الغياب صادمًا، كما أوضح إدوارد سعيد في نقده اللاذع في كتابه تغطية الإسلام (2008).
وبصورة أكثر تحديدًا، فقد أغفلت سوسيولوجيا الدين (وفرعها الفرعي: الدين المعيش أو اليومي) دراسة الإسلام والمسلمين، سواء من الناحية النظرية أو اللاهوتية، واكتفت كذلك بتخصيص عدد أقل من الدراسات لحياة المسلمين مقارنة بما نُشر عن المسيحيين، مثلاً.
ولهذا السبب، لطالما أشار علماء الاجتماع إلى ضرورة تطوير مقاربات نظرية غير مسيحية وغير غربية في سوسيولوجيا الدين، خصوصًا عند تناول الإسلام والمسلمين، على مدى عقود. أولًا، لأن الفرضيات والأطر التي تبدو منطقية في سياق المسيحية أو الغرب لا تنطبق بالضرورة على أديان وسياقات أخرى. فقد كان عالم الاجتماع الإيراني علي شريعتي رائدًا في اقتراح سوسيولوجيا للإسلام منذ ستينيات القرن العشرين، حيث دعا بجرأة إلى استقاء نظريات التغيير الاجتماعي من الإسلام لفهم التحولات التي شهدتها إيران بشكل أكثر دقة من الطروحات الغربية الشائعة (1979).
وبالمثل، يوضح أسد (1993) أنه لا يمكننا أن نفترض أن الممارسات والمواقف وأدوار رجال الدين في المسيحية قابلة للتعميم على أديان أخرى؛ بل يجب النظر إلى كل ديانة كوحدة قائمة بذاتها، ذات مفاهيم ومسارات ودوافع وتوترات خاصة ضمن بنيتها الذاتية. وبالتالي، عند تناول حياة المسلمين وممارساتهم الدينية، لا يمكننا ببساطة اقتطاع التفسيرات الأوروبية أو المسيحية وإلصاقها بالمسلمين؛ بل ينبغي النظر إلى تجارب المسلمين العاديين بطريقة تتسم بالتماسك الداخلي.
وعند استخدام الأطر النظرية والنصوص التي يستخدمها المسلمون أنفسهم لوصف وفهم ذواتهم، يتساءل أحمد: “ما مدى اكتمال وصدق وعمق الملاحظات حول المسلمين الأحياء الذين يتنفسون، إذا لم نأخذ بعين الاعتبار النصوص التي يقرؤونها ويتعلمون منها ويُعلِّمونها ويتشاركونها؟ ... هل يمكننا التظاهر بأننا نفهم المسلمين المعاصرين إن لم نعد إلى نصوصهم، وليس القرآن فحسب؟” (2022: 136).
ويذهب سالفاتوري (2016) إلى أبعد من ذلك، إذ يدعو إلى تبني إطار تفسيري مغاير لما هو مستخدم عادة في سوسيولوجيا الدين—”سوسيولوجيا الإسلام”—وذلك لمساعدة علم الاجتماع على التحرر من “الخطيئة الأصلية الثقيلة” المتمثلة في “عدم الاعتراف بالدينامية الاجتماعية والمدنية للتجليات غير الغربية للدين” (ص 6).
وتُعد سوسيولوجيا الإسلام، وفقًا لسالفاتوري، “منظورًا مستوحًى من الوزن النوعي والغنى الخاصين بالممارسات التاريخية والتفسيرات الإسلامية للدين” (2016: 8)، مما يجعلها مقاربة أكثر أصالة في تصورنا لحياة المسلمين العاديين الدينية. ومع ذلك، فهي ليست مقاربة منغلقة على ذاتها أو مناهِضة للعلم، بل يمكنها أن تثريه، إذ يرى سالفاتوري أنها توفر وسيلة جديدة لاستكشاف القضايا الأساسية في علم الاجتماع عبر أدوات تفسيرية إضافية، وتجدد في الوقت ذاته أهداف هذا العلم، الذي يدّعي العالمية بينما يؤدي وظائف خاصة.
ثانيًا، جادل عدد من الباحثين بضرورة تبنّي مقاربات غير مسيحية وغير غربية، لا سيما تلك التي يقودها مسلمون، في سوسيولوجيا الدين، نظرًا لوجود خيارات تفسيرية يمكن أن تشرح الإسلام والمسلمين بطريقة أكثر أصالة وعمقًا من الأدوات الشائعة، لكنها لا تزال إلى حد كبير غير مستثمرة (سبكارد، 2001 و2017؛ الأتاس، 2014).
فقد اقترح سبكارد (2001) “سوسيولوجيا إسلامية للدين”؛ إذ رأى أن فئات سوسيولوجيا الدين الغربية “ليست عالمية كما يزعم أنصارها”. ومثل سالفاتوري، رأى سبكارد أن توسيع علم الاجتماع ليشمل التفسيرات والأفكار الإسلامية سيكون “مثمرًا سوسيولوجيًا” (2017: 15)، مشيرًا إلى أننا “بحاجة إلى صندوق أدوات مفاهيمي أكبر إذا أردنا فهم الظواهر الدينية عالميًا” (2001: 104)، وذلك من أجل تفكيك مكونات الحياة الدينية التي تم التغاضي عنها سابقًا.
وعلى الرغم من أن هذه الحجج القوية طُرحت منذ سنوات وحققت مساهمات مهمة (شريعتي، 1979؛ وود وكيسكن، 2013)، فإن التركيز الحديث ظل عامًا، إذ غطى “جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية في المجتمعات الإسلامية، وليس الدين فقط” (كورتزمان، 2019: 266). ولم يُحرز تقدم كبير في تبنّي اقتراحات باحثين مثل سبكارد لتقديم تصوير أكثر صدقًا لحياة المسلمين وتجاربهم الدينية، ومن خلال ذلك، لتوسيع البنية التفسيرية لسوسيولوجيا الدين ككل.
أخيرًا، رغم ازدياد الدراسات حول الدين المعيش لدى المسلمين (بيكرز، 2018؛ دي كونينغ، 2018؛ ديسينغ وآخرون، 2013؛ يلدتوف، 2011؛ كلوس، 2018؛ بييلا وكروتوفيل، 2021)، فإنها لا تزال محدودة بشكل عام (أمّيرمان، 2016؛ يلدتوف، 2011). فقد وجدت أمّيرمان (2016) في دراستها التحليلية للأدبيات أن ثمانية فقط من أصل 64 مقالًا أكاديميًّا، تناولت الدين المعيش ركّزت على الإسلام؛ أي أقل من 13%. ولا يزال هذا الحقل مائلًا بشكل كبير نحو الطوائف المسيحية المختلفة. ومع تطور المجال، يصبح من الضروري بناء فهم أعمق حول الأفراد وممارساتهم اليومية عبر طيف واسع من التقاليد الدينية والروحية.
وبالتالي، فإن دراسة الإسلام والمسلمين ضمن إطار سوسيولوجيا الدين تعاني من محدودية في الاهتمام والبحث، غالبًا ما تُصاغ هذه الاستنتاجات باستخدام مقاييس وأدوات مستمدة من تقاليد أو سياقات لا تتطابق مع تجربة المسلمين[2]. وللعودة إلى سؤالنا السابق، فإن هذه المسألة تهمنا لأن تصوراتنا حول الإسلام والمسلمين في مجال سوسيولوجيا الدين غالبًا ما تكون غير مكتملة أو غير دقيقة، مما يجعل هذا المجال نفسه ضعيفًا. إن تبني أدوات نظرية أكثر تنوعًا سيسمح لـ “الحداثة الغربية بأن تفتح نفسها على مفاهيم أكثر تعددية وتبادلية حول المجتمع الحديث والفاعلية فيه” (سالفاتوري، 2016: 12).
كيف نوسّع أدواتنا المفاهيمية لدراسة الدين المعيش عند المسلمين؟
كيف لنا، إذن، أن نوسّع صندوق أدواتنا المفاهيمية عند دراسة الدين المعيش لدى المسلمين، كما دعا أسد، وشريعتي، وسبكارد، وغيرهم؟ لا تهدف هذه الورقة، ولا تدّعي، تقديم نموذج نهائي لسوسيولوجيا الإسلام أو سوسيولوجيا إسلامية للدين المعيش، بل إن هدفنا، الأكثر تواضعًا وإن كان أساسيًّا، هو أن نُظهر كيف أن الانتباه إلى عملية تشكيل المعنى لدى المسلمين من خلال إطار تأسيسي أصيل يمكن أن يُوسّع ويُغذي نظرياتنا السوسيولوجية حول الدين المعيش.
ولأجل ذلك، اخترنا أن نطبّق ونوسّع مفهومًا نظّره (وربما يمكن اعتباره)[3] أول عالم اجتماع في التاريخ، ابن خلدون (ت. 1406)، قبل أكثر من 600 عام، استنادًا إلى ملاحظاته عن المسلمين الأوائل؛ وذلك بغية تفسير مواقف وسلوكيات المسلمين المعاصرين. وقد اخترنا أن يكون موضوعنا دراسة تجريبية حول تجارب المسلمين الأستراليين في رمضان، بوصفها حالة توفّر اتساقًا من خلال إطار داخلي تأسّس في سياق إسلامي لفهم التجربة الإسلامية.
وعلى الرغم من أن هذه الورقة تمثل إسهامًا تمهيديًّا، فإننا نأمل أن تقدم رؤية جديدة في مجال دراسة السوسيولوجيا الدينية للمسلمين. وعلى غرار دعوة سبكارد (2001، 2017) إلى سوسيولوجيا إسلامية للدين، فإننا في هذا البحث نستخدم أعمال المفكر الموسوعي ابن خلدون، المولود في تونس سنة 1332، أي بعد حوالي 700 عام من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونستند تحديدًا إلى مؤلفه الشهير “المقدمة” (1377، ترجمة روزنتال، 1958)، وهو القسم الافتتاحي من عمله الكبير المكوّن من سبعة مجلدات “كتاب العبر”، الذي يُعد حجر الزاوية في سوسيولوجيته الإسلامية. ونركّز على أحد المفاهيم المركزية التي طرحها وناقشها نظريًا، وهو مفهوم “العصبية” (ʿaṣabiyya).
شرح لغوي:
من الناحية الاشتقاقية، تأتي كلمة “العصبية” من الجذر العربي: ع-ص-ب، الذي يدل على “الشدّ أو الربط”، كما في لفّ العمامة حول الرأس (كوان، 1993: 720). ومصطلح “عصبية”، الذي صاغه ابن خلدون، يشير إلى التماسك الاجتماعي أو “روح الجماعة، والولاء القبلي، وروح الفريق” (كوان، 1993: 720). إذن، جوهر الكلمة في أصلها العربي يدل على الارتباط الوثيق، سواء كان لفّ القماش على الجسد، أو ارتباط البشر بعضهم ببعض في المجتمع.
ومن الجدير بالذكر هنا أن ابن خلدون ناقش العصبية بوصفها مرتبطة بالدم والنسب، لكنه لم يحصرها في ذلك، بل نظر إليها بمنظور أوسع. فقد أشار كايا بينار إلى أن ابن خلدون “لا يقصر العصبية على روابط الدم فقط، بل يضيف العملاء والحلفاء والجيران إلى نفس الفئة” (2008: 383)، معتبراً أن العصبية تتعلق بمن هم على اتصال وثيق. ويذهب كايا بينار إلى القول: “فيما يتعلق بالعصبية… ما يهم ليس الوجود الحقيقي للعلاقة الدموية، بل وجود التصور أو الإيمان الذي يخلق الاتصال الوثيق والمساعدة المتبادلة” (المصدر نفسه). وهذا التفسير يتفق مع ما طرحه غلنر، الذي انتقد تفسيرات القرابة الحضرية التي ترى العصبية نتيجة مباشرة للعلاقات الدموية، معتبرًا إياها “زائفة، لا لأنها غير صحيحة من الناحية الجينية — فقد كان ابن خلدون يعلم أن هذا الأمر موجود أيضًا في المجتمعات القبلية ولم يكن له أهمية — بل لأنها غير صحيحة سوسيولوجيًا؛ أي إنها لا تعكس تماسكًا اجتماعيًّا” (1975: 205؛ والتأكيد في النص الأصلي). كما رأى مهدي (1957) أن روابط الدم ليست سوى “أبسط أشكال” العصبية (ص. 196)، وأن “النسب المشترك، والمصالح المشتركة، والتجارب المشتركة للحياة والموت، تعزز بعضها بعضًا في تنمية العصبية” (ص. 196–197). هذه “المصالح والتجارب المشتركة” وعلاقتها بالعصبية، هي ما سننظر فيه في هذه الورقة.
الخلفية والسياق
في شهر رمضان من عام 2020، كانت مدينة ملبورن (على خلاف مدن أسترالية أخرى) تمرّ بمرحلة إغلاق صارمة بسبب جائحة كوفيد، استمرت لعدة أشهر، وكانت حينها تُعدّ أطول وأشد إغلاق في العالم (فرناندو، 2020). شملت تلك الإجراءات منع استقبال الضيوف في المنازل، أو زيارة الآخرين، أو حضور التجمعات الدينية أو أداء العبادة في المساجد. وفي أكثر مراحل الإغلاق تشددًا، لم يكن يُسمح لسكان ملبورن بالخروج من منازلهم سوى لساعة واحدة يوميًا لممارسة الرياضة، وكان هناك حظر تجول يبدأ من الثامنة مساء، وحدّ أقصى للتنقل لا يتجاوز 5 كيلومترات. كما لم يكن يُسمح إلا للعاملين في القطاعات الأساسية بالذهاب إلى أماكن عملهم، بينما كان طلاب المدارس والجامعات وسائر العاملين يؤدون مهامهم من المنزل. وبذلك، كانت تلك الفترة مشبعة بالحياة المنزلية والانكفاء إلى الذات، وخلالها جاء رمضان 2020.
أما رمضان 2021، فقد حلّ في وقت كانت فيه قيود كوفيد قد رُفعت بشكل شبه كامل في ملبورن، لدرجة أن رمضان لم يتأثر بها تقريبًا.
وقد وفّرت هاتان التجربتان الرمضانيتان المختلفتان تمامًا أرضية مثالية لتقييم الدور الذي تلعبه الجماعة والوصول إلى المسجد في حياة المسلمين في ملبورن؛ وذلك من خلال مقارنة تجربة رمضان في عام 2021 (حيث لا إغلاق)، مع رمضان 2020 الذي فرض على الناس تجربة دينية خاصة داخل منازلهم بسبب الإغلاق. إن توثيق وتحليل كيفية استجابة مسلمي ملبورن لهاتين التجربتين المختلفتين كان ذا أهمية كبيرة، سواء من منظور تاريخي — بوصفه توثيقًا لِكيفية عيش مجموعة من المسلمين لرمضان خلال جائحة عالمية تحدث مرة في القرن — أو كفرصة فريدة لدراسة التفاعل بين الجماعة، والممارسات الدينية، والمشاعر التي قد تولدها، أي: العصبيّة.
تعتمد هذه الدراسة مقاربة “الدين المعيش” (lived religion) التي تركز على كيفية ممارَسة الدين من قبل الناس العاديين في حياتهم اليومية (أمّيرمان، 2016؛ هال، 1997)، وتهتم بكيفية “ممارسة” المسلمين لدينهم في منازلهم ومساجدهم. ومن المهم الإشارة إلى أن العديد من هذه الممارسات اليومية تتجلى داخل المساجد تمامًا كما في البيوت، ما يشكل تصحيحًا مهمًا لاتجاه بعض دراسات الدين المعيش التي تميل إلى استبعاد الأعمال المرتبطة بالمؤسسات الدينية التقليدية. كما تؤكد أمّيرمان: “عندما يستبعد باحثو الدين المعيش الأفعال المرتبطة بالمؤسسات الدينية التقليدية، فإنهم لا يستبعدون فقط ما يعتبره معظم الناس ممارسة دينية، بل كذلك الكثير مما يفعله الناس فعليًا” (2016: 10؛ التشديد في الأصل). وعند النظر إلى المسلمين في ملبورن خلال رمضان، تسهم العصبيّة في بناء وإعادة تشكيل الأمة (الأمة الإسلامية) أو ما يسميه سالفاتوري “الإيكيوميني الإسلامي”، أي “الجسد الإسلامي الجمعي القادر على التبلور في جماعات مترابطة” (2016: 10)، سواء كان ذلك في المنزل أو في المسجد.
الواجبات الدينية في رمضان: الارتباط بالجماعة
يُعدّ الصوم في رمضان فرضًا شرعيًّا على كل مسلم بالغ صحيح البدن، ويشكّل جزءًا من البُعد الطقوسي في التدين الإسلامي (حسن، 2002). حين يصوم المسلمون في رمضان، يُطلب منهم الامتناع عن الأكل والشرب، وكذلك عن العلاقات الزوجية، من الفجر حتى المغرب، تعبيرًا عن الطاعة لله. ولا يقتصر الصوم كفعل ديني على المسلمين فقط، بل توجد أنماط متعددة من الامتناع الطوعي عن الطعام أو الشراب في أديان عالمية أخرى، حيث يُنظر إلى الصوم الجماعي فيها كوسيلة لتشكيل المجتمع، والهوية الاجتماعية، والمكانة (ديتلر، 2011: 187).
ينظر المسلمون إلى الصوم في رمضان على أنه عمل بالغ الأجر، وقد ورد الثواب المترتب عليه في القرآن الكريم وفي أحاديث نبوية شريفة. من ذلك ما رواه البخاري: “من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدم من ذنبه” (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب 28، حديث 38، 1997). علاوة على ذلك، يمثل رمضان للكثير من المسلمين وقتًا للدعم الجماعي والتواصل الاجتماعي، حيث تخدم الأعمال العبادية مثل الصيام والصدقة غايةً أسمى ذات بُعد عدلي اجتماعي (منصوري وآخرون، 2017).
ومن الجوانب المهمة لهذه الدراسة أن المسلمين يعتقدون أن الله يمنحهم أجرًا مضاعفًا عند أداء العبادات في سياق جماعي خلال رمضان، مثل أداء صلاة التراويح في المسجد أو تفطير الآخرين. ويتأسس هذا المفهوم على أحاديث نبوية متعددة، منها ما ورد في صحيح البخاري: “أن الصلاة في جماعة أفضل من الصلاة الفردية بسبع وعشرين درجة” (صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب 30، حديث 645، 1997). كما ورد في الترمذي أن “من قدّم طعامًا أو شرابًا للصائم عند فطره ينال أجر الصائم نفسه” (سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب 82، حديث 807، 2007).
تُقام العديد من طقوس رمضان في المسجد بوصفه فضاءً مؤسسيًا ذا دلالة دينية عميقة. ففي أستراليا، كما في دول غربية أخرى، مثّلت المساجد منذ وقت مبكر مركزًا محوريًا في بناء الهوية الثقافية والدينية لدى المسلمين (ستيفنز، 1989؛ سكرايفر، 2004؛ بوما، 1997). ومع ذلك، فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، واجه بناء المساجد مقاومة كبيرة من بعض المجتمعات المحلية، وازدادت التوترات السياسية حول قضايا التعددية الثقافية والهوية الوطنية (دن، 2005).
وتكتسب المساجد أهمية خاصة في رمضان نظرًا للطقوس التي تؤدى خلالها في هذا الشهر، والتي لا تُمارَس عادةً خلال بقية السنة. وتُعدّ صلاة التراويح، وهي صلاة ليلية إضافية خاصة برمضان لدى المسلمين السنّة، إحدى هذه الطقوس؛ إذ يتلو فيها بعض الأئمة القرآن كاملًا على مدى ليالي رمضان. وغالبًا ما تكون هذه الصلاة طويلة ومرهقة جسديًا. كما تنظم العديد من المساجد وجبات إفطار جماعية، كما أظهرت دراسة أندرابي (2014) عن مساجد سيدني، حيث توفّر 90٪ من المساجد هذه الخدمة، ويقدّم حوالي 50٪ منها وجبة الإفطار يوميًّا.
تسهم هذه الطقوس الدينية والاجتماعية الرمضانية التي تتم في المساجد في تعزيز الروابط الاجتماعية، وتشير إلى أن المسجد يُعدّ “شكلًا مكانيًّا للانتماء والتواصل” (منصوري وآخرون، 2017: 36).
لكن هل رمضان في الإغلاق إشكالي من الناحية الدينية؟
على الرغم مما سبق من توضيح لأهمية الجماعية والمكان المؤسسي (أي المسجد) في أداء الطقوس الرمضانية، فإن رمضان في ظل الإغلاق لا يُعدّ إشكاليًّا بالضرورة من منظور لاهوتي. كما يوضح مراد (2020)، فإن جميع العبادات المطلوبة في رمضان يمكن أداؤها في المنزل، ولا توجد طقوس يشترط لصحتها الانعقاد في المسجد، أو أن تتم جماعيًّا، أو بإمامة إمام. ومع ذلك، فإن العديد من الممارسات الرمضانية المهمة تؤدَّى تقليديًّا في جماعة، وفي المسجد تحديدًا (مثل صلاة التراويح للمسلمين السنّة ووجبة الإفطار)؛ وذلك لأن أداءها جماعيًّا يُنظر إليه على أنه أكثر فَضلًا من الناحية الدينية، إضافةً إلى ارتباطه بعادات وتقاليد اجتماعية راسخة.
وهكذا، فإن الأفعال الدينية في رمضان تمثل تفاعلًا بين البعد الفردي والجماعي، وتنسج رابطًا بين التقوى والروابط الاجتماعية من خلال الثواب الإلهي.
المنهجية
تعتمد هذه المقالة على بحث أُجري في أوساط المسلمين المقيمين في مدينة ملبورن خلال رمضان 2021، حيث طُلب منهم مقارنة تجربتهم في هذا العام مع تجربة رمضان في عام 2020 أثناء الإغلاق الشديد. ووفقًا لتعداد 2021، بلغ عدد المسلمين في أستراليا حوالي 813,000 نسمة، أي ما يعادل 3.2٪ من مجموع السكان (المكتب الأسترالي للإحصاء، 2022).
لقد استخدمنا منهجًا مبتكرًا لالتقاط المواقف الشخصية والداخلية للمشاركين بأكبر قدر ممكن من الصدق. تم ذلك من خلال مطالبة المشاركين بتدوين يومياتهم بشكل مجهول خلال رمضان، واعتمدنا عدة إجراءات تضمن عدم إمكانية معرفة هوية المساهمين من قبل الباحثتين (اللتين تنتميان أيضًا إلى المجتمع المسلم في ملبورن)، مع الحفاظ على إمكانية ربط الإدخالات ببعضها حين تكون من الشخص نفسه. وقد مكّن ذلك المشاركين من التعبير بحرية بالغة، حيث كتب البعض أنهم بكوا أثناء التدوين، وعبّر آخرون عن شكوكهم الدينية، فيما شارك آخرون صراعات روحية عميقة مرّوا بها خلال هذا الشهر الكريم، مثل الوحدة الحادة، والشك، والعزلة، والخوف، واليأس الديني، إلى جانب مشاعر الفرح، والأمل، والحماسة، والإحساس بالإنجاز.
وعلى الرغم من أن دراسات سابقة استخدمت اليوميات الرمضانية (جونز-أحمد، 2022)، فإننا—بحسب علمنا—أول من استخدم يوميات متعددة الإدخالات ومجهولة الهوية في رمضان، مما أتاح الحصول على ردود أصيلة حتى عند تناول مواضيع غير شعبية اجتماعيًا أو دينيًا، مع تعدد الإدخالات لتقديم صورة أكثر شمولية عن كيفية تذبذب المشاعر والسلوكيات أو استقرارها طوال الشهر.
تمت دعوة المشاركين عبر البريد الإلكتروني من خلال شبكات الباحثتين الشخصية، كما نُشرت دعوة للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم الإعلان عنها ضمن نشرات ومجموعات إلكترونية للمجتمع المسلم، وذلك لضمان الوصول إلى فئات متنوعة وواسعة. وقد حرصنا خلال عملية الترويج على التأكيد أن الدراسة ترحب بجميع المسلمين، بمختلف درجات التديّن، لتجنب الاقتصار على “المتدينين جدًا”. كما أوضحنا أن جميع المساهمات ستظل مجهولة الهوية، من أجل تعزيز صدق المشاركات.
وبما أن الباحثتين مسلمتان، فقد أدركنا احتمال أن يحرص بعض المشاركين على إخفاء بعض الجوانب من ممارساتهم أو مواقفهم خوفًا من الحكم عليهم، أو بدافع إظهار “سلوك المسلم الجيد” أمام باحثات مسلمات (فاساديس وآخرون، 2015)، وهي ظاهرة تُعرف بـ “التحيّز نحو المقبولية الاجتماعية” (social desirability bias). وقد أظهرت البحوث أن هذه الظاهرة تؤثر بشدة على مصداقية الإجابات، خصوصًا في المواضيع الحساسة (لارسون، 2019؛ نيدرهوف، 1985)، وتؤدي إلى “تقليص التنوّع في الردود” (بيرغن ولابونتي، 2020). وقد أظهرت دراسات عديدة أن الناس يبالغون في إظهار تدينهم نتيجةً لهذا التحيز، مثل ادعاء الحضور المنتظم إلى الكنيسة أو الكنيس، أو تقديم إجابات “متدينة” إذا كان الباحث يرتدي رمزًا دينيًا واضحًا (بلايدز وجيلوم، 2013).
ولتقليل هذا التحيز، اعتمدنا أحد الأساليب المعروفة وهو ضمان السرية التامة (دورماز وآخرون، 2020). ونظرًا لأن المشاركين كانوا بحاجة إلى التسجيل باستخدام معلومات تعريفية، فقد وظّفنا مديرة مشروع غير مسلمة لا علاقة لها بالمجتمع المسلم لإدارة جميع الاتصالات وربط البيانات، بهدف استبعاد أي احتمال للتعرّف على المشاركين من قبل الباحثتين. وقد تم إبلاغ المشاركين بذلك عدة مرات. كما أن اختيار اليوميات الإلكترونية المجهولة، التي تُملأ في خصوصية المنزل، بدلًا من المقابلات المباشرة أو عبر الفيديو، منح المشاركين حرية أكبر في التعبير (بريك وآخرون، 2019؛ ويلان، 2008). كما وجدت ماركوس (2019) أن الاستبيانات الإلكترونية المجهولة “توفر بيئة يشعر فيها المشاركون بحرية أكبر للإفصاح عن آرائهم بصدق”.
طُلب من المشاركين تقديم أربع مداخلات يومية عبر الإنترنت، من خلال روابط تم إرسالها إليهم بالبريد الإلكتروني، وكان لديهم مهلة 6 أيام لإكمال كل مدخلة قبل إغلاق الرابط. تضمنت كل مدخلة أسئلة موجهة مفتوحة النهايات، ليتمكن المشاركون من الإجابة بإيجاز أو بإسهاب، بما يتوافق مع ما تسميه أمّيرمان “الآليات الدقيقة للممارسة الدينية” (2020: 8). احتوت المداخلة الأولى على أسئلة ديموغرافية أساسية حول العمر، والجنس، والخلفية الثقافية أو الإثنية، إلى جانب أسئلة عن الممارسات الدينية، والروابط الاجتماعية، والتطلعات الرمضانية. أما المداخلات الثانية والثالثة والرابعة، فقد تضمنت أسئلة مماثلة، إضافة إلى أسئلة تقارن رمضان 2021 برمضان 2020.
بلغ عدد المشاركين في المداخلة الأولى 95 شخصًا، منهم 80 (84٪) من الإناث، و15 (16٪) من الذكور. تراوحت أعمارهم ما بين 18 و65 عامًا، وكانت الفئة العمرية الأكبر هي 36–45 عامًا بنسبة 40٪. ومن حيث الخلفية الثقافية أو الإثنية، شكّل القادمون من جنوب آسيا أكبر نسبة (29٪، أي 28 مشاركًا)، بينما توزعت البقية على خلفيات من وسط آسيا، والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، وإفريقيا، وأنغلو-سلت.
وصل عدد الردود في المدخلة الثانية إلى 77، والثالثة إلى 67، والرابعة إلى 61. وقد كانت هذه النسبة أقل من التراجع المتوقع، خصوصاً وأن المداخلة الأخيرة تمت بعد شهر من انتهاء رمضان، حيث بدأت المشاعر الرمضانية تخفّ تدريجيًّا.
ولتقديم حافز للمشاركة، مُنح المشاركون قسيمة هدية بعد إكمال المداخلات الأربع، وقد قُدِّر الوقت اللازم لكل مداخلة ما بين 15–20 دقيقة، بحسب طول الإجابة. اختار المشاركون رموزًا خاصة بهم لربط الإجابات دون الكشف عن الهوية.
تم تحليل البيانات باستخدام “التحليل الموضوعاتي التطبيقي” Guest) وآخرون، 2012 (، نظرًا لأن بياناتنا وأسئلتنا البحثية (مثل: “تجارب الناس المعيشة حول... وجهات نظرهم بشأن... العوامل والعمليات الاجتماعية التي تكمن وراء ظواهر معينة”) تتناسب تمامًا مع هذا النهج (كلارك وآخرون، 2015: 227). وقد اختير هذا النوع من التحليل لمرونته (وولجموث وآخرون، 2024) وقدرته ليس فقط على الكشف عن المعنى، بل على نقله عبر “الموضوعات”. كما كان مفيدًا لتحليل مجموعة البيانات الواسعة، والمعقدة عاطفيًا، والمتضاربة أحيانًا—وهي ما وصفها وولجموث بأنها “بيانات تفتننا وتنهكنا” (2024: 281) و**”فوضوية”** (ص 284). وقد أتاح لنا هذا التحليل “التموضع في فضاءات منتجة حيث تزدهر الأفكار الجديدة والهامشية بدلًا من أن تُقصى بوصفها غير عقلانية أو غير ذات صلة” (المصدر نفسه).
وبتوجيه من هذه المبادئ، قمنا بتحديد الموضوعات عبر تكرار الأفكار (بيرنارد وآخرون، 2017)، وطورنا ما يسميه سلدانا (2024) “السرد التحليلي” (ص 22)، ليُبرز جوهر الظاهرة المدروسة.
النتائج
عندما درس ابن خلدون جماعات المسلمين قبل أكثر من 600 عام، لاحظ أنه عندما يمرّ أفراد الجماعة بمشقة- ما أسماه سبكارد لاحقًا بـ”مشقات الحياة” (2017: 145)- فإن ذلك يؤدي إلى تشكّل عصبية قوية؛ أي تماسك وترابط اجتماعي. فالتجربة المشتركة للمشقة تعمل كغراء يربط بين الناس. كما اعتقد ابن خلدون أن الإسلام، بحد ذاته، يمكن أن يعزز العصبية، ويُسهم في توحيد جماعات كانت متباعدة في الأصل. وقد جادل (ابن خلدون، 1377، ترجمة روزنتال، 1958) بأن المشقة الجماعية، إلى جانب الإسلام، هما المصدران الأساسيان لتشكّل العصبية أو “الرباط الاجتماعي” بين المسلمين.
تُقدّم هذه الدراسة حجة مفادها أن المسلمين الذين شاركوا فيها من مدينة ملبورن، خلال شهر رمضان، لم يعيشوا كلًّا من هذين العنصرين (المشقة، والإسلام) بشكل منفصل فحسب، بل إن تشابك هذين العنصرين—أي المشقة الناتجة عن الممارسة الدينية—هو ما ولّد لديهم الشعور الفريد بالعصبية، كحالة وجدانية واجتماعية متداخلة. وبالرغم من أن ابن خلدون قد نظّر لهذه الفكرة في أواخر القرن الرابع عشر بناءً على ملاحظاته لمسلمين في المغرب، والأندلس، وتونس، والجزائر، إلا أن هذه هي المرة الأولى- بحسب علمنا- التي يُستخدم فيها هذا الإطار التحليلي لتفسير تجربة المسلمين المعاصرين في رمضان.
الجهاد الروحي والبدني في رمضان
يتضمن رمضان مشقة جسدية—وهو ما أطلق عليه شيلكه “طابعه الزهدي” (2009: 24)—تشمل الجوع والعطش الناتجَين عن الصوم، وكذلك الإرهاق الناتج عن قلة النوم (شيبرد، 2013). وعلى مدى ثلاثين يومًا، يمكن أن تصبح هذه المشقة مرهقة.
في بداية الدراسة، وعلى الرغم من التعبير عن الحماسة لقدوم رمضان، أبدى العديد من المشاركين قلقهم بشأن قدرتهم على مواجهة هذا التحدي الجسدي والروحي. قال أحدهم:
“أشعر دائمًا ببعض التوتر والعاطفة قبيل رمضان. أطرح على نفسي سؤالًا: هل أنا مستعد لهذا؟” (QWE123)
وقال آخر:
“أنا متوتر قليلًا لأن الصوم يمكن أن يكون مرهقًا .” (JEA211)
وقد استخدم عدد من المشاركين كلمات مثل “متوتر”، “قلق”، “متحفظ” لوصف مشاعرهم قبل بدء الشهر. وشرح أحدهم كيف تؤثر متطلبات الشهر الجسدية على عمله:
“أهم مصدر للقلق بالنسبة لي هو الإرهاق. هذا أكثر تأثيرًا عليّ من الجوع. تنظيم النوم بسبب الاستيقاظ للسحور مثلًا يصبح صعبًا، مما يسبب اضطرابًا في نومي، وقد يؤثر على عملي.” (RAM021)
كما عبّر بعض المشاركين عن قلقهم من التوفيق بين الصوم ومتطلبات العائلة، خاصة في حالة الرضاعة. كتبت إحدى الأمهات:
“أشعر بالقلق بصراحة، فهذا أول رمضان أصومه وأنا أعتني بطفل حديث الولادة. لا أعلم إن كنت سأستطيع صيام الشهر كاملًا وأنا مرضعة، لكنني سأحاول قدر استطاعتي.” (ZSA540)
وتحدّث بعض الطلاب عن أثر الصيام على أدائهم الدراسي:
“أشعر بالقلق قليلًا حول تأثير الصيام على إنجاز واجباتي الجامعية، لأنه مرهق بدنيًا.” (HMS200)
“أكبر همومي (وكما هو الحال دائمًا) هي التوفيق بين العمل والدراسة وعبادات رمضان… الصيام وسط كل هذا مرهق جدًا.” (MCC081)
وبينما أعربوا عن حماستهم لـ رمضان، قالوا إن الصعوبات الجسدية كانت حاضرة في أذهانهم.
إليك بقية ترجمة القسم المتعلق بالجهاد الروحي، والصراع الداخلي في رمضان، كما عبر عنه المشاركون في الدراسة:
إلى جانب التحدي الجسدي، رأى المشاركون في رمضان تمرينًا روحيًا لضبط النفس وتزكية النفس، بل وشهرًا للسمو الأخلاقي الاستثنائي (شيلكه، 2009: 26–27). وقد وضع كثير من المشاركين تركيزًا كبيرًا على الجهاد الروحي والعمل على إصلاح الذات بعمق.
قال أحدهم:
“آمل أن أعمل على نقاط ضعفي، سواء في الممارسة الدينية مثل صلاة السنن وقراءة القرآن، أو على مستوى الصلة الروحية بالله، من خلال تهذيب النفس (النَّفْس) والتخلص من الغيبة والكبر والغضب والتسويف.” (IND296)
وعلى الرغم من أن رمضان يُعدّ فرصة للنمو الروحي، فإن المشاركين أعربوا عن قلقهم من متطلبات الشهر الروحية تمامًا كما عبّروا عن قلقهم من المتطلبات الجسدية. وقد أشار الغافلي وآخرون (2019) إلى أن التحديات الروحية قد تكون أشد صعوبة من الجسدية عند بعض المسلمين. وقد عبّر أحد المشاركين عن ذلك بقوله:
“الصيام بحد ذاته ليس صعبًا كما كنت أظن، ويمرّ اليوم بسرعة. التحدي الحقيقي هو كبح العادات القديمة للسان والفكر.” (CAT725)
ويؤيد ذلك ما خلصت إليه دراسة مولر (2005) عن المسلمين الجاويين، حيث وصفوا جهادهم في رمضان بأنه “الجهاد الأكبر”، واعتبروه أصعب من القتال (الذي يُطلق عليه “الجهاد الأصغر”). وقد تم التعرّف على هذا الجهاد الروحي — جهاد النفس — باعتباره تحديًا وفي الوقت ذاته مصدرًا للمكافأة والسمو لدى المسلمين (خان وآخرون، 2018؛ ساريتوبراك وآخرون، 2018 و2020). وقد اعتبر المشاركون أن هذه التحديات، إلى جانب المشاق الجسدية، تمثل ممارسات موحدة ومشتركة في رمضان، تؤدي إلى شعورهم بالعصبيّة تجاه بعضهم البعض.
وقد عبّر رجال ونساء من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية عن خشيتهم من صعوبة التوفيق بين متطلبات الصيام الروحية والبدنية، رغم تعبيرهم في الوقت ذاته عن الحماس والتوق لرمضان. وقالت إحدى المشاركات:
“آمل أن أخرج من رمضان وأنا مسلمة أفضل، في عباداتي وفي أخلاقي… أعتقد أن كل رمضان يتطلب جهدًا حقيقيًا للتحسن… أشعر بالحماس لأنني بحاجة حقيقية إلى هذا الشهر من أجل تنقية نفسي وإعادة ضبط عاداتي. لكني أشعر بالتوتر أيضًا… (ZAH294)”
ومع ذلك، لم يعتبر كل المشاركين أن طقوس رمضان الدينية مرهقة. فقد وصفها البعض بالحماس والراحة، مثل AWA751 التي كتبت:
“أنا متحمسة جدًا ولا أستطيع الانتظار حتى يبدأ الشهر المبارك. إنه الوقت المفضل لي في السنة، وأنا أعدّ الأيام حتى يبدأ رمضان.”
كما وصفته مشاركة أخرى بأنه مصدر ارتياح عاطفي، فقالت CLE108:
“أريد أن أشعر بالقرب من الله ومن نفسي. هذا الصباح شعرت بإحساس متزايد بجمال العالم من حولي، وكأن قلبي يتمدد. الآن، بدأت أشعر بالعاطفة، وكأنني على وشك البكاء. لأن هذا الوقت مميز جدًا ولا أستطيع وصفه بالكلمات، إنه شعور… نعم، سأبدأ بالبكاء الآن، لكن بطريقة جيدة. كأنها طهارة من التوتر المتراكم، ومن الدنيا التي تغادرني.”
الخلاصة في هذا الجزء:
على الرغم من أن بعض المشاركين رأوا في رمضان مصدر راحة وفرح، فإن الأغلبية ربطت هذا الشهر بالجهاد الروحي والجسدي، ورأت في هذا الجهد المشترك سببًا في توليد العصبيّة؛ أي الشعور بالترابط والانتماء داخل المجتمع المسلم، وهو ما سنراه بوضوح في القسم القادم.
تجلّي العصبيّة من خلال التجربة الجماعية
أشار العديد من المشاركين في هذه الدراسة إلى الشعور بالفرح والمعنى في رمضان 2021، بعد رمضان 2020 الذي عاشوه في ظل الإغلاق. قال أحد المشاركين:
“الحمد لله، هذه السنة نحن مباركون جدًا بعودة الإفطارات المجتمعية الأسبوعية، وبالعودة إلى الإفطارات العائلية أيضًا، فقد افتقدناها كثيرًا العام الماضي بسبب قيود كوفيد. سبحان الله، كان رمضان الماضي مرهقًا بسبب عدم قدرتنا على مشاركة الأهداف الروحية لهذا الشهر المبارك مع الآخرين”.(ROR2021)
نحن نتفق مع يادن وآخرين (2020) في أن الممارسات الدينية المجسّدة في رمضان - كالصيام، والصلاة اليومية (الصلوات الخمس)، وقراءة القرآن، وصلاة التراويح (التي يؤديها المسلمون السنة ليلًا) - تُعدّ طقوسًا ذات معنى. ومع ذلك، وعلى خلاف يادن وآخرين، نرى أن هذه الطقوس لدى المسلمين في رمضان هي في آنٍ واحد فردية وجماعية، إذ أظهر المشاركون انتقالهم بسلاسة بين الحديث عن الطقوس الشخصية والجماعية، وأهمية التفاعل بين الجانبين.
فكما عبّر ROR2021، فإن غياب الجماعة في الطقوس الرمضانية جعل الممارسة الفردية أكثر صعوبة. كذلك قال مشاركون آخرون عن أثر الصلاة الجماعية في رمضان:
“أحب شعور الصلاة مع أصدقائي المقربين. هذا هو الجزء المفضل لدي من لقاءات رمضان. أستمتع أيضًا بمشاركة الطعام والحديث، لكن الصلاة الجماعية تحدث كثيرًا خلال رمضان وهي تمنحني شعورًا روحيًا دافئًا من الداخل.” (2117LSC)
“أعتقد أن اللقاءات والصلاة الجماعية مهمة في تقوية المجتمع، والصلاة إلى جانب الآخرين تذكرنا بجمال الوحدة، وهذا شيء رائع.” (CLE108)
إن صلاة التراويح، وهي صلاة ليلية طويلة وفريدة في رمضان عند المسلمين السنة، تجمع بين الفردي والجماعي، وتخلق ما وصفه هنكل بـ”إطار خطابي مشترك لجماعة المؤمنين” (2005: 503). وتؤدي هذه الصلاة، كما يبدو من أقوال المشاركين، إلى تشكيل العصبيّة أو ما يمكن تسميته “وحدة جميلة”، تعزز الحياة الجماعية وتعيد إنتاجها.
وقد رأى بعض المشاركين أن رمضان يتمحور حول العلاقات مع الآخرين. كما قال QWE123:
“ما شكل تجربتي الرمضانية حقًا هو الروابط. وأدركت أنني أرتبط كثيرًا بهذا الشهر من خلال علاقاته الاجتماعية.”
ومع أن معظم المشاركين عبّروا عن ارتباطهم الجوهري بالجوانب الجماعية من رمضان (خصوصًا الإفطار والصلاة)، إلا أن قلة قليلة قالت إنها تفضل ممارسة طقوسها الرمضانية بشكل فردي وخاص. ففي مدخلاتهم الأولى قبل رمضان، عبّر بعضهم عن ارتياحهم للتجربة الرمضانية الهادئة أثناء الإغلاق، بوصفها نموذجًا روحانيًا أعمق.
قال أحدهم:
“بصراحة، اعتدنا إقامة العديد من الأنشطة الاجتماعية في رمضان، لكن تغير كل شيء العام الماضي بسبب الإغلاق، وهذا أتاح لنا فرصة للاستمتاع برمضان دون تلك الانشغالات والتركيز أكثر على الجانب الروحي. ونحن كعائلة ننوي هذا العام اتباع نفس النمط وتخفيف الأنشطة الاجتماعية قدر الإمكان.” (AWA751)
وقالت مشاركة أخرى:
“منذ الإغلاق العام الماضي، استطعت أن أتأمل بعمق في معنى تعظيم رمضان على مستوى روحي. لقد ساعدني الانعزال على التفكير في ممارساتي دون إلهاء الإفطارات اليومية.” (ANE511)
لكن اللافت أنه بحلول المداخلة الأخيرة (بعد نهاية رمضان بشهر)، غير كلا المشاركين رأيهما، وأقرّا بأهمية الروابط الاجتماعية في رمضان. فكتبت AWA751:
“لا أستطيع أن أعبّر بما يكفي عن أهمية التواصل الاجتماعي. لم أُدرك ذلك إلا بعد أن عشت الإغلاق الطويل في ملبورن. كنت أعتبره أمرًا مسلّمًا به، لكن التواصل مع المسلمين الآخرين يعزز إيمانك ويمنحك إحساسًا بالانتماء”.
وهكذا، فإن التجربة الجماعية لرمضان في 2021 أعادت لهؤلاء المشاركين اكتشاف قيمة التواصل والعبادة الجماعية.
الهوية كأقلية وتعزيز العصبيّ
لعبت المكانة الأقلوية لمسلمي ملبورن دورًا مهمًّا في تعزيز شعورهم بالحاجة إلى الجماعة والانتماء خلال رمضان. وكما ذُكر سابقًا، يشكّل المسلمون فقط 3.2٪ من سكان أستراليا، وهي دولة تعاني منذ سنوات من مشكلات تتعلق بالإسلاموفوبيا (دودريجا وراني، 2019؛ جرافيل، 2021؛ إينر وآخرون، 2022؛ بوينتينغ وبريسكمان، 2018).
وقد أشار أحد المشاركين في المدخلة الرابعة إلى هذه النقطة صراحةً، قائلًا: “بكل بساطة، الإسلاموفوبيا منتشرة بشكل واسع في مجتمعاتنا.” (AAW212)
حتى في غياب مظاهر الإسلاموفوبيا الصريحة، كان المشاركون مدركين لحقيقة أنهم يُنظر إليهم كمختلفين من قبل مجتمع لا يفهمهم - وأحيانًا يكنّ لهم العداء. وقد مثلت التجربة الجماعية في رمضان ملاذًا ومصدرًا للانتماء، إذ عمّقت شعورهم بالعصبية بينهم. كتب أحدهم: “رمضان وقت مميز لمشاركته مع المسلمين لأننا جميعًا نفهم بعضنا بعضًا.” (Tails06)
وأضاف مشارك آخر: “عندما تذهب إلى إفطار جماعي، تدرك أنك تستطيع أن تكون على طبيعتك تمامًا مع الآخرين، وأن تركز على ما يجمعك بهم كمسلمين.” (74488ehriaq)
ويشير شعور “أن تكون على طبيعتك” هنا إلى التوتر الذي يعيشه بعض المشاركين خلال السنة، حين لا يشعرون أنهم مقبولون تمامًا في المجتمع الأوسع. أما التفاعل مع المسلمين الآخرين، الذين يشبهونهم في المعتقد والممارسة، فكان بمثابة تأكيد للانتماء.
كرر المشاركون مرارًا أن الروابط الاجتماعية التي بُنيت أو أُعيد بناؤها خلال رمضان كانت علاجًا لمشاعر العزلة أو التميّز أو عدم الفهم التي يشعرون بها في بقية العام.
“من الرائع قضاء الوقت مع مسلمين آخرين في رمضان، فقد أمضيت أغلب وقتي مع غير المسلمين الذين قد يعرفون أن هذا شهر خاص، ويعلمون أننا نقوم بعبادات إضافية، لكن هذا لا يُقارن بمشاركة التجربة مع من يعيش نفس الشيء.” (TTS798)
“أعتقد أنني في مرحلة من حياتي أصبح فيها رمضان تجربة روحية بالدرجة الأولى، وهذه الروحانية لا أشعر بها مع من لا يشاركونني الصيام… بل أشعر أنني أستمد طاقتي من الآخرين الصائمين. التفاعل مع غير الصائمين يرهقني.” (RAM021)
“العلاقات الاجتماعية تمنحك دفئًا عاطفيًا وتشعرك بالقوة، لأنك تنتمي إلى جماعة تدعم معتقداتك؛ لست وحدك من يصوم” (NKA839)
“الأمر مهم جدًّا، خصوصًا في بلد لا يحتفل برمضان. في الشرق الأوسط، الدولة بأكملها تستعد وتدعم رمضان، بينما هنا يمكن أن يكون رمضان تجربة انعزالية دون تلك الروابط.” (AOSW93)
في هذا السياق، جعل رمضان الاختلاف الذي يشعر به المشاركون كأقلية دينية أكثر وضوحًا، مما عمّق من حاجتهم للعصبية، بل وسهّل تحقيقها. وهكذا، كان رمضان- في آنٍ واحد - تجربة روحية، واجتماعية، وهوية أقلوية معيشة.
العصبيّة لا تُبنى فقط عبر الطقوس الجماعية، بل من خلال تداخل المشقة الدينية مع الجماعة
على الرغم من أن الطقوس الجماعية تُعدّ عنصرًا أساسيًّا في بناء العصبية، فإن العصبية لدى المسلمين في ملبورن لا تتشكل فقط من خلال الصلاة أو الإفطار الجماعي، بل - كما نقترح - من خلال تفاعل مركب بين عنصرين حددهما ابن خلدون بشكل منفصل: الإسلام والمشقة؛ فالمشقة التي تنشأ من متطلبات الإسلام؛ أي إن الجهد الجسدي والروحي الناجم عن أداء العبادات هي ما تولّد مشاعر الربط والانتماء (العصبية)، والتي تتجلى لاحقًا من خلال الممارسات الجماعية.
الثواب، الإسلام، والعصبية
كما ذُكر سابقًا، يرتبط بالطقوس الجماعية في رمضان ثواب روحي كبير، وخصوصًا فيما يتعلق بالإفطار الجماعي، والصلاة الجماعية (كالصلاة المفروضة وصلاة التراويح الخاصة بشهر رمضان). وقد علّق كثير من المشاركين على غياب هذه الطقوس خلال الإغلاق، وعبّروا عن الامتنان لعودتها:
“أشعر بالامتنان لأنني استطعت الاحتفال برمضان مع أصدقائي وعائلتي، فقد كان شعور العزلة في الشهر الماضي غريبًا جدًا.” (HMI123)
ثم أضافت، معبرةً عن قناعتها الدينية:
“ونحن نعلم أن الله يريدنا أن نكون اجتماعيين في هذا الشهر، لأنه يشجّعنا على إطعام الآخرين — فنحن في النهاية كائنات اجتماعية!”
يعكس هذا الرأي القناعة بأن العلاقة بين المجتمع والثواب الإلهي في رمضان علاقة مزدوجة الاتجاه. وهذا التصور شاركه عدد من المشاركين الآخرين.
قالت SBS807:
“تجتمع عائلتي مع عائلات أخرى في مركز مجتمعي مرة أسبوعيًا لتناول الإفطار معًا وأداء التراويح. وسنُثاب إن شاء الله لمشاركتنا الطعام والصلاة في الجماعة.”
وبالمثل، قالت ZSA001:
“أحب الصلاة مع الآخرين كثيرًا، فهي مهمة وتحمل أجرًا أعظم”.
أما Junaid2015، فقد أوضح كيف أن إيمانه بفكرة الأجر الإلهي ساهم في شعوره بالترابط والروح الجماعية:
“روح رمضان تتجلى في مثل هذه اللقاءات [مع مسلمين آخرين]. إنها توقِد روابط الأخوة، والتي نعتبرها طريقًا إلى رحمة الله. والجميل أن الأحاديث تدل على أنك تُثاب أحيانًا بحسب أتقى شخص في الجماعة. الله أعلم، لكنها طريقة رائعة لتذكّر سخاء الله”.
يرى جُنيْد أن التجمّع مع الآخرين - وهو جوهر العصبيّة - يمثل روح رمضان نفسها، وهو ما يتقاطع مع ما تسميه طومسون (2023) في دراستها عن المسلمين غير النمطيين “الجماعة الوجدانية” (affective community)؛ أي الإحساس بالانتماء الذي يُبنى من خلال تفاعلات وجدانية ذات معنى.
وقد أشار بعض المشاركين إلى أن هذا الإحساس يمكن أن يُبنى حتى مع الغرباء، من خلال أداء الطقوس الجماعية. كتبت IND296:
“أشعر باتصال عميق مع الآخرين، خاصة حين نجتمع لذكر الله. الصلاة بجانب أحدهم، سواء كنت أعرفه أم لا، تولّد لدي إحساسًا رائعًا بالانتماء. إنه شعور عميق.”
هذا الإحساس بـ “الترابط العميق” المتولد من الطقس الإسلامي الجماعي يؤكد ما وصفه ماكدونو وهوودفار (2009: 134) بـ “الإسلام العابر للحدود القومية” (transnational Islam)، ويعيد إحياء أطروحة ابن خلدون بأن الإسلام يمكن أن يبني العصبية بين أناس من خلفيات مختلفة.
وقد فسّر ابن خلدون ذلك بقوله إن الإسلام “يزيل الغيرة والحسد بين من يشتركون في العصبية”؛ لأن “الدين المشترك” الذي يجمعهم يُطهّرهم من “الصفات الذميمة”، مما يسمح بتكوّن جماعة متماسكة (ابن خلدون، المقدمة، ص 120–126).
وقد عبّر المشاركون عن حرصهم في رمضان على الالتزام بتعاليم الإسلام وتحسين ذواتهم، كما قالت IND296 سابقًا، وهو ما يجعلهم في “حالة دينية أفضل” وأكثر استعدادًا للانفتاح على العصبية، تمامًا كما تنبأ ابن خلدون.
هل العصبيّة تجربة إسلامية فقط؟ وما الذي يجعلها مميزة في السياق الإسلامي؟
من المؤكد أن الشعور بالترابط أو الجماعة ليس حكرًا على المسلمين. فقد لاحظ باحثون من ديانات وتقاليد روحية متعددة أن الممارسات الدينية الجماعية — مثل الغناء، الصلاة، الصيام، التأمل — تخلق إحساسًا عاطفيًا قويًا بالوحدة والانتماء. على سبيل المثال، يشير كولينز (2004) إلى أن “الطقوس المليئة بالطاقة” (high-energy rituals) تولّد “تضامنًا عاطفيًا”، وهو مفهوم قريب مما سماه دوركهايم “التماسك الجماعي”. كذلك تؤكد دراسة ديملينغ وآخرون (2020) عن الصوم عند المسيحيين أن الممارسة المشتركة تُنتج إحساسًا بالتقارب والتضامن الروحي.
ولكن ما يميز العصبية في السياق الإسلامي هو ما يمكن أن نطلق عليه “النية الجماعية” (collective intention) المرتبطة بثواب روحي “مُتجاوز” (transcendent reward). فبينما تولّد الممارسات الدينية الجماعية في تقاليد أخرى مشاعر اجتماعية قوية، فإن التجربة الإسلامية تضيف بُعدًا لاهوتيًا فريدًا: الجماعة ليست فقط وسيلة للراحة أو العزاء أو الدعم الاجتماعي، بل هي أيضًا وسيلة للوصول إلى الله ونيل الأجر.
قال أحد المشاركين:
“نحن لا نجتمع فقط لنشعر بأننا أقل وحدة، بل لأننا نؤمن أن الله يحب أن نكون معًا، وأنه يكافئنا على ذلك” (HIF209).
وبهذا المعنى، فإن العصبيّة ليست فقط ظاهرة اجتماعية أو نفسية، بل هي ممارسة دينية ذات مغزى غيبي، تُعتبر بحد ذاتها طريقًا إلى البرّ والتقوى. وكما أظهر ابن خلدون، فإن الإسلام - من خلال تشريعه للعبادات الجماعية، وربطها بالأجر والمغفرة - يُسهم في خلق شكل فريد من التماسك الاجتماعي يتجاوز الرابطة القَبَلية أو الجغرافية.
في السياق الغربي الحديث، حيث يشعر المسلمون أحيانًا بالعزلة أو الغربة، كما أوضح المشاركون، فإن هذه العصبيّة الرمضانية تكتسب أهمية خاصة؛ فهي تمنحهم ليس فقط شعورًا بالانتماء، بل أيضًا إحساسًا بالمعنى والتقوى والاصطفاء الروحي، وهو ما يجعلها أكثر من مجرد “شعور بالجماعة”.
الاستنتاجات والمساهمات النظرية
لقد حاولت هذه الدراسة تقديم مساهمة متواضعة ولكن ضرورية في سوسيولوجيا الدين، من خلال إظهار قيمة استخدام إطار نظري نابع من داخل التراث الإسلامي نفسه - وبالتحديد، من أعمال ابن خلدون - لفهم ممارسات ومواقف المسلمين العاديين في سياق معاصر، وتحديدًا في رمضان بمدينة ملبورن.
لقد وجدنا أن مشقة الصيام - الجسدية والروحية - حين تُعاش جماعيًّا وفي سياق من المعتقد المشترك، تُنتج العصبيّة كما صاغها ابن خلدون؛ أي رابطة شعورية واجتماعية عميقة توحّد الأفراد في جماعة ذات مغزى. وهذه العصبيّة لا تنشأ فقط من أداء الطقوس الجماعية، بل من النية المشتركة لخوض المشقة تقرّبًا إلى الله، وهي نية تنبع من التصور الإسلامي للعبادة والثواب.
وتُظهر الدراسة أن رمضان يخلق لدى المسلمين في المهجر - الذين يعيشون كأقلية دينية وثقافية - فرصة لإعادة التشبيك (re-embedding) الاجتماعي والروحي، وتعزيز الشعور بالانتماء إلى أمة أوسع تتجاوز الحدود القومية. وقد أشارت العديد من الأصوات في الأدبيات إلى أهمية الجماعة في الإسلام، لكن القليل فقط تناول كيف تتشكل هذه الجماعة في لحظة زمنية معينة، من خلال فعل جماعي متكرر ومقصود كرمضان.
كذلك وسّعت هذه الورقة مفهوم العصبيّة من مجرد ارتباط بالدم أو القبيلة - كما ركزت بعض الدراسات الغربية - إلى ما رآه ابن خلدون نفسه: رابطة تتولد من تجربة مشتركة ذات مشقة، يؤطرها الإسلام بمعاني روحية وأخلاقية.
وقد أظهرت بياناتنا أن هذه الرابطة لا تعتمد على أصل إثني أو ثقافي، بل تتشكل وتُستشعر عبر الأداء الطقوسي، والمعاناة الطوعية، والتضامن الروحي، في إطار من النية المشتركة والثواب المنتظر.
نأمل أن تفتح هذه الورقة مجالًا أوسع لاستخدام أطر تحليلية نابعة من داخل الإسلام لفهم المسلمين، بدلًا من الاستمرار في فرض مفاهيم خارجية غربية أُنتجت في سياقات دينية وثقافية مغايرة. وبذلك، يمكن لسوسيولوجيا الدين أن تصبح أكثر عالمية ومرونة، وأقل تمركزًا حول التجربة المسيحية الأوروبية.
[1] - العنوان: Beyond external theories: Muslims, ‘asabiyya, and the jihad of Ramadan المؤلفتان: Susan Carland & Anisa Buckley الناشر: Springer (مجلة الإسلام المعاصر - Contemporary Islam) تاريخ النشر: 24 فبراير 2025، رابط المقال الرسمي (نسخة PDF):
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11562-025-00576-1.pdf
صفحة المقال على Springer:
https://link.springer.com/article/10.1007/s11562-025-00576-1
*- شكر وتقدير:
تتوجه الباحثتان بالشكر للمشاركين في الدراسة الذين شاركوا يومياتهم الصادقة والعميقة، وللمؤسسات المجتمعية الإسلامية في ملبورن التي ساعدت في نشر الدعوة للمشاركة.
[2] - ملاحظة: على سبيل المثال، انظر إلى ما أشار إليه المنوّر (2014) من خطأ كبير في افتراض أن حضور الكنيسة كمؤشر على التدين لدى المسيحيين يعادل حضور المسجد لدى المسلمين
[3] - ملاحظة: للاطلاع على نقاش موسّع حول ما إذا كان ابن خلدون هو أول عالم اجتماع، انظر: Soyer and Gilbert (2012).