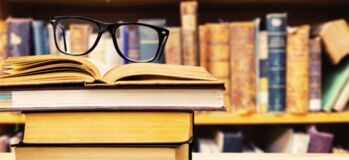نشر الرّسالة
فئة : ترجمات

نشر الرّسالة[1]
فرانسيس إدوارد بترز
ترجمة علي بن رجب
في نهاية مسيرتهما، ترك كلّ من عيسى ومحمّد لأتباعهما مجموعة من التّعاليم والذكريات لسلسلة من الأفعال. وقد بدأ حفظ تلك التّعاليم وجمعها خلال حياة كلّ منهما، لكن الأحداث استمرّت في تطوّرها حتى النّهاية، ولم يكن ممكناً فهم المغزى الكامل لتلك التّعاليم والعمل بها إلّا لاحقاً. ليس هناك شكّ في أنّ كلّا من الرجلين المقدّسين قد نصّا على أمور ضروريّة ملحّة: لقد كان من الضّروريّ أن يُقاد الجميع إلى الإيمان. على الرّغم من أنّه بالنّسبة إلى عيسى نفسه، يبدو أنّ ما كان يعنيه بكلمة «الجميع» هم معظم اليهود، بنو إسرائيل، ولكن سرعان ما وسّع أتباعه معناها إلى عالم الأمم الأكبر لغير اليهود، كما رأينا. أمّا محمّد، الذي عاش في مجتمع أصغر وأكثر انغلاقاً، فربّما كانت لديه في الواقع رؤية أوسع، رؤية غير مقيّدة بأيّ فكرة عن «الشّعب المختار». فكلمة «الجميع» تعني الجميع (1).
ما جعل الرّسالة ضرورة ملحّة هو هول الآخرة الذي يلوح في الأفق. لم يختلف كلا الرّجليْن حول معنى هذه الفكرة، وربّما كان كلّ منهما يعمل في الواقع بنفس سيناريو الآخرة اليهودي: سيكون هناك اضطراب كوني يتبعه يوم الحساب العظيم وعقابه المجرمين بالخلود في جهنّم، ومكافأته المتّقين بالنّعيم في جنّة عدن. إنّ صيغة عيسى تتضمّن، مع ذلك، تفسيره الشّخصي لــــ «يوم القيامة» على أنّه مجيء «الملكوت»، مع فروق دقيقة للدّافع السّياسي والدّيني التّقليدي لادّعاء بني إسرائيل، «شعب الله». لا تتضمّن الآخرة الإسلامية فكرة الادّعاء -لا شيء يشير إلى أنّ المسلمين كانوا هم بنو إسرائيل الجدد- ولكن ما تختلف فيه الرّؤيتان الأخرويتان هو بشكل رئيس في اقتراب موعدهما. إنّ ما ينقله عيسى، والذي تمّ التحقّق منه من خلال ردّ فعل أتباعه، هو أنّ الآخرة -المرتبطة بمفهوم كايروس kairos، أو «اللّحظة المناسبة»، وبمسار سياسة بني إسرائيل المعاصرين له- قريبة جدًّا، وأنّه هو ذاته سيكون له في الآخرة دور بارز بصفته «ابن الإنسان» المسياني. هذه الملاحظة غائبة عن القرآن: فيوم الحساب الذي لا علاقة له بمكّة ولا بالعرب، لا مفرّ منه، لكنّه ليس بالقريب. كما لا يُسند أيّ دور في الآخرة إلى محمّد أو أمّته، أمّة المؤمنين: سيكون يوم القيامة قبل كلّ شيء يومَ الحساب الشّخصي.
من دون الربّ
ليست هناك حاجة للتكهّن بما حدث للبشارة في الأيام التي أعقبت موت عيسى مباشرة، وما بلغنا عن ظهوره، واختفائه النّهائي من أورشليم وتاريخ البشرية، وبولس المعاصر له وأعمال الرّسل ترشدنا إلى ذلك؛ أوّلاً، لقد تمّ تغيير محتوى البشارة، ما تمّ وصفه في البداية على أنّه «لقد كمُل الزّمان واقترب ملكوت الله، فتُوبُوا» (مرقس 1: 15) يُعلن الآن على أنّه «ليقبل كلّ بيت إسرائيل يقيناً أنّ الله قد جعل من عيسى هذا الذي صلبتموه ربًّا (كيريوس) ومسيحًا» (أعمال الرسل 2: 36). وما كان مجرّد حثٍّ على «التّوبة» أو «غيّر حياتك» هو الآن «توبوا واعتمدوا باسم يسوع المسيح. عندئذ ستُغفر خطاياكم وتنالون عطيّة الرّوح القدس» (أعمال الرّسل 2: 38). لقد تمّ الآن إدماج طقوس معمودية يوحنّا في بداية احتفالية التّعميد، وهي علامة على أنّ المؤمن قد نال "عطيّة الرّوح القدس".
ما هو جدير بالملاحظة هنا أنّ رسالة عيسى نفسها، وتعاليمه الشّخصية الواردة في كلماته الخاصّة في الأناجيل، لا تلعب أيّ دور في «إعلان» الرّسل عن ربّهم. كما أنّها ليست كذلك في صيغة بولس عن «البشارة»، والتي قد تكون حدثت بعد عشرين عاماً ممّا هو موصوف في سفر أعمال الرّسل، على الرّغم من أنّها قد ذُكِرت قبل ذلك بقليل. في كلتا الحالتيْن، وبحسب «النّصوص المقدّسة»، فقد تحوّل محتوى «البشارة» من تعاليم عيسى إلى حدث موت عيسى وقيامته. واللّافت للنّظر أيضاً هو أنّ أتباع عيسى اليهود يطلقون عليه هنا، وحتى قبل ذلك في بولس، لقب كيريوس، أو «الربّ»، التّسمية اليهودية اليونانية للإله بامتياز. وبالتّاكيد، فإنّ هذه الممارسة تسبق بولس؛ لأنّ الصّرخة الآرامية مارانا ثا Marana tha والتي تعني «ربّنا تعال!» (1 كورنثوس 16 :22) وترنيمة المسيح في رسالة بولس إلى أهل فيلبي -«رفعه الله إلى الأعلى وأعطاه اسماً فوق كلّ الأسماء... يسوع المسيح هو الربّ» (2: 6-11)- قد تمّ تداولهما على ما يبدو قبل أن يقتبسهما بولس بكثير.
لقد تشكّلت إذن حركة عيسى في وقت مبكّر بديناميكية جديدة. يبدو أنّ عيسى قد أشار خلال فترة حياته إلى تحقيقه لنبوّة بيبليّة تدعم ادعاءاته المسيانية؛ من الآن فصاعدًا، يستشهد أتباعه بعد موته وقيامته من بين الأموات، بهذه النّبوّة كدليل على ربوبيته (= الألوهية). كانت قيامته أيضاً «دليلاً» على هذه المكانة الإلهية، وكذلك ضماناً للقيامة إلى حياة أبدية لجميع الذين اعتمدوا باسمه (1 كورنثوس 15: 3-7، 12-15). شرح بولس ذلك في المصطلحات اليهودية التّقليدية للكفّارة: كان موت عيسى («الفداء») لتحرير البشرية من الخطيئة / الموت، وهي فائدة يمكن لأيّ شخص أن يشارك فيها، ليس التزاماً بالتّوراة، كما كانت قناعة اليهود، ولكن بوضع ثقته أو ثقتها في عيسى (رومية 6: 2-4).
تمّ إبراز قيامة عيسى بجرأة في أعمال الرّسل (4: 2)، على الرّغم من عدم ذكر الكَفّارة والفداء في وصف لوقا للوعظ المبكّر لحركة عيسى في الإصحاح الثّاني من أعمال الرّسل. ينقل تفكير بولس في تلك السّنوات الأولى شعوراً قويًّا بأنّ النّهاية الكونيّة المرتقبة للملكوت كانت قاسية عليهم جميعاً (1 تسالونيكي 4-5)، وهو شعور يتسرّب أيضاً من بين سطور أعمال الرّسل، حيث اختار المؤمنون الذين يتزايد عددهم تدريجيًّا (أعمال الرّسل 1: 15؛ 2 :41، 47؛ 6: 7) الخطوة الأخروية المتمثّلة في تجميع ممتلكاتهم وفي تفضيل «تقاسم الحياة المشتركة وكسر الخبز والصّلاة» (2 :42).
يبدو أنّ ما قام بدفع حركة عيسى التّبشيرية العلنيّة في مرحلتها الأولى بعد عيسى كان أساساً الاقتناع بأنّ الاثنيْ عشر، وربّما الآخرين الذين وقفوا أمامهم، قد رأوا عيسى حيًّا، بعدما مات ودُفِن، وبأنّ هذا الرّجل الذي ادّعى أنّه المسيح قد قام حقيقة وواقعاً من بين الأموات. وقد تعزّزت هذه القناعة من خلال «آيات» مختلفة مثل الشّفاء ومعجزات أخرى كان أتباعه قادرين على القيام بها باسمه (أعمال الرّسل 3: 16، 14: 8). وبدورهم قام المؤمنون الذين وصلوا إلى مرحلة اليقين «الإخوة»، إقناع الآخرين، بمساعدة عقيدة الخلاص الآخذة في النّموّ: لقد خلّص عيسى بالفعل المُذنِبَ من غضب الله الأبدي وخلّص كذلك، ربّما بشكل أكثر تأثيراً، المؤمنَ من نسيان الموت.
كيف انتشرت الرّسالة
كما رأينا، قد لا يكون عيسى فكّر أو قصد أن يسمع رسالته أحدٌ غير بني إسرائيل. ومع ذلك كان الأمر كذلك، عن طريق الصّدفة تقريبًا، وقد غيّر مصير الحركة. هذه «الإرساليّة إلى الأمم» التي شكّلت حقبة تاريخيّة، لم تحدث بأمر من عيسى ولا من خلال خطّة رسولية، ولكن لأنّ أمماً كانت متواجدة فعليًّا على أطراف المجتمع اليهودي، ولا سيما في مدن وقرى الشّتات المتوسّطي الواسع، «تشتّتٌ» خارج أرض إسرائيل، حيث كان هناك العديد من الجماعات اليهودية. وصلت رسالة عيسى إلى هذه الجماعات في المقام الأوّل؛ لأنّها كانت رسالة يهودية، ولأنّ يهودًا كانوا يعيشون في مجتمع منفتح ومتوافق. وعلى الفور، أُجبِر العديد من أتباع عيسى على الخروج من أورشليم في ردّ الفعل العنيف الذي أعقب تبشير ستيفن الفاضح، وكذلك موته المُشين بالرّجم علناً (أعمال الرّسل 8: 1). كان بولس، الذي لم يعتنق بعدُ المسيحيّة، يعرف ذلك جيّداً، وعندما انطلق في تهديد وقتل أعضاء حركة عيسى، توجّه مباشرة إلى «تجمّعهم» الجديد (ekklesia) في دمشق (أعمال الرّسل 9: 2).
لا يوجد سرّ في كيفية انتشار المسيحيّة في مراحلها الأولى. لقد تمّ نشرها من قبل دعاة مؤثّرين ومتحمّسين مثل بولس الذي اعتنق المسيحيّة الآن ويعمل من خلال شبكة كثيفة من التجمّعات اليهودية حول البحر الأبيض المتوسط. كان لكلّ مدينة يونانية رومانية كبيرة طائفتها اليهودية، وكان لكلّ طائفة كنيسها الخاصّ أو مكان للتجمّع، سواء كان مبنى مخصّصاً أو مجرّد منزل لشخص ما، حيث يتجمّع اليهود المحلّيون للصّلاة أو لدراسة التّوراة، أو للقيام بأنشطة مجتمعية. كان الكنيس مفتوحاً للجميع، للمقيمين والعابرين، والمرتدّين وحتى المتعاطفين من غير اليهود. وهنا وجد اليهود النّشطون من أتباع عيسى، الذين تمّت دعوتهم إلى «اليما» لخدمة السّبت، جماهيرهم الأسبوعيّة (أعمال الرّسل 13:13، 17: 2-3، 19: 8).
كان من المرجّح أن تنتشر أولى التحوّلات إلى المسيحيّة في مجتمع عيسى عبر العلاقات الاجتماعية القائمة، وبشكل أساسي عبر العائلات والأصدقاء، كما حدث بين المسلمين الأوائل وما زال يحدث في ظروف متوازية. بعد ذلك، يبدو أنّ المجموعة اللّاحقة الأكثر احتمالاً لتبديل الولاءات هم أولئك الذين لهم انتماءات دينية ضعيفة خاصّة بهم، وكما كان متوقّعاً، أولئك المغرّبين والسّاخطين، ومرّة أخرى يجب أن نفكّر في أوائل المكّيّين الذين اعتنقوا دين محمّد. لا توجد علامات واضحة لهوّية هذه الموجة الأولى من المسيحيّين المتحوّلين -تمّ التخلّي عن المقترحات السّابقة القائلة بأنّهم كانوا عبيداً؛ وذلك بسبب نقص شبه كامل في الأدلّة- ولكن يبدو من المعقول جدًّا أنّ حركة عيسى قد حقّقت نجاحات عميقة في مجتمعات يهود الشّتات. سيكون هؤلاء اليهود الأكثر استيعاباً «للدّين المدني» اليوناني الرّوماني في بيئتهم. وفي مواجهة التّدمير الكارثي للطّائفة اليهودية وقاعدتها السّياسية في فلسطين عام 70م وما ترتّب على ذلك من عدم ثقة الرّومان في اليهود في كلّ مكان، فمن المحتمل أيضاً أن يكونوا الأكثر انجذاباً إلى ما تمّ وصفه بأنّه شكل من أشكال «اليهودية التّوفيقية». لاحقاً قام بعض اليهود الأوروبيّين، في الظروف نفسها تقريباً، بـ «توافق» خاصّ بهم في شكل اليهودية الإصلاحيّة، ولكن سرعان ما ظهر هنا بديل في تلك المعابد ليهود الشّتات، بديل تمثّل في رؤية مألوفة ولكنّها جديدة ومختلفة عن اليهودية.
إيجاد مسيحيّين
مع اعتناق قسطنطين للدّين المسيحيّ، انتقلت المسيحيّة بسرعة من دين فيه متسامح إلى دين مفضّل، ثمّ أخيراً في عام 381م، انتقلت إلى الدّين الرّسمي للإمبراطورية الرومانية، وهي حركة قادتها في النّهاية إلى الحفاظ على علاقة قديمة، وغالباً متوتّرة مع المؤسّسات السياسيّة والقانونية لدولة قويّة وموقّرة ومحافظة للغاية. كما حملت المسيحيّين إلى إقامة علاقة جديدة مع خصومهم الدّينيّين، اليهود من ناحية، والطّوائف الوثنيّة بأكملها من ناحية أخرى. كان لدى المسيحيّين، كما يطلق عليهم الآن، مجموعة واضحة المعالم من المعتقدات والطّاقة والإيمان لمحاولة إقناع الآخرين بصدق تلك المعتقدات؛ ذلك ما فعلوه بالضّبط، وحقّقوا نجاحاً كبيراً بين الوثنيّين، آخرُ مَنْ ظلّ من غير اليهود في المناطق النّائية، ولكن مع تناقص سريع في النّتائج بين اليهود وتكاد تكون منعدمة فيما بعد بين المسلمين.
بحلول القرن الرّابع، أصبحت حركة عيسى بالفعل «كنيسة» ذات طابع مؤسّساتي، ولكن لم يكن لديها سوى القليل من وسائل الإجبار، إمّا على الإيمان أو الامتثال، إلّا بالاستعانة بالدّولة. في حالة الوثنيّين، كان هناك تردّد بسيط في القيام بذلك: تمّ سنّ التّشريعات الإمبراطورية -في الإمبراطورية الرّومانية اللّاحقة، الإمبراطور وحده هو الذي يسنّ القوانين- التي تجعل عبادة أيّ إله غير قانونية باستثناء إله المسيحيّين. في عام 453م، أعلن دستور إمبراطوري أنّ الوثنيّين أعداء للدّولة، وأنّه يجب مصادرة ممتلكات أولئك الذين اقتنعوا بذلك وإعدامهم. تمّ تدمير المعابد الوثنية، في كثير من الأحيان من قِبل الجماهير كما من قِبل الدّولة، وفي عام 529م لم يُغلق الإمبراطور جستنيان فقط آخر معبد وثنيّ تمّ التّسامح معه في الإمبراطورية -كان ذلك في أسوان، حيث جاء النّوبيون عبر الحدود للتّجارة، وفي السّابق للعبادة- ولكن أغلق أيضاً آخر معقل للوثنيّة الفكرية، أكاديمية أفلاطون، التي كانت لا تزال نشطة في أثينا بعد ما يقرب من ألف عام.
وفي هذه الأثناء، عَبَر حدود الإمبراطوريّة المبشّرون المسيحيّون، منهم كثير ممّن ينتمون إلى الجماعات الرهبانية في الكنيسة. تسلّقوا جدار هادريان في بريطانيا لتبشير «البيكتس»، وأبحروا في البحر الأيرلندي لدفع شعوب السّلت Celts المتوحّشة على الجانب الآخر من السّاحل لاعتناق المسيحيّة، وعبروا نهر الرّاين والدّانوب لإدخال القبائل الجرمانية أوّلاً، ثم السّلاف في الحظيرة المسيحية. سلك المسيحيّون الشّرقيون، التّجار والرّهبان، طريق الحرير شرقاً إلى الصّين والهند وهناك وضعوا الصّليب.
كان اكتشاف عوالم جديدة يعني غزو واحتلال عوالم جديدة للمسيح وللملك. ركب اليسوعيّون والدّومينيكان والفرنسيسكان القوافل البرتغالية والإسبانية والسفن الحربية إلى أقصى مناطق آسيا وأمريكا، حيث زرعوا راية الإيمان والإكليل، على نفس الأسس في غالب الأحيان. ومع الإصلاح والتّنوير اللّذيْن أعقبا ذلك، بدأ المسيحيّون يتّجهون إلى مهمّة قد تكون أقلّ نفعاً، ولكنّها بالتأكيد مصدر سعادة بمحاولة إقناع بعضهم بعضاً بصيغة طائفية معيّنة من الإيمان. استمرّت المؤسّسات الخارجية بين الوثنيّين، ولكن الآن بدون مساعدة أو دعم حكومي، ومع ذلك لا يمكن تجاهل دور الكنائس في توسّع الاحتلال. واجه المسيحيّون المبشّرون باستمرار خصومهم التّبشيريّين الآخرين من أجل أرواح الوثنيّين، المسلمين.
من دون النّبيّ
ينتهي القرآن، بالطّبع، بموت محمّد. أمّا السيرة، فتستمرّ، وهي تقتفي آثار وفاة النّبيّ، من خلال أحداث الخلافة المتشابكة والمعقّدة إلى حدّ ما، ومن ثمّ إلى الشّأن الإسلامي الأوّل. إنّ بدو الجزيرة العربية، الذين كانوا يستهينون بمقتضيات الدّين، كما يشهد القرآن نفسه في الآيات التّالية (سورة التّوبة، 97- 98: «الأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً وَأَجْدَرُ أَلّا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَمِنَ الأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، سورة الحجرات، 14: «قالَتِ الأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمّا يَدْخُلِ الإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».)، قد انتهزوا مناسبة موت محمّد للتخلّي عن دفع الزّكاة المفروضة عليهم كمسلمين إلى خزائن بيت المسلمين في المدينة. كان على المسلمين اتّخاذ القرار متمثّلاً في شخص الخليفة أبي بكر الذي اختاروه للتّوّ، ما إذا كان يجوز الانفصال عن الأمّة، كما فعل البدو الانتهازيون. فكان الجواب بالنّفي: الانفصال ردّة. وبأمر من أبي بكر، تمّ إكراه البدو بقوّة السّلاح على البقاء مسلمين يدفعون الزّكاة.
تمّت السّيطرة على المرتدّين، ولم يرتكب غيرهم نفس الخطأ لاحقاً. استأنف جنود المسلمين، الذين هم على دراية منذ فترة طويلة بفنون الحرب الخاطفة والبعيدة المدى، «الغارات» النّاجحة والمثمرة للغاية، والتي، في نظر كتّاب السّيرة، ميّزت إلى حدّ كبير مسيرة النّبيّ في المدينة، ثمّ ابتعد خلفاؤه عن شبه الجزيرة العربية وعادوا إلى حيث قادهم محمّد نفسه، إلى المقاطعات الغنيّة للإمبراطورية الرّومانية الشّرقية والإمبراطورية السّاسانية في العراق وفارس. امتدّت سلسلة نجاحاتهم العسكرية الطّويلة لأكثر من قرن، وبحلول الذّكرى المئوية لوفاة النّبي، كانت الجيوش الإسلامية قد وصلت جنوب فرنسا وحدود الصّين. ومع ذلك، لم يكن هناك مبشّرون بين هؤلاء المحاربين، ولا قدّيسون أو علماء أو رجال ملهمون لإقناع الرّعايا الجدد باعتناق الإسلام.
الدّافع التّبشيري
منذ البداية، كانت المسيحيّة مسكونة بدافع تبشيري؛ أي بالضّرورة الملحّة التي أعلنها عيسى نفسه، للتّبشير بعيسى، والسّير على خطاه ومحاولة إقناع الآخرين، بما في ذلك، كما يعتقد أتباعه، حتى غير اليهود. لاقت دعوة محمّد التبشيرية في مكّة، مثل بشارة عيسى، نجاحاً متواضعاً، وكادت تحذيراته الإلهية التي وجّهها لقريش أن تكلّفه حياته. لم تبدأ الحركة التي نسمّيها بالإسلام في الانتشار إلّا في المدينة وبعد التّجربة العسكريّة لآبار بدر فقط، عندما بدأ الخضوع الرّوحيّ يتبع الخضوع السّياسي لسلاح المسلمين.
أرسل النّبيّ الجيوش، لكنّه لم يرسل أبداً صحابته لدعوة البدو إلى الإسلام؛ كانت القبائل هي التي أرسلت إليهم وفوداً تطلب منهم الدّخول في الدّين الجديد. خلال حياة محمّد، ولفترة طويلة بعد ذلك، كانت الدّعوة إلى الإسلام تأتي دائماً بعد الغزوات، ولم تكن أبداً سابقة لها. وفي المقابل، كان المسيحيّون قد قاموا بتنصير ما بين 10 في المائة إلى 20 في المائة في أماكن مختلفة من الإمبراطورية الرّومانية قبل أن يصبح قسطنطين مسيحيًّا. غالباً ما سبق المبشّرون المسيحيّون الجيوش؛ لقد عبروا الحدود، ونشطوا خلف خطوط العدوّ في عمق ألمانيا وآسيا الوسطى والهند والصين.
هذا الدّافع التّبشيري المسيحيّ، الذي كان حاضراً دائماً قبل السّلطة الرّومانية التي نادراً ما كانت سابقة له، قد حوّل إلى المسيحيّة كامل حوض البحر الأبيض المتوسط بحلول منتصف القرن السّابع، في حين انتزعت الجيوش الإسلامية معظم النّصف الجنوبيّ منه إلى الأبد. أصبحت أوروبا المسيحيّة تواجه من الآن فصاعداً منافسًا دينيًّا وسياسيًّا جديدًا على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسّط في «دار الإسلام»، كما أطلق المسلمون ذلك على نظامهم السّياسي الموحّد إيديولوجيًّا، سريع التنوّع أساسًا. على عكس الأوروبيّين الذين لم يحكموا المسلمين بعد، كان للمسلمين رعايا مسيحيّون. في الواقع، كان السواد الأعظم من الذين تمّ غزوهم من العراق إلى المغرب مسيحيّين بصفة شكلية على الأقلّ. لم يُجبَروا على التحوّل إلى الإسلام عندما استسلموا لسلاح المسلمين، إلّا أنّه وفي غضون قرنيْن من الزّمان، كان هؤلاء المسيحيّون (واليهود)، الذين يتمتّعون بحماية دينيّة، ولكنّهم يتذمّرون من وضعهم المتدهور سياسيًّا واجتماعيًّا في ظلّ الإسلام، قد أصبحوا في أغلبيتهم السّاحقة مسلمين.
تحوّل وانصهار
كان الإسلام، في أولى تجلّياته، دين العرب الذي أوحى به نبيّ عربيّ، حيث كانت رسالته، كما كان يتفاخر بذلك، «بلسان عربيّ مبين». في التّحوّلات الأولى إلى الإسلام، انتقل العرب من قبيلة إلى أمّة، وفقدوا بذلك هوّيتهم القبلية (ولو لفترة وجيزة فقط)، لكن، وكما تبيّن لاحقاً، لم تتغيّر أيٌّ من المميّزات الثّقافية للّغة، واللّباس، والطّعام، وما شابه. حُدّد الإسلام في البداية بالصّلاة، التي لا يمكن متابعتها في كلّ الأوقات ولا في كلّ الأماكن، وبدفع الزّكاة لمن استطاع ذلك. ولكن عندما انتشرت الدّعوة إلى الإسلام بين الشّعوب الأخرى، فقد بدت مألوفة لاهوتيًّا لدى النّاطقين باليونانية والآرامية في سوريا وفلسطين، والشّعوب النّاطقة باليونانية والقبطية في مصر، والشّعوب النّاطقة باليونانية والآرامية والبهلويّة في العراق وإيران، ولكنّها ظلّت دعوة عربية من النّاحية الثّقافية. استمرّ الأمر على هذا النّحو لفترة طويلة جداً -الذي ضمن ذلك هو ترسيخ القرآن باللّغة العربية- حيث كان على معتنقي الإسلام الانصهار في ثقافة جديدة بالإضافة إلى تأكيد عقيدة جديدة.
كان الانصهار في الثقافة العربية لمعتنقي الإسلام سريعاً بشكل مذهل -في غضون ثلاثين أو أربعين عامًا كانت لغة البدو تُستخدم كلغة الدّولة- وبصورة شاملة لدرجة أنّها حوَّلت كامل مساحة شمال إفريقيا والشّرق الأدنى إلى منطقة ثقافية عربية. كان هناك ناجون - فقد حبست الثّقافة الفارسية أنفاسها لفترة طويلة جدًّا تحت الطّوفان العربي إلى أن التقطتها مرّة أخرى بعد حوالي قرن من الزّمان، ولكن بدلالات عربية قويّة- لكنّ التحوّل كان مكتملاً بما فيه الكفاية، حتى إنّ أولئك المسيحيّين واليهود وغيرهم ممّن رفضوا اعتناق الإسلام كانوا راضين في النّهاية للتحدّث بلغة الإسلام وتبنّي طرائق عربية عديدة.
سواء تعلّق الأمر بالمسيحيّة أو بالإسلام، فنحن لا نعرف ولا يمكننا أن نعرف على وجه اليقين سبب حدوث التحوّل، باستثناء ربّما عند تحوّل شيخ القبيلة أو صاحب السّيادة ويتعيّن على قومه بحكم الضّرورة اتّباع عقيدته الجديدة، كما حدث على ما يبدو أثناء تحوّل شعوب السّلاف في البلقان إلى المسيحية، أو العرب البدو وبربر شمال إفريقيا إلى الإسلام.
على الرّغم من أنّنا نستطيع أن نقدّر ونقيّم بوجه عامّ بعض الحوافز الاجتماعية والاقتصادية المشجّعة لعمليّة التّحوّل، ولكنّنا لا نستطيع اتّخاذ أيّ مقياس للحوافز الرّوحية، إلّا في الحالات الفردية النّادرة، حيث يتعهّد شخص ما بشرحها. نحن نعلم أنّ المسلمين كانوا في البداية أقلّية صغيرة جدًّا في الأراضي التي احتلّوها بسرعة كبيرة، وأنّهم في النّهاية، ربّما بعد قرنيْن أو ثلاثة، أصبحوا الأغلبية. نحن نعلم أيضاً أنّ الشّعوب التي أسلمت من إسبانيا إلى العراق كانت في الأصل مسيحيّة وبعضاً من اليهود، وفي أقصى الشّرق من أتباع الزرادشتية. كان المسلمون حكّام هذه الشّعوب، من حيث السّلطة والثّروة، إن لم يكن من حيث التطوّر والمعرفة. بالتّأكيد كان إغراء السّلطة والثّروة، وليس التطوّر والمعرفة؛ أي إمكانية تقاسم سلطة المسلمين أو ثروتهم (أو على الأقلّ لتجنّب معاناة الإقصاء من مزايا النّظام الجديد) هو الذي دفع أهل الكتاب الآخرين إلى مغادرة مجتمعاتهم الأصلية والانضمام إلى الأمّة الإسلامية المنتصرة.
إيجاد مسلمين
كان محمّد مبشّرًا، هدفه الأساسي هو تحويل الوثنيّين في مكّة إلى عبادة الإله الواحد الحقيقي. أثناء وجوده في المدينة، ومع النّجاح المتزايد لرسالته، انتقل من اعتناق الدين الجديد إلى التعليم الديني، وهو تعليم أولئك الذين كانوا بالفعل مسلمين. شعر المسيحيّون الأوائل أنهم كُلّفوا بنشر «البشارة». بدأ خلفاؤهم بالعمل داخل الإمبراطورية الرّومانية. وفي وقت لاحق، تبعوا خطى الجيش مع اتّساع حدود الإمبراطورية، وتجاوزوا قوّات الإمبراطور في حماس واندفاع لنقل الكلمة إلى الضالّين. أمّا في الإسلام، فقد كانت القوّات هي المبشّر في المقام الأوّل: فالجنود هم المبشّرون.
«الخضوع» يعني قبول السّيادة السّياسية للمسلمين، وإذا كنت وثنياً، فإنّه، ودون أيّ شروط مسبقة، الخضوع لسيادة إله المسلمين المطلقة. ولكن لم يكن على المسيحيّين واليهود، ولاحقاً الزّرادشتيّين، الذين سرعان ما شكّلوا الغالبية العظمى من الشّعوب المهزومة، سوى قبول سلطة الغزاة السّياسية؛ لأنّهم كانوا يعبدون بالفعل، وإن كان بشكل غير كامل، الإله الحقيقي الذي هو الله. وهكذا توسّعت دار الإسلام سياسيًّا، ومع تزايدها، كان بها أعداد كبيرة من أهل الكتاب المحميّين الذين لا يمكن إكراههم على الدّخول في الإسلام، ولكن يمكن ترغيبهم فيه. وهذا ما حدث فعلاً: إذ أصبح معظم اليهود والمسيحيّين، وليس جميعهم، في دار الإسلام مسلمين، بشكل بطيء في البداية ثمّ بتزايد سريع بعد ذلك. لقد كان التّحوّل إلى الإسلام من الدّاخل، ولم يتمّ عن طريق الدّعوة الإسلامية، بل من خلال الاقتداء بالمسلمين وإغراءاتهم. استمرّت العملية طويلاً؛ وذلك لاتّساع الحدود السياسية لدار الإسلام، ولمّا لم تعد كذلك، بعد ما يقرب من ألف عام، خرج مسلمون آخرون، الصّوفيون بشكل أساسي، للموعظة ونشر كلمة الله بين النّاس في الشّرق -أمّا في الغرب، فقد بقي المسيحيّون واليهود فقط، الذين أظهروا رغبة قليلة جدّاً في اعتناق الإسلام ما لم يكونوا رعايا مسلمين، الرغبة القليلة نفسها التي أظهرها المسلمون ما لم يكونوا رعايا مسيحيّين.
[1] - ترجمة مقتطفة من كتاب عيسى ومحمد توازي المسارات، توازي السِّيَر، فرانسيس إدوارد بترز، ترجمة علي بن رجب، صدر عن دار مؤمنون بلاحدود.