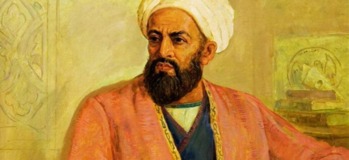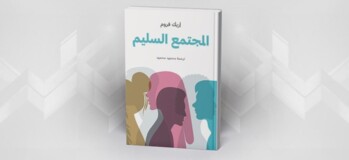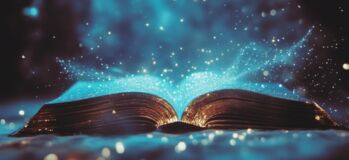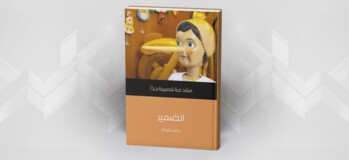أن تتفلسف هو أن تتعلم كيف تموت
فئة : ترجمات

أن تتفلسف هو أن تتعلم كيف تموت
تأليف: كلود جان لونوار
ترجمة: مصطفى كومي
"إن التفكير في الموت تفكير في الحرية، ومن تعلم كيف يموت فقد تحرر من رق الموت وعبوديته".
مونتين، المقالات، الكتاب الأول[1].
يدعونا مونتين في المقالات، إلى التفكير في المستقبل الغريب الذي ينتظرنا نحن البشر؛ فالموت جزء لا يتجزأ من الحياة.
يمنحنا الرسامون درسا بليغًا
كان الرسامون الهولنديون، في القرن السادس عشر، قد بلغوا ذروة البراعة في فن الطبيعة الصامتة: لمعان تلك الفواكه التي بلغت نضجها؛ رهافة الزهور المتفتحة... موائد مرصعة بأطباق لا تؤكل، بل تتذوق بالعين. طريدة بلحم نفاذ الطعم. بيد أنه، غالبا، ما يظهر نذير سابق بمصير يكاد يكون مؤكدا: هناك، في زاوية اللوحة، ذبابة... "إنها تعلن، كما يشرح بيير بونافو، أنه في غضون ساعات، أو أيام قليلة، ستبدأ الزهور في الذبول، والفواكه في الانكماش، والخضار في التعفن، واللحم في التفسخ والنتانة." إنه زمن فريد؛ ذلك الذي تنبض به الطبيعة الصامتة؛ زمن يحمل تهديدا... الكائنات والأشياء، كلها، تطالبنا بأن نعي: هناك استعجال ما، شيء من الإلحاح. قليل من الوقت بعد، وسيكون الأوان قد فات.
الرسام، من خلال فنه، لا يقتصر درسه في تمثل الأشياء، بل فيما يتجاوزها. درسه لا يتعلق بتلك الفواكه، ولا بتلك الزهور، ولا بتلك الأطباق، بل بمن يتأملها: نحن، أيضًا، من نسيج الزوال [وجزء من عالم الفناء]. ولو أولينا هذا المشهد قدرًا أوسع من الانتباه، لأدركنا أن الوقت قد حان للتفلسف. أليس التفلسف، بحسب مونتين، هو تعلم الموت؟ وبالتالي، هو تعلم الحياة؛ لأن: "التفكير في الموت تفكير في الحرية، ومن تعلم كيف يموت فقد تحرر من رق الموت وعبوديته."
لدى كل واحد منا، تتقاطع الأزمنة: زمن النظرة اللحظية، وزمن ما تحمله تلك النظرة من استبصار بمستقبل، نشعر في قرارة أنفسنا، منذ الآن، بأنه سيكون مأساويًا حين يتحقق.
هذا الوعي بطبيعة الحياة الزائلة، ندين في إدراك عمقه للفيلسوف الدنماركي سورين كيركغارد، الذي رأى فيه وعيا يرتبط ارتباطا وثيقا بإدراكنا للخلود، كما كتب: "الإنسان، كائن محدود، يحمل في ذاته وعيًا باللامحدود."
كائن محدود: الإنسان فان، لكن هذا الإنسان الفاني يمكنه أن يعتقد أنه يتجاوز هذا المحدود من خلال الوعي الذي يمكن أن يكون لديه بتجاوز حدود الزمن. عندئذ سيكون المستقبل عبورا، قفزة نحو ما بعد يقال له إنه "لغز"...
ألا يتجلى كل شيء من خلال القصة الفريدة لكل إنسان، لكل واحد منا، في هذا التناقض الغامض الذي يجعل، في صميم ما سيعرفه فلاديمير جان كيليفيتش على أنه "لا شيء تقريبا"، "لا أعرف ماذا"، يقيم في الآن نفسه الشعور اليقيني بتلاشيها والرغبة اللاواعية في أن تبقى وتتسلسل إلى ما لا نهاية. بشكل أبدي.
الخوف من الموت: مصدر للخرافات وللظلامية الدينية
أليس الإنسان هو محور صراع دائم، ناشئ عن التواضع الذي يفرضه عليه وعيه بذاته ـ إنه فان ـ ومن الكبرياء اللامحدود الذي يدفعه إلى أن يتخيل نفسه خالدا؟
أليست هذه الرغبة في الخلود هي الكذبة التي لا نتوقف عن تكرارها على أنفسنا، ما دام الموت؛ إذ لا بد من تسميته، يظل عصيا على الفهم؟ مستحيل الاستيعاب؟ الموت ينتمي حقا إلى تلك الجهة التي يستعصي التعبير عنها في كياننا، إلى ذلك "المختلف كلية" الذي لا يمكن اختزاله: "الموت، [هو] الشيء الوحيد الذي يفوق الكلمة التي تسميه"، كما قال جان روستان، "الموت، هذا الحدث الأخير الذي لا أستطيع السيطرة عليه، ولن أعرف عنه شيئا؛ لا يمكنني أن أتصوره لأنه يمثل، سلفا، القطيعة الجوهرية، الغير قابلة للفهم؛ لأنه “الآخر كلية”." هذا الآخر كلية، إذا لم نقدم على التفكير فيه، إذا لم نتأمله، إذا لم نمتلك الشجاعة لفعل ذلك، فسيمنح قوته لبعض الإيديولوجيات الفلسفية، أو السياسية، أو الدينية.
خلال مساري الماسوني، على سبيل المثال، كم مرة دعيت إلى التعرف إلى نفسي بشكل أفضل، إلى التعرف على نفسي ببساطة، من خلال تطبيق شعار "اعرف نفسك"، الشعار الذي اعتمده سقراط، والمنقوش على واجهة معبد دلفي؟
سيهاجم غوته هذا الشعار بوصفه، في الواقع، "حيلة زمرة من الكهنة أرادوا بها أن يربكوا الإنسان عبر مطالب يستحيل تحقيقها، وصرف انتباهه عن التأثير في العالم الخارجي نحو تأمل داخلي زائف".
بعد التفكير مليا، فإن ما قد يبدو طموحا فلسفيا محترما، سيصطدم دائما، في الواقع، بذلك النقص في المسافة الذي يجعلنا غير قادرين على أن نكون، الموضوع والسؤال في الآن ذاته: أليس من المستحيل أن يكون المرء، في الآن نفسه، في نافذته، وأن يرى نفسه يمر في الشارع، كما سيشير ماين دو بيران؟
إن معرفة الذات تجد، إذًا، حدودها. تلك الحدود هي، بالأخص، ما تفرضه علينا الموت. حدود لحريتنا. وحدود تصطدم بها قدرتنا على التعقل. بيد أن هذه الحدود ذاتها، ستكون هي تخوم الفضاء الضيق الذي تشغله الأديان، لا سيما الكاثوليكية الرومانية، بل في الواقع، الديانات السماوية الثلاث.
ما لا نعرفه، ما نرغب في تجاهله كليا، يولد الخوف. والخوف يغذي اللاعقلاني، واللاعقلاني يغذي الديني، وكما يحلل كوندرسيه، يغذي الخرافة والظلامية: "لقد كان هناك زمن كان فيه الحماس الديني يتدخل في كل اضطرابات الشعوب ويقرر تقريبا مصير كل الديانات الكبرى: وكان النفاق آنذاك ملكة العالم"، ثم يضيف: "هذه الأزمنة ليست بعيدة عنا، بل لم تمض أصلا بالنسبة إلى كل الشعوب". هل كانت هذه الديانات السماوية، ومنها شكل معين من المسيحية، لتظل قائمة لو لم يكن الإنسان واعيا بهشاشة وجوده، وعاجزا، في الآن نفسه، عن تحملها؟ ليس «العقل السليم» هو الأكثر تشاركا بين البشر، بل السذاجة، هذه الخديعة التي نحتمي بها ـ زيفا ـ من القلق والخوف من الموت. أندريه جيد، في كتابه "الأطعمة الجديدة" (Les Nouvelles Nourrritures)، أدرك ذلك جيدًا: "يا رفيقي، لا تؤمن بأي شيء، ولا تقبل شيئا بلا برهان. لم يثبت دم الشهداء شيئا قط. ليست هناك ديانة مجنونة لم يكن لها أتباعها ولم تثير شيئا متقدا، وألهبت بها قناعات حارة. إننا نقتل باسم الإيمان. إن الرغبة في المعرفة تنبع من الشك. توقف عن الإيمان، وتعلم. لا يحاول أحد أن يفرض شيئا إلا عندما تنعدم البراهين. لا تدع أحدا يقنعك. لا تدع أحدا يفرض عليك شيئا".
انطلاقا من هذه الملاحظة، ألا يقع الأمر على عاتقنا، في أن نبني مجتمعا متحررًا أخيرا من الظلامية الدينية، من الخرافات على اختلافها، بل ومن تلك الصيغ الماسونية «الجاهزة» التي يقنعوننا بأنها طريق الحرية: معرفة الذات، التسامح، الأخوة... وغيرها الكثير؟
الجهل والخوف، هما ركيزتان الركيزتان الأساسيتان لكل دين (بارون هولباخ)
الإنسان فان. أنا فان. من المبتذل أن نذكر بذلك. ومن الصعب تحمل فهمه. لذا، يتم بذل كل جهد ممكن لإخفاء هذه الحقيقة، خاصة وأن الموت يلازمنا منذ اللحظات الأولى من وجودنا. بل إنه جزء لا يتجزأ من الحياة.
ومع ذلك، فإننا نتعامل مع هذا السيد الذي يتحكم في مصيرنا كأنه غريب. غريب لا نكف عن استبعاده. الموت؟ إنه دائما موت الآخرين. ليس موتي أنا.
هكذا والحال هذه، بالنسبة للوضع البشري المتناقض، ففي الواقع، أي تساؤل حول معنى الوجود يؤدي إلى استنتاج أن الحياة والموت مرتبطان ارتباطا وثيقا، ويؤدي في الوقت نفسه إلى رفض عاطفي ومثير للشفقة لهذه الحقيقة.
ومن ذا الذي لا يذكر فيلم الخاتم السابع لإنغمار برغمان؟ هذا الابن لكاهن لوثرياني، والذي عانى طويلا من وطأة ذلك الإرث الروحي، ينسج لنا حكاية فارس مسيحي، يعود من الحروب الصليبية بعد رحلة طويلة في فلسطين بحثا عن الحقيقة، كما ظن من سبقوه أن بإمكانهم العثور عليها هناك، يعود خائبا محبطا من بحث طويل وعقيم لكنه لم يفقد بعد أملا داخليا بالنجاة من عبث تلك المغامرة. بيد أنه خسر لعبة الشطرنج الرمزية أمام الموت. كان الموت كامنا في الظل، يتنكر في هيئة قس، فينخدع به الفارس ويخبره بالحركة الحاسمة التي كان يظن أنها ستمنحه النصر وتوقع الموت في هزيمته الحتمية (échec et mat)[2]. ما الذي كان يبحث عنه هذا الفارس في تلك الأرض البعيدة؟ أكان يطلب سر حياة لا تنتهي؟ الأبدية؟ أم كان يفتش عن الممر الضيق، عن الباب الذي يقود إلى الفردوس، إلى الأرض الموعودة التي تفيض ب "الحليب والعسل"؟
أليس الإنسان، في جوهره، غير راض دائما على الحاضر، كما لو أنه لا يريد أن يكون له سوى الماضي الذي لم يعد له سيطرة عليه ومستقبل لم يحكمه بعد، ولكنه يتوق إليه كما في الحلم؟ ألسنا، في أعماقنا، بناة مستقبل لا يعدو كونه حلما؟
الموت المغيب؟
هذا الرفض لقبول الحقيقة ـ الإنسان فان ـ هو رفض تغديه العاطفة، لا لجهل بها، بل لكون الإنسان على وعي بها، وإن كان وعيا موارى، ومرد ذلك، في الغالب، إلى تربية دينية، وأحيانا حتى علمانية؛ لأن الحدود في هذا المضمار غالبا ما تكون دقيقة وملتبسة. ألا ينذر الطفل المدلل في مجتمعاتنا الغربية بالراشد الذي لا ينفك يعيد اختراع فضاء وهمي من الأمان والنظام، ذلك الفضاء الذي يرى نفسه عاجزا دونه؟
في مجتمع يرتكز على ما يسمى بـ "القيم البرجوازية" (valeurs bourgeoises)، حيث الطاعة، والمنافسة، والمال، والنجاح الاجتماعي هي الكلمات المفتاح، لا يمكن تصور الموت إلا كأقصى درجات الفوضى. ومن ثم، لا بد أن ينحى عن هذا العالم: فمجتمع النجاح المادي مضطر إلى إقصاء كل سؤال يحرجه، فهذه الأسئلة مزعجة!
ينبغي للمرء أن يكون إيجابيًّا، شابًّا، جميلًا، وبلا وخز ضمير. أما اليوم، فقد أضيفت الشعارات الإعلانية إلى الخطابات الدينية، التي لا تقل عنها تضليلا. إن المجتمع الليبرالي الغربي لا يريد إلا رجالا ونساء يربحون، يستهلكون، دوما أكثر، وإن لم يكن أفضل. لا حاجة له بأناس يفكرون أو يراجعون ذواتهم. لم نعد بإزاء "عقل سليم في جسم سليم"، بل صرنا أما "جسد سليم بلا عقل". وهنا نعود إلى مقولة إمبراطور روماني: "ماذا نعطي الشعب؟ الخبز والألعاب!"[3]. حسبنا أن نرى الحيز الذي يحتله الخبر الرياضي في نشراتنا اليومية، وما فيها من مقابلات سطحية للاعبي كرة القدم والرغبي، لا يزيد بعضها عن بعض تفاهة. ومع ذلك، فغالبية رجال عصرنا يتحمسون، بل ويتعاركون، من أجل ألوان فريقهم. يا له من زمن سعيد هذا الذي نعيشه.
يبدو الأمر كما لو أن الإنسان لم يعرف تغيرًا، رغم القرون المتعاقبة، ورغم التقدم العلمي والتقني الذي لا يمكن إنكاره. كأن الكائن البشري لا يزال يبحث عن مأوى داخل جدران أربعة، يلوذ بها اتقاء لكون لا متناه يملأه رهبة. أليس هذا العالم المنغلق الذي تمثله شققنا ومنازلنا نوعا من النفي المطمئن للخطابات الفلسفية المزعجة التي ما فتئت تذكرنا بهشاشتنا؟
علينا أن نعترف، ولو على مضض، بأن الغالبية العظمى من الناس ـ ونحن منهم ـ تميل إلى سلك الطريق الأسهل، لا طريق الجهد والمواجهة. ولو كان لا بد من وصف جامع لهذا الإنسان، لقلنا إنه "الإنسان المتوسط" (homme moyen)، وهو ذاك الإنسان الذي أراد الفيلسوف جون بول سارتر أن يكرس له دراسة بعنوان: "أخلاق التوسط"، أو "أخلاق الإنسان المتوسط".
الإنسان المتوسط[4]: هو ذاك الذي يفضل أن يضيع في متاهة الوسائل، كي لا يضطر إلى مواجهة الغاية وجها لوجه. كرسام لا ينتهي من انتقاء فرشه، دون أن يرسم لوحة واحدة. هو من يطلب العزلة في زحمة الحشود، لا تواضعا بل خوفا، ويعتقد أن المصائب مجرد ضربات حظ، لا نتيجة لخياراته... هو ذلك الإنسان الإحصائي، الذي لا يريد أن يعترف بمصيره.
هل يمكن أن تكون إعادة إدماج الموت عاملا للحرية؟
وأن نفكر انطلاقا من ذواتنا، فذلك أن نتعلم كيف نقبل نسبية كل شيء، بدءا من نسبية وجودنا ذاته. يتعلق الأمر إذن بدمج هذه المحدودية في أذهاننا لتصبح قوة وعاملا من عوامل الحرية والتواضع. فإذا كانت اليوتوبيا ضرورية لتحريك البشر، فليتها تظل عصية على التحقق. ذلك أن اليوتوبيا حين تتحقق لا تفضي إلا إلى قيام مجتمعات شمولية، متحصنة وراء جدرانها، على غرار العالم المثالي عند فورييه، أو المثال الشيوعي كما طبق في الاتحاد السوفياتي أو ألمانيا الشرقية، بل وحتى في التجربة الإسرائيلية. هناك تبنى الجدران. وترفض الجسور التي وحدها تتيح اللقاء.
وأن التفكير النقدي ينبغي له، في الحقيقة، أن يمارس على كل المستويات، ولا سيما على تلك التي تمس حريتنا وخياراتنا في الحياة والموت. وهو يفترض، على سبيل المثال، الاعتراف بحق الإنسان في أن يموت بكرامة، بل وفي أن يمارس حريته في وضع حد لوجود لم يعد أكثر من مجرد بقاء مفروض.
فالحرية تبدأ من الوعي بنسبيتنا الوجودية، وبالمفارقة، من تلك الحرية التي نؤتمن عليها جميعا. وإن التزاماتنا، بقدر ما تبدو مشروطة بخفتها الذاتية وراديكاليتها المطلقة، تزداد قيمة وجدوى.
"لا يدرك الإنسان ذاته إلا بقدر ما يدرك العالم، ولا يدرك العالم إلا في ذاته، ولا يكتشف ذاته إلا من هذا العالم الذي يتجلى فيه" – غوته.
إن غوته، الناقد لما ذهب إليه سقراط في شعاره الأشهر، يدرك تمام الإدراك أن هذه المعرفة تظل نسبية في جوهرها. وهو بذلك، يلتقي مع كيركغارد، ذلك الفيلسوف الذي رأى، بدوره، أن الحقيقة، إن وجدت، فإنما تكمن في الذاتي، لا في الموضوعي: "وحدها الذاتية هي الحقيقة". ما الذي يجمع بينهما؟ وعي مشترك بقيمة الحرية الفردية تلك الحرية التي لا ينبغي لأي شيء أن يقيدها حتى الموت ذاته؛ إذ إن الموت، في هذا المنظور، لا يقدس ولا يستسلم له، بل يدمج ضمن الحياة كعنصر أساسي من عناصر التقدم.
وإذا كانت الذاتية هي موضع الحقيقة فإن هذه الأخيرة لا تكون إلا دائما مشروعا في طور التكون، حقيقة لا تدرك أبدا في اكتمالها. فالاعتقاد بوجود "حقيقة موضوعية" ليس إلا وهما، لا يولد إلا في أذهان العقائديين والطغاة، سواء كانوا من صنف رجال الدين أو من أتباع الأنظمة الشمولية.
هل يعدّ ضعفا أم قوة التفكير، كما يفعل الشاعر أو الفيلسوف، بأن العالم لا يوجد إلا من خلال النظرة التي ننظر بها إليه؟ إن التفكير على هذا النحو يفرض وعيا أكبر بالمسؤولية التي تقع على عاتق كل فرد إزاء وجوده.
في قصيدته "الرغبة المباركة" (Bienheureux désir) المقتطفة من الديوان الشرقي-الغربي، يصور غوته فراشة يستهويها لهب شمعة في عتمة الليل. تهرع الفراشة، مأخوذة بسحر الضوء، وما إن تمس الشعلة حتى تموت محترقة.
ومن هذا المشهد، يستخلص الشاعر الحكمة التالية:
"ما دمت لم تفهم بعد هذا: مت وكن!
فأنت مجرد ضيف غامض على أرض معتمة!"
هنا يفرض علينا من جديد هذا التناقض، كمرآة لتعقيد الأسئلة التي لا بد أن يطرحها الإنسان؛ ذلك الكائن المتفلت من كل تعريف. ومع أن البشر يدركون، في قرارة أنفسهم، هشاشة هذا الكائن وتعدد وجوده، فإنهم لا يفتؤون يختزلون بعضهم بعضا عبر تقنيات الرد إلى المبادئ، إلى الأخلاق، إلى التقاليد؛ مما يجعل هذا الاختزال ذاته محركا لعدم وجودهم الحقيقي.
أن تعرف، يعني أن تقلص، [أن تختزل ما لا يحاط به] وحين نفرط في التعريف نصل حد ألا نوجد، حتى لا نضطر للموت!
لكن، وعلى العكس، فإن كل موت للذات، إذا ما قبل وتم التماسه بوعي، يفتح السبيل نحو امتلاك ـ بل استعادة متجددة ـ لحرية لا تكف عن الإفلات من قبضتنا، أو لعلنا من لا يكف عن الهرب منها. أليس من المغري دائما أن نختار الطريق الأسهل، طريق أقل مقاومة؟ فالحرية في حقيقتها، صراع عنيف لا يهدأ. ونحن نعرف ذلك جيدا؛ إذ كثيرا ما نشبه ـ أحيانا بدافع التعب ـ وأحيانا أخرى بفعل التقليد، وغالبا تحت وطأة العجز ـ لندخل في هيئة "العدم الصغير" الذي رسمه الشاعر جان تارديو، تلك الكائنات التي يقول عنها [بتهكم لاذع]:
"ماذا فعل؟ لا شيء.
ماذا قال؟ لم يقل شيئا.
فيما فكر؟ لم يفكر في شيء.
ولم لم يفعل شيء؟ ولم لم يقل شيئا؟ ولم لم يفكر في شيء؟ لأنه ببساطة غير موجود."
بهذا، يلتقي تارديو مع الفيلسوف جون بول سارتر، الذي فكك صورة الإنسان "المتوسط"، ذاك الذي يدرك، مرغما، أنه "محكوم عليه بأن يكون حرا".
وفي الختام، أستحضر قول رونيه شار الحاد: "ما جاء إلى العالم دون أن يزعجه، لا يستحق لا الاحترام ولا الصبر." ([من ديوان] الغضب والسر)
وعليه، إن أردنا أن نكون من بناة المستقبل، فلا بد أن نخوض مغامرة إزعاج هذا العالم، دون أن ننسى درس مونتين الذي يقول: "التأمل المسبق في الموت، هو التأمل المسبق في الحرية."
المصدر المعتمد في الترجمة:
ـ دو مونتيني (مشيل)، "المقالات، الكتاب الأول"، ترجمة: فريد الزاهي (دار معنى للنشر والتوزيع، 2021).
[1] ترجمة هذه العبارة التي استهل بها جان لونوار مقاله، اقتبستها من كتاب: ميشيل دو مونتيني، المقالات، الكتاب الأول، ترجمة: فريد الزاهي (دار معنى للنشر والتوزيع، 2021) ص: 185
يضيف مونتين لهذا قائلا: "إن استعدادنا للموت ويقيننا من قدرتنا على مواجهته يحررنا من كل عبودية وكل إكراه". (المترجم)
[2] Échec et mat: هي عبارة تستخدم في لعبة الشطرنج، ترجمتها الحرفية للعربية "كش ملك" وتعني أن الملك أصبح مهددا ولا يمكنه الهروب، وبالتالي تنتهي اللعبة بخسارة الطرف الذي تعرض للكش، لكن هنا اخترنا لها ترجمة "هزيمة حتمية" لتناسب سياق النص. (المترجم)
[3] معنى ذلك، بكل اختصار، هو: يكفي الطعام والتسلية لإلهاء الشعب والسيطرة عليه (الخبز لبطونهم، والألعاب لعقولهم؛ قوت يسكت الجوع، ولهو يخدر الفكر). (المترجم)
[4] الإنسان المتوسط لدى سارتر هو النموذج السلبي أو الضد فلسفي لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان الأصيل، أي هو الإنسان الذي يتنازل عن حريته، ويعيش وفق القيم الجاهزة، ويتخفى خلف القواعد الاجتماعية أو الأخلاقية العامة، بدل أن يخلق قيمه الخاصة. (المترجم)