إعادة التفكير في التقنية: من أجل تكنولوجيا ديموقراطية
فئة : قراءات في كتب
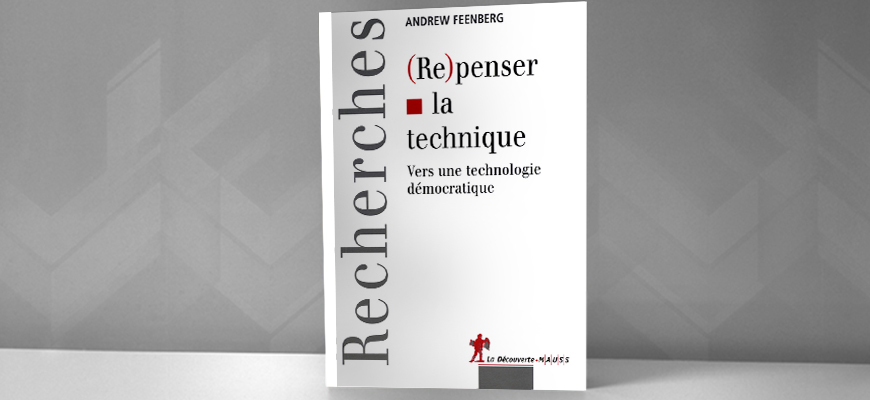
إعادة التفكير في التقنية: من أجل تكنولوجيا ديموقراطية
أندرو فينبرغ، منشورات لاديكوفيرت، باريس 2004، 244 ص.
هذا الكتاب المترجم إلى الفرنسية مؤخرًا، ذو أهمية بالغة على الرغم من مرور أكثر من عقد على صدوره باللغة الإنجليزية ("مساءلة التكنولوجيا" في صيغته الأصل). ولعل أهميته القصوى تأتي بنظر صاحبه، من كونه جاء نتيجة لتقاطع عميق بين ماركسية مدرسة فرانكفورت والثورة المعلوماتية وعلم اجتماع التقنية.
إنّ الدرس الأساس الذي بالإمكان استخلاصه من هذا التقاطع إنّما يكمن، بنظر الكاتب، في أنّ الاختيارات التكنولوجية المختلفة يمكن أن تساهم في دمقرطة المجتمع، من خلال تمكين التنظيم الذاتي داخل الفضاء التقني ذاته.
وعليه، فإنّه حيثما كانت العلاقات الاجتماعية متمحورة حول التقنية العصرية، فإنّه سيكون بالإمكان تضمينها لمراقبة ديموقراطية ما، ومن ثمة إعادة تشكيل القاعدة التقنية بطريقة تفسح المجال واسعًا للكفاءات وللمبادرة الإنسانية.
وهي مقاربة تقترب من الطرح الماركسي، إلا أنّ المؤلف يؤكد بأنّه "إذا كان ماركس لم يفكر بهذه الطريقة إلا فيما يخص الإنتاج، فلأنّ في زمنه (زمن ماركس) كان الإنتاج هو مجال التطبيق الأساس للتقنية". أما وأنّ الموسطة التقنية قد انتشرت بكل مجالات الوجود الإنساني، فإنّ "الإمكانات المتاحة من لدن التقنية قد تضاعفت، في الوقت الذي تزايدت في ظله التناقضات التقنية".
في الآن ذاته، يرى المؤلف أنّ الثورة المعلوماتية التي انفجرت بأواسط ثمانينات القرن الماضي، قد أسهمت بقوة في تزكية طرح دمقرطة النفاذ للمعلومات، وذلك قبل أن تنتشر شبكة الإنترنيت وتصبح أداة "للمساواة في البلوغ" ثم الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات.
بصلب ذلك، ازدادت أهمية علم اجتماع التقنية، إلى جانب مدارس البناء الاجتماعي ونظريات شبكات الفاعلين. إلا أنّ علم اجتماع التقنية الجديد (الذي أتى في أعقاب المواجهات النظرية التي أفرزتها أطروحات الحداثة) قد أعاد للواجهة من جديد المناهج المحيلة على الدور الديموقراطي للتقنية، عوض الاقتصار على المناهج التقنوية التي كانت تراهن على التحديد التقني باعتباره العنصر المهيمن لا المساعد.
إنّ هذا الكتاب، بنظر صاحبه، إنّما يقترح دراسة التقنية من الناحية الفلسفية، بطريقة يريدها مختلفة عن المقاربات المهيمنة في حقل الأخلاق التطبيقية، والتي تنظر إلى التكنولوجيا باعتبارها معطى قارًّا وساكنًا، ومن ثمة لا تسائل التصورات التي ثوت خلف نشأتها وتكونها وتطورها.
ثم إنّ هذه المقاربات تتجاهل، بنظر المؤلف، حقيقة أنّ الاحتمال الذي يظهر على كل التناقضات الأخلاقية الفردية، بإمكانه أن يعالج من خلال ترتيبات تكنولوجية مختلفة. ولذلك، فإنّه يعتقد بأنّ السؤال المحوري الذي على الفلسفة أن تطرحه هو الذي يطال المنبع الاجتماعي الصرف للتكنولوجيا وللأنظمة التكنولوجية، ويطال بالآن ذاته "الإمكانات التي تتوفر لدينا لتغييرها".
هذا الموقف إنّما من شأنه، يتابع المؤلف، أن يحيل بصورة مباشرة على التساؤل السياسي لطبيعة الحداثة، ويفسح المجال لإمكانيات إنبات بدائل جديدة للنظام المهيمن.
من جهة أخرى، يرى الكاتب أنّه إذا كانت الحركة الديموقراطية (في السابق من أزمان) تضع كل ثقلها في المسلسلات الطبيعية للتطور التكنولوجي، فإنّ النقاد المحافظين كانوا "يأسفون" للثمن المرتفع لهذا التطور، لا سيما من زاوية النظر الثقافية. إذ كان كل من روسكين وهايدغر "يتحاملان" على التطور التكنولوجي وعلى المكننة، في حين كان الديموقراطيون والاشتراكيون يصفقون للمهندسين ويذهبون إلى حد اعتبارهم "فاتحين جددا" لمكنونات الطبيعة.
بيد أنّ الكل كان يتفق على اعتبار التقنية قوة مستقلة تفعل من خارج المجتمع، فيما يعتبر "طبيعة ثانية تطال الحياة الاجتماعية، انطلاقاً من مملكة الإدراك، حيث يجد العلم نفسه مصدره". بالتالي، فقد كان منبع التقنية (بوصفه مصدرًا للنجاعة والعقلانية) هو الذي يؤسس الخيط الناظم للحياة العصرية. إلا أنّ هذا التصور يستبعد كل الإمكانات المتاحة الممكنة كي توسع الديموقراطة من المجال التقني.
إنّ التقنية، في ذهن الكاتب، إنّما تمثل الوسيط للحياة اليومية في المجتمعات العصرية، وأي تحول تكنولوجي كبير له تداعيات وتأثيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وما سواها. بالتالي، فطالما استمررنا في اعتبار عالم التقنية والعالم الاجتماعي مجالين متمايزين، فإنّ هذه الأبعاد من وجودنا ستستمر، بخصوص العديد من النقط، خارج أيّ إمكانية للتدخل الديموقراطي.
بمعنى أنّ الديموقراطية هي معطى مرتبط بالفكرة التي لدينا عن التقنية، إما باعتبارها أداة استعباد حقيقية (لا سيما في رافدها الاقتصادي الصرف)، أو أداة لتحرر الإنسان في وجه التحديث والأنسنة التي من المفروض أن تنشدهما في الزمن والمكان: الآلات كما منطق السوق هما أداتان لاستعباد الإنسان أو لتحرره.
بيد أنّه إذا كانت الديموقراطية تضع على المحك استقلالية التقنية، فإنّ الفلسفة "الأساسية" للتقنية قد أضحت هي نفسها على محك الطرح ذاته. لقد حان الوقت، يقول الكاتب، لتصور فلسفة تتجاوز على "أساسية" التقنية، لأنّ من شأن ذلك أن يضع حدًّا لما يسمى بالإكراهات التكنولوجية، بالعقلانية الأدواتية، بالنجاعة وبالتأطير وبباقي العناصر النظرية.
وعلى هذا الأساس، فإنّ المؤلف يقترح هنا بديلاً عمليًّا للمقاربة التي يتبناها "الممثلون المؤثرون" لأطروحة "أساسية التكنولوجيا"، لا سيما جاك إيلول وبورغمان وهايدغر.
إنّ هذه الأطروحة ترتكز، بنظر الكاتب، على فكرة أنّ التقنية تختزل الكل في وظائف ومواد أولية، والممارسات التقنية الموجهة لهدف محدد تطغى على الممارسات المتضمنة للبعد الإنساني. بالتالي، فإنّ النجاعة تكنس أي معيار آخر وتحدد مسلسل الاستقلالية للتطور التكنولوجي.
من هذه الزاوية، فإنّ أيّ محاولة لإدماج معنى ما في التقنية سيبدو كعملية إدماج قسرية، من بين ظهراني مجال عقلاني له منطقه وقوانينه الخاصة. إلا أنّ هذه النجاعة، وكيفما كان مستواها، ترتد على مصمميها، مهددة بذلك لا فحسب البقاء المادي، بل وكذلك البقاء الروحي للإنسان.
إنّ الثنائية المنهجية للتقنية وللمعنى ذات تبعات ونتائج سياسية مؤكدة. فالتقنية، من ناحية، تتطلع لتقويض المعاني التقليدية والاتصال، وتدعونا، من ناحية أخرى، للحفاظ على وحدة عالم المعنى.
وبما أنّ مصدر التقنية غالبًا ما لا يتأثر كثيرًا بالتحولات التقنية الفردية، فإنّ "الإصلاح التكنولوجي يبقى غريبًا على مجال الأسئلة الفلسفية". بالتالي، فالمفروض أن تتم مواجهة كونية التقنية من خلال محاصرة الميدان التقني ذاته.
هل من الوارد أن يكون لهذه الثنائيات شرعية ما في القرن الحالي؟
يجيب المؤلف: إنّ "هذه المقاربة تجعلني مترددًا، لا فحسب لأنّها تؤكد وجود باطولوجيا اجتماعية مرتبطة بالتقنية، ولكن أيضًا لأنّها تركن إلى الجانب أي فعل جاد لمعالجتها".
ومع ذلك، فإنّ تغيرات عميقة تبرز في ميادين كالطب والمعلوماتية، بفعل الاحتجاج السياسي وتدخل الجمهور. وهو ما يعبر عنه، طيلة العقود الثلاثة الأخيرة، دور منظمات البيئة، والتي باتت تتدخل بقوة في كل ما يتعلق ويرتبط بالتقنية، مما يعني أنّ العالم التكنولوجي الذي سنعيشه ونعايشه في المستقبل، سيكون نتاج الفعل العمومي وإلى حد بعيد.
صحيح، يتابع الكاتب، أنّ زوايا النظر ستبقى مرتبطة بثقافتنا المهنية وبطبيعة العلاقة التي ستكون لنا مع "الثقافات التقنوية". إلا أنّ هذه الزوايا ستبقى هي الأخرى رهينة الواقع المعيش على الأرض.
بيد أنّ هذه القضايا لا تستطيع أن تخرج عن التمثلات الثقافية التي يراها الكاتب قائمة وضاغطة، على الرغم من أنّ معيار النجاعة الذي تنشده "الأدوات" التقنية، يتجاهل الأبعاد الاجتماعية التي تتأثر بها شكلاً وجوهرًا.
إنّه التقسيم الجديد للعمل الذي ترتضيه "الفلسفة الأساسية"، يقول المؤلف، إذ تمامًا كالتمثل التقني، فإنّ هذه الفلسفة تعتبر التقنية إنّما هي أدوات موجهة لخدمة النجاعة، النجاعة دون سواها. وعلى هذا الأساس، فإذا كانت هذه الفلسفة "تأسف" للتبعات الاجتماعية للتقنية، فإنّ التمثل التقني لا يعير هذه الأخيرة أدنى اعتبار، لا بل ولا يوليها أي اهتمام يذكر.
إنّها نقطة ضعف هذه الفلسفة، بنظر الكاتب: "إنّها تقدم نقدًا قويًّا لهوس النجاعة التي تهيمن بمجتمعاتنا، والتي تجد ترجمتها في التصور التقني للعديد من الأدوات والنظم، لكن دونما أن تبين بأنّ هذا الموقف يعبر عن ميلاد التقنية العملي، كما تموج في التاريخ، وكما يظهر اليوم وكما يمكنه أن يتمظهر في المستقبل".
بالتالي، فإذا كانت "الفلسفة الأساسية" عديمة البصر فيما يتعلق بعناصر محدوديتها، فلأنّها تخلط بين الموقف وبين الموضوع، بين الهوس المعاصر للنجاعة وبين التقنية في حد ذاتها.
إنّ "أصل" التقنية الحقيقية، يتابع المؤلف، والذي قد نكون بإزائه في كل تعقيداته، لا يمكن أن يختزل في النجاعة، لأنّ الأدوار المختلفة التي تلعبها لا يمكن أن تنحصر هنا وبهذه السهولة.
ولذلك، فإنّ علم الاجتماع "البنائي" للتقنية، إنّما يأخذ مكانته ويجد مشروعيته، لا سيما عندما يدفع بالخصوصية الاجتماعية والتاريخية للأنظمة التقنية، وارتهان التصور واستخدام التقنية بالقياس إلى الثقافة وإلى استراتيجيات مختلف الفاعلين التقنيين.
يبدو لي، يتابع الكاتب، بأنّ ثمة "تمايزًا جوهريًّا بين الفاعلين التقنيين، وبأنّه هو الذي بإمكانه ربط القضايا الاجتماعية بالقضايا الفلسفية. إنّه تمايز يضع حدودًا بين وضعيات الهيمنة والارتهان بإزاء الأنظمة التقنية".
إنّ هذه الجزئيات الفاصلة هي التي تبدو للمؤلف، نقطة ضعف "فلسفة التقنية"، لا سيما الرواد الذين لم يأخذوا بهذه التمايزات ولا أعاروها الأهمية العميقة التي تعبر عنها التقنية بوصفها معطًى اجتماعيًّا وتاريخيًّا.






