الإيديولوجيا المناسبة للمرحلة الحاليّة من منظور الفلسفة الإسلاميّة وعلم الاجتماع
فئة : مقالات
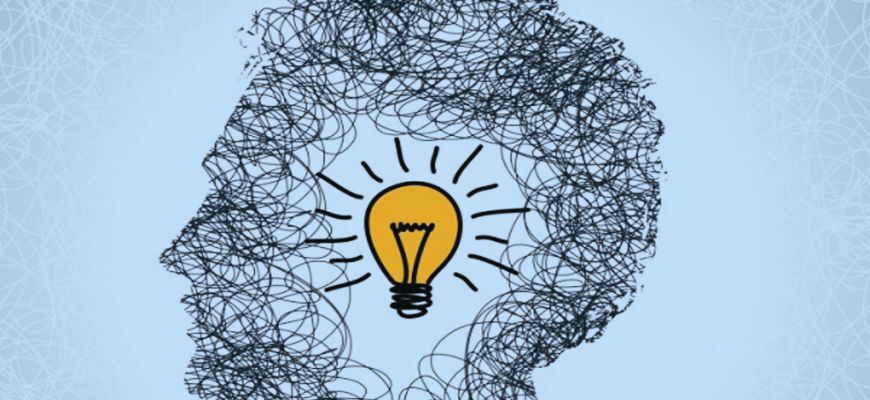
الإيديولوجيا المناسبة للمرحلة الحاليّة
من منظور الفلسفة الإسلاميّة وعلم الاجتماع
تمتاز الرّسالة المحمّديّة عن سائر الرّسالات السّماويّة بإمكانها الحضاريّ الشّامل، والحضارة منهجٌ فكريّ متشكّل في إنتاج ماديّ ومعنويّ، ولو تفحّصنا منتجات الحضارة الإسلاميّة، لوجدنا أن من أهمّها هو الأمّة العربيّة من خلال إنتاج عناصر تكوينها، الوطن والشّعب واللّسان والعقيدة والرّسالة والدّولة. فالفتح الإسلاميّ حرّر المنطقة العربيّة من المحتلّين، الفارسيّ والروميّ، وأقام فيها الخلافات الإسلاميّة العربيّة المتتالية، وحثّ فيها على الدّيانة الإسلاميّة، حتّى انتشرت كعقيدة ورسالة ولغة جامعة.
وبفعل عامل الزّمن حوّل الإسلام العروبة من عرقٍ إلى عمق ثقافيّ استيعابيّ تختلط فيه الأعراق المختلفة كالسّاميّة والأمازيغيّة، قائداً ومواكباً للتّحضّر الإسلاميّ، يراكم المعارف، ويهندس التّطبيقات، ويفتح البلاد، وأعاد تشكيل أهل الأرض العربيّة من قبائل متفرّقة متناحرة متخلّفة مغمورة، إلى مجتمع مدنيّ متماسك يدير شؤونه بنفسه.
فالتّحضّر هو عمليّة تفكيك المركّب، لذلك كلّما تقدّمت ونمت، تمايزت أبعادها الحضاريّة وتعدّدت، وقد بدأت متّحدة في نبيّ البشريّة محمد بن عبد اللّه، صلّى اللّه عليه وسلّم، وصحابته رضوان اللّه عليهم في دولة المدينة المنوّرة.
وبعد مرور الزّمان وتقلّب الأحوال، دخلت الحضارة حالة السّكون تلتها حالة الانكماش، ثم على إثر حملة نابليون اكتشفت تخلّفها الشّديد في جميع أبعادها الحضاريّة، السّياسيّ والاقتصاديّ والأخلاقيّ والقيميّ والعلميّ والفلسفيّ والأدبيّ والفنيّ وغيرها، المتفاوت، سواء في التّنظير أو التّطبيق.
نحن أمّة تدور حول النّص، يبدأ الإنتاج الفكريّ في حضارتنا بإنتاج علومٍ شرعيّةٍ معاصرة، يُبنى عليها إنتاج تلك العناصر الحضاريّة. المنتج الأوّل، العلوم الشّرعيّة، اعتقاديّ، يُنافس المعتقدات الأخرى، ويُحاكَم بمعايير العقل والمعنى والفطرة عموماً. والمنتج النّهائيّ، الأبعاد الحضاريّة، فكرٌ وأخلاقٌ ونظمٌ إنسانيّة تخلو من الغيبيّات، وتنافس منتجات الحضارات الأخرى، إن غلَبَت في النّظريّة وعلى أرض الواقع، تسود كأفضل منهج للحياة، ومعيار المفاضلة هو مدى تحقيقها المصلحة البشريّة. خلوّها من الغيبيّات، لا يعني خلوّها من الإيمانيّات، وخلفيّتها الدّينيّة لا تعني الجور على حقوق معتنقي المعتقدات الأخرى، فهي لا تتقاطع في جانب العقديّ وتشريعه مع الأديان الأخرى، بل هي في ازدهارها حقٌ لكل من له حقٌ في أرض الإسلام ومَفخرة، وتطبِّق الدّولة منها القدر الّذي يتحمّله النّاس ويرضي الأغلبيّة؛ فالمجتمع أفراد اجتمعوا على العيش المشترك -التّعايش- قبل العيش الأصلح.
الإسلام الحضاريّ بقوّة جاذبيّته وأدبيّاته، يقصّر المسافات ويذيب التّناقضات ويعزّز اللُّحمة بين الأمم والثّقافات، بينما الإسلام المتقادم ضعيف، يُفتّق تلك الجماعات طائفيّاً في حالة تعدّد الأديان والمذاهب، أو تصارعاً على مكانة الدّين والمتديّنين في حالة تعدّد الإيديولوجيّات، وفي هذه الظّروف قد دأب الاستعمار وجَدَّ على محاربة مظاهر التّديّن وشيطنتها، وفي الوقت ذاته دعَمَ الأصوليّات، ولعب على وتر الأقليّات.
وفي ظلّ انكماش الحضارة الإسلاميّة وذبول روابطها وشدّة فساد الخلافة العثمانيّة، وتحت وطأة الاستعمار المتحكّم بالسّاسة والموطّد للتّخلّف والجارف للثّقافة والمنتهك للحرمات والسّارق للأرض والثّروات، تاه العرب في تعريف الذّات، أتجمعهم أخوّة العروبة أم أخوّة الإسلام؟ أمسارهم الارتواء من حضارة الغرب العدميّة، أم الاقتيات على بقايا حضارتهم المؤمنة؟
ظروفٌ أفضت إلى شعور عميق بعظمة ماضٍ مجيد يُجرح، وحاضر خانق، ومستقبل قلق معتم، فتولّدت عاطفة ضخمة عمياء، ربّما تفضي إلى طرح أسئلة النّهضة وربط عرى المجتمعات، أو إلى انقسامات عاموديّة -إسلاميّ وقوميّ- تهتك بالمكوّن الاجتماعيّ وتطمس العقول والقلوب. إمّا تشخيص المرض وعلاجه، أو انتخاب الجينوم المتكيّف معه، ذلك يعتمد على من سيتصدّر المشهد...
في القرن المنصرم، شُقّت هويّتنا نصفين بسيف الاستعمار الخبيث، على شرف وجاه شعبويّات الغرائز والجهالات، وضاع النّاس بين نارين؛ وأُجهضت دعاوى النّهضة للكواكبيّ والأفغانيّ وغيرهم، وكل من حاول بعدهم كمالك ابن نبيّ والمسيري، وافتَرس المجتمعَ الضّعيف، العسكرُ المنظّم، وضُربت علينا الذِلّة والمسكنة. وبالقياس على مبدأ "الفرصة البديلة" في الاقتصاد، لقد فقدنا آلاف مؤلّفة من لبنات النّهضة.
عندما تعجز الشّريعة عن إنتاج حضارة، فهي بالضّرورة قد عجزت عن إنتاج منهجيّة تديّن سليمة، متفاعلة مع الفطرة، منبثقة عن تراكم المعرفة، تشتبك مع نمط الحياة المعاصر وتفرض نفسها عليه، بل تنتج تديّناً مفرغاً من العقلانية والمعاني القرآنيّة والتّزكية، تعويضيّ، تغلب عليه الشّكليّات، تختلط فيه القناعة المطلقة بصحّة الاعتقاد، مع قناعة مطلقة بقدسيّة التّراث، وقناعة مطلقة بسلامة التّديّن، وفقه فاقد الإحساس برسالة الإسلام.
كل انحراف في نمط التّديّن، يؤدّي إلى انحراف في هرميّة المجتمع؛ نوعيّة نخبته الدّينيّة والأخلاقيّة ومقاليدها ونمط تصدّرها، وهذا الدّولاب يراكم باستمرار طبقات من المصالح الشّخصيّة فوق كتاب اللّه وسنّة رسوله وفطرة الإنسان، أردتنا إلى الإلحاد بأسمائه جلّ جلاله.
هكذا أفضى تقادم الفكر الدّينيّ، وبريقُ سلطانه، إلى الصرامة التّلقائيّة مع المخالفين على قاعدة إمّا معي أو عليّ، فتبخّرت طاقات المسلمين ومقدّراتهم في مشاريع لم تغيّر شيئاً، بل كانت على حساب المبدعين والموهوبين والعباقرة والقادة والمنتجين، وأُخذ التّديّن تشريفاً على البشر، قبل أن يؤخذ تكليفاً أمام اللّه، وتجوهرت الجهالات، وتفشّت الآفات، وتشعّبت الانقسامات؛ فالفرق كبير بين أن تكون جزءاً من النّاس، أو أن تفرض نفسك الوصيّ عليهم. والنّتيجة، تمزّق وحدة صفّ الأمّة، وانحسار الإسلام فيها كمّاً ونوعاً.
بينما الإسلام المنتصر المقدام، كان من أسباب اجتماع النّاس عليه منذ رسول اللّه مروراً بمرحلة الفتوحات وما بعدها، هو سعة استيعابه العنصر البشريّ، وكانت مسؤوليّة حملة الرّسالة، الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وكان موقف المسلم إزاء ضلال الآخرين، الإنابة إلى اللّه والاستغفار للنّفس واتّهامها بالتّقصير، وأنّ الرّسل تفاضلوا فيما بينهم بمقدار تصبّرهم على الدّعوة، ولم يختلط هدف وحدة أهل أرض الإسلام مع هدف تديّنهم، تحقيقاً للرّحمة والعدالة.
وعلى الرغم من انحراف الحراك القوميّ وتكفيره أدبيّاً، استطاع التّغلغل في المجتمع ومراكز القوّة والوصول إلى سدّة الحكم وتغيير شكّل المنطقة؛ لأنّه في بدايته قَبِل النّاس كما هي دون اشتراطات، ولم يَخلط الأدلجة بالوحدة كأهداف، على غرار الدّخول في الإسلام.
بالطّبع نزاهة أهل اللّه، مركز ثقل أخلاقيّ كبير للمجتمع والأجيال، وصمّام أمان في هيكل الدّولة، كذلك أهميّة التّربيّة الإسلاميّة الصّافية والإعلام والتّعليم والدّعوة... إلخ، لكن كلّ هذا يُبنى اجتماعيّاً على سنّة بشريّة فطر اللّهُ النّاس عليها، هي أنّ نسج وشائج أي زمرة بشريّة دون فرضٍ وشموليّة، يؤدّي بالضّرورة إلى نشر الأخلاق الجماعيّة -تأسيس العقد الاجتماعيّ- من باب مصلحة العيش المشترك، كالتّضامن القلبيّ، أو مؤاخاة المهاجرين والأنصار والفلسطينيّين، أو الدّيمقراطيّة اليونانيّة والقانون الرّومانيّ، أو الطّبقة الوسطى وحقوق الإنسان وقيم المساواة والتّسامح والحريّة، أو أخلاق ومبادئ المسلمين وآدابهم. هكذا تتطوّر أخلاق المجتمعات، فلسفة واقعيّة-مثاليّة، تأخذ شكل مبادئ وقضايا إيمانيّة.
إذن خلاصة الأمر، أنّه كلّما امتدّت- تعزّزت أنا الجماعة، ارتفع منسوب العدالة والحقوق والواجبات وتطلّعات التّقدّم. وفي سياقنا العربيّ والإسلاميّ، اتّسعت رقعة الأمّة، وعمّ الدّين والنّماء.
إذن مع نهاية الخلافة الإسلاميّة، والانحطاط أمام الأمم الأخرى، وعلى إثر ممارسة العثمانيّين سياسة الاحتلال تحت مظلّة الوحدة الإسلاميّة، وكرد فعل على نموذج التّديّن المتقادم التّشريفيّ، الّذي سحب بساط الدّين من تحت أرجل مناوئيه، والمصرّ على استراتيجيّة التّقوقع تجاه المجتمع العالميّ، الغريب والمستهجن عن اتجاهاتٍ ظهرت في المجتمع العربيّ، انحسرت جاذبيّة الإسلام، وبحث النّاس عن الاستقرار والأمان والتّعاضد والانعتاق في هويّات وانتماءات أخرى. هكذا كانت الأحوال، بغض النّظر عمّا درجت عليه الشّعارات والأقوال.
في هذه الظروف المتلاطمة، من الطّبيعيّ أن يستغل الفرصة ويقبض على الدفّة، أقل النّاس اكتراثاً للإسلام، وأكثرهم بعداً عنه وجرأة على تجاوزه...
القوميّة منزوعة الإسلام، كانت ضئيلة ولم تستطع احتواء نمط الحياة البسيطة الأميّة لأبناء الصّعيد، المجتمعين على منبر الجمعة، وكانت فارغة فمَلَأها كل ناشدٍ للسّلطة؛ ذلك أنّ جُلَّ التّدوين والتّحضر الوسيط في المنطقة العربيّة، يبدأ مع الإسلام، وأنّ عقيدته امتدادٌ لمن سبقها من الرّسل والأنبياء المسلمين، بسردها سِيَرَهم الصّافية، أعادتهم أحياء على الألسنة وفي الصّدور.
لذلك استوردت الإيديولوجيا القوميّة نماذج الشّيوعيّة والعلمانيّة واللّيبراليّة... إلخ، منبهرةً بها باعتبارها قالب التّحضّر والتّحرّر المعاصر، وكأنّ هذه "الترندات" قادرة على المدى المتوسّط والبعيد مقارعة أجلّ وأعظم عمق تاريخيّ عرفته البشريّة، من آدم إلى أشراط السّاعة ويوم الحساب، وأبطاله هم خير البريّة. وخصوصاً بعدما أثبتت الحداثة فشلها وتآكلها في كثير من المناحي الحضاريّة، حدّ تحييد الفطرة أو تفكيكها.
وأيضاً هذه المدارس والفلسفات الغربيّة غير قابلة للاستنساخ، فهي ثمرة تطور تاريخيّ مختلف كليّاً في سياقه وظروفه ومشاكله، يستحيل إسقاطها على حياة العرب، وتركيبها على المواطن العاديّ، حتّى مع طول الأمد، فهو الّذي يؤمن بالإسلام نمط الحياة، لا ينفك عنه، ولو جرّه ذلك إلى الأخدود، بل كان من المفترض الاستفادة من تراكمها المعرفيّ الموضوعيّ، وهو ما يحدث على استحياء بسبب توظيفنا الإيديولوجيّ والعلمانيّ والإباحيّ، وثقافة التّكفير الأدبيّ لكل ما هو جديد. وبدلاً من الاكتفاء بتعريب سياقهم التاريخيّ، الأخلق استخلاص قيم النّهضة الأوروبيّة من تربتها العلمانيّة، وزراعتها في تربتنا الحنيفة، باعتبارها قاعدة الشّراكة مع البشريّة، ولاستئناف الرّسالة المحمّديّة، فلدينا ما هو أكبر بكثير من أن نتبعهم في الصّالح والطّالح، إنّما نأخذ منهم ما ينفع، فنخرج منّا ما هو أنفع، بفلسفة ذات أطر وأبعاد أوسع أبدع، وتنزيل أخصب مرتع.
إنّ النّص الإسلاميّ معجزٌ عن ذكر منافعه وفضائله ومناقبه وشمائله. إنّ في سِيَره وأدبه ومقدّساته ورمزيّاته، جنان طهر وصفاء وعفّة وجمال وشكر وامتنان. وجبال عزّة وبطولة وإقدام وفداء ورقيّ وفخار. وسهول توكّل واكتفاء واعتماد ووثوق ورضا واطمئنان. ومنجم إيمان وأمل وصدق ويقين وتسليم وهداية. وحصن عدالة وسلام ومسؤوليّة وزهد وستر وحفظ. وبحار رحمة وحب وشوق وأُنس وتخلٍ ووصال. فيه منظومة مقاصدٍ وأفكار ومبادئ وتصوّرات، يبنى عليها أجدى الفلسفات، وأصلح النّظريّات، وأسمى الحضارات. يُحرّر الإنسان من دنوّ الدّنيا إلى سموّ الرّوح، ومن عبادة اللذّة والمذلّة للبشر إلى العزّة برب البشر والسّعادة بمعرفته. تُفتح به القلوب والعقول والعصور، وتعاد به الحقوق. يُخرج من عُمّاله المعجزات، وعلى مريديه الفتوحات. فهل يترك مثل هذا! هل يتنازل الملك عن ملكه، والغنيّ عن غناه، والوسيم عن وسامته! فكيف بالجنّة وما فيها من نعيم، وما يقرّب إليها من قول أو عمل!
اللّه أكبر هزمت الرّوم! اللّه أكبر هزمت الفرس! اللّه أكبر فُتحت بلاد العرب وآسيا والأناضول والأندلس! اللّه أكبر عادت القدس! اللّه أكبر تحرّرت العراق والشّام ومصر وليبيا والجزائر! اللّه أكبر ستحرّر فلسطين مرّة أخرى بإذن اللّه..
كيف للعروبة أن تختزل في مفهومها تهميش الإسلام، وهو في حقيقته وحاجته الأم الحنون! وكيف يمكن للعربيّة أن تكون غربيّة، وهي لغة القرآن! وكل هذا التّراث الغنيّ العزيز! ما هذا التناقض الغريب! وما هذا الجحود والنّكران والسّخط!
وبناء على ما سبق، نَزعُ الإسلام عن الوعي القوميّ، هو كإخراج السّمكة من الماء، هو فقدان العربيّة ذاكرتها التّاريخيّة، وشنُّ الحرب على تراثها، واعتباره التّخلّف والرّجعيّة، وخلعُ رداء العزّة والعظمة والأخوّة... إلخ، وارتداء الجهل والدّناءة والتّبعيّة والذّوبان والدّونيّة.
إنّ هذا الاستعمار الثّقافيّ، يَحول دون غرس المبادئ، ويضرب فينا التناقضات العربيّة-الغربيّة اجتماعياً، والإسلاميّة-العلمانيّة فكريّاً.
وهكذا انبثق عن الفكر القوميّ لا شيءَ سوى تغريب وعلمنة الثّقافة العربيّة، درجةَ إنكار الإسلام ديناً معجزاً للطّبيعة مفسّراً لما خلفها، وحضارةً استثنائيّة مشهوداً عليها؛ ذلك أن منهجيّتهم في البحث العلميّ تدور حول المادّة، لا تتجرّد عنها، بينما إطار إدراك المخلوقات وتفسير الطّبيعة (الكَوْن) أوسع بكثير، إنّه زوج المنطق والشّعور.
أمّا على النّاحية القطريّة، فلا تستطيع أن تستخرج وتستحثّ مشاعر العزّة والكرامة والوحدة...إلخ، من دول فاشلة، خَطَّها الاستعمار على مقاسه، تحكمها الأقليّات، وعمرها يقاس بالعقود، وإسهاماتها في التّراث معدومة، وشرعيّتها استعماريّة، جرّت لسكّانها الويلات والخيبات والغربة عن الوطن. الهويّة القطريّة صغيرة، تملأها التّنازعات، فيها من الهويّات الجزئيّة ما هو أعرق وأقوى، خاضعة تماماً لرواية الدّولة الوحش، فيصعب فصل الدّولة عن النّظام الحاكم، درجة تفشّي التّسحيج والتّشبيح أو رفض الدّولة. أحالت المجتمع هرميّات استبداديّة، وطبقيّات نفعيّة، ومآتم للضّمير والرّجولة، ومراجل لعديمي الشّرف والإنسانيّة، ومداجنَ للحمقى المتعصّبين. مجتمعٌ تطأ رجله اليمنى في لاس فيغاس، واليسرى في شلنّر. فأنّى لهذا القطر أو ذاك إنجاز دولة وطنيّة، أو نظام ديمقراطيّ، أو مجتمع عضويّ، أو تحقيق سيادة واستقلال وأمن قوميّ، بالطّبع ستحظى بشعوب خاملة عن تبنّي مسؤوليّة الشّأن العام، وسياسيّين مصالحهم مقزّمة.
هكذا بفعل تصدّع وهلاميّة المتاح من الانتماءات العليا، لجأ النّاس للانتماءات الضّيقة، كالطائفيّة والعشائريّة والإثنيّة والشلّيلات، فكلّما أضيفت الهويّة، تكثّفت المصالح والقيم والأعراف... إلخ، وتحقّق الأمن والتّماسك والبقاء...إلخ.
وأمّا على المستوى النّخوبيّ، عند تفشّي أنا الجماعات-الضيّقة والتّديّن التّشريفيّ المتقادم والأخلاق الماديّة، تكون المشاريع الإصلاحيّة في خدمة المصلحة الشّخصيّة لأصحابها. وإنّ أيّ عمل إصلاحيّ يقوم على تقاطع المصالح، يضمحل عن طموحه ولا يؤتي أُكُله، مهما كبرت التّضحيات والمسؤوليّات والنّفقات والمنافع المرجوّة، وهذه عموم حالتنا إلّا من رحم! بينما عند إعلاء أنا الجماعة والتّديّن التّكليفيّ المُحتسب والنّبل الفرديّ، وهو ما تُورده وتُعبّده وتَملأ منه أدبيّات الإسلام، حينها تُصبح المصلحة الشّخصيّة في خدمة قضايا الإصلاح. وهنا يُمكن لمشاريع متواضعة إحداث مساهمات كبيرة نحو الشهود الحضاريّ، فهي تتّسع لإمكانات المجتمع وقدراته، وتحترم قيمة المهنيّة. بذلك صمدت غزّة! ومنه تُعرف النّخبة! وإنّ المجتمع القويّ، خارق للطّبيعة!
اليوم تُرتكب بحقّنا أشهر مذابحِ التّاريخ، بينما نحن مندسون في رؤية تعاني من غياب هائل للواقعيّة والحكمة والتّواضع والمراجعات النّقديّة، تنادي بالوحدة الإسلاميّة والأستاذيّة العالميّة، لكنّها قسّمت الهويّات القطريّة، وفشلت في حل مشكلة من مشاكل واقعها، ورغم ذلك تستحوذ وتستأثر أحقيّة الخطاب الإسلاميّ وتفسير النّص، وتبتزّ وتشوّه من يخرج عن التّقليد.
ترى المسلم كائناً ملائكياً لا تَشدّه العادات والتّقاليد والجغرافيا والثّقافة واللّغة والتّاريخ والحياة الشّعبيّة والفن والأدب والفلكلور والتّراث والعائلة والمهنة والتّعليم والمذهب والخيارات الشّخصيّة... إلخ. وديانة العائلة عند غير المسلم.
بينما على أرض الواقع يشعر الفرد منّا بجمعانيّته العربيّة أكثر من جمعانيّته الإسلاميّة، رُغم انهيار المشروع القوميّ، ومرور قرنٍ على المشاريع الأصوليّة الّتي أُنفق عليها المليارات، والقضيّة الفلسطينيّة أكبر دليل؛ إذ كلّما ازدادت بساطة المجتمع، اطمئن للرّوابط الدنيا، هكذا القوميّة أقرب بكل معايير النّسيج الاجتماعيّ، بينما الإسلام أكثر ميلاً للتّجرّد والفكرة، وهي سمات تنضج مع التّحضّر الأمميّ والتّثقيف الاجتماعيّ والإدراك الفرديّ.
وتعيش المجتمعات العربيّة في هذه المرحلة التّاريخيّة ضمن سقف أفكار الحياة الشّعبيّة، وهم بحاجة لهويّات تجسّد هذا المستوى من التّفاعلات البشريّة دون تعقيد. تجمع عودهم، وتلمّ شعثهم، وتنير بصيرتهم، وتشحذ هممهم، وترسم وجهتهم، وتثمر دربهم. منفتحة متجدّدة ترتقي بهم خطوة تلو خطوة ضمن خصوصيّة المنطقة، من التّكافؤ مع ثقافة هذا العصر الحداثيّ، إلى تجاوزه بالمنظور الإسلاميّ. فالدّين لا يحتاج إلى أدلجة وتعلّق بالماضي وتعصّب، كي يَنفذ ويشكّل جمهرة عاطفيّة ويُعقلنها، إنّما يستدعي مقولاته الدّينيّة ومخزونه التّاريخيّ وذاكرته الجماعيّة، فتراثنا ليس ناقصاً أو بائداً كي يستعين بالغرب، وأدبنا العربيّ جليلٌ ماجد.
بيد أنّ ثقافتنا "منفلخة" شقّين متناقضين، تناقض إبليس المَلَك الشّيطان، وتسود بيننا الرّهبة والحذر والرّيبة والشّك والتوجّس والالتباس خصوصاً تجاه المسيّسين والمؤدلجين، ما أفسح المجال لتغوّل الأنظمة العربيّة الحديثة. حسناً نحن أحوج ما يكون إلى وحدةٍ قويّة بما فيه الكفاية، تحرّر من الاستبداد، وتحقن دماء العباد، وتمنع في بلادنا الفساد. إذا شعوبنا اليوم أرادت الحياة، فلا بد أن تستجيب لقدرها الوحيد، وهو الاتّحاد في جسد واحد تستعيد به شوكتها التّليدة، وقد كان جسدها وشوكتها ولسان حالها وما زال، أنا عربيّ أنا مسلم.
والإسلام يحتاج في هذه المرحلة الصّعبة، عصبيّة تحمله على أكتافها، تلك كانت استراتيجيّة الرّسول، وهكذا توالت الخلافات الإسلاميّة، هي الرّكيزة المتصالحة مع الطّبيعة البشريّة، فكيف لو أنّ هذه العصبيّة قد ترعرعت في حضن الإسلام! عليك بإحيائها وتهذيبها من النَّزَعات. أمّا من النّاحية الشّرعيّة، فالأحكام مقاصدٌ وموافقات، الأمميّة-الإسلاميّة مقصد قرآنيّ، لكنّ الواقع بكل ما يعج به من معضلات لن يوافق عليها دفعة واحدة، مهما عاندته الأجيال تلو الأجيال.
إنّ القوميّة العربيّة المنغمسة في الإسلام، هي المزاج الشّعبيّ العميق، والحد الأدنى الّذي بالتّنازل عنه لا تبقى أمّة ذات عُصبة شديدة وجمهرة متفجّرة، تعجّ وتنضح بالعواطف الجيّاشة والمعنى المحرّك والبواعث النّفسيّة للفعل، تُنزل الرؤية والأهداف والمصالح الاستراتيجيّة منزلة التّفاصيل المعاشة، جمهورها معظم الشّعب ومتواجد في كل مراكز القوّة والدّوائر الاجتماعيّة، وهي الحد الأعلى الّذي من دون تحقيقه يستحيل طلب ما بعده، بل هي بحد ذاتها طموح كبير، وتحدٍ أكبر، وغنيمة أكبر أكبر، فلا توجد استراتيجيّة عاقلة عمليّة قنوعة تستهدف منذ البداية هدفها النّهائي من خلال خطّة خياليّة حالمة، بل حصر الدّعوة الأمميّة-الإسلاميّة بالقوميّة العربيّة، وتعويض ضعف الإمكان الحضاريّ، بالانفتاح على منتجات الغرب بالطّريقة المذكورة آنفاً، وضمن حدود الحلال والحرام، ثم الانطلاق من هذا الأساس الرّاسخ المتين نحو الأمميّة-الإسلاميّة، بالتّدرّج والتّوسّع والإبداع الفكريّ والاستجابة للتّحديّات. والعالم بحاجة إلى من يقدّم البديل الأخلاقيّ وفلسفته، خاصّة على إثر "طوفان الأقصى".
هذا المنظور والنّمط الجديد يفضي إلى تخفيف كثافة الأصوليّات في مجتمعاتنا؛ وذلك من شأنه شقّ مسار التّجديد الشّرعيّ، بالبناء على نقلة القرضاوي ومدرسة المقاصد في المغرب العربيّ، نحو إيقاف تغوّل قبليّات المدارس العلميّة-التّاريخيّة على مقولات النّص المنطقيّة وعلى إسقاط منظومة معانيه على واقعنا المغاير عن زمان التّنزيل وأسبابه، وأيضاً سيُسَهّل من مهمّة نشر الوعي بين الشّباب بمفاهيم وتصوّرات أصيلة ومعاصرة.






