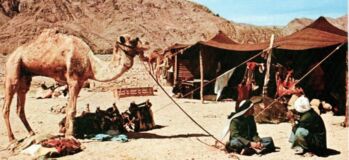الدّين والمنهج عند أبي الحَسَنْ العَامِري في ضوء: "الإعلام بمناقب الإسلام"
فئة : أبحاث محكمة
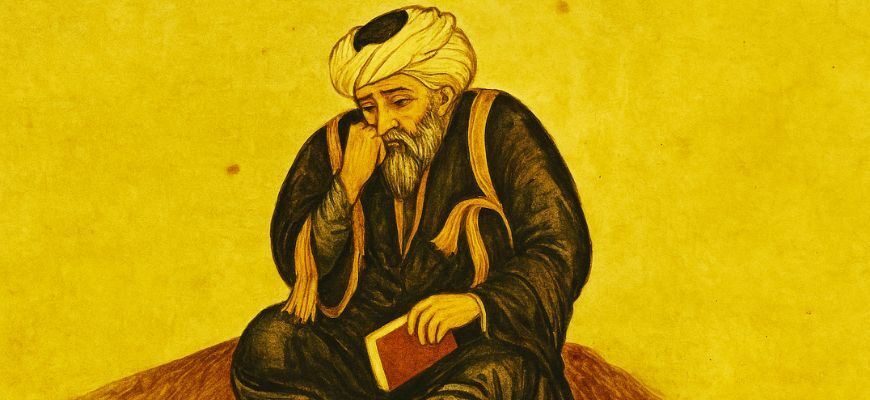
الدّين والمنهج عند أبي الحَسَنْ العَامِري في ضوء: "الإعلام بمناقب الإسلام"
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بفكر أبي الحَسن العامري كأحد فلاسفة القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، حيث يُشهَد له في كتب التراث والفلسفة على أنّه من كبار عصره، ثقافةً وعلماً، وأكبر العارفين بالتراثين اليوناني والإسلامي. ودراستنا هذه خصصناها لإشكالية الدّين والمنهج عبر المقارنة بين الأديان في ضوء كتابه: "الإعلام بمناقب الإسلام"، هكذا، فكّر العامري من منظور علم الأديان المقارن، حيث أجرى مقارنة بين العناصر الأساسية المشتركة بين الأديان، مستعينا بمنهجية عقلية ليختبر مدى تماسكها المنطقي، وساعدته في ذلك ثقافته الواسعة، وترحاله المستمر بين الأمصار.
وعليه، يُمكن القول إنّ منهج العامري كان أقرب إلى علم الاجتماع الديني. والدافع وراء كتابة هذه الدراسة هو أنّ أبا الحسن العامري لم ينل حقّه من العناية البحثية.
مقدمة
إنّ الأطروحة التي أنوي إثباتها في البحث، فهي بسيطة مؤداها: أنّ كتاب أبا الحسن العامري الموسوم بـ «الإعلام بمناقب الإسلام «وجدناه يتناول مسألة الأديان بجرأة غير مسبوقة؛ وذلك جليّ من نوعية المنهج الذي سلَكَه لتحقيق هذه الغاية؛ إذْ الكتاب يتناول أكثر المسائل صُعوبة، ربما انتظرنا عقودًا من الزمن ليظهر تخصص "علم الأديان المقارن" في الغرب كفرع يهدف إلى إقامة حوار جاد بين الأديان التوحيدية، حتى وإن كان هذا الحوار يتعثر في أحايين كثيرة، فيصبح مجرد "حوار صالونات"[1]، ويُقصد به ذلك الحوار الذي لا يعود إلى جذور المشكل بين الديانات التوحيدية الثلاث، بل أحيانًا يكون الخِلاف حادًّا بين الفِرق داخل الديّن الواحد، وعلى خلاف حوار - الصالون- نحتاج إلى "منهج أركيولوجي" يعود عبر الحفر في الجذور، ولا يكتفي بالثناء وإطلاق شعارات رنانةٍ، من قبيل التسامح والتعايش، فتنزيل هذه القيم يحتاج إلى "براديغم الاعتراف"[2] paradigme pour la reconnaissance.
قبل مواصلة المسير في دروب هذه الإشكالية الإبستيمولوجية، نقول إنّ ما دفع العامري ليبحث مسألة المقارنة بين الأديان، هو التساؤل التالي: لماذا أقبل الإسلام وأرفض غيره من الأديان؟ فأراد رفع القلق واللّبس من خلال شق طريق البحث والمعرفة، وليس الاكتفاء فقط بالفطرة؛ لأن الأغلب يأخذ الديّن بالفطرة، وقليل منهم من يسلك طريق الشك و"مسح الطاولة" بالمعنى الديكارتي (R. Descartes)؛ أي اتباع طريق المُساءلة النقدية التي تسبقها الحيرة؛ حيرة الباحث، الذي من أهدافه بلوغ الحقيقة، ونحن نرى أنّ العامري توّفق إلى حدٍّ كبيرٍ في دخول غِمار هذه التجربة، لما لها من خطورة، فمن يبحث في الديّن، فإنه يشبه من يتحرك فوق "حقل ألغام"، قد يُكفّر أو يتهم بالإلحاد، ويسفك دمه، ولنا في التاريخ الإسلامي القديم والمعاصر عدة شهود وقرائن على ذلك.
يفرض طرق باب هذه الإشكالية الفلسفية البالغة الأهمية توفر عُدة معرفية ومنهجية بغية فهم فكر العامري كمفكر استثنائي، وعليه نتساءل: كيف استفاد العامري من إبستيمية عصره؟ إلى أي حد استطاع العامري إقامة حوار بين الأديان المذكورة في نصه "الإعلام بمناقب الإسلام"؟ ما نوعية المنهج المعتمد في نصه؟
أولاً: العامري وإبستيمية عصره[3]
إذا كان البحث شاقا في تتبع تلابيب وخيوط فكر المفكر والفيلسوف الأوّل في الثقافة الإسلاميّة، فإنّ الأمر يزداد صعوبة عندما نريد البحث في الفلاسفة الثوّاني؛ أي المفكرون الذين لم تعترف بهم الثقافة الرسمية، والعالِمة، لكن منهجيات علوم الإنسان الجديدة، قدّمت لنا هذه الخدمة، المتمثلة في إعادة قراءة الفكر الإنسانيّ في ضوء ثقافة الهامش، وليس في ضوء ثقافة المركز، وهذه المُهمة التي جعلها أركون نصب عينيه؛ أي اتباع ما أسماه بـ "المنهج السلبي" الذي يُعيد قراءة اللاّمفكّر فيه والمستحيل التفكير فيه، في الثقافة الإسلامية. وبهذا يكون قد اكتمل مربع كتابة تاريخ كلي أو شامل للفكر الإسلامي.
إن قراءتنا لمسألة الحوار بين الأديان الستة، كمسألة مركزية في كتاب العامري؛ "الإعلام بمناقب الإسلام"، ستكون في ضوء منجزات العلوم الإنسانية الحديثة، مستعينين في ذلك بقراءة محمد أركون لفكر العامري، حيث كتب دراستين؛ الأولى موسومة بـ "معركة السعادة حسب العامري"[4]، والثانية موسومة بـ «اللوغوس المركزي والحقيقة الدينية في الفكر الإسلامي: من خلال كتاب الإعلام بمناقب الإسلام لأبي الحسن العامري"[5]. كما وجدنا من الباحثين من يتحدث عن "التكامل المعرفي عند أبي الحسن العامري"[6].
نرى من المفيد جدًّا، أن نبدأ الحديث عن القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، حيث شكّل أوج قوة الفكر الإسلاميّ الكلاسيكي؛ إذْ نجد أبا الحسن محمد بن يوسف العامري (300 هـ/912م -27 شوال 381هـ/991م) واحد من كبار فلاسفة القرن الرابع الهجري. ولد في نيسابور عام 912م، وتعلّم فيها العلوم الدينية، ثم انتقل إلى بلخ، حيث تتلمذ على يد أبو زيد البلخي[7] وتعلّم منه الفلسفة. وبعد وفاة معلمه[8]، انتقل إلى چاچ (طشقند)، حيث علّم الفقه وأصول الدّين والمنطق. ثم انتقل إلى بخارى، حيث كتب كتابه الشهير "السعادة والإسعاد"، ثم انتقل إلى نيسابور وعاش من 342-352، ثم انتقل إلى الرّي، حيث أقام خمس سنوات. إنه وليد إبستيمية عصره، وتنقلّ كغيره من المفكرين بين عواصم المعرفة في العالم الإسلامي بحثا عن المعرفة. هكذا» قضى العامري حياة حافلة بالعلم والتدريس والتأليف والترحال العلمي بين الحواضر الثقافية الكبرى للعالم الإسلامي حينذاك، ولا سيّما بغداد والريّ وبخارى"[9]. ودرس العامري بخرسان، ونبغ في العلوم الفلسفية، حتى صار يُعرف بـ: "الفيلسوف النيسابوري Le Philosophe de Nishapur".
يعود الفضل إلى "المؤرخ الإيراني مجتبى مينوفي[10] (Mojtaba Minovi)، في التعريف بأبي الحسن العامري، عندما نشر سنة 1957، في مجلة كلية الآداب طهران، بيبليوغرافيا حول العامري"[11]، وهو ما سهلّ الأمر على مستشرقين اشتغلوا على العامري، مثل: الدراسة المتميزة[12] التي قام بها فرانز روزنتال (Franz Rosenthal)، الدولة والديّن حسب أبو الحسن العامري، على اعتبار أن إشكالية التوفيق بين الدين والدولة من بين المسائل التي تعرّض لها مفكرو الإسلام، بنوع من الجُرأة، خاصة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي.
نجد العامري يصف عصره، من ناحية الفكر بأنه فكر إنساني؛ أي "ثقافة عابرة للحدود"، لم يكن المجتمع المسلم منغلقاً على ذاته، وإنّما كان منفتحاً على ثقافات عدّة؛ كالثقافة اليونانية، والفارسية، والهندية، فاعتكف عليها المسلمون وترجموها، خاصة ما هو مفيد منها المجتمع؛ كالطب، والفلسفة، والأخلاق (الأخلاق النيقوماخية لأرسطو). فكان هذا التلاقح الثقافي شاهدا على حركية الترجمة، فتعدد المجتمع الثقافي دليل على تنوّعه وغناه. وعندما يؤمن الفيلسوف -العامري- بمثل هذه الموقف الإنسانية يكون عرضة الاتهام بالكفر والإلحاد، كما اتهم أستاذيه الكندي والبلخي من قبله[13].
يبقى القرن الرابع الهجري متميّزا؛ لأنّه عرف نقاشاً حول أضداد مفهومية من قبيل؛ اللوغوس/ الميتوس، والنقل/ العقل، الخير/ الشر، ظاهر/ باطن، جوهر/ عرض ...إلخ. وهي مفاهيم وافدة من بيئة يونانية، غريبة عن البيئة الإسلامية، ممّا كان عليهم توطينها، وغرسها في تربة فكرية متديّنة؛ إذْ الفيلسوف يصبح عرضة الاتهام بالكفر والزندقة، نذكر على سبيل المثال نكبة ابن رشد[14]. وفي هذا الجو المشحون طرحت أكبر المسائل جُرأة في تاريخ الإسلام. إنّها مسألة "خلق القرآن"؛ وبهذا المنع "خسر الفكر الإسلامي كثيراً عندما أخرس صوت المعتزلة، وكفرّ أطروحتهم الخاصة بالقرآن. نعم، لقد خسر عندما أغلق بعنف مُباغت تلك المناقشة الحاسمة الدائرة حول القرآن المخلوق، وقد أغلقها بقرار سلطوي صادر من فوق؛ أي من الخليفة القادر بالله شخصيًّا، كان ذلك سنة 432هـ/ 1041م"[15].
اعترف أهل الحِكمة لأبي الحسن العامري بسعته المعرفية، واتصافه بالحكمة، وشغفه بالمعرفة جعله يتنقل بين المصائر بحثا عنها، حيث نجد صاحب "الملل والنحل"، خصص الفصل الرابع من كتابه لما أسماهم، المتأخرون من فلاسفة الإسلام، والعامري واحد من هؤلاء، وقدمه كعالم بالمنطق والفلسفة اليونانية[16]. أمّا التوحيدي تحدث عن العامري في المقابسة العشرون، والتي عنونها ـ «في أن النظر في حال النفس بعد الموت مبني على الظن والوهم"، على أن أبي الحسن العامري كان ذا حظ وافر من الحِكمة[17]. وفي كتابه "الإمتاع والمؤانسة" تحدث عنه في "الليلة السادسة عشرة"، وطريقة بناء الكتاب على شكل "مجموع مُسَامَرات في فنون شتى"، "كُنتَ حكيتَ لي أن العامري صنّف كتاباً عنونه (بإنقاذ البشر من الجبر والقدر) فكيف هذا الكتاب؟ وهو كتاب نفيس، وطريقة الرجل قويمة"[18].
هكذا يبقى السؤال مشروعاً هل كُتبَ كتاب: "الإعلام بمناقب الإسلام" تحت الطلب؟ وهذه أيضاً كانت إحدى سِمات القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، كان تقرّب الحُكماء والأدباء والفنانين من الملوك والعُمداء شيء جاري به العمل، وهذا ما حصل مع العامري، حيث يقول: "ووجدت الشيخ الفاضل الرئيس أبا نصر[19]، بلّغه الله من المحامد غاية الأمنية، (...) وعلمتُ أنّه لا تحفة عنده أجلُّ موقعاً، وأشرفُ محلاً، من الإيضاح لفضيلة الملة الحنفية"[20]. هكذا نتأذى إلى القول، إنّ العامري كتب الكتاب رغبة منه في التقرب من الوزير، في رفع "القلق" والإيضاح لفضيلة وسماحة الإسلام.
ثانيا: الدينُ والمنهجُ عند أبي الحسن العامري
لعلّ التساؤل الذي دفعنا للبحث في مسألة الحوار بين الأديان الستة، كيف أجرى العامري حواراً بين هذه الأديان في ضوء المعادلة الآتية: الإسلام الحقيقة المثلى والعليا؟ وكأنّه منذ البداية يقرّر حقيقة سابقة جاهزة، ويريد إثباتها، وهذه المنهجية تبقى بِنتُ زمانها. ماذا عن تعامل المنهجية الجديدة في العلوم الإنسانية الاجتماعية مع الدين. بالعودة لكتاب "إميل دوركهايم" الموسوم بـ "الأشكال الأولية للحياة الدينية"، نجده يضع شرطًا منهجيًا على عالِم الاجتماع أو غيره الامتثال له؛ أي "التخلّص من الأحكام المسبقة، ودراسة جميع الأديان على قدم المساواة، وخاصة الأديان البدائية"[21]. وفق هذا الشرط يمكننا الكشف عن الانقلاب المنهجي الذي عرفته العلوم الإنسانية، سواء على مستوى منهجية علم الأديان المقارن، أو المنهجية السوسيولوجية أو علم الإناسة، هذه المناهج كشفت عن ضعف وعِوَز المنهجية التقليدية كتلك التي طبقها العامري في نصه، "الإعلام بمناقب الإسلام"، نجد الشرطين معاً غائبين؛ نقصد الأحكام المسبقة، لم يتغلب على الجانب الذاتي، ليحقق شرط المقارنة السليمة، وهي المنهجية المتبعة في نصه، ثم لم يتعامل بنفس القدر من المساواة بين الأديان، عندما نظر إلى الإسلام كحقيقة مثلى وعليا. ونقدنا هذا لا ينقص من قيمة العامري؛ إنه "فيلسوف بارع"[22]، وأكثر موسوعية من بين مفكري العصر الوسيط.
وعلى ذلك يمكننا القول، إنّ العامري طرح موضوعًا في غاية الأهميّة يتعلق بمقارنة الأديان، بناء على الأديان المذكورة في الآية التالية: "إنّ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إنّ الله يفصل بينهم يوم القيامة" (الحج 22:17). أي أنّه يُقارن بين الأديان الستة التالية، وهي: الإسلام، واليهودية، والنصرانية، ودين الصابئة، ودين المجوس (الزرادشتية)، والشرك (عبادة الأصنام). والهدف من المقارنة هو "الإيضاح لفضيلة الملة الحنيفية على سائر الملل"[23].
نشهد تقسيما للأديان عند الشهرستاني قريب جدا من الآية التي أوّلها العامري، غير أن صاحب "الملل والنحل"، تحدث عن أهل الملل، وأهل الأهواء والنحل؛ "فأرباب الديانات مطلقاً مثل المجوس، واليهود، والنصارى، والمسلمين. وأهل الأهواء والآراء مثل الفلاسفة، والدّهرية، والصابئة، وعبدة الكواكب والأوثان، والبراهمة"[24]. ومن أجل تبيان تميّز الدّين الحنيف، أي الإسلام، لجأ الشهرستاني كغيره، من المسلمين إلى حديث النبي[25]، الذي يُفسر افتراق أهل الأديان إلى شيّع؛ "فافترقت المجوس على سبعين فرقة. واليهود على إحدى وسبعين فرقة. والنصارى على اثنين وسبعين فرقة. والمسلمون على ثلاثٍ وسبعين فرقة. والناجية أبداً من الفرق، واحدة"[26].
في ضوء النصين السابقين يمكن القول، إن التاريخ الإسلاميّ بني على نقل التعدد إلى الوحدة، وهو مبدأ يوناني قديم، قال به الفلاسفة ما قبل سقراط، وفي هذا الحديث نجد هذا المبدأ، هناك تعدد للفرق والأديان، هذا التعدد عليه أن يحقق شرط الذوبان في الوحدة، وهو الأمر الذي يبدو في نظرنا صعب التحقق، واستحالة الإمكان؛ لأن كل فرقة تدعي هي الحقيقة والباقي بهتان وزور، وهذا الحديث انحرف عن مقاصده، وصار اليوم يُشهّر ضد كل من خالف عقيدة الحاكم، الآمر والناهي، يتهم بأنه ليس له من رسول الله شيء؛ لأنه لم يتبع طريقه، في حين المالك للسطلة والقوة، هو من يمثل نهج النبي، وصُحْبَتِه.
ثم لا ينبغي أن يفوتنا، الإشارة إلى شرط المقارنة عند العامري، يقوم على ما يسميه "الأشكال المتجانسة" في الأديان: أي يقارن الأصل بالأصل، والمهم بالمهم. فمن الخطأ وعدم الإنصاف مقارنة الأصل بالفرع، أو مقارنة جانب مهم دين ما بجانب أقل أهمية في دين آخر.[27] إنه يقارن العامري العقائد بالعقائد، والعبادات بالعبادات، ويقارن في كل منها الأصول بالأصول، والفرائض بالفرائض، أي لا يقارن الأصل بالفرع، ولا الفريضة بالنافلة.
يحدد العامري أربعة أقسام عليها مدار المقارنة بين الأديان التوحيدية وغيرها: "أعني الأركان الاعتقادية، والأركان العبادية، والأركان المعامَلية، والأركان المزاجرية"[28].
على المستوى الاعتقادي: إن صاحب "الإعلام" عقد المقارنة بين الأديان الستة، بقوله: "أما الاعتقادات فمدارها عند ذوي الأديان الستة لن يكون إلاّ على أركان خمسة، وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الأخر. قال تعالى: "ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر فقد ضلّ ضلالاً بعيداً"[29].
على مستوى العبادة: يقول؛ "وأما العبادات فمدارها أيضاً عند ذوي الأديان الستة لن يكون إلاّ على أركان خمسة، وهي: العبادة النفسانية كالصلاة، والعبادة البدنية كالصيام، والعبادة المالية كالزكاة، والعبادة الملكية كالجهاد، والعبادة المشتركة من هذه الأربعة كالحج"[30].
على مستوى المعاملات: يقول؛ "وأما المعاملات فمدارها أيضاً عند ذوي الأديان الستة إلاّ على أركان خمسة وهي: المعلومات كالبيع والإجارة، والمناكحات كالتزوج والطلاق، والمخصمات كالدعاوى والبيّنات، والأمانات كالودائع والعواري، والتركات كالوصايا والمواريث"[31].
على مستوى المزاجر: يقول؛ "وأما المزاجر فمدارها أيضاً عند ذوي الأديان الستة لن يكون إلاّ على أركان خمسة وهي: مزجرة قتل النفس كالقَوَد والدّية، ومزجرة أخذ المال كالقطع والصلب، ومزجرة هتك الستر كالجلد والرجم، ومزجرة ثلب العرض كالجلد مع التفسيق، ومزجرة خلع البيضة كالقتل عن الردّة"[32].
وإذا كان من الضروري التعليق على هذه المقارنات، فسنقول إنّ العامري في منهجه المقارن انتصر إلى العقل (علي أمليل)، حيث حدد شروطا منها؛ مقارنة الأصل بالأصل والفرع بالفرع من هذه الأديان، أي على من يهب نفسه لهذه الحِرفة – المقارنة – أن يُحكّم عقله في التمييز بين الأشرف والمشروف، ليتوصل به إلى درجة المستبصرين. يرفض العامري التحامل أو الإقصاء غير العلمي لأي دين بداعي أيديولوجي، فروح المنهج تقتضي من الباحث التزام بالإتيان بالحجج الكافية لإثبات والنفي عندما يريد إبطال أي دعوى. هكذا، "ف–العامري- في هذا الكتاب يعالج الإسلام –ويقارنه بغيره من الأديان-ليس كمفهوم عقائدي ونظام اجتماعي وسياسي، وخلقي فحسب، بل كمفهوم ثقافي كذلك"[33]. ويضيف الباحث أحمد عبد الحميد غراب، "أن النظرة الثاقبة إلى الإسلام كثقافة لا نجدها عند كثيرين من المفكرين المسلمين"[34].
نستشف من هذا القول، أنّ العامري كان وريث المدرسة العقلية؛ خاصة في صيغتها الأولى مع الكندي، أو فيما بعد مع ابن رشد (العامري توفي قبل ابن رشد)، التي تنظر إلى علاقة علوم الحِكمة وعلوم الشريعة لا تعارض بينها، وأن الفلسفة بعلومها وفروعها مؤسسة على العقل، والدّين الحق يدعونا إلى إعْمَال البَصِيرة، والتعقّل في الأمور الدينية. إذْ، ابن رشد في "فصل المقال" جعل من "الفلسفة الأخت الشقيقة للشريعة"، والحق بالبرهان لا يُعارض الحق، بل يوافقه ويشهد له. بل من أحسن هذه العلوم الحكمية قد تكون له خير قنديل يُنير طريقه للدلالة على وجود الصانع، والخالق.
يشترط العامري في منهجه القائم على التقابل والمقارنة بين الأديان على ركيزتين: "أحدهما ألاّ يُوقع المُقايَسَة إلاّ بين الأشكال المتجانسة، أعني ألاّ يعمد إلى أشرف (شرف) ما في هذا فيقيسَه بأرذل ما في صاحبه، ويعمَدَ إلى أصل من أصول هذا فيقابله بفرع من فروع ذاك. وألاّ يعمَدَ إلى خلّةٍ موصوفة في فرقة من الفرق، غير مستفيضة في كافّتها، فينسبها إلى جملة طبقاتها"[35].
وفي مسألة الكتب السماوية، وصفا إياها بأنها كلها جليلة القدر، موضحا "الذي استجمعه القرآن من الفضيلة في صورة الخطاب، ومن الفضيلة في نظم الألفاظ، ومن الفضيلة في تأليف المعاني؛ هو شيء بايَن به الكتب"[36]. يُبين العامري قيمة القرآن بين الكتب السماوية الأخرى من خلال صورة الخطاب، فهو خطاب خارج عن ملِك مقتدر لخوله وعبيده. ثم نظم الألفاظ؛ فهو خطاب رجل حكيم، أنبأ عن حكمته بألفاظه وعباراته. ثم تأليف المعاني؛ إنه خطاب غير مشابه لما ابتذله البشر فيما بينهم، من تأليف المعاني قد يجتمع في الجزء منه الشبيه بما هو موجود في الكل. وهذا ما لم يتحقق في نظر العامري في الكتب الأُخر. يستشهد بقوله تعالى: "وإنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه" (صورة فصلت 41، 42).
"إن أحقَّ الأديان بطول البقاء ما وُجدت أحواله متوسطة بين الشدة واللين، ليجدَ كل من ذوي الطبائع المختلفة ما يصلح به حاله في معاده ومعاشه، ويستجمع له منه خير دنياه وآخرته"[37]. فمن خلال قول العامري نستشف انتصاره للملة الحنيفية؛ أي الإسلام نظراً لتوسطه بين الشدة والليّن، أي دين يقوم على الوسطية والاعتدال، وهذا القول نلمسه عند أغلب الفلاسفة المسلمين، مثلا ابن خلدون في حديث عن طبيعة السلطة السياسية يدعو الحاكم أو السلطان إلى إتباع الوسطية والاعتدال.
ويضيف قوله؛ "كل دين لم يوجد على هذه الصفة، بل أُسسَ على مثال يعود بهلاك الحرث والنسل، فمن المحال أن يسمى هيناً فاضلاً"[38]. يقصد العامري بهذه الصفة، أي على أي دين من الأديان أن يتصف بالوسطية واللين، ويبتعد عن التشدد وغلظة الطبائع، ولكي يكون قوله به معنى قدم مثالا عن رهبانية النصارى، حيث يهجرون المناكح، وينفردون في الصوامع، ويتركون طيبات الرزق. وهو أمر ينطبق على طبقة الصديقين؛ "وهي إحدى طبقات المانوية؛ وكان يحرم عليهم مباشرة المهن، والسعي وراء المال، وأكل لحم الحيوان، وطبخ الخضر، وشرب الخمر، والزواج، وألا يملكوا إلاّ غذاء يوم واحد، وكساء سنة واحدة"[39]. ويعلق بنوع من المفاضلة بين الإسلام والأديان الأخرى؛ كدين النصارى مثلا، أو بصيغة أوضح، كيف يفهم الإسلام من طرف الفقهاء وكيف يفهم الدين من طرف الرهابنة، فالإسلام لا يحرم على الفقيه المتع، من قبيل الزواج، والبيع والشراء، في حين الرهبان في نظر العامري يلازمون "الأصول الخمسة، التي هي عندهم: الصدق، والطهر، والراحة، والقدس، والمسكنة، دون غيرها من حركات العمارة"[40]. أيضا يقدم العامري مثالاَ يقارن به الطقوس، ومفهوم الطقس في دلالته السوسيولوجية، خاصة سوسيولوجيا الأديان أغنت حقل الدراسات الدينية، حيث أصبح للطقس، والرمز، والأسطورة معنى. وزمن العامري لم يكن يسمح لكي يقرأ طقوس الهند على أنها ممارسات تعبدية، يقترب من خلالها الإنسان إلى ربه، أو معبوده، وإنما رأى فيها طقوساً غير أخلاقية، حيث رأى فيها تعذيبا وهلاك للأنفس، يقول "وما انتهجه نُساك الهند من إحراق الأجساد، وتغريقها في الماء، والتردي من الجبال، واهلاكها بالضم (أي قبض الجسد عن الطعام)، والأزم (الإمساك والحمية)"[41].
دليل العامري على أن هذه الممارسات التعبّدية غير مقبولة، هو استناده إلى القرآن والآيات التي تحفظ النفس، حيث إن الله تعالى لم يحمل عباده على إهلاك أنفسهم، وإنّما دعا إلى حفظ النفس، وهداهم لصنوف العقاقير النباتية ليستشفوا بها من الآلام المُعترية.
"أما العبادة النفسانية – وهي الصلاة المشتملة على ذكر الله تعالى، وإخلاص النفس له بالخضوع والخشوع – فشيء تشترك فيه الأديان. غير أن ما يستعمله أهل الإسلام منها هو الأفضل؛ لوجهين: أحدهما الكميّة، والآخر الكيفية"[42]. يقيم العامري مقارنة بين الأديان على مستوى العبادة النفسانية؛ أي الصلاة، معترفاً بأنّ الأديان جميعها تشترك فيها، غير أنه جعل صلاة أهل الإسلام أفضل، وذلك لوجهين؛ لم تتصف بالكثرة والإسراف مثل صلوات رهبانية النصارى، ولم تتصف بالقلة في رتبة التقصير مثل صلوات المجوس. بل صلاة أهل الإسلام توسطت بين الكثرة والقلة أو التقصير، حتى يتسع للمتدين بها التصرف في أسباب المعاش، مع قضاء حق التعبد.
"وأما العبادة البدنية – وهي الصيام المشتمل على صورة التقلّد للأمانة في أشياء ينجذب إليها الطبع، والصبر على حفظها مع دواعي النفس إلى الإخلال بها – فشيء تشترك فيه الأديان الستة"[43]. يستند العامري في مقارنته بين الأديان الستة في العبادة البدنية؛ أي الصيام، إلى مقتضى العقل، منتصراً إلى عبادة أهل الإسلام، وذلك لوجهين؛ من جهة الكمية: أن صوم أهل الإسلام لم يطل فيملّ، كصوم رهابين النصارى، والصديقين من الثنوية وعبدة الأصنام، وفي نفس الوقت لم يتصف بالتقصير كصوم المجوس، إذ ليس هو بصيان على الحقيقة، (هذا الحكم للعامري). أمّا من جهة الكيفية: فجميع الأديان حرمت تناول اللذات الحيوانية، وعزفت عن الشهوات الجسدية، لكن منها من بالغ مثل دين النصارى والثنوية الذين يعتقدون منه تحريم اللحمان، ويسلطون على أنفسهم النحول. أما اليهود، فصومهم في نظر العامري متفرق في أيام السنة على صورة لا يوجد لها نظام مستقر، على خلاف دين أهل الإسلام الذين يمتد لثلاثين يوماً؛ أي شهراً كاملاً.
"وأما العبادة المالية – وهي الزكاة المشتملة على التسمّح بالأموال الثلاثة: أعني الحيوانية والنباتية والمعدنية – فشيء تشترك فيه الأديان كلها ما خلا النصرانية؛ فإنها أسست على التأله المحض"[44]. كل الأديان في نظر العامري تشترك في العبادة المالية باستثناء النصرانية، التي تقوم على مبدأ التأله المحض، أي يهب المرء نفسه لله. وأما الإسلام، فهو يفوق الأديان كلها في نظر العامري؛ لأنه جلها – العبادة المالية – فريضة واجبة، منزلتها إلى جانب الصلوات المكتوبة.
"وأما العبادة الملكية – وهي الجهاد المشتمل على حراسة الملة – فهو شيء تشترك فيه الأديان الستة"[45].
"وأما العبادة المشتركة – التي هي النسك الأعظم – فقد اشتملت على عبادة نفسانية، وعبادة بدنبة، وعبادة مالية، وعبادة ملكية"[46]. يقصد العبادة المشتركة، الحج.
ومن باب البيان، نقول إن العامري كان يهدف من مقارناته إلى تفنيد وتكذيب بعض الشُبهات التي أثيرت حول الإسلام. وهذه الشُبهات كثيرة، لكنه يرى أربعاً منها تستحق الوقوف عنها؛ وهي: شبهة انتشار الإسلام بالسيف، وشبهة فُرقة المسلمين، وشُبهة البيان القرآني، وأخيراً البشارة بالرسول (ص) في التوراة والإنجيل. والعامري تبقى صوت حريص على المرافعة على الإسلام، كدين "يمثل الحقيقة العليا، أي الملة الحنفية"[47].
خاتمة
ختاماً يمكن القول، إنّ العامري ابن عصره ونجد في فكره اليوم ما هو أنسب لنا على مستوى المحاجة والنقد، أو من حيث طلب المعرفة والجهاد النفسي في بلوغها في زمن تعلوا فيه أصوات التكفير. هكذا نكون قد خدمنا تراثنا الإسلامي عبر التهوية من الداخل، وفتح الأضابير التي أغلقت بإحكام، من قبل السلطة الرسمية والثقافة العالِمة، وذلك من خلال تطبيق أحدث المنهجيات الحديثة في العلوم الإنسانية والاجتماعية. وتجاوز قدر الإمكان نواقص المنهجية التي وسمت الخطاب الإسلامي التقليدي، الذي ظلّ وفيًّا للقول المشهور: "ليس في الإمكان أبدع مما كان"، بل نتجرأ ونقول نعم لنا حق في الإبداع.
قائمة المصادر والمراجع
*- العربية
- القرآن الكريم.
- العامري، أبي الحسن، الإعلام بمناقب الإسلام، تحقيق الدكتور أحمد عبد الحميد غراب، مؤسسة دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام، الرياض، الطبعة الأولى، 1988
- أركون، محمد، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ترجمة: هاشم صالح، مركز الإنماء القومي ـ بيروت، المركز الثقافي العربي ـ الدار البيضاء، الطبعة الثانية 1996
- أركون، محمد، العلمنة والدين: الإسلام، المسيحية، الغرب، ترجمة، هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، بحوث اجتماعية عدد 04، الطبعة الثالثة، سنة 1996
- أركون محمد، الفكر الإسلامي قراءة علمية، ترجمة: هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 1996
- أركون محمد، قراءات في القرآن، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، الطبعة العربية الأولى، 2017
- أركون، محمد، حين يستيقظ الإسلام، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، الطبعة الأولى، 2019
- المراكشي، عبد الواحد، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. 2، 2005
- الجابري، عابد محمد، المثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط. 2
- التوحيدي، أبو حيان، الإمتاع والمؤانسة، راجعه هيثم خليفة الطعيمي، المكتبة العصرية، بيروت، ج. 1، 2011
- دوركهايم، إميل، الأشكال الأولية للحياة الدينية: المنظومة الطوطمية في أستراليا، ترجمة رندة بعث، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، ط. 1، يوليو 2019
- الشهرستاني، أحمد، الملل والنحل، تحقيق علي مهنا وعلي حسن، دار المعرفة، بيروت، ج. 1، ط. 3، 1993
- الفجّاري، مختار، نقد العقل الإسلامي عند أركون، دار الطليعة – بيروت، الطبعة الأولى، مايو 2005
- حرب، علي، نقد النص، (النص والحقيقية – 1)، المركز الثقافي العربي، البيضاء، الطبعة الرابعة، 2005
- حمد عبد الحميد غراب، مفهوم الثقافة الإسلامية عند أبي الحسن العامري، المجلة، ع. 126، يونيو 1967.
- بالي، حسين، التكامل المعرفي عند أبي الحسن العامري وأهميته في مدّ الجسور بين العلوم، مجلة الجامعة القاسمية، المجلد 2، العدد 1، يونيو 2022م.
*- مراجع أجنبية
- Arkoun, Mohammed, la conquête du bonheur selon Abu-I-Hasan Al-Amiri, Studia Islamica, No, 22, (1965).
- Arkoun, Mohammed, Logocentrisme et vérité religieuse dans la pensée islamique: d'après al-I'lām bi-manāqib al-Islām d'al-'Âmirî, Studia Islamica, No, 35, (1972).
- Rosenthal, Franz, state and religion according to Abu L-Hasan Al-Amiri, Islamic Quaterly, London, Vol III, N 1, (Apr 1956).
[1] - محمد أركون، العلمنة والدين: الإسلام، المسيحية، الغرب، ترجمة، هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، لبنان، بحوث اجتماعية عدد 04، الطبعة الثالثة، سنة 1996، ص .54
[2] - أكسل هونيت Axel Honneth، فيلسوف ألماني، ويعتبر من الجيل الثالث لمدرسة فرانكفورت، صاحب نظرية الاعتراف، وتلميذ مباشر لـ"يورغن هابرماس".
[3] - يستعمل محمد أركون مصطلح: "المنظومة الفكرية؛ أي (الابستمي Epistème) لدلالة على الشروط الفكرية التي كانت تحكم العصور الوسطى وهي مختلفة عن المنظومة الفكرية في العصر الحديث". يُنظر: محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمية، ترجمة: هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، الطبعة الثانية، ص 8
[4] - Mohammed Arkoun, la conquête du bonheur selon Abu-I-Hasan Al-Amiri, Studia Islamica, No, 22, (1965).
[5] - Mohammed Arkoun, Logocentrisme et vérité religieuse dans la pensée islamique: d'après al-I'lām bi-manāqib al-Islām d'al-'Âmirî, Studia Islamica, No, 35, (1972).
[6] - حسين بالي، التكامل المعرفي عند أبي الحسن العامري وأهميته في مدّ الجسور بين العلوم، مجلة الجامعة القاسمية، المجلد 2، العدد 1، يونيو 2022م.
[7]- أبو زيد البلخي (235 – 322 هـ / 849 -934 م)، أحد أكبر حكماء الإسلام، البارزين في الأدب والفقه والفلسفة، مدرسته الفكرية تابعة للفيلسوف الكندي، ولد في إحدى قرى بلخ، اشتهر بالجغرافيا. يُنظر: أبي الحسن العامري: الإعلام بمناقب الإسلام، تحقيق الدكتور أحمد عبد الحميد غراب، مؤسسة دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام، الرياض، الطبعة الأولى، 1988، ص 7
[8] - "وإذا كانت معظم أعمال البلخلي لم تصل إلينا، فإننا نستطيع أن نثق فيما روته عنه المراجع العربية من أنه كان يجمع بين علوم الحكمة وعلوم الشريعة، وأنه كان فيلسوفا وأديباً في نفس الوقت". يُنظر: أحمد عبد الحميد غراب، مفهوم الثقافة الإسلامية عند أبي الحسن العامري، المجلة، ع. 126، يونيو 1967، ص 11
[9] - أبي الحسن العامري: الإعلام بمناقب الإسلام، ص 7
[10] - مجتبى مينوفي (Mojtaba Minovi): مؤرخ إيراني معاصر، وأستاذ بجامعة طهران.
[11] - Mohammed Arkoun, la conquête du bonheur selon Abu-I-Hasan Al-Amiri,Op. cit, p 57
[12] - Franz Rosenthal, state and religion according to Abu L-Hasan Al-Amiri, Islamic Quaterly, London, Vol III, N 1, (Apr 1956).
[13] - أحمد عبد الحميد غراب، مفهوم الثقافة الإسلامية عند أبي الحسن العامري، مرجع سابق، ص 15
[14] - تعددت الروايات بخصوص نكبة ابن رشد، من بينها نجد صاحب "المعجب" عبد الواحد المراكشي يقدم رواية بها سببان: جليّ زخفيّ؛ لما شرح كتاب "الحيوان لأرسطو" قال أمورا في غاية الجرأة، فكان فرصة لمنافسيه في المعرفة، يقول المراكشي: "إن قوما ممن يناوئه من أهل قرطبة ويدعي معه الكفاءة في البيت وشرفِ السلف، سعوا به عند أبي يوسف ..." انظر: عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. 2، 2005، ص 218. أما الجابري فنجد له رأي أخر، يجعل سبب نكبة ابن رشد، ممثل في سبب سياسي لما تحدث عن "وحدانية التسلط" و"قيام ابن رشد لعلاقة بينه وبين أخ الخليفة أبي يحي والي قرطبة". يُنظر: محمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط. 2، ص 131
[15] - محمد أركون، قراءات في القرآن، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، الطبعة العربية الأولى، 2017، ص 19
[16] - أحمد الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق علي مهنا وعلي حسن، دار المعرفة، بيروت، ج. 1، ط. 3، 1993، ص 490
[17] - أبو حيان التوحيدي، المقابسات، ص 28. (نسخة الكترونية).
[18] - أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، راجعه هيثم خليفة الطعيمي، المكتبة العصرية، بيروت، ج. 1، 2011، ص 155.
[19] - لعله أبو نصر بن أبي زيد وزير السامانيين. انظر: أبي الحسن العامري: الإعلام بمناقب الإسلام، مصدر سابق، هامش ص 70
[20] - المصدر نفسه، ص 70
[21] - إميل دوركهايم، الأشكال الأولية للحياة الدينية: المنظومة الطوطمية في أستراليا، ترجمة رندة بعث، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، ط. 1، يوليو 2019، ص 20
[22] - Mohammed Arkoun, la conquête du bonheur selon Abu-I-Hasan Al-Amiri, op. cit, p 60
[23] - أبي الحسن العامري: الإعلام بمناقب الإسلام، مصدر سابق، ص 24
[24] - الشهرستاني، الملل والنحل، مرجع سابق، ص 19
[25] - "وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتّي على ثلاثٍ وسبعين فرقة، الناجيةُ منها واحدة، والباقون هلكى. قيل: ومن الناجية؟ قال: أهل السنة والجماعة. قيل: وما السنة والجماعة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي". انظر: أحمد الشهرستاني، الملل والنحل، مرجع سابق، ص 20.
[26] - أحمد الشهرستاني، الملل والنحل، مرجع سابق، ص 19
[27] - أبي الحسن العامري: الإعلام بمناقب الإسلام، مصدر سابق، ص 23
[28] - المصدر نفسه، ص 122
[29] - المصدر نفسه، ص 122
[30] - المصدر نفسه، ص 122
[31] - المصدر نفسه، ص 123
[32] - المصدر نفسه، ص 123
[33] - أحمد عبد الحميد غراب، مفهوم الثقافة الإسلامية عند أبي الحسن العامري، مرجع سابق، ص 12
[34] - المرجع نفسه، ص 13
[35] - أبي الحسن العامري، الإعلام بمناقب الإسلام، ص 125
[36] - المصدر نفسه، ص 132
[37] - المصدر نفسه، ص 137
[38] - المصدر نفسه، ص 137
[39] - المصدر نفسه، انظر هامش الصفحة، 137
[40] - المصدر نفسه، ص 137
[41] - المصدر نفسه، ص 138
[42] - المصدر نفسه، ص 139
[43] - المصدر نفسه، ص 142
[44] - المصدر نفسه، ص 143
[45] - المصدر نفسه، ص 146
[46] - المصدر نفسه، ص 148
[47] - Mohammed Arkoun, logocentrisme et vérité religieuse dans la pensée islamique, op, cit, p 16