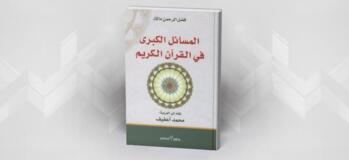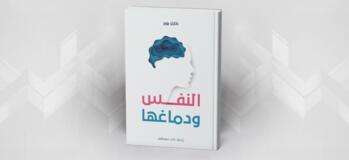الحس المشترك عند ابن سينا: شرط وحدة الوعي والإدراك
فئة : مقالات
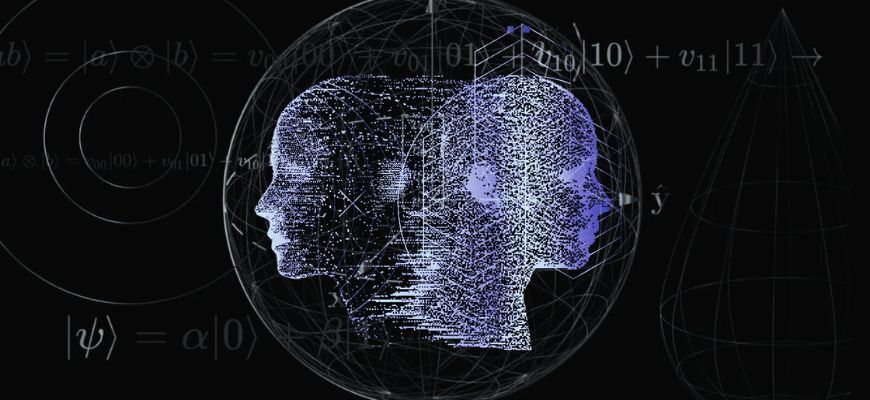
الحس المشترك عند ابن سينا: شرط وحدة الوعي والإدراك
حسن منصور
تحت إشراف: د. محمد البوغالي
شكّل الحسّ المشترك عند ابن سينا لحظة تأسيسية في نظرية الوعي والإدراك، ليس فقط بما هو قوّة باطنة ضمن منظومة النفس، بل بما هو بنية إبستمولوجية كونية تتيح إمكان الوعي ذاته. فالحواس الظاهرة، مهما بلغت دقّتها، لا تقدّم إلا معطيات متفرّقة، أشبه بشظايا إدراكية متناثرة. لكن النفس لا تدرك العالم في صورة شظايا، بل في وحدة متماسكة؛ أي نسقٍ من الصور الموحَّدة. هذا التحوّل لا يمكن تفسيره بآليات الحواس الظاهرة، بل يفترض قوّة أعمق، هي الحسّ المشترك، الذي يمثّل الشرط القبلي لتكوّن وعي وإدراك موحّد.
إنّ الحسّ المشترك عند ابن سينا لا يُفهم باعتباره وظيفة نفسية محدودة، بل بوصفه البنية الأولى التي تتكثّف فيها الصور الحسية الجزئية، لتتحول من تشتتٍ مبعثر إلى إدراك واحد متماسك. فهو يشكّل ما يمكن اعتباره أساس الوعي والإدراك؛ إذ يتيح للنفس أن تنتقل من مجرّد الانفعال بالمحسوس إلى إمكان المعرفة المنظّمة. ومن هذا المنظور، ينفتح الفكر السينوي على أفق فلسفي يستبق بعض النقاشات المعاصرة في الفينومينولوجيا وفلسفة العقل، ولا سيما تلك المتصلة بمسألة وحدة الشعور وكيفية اندماج المعطيات المتعددة في خبرة شعورية واحدة. فما الوظائف الأساسية التي يحددها ابن سينا للحس المشترك، وكيف يساهم في عملية الإدراك الحسي الموحد؟ وما الحجج العقلية التي يسوقها ابن سينا لإثبات وجود الحس المشترك، ولماذا يُعد في توحيد المعطيات الحسية في إدراك واحد؟
إن النفس مزودة بخمسة قوى هي الحواس الظاهرة (اللمس، الذوق، الشم، السمع، البصر)، تُدرك بها المحسوسات الخارجية المختلفة، لكن هذه الدرجة من المعرفة لا تكفي في امداد النفس بما تحتاج إليه من المادة اللازمة للقيام بوظيفة الإدراك (*) يقول ابن سينا: » الحواس الظاهرة ليس شيء منها يجمع بين إدراك اللون والرائحة واللين، وربما لقينا جسماً أصفر وأدركنا منه أنه عسل حلو طيب الرائحة سيَّال، ولم نذقه ولا شممناه ولا لمسناه. فبيّنٌ أن عندنا قوةً اجتمعت فيها إدراكات الحواس، وصارت جملتها عند صورة واحدة. ولولاها لما عرفنا أن الحلاوة مثلاً غير السوداء؛ إذ المميز بين شيئين هو الذي عرفهما جميعًا. وهذه القوة هي الموسومة بالحس المشترك وبالمتصورة، ولو كانت من الحواس الظاهرة لاقتصر سلطانها على حال اليقظة فقط؛ والمشاهدة تشهد بخلاف ذلك، فإن هذه القوة قد تفعل فعلها في حالتي النوم واليقظة جميعًا. [1]« يشير ابن سينا إلى أن الحواس الظاهرة لا تكفي لتكوين إدراك موحَّد، فكل حاسة تدرك نوعاً محدداً من المعلوم، لكن النفس تستطيع إدراك شيء واحد كالعسل في صفاته المختلفة (اللون، الطعم، الرائحة) بفضل قوة باطنة تُسمّى الحس المشترك. هذه القوة توحّد الصور الجزئية للحواس في إدراك واحد، وتشكّل شرط إمكان وحدة الوعي؛ إذ لا يمكن التمييز بين المدركات إلا بوجودها، وتظل فاعلة حتى في النوم، ممهّدة بذلك الطريق للخيال والعقل. مثال على هذا أن كل حاسة من الحواس الظاهرة تدرك محسوساتها الخاصة فقط، ولا تستطيع التمييز بينها وبين محسوسات الحواس الأخرى. فالبصر يدرك الألوان، لكنه لا يستطيع أن يميز بين الألوان والأصوات، لأن الأصوات يدركها السمع فقط ولا يدركها البصر.
إذن، من الضروري لكي تتم المعرفة ويحصل الغرض منها وهو اكتساب الكمال، اجتماع هذه المحسوسات المختلفة عند قوة واحدة تستطيع الحكم عليها والتمييز بينها.» هذه القوة تتصور باطلاً كاذبًا، وما لم تأخذه على هيئته من الحس. وهذه القوة هي المسماة بالمخيلة. [2]« ليس هذا فقط ضروريا لاكتساب المعرفة، ولكنه ضروريا أيضا لاستمرار الحياة؛ بمعنى الحياة متعذرة، إن لم يكن من الممكن التمييز بين المحسوسات المختلفة والمقارنة بينها.
يتنزل الخيال ضمن النسق الابستمولوجي لفلسفة ابن سينا، في إطار القوى الحسية الباطنية التي تُعدّ حلقة وسيطة بين الإدراك الحسي المباشر والتجريد العقلي الخالص، وتتصدر هذه القوى الحس المشترك، إذ يضطلع بوظيفة توحيد المدركات الحسية الظاهرة وتثبيتها في النفس، فيكون بذلك شرطاً أوليًّا لتكوين الصور الحسية. تلي ذلك الخيال أو المصوّرة، التي تحفظ الصور الجزئية بعد انقطاع الموضوع الخارجي، وتُعَدّ مستودعًا لصيغ المحسوسات، ثم تتدخل القوة المتخيلة -وتسمى أحياناً المفكرة- تقوم بتركيب تلك الصور وتفكيكها، فتُنتج بها صوراً جديدة تتجاوز حدود الواقع المُدرَك، وهو ما يمهد لعملية التخييل. أما الوهم، فيُدرك المعاني الجزئية الملازمة للمحسوسات كالعداوة أو الموّدة، دون أن تكون مدركة بالحس الظاهر. أخيراً تتولى القوة الحافظة حفظ هذه المعاني والصور لتستعيدها النفس عند الحاجة. وبهذا التراتب يتبوأ الخيال منزلة مفصلية في بنية الإدراك الإنساني؛ إذ يمثل المجال الذي تتداخل فيه الصور الحسية بالمفهوم، والمحسوس بالمجرد، في أفق تمهيدي للارتقاء المعرفي نحو العقل الفعال.
لا يخلو التراث الفلسفي منذ أرسطو من النقاش حول القوى الباطنة، ومن بينها ما يُسمى بالحس المشترك، وظيفته جمع المعطيات الواردة من الحواس الخارجية الخمسة، كذلك دراسة الفارابي لهذا المفهوم، لكن ابن سينا يحدد لهذه الملكة تحديداً دقيقاً، سواء من حيث موقعه في الدماغ ومن حيث دورها المعرفي في سلسلة الإدراك الباطن بالتعريف التالي: » الحس المشترك هي القوة المترتبة في التجويف الأول من الدماغ (*) تقبل بذاتها جميع صور المنطبعة في الحواس الخمس المتأدية إليه. [3]« أما بخصوص البرهنة على ضرورة وجوده، فيسوق ابن سينا جملةً من الحجج منها، أنه "لو لم يكن في الحيوان ما تجتمع صور المحسوسات لتعذرت عليه الحياة ولم يكن الشمُّ دالاّ لها على الطعم، ولم يكن الصوت دالاً إياها على العم، ولم تكن صورة الخشبة تذكّرها بصورة الألم حتى تهرب منه، فيجب لا محالة أن يكون لهذه الصور مجمع واحد من باطن ".[4] تأتي هذه الحجة بغية إقامة دليل على وجود الحس المشترك وجوداً فعليًّا، رغم أنه باطني غير مشاهد، لكن وظيفته تشابه وظيفة الحواس الظاهرة، وهي إدراك صور المحسوسات، وسنذكر حجج أخرى لابن سينا، لأن هناك شكوك حول وجود قوة خاصة غير الحواس الظاهرة تُدرك صور المحسوسات الخارجية، وقد يُظن كذلك أن وظائف الحس المشترك ليست إلا مجموع وظائف الحواس الظاهرة، وليست لها حاسة خاصة.
إن أرسطو يعدّ الحس المشترك ليس حسًّا خاصًّا له عضو خاص، ويبرهن على عدم وجود حاسة سادسة غير الحواس الخمس الظاهرة، وهو لا يعني بالحس المشترك حِسًّا خاصًّا له عضو كما يذهب ابن سينا، وإنما يعني به الطبيعة المشتركة بين الحواس الظاهرة؛ أي مجموع الحواس الظاهرة المتحدة، حيث تصبح كأنها حس واحد. فهو ينظر إلى القوة الحاسة أو النفس الحاسة بوصفها قوة واحدة تقوم بوظائف مختلفة، وتستخدم في ذلك الحواس الخمس الظاهرة.[5] يُفهم من هذا أنه إذا نظرنا إليها من حيث هي طبيعة واحدة فهي الحس المشترك عند أرسطو.
إذا صرح أرسطو أن القلب هو عضو الحس المشترك أو مركزه، فليس معنى ذلك أن الحس المشترك حس خاص ذو عضو خاص، وإنما معنى ذلك أن القلب عضو النفس الحاسة أو مركزها. ولكن للنفس الحاسة من حيث هي طبيعة واحدة وظائف خاصة غير الوظائف التي تقوم بها الحواس الظاهرة، وهي الوظائف التي ينسبها أرسطو إلى الحس المشترك.[6]
لكن نفهم مع ابن سينا أن الحواس الخمس شعب ومصادر للحس المشترك، و محركات له، ويصف الحس المشترك مبدأ النفس الحاسة في مجموعها مثل أرسطو، لكن يعدّه حسًّا خاصًّا له شخصية مستقلة عن الحواس الظاهرة من جهة، وعن مجموع النفس الحاسة من جهة أخرى.
عودةً إلى الحجج التي يسوقها ابن سينا على ضرورة وجود الحس المشترك بشكل مستقل: أولا، »إن المصاب بالدوار يخيَّل إليه أن كل شيء يدور أمام عينه. وليس الدوار أمراً عارضاً في المرئيات أو في العين، وإنما هو ينشأ عن حركة الروح في الدماغ. فقد يعرض لذلك الروح أن يدور فتتأثر بذلك قوة الإبصار الموجودة هناك فترى الأشياء كأنها تدور. [7]« هذا الدليل يوضح على وجود حس باطن مبصر غير الحس الظاهر. ثانياً، هي حينما نرى القطرة الساقطة خطاً مستقيماً والنقطة الدائرة بسرعة خطًّا مستديراً؛ وذلك على سبيل المشاهدة لا على سبيل التخيل أو التذكرّ، وكما هو معروف أن البصر ترتسم فيه صورة المقابل. والمقابل في كلتا هاتين الحالتين نقطة لا خط. والنقطة ترتسم في البصر عند وصولها إلى مكان ما تحدث بحسبه المقابلة بينهما، وتزول عند صورتها فيها حيناً، حيث تتصل فيها ارتسامات النقطة المتتالية على البصر بعضها ببعض، فتشاهد كأنها خط "إن هناك روحاً مؤدية للمبصر لا مدركة، وإلا لا فترق الإدراك مرة أخرى لافتراق العصبتين. وهذه المؤدّية هي من جوهر المبصر وتنفذ إلى الروح المصبوبة في الفضاء المقدم من الدماغ فتنطبع الصورة المبصرة مرة أخرى في تلك الروح الحاملة لقوة الحس المشترك، فيقبل الحس المشترك تلك الصورة وهو كمال الإبصار. [8]" أما بخصوص الحجة الثالثة، أن الحس المشترك يعرض لمن تعطل عنده فعل الحواس الظاهرة لسبب مَا أن يرى أشباحاً كاذبة، أو يسمع أصوتاً، دون أن يكون لهذه الأشباح أو الأصوات وجود حقيقي في الخارج. ليس السبب في ذلك إلا مثول هذه الأشباح أو الأصوات في قوة باطنة هي الحس المشترك.[9]أما الحجة الرابعة هي سبب الأحلام التي يراها النائم، فهي ارتسام الصور في إحدى القوى المدركة، حيث تظهر للنائم على شكل أحلام. وليس هذه القوة هي المصورة؛ لأنها لو كانت المصوّرة لكانت كل الصور المخزونة فيها ماثلة في النفس ومرئية في الأحلام، ولا يكون بعضها أخصّ من بعض في ذلك. فلابد إذن من مثول الصورة في قوة أخرى، وليس هذه القوة حساً ظاهراً؛ لأن الحواس الظاهرة متعطلة في النوم. فلابد أن تكون حسًّا باطنا. ولا يمكن أن تكون إلا المبدأ للحواس الظاهرة وهو الحس المشترك.[10]
أما بخصوص سؤال وظائف الحس المشترك، فأولها الجمع بين المحسوسات، على اعتبار أن الحس المشترك قوة تتوسط بين الحواس الظاهرة والقوى الباطنة، وشرط لوحدة التجربة الإدراكية الإنسانية. فالحواس الخمس، وإن كانت أدوات اتصال النفس بالعالم الخارجي، تظل قوة جزئية لا تدرك إلا نوعاً واحداً من الحواس؛ مثلاً العين لا تتجاوز اللون، والأذن لا تعي غير الصوت، والأنف لا يتخطى الرائحة. بيد أن الإنسان لا يختبر العالم متشظيًا، بل موحَّدًا. من هنا وجب وجود قوة جامعة تؤلّف بين هذه المعطيات وتربطها في إدراك واحد، هي الحس المشترك، يقول ابن سينا: » الحواس الظاهرة ليس شيءً منها يجمع بين إدراك اللون والرائحة واللين؛ وربما لقينا جسماً أصفر وأدركنا منه أنه عسل حلو طيب الرائحة سيَّال، ولم نذقه ولا شممناه ولا لمسناه. فيبنٌ أنه عندنا قوة اجتمعت فيها إدراكات الحواس الظاهرة. [11]« بهذا المعنى، لو لم يكن هناك جامع لما أمكن للنفس أن تحكم على شيء واحد من خلال تعدد المحسوسات، كالقول إن العسل أصفر وحلو في آنٍ واحد. » إن الحس المشترك مركز الحواس وإليه تتأدّى إليه المحسوسات كلها. [12]« يحيل مدلول هذا القول أن الإحساسات المختلفة تجتمع في الحس المشترك ويحدث عن ذلك الإدراك الحسي.
لكن كيف يحدث هذا الاجتماع وهذا التأليف بين الاحساسات؟ من الواضح أن ذلك يحدث طبقاً لعلاقات خاصة بينها، تعبر عنها قوانين تداعي الصور الذهنية؛ بمعنى أن النفس لا تتلقى الصور المحسوسة بشكل منفصل وعشوائي، بل وفق نظام داخلي دقيق تحكمه قوانين تداعي الصور*. هذا ما يعبر عنه ابن سينا بقوله: » لو لم يكن قد اجتمع عند الخيال من البهائم التي لا عقل لها المائلة بشهوتها إلى الحلاوة، مثلاً أن شيئًا صورته كذا هو حلو، لما كانت إذا رأته همَّت بأكله، كما عندنا نحن أن هذا الأبيض هذا المغنّى لما كنّا إذا سمعنا غناه الشخصي أثبتنا عينه الشخصية وبالعكس. ولو لم يكن في الحيوان ما اجتمع فيه صور المحسوسات لتعذرت عليه الحياة، ولم يكن الشمّ دالاً لها على الطعم، ولم يكن الصوت دالاً إياها على الطعم، ولم تكن صورة الخشبة تُذكّرِها صورة الألم حتى تهرب منه، فيجب لا محالة أن يكون لهذه الصور مجمع واحد من الباطن. [13]«
ميزة أخرى يضيفها ابن سينا إلى وظائف الحس المشترك، بأنه يدرك ما يسميه الكيفيات المشتركة (المحسوسات المشتركة)؛ أي الصفات التي تنالها حاسة بعينها: مثل الحركة والسكون، الوحدة والكثرة، الشكل والترتيب. هذه المعاني ليست من شأن البصر وحده ولا سمع وحده، بل لا تُدرك إلا من حيث هي أفق جامع للمحسوسات. يبرهن ابن سينا بالقول: »الحس المشترك والحواس الظاهرة فإنها تحكم بجهة ما أو بحكم مّا، فيقال إن هذا المتحرك أسود وإن هذا الأحمر حامض، وهذا الحافظ لا يحكم به على شيء من الوجود إلا على ما في ذاته بأن فيه صورة كذا.[14]« كذلك يمكن فهم أن لإدراك المحسوسات المشتركة أهمية كبيرة في الإدراك الحسي. فليست الحواس الظاهرة تحس الكيفيات الحسية فقط، وإنما تحس أيضا شكل الشيء الحاصل على هذه الكيفيات الحسية، وتحسّ مقداره وحجمه، وتحس أيضا عدده وحركته أو سكونه. فهناك إذن علاقة ضرورية بين إحساس الكفيات الحسية الأولية، وبين إحساس المحسوسات المشتركة.
إذا نظرنا إلى علماء النفس في العصر الحديث من خلال دراستهم للمحسوسات المشتركة التي طرقها ابن سينا سلفاً، من حيث هي عناصر داخلة في تكوين الإدراك الحسي. نجدهم يبحثون في كيفية إدراك الشكل والحركة والامتداد أو المكان والمقدار، والحجم والمسافة، وبعبارة أخرى الخصائص الهندسية للأشياء. مثلاً جيمس غيبسون (James J. Gibson) في قدرة الحواس على إدراك الشكل والحركة والامتداد ضمن البيئة المحيطة معتبراً أن الإنسان يلتقط مباشرة المعطيات البصرية المتعلقة بالخائص الهندسية للأجسام.[15]كما أظهرت إلينور غيبسون (Eleanor J. Gibson) أن التعلّم الإدراكي يسمح للإنسان بتحديد الحكم والمقدار والامتداد عبر الخبرة الحسية وتكامل الحواس.[16]كذلك نجد جيروم برونو) Jérome (Bruner، إلى أن تصنيف وفهم الشكل والحركة والمقدار يتطلّب بنية إدراكية مكتسبة، وهو ما يعكس تماماً الفكرة السيناوية في أنّ الحواس لا تعمل بشكل معزول، بل تساهم مع القوى الباطنة في تكوين الإدراك المتكامل.[17]
للحس المشترك وظيفة أخرى وهي إدراك المحسوسات التي بالعرض؛ بمعنى ليس الإدراك الحسي عبارة عن إدراك الكيفيات الحسية الأولية للمحسوسات المشتركة فقط، بل هناك عنصراً آخر يدخل في تكوين الإدراك الحسي. مثلاً، إذا نظرنا إلى شيء أبيض فإن حِسنا ينفعل عن اللون الأبيض، ويحدث عندنا إدراك اللون الأبيض. ولكن إدراكنا لا يقف عند هذا الحد، فإننا ندرك أيضاً أن هذا الأبيض هو هذا الشيء. وليس هذا الإدراك الثاني مستمداً من حواسنا، لأن حواسنا لا تنفعل عن الشيء، ولكنها تنفعل فقط مع اللون. إذن، للحس المشترك دور في الوعي والإدراك في وحدة متماسكة لكل الإدراكات الحسية.
نخلص أنه إذا تم النظر في عمق تحليل ابن سينا، نجد أن الحس المشترك ليس مجرّد آلية وظيفية، بل هو شرط لوحدة الإدراك. فمن دونه لا سبيل للنفس إلى أن تتجاوز التعدد الحسي نحو إدراك واحد متماسك، ولا يمكنها أن ترتقي من الجزئي إلى الكلي، ومن الحسي إلى العقلي. إنه القوة التي تجعل الإدراك ممكناً بوصفه إدراكاً للشيء في وحدته، لا لتراكم صفاته فقط. وعليه، لا يقدّم ابن سينا مجرّد معالجة سيكولوجية لقوى النفس، بل يؤسس لفلسفة في الوعي مفادها أنّ الإدراك لا يقوم إلا من خلال بنية باطنة تُحوّل التعدد إلى وحدة، والجزئي إلى كلي. وبذلك، يغدو الحسّ المشترك أكثر من آلية إدراكية، إنه شرط أنطولوجي وإبستمولوجي يضمن للنفس وحدة تجربتها، ويجعل الوعي ذاته ممكنًا في معناه الأصيل.
(*) يُعرف ابن سينا الإدراك على العموم سواء كان حسياً أم عقلياً هو قبول المُدْرِك لصورة المُدْرَك. يقول:» أن كل إدراك هو أخذ صورة المدرك بنحو من الأنحاء. « ابن سينا، الفن السادس من الطبيعيات، من كتاب الشفاء القسم الأول، ص59
[1] ابن سينا، أحوال النفس، رسالة في النفس وبقائها ومعادها، مصدر سابق، ابن سينا، أحوال النفس، رسالة في النفس وبقائها ومعادها، تحقيق، د. أحمد فؤاد الأهواني، طبعة آفاق الأولى 2020، ص 229
[2] نفس المصدر، ص 230
(*) سه تجويف دارد دماغ بشر *** زاحساس باطن دهندت خبر
مقدم ز تجويف أول بداندك *** بو دحاسه مشترك رامقرّ.
مؤخرا زأو شد محل خيال *** كه ما ند در أو أز تصور أثر.
يس اندر نخستين أوسط بود *** تخيل زحيوان وفكر از بشر.
أخير وسط جاى وهم است وحفظ *** زتجويف آخر نباشد بدر.
تُمثّل هذه القصيدة تجليًا شعريًا لنسقٍ فلسفيّ راسخ في الفكر الإسلامي الوسيط، يتعلّق بتقسيم قوى النفس الباطنة ومراتبها الوظيفية داخل البنية الدماغية، كما قرّره الحكماء، وفي طليعتهم ابن سينا والفارابي. إذ يُشير الشاعر إلى أن الدماغ الإنساني مؤلّف من ثلاثة تجاويف متمايزة، يتوزّع فيها فعل الإدراك الباطني وفق تراتب دقيق. فالتجويف الأول، وفي جزئه الأمامي، يضمّ الحسّ المشترك — وهو المبدأ الجامع للمدركات الحسية الجزئية — إلى جانب حاسة الشم. أما القسم الخلفي منه، فيحتضن قوة الخيال، التي تحفظ الصور المحسوسة بعد غياب مادّتها عن الحس. يلي ذلك التجويف الأوسط، وفيه تبرز قوتان: "المتخيلة" التي تقوم بتركيب الصور وتفكيكها، وهي مشتركة بين الإنسان والحيوان، و"الفكر" الذي يختص به الإنسان، وبه يُدرَك المعقول وتُستنبط الكليات. أما التجويف الأخير، ففيه تستقر قوة "الوهم"، المدركة للمعاني الجزئية غير المحسوسة، كإدراك العداوة والصداقة، إلى جانب "الحافظة" التي تحفظ تلك المعاني وتسترجعها عند الحاجة. هذا الترسيم الوظيفي يتأسّس على ما جاء في المتن الفلسفي السينوي، لا سيما في كتابيه الشفاء والنجاة، حيث تُقسم قوى النفس الباطنة إلى ست: الحس المشترك، الخيال، المتخيلة، الفكر، الوهم، والحافظة، موزّعة على البطون الدماغية الثلاثة. وقد تابع هذا البناءَ الفكري عدد من الأطباء والفلاسفة كالفارابي والرازي، في مسعى للتوفيق بين المعطى التشريحي والتأمل العقلي في ماهية النفس وأدوات إدراكها. وعليه، فالقصيدة لا تُقوّم بوصفها عملاً أدبيًا صرفًا، بل تُعدّ مقالةً فلسفيةً منظومة، تكثّف نظرةً معرفية عميقة إلى البنية الشعورية للإنسان وقواه المُدرِكة. انظر: ابن سينا، النفس، الشفاء، تحقيق آية الله حسن زاده الآملى، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلام، الطبعة الأولى 1385، ص 61
[3] نفس المصدر، ص 61
[4] ابن سينا، أحوال النفس، رسالة في النفس وبقائها ومعادها، مصدر سابق، ص158.
[5] Aristotle. (n.d.). De Anima (Book III, ch. 1, 425a30-39). In R. Ross (Trans.), Aristotle (p. 196); W. Hicks (Trans.), De Anima (pp. 425–426); J. Tricot, De l'âme d'Aristote (p. 150, note 5). Paris, 1934
[6] محمد عثمان نجاتي، الإدراك الحسي عند ابن سينا، بحث في علم النفس عند العرب، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، ج، ص156
[7] ابن سينا، النفس، الشفاء، مصدر سابق، ص ص62-61
[8] ابن سينا، النفس، الشفاء، مصدر سابق، ص210
[9] نفس المصدر، ص229
[10] نفس المصدر، ص230
[11] ابن سينا، أحوال النفس، رسالة في النفس وبقائها ومعادها، مصدر سابق، ص 229
[12] ابن سينا، النفس، الشفاء، مصدر سابق، ص 229
(*) يُعرَف تداعي الصور الذهنية عند ابن سينا بأنه انتقال النفس من صورة متخيلة إلى أخرى مرتبطة بها بعلاقة مخصوصة، كالمشابهة أو المجاورة أو السببية، وهو فعل من أفعال القوة المتخيلة التي تُعدّ إحدى قوى النفس الداخلية. هذه القوة تحتفظ بصور المعقولات والمحسوسات بعد غيابها عن الحس، وتعيد ترتيبها أو استدعاء بعضها إثر بعض بحسب ما انطبع في النفس من ترابط بينها، سواء كان هذا الاستدعاء تلقائيًا أو مقصودًا. وقد أشار ابن سينا إلى ذلك في الشفاء، حيث قال: "وقد تتداعى هذه الصور في النفس، فتنجرّ صورة إلى صورة، إما لمشابهة بينهما، أو لمجاورة، أو لسببية اتفقت في التصور الأول. وهذا الفعل يُشكّل أساسًا لفهم الظواهر النفسية كالتذكر والتخيل والحلم، ويكشف عن البنية الترابطية التي تحكم اشتغال المخيلة في نظر ابن سينا، والتي تتوسط بين الإدراك الحسي والعقل المجرد، مما يضفي على تصوراته النفسية طابعًا عقلانيًا دقيقًا يجمع بين الفلسفة والمنطق وعلم النفس المبكر. انظر: بن سينا، كتاب الشفاء (الطبيعيات – النفس)، محقّق: حسن زاده الآملي، الطبعة الأولى، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، الصفحة 162
[13] ابن سينا، أحوال النفس، رسالة في النفس وبقائها ومعادها، مصدر سابق، ص 8.2
[14] ابن سينا، النفس، الشفاء، مصدر سابق، ص 230
[15] James J. Gibson, The Ecological Approche to Visual, Perception 1979, p 240
[16] Eleanor J. Gibson, Principles of perceptual Learning and Développement, 1969, p34
[17] Jérome Bruner, Beyond, the information, Given, 1973, p119