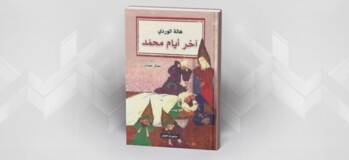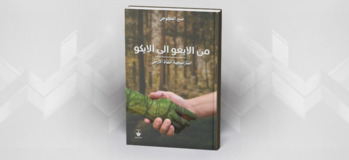ابن مسكويه: فيلسوف الأخلاق
فئة : مقالات

ابن مسكويه: فيلسوف الأخلاق
يعدُّ سؤال الأخلاق من أهم أسئلة العصر، وقد حظي الموضوع بكتابات ودراسات كثيرة، ما بين الشرق والغرب، وكلٌّ ينظر إلى الموضوع ويقارب أسئلته من زاوية نظر مختلفة. في العالم العربي، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، كتاب طه عبد الرحمن "سؤال الأخلاق"، وكتاب المهدي المنجرة "قيمة القيم"، وكتاب محمد عابد الجابري "نقد العقل الأخلاقي العربي"، وكتاب عبد الله دراز "دستور الأخلاق في القرآن". لسنا هنا بصدد نقاش مختلف المقاربات التي تطرقت لموضوع الأخلاق، لكن نلفت النظر إلى أن موضوع الأخلاق، بدرجة أولى، يعود إلى الإنسان وطبيعته. وبمعنى أدق، فالنفس هي موطن الأخلاق، وهي مسألة تطرق إليها ابن مسكويه في القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي، في كتابه "تهذيب الأخلاق"، وكم نحن اليوم في أمس الحاجة إلى تهذيب الأخلاق في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وبمختلف الكائنات من حوله.
فالإنسان لا يسري عليه ما يسري على الحيوان الذي يشترك معه فيما هو طبيعي من المأكل والمشرب، كما لا يسري عليه ما يسري على الملائكة. فهو من جهة تركيبته النفسية يتصف بنوع من الجدل بين القوى النفسية الثلاثة: "النفس البهيمية [المحمولة بالغريزة والشهوة]، النفس السبعية [التي تميل إلى الغضب]، النفس الناطقة [التي تميل إلى الحكمة والعقل]. فبالنفس الناطقة، شارك الإنسان الملائكة وفارق البهائم.[1]"
هذه الأبعاد الثلاثية للنفس لا تزال موضوع الدراسة في الزمن الحاضر في علاقة النفس بالحواس والجهاز العصبي والدماغ، ومختلف المتطلبات الطبيعية التي يتطلبها الجسد بهدف النمو والحياة والعيش. فعلم النفس العصبي يدرس علاقة الدماغ بمختلف التصرفات والسلوك، ويهتم بتشخيص وعلاج مختلف الاضطرابات العصبية المؤثرة على السلوك والإدراك. وفي علاقة النفس بمختلف الطباع والعادات وما يتلقاه الأفراد من مختلف مظاهر التنشئة الاجتماعية، وفي علاقة النفس بالقوى الباطنية للعقل والنظر والتمييز الذي يتصف به الإنسان عن غيره من الكائنات. فالعقل الباطن يتكون من عمليات في العقل تحدث تلقائيًا.
تهذيب الأخلاق أمر يتأتى بطبيعة معرفة الأنفس، فالنفس في الإنسان لا ينطبق عليها ما ينطبق على الجسد من جهة الشكل المحدد المعالم من جهة الشكل والطول والعرض. فالنفس ليست لها كيان ظاهر ومحسوس المعالم، فهي يسري عليها ما هو معنوي. يقول ابن مسكويه: "إنا لمَّا وجدنا في الإنسان شيئًا ما يُضادُّ أفعال الأجسام وأجزاء الأجسام بحدِّه وخواصِّه، وله أيضًا أفعالٌ تُضادُّ أفعال الجسم وخواصه، حتى لا يشاركه في حال من الأحوال. وكذلك نجده يُباين الأعراض ويضادُّها كلَّها غاية المباينة، ثم وجدنا هذه المباينة المضادة منه للأجسام والأعراض إنما هي من حيث كانت الأجسام أجسامًا والأعراض أعراضًا؛ حكمنا بأن هذا الشيء ليس بجسمٍ ولا جزءٍ من جسم ولا عرضًا؛ وذلك أنه لا يستحيل ولا يتغير. وأيضًا فإنه يُدرك جميع الأشياء بالسويَّة، ولا يلحقه فتور ولا كلال ولا نقص." «وبيان ذلك»: أن كل جسم له صورةٌ ما"[2]
فالنفس إذن، ليست هي جسد الإنسان، رغم أنه يتعذر الحديث عنها بفناء الجسد. لكن ما هي علاقة النفس بالحواس في الجسد؟ إنها علاقة المعرفة والإدراك. فالحواس مصدر للتمييز بين مختلف الظواهر والأشياء. فالسمع والبصر هما وسيلة الإنسان في النظر والفكر والتفكر. لكن هل كل ما يخبرنا به الحواس يكون صوابًا؟ فالأمر على العكس من ذلك، فلاقتراب من الحقائق أمر يعود إلى النفس وبديهتها، من بعد الحواس التي لا ينبغي التوقف عندها وعند ظاهر ما ندركه من خلالها. "ونحن نجد النفس العاقلة فينا تستدرك شيئًا كثيرًا من خطأ الحواس في مبادئ أفعالها، وترد عليها أحكامها. من ذلك أن البصر يخطئ فيما يراه من قرب ومن بعد. أما خطؤه في البعيد فبإدراكه الشمس صغيرة مقدارها عرض قدم، وهي مثل الأرض مائة ونيِّفًا وستين مرة؛ يشهد بذلك البرهان العقلي، فتقبل منه وتردُّ على الحس ما شهد به فلا يقبله.[3]"
والقرآن الكريم عندما لفت نظر القارئ إلى وسيلة الحواس، على رأسها السمع والبصر، في تحصيل العلم والمعرفة، لم يتوقف عندها بل ربطها بالفؤاد، قال تعالى:﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ﴾ (الإسراء/36). فالعلم والمعرفة تأتي من بعد التأمل والتمعن فيما أخبرتنا به الحواس. فالوقوف عند ما فهمناه من الحواس سيجعل منها خادعة لنا في معرفة حقائق ما نحن ننظر فيه أو بشأنه. في هذا السياق، يقول ديكارت: "حواسنا خادعة ومن الحذر أن لا نطمئن لمن خدعونا ولو لمرة واحدة." "فإن النفس وإن كانت تأخذ كثيرًا من مبادئ العلوم عن الحواس، فلها من نفسها مبادئ أُخرى وأفعال لا تأخذها عن الحواس البتَّة؛ وهي المبادئ الشريفة العالية التي تنبني عليها القياسات الصحيحة؛ وذلك أنها إذا حكمت أنه ليس بين طرفي النقيض واسطة، فإنها لم تأخذ هذا الحكم من شيء آخر؛ لأنه أوليٌّ، ولو أخذته من شيء آخر لم يكن أوليًّا. وأيضًا فإن الحواس تدرك المحسوسات فقط. وأما النفس فإنها تدرك أسباب الاتفاقات وأسباب الاختلافات التي من المحسوسات، وهي معقولاتها التي لا تستعين عليها بشيء من الجسم ولا آثار الجسم.[4]"
والنفس وفق هذا المبنى هي الفؤاد الذي لا يتوقف عند الحواس ولا يتماهى مع الجسد ولا يأخذ بالظاهر، بل يسعى من أجل فهم القضايا والأشياء في ذاتها وكما هي، وليس كما ندركها من النظرة الأولى من خلال حواسنا.
فخاصية العلم والمعرفة في النفس تعود بدرجة أولى إلى "ذاتها وجوهرها؛ أعني العقل. وليست تحتاج في إدراكها إلى شيء آخر غير ذاتها... فأما الحواس فلا تحس ذواتها ولا ما هو موافق لها كل الموافقة... النفس إذن ليست بجسم ولا بجزء من جسم ولا حال من أحوال الجسم، وأنها شيء آخر مفارق للجسم بجوهره وأحكامه وخواصه وأفعاله."[5]
الأخلاق وقوى النفس
الأفعال الصادرة من الإنسان تحكمها دوافع ليست بالضرورة هي الدوافع التي تدفع مختلف الكائنات في الوجود. فالحيوان يندفع للفريسة بدافع غريزة الجوع، وليس بدافع العداء والانتقام، وتندفع مختلف الحيوانات إلى المراعي بهدف الأكل ذاته، لا بهدف آخر. والكلب يحرس باب البيت لأنه رُوِّض على ذلك، لا يحرسه بدافع الوفاء والإخلاص كما يتصور البعض. مجمل دوافع الحيوانات على الفعل تدور في دائرة الغريزة والحواس والجسد، فالحيوانات تدور في دائرة أجسادها وحواسها، ولا تفارقها إلى عالم آخر. ومن البديهي أن ما تطرحه أجسادها من فضلات يعد جزءًا منها، وقد تفترشها ولا تفارقها. باختصار، دوافع الفعل عند الحيوان ليس من ورائها قيمة الخير أو الشر، والدليل على ذلك أن الإنسان قد استطاع ترويضها وتسخيرها لصالحه.
بينما دوافع الفعل عند الإنسان تتصف بأبعاد ودوافع مركبة تجمع ما بين الحواس ومتطلبات الجسد من المأكل والمشرب، وما وراء ذلك من مقاصد الفعل. منها ما هو ظاهر ومعروف، ومنها ما يكون مستبطنًا لا يعلمه إلا صاحب الفعل. فالإنسان عندما يقبل على أي فعل، يسبقه في الذهن مبدأ أخلاقي، بقصد أو بدونه. فوجوده في الحياة لا يتوقف عند الوجود ذاته، بل هو وجود يتجاوز الوجود إلى ما بعده وما قبله، بالنظر في المعنى والغاية من الوجود ذاته، والتأمل في قبلياته وبعدياته. وهي مسألة يترتب عنها سؤال الصواب والخطأ، الصالح والطالح، الخير والشر.
فثنائية الخير والشر، الصواب والخطأ، مسألة أخلاقية بامتياز. فالأخلاق هي التي ترفع الإنسان وتجعلهم يفارق عالم الحيوان. "ولمَّا كان الإنسان من بين الموجودات كلها هو الذي يُلتمس له الخُلق المحمود والأفعال المرضية، وجب ألَّا ننظر في هذا الوقت في قواه وملَكاته وأفعاله التي بها يشارك سائر الموجودات؛ إذ كان ذلك من حق صناعةٍ أخرى وعلمٍ آخر يُسمَّى العلم الطبيعي. وأما أفعاله وقواه وملَكاته التي يختص بها من حيث هو إنسان، وبها تتم إنسانيته وفضائله، فهي الأمور الإرادية التي بها تتعلق قوة الفكر والتمييز. والنظر فيها يُسمَّى الفلسفة العلمية. والأشياء الإرادية التي تُنسب إلى الإنسان تنقسم إلى الخيرات والشرور؛ وذلك أن الغرض المقصود من وجود الإنسان إذا توجَّه الواحد منا إليه حتى يحصل هو الذي يجب أن يُسمَّى به خيِّرًا أو سعيدًا. فأما من عاقه عنها عوائق أُخَر، فهو الشرِّير الشقي. فإذًا الخيرات هي الأمور التي تحصل للإنسان بإرادته وسعيه في الأمور التي لها أُوجِد الإنسان ومن أجلها خُلِق. والشرور هي الأمور التي تعوقه عن هذه الخيرات بإرادته وسعيه أو كسله وانصرافه."[6]
الفعل الإنساني يعود إلى إرادة في النفس، فالإنسان سيد قراره، وهو قرار تتنازعه قوى النفس، وهي ثلاثة: "القوة الناطقة وهي التي تُسمَّى الملكية، وآلتها التي تستعملها من البدن الدماغ. والقوة الشهوية وهي التي تُسمَّى البهيمية، وآلتها التي تستعملها من البدن الكبد. والقوة الغضبية هي التي تُسمَّى السَّبُعية، وآلتها التي تستعملها من البدن القلب؛ فلذلك وجب أن يكون عدد الفضائل بحسب أعداد هذه القوى. وكذلك أضدادها التي هي رذائل. فمتى كانت حركة النفس الناطقة معتدلة وغير خارجة عن ذاتها، وكان شوقها إلى المعارف الصحيحة (لا المظنونة معارفَ وهي بالحقيقة جهالات) حدثت عنها فضيلة العلم، وتتبعها الحكمة. ومتى كانت حركة النفس البهيمية معتدلة، منقادة للنفس العاقلة، غير متأبِّية عليها فيما تقسطه لها، ولا منهمكة في اتباع هواها، حدثت عنها فضيلة العفة، وتتبعها فضيلة السخاء. ومتى كانت حركة النفس الغضبية معتدلة تطيع النفس العاقلة فيما تقسطه لها، فلا تهيج في غير حينها ولا تتحمس أكثر مما ينبغي لها، حدثت منها فضيلة الحلم، وتتبعها فضيلة الشجاعة. ثم يحدث عن هذه الفضائل الثلاث باعتدالها ونسبة بعضها إلى بعض فضيلة هي كمالها وتمامها؛ وهي فضيلة العدالة. فلذلك أجمع الحكماء على أن أجناس الفضائل أربع؛ وهي: الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة؛ ولهذا لا يفتخر أحد ولا يتباهى إلا بهذه الفضائل فقط."[7]
"يرى مسكويه أن قوى النفس الثلاث، أقلها درجة هي النفس البهيمية، وأوسطها النفس السبعية، وأشرفها النفس الناطقة. والإنسان إنما صار إنسانًا بأفضل هذه النفوس، أعني الناطقة، وبها شارك الملائكة وبها باين البهائم[8]. فتهذيب الخلق يقتضي أن تكون النفس الناطقة لها الغلبة على النفس السبعية التي تقتضي الغضب والسرعة، وتكون لها الغلبة أيضًا على النفس الشهوية، وحينها سيكون الغضب متحكمًا من زاوية العقل والحكمة والعفة... وتكون شهوة الأكل وغيرها من ضروريات الجسد والحواس، تدور في دائرة العقل والحكمة. أما إذا تراجعت القوة الناطقة (أي العقل والحكمة والعفة...) وحضرت قوة الشهوة والغضب، فستأتي الأخلاق على أسوأ حال، إذ يغلب جانب الحواس والجسد ويتقلص جانب العقل والحكمة، والنفس في حاجة إلى التقويم وإلا فسد حالها. ويحتكم الإنسان إلى قوة الجسد والسلاح فيما هو مختلف فيه، ويتعامل مع مختلف موارد الطبيعة بنفس يغلب عليها التبذير والاستهلاك غير الممنهج الذي لا يراعي شروط استغلال البيئة، مما سيكون سببًا مباشرًا في تدمير الطبيعة من حوله.
في هذا السياق، نستحضر بعض الآيات القرآنية، ليس من باب الوعظ، ولكن من باب لفت نظر القراء، بأن القرآن الكريم يتحفنا بنظرته الأخلاقية للعالم والإنسان، وهي نظرة يعول عليها في إعادة بناء مداخل معرفية في نظرتنا للحياة والعالم والوجود من حولنا. قال تعالى: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (10) ﴾ (الشمس). وقال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ (الحج/46). وقال تعالى: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ (الأعراف/179)."
[1] ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ط.1، 2024م، ص. 41 (بتصرف)
[2] نفسه، ص.21
[3] نفسه، ص.21
[4] نفسه، ص.21
[5] نفسه، ص.21
[6] نفسه، ص. 23
[7] نفسه، ص. 25
[8] نفسه، ص. 41