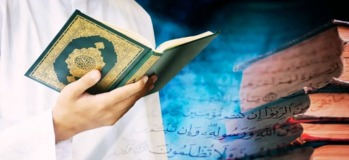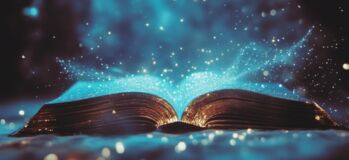الدين في الفضاء العمومي ما بعد علماني: مقاربة بين غوشيه وهابرماس
فئة : أبحاث محكمة

الدين في الفضاء العمومي ما بعد علماني:
مقاربة بين غوشيه وهابرماس
الملخص
يسعى هذا البحث إلى إثبات أن هابرماس في قراءته الأخيرة لدور الدين في المجال العام ما بعد العلماني يغفل بعدًا أساسيًّا للدين، والمتمثل في قدرته على تأسيس المجتمعات بشكل رمزي. من جانبه، ينطلق غوشيه من رؤية للدين يكون فيها هذا البعد الأساسي محوريًّا. وفي تقييمه لدور الدين في مجتمع ما بعد العلماني، يتوصل بالتالي إلى نتائج مختلفة تماما عن نتائج هابرماس. ومع ذلك، أعتقد أن غوشيه يقلل أيضا من تقدير مدى بقاء سلطة الدين كمؤسسة مجتمعية رمزية سليمة في المجتمع الحديث ما بعد العلماني. دفاعا عن هذا الموقف، أوضح كيف أن الظواهر غير المتجانسة نسبيا داخل المجتمعات الغربية، مثل الأهمية المتجددة للدين في المجال العام، وإحياء أشكال معينة من القومية وما يرتبط بها من مطالبة بالاعتراف بحقوق الجماعة، وبالتالي أشكال التعددية القانونية، قد تمهد لتحول جديد في المجال العام.
المقدمة
على مدى العقود الماضية، تعرّض الفصل الحديث بين الأدوار الدينية والسياسية، الذي ما يزال مبدأ فصل الدين عن الدولة هو الرمز الأكثر بلاغة في العصر الحديث، لضغوط متزايدة. وقد ساهمت في ذلك تطورات عديدة، لا سيما التأثير المتعاظم الذي اكتسبته الحركات والمعتقدات الدينية (المتشبعة بالحماسة) - سواء كانت يهودية أو مسيحية أو إسلامية - على الرأي العام. وجوهر إشكالية هذا التقسيم العلماني بين الدين والسياسة هو أنه لم يعد من المقبول أن الدين شأن/مسألة خاص(ة) بحت(ة)، بل ينبغي أن يحتل مكانته المشروعة والصحيحة في المجال العام. وقد تبنّت الفلسفة السياسية هذه القضية أيضا، إلى درجة أن بعض الباحثين ساروا على نهج هابرماس[1]، ويشيرون إلى ما يسمى بـــ"المجتمع ما بعد العلماني": أي المجتمع الحديث الذي تخلّى عن علمانيته المتشددة في الأصل، وأصبح مستعدًّا لقبول منح الدين مساحة أكبر في الفضاء العام.
السؤال الرئيس هنا، بالطبع، هو ما هي المكانة التي ينبغي أن يُمنح للدين، وعلى أيّ أساس؟ في هذه النقطة، تختلف الآراء بطبيعة الحال. وما يلفت الانتباه في هذا السياق هو الخلاف المثير بين جان رولز John Rawls ويورغن هابرماس Jürgen Habermas. يعتقد رولز أن الدين لا ينتمي إلى المجال العام، في حين يعتقد هابرماس أنه يمكن له أن يندمج فيه تحت شروطٍ تقييدية معينة. وقد أثار هذا النقاش ردود فعل عديدة. إلا أن النقطة التي نود إثارتها هنا تكمن في مستوى النقاش الذي دار بين فيلسوفين غربيين وهما مارسيل غوشيه Marcel Gauchet وهابرماس. في هذا النقاش، تميل وجهة نظر معينة للدين إلى الافتراض الضمني الذي هو أبعد ما يكون عن البديهية، ولكنه يُحدد المنظور الذي تُبنى عليه الإجابات. فيما يلي، أسعى في المقام الأول إلى تسليط الضوء على إشكالية هذا التصور الضمني؛ لأنه يتجاهل بُعدًا جوهريًّا في الدين: قوته التأسيسية للجماعة الرمزية. ويمكن ملاحظة أن هابرماس، على وجه الخصوص، يركز بشكل أحادي على الجوانب المعرفية-الأخلاقية والإبستيمية للدين، متغاضيا النظر عن قدرته المستمرة على بناء جماعة رمزية موحَّدة. وبالاستناد إلى أعمال الفيلسوف وكاتب المقالات السياسية الفرنسي مارسيل غوشيه، نسعى إلى تسليط الضوء على هذا الجانب الجوهري للدين، وسنبين أنه يؤدي إلى تقييم مختلف تماما لدور الدين في مجتمع ما بعد العلماني. ومع ذلك، نعتقد أن غوشيه أيضا يقلل من شأن استمرارية السلطة الدينية التأسيسية للجماعة الرمزية في المجتمع الغربي الحديث ما بعد العلماني. وتأييدًا لهذا الموقف، سنوضح كيف أن الظواهر المتنوعة وغير المتجانسة نسبيًّا داخل المجتمعات الغربية، مثل الأهمية المتجددة للدين في الفضاء العام، وإحياء أشكال معينة من القومية وما يرتبط بها من مطالبة بالاعتراف بحقوق الجماعات، وبالتالي أشكال التعددية القانونية، قد تكون مؤشرات على تحولات جديدة في المجال العام، وهي تحولات ليست خالية تماما من الإشكاليات.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
[1] - Voir Jürgen, Habermas, Entre naturalisme et religion: Les défis de la démocratie, trad. Alexandre Dupeyrix, éds. Gallimard, Paris, 2008, 400 pages.