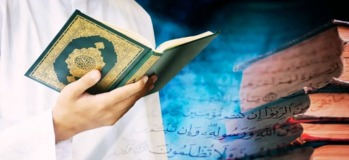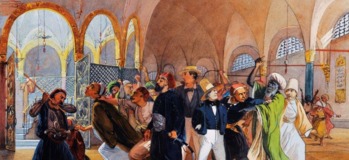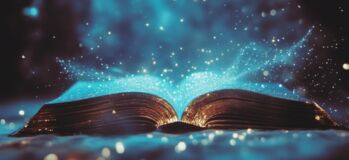حوار مع الدكتور رضوان السيد حول مستقبل الدراسات الإسلامية
فئة : حوارات

حوار مع الدكتور رضوان السيد حول مستقبل الدراسات الإسلامية
10 نوفمبر 2023، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
د. حسام الدين درويش:
مساء الخير دكتور رضوان، يسعدني أن أتحاور معك، وأن يستمع لك جمهورك الواسع، جمهور مؤمنون بلا حدود، حول موضوع الدراسات الإسلامية ومستقبلها.
المسألة الأساسية الأولى التي أودّ طرحها ومناقشتها معك تتعلّق بالتوتّر القائم، في الدراسات الدينية عمومًا، ومن ضمنها الدراسات الإسلامية، و(حتى) في الجامعات الغربية، بين الدراسات الإيمانية-اللاهوتية من ناحية، ودراسات العلوم الإنسانية - كعلم الاجتماع والتاريخ وغيرها - التي تتناول الدين والظواهر الدينية، من ناحية أخرى. ويبدو أنّ هذا التوتّر أشدّ حينما يتعلّق الأمر بالإسلام. فهل ثمة خصوصية للإسلام في هذه المسألة؟ ولمَ يوجد هذا التوتّر بين طرف لاهوتي إيماني خالص، وطرف علمي يبدو، أحيانًا، مضادًّا أو مناقضًا لهذا الديني أو اللاهوتي؟
د. رضوان السيد:
تاريخنا الديني مختلف عن التاريخ الأوروبي. قبل أيام صدر كتاب لكانط الفيلسوف الألماني مترجمًا إلى العربية بجهد فتحي إنقزو، بعنوان "نزاع الكلّيات"؛ أي الصراع بين كلية اللاهوت وكلية الفلسفة. حينها كان الصراع على أشدّه بين الطرفين؛ إذ كانت الفلسفة تطمح إلى أن تكون مرجعية، حتى في فهم الدين وتأويله، بدلًا من اللاهوت. هم يقولون: نحن لا نحلّ محلّ اللاهوت، ولا نريد أن نبني كهنة أو قساوسة يقيمون الشعائر، بل نريد أن ندرس الدين ونقرأ قيمه ونصوصه قراءة علمية.
هذه المشكلة لم تُحلّ، لكن المؤسسات الدينية انهزمت لصالح الفلسفة في القرون الثامن عشر والتاسع عشر ثم العشرين. عاد النزاع، لكنه كان خافتًا بين اللاهوتيين والفلاسفة الغربيين خلال الثلاثين سنة الأخيرة، تحت الشعار الذي سُمّي "عودة الدين". غير أنّ القائلين بعودة الدين فريقان: الأول يتمثل في الحركات الإنجيلية النشطة في الشارع، وهذه لا علاقة لها لا بالصراع على الدين، ولا بالصراع على العلم والفلسفة. أما الثاني، فيمثله فلاسفة مثل تشارلز تايلور وريكور وغادامر في مسألتيْ التراث والتأويل. هؤلاء جميعًا فلاسفة، لكنهم يدعون إلى إعادة النظر في الدين لا بوصفه سبيلًا إلى الإيمان، بل بوصفه مجالًا لتأمل النصّ الديني في الحياة الإنسانية: كيف أثر في الماضي وكيف يؤثر اليوم، مع الإشارة إلى أن القيم المدنية أو العلمانية الحديثة ذات أصول دينية، هذا هو الأمر في إيجاز.
أمّا عندنا فالصراع أقدم؛ إذ نجد منذ القرن الثالث الهجري، الكندي، وهو أول فيلسوف يشكو من المترّئيس بالدين، في رسالته في الفلسفة الأولى. كما كان الحال مع اللاهوتيين الأوروبيين في القرن الثامن عشر؛ إذ كانوا ينكرون على الفلاسفة حقّ النظر في الدين وفي قيمه. هم لا ينظرون في التعاليم الدينية المتعلّقة بالعبادات، وإن كان بعضهم - مثل ابن سينا - يحاول تأويلها، بل ينظرون في الفكرة ومقتضياتها من نظرية الدين، وفي الآثار الأخلاقية للدين.
هذا الصراع لم يُحسم؛ لم ينهزم المتديّنون، ولم ينهزم الفلاسفة، وظلت هناك محاولات. فقد ردّ ابن رشد على الغزالي، كما ظهرت محاولات في الفلسفة الإشراقية للمزج بين الأمرين، وحتى عند بعض المتكلّمين مثل فخر الدين الرازي وقبله الآمدي، الذين أرادوا الجمع بين القيم الدينية أو الفكرة الدينية، وبين التأويل الفلسفي للدين خارج مسألة العبادات. فالمسألة لم تُحسم في ما يسمى بالأصول الكلاسيكية الإسلامية. وزعم كثيرون أنّ الغزالي أنهى الفلسفة، وهذا كلّه كلام غير دقيق.
د. حسام الدين درويش:
وهناك ردودٌ قوية على هذا الزعم.
د. رضوان السيد:
حتى المستشرقون، ومنهم أحد أبرز المتخصصين في الغزالي، واسمه فرانك غريفِل، الذي ألّف قبل سنتين كتابًا ضخمًا عن الفلسفة بعد الغزالي. فهذا الملف ما يزال مطروحًا منذ الأزمنة الكلاسيكية، بل أقدم من الطرح الأوروبي لمسألة علاقة الفلسفة بالدين. فالفلاسفة لا يزعمون أنّهم يريدون انتزاع الدين من أهل العلم الديني، أو ممن نسميهم الفقهاء والشيوخ، ولكنّهم يرون لأنفسهم الحق في عقلنة الدين، حتى يصبح مفهومًا، ولا يبقى مجرد ظاهرة ميتافيزيقية أو سحرية أو عجائبية وصوفية. ويبقى السؤال: هل هناك تمايز بين التاريخين؛ أي بين صراع الكليات أو صراع الفلسفة مع الدين في التاريخين الإسلامي والمسيحي؟
لقد وجدتُ أن الخلاف كان أساسيًّا في القرن الثالث الهجري، في نظرية العقل، بين نظرية "العقل الفعّال" و"الجوهر الفرد" كما نجدها عند الكندي وابن سينا والفارابي، وبين مواقف الفقهاء والمتكلّمين. وأقدم ما وصلنا في نصّ مكتوب هو للحارث بن أسد المحاسبي (توفي 243 هـ)، الذي ألّف كتابًا بعنوان "ماهية العقل وحقيقة معناه واختلاف الناس فيه"، يقول فيه: إنّ العقل غريزة، وليس جوهرًا مفروضًا، وهو كسائر الغرائز، لا يُعرف إلا بأفعاله عن طريق الجوارح، فلا يُدرك برؤية ولا بشمّ ولا بذوق ولا بسمع، بل يُعرف بأفعاله وآثاره في الجوارح.
فهل يشبه هذا ما قاله كانط في مسألّة العقل والدراسة الفلسفية للدين؟ فعنده – كما تعلم – كتاب في القراءة الفلسفية أو الدراسة الفلسفية للدين، "الدين في حدود مجرّد العقل". فالنظر العقلي في الدين، غير النظر اللاهوتي في الدين.
د. حسام الدين درويش:
إذا تعمقنا في هذه الفكرة، في مسألة إمكان وجود اختلاف بين المسار التاريخي للغرب والشرق، أو بين المسلمين والمسيحيين، وجدنا أنّه إذا أخذنا ابن رشد الذي ذكرتَه، وقارنّاه بتوما الأكويني، بدا أنّ الاتجاه الغالب في العالم الإسلامي كان عمومًا الاستناد إلى الدين في شرعنة الفلسفة. فابن رشد، في كتاب "فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال"، فال، أو أراد أن يقول، إنّ الفلسفة، تبعًا للدين أو لفهمه للدين، مشروعة أو ينبغي أن توجد، وأنّ لها مكانة (يمكن أن تكون) موازية له. أمّا توما الأكويني، فقد حاول أن يشرعن الدين، ويبرهن على معقوليته، وعلى وجود الله، من خلال الفلسفة أو بالاستناد إليها. وعلى هذا النحو، يبدو أنّ الأولوية قد اختلفت: فهل الفلسفة هي الأولى التي تشرعن الدين، كما فعل الأكويني، حين قال: إنّ العقل يثبت وجود الله، وبالتالي فالعقل هو الذي يشرعن الدين؟ أم إن الدين هو الذي يشرعن الفلسفة، كما هو الحال عند ابن رشد، حين قال: إن الفلسفة وفقًا للدين واجبة أو على الأقل ممكنة ومباحة؟ هل يمكن التمييز بين الفلسفتين المسيحية والإسلامية في العصر الوسيط، من خلال أو القول بوجود هذا الاختلاف؟ حتى الآن هناك كثير من الباحثين، عندما يريدون أن يقولوا شيئًا، يقولون: "وفقًا للدين هذا معقول"، أو "وفقًا للدين هذا مقبول". فيبدو أنّ الدين عندنا؛ أي الإسلام، هو الأساس الأوسع والأشمل، الذي ينبغي للجميع أن يتخذوه سندًا، حتى في حالة الخروج منه، بمعنى القول بإمكان وجود طريق آخر.
د. رضوان السيد:
تفسيرك جميل، ويقدّم إمكانية واضحة لتمييز الفرق بين الأمرين. فالعقل في العصور الوسطى الإسلامية عند المسيحيين منفصل عن الإنسان، بينما المتكلمون والفقهاء يعدّونه جزءًا من الإنسان، مثل غريزة الأكل والشرب. ومن ثم، يصبح الدين والفلسفة، أو النتاج العقلي، شيئًا واحدًا؛ بمعنى أنّهما يتعددان بتعدد الغرائز، ولكل غريزة وظائفها. فالعقل بوصفه غريزة، له وظائفه التفكيرية والتدبيرية في شأن الجسد الإنساني والمجموعة الإنسانية بشكل عام. كما أن غريزة الأكل لها وظيفتها في بقاء الإنسان، وكذلك الشرب. أما الدين، بحسب هذه الرؤية التسكينية، فوظيفته إحداث السكينة في الإنسان، بما يتيح للعقل أن يدبّر تدبيرًا حكيمًا، من خلال توافق العقل مع الدين، على اعتبار أن الدين أيضًا ناتجٌ عن الفطرة. فأنا أرى أنّ تفسيرك مغرٍ.
د. حسام الدين درويش:
يعني يبدو أحد ممكنات الفهم.
د. رضوان السيد:
وهو أقلّ تعقيدًا من تفسيري أنا الذي أوضحته في كتابي "الأمة والجماعة والسلطة"، حيث خصصت فصلًا للحديث عن "العقل والدولة".
د. حسام الدين درويش:
إذا تابعنا في هذا المسار، فإنّك - كما ذكرتَ في المحاضرة التي ألقيتها قبل قليل - أكدت مسألة غاية في الأهمية، وهي عالمية المعرفة، بعيدًا عن مسألة الهويات، وأنت تعرف كم هي حاضرة اليوم عمومًا، وفي الدراسات الدينية خصوصًا. فليس هناك "معرفة إسلامية" و"معرفة مسيحية" و"معرفة شرقية" و"معرفة غربية". حتى في الدراسات الإسلامية، هناك مناهج معرفة عالمية يمكن الاستناد إليها. لكنك تعلم أنّ نقد الاستشراق غالبًا ما أنتج استغرابًا أو ما يمكن أن نسميه "استشراقًا مقلوبًا"؛ بمعنى أنّه أكّد الثنائيات نفسها: "الشرق شرق، والغرب غربٌ، ولن يلتقيا"، كما قال الشاعر الإنجليزي "روديارد كبلينغ". وهنا لديّ انطباع أرجو منك تصحيحه: عندما تحدّثتَ عن المستشرقين، بدا كأن هناك معرفة جوهرية وهُويّاتية، ثابتة ودائمة، مع أنّ لديّ انطباعًا بأنّهم قدّموا الكثير من المعارف المفيدة، وأن لديهم، هم أنفسهم، معارف مغايرة لهذه النظرة النمطية للاستشراق - وبرنارد لويس ممثّلها البارز أو الأبرز - لكن حتى إدوارد سعيد، عندما تحدث عن الاستشراق، غالبًا ما لجأ إلى النصوص الأدبية، ولم يلتفت كثيرًا إلى الاستشراق الألماني أو الفكري.
فكيف يمكن الحديث عن هذه الثنائية "المستشرقين ونحن"، من جهة، ومن جهة أخرى، عن عالمية المعرفة التي ينبغي أن تتجاوز الهويات، حيث نأخذ الحكمة من أي مصدرٍ، بغض النظر عن هوية صاحبها أو انتمائه؟
د. رضوان السيد:
لقد حاولتُ تبرير أو تسويغ استمرار الاتصال الوثيق بيننا وبين الدراسات الإسلامية في الغرب، ليس فقط من منطلق عالمية المعرفة، بل أيضًا انطلاقًا من طريق وجود مستشرقين جدد، يرون أنفسهم جزءًا منّا، جزءًا من هذه الحضارة العربية الإسلامية، ويدرسونها بصفتهم جزءًا منها. وقد سمعتُ أخيرًا أمين معلوف، بعد تولّيه رئاسة الأكاديمية الفرنسية، يقول: "أنا من الحضارة الإسلامية، أنا من الحضارة العربية الإسلامية". وهذا الكلام يقوله عشرات الأساتذة الموجودين في أمريكا وأوروبا.
وقد ضربتُ مثلًا بهذا الأستاذ الإيراني ـ الألماني نَفِي كرماني، الذي يكتب عن جماليات القرآن. والمقصود أنّ عالمية المعرفة تتيح لنا شركاء يشاركوننا الهموم نفسها. فأنا مثلًا تعلمتُ عند جوزف فانِس، الذي كتب كتابًا في ستة مجلدات عن علم الكلام الإسلامي في القرنين الثاني والثالث فقط، وهو جهدٍ جبّار غير إنساني لشدة جبروته! فكيف يُقال إنه يكره هذه الحضارة أو إنه ضدها؟ هناك عدد قليل من المستشرقين الذين كانوا مبشّرين، مثل هنري لامنس وبرنارد لويس في آخر أمره.
د. حسام الدين درويش:
برنارد لويس بعد تغيير أو تغيُّر موقفه.
د. رضوان السيد:
طبعًا، برنارد لويس عندما اعتنق الأتراك الإسلام، ظلّ يرى في ظهور تركيا الحديثة اتجاهًا علمانيًّا يمكن أن يكون ممكنًا في الإسلام. غير أنه مع صعود الأحزاب الإسلامية، وخاصة في أيام تورغوت أوزال في الثمانينيات، تحول موقفه؛ إذ إنه لم يعد قادرًا على الاقتصار على الهوية تركية فحسب، بل أصبح يراها إسلامية أيضًا. فرأى أنّ الإسلام شيء واسع ومتعدد. وهذا الكلام موجود في كتبه قبل عام 1967. لكن بعد هزيمة 1967، حين شعر بخوف شديد على إسرائيل، ثم بفرح شديد بانتصارها، خصّ العرب بالهجوم، وليس الإسلام. أما موقفه من الإسلام، فلم يظهر إلا بعد تحوّل الأتراك إلى الإسلام.
ما أقصده هو أن المستشرقين، سواء القدماء أو المحدثين، يختلفون في مواقفهم؛ فبعضهم يؤكد أصالة القرآن، وبعضهم لا يؤكدها. لكن، وفي كل الأحوال، يمكن الاستفادة منهم جميعًا. حتى إن باحثًا مثل آرثر جيفري الذي كتب كتابًا ضخمًا بعنوان "The Foreign Vocabulary of the Qur’an" عن المفردات غير العربية في القرآن، وقدم بحثًا شبيهًا بما قام به المستشرقون في القرن التاسع عشر؛ إذ وجد على سبيل المثال، ألف مفردة غير عربية في القرآن؛ يعني ثمة أمور واضحة، وأخرى غير واضحة على الإطلاق، حتى اسم محمد قال إنه غير عربي. أقصد كيفما كان إسراف المستشرقين، تظل الإفادة منهم ممكنة من جهتين:
*- من جهة المعرفة، فهم يقدّمون معرفة قد لا نعرفها أحيانًا، حتى لو لم تكن مقاصدهم حسنة.
*- من جهة المناهج؛ فهم يعرضون مناهج كاملة للبحث والتفتيش والتنقيب والاستنتاج، لم تكن مألوفة أو متعارفًا عليها في أوساطنا الأكاديمية، حتى المتطورة منها، مثل طه حسين وعباس محمود العقاد.
لهذا، نعم، أنا أرى أنّ الاتصال، بقديمهم وحديثهم، ضروريٌّ ومثمرٌ.
د. حسام الدين درويش:
من المناهج التي ذكرتها وتحدثت عنها، وربما أهمها، منهج التأويل أو الرؤية التأويلية، أو الرؤية الهيرمينوطيقية. وهذا يقودنا إلى نقطتين. الأولى هي أنّ الهيرمينوطيقا غالبًا ما تتضمن رؤية فلسفية للعلاقة مع الماضي. وقد ذكرتَ في تصنيفك أنّ هناك طرفًا استشراقيًّا غالبًا ما يشكك في المئتيْ سنة الأولى، وفي وجود الأسس الدينية أصلًا.
د. رضوان السيد:
المستشرقون الجدد فقط، الذين يختلفون عن القدامى.
د. حسام الدين درويش:
ولدينا، من جهة أخرى، طرف عربي - إسلامي يريد أن يرمي بهذا التراث كلّه إلى سلّة المهملات. إذن، فهم لا يطالبون بالقطيعة بالمعنى المعرفي القوي، فحسب، بل يعبِّرون عن نفورٍ وكُرهٍ وازدراءٍ وقرفٍ واحتقانٍ، إلى آخره. وهذان الاتجاهان موجودان. وهنا ربما تكمن أهمية الرؤية الهيرمينوطيقية، وهو أنها تتجاوز الفهم الكلاسيكي البسيط أو التبسيطي القائل إن الماضي هو الذي يُنتِج الحاضر، بينما ذكرتَ أنت، في محاضرتك منذ قليلٍ، أننا، انطلاقًا من همومنا المعاصرة ومنظوراتنا الراهنة، نقرأ الماضي؛ أي إن الحاضر يؤثر في الماضي، أكثر مما يؤثر الماضي في الحاضر؛ لأننا، بأدواتنا المعرفية الحالية، نحاول أن نصوغ أو نعيد صياغة هذا الماضي ونقرأه ونفهمه.
د. رضوان السيد:
إعادة صياغته مرتبطة بأمرين هما: الهموم والقضايا.
فيما يتعلق بالهموم، نواجه مشكلة لا نجد لها حلًّا، فننظر إلى كيف عالجها النبي ﷺ أو كيف تعامل معها الصحابة. أما الأمر الثاني، فهو القضايا الكبرى: قضايا الخير العام، قضايا السلام، قضايا الاجتماع الإنساني، قضايا العيش المشترك، قضايا التسامح، قضايا التعايش، قضايا التعارف…إلخ، وكلها قضايا إنسانية. هؤلاء كانوا بشرًا لديهم نصّ ديني وحياة وحضارة ضخمة، فكيف كانوا يفكرون في هذه القضايا؟ من الطبيعي أن تكون لديهم فرضيات وهموم تشبه همومنا، وقضايا قد تشبه قضايانا، قد لا تكون همومهم مثل همومنا؛ فهم كانوا دولة عظمى وحضارة كبرى، ولم تكن لديهم هموم الضعف التي نعاني منها نحن اليوم. لكن كيف كانوا يعالجون مشكلاتهم ويتأملون فيها؟ لذلك، فإن النظر إلى الماضي بعيون الحاضر يتضمن هذين البعدين: المخاوف والآمال والإمكانيات الضخمة التي نُحرم منها عندما نُقيم قطيعة.
أنا لا أتحدث، هنا، عن التدين الخاص أو عن الإيمان الخالص؛ فهذا أمر لا يستطيع أحد أن يتعرض له ولا يؤثر فيه. انظر مثلًا إلى العهد القديم والعهد الجديد: لم يقلّ عدد اليهود ولا عدد النصارى، بل على العكس، زاد عدد المؤمنين عند النصارى، رغم شلايرماخر وكل الملحدين الغربيين. نحن لا نتحدث عن الإيمان، بل عن قضايا الإنسان وهمومه الكبرى، ومن ضمنها قضية الإيمان بطبيعة الحال.
لقد رأيت بعض الأشخاص يتحدثون عن البيئة في القرآن، وهذه من هموم الإنسان ومخاوفه، فهل يمكن الاستفادة من حلول تفكيرهم في قضايا البيئة؟ لا أعرف، لكنني متأكد أن قضايا السلام، والتعايش والتعارف، والكرامة، ومسألة الحرب والسلم، والعيش مع الآخر، كلها يمكن الاستفادة فيها من تجاربهم.
د. حسام الدين درويش:
على الأقل الاطلاع عليها وأخذ تفكيرهم في الحسبان. طبعًا، هناك مسائل أخرى، مثل الدولة الوطنية والواقع السياسي الراهن الذي يختلف تمامًا عن زمن الإمبراطوريات، وهذا ليس خاصًّا بالمسلمين وحدهم. لذلك، يجب أخذ هذا الاختلاف في الحسبان.
سأختم برأي في هذه المسألة، وهي الأهم من وجهة نظري. ذكرتُ ذلك من قبل، وسأعيده: كل قراءة للنص هي تأويل. والتأويل بالمعنى الذي أفهمه، يعني دائمًا إمكانية التعددية. عندما أقول إن قراءتي تأويل، أعني أن هناك دائمًا إمكانية لقراءة أخرى. وأنت تعلم أنه في الهيرمينوطيقا الصراعات التأويلية لا تنتهي، ولا يمكن حسمها إلا بالقسر. وبالتالي، في المجال المعرفي، يتم امتحان الحجة بالحجة المضادة، والتأويل بالتأويل، ويمكن للمعرفة أن تتطور في هذا الإطار. هل هناك ضرورة، في أي مجال خارج المعرفة، لحسم التأويلات أو لحسم صراع التأويلات؟ وما حدود هذا الصراع؟
د. رضوان السيد:
في رأيي، معنى التأويل هو أن الخلاف أو الاختلاف لا حلّ له، وهذا هو التأويل. في القرآن الكريم: ﴿قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي﴾. كلمات الله هي الاختلافات الكونية، والوقائع المتعددة التي لا تتوحد؛ فالتعددية هي أهم مظاهر التأويل. وكما يقول توماس باور في كتابه "ثقافة الالتباس": جميع المسلمين كانوا مختلفين في كل شيء، حتى في تفسير القرآن؛ فما من آية إلا ولها خمسة تفسيرات أو أكثر، ولم يكن ذلك مشكلة، بل على العكس، كان هناك قبول واحترام متبادل على اختلاف الآراء. أما الفكرة الخبيثة، فهي القول إنه لا يجوز أن يُفسَّر القرآن إلا تفسيرًا واحدًا، بوصفه خطابًا متعلقًا بأفعال المكلفين، وأنه ينبغي للمكلفين أن يعرفوا ما يريد الله. لكن مع وجود الاختلاف، لا تعود هناك معرفة واحدة بالمراد.
هذا كله كلام، فقراءات القرآن نفسها تؤكد ذلك؛ يعني ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾: هل هم الفرسان؟ أم الخيول؟ أم الملائكة؟ أم المجاهدون؟ وليس صحيحًا، إذا تعدلت الآيات، أننا لا نفهم خطاب الله. ثم إن هذا ليس خطابًا تشريعيًّا، بل خطاب وصفي يقول إن هذه الظاهرة تستحق أن يُقسم بها الله عز وجل من مظاهر الكون.
لذلك، وجهة نظري أن المدخل الرئيس في التأويل هو الاختلاف أو التعدد؛ لأنه يقول إن النص لا نهاية له، فهو دائم الولادة، وتتولد منه معانٍ جديدة يستنتجها العقل ويشتغل عليها، وتبدو مُشاهدة في حياة الناس. وهذا معنى أننا مأمورون، كمسلمين وكبشر، بالتعارف: أن أحاول أن أفهمك وتحاول أن تفهمني. وقد قال المفسرون للقرآن قديمًا إن للتعارف فائدتين: الأولى إزالة العداوة؛ لأن الإنسان عدوّ ما يجهل؛ والثانية أنني أعرفك وأنت مختلف عني، ولكن بالتعارف نكتشف القواسم المشتركة، ومن ثم يمكن أن يستفيد كل منا من هذا التعارف المتجدد، فهو لا ينهي الكراهية فقط، بل يبعث على الاعتراف المتبادل، ويبعث على التعاون والتضامن في كثير من المجالات الإنسانية.
د. حسام الدين درويش:
وأضيف هنا أن كلمة "معروف" في اللغة العربية لها بعد معياري، ليس الأمر معرفيًّا فقط، بل هناك بعد معياري أخلاقي.
د. رضوان السيد:
نعم، هناك بعد معياري أخلاقي. والتأويل الديني يُظهر المعنى العميق للدين أكثر مما يظهر لدى الحروفيين. فعندما يقول الله عز وجل: ﴿وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾، يقول البعض إن الله أقرّ القتال، وربطه بالذين يقاتلونكم، ونهى عن الاعتداء. فلماذا نأخذ فقط "قاتلوا الذين يقاتلونكم" ونهمل "ولا تعتدوا"؟ المسألة هنا أن القراءة حروفية لظاهر النص، مع أن هذا التقليدي الأصولي يقول إن التأويل معناه العودة إلى النص، إلى المعنى الأول للنص، إلى المعنى غير الظاهر. فأنت تشتغل بالمعنى الظاهر وتجعله هو القاعدة التي على أساسها تتصرف. لذلك، العبث هو أن يُفهم الدين فهمًا حرفيًّا أو حروفيًّا. فحين يقال لك في مسألة لصلاة: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾، فهل مجرد قراءة بعض آيات وركوع وسجود تكفي للنهي عن الفحشاء والمنكر؟ كيف تستطيع من دون تأويل؟ هل لأنك تقرأ آيات قرآنية تأمرك بالفضيلة؟ ما معنى تنهى؟ "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"، ثم يقول: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾، فهل لأن الله يُذكر، فتنتهي أنت عن الشرور؟ ما معنى الصلاة بركوعها وسجودها والقراءة فيها تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل تعمل سكينة؟
د. حسام الدين درويش:
يعني هناك إمكانيات متعددة.
د. رضوان السيد:
حتى في العبادات التي لا يختلف شكلها، ولا يتعدد المعنى فيها؛ إذ تجد فيها تعددًا، حيث يقال إن الصلاة الحقيقية هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن عليك أن تكتشف. فرأي الصوفي مختلف عن رأي الفقيه. ورأي الفقيه مختلف عن رأي المتكلم في مسألة النهي عن الفحشاء والمنكر، فكيف تُفهم هذه الصلاة؟
د. حسام الدين درويش:
هذه رؤية إيجابية جدًّا للتأويل، تأتي من أستاذ متخصص في الدراسات الإسلامية، مع أن الصورة الشائعة تشير إلى أن المشكلة الكبرى في المجال الديني تكمن في رفض التأويل، ورفض التعددية والاختلاف، والسعي إلى تأكيد أحادية دوغمائية تريد أن تفرض ذاتها على الآخر.
د. رضوان السيد:
الإسلام في أصله واسع. جاء رجل إلى النبي ﷺ فأسلم، وقال: "يا رسول الله، قومي كلهم ينكرون دعوتك". فقال له النبي ﷺ: "اجلس هنا وتعلم"؛ يعني تعاليم الدين. وبعد شهر استدعاه، فقال له: "ظننتك يا رسول الله نسيت"، فرد النبي ﷺ قائلا: "اذهب إلى قومك بما تعلمته: بالتوحيد، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، فإن آمنوا فذلك خير، وأنت عارف بهم، وإن لم يؤمنوا فعد إليّ". فالإسلام واسع وعريض، يتعدد ويشمل الناس جميعًا. وترجمة هذا الرجل موجودة.
د. حسام الدين درويش:
لا أعرف كيف سيتصرف الحرفيون أو الحروفيون مع هذا؟
د. رضوان السيد:
في هذه الأمور أنا أتجادل كثيرًا معهم، وبالذات السلفيين، وهم لا يفقدون صبرهم. أما الذين يفقدون صبرهم، فهم جماعات مثل القاعدة وداعش؛ إذ يهددون بالقتل، وينكرون الدولة، ويرون أنها لا تطبق الإسلام، وكذا مثل هذه الأمور. أنا أرى أن التحدي يكمن عندنا في الاتجاهات الأكاديمية الليبرالية، وفي الدراسات الإسلامية، وفي مسألة إقامة الدولة الوطنية. لم يعد هناك حلٌّ غير السكينة في الدين، وتجديد تجربة الدولة الوطنية، وإقامة علاقة صحية مع العالم. وهذه كلها أمور تعاني في أوساطنا من اضطرابٍ شديد.
د. حسام الدين درويش:
بالفعل، المعيار الأول في محاكمة ونقد الإسلاميين أو الإسلامويين هو مسألة الدولة أو رؤيتهم للدولة. فهم لا يقيمون وزنًا للرابطة الداخلية، ومن ثم تفشل الأمور. وأنا أعرف رأيك الذي سأستحضره سريعًا في خصوص مسألة الدولة. فأنت تعرف وائل حلاق والعاصفة التي أثارها حول التناقض بين الدين والشريعة والإسلام من جهة، والدولة الحديثة من جهة أخرى، وهو ما أثار غضب الإسلاميين؛ لأنه قال لهم: لا يمكن إقامة الدولة الإسلامية التي تسعون إلى إقامتها. ومع أنه حاول مراوغتهم بعد ذلك، فإنه، من ناحية أخرى، وضع مشكلة أمام المسلمين؛ كيف نتعايش مع حداثة بلا أخلاق، ونحافظ في الوقت ذاته على الأخلاق؟
د. رضوان السيد:
من وجهة نظره، الإسلام منظومة عظيمة، لكن الحداثة لا تسمح بالأخذ بهذه المنظومة. فالحداثة، نفسها، إجرام وشرٌّ كثيرٌ. سألته: طيب، أين نذهب؟ فقال لي: "هل أنا شيخ؟ أنا واعظ، أنا أشخّص الأمراض". فقلت له: أنت مرض نفسك، صرت مرضًا. لست غاضبًا من رأيك في أن الإسلام مطبّق، ولا مشكلة إلا مع الأصوليين المتطرفين، بل أنا غاضب؛ لأنك تريد تدمير العالم بحجة أن الغرب سيء.
د. حسام الدين درويش:
لكن، حسبما فهمت، لقد فوجئت برأيه، رغم أنك كنت متابعًا له قبل ذلك.
د. رضوان السيد:
أنا أعرف دراساته الإسلامية، وهو أعظم مؤرخ للفقه الإسلامي (الفقه وليس الفكر). لا يعرف علم الكلام كثيرًا، ويعرف قليلًا من الفلسفة؛ فقد ترجم "الرد على المنطقيين" لابن تيمية، لا يعرف علم الكلام، ولكنه ملمّ بالفقه الإسلامي؛ هذا التراث الضخم، فهو يعرف ثلثي المخطوطات الفقهية معرفة دقيقة.
هذا الرجل عنده كتاب بعنوان "الشريعة"، وكتب سابقة في النظريات. كتاب الشريعة معجزة في فهم الفقه الإسلامي كمنظومة تشريعية وفكرية. أنا أراها ثقافية أكثر منها تشريعية أو فكرية. لكن على كل حال يعرفها معرفة جيدة، ولديه رؤية لمحاولة المسلمين، إسلاميين وغير إسلاميين. فهو يتلاءم مع الحداثة من خلال الفقه (مجلة الأحكام العدلية العثمانية وما شابهها). ورأيه أن هذا التلاؤم فشل بسبب ذنوب الحداثة. لكنني لم أكن أتوقع أن يؤلف كتابًا بعنوان "الدولة المستحيلة"، أو كتابًا بعنوان "قصور الاستشراق"، كأنه يقول إن إدوارد سعيد مستشرق متوهَّم. فهو يطالب المستشرقين بعدم خيانة القيم الليبرالية التنويرية الأوروبية؛ لأنهم خانوا هذه القيم حين صوّروا الإسلام بصورة سيئة. ألا يعرف إدوارد سعيد أن الليبرالية نفسها كانت سبب المصيبة التي يطالب المستشرقين بالوفاء بها؟ أمر عجيب، لكنه شائع عند اليساريين المتطرفين كلهم.
د. حسام الدين درويش:
المؤسف أنه حتى اليمين الإسلامي استند في العالم الإسلامي إلى طه عبد الرحمن أيضًا، وأصبح يمثل ظاهرة.
د. رضوان السيد:
طه عبد الرحمن قبل وائل حلاق، كان يرى أن العلمانية شرٌّ غربي مطلق، شيطان كبير. في زمننا، عندما كان كل المغاربة يساريين، كانوا يهاجمونه ويستهزئون به ويطالبون بفصله من الجامعة، ثم صار فيما بعد فيلسوفًا كبيرًا. أنا زرته مرتين، وهو رجل طيب، لكن لديه وهمٌ بأن العلمانية شيطان كبير.
د. حسام الدين درويش:
أول من قدّم العلمانية في العالم العربي بمعنى إيجابي هو بطرس البستاني في نفير سوريا، حيث تحدّث عن ضرورة الفصل بين الديني والسياسي. أما أول من قدّمها بصورة شيطانية فهو جمال الدين الأفغاني في كتابه "الرد على الدهريين" الذي ترجمه إلى العربية محمد عبده، حيث قسّم العالم إلى قسمين: كل ما هو ديني جيد، وكل ما هو غير ديني سلبي. أما طه عبد الرحمن، فقد تجاوز استخدام كلمة "الدهري" إلى ما سمّاه "الدهرانية".
د. رضوان السيد:
عند طه عبد الرحمن الدولة نفسها ظاهرة دهرانية مرتبطة بالغرب، والدولة نفسها ظاهرة سيئة. وهذا أمرٌ شديد. فعندما كان في بداياته، كتب عن الاستقلال الفكري، وعن التجديد في الفكر الفلسفي، وعن الحق في الاختلاف، وهذه أمور جيدة. وكان يتحدى بها العلوم الاستعمارية كالأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا. وهو أستاذ فلسفة الرياضيات، ومنطق رياضي.
د. حسام الدين درويش:
وله عدة قوية في المنطق واللغة.
د. رضوان السيد:
لكن بعد ذلك، ربط جميع سيئات العالم بالعلمانية. ثم جاء وائل حلاق وكتب عنه كتابًا.
د. حسام الدين درويش:
وهو يرى فيه أن العلمانية تعني الانفصال عن الأخلاق.
د. رضوان السيد:
وعما هو مقوّم الحياة الذي يُبقي الإنسان حيًّا: الدين والأخلاق.
د. حسام الدين درويش:
في النهاية، لطه عبد الرحمن أصلاً رؤية استغربت جرأته على طرحها؛ وتتمثل في القول إن المسلم يبقى أخلاقيًّا في علاقته مع ذاته، مهما فعل. وغير المسلم لا أخلاق حقيقية له مهما فعل؛ لأن ما يفعله يبقى شكلانيًّا؛ فهو يعيش في عالم غربي يسوده العدل، ومن الطبيعي أن يتعامل بأخلاق. لكن في علاقته مع ذاته، وفي جوهره، يبقى غير أخلاقيٍّ؛ لأنه غير مسلم. فهل من المعقول قسمة العالم بهذه الطريقة؟
د. رضوان السيد:
الدين هو الأخلاق، والأخلاق هي الدين. ولأن الغرب انفصل عن الدين، فقد انفصل عن الأخلاق أيضًا. لقد أمضى أربعين سنة يعمل على هذه الفكرة، ضمن المنهج الائتماني والمنهج الدهراني. في البداية، كان يسميها "العلمانية"، ثم صار يسميها "الدهرانية"؛ أي إن الدولة ظاهرة دهرية أو دهرانية.
د. حسام الدين درويش:
أعلم أن الحديث طال، لكن لدي سؤال أخير. كان المتدينون في السابق - مسلمين وغير مسلمين - يستصعبون تقبّل فكرة وجود إنسان غير مؤمن وأخلاقي في الوقت نفسه؛ لأن الدين في نظرهم أساس الأخلاق، والأخلاق أساس الدين. فكيف يكون غير المتدين أخلاقيًّا؟
اليوم نعاني من ظاهرة أخرى: وجود كثير من المتدينين – مسلمين وغير مسلمين – يفصلون الدين عن الأخلاق. فهم يريدون تطبيق التعليمات والشرائع والعقائد، بغض النظر عن كونها أخلاقية أو غير أخلاقية. وقد يصل الأمر ببعضهم إلى القتل، وسفك الدماء، والسرقة، والنهب، وكل ذلك بزعم أنه "من الدين". فهل يمكن القول إن بعض الاتجاهات الدينية الإسلامية، اليوم، تفهم الدين على أنه منفصل عن الأخلاق، حيث يصبح هناك دين بلا أخلاق؟ وهنا، نحن لا نتحدث فقط عن "أخلاق بلا دين"؟
د. رضوان السيد:
نحن لا نعاني من وجود "دين بلا أخلاق"، نحن نعاني لدى الجمهور الإسلامي من وجود سؤال: هل صحيح أن هناك ما يسمى "الضمير الأخلاقي" المستقل عن الدين؟
نعم، هذا ما يزال موجودًا عند المسلمين، وإن كان قد ضعف. المؤسسات الإنسانية دائمًا تبرز في مصائبنا: يبرز الصليب الأحمر، يبرز أطباء بلا حدود، تبرز منظمة العفو الدولية. تبرز هذه الجهات، وهي ليست جهات إسلامية، وليست مسيحية. إذن هناك ما يسمى الضمير الأخلاقي. هذه كانت مشكلة عند الغربيين عندما وضعوا ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ إذ كانوا يزعمون أن هذه القيم من اختراع العلمانية، وليس للمسيحية علاقة بها. لكن الأمر بدأ يتصدّع عندنا: فما زال هناك أناس منصفون متعاطفون، وكثير منهم أخلاقيون، بل يستشهدون بالبابا فرنسيس في الدعوة إلى الضيافة، والجوار، والسلام، والرحمة. وهذه كلها قيم إسلامية في أصلها، لكنها موجودة عند البابا باسم المسيحية. إذن، لدينا ملفان:
-الأول حول إمكانية وجود دين بلا أخلاق.
-الثاني الذي ذكرناه، وهو إنكار وجود أخلاق بلا دين. كان اعتقادًا شائعًا لدى المثقفين كذلك، لكنه تصدع وصار ندًّا للمثقفين ولدى الجمهور؛ إذ بدأ الاعتراف بأن هناك أخلاقًا حتى عند من ليسوا مسلمين. لكن مسألة "الدين بلا أخلاق" ليس لها تبرير عندنا، ولا يتحدث عنها أحد. نحن نعلم أن هناك متدينين فاسدين وقاصرين أخلاقيًّا. لكن المسلم عمومًا حسن الظن بدينه، فإذا وجد شخصًا يصلي، ولكنه يسرق، فإنه يفضحه ويصفه بالمنافق. المسلم حسن الظن بالدين في كل الحالات. وكان سيّئ الظن بوجود أناس صالحين من غير المسلمين.
أما الآن، فقد تزعزعت هذه الفكرة. والمسلم العادي ما يزال، وأنا لا أتحدث عن المثقفين، لا يقول بوجود متدين، ممكن أن يكون متدينًا بلا أخلاق. فالحكم عنده هو الأخلاق على تدينه، فهو مستعد فورًا أن ينفي تدينه، إذا تبين أنه غير أخلاقي. ولهذا، كانت فظائع "داعش" في نظر المسلمين تكمن في قتل الناس. فكيف يمكن أن تكون مسلمًا وتقتل بهذه الطريقة؟ جميل أن تدعو إلى تطبيق الشريعة، أو إلى إقامة دولة إسلامية؛ لكن، لماذا القتل والذبح والإغراق؟ المسلم المتدين لا يقرّ هذه التصرفات غير الأخلاقية، ويعدّ أن من يفعلها "لا دين له".
د. حسام الدين درويش:
شكرًا جزيلًا، دكتور رضوان، على هذا الحوار الغني، وأتمنى وأتوقع أن يكون مفيدًا لكل المهتمات والمهتمين بالدراسات الإسلامية.
د. رضوان السيد:
أوجّه شكرًا خاصًّا للدكتورة ميادة كيالي، فهي مناضلةٌ منذ عشرين أو ثلاثين سنة في هذه القضايا.
د. حسام الدين درويش:
هي كذلك مع "مؤمنون بلا حدود"، وهي، بالفعل، أكثر من حمل ويحمل هذه المؤسسة على كتفيه.