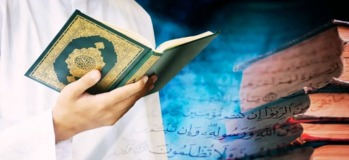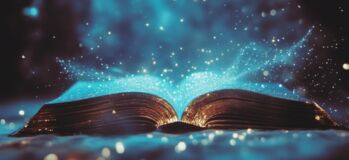حوار مع الدكتورة ميادة كيالي: من التخطيط الهندسي إلى تأملات الفكر والدين
فئة : حوارات

حوار مع الدكتورة ميادة كيالي:
من التخطيط الهندسي إلى تأملات الفكر والدين
حاورها د. ساري حنفي
"الدين حاضر في كل العلوم الأخرى، وخاصة بالنسبة لنا كعقل عربي"
د. ساري حنفي:
أهلاً وسهلًا بكم في حلقة جديدة من سلسلة بودكاست ربط البحث الاجتماعي بالمجتمع.
معكم ساري حنفي، مدير مركز الدراسات العربية والشرق أوسطية في الجامعة الأمريكية في بيروت، ومؤسس البوابة الإلكترونية حول الأثر الاجتماعي للبحث العلمي في ومن العالم العربي: بوابة "أثر".
يسرّني اليوم كثيرًا أن أقدّم الزميلة الدكتورة ميادة كيالي.
مرحبًا بكِ ميادة.
د. ميادة كيالي:
أهلًا وسهلًا بك.
د. ساري جنفي:
ميادة كيالي باحثة وكاتبة سورية، مديرة "سراج للأبحاث والدراسات" في هيئة أبو ظبي للإعلام، والمؤسِس والمدير العام لدار النشر "مؤمنون بلا حدود" في بيروت والشارقة.
بالإضافة إلى ذلك، درست الهندسة المدنية، وحصلت على الماجستير والدكتوراه في الحضارات القديمة من جامعة فان هولاند – كلية الحضارات والأديان في أمستردام.
صدر لها عدد من المؤلفات الإبداعية، منها: أحلام مسروقة، ورسائل وحنين. كما أصدرت مؤلفات أكاديمية، من بينها كتاب المرأة والألوهة المؤنثة، وكتاب آخر هندسة الهيمنة على النساء: الزواج في حضارات العراق ومصر القديمة.
إذن، مرة أخرى، مرحبًا بكِ ميادة، ويسرّني جدًّا استضافتك.
وفي الحقيقة، قبل أن أبدأ، أودّ الإشارة إلى أمر يجمعنا: نحن الاثنان مهندسان مدنيّان، وهناك فارق سنتين بيننا في كلية الهندسة.
هل يمكنك أن تحدثينا عن مسارك؟ كيف انتقلتِ من الهندسة المدنية إلى الاهتمام بالدراسات الدينية، ومن التركيز على التاريخ؟ هل يمكن أن توضحي لنا السياق الذي كان في سوريا آنذاك؟
د. ميادة كيالي:
نعم، بالنسبة لي، هناك سؤال، أو بالأحرى حادثة حصلت معي عندما كنت في الصف التاسع الإعدادي.
في ذلك الوقت، كنتُ مهتمة جدًّا بالدراسات الدينية؛ لأنني انتقلت إلى مدرسة كانت فيها مُدرّسة الدين تملك صوتًا عذبًا، وتقريبًا، يمكن أن تقول إن ثلاثة أرباع بنات المدرسة تحجبن على يديها. أتحدث هنا عن مدرسة في مرحلتيْ الصف الثامن والتاسع، حيث انتقلتُ إلى مدرسة الزكي الأرسوزي، مع أنها ثانوية، بسبب أنني كنت من الأوائل في الصف السابع الإعدادي. قررت المديرة أن ترفع من مستوى المدرسة الإعدادية -الثانوية، فجمعت كل الأوائل من مدارس دمشق، وضمّتهم في شعبة خاصة بالأوائل في مدرسة الزكي الأرسوزي. فكنا مدللات عند الجميع.
كنّا ننقسم في درس اللغة: نحن 25 طالبة من الأوائل، 12 في شعبة الإنجليزية، و13 في شعبة الفرنسية. كنا ننقسم في درس اللغة، وكان هناك نوع من العناية بنا، حتى نرفع فعلًا من مستوى المدرسة.
وكانت عندنا مدرّسة التربية الإسلامية، في ذلك الوقت، وهي تملك أسلوبًا وصوتًا جميلين في الحقيقة. وأنا لديّ خصلة أنني أحب أن أكون دائمًا حاضرة في الصف، لا أحب أن أستمع فقط، بل أحب أن أشارك دائمًا. فكانوا يفرحون؛ لأن مادة التربية الإسلامية لم تكن من المواد التي يشارك فيها الطلاب كثيرًا ويجيبون، بينما أنا كنت أشارك. فدائمًا كان عندي هذا الحب للمشاركة.
في إحدى المرات، قالت لي المدرّسة: "آه يا ميادة، والله إنك بئر عميق، ولكن، ولكن… آه، يعني الحجاب!" أتذكر حين نجحتُ في الصف التاسع، كان أحد أصدقاء أخي الكبير يتحدثون معي، وكانوا يعرفون أنني دائمًا أهتم بالقصص الدينية، وأحب أن أفتخر بالدين بطريقة جميلة، حيث أشعر بشعور بالفخر لأني مسلمة. فكانوا يتحدثون عن قصة: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب". فقلت لهم: "نعم، طبعًا، العلم أثبت أن هناك جرثومة لا تقتل إلا بالتراب".
فقام صديقنا، وقال لي: "ولو يا ميادة! كل المعقمات الآن والمنظفات، ولا يوجد غير التراب ليقتل الجرثومة؟"
وقتها، بالنسبة لي، صُعقت من هذا، وشعرتُ بسطحية وهشاشة الشيء الذي كنت أدافع عنه، أنه ربما يمكن أن نقول إننا في ذلك الوقت لم يكن بين أيدينا شيء، مثلًا عندما نذهب في نُزهة أو رحلة، وأحيانًا كثيرة نحتاج أن نُزيل الزفر بالتراب، ثم نغسلهم إلى أن نعود إلى البيت. العملية نفسها.
فقلت: هناك فرق كبير جدًّا بين أن أبرّر بأن أحاديث الرسول هي عبارة عن علوم، وبين أن أبحث عن السبب الحقيقي. وراء كل حديث أو حادثة، طبعًا، في ذلك الوقت، كان لدي أيضًا، من جانب آخر، في الصف الثامن والتاسع، في هذا العمر، كنت أقول: لماذا القرآن متعبّد بتلاوته فقط؟ يعني، فقط إذا قرأت ختمة من الجلدة إلى الجلدة، أنا أستطيع أن أقوم بعبادة؟ لماذا لا يكون متعبدًا بفهمه؟
فحاولت أن أبوّب السور بأحداثها، فأقول: في سورة البقرة هناك كذا، في قصة موسى كذا، في سورة المائدة كذا، في سورة مريم كذا، وصنّفتها واحتفظت بها لفترة. كنت أحاول أن أدرس بطريقتي.
ثم جاءت الحادثة أيضًا لتوسّع أفقِي. وطبعًا، تابعتُ ودخلت كلية الهندسة المدنية. كما تعلم، عندنا الكلية لا تدخلها فقط بناءً على ما ترغب، وإنما حسب العلامات، وهذا ما يوجّهك، إمّا للعلمي أو للأدبي.
وللأسف، هذا التصنيف يُقلل من أهمية العلوم الاجتماعية، التي كانت تُترك للمجموع الأدنى، بينما الكليات العلمية كانت تأخذ النصيب الأكبر. لن نقول "الحصة"، بل "النصيب الأكبر".
فدخلت، ولكن كان لدي حب للهندسة؛ لأن عندي ميولًا للرسم وميولًا فنية، كانت ظاهرة في ذلك الوقت، وفي الوقت نفسه كنت أحب مادة الرياضيات. فنصحني أحد الأشخاص قائلاً: "ادخلي مدني، أفضل من العمارة". كنت محتارة بين المدني والعمارة. أما الأهل، فكانوا كلهم يضعون أعينهم على ماذا؟ على كلية الطب. لكنني رفضتُ رفضًا قاطعًا. الطبّ؟ لم أشعر أنه يتناسب معي أبدًا، ولم أندم على هذا الخيار.
دخلت كلية الهندسة المدنية، والتقيت في الكلية بالدكتور محمد شحرور، في السنة الثانية، حيث درسنا مادة "ميكانيك التربة"، وفي السنة الخامسة درسنا مادة "الأساسات". فكان لهذا اللقاء أثره في حياتي؛ لأنه كان من الأساتذة الذين يشرحون ويربطون بين فلسفة الهندسة، ليس فقط كأرقام، بل كفلسفة بناء، وفلسفة مواد البناء، وهوية التربة؛ فهذه الأمور لم نكن نسمعها من أساتذة آخرين.
د. ساري حنفي:
في الحقيقة، ما أثار انتباهي هو مدى إخلاصه للتعليم، وإلى آخره، لكن لم ألاحظ اهتماماته الثقافية الأخرى التي تتجاوز الهندسة. لذلك، عندما صدر كتاب: القرآن، كتابه الأول، شككتُ: هل هو نفسه؟ أم لا؟ لكنني أعتقد أنني أذكر جيّدًا، كان مكتوبًا على الغلاف الدكتور المهندس محمد شحرور، فعرفت أنه هو نفسه. واشتريتُه وقتها.
د. ميادة كيالي:
بعد أن تخرجت في عام 1986 من كلية الهندسة المدنية، كنت ألتقي الدكتور شحرور؛ لأن مكتبه كان خلف بيت أهلي؛ أي بيننا خطوات فقط، فكنت أراه دائمًا أثناء الطريق وأسلّم عليه. بعد سنتين من تخرّجي، عملت في هاتين السنتين الأوليين في شركة جبل قاسيون، وبعدها انتقلت لأعمل في مخبر المحافظة، حتى نهاية الفترة التي سبقت تركي للحقل الهندسي. اشتغلتُ في مخبر المحافظة، وهو المكان الذي عدت فيه لألتقي بشحرور من جديد. كان مكتبه من أهم المكاتب الهندسية التي تُصدر تقارير ميكانيك التربة، والتي يُعتمد بناءً عليها هذا الحل أو ذاك. وكان مخبر المحافظة هو المخبر المعتمد لأي مشروع، من أجل أن يمنح الموافقة على العينات ونتائجها، سواء في كل نواحي البناء: مواد البناء، أو العينات الأسطوانية من الخلطات البيتونية أو من الأسفلت. فكان يأتي ويجلس معنا. كنا ثلاث مهندسات، في غرفة واحدة، وكان الدكتور شحرور دائمًا يحدّثنا، ويطرح علينا قصصًا، ويعرض علينا قضايا خلافية في العقيدة، والإيمان، والعبادات، والمحرمات.
لكن في ذلك الوقت، لم أكن أعلم إطلاقًا قادم على هذا المشروع أصلًا؛ لأن هذا الحديث كان في عام 1988، بينما صدر كتابه في عام 1990. بقينا سنتين في هذا الحوار والنقاش، إلى أن علمنا بوجود كتاب سيصدر، ثم صدر الكتاب. وطبعًا، عندما صدر الكتاب، شعرتُ وكأن الشيء الذي كنت أبحث عنه في تمرّدي على السائد قد وجدته. ووجدتُ الدعم في أفكار شحرور وكتابه، وبدأت أتحمّس، وأصبحت أناقش في كل مجال، بكل قوّة، وقد صنع حالة غير مسبوقة.
د. ساري حنفي:
أنا كنت في فرنسا، لذلك لا أعلم بالضبط ماذا حدث، لكنني علمتُ أن محمد شحرور أقام ندوات في دمشق بعد صدور الكتاب.
د. ميادة كيالي:
بمجرّد صدور الكتاب، واجه رفضًا شديدًا، ومن ضمنهم الشيخ البوطي، الذي قيل إنه وزّع في الجوامع منشورات بعنوان "شذوذات محمد شحرور". وقيل إن من كتبها هو الشيخ البوطي.
وطبعًا، بدأ الناس بإصدار الكتب ضده، رغم أنني كنت قد استمعتُ إلى شحرور لمدة سنتين قبل صدور الكتاب. وبعد صدوره، قرأتُ المقدّمة – التي هي أول 200 صفحة – وكرّرتها أربع أو خمس مرات، لصعوبتها عليّ. فكنت أستغرب كيف يمكن الرد بهذه السرعة. ربما الآن، في وقتنا الحالي، مع الذكاء الاصطناعي، يمكن للمرء أن يحاول أن يُعدّ ردًّا سريعًا، ويُراجع الكتاب. أما في ذلك الوقت، فلقراءته ونقده، يحتاج الأمر إلى وقت طويل. طبعًا، إذا كنت تؤمن بأن النقد إيجابي، قبل أن تؤمن فقط بأنك تريد تكفير هذا الشخص.
د. ساري حنفي:
أنتِ تحاولين أن تقولي لنا إن النقد كان مبنيًّا على مبدأ أستاذ في الهندسة، ما علاقته بتفسير القرآن الكريم؟
د. ميادة كيالي:
ما عهدنا على موائد العلماء. وهذه العبارة كانت دائمًا تُقال لنا. حتى إنني عندما كنت أناقش مواضيع تتعلّق بشحرور، كانوا يقولون لي: "هل نقدر نحن أن نناقشك في الهندسة المدنية؟ نحن لا نعرف شيئًا في الهندسة المدنية". وكذلك نحن لا نناقش. قالتها لي مرةً مدرسة، وكانت هناك 200 امرأة يحضرن عندها. قالت لي: "وكذلك نحن لا نناقش". فقلتُ لها: "لماذا لا نناقش؟ ما الذي يمنع أن أكون مهندسة ومؤمنة، وهذا الكتاب نزل باللغة العربية، ومن المفروض أنني أفهمها، وهو خطاب للعالمين، وفيه رحمة للعالمين؟! كيف؟ الله لم يقل لي أن تتلمذي على يد أي معهد، أو أي شيخ، أو أي جهة، بل قال: هذه هي الرسالة لك، وقال: "لا إكراه في الدين"، وعلَيَّ أن أتبيّن الخطأ من الصواب.
د. ساري حنفي:
حدث انقطاع، ثم ذهبتِ إلى الإمارات، كيف كان لقاؤك مع شحرور، وبدايتك هناك؟ بدأت تعملين عمليًّا ضمن فريق مع محمد شحرور. هل يمكنك أن تحدّثينا عن هذه المرحلة؟ لأنها، في رأيي، مهمة جدًّا.
د. ميادة كيالي:
في الفترة التي صدر فيها كتاب شحرور؛ أي من عام 1990 إلى عام 1994، وهي الفترة التي اعتزلتُ فيها الهندسة والحياة كلها، وتزوجت وتفرّغت للأمومة والزواج، كان يحدث لقاءات، وبدأت صالونات أدبية، وكان اتحاد الكتّاب، في مختلف المجالات، يقيم محاضرات. مرة واحدة أُلغيت له محاضرة في مكتبة الأسد؛ لأن حجم الحضور فاق التوقعات، فخافوا، فألغوها. كانوا قد وضعوا شاشات خارج القاعة، خارج المكان، وكان العدد كبيرًا جدًّا، فخافوا وألغوها.
بعد عام 1994، تزوجت وسافرت إلى لبنان. وحتى عام 2006، كنت فقط أتلقّى منه كل كتاب جديد يصدر، أتلقّاه مرفقًا بالإهداء. وانعزلتُ نوعًا ما عن الحياة الفكرية والأكاديمية، وحتى عن الحياة العملية، وتفرّغت لتربية الأولاد، ولأكون قد ربّيتُ أسرة.
في عام 2006، بعد حرب تموز التي وقعت على لبنان، اضطُررت إلى السفر ومغادرة المكان بسبب الدمار والتضرّر، فأخذت أبنائي وذهبت إلى الإمارات. هناك، التقيت بشحرور، وكنت مستضافة، وكان هناك احترام لفكره، وكان ينوي تحويل مجمل فكره إلى اللغة الإنجليزية. فشكّل فريقًا، وقال لي: "ميادة، هل لديك مانع أن تشتغلي معي؟". قلت له: "أنا أتمنى ذلك، وأنتظر هذا الوقت الذي أعود فيه للفكر، ولهذا الحراك الجميل." كنتُ مسؤولة عن المواد، وتلخيص الأفكار الأساسية من كل كتبه، وكانت خمسة كتب، لنلخّص منها الأفكار الأساسية، ونقدّمها للدكتور أندرياس كريسمان، الذي كان مشرفًا على إعادة صياغة هذا الفكر وتحريره وتقديمه للقارئ الأجنبي. وقدّم للكتاب الدكتور ديل أكلمان.
كانت تجربة مهمّة جدًّا بالنسبة إلي، ليس فقط لأنها أعادتني إلى فكر شحرور، بل أيضًا لأنها جعلتني أكتشف مواهب أخرى ربما شكّلتها الهندسة المدنية في شخصيتي، وهي موهبة تنظيم العمل وإدارته: كيف يتم توزيع الوقت، وتخطيط العمل حتى يكتمل، وكل الأشياء الجانبية، من التحضير، ومن دار النشر التي سنتعامل معها، ومن تحديد موعد النشر. تابعتُ كل هذه الأمور خطوة بخطوة، حتى بروتوكول الاجتماعات مع أندرياس وديل أكلمان. وكانت معنا مهندسة ثانية، رحمها الله، الدكتورة المهندسة رندا السهلي، توفّيت لاحقًا، لكنها لم تُكمل معنا المشوار، توقّفت في نهايته تقريبًا، وأكملتُ أنا مع شحرور.
د. ساري حنفي:
كيف تمأسس هذا الاهتمام، من خلال "سراج"؟ هل يمكنك أن تحدّثينا عن دخولك إلى مؤسسة "سراج"؟
د. ميادة كيالي:
في الحقيقة، في ذلك الوقت، من خلال عملي مع شحرور، انفتح المجال أمامي لأن أكون مشرفة على
تأسيس مركز دراسات يُعنى بالفكر المتنور، ويقدّم دراسات وأبحاثًا في هذا المجال الذي أحبّه، فكانت مؤسسة "سراج". كانت تجربة غنيّة جدًّا بالنسبة لي؛ إذ قابلت مفكرين ومثقفين من الوطن العربي، وربما للمرة الأولى في حياتي. هذه الشبكة، في بدايتها، كنت أختار أفرادها انطلاقًا من معيار الدكتور شحرور؛ لأنه إذا كان الشخص لديه - على الأقل - موقف من شحرور، فهذا يدلّ على أنه اطّلع عليه وبلور رأيًا تجاهه، ومن خلال ذلك يمكنني أن أعرف مدى تنوّره، أو أن لديه بعض التحفظات على شحرور، ولكن أيضًا يحمل أفكارًا قيّمة أخرى.
د. سار حنفي:
هل يمكن القول إن مركز "سراج" كان مهتمًّا بالفكر الإسلامي المتنور، وتحديدًا بتجديد الفكر الديني. ما علاقة "سراج" بمؤسسة "مؤمنون بلا حدود"؟
د. ميادة كيالي:
من خلال عملي في "سراج"، تعرّفت على مجموعة من الباحثين المهمين، وكان بينهم تفاوت فكري واضح. ومن بين هؤلاء من تمّ اختيارهم في النهاية للعمل في "سراج". في الحقيقة، كانت هذه الشرارة الفكرية التي دفعتنا إلى تأسيس مؤسسة "مؤمنون بلا حدود". في تلك الفترة، كنت قد وصلت إلى قناعة بأن شحرور ليس حالة قائمة بذاتها فحسب، بل نحن بحاجة إلى عمل مؤسسي يضمّ شحرور وغير شحرور، وكل المشارب والمدارس الفكرية التي عملت على تجديد الفكر الديني، من أجل فتح المجال أمام التعاون والتشارك في نشر الأبحاث والاطلاع عليها.
بدأ هذا الانفتاح من خلال تعارفي على هؤلاء الباحثين، ثم انفتح أمامي لاحقًا مجالٌ أوسع للتعرف على باحثين في شبكات أكبر. كما أنني لم أساهم فقط في مشروع شحرور، بل حتى جمال البنا نفسه تواصل معي يومًا ما بعد لقائنا في مصر، وأعرب عن رغبته في أن أساعده في الحفاظ على مكتبته. شعر بأن لدي هذا الهمّ الثقافي.
د. ساري حنفي:
هل يمكنك أن تقدمي للقارئ ولمن لا يعرف، من هو جمال البنا؟
د. ميادة كيالي:
جمال البنا، رغم أنه شقيق حسن البنا، إلا أنه كان على النقيض منه فكريًّا. جمال البنا كان من أوائل من فسحوا المجال لوجود رؤية ثانية في الفقه، وأظهر مرونة كبيرة في التعاطي مع القضايا الفكرية. كما خفّف من أعباء كثيرة.
د. ساري حنفي:
وكان مناضلًا نقابيًا له اهتمام بالسوسيولوجيا في مصر.
د. ميادة كيالي:
وله كتابات ضخمة. مكتبته كانت تحتوي على نحو 40 ألف كتاب. طلب مني ذات يوم أن أساعده في أن تبقى هذه المكتبة منارة مفتوحة لطلاب العلم، وأن أساعد من خلالها الباحثين والطلبة الذين لا يمتلكون الإمكانيات، وكان يدعمهم حتى اللحظة الأخيرة، سواء بطباعة أبحاثهم أو دعمهم ماديًا، مع أنه كان يعيش ظروفًا صعبة... لكن الحديث عن ظروف جمال البنا يتطلب تسجيلًا آخر، فلا أستطيع الحديث عنه هنا بتفصيل. أيضا طلاب ومحبو الدكتور الراحل أبو القاسم حاج حمد، تواصلوا معي أيضًا لأن هناك مخطوطات لا تزال موجودة غير منشورة، ومكتوبة بخط يده، فعملنا على هذا المشروع أيضًا. أيضا الدكتور مصطفى أبو هندي كان كذلك يرغب في إنشاء مركز أديان في المغرب، وقد تمكنا من ذلك. كان لدي شعور أننا بدأنا بحلم صغير، لكنه فتح المجال للتوسع نحو أحلام أكبر من ذلك بكثير.
د. ساري حنفي:
أعدتم نشر أعمال نصر حامد أبو زيد؟
د. ميادة كيالي:
طبعًا هذه كانت في ما بعد مع "مؤمنون بلا حدود". فكرة "مؤمنون بلاحدود" كانت أننا لا نحتاج إلى مكان محدد، لأن تجمع هذه الشبكة من الباحثين، بل يمكن أن يكون ذلك عبر العالم الافتراضي، حيث يتم جمعهم، وكانت هذه هي الفكرة الأساسية.
د. ساري حنفي:
ما معنى كلمة "بلا حدود"؟
د. ميادة كيالي:
هناك بعض الأشخاص يتساءلون ألا تفهم بأنها ملحدون؟ الاسم مقسم إلى قسمين؛ مؤمنون، وبلاحدود، بلا حدود مثل أطباء بلا حدود؛ فهي من كل مكان، ونجمع معهم المؤمنون. المؤمنون بخيرية الإنسان، المؤمنون بقدرة الإنسان على صنع الخير، وعلى التمسك بالقيم والأخلاق، واحترام الاختلاف واحترام التعددية.
د. ساري حنفي:
وهذا هو ما جعلكم تفتحون أبواب العلوم الاجتماعية، فلو قمتُ بتحليل مضمون موقع "مؤمنون بلا حدود"، أجد فيه جانبًا يتعلق بفلسفة الدين وسوسيولوجيا الدين، لكن هناك أيضًا جانبًا يتعلق بفهم النظريات الحديثة في علم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، والفلسفة. هذا ما جعلكم تفتحون بما يتجاوز العلاقة التقليدية بين العلوم الاجتماعية والإنسانية والدين، أليس كذلك؟
د. ميادة كيالي:
صحيح، لأننا حاولنا أن نرى أن الدين حاضر في كل العلوم الأخرى، وخاصة بالنسبة لنا كعقل عربي.
لنقل إن الدين يشكل العنصر الرابط الموجود في كل شيء، فدرسنا علاقة السياسة بالدين، وعلاقة الاجتماع بالدين، وعلاقة التاريخ بالدين، وعلاقة الفلسفة بالدين، حتى نتمكن فعلاً من بناء دراسات مهمة.
إضافة إلى ذلك، سعينا كثيرًا للاشتغال على الترجمة، وترجمة أمهات الكتب إلى اللغة العربية، وخصصنا
لذلك جزءًا كبيرًا، ووصلنا إلى مرحلة بلغت حوالي 25% من الإنتاج المترجم.
د. ساري حنفي:
لاحظت من الأسماء التي استكتبتوها، أن هناك أسماء كانت قبل سنوات قليلة مغمورة، وواضح من سيرهم الذاتية، ومن تعريفهم أنهم شباب يحملون ماجستير، وبعضهم كانوا في طور إتمام الدكتوراه أو تخرجوا قبل سنة أو سنتين. وفي الحقيقة، لاحقًا صاروا نجومًا، أو على الأقل صاروا أساتذة.
هل هذا التوجه باتجاه الشباب كان مقصودًا؟ هل هذا حدث صدفة، أم لأن الشباب وخصوصا طلاب الدكتوراه - كما تعلمين - هم من يجددون المعرفة؟ تحدثي لنا عن هذه النقطة بوصفها نقطة ميزت مؤمنون بلاحدود.
د. ميادة كيالي:
إذا لاحظت، دكتور ساري، أو أي شخص يتابع الندوات الحوارية التي نقوم بها منذ مدة، أنا والدكتور
حسام الدين درويش، نناقش فيها الكتب والمشاريع التي عملناها في "مؤمنون بلا حدود". سيلاحظ أحيانًا أنني أتوقف عند بعض المؤلفات التي قابلت فيها الباحثين منذ عام 2008؛ أي حتى قبل تأسيس "مؤمنون بلا حدود"؛ لأن منهم من كان في مرحلة دراسة الماجستير، ومنهم في مرحلة الدكتوراه، وكملوا مسيرتهم. والقسم الذي استمر معنا في "مؤمنون بلا حدود" فعلاً فتحنا له المجال والمنصة ليظهر فيها. كنا نحاول دائمًا، حتى إننا أنشأنا جوائز للأبحاث، ولم نركز على الجيل المخضرم الذي له اسم وسمعة، وكان له وجود وحضور، وكان لدينا أسماء مهمة كثيرة، لكن في الوقت نفسه أخذنا بيد الباحثين المغمورين؛ لأن منهم من قدّم بالفعل أبحاثًا وكتبًا ودراسات مهمة وبرزوا معنا.
تشعر وكأننا أسسنا عائلة أو تيارًا، فيما بعد؛ لأن تيار "مؤمنون بلا حدود" أصبح بالفعل له اسم موجود في المغرب وتونس ولبنان وحتى سوريا. يمكنني أن أخبرك أنني رجعت إلى سوريا بعد غياب طويل؛ إذ كانت آخر زيارة لي عام 1994، وعدت في 2009، ورجعت اليوم، وهم يعرفونني؛ أي أنني موجودة، ولم أغب؛ لأنني موجودة من خلال "مؤمنون بلا حدود".
كان تركيزنا كبيرًا على جيل الشباب، الذي ساهم كثيرًا، وهذه ميزة لنا، وكتبوا عنا أكثر من مقال وأكثر من دراسة، وكان واضحًا تركيزها على جيل الشباب من الباحثين.
د. ساري حنفي:
أود العودة إلى "مؤمنون بلا حدود" حتى آخر نقطة، لكن لا أريد أن أفقد مرحلة مهمة في حياتك، وهي أنكِ ريادية في مجال البحث، وباحثة أولًا، وأيضًا روائية (سأترك الحديث عن الروايات لاحقًا).
لكن أريد أن أتحدث الآن عن لحظة البحث العلمي؛ اهتمامك بقضايا المرأة العربية ووضعتها في سياق تاريخي، وأنتِ أتممتِ ماجستير ودكتوراه في الحضارات القديمة. هل يمكنك أن تحدثينا قليلاً عن سبب قيامك بذلك؟ وأريد أن أعرف أيضًا، هل شعرتِ، وأنتِ ترسمين مسارك كباحثة (Researcher) رائدة، أنكِ واجهتِ تقبلًا مختلفًا لو كنتَ رجلاً؟ حدثينا عن هذه المرحلة من شغلك وحياتك.
د. ميادة كيالي:
أنا لا أنكر أنه في وقت من الأوقات قال لي، رحمه الله، الدكتور محمد شحرور: "ميادة"، قلت له: "أنا دكتور، وأحب أن أعمل دراسات عليا بفكر محمد شحرور، وأشعر أنني يومًا ما سأعمل دكتوراه بفكر محمد شحرور."
كانت هذه في بدايات العمل في مركز "سراج"، فقال لي: "لا، هذا ضروري جدًّا." أنا أتخيّل أن هذه الكلمة في ذلك الوقت أعطتني حافزًا؛ قال لي: "ميادة، أنتِ تديرين مركز دراسات فيه دكاترة، ويجب أن تكوني أنت أيضًا في هذا المستوى."
بالنسبة لي، فصلت بين موضوع الإدارة وكونك تدير عملًا، حتى لو كان بحثيًّا يحتاج إلى ملكات مختلفة عن التي يحتاجها أن تكون مفكرًا أو مديرًا للأبحاث.
ومع ذلك، ظلّت هذه الكلمة حافزًا في ذهني، ولم تغب عن بالي، أنني يومًا ما، صحيح، سأدير هذا العمل، لكن لن أكون أقل من أي شخص موجود بدرجتين.
وفي الوقت نفسه، كانت لدي وصية من والدتي، رحمها الله، التي كانت تحلم أن أكمل دراستي في الهندسة، وكانت متمنية أن أحصل على دكتوراه في الهندسة.
والحقيقة أن ما قالته لي والدتي صنعني؛ لأنها رفضت أن أتنازل عن الجانب العملي والأكاديمي في حياتي، وأتفرغ فقط للعائلة.
د. ساري حنفي:
بما أن الموضوع سوسيولوجي، يهمنا أن نعرف: ماذا كانت تعمل والدتك؟ هل كانت متعلمة؟
د. ميادة كيالي:
كانت أمّي غير متعلمة، إلا أنها كانت تعظم العلم وتقدس العمل. في وقت من الأوقات، تعرض والدي لحادث فلم يعد قادرًا على العمل كما يجب، فساعدته ووقفت بجانبه حتى تعلمت مهنة الخياطة، وصارت تعمل بها. بعد أن تعلمت من الخياط اللبناني الشهير الذي كان يخيط لها، فتحت معه مشغلًا صغيرًا، وظلت تساعدنا حتى تخرجنا من الجامعة. كانت والدتي تقول: "في أي يوم من الأيام، مهما كان عمرك، إذا بقي لديك يوم في حياتك يمكنك أن تتعلم فيه شيئًا جديدًا، يجب أن تتعلم؛ لأنك لا تعرف ما الذي سيحدث."
أتذكر في عام 2003، قبل وفاتها بعشرين يومًا، كنت في زيارة لها، وكانت موجودة في الإمارات عند أختي، فقالت لي جملة ظلت معي وأرددها، وربما لن أنساها أبدًا، هذه الجملة صنعتني وصنعت كل نجاحي فيما بعد. قالت لي: "أنا لا أغضب إلا لأنك تركتِ استكمال دراستك"، فقلت لها: "ليس عندي مال، وتفرغت لهم." فقالت لي: "لو لم تكن ميادة، لما استطاعت أن تجمع بين كل هذه الأشياء معًا."
وأضافت: "إذا جاء الإنسان إلى هذه الحياة ورحل دون أن يترك شيئًا يتذكره الناس بعده، كأنه لم يولد ولم يعش." كانت هذه آخر جملة قالتها لي، وظلت معي. بعد وفاتها، بدأت أفكر في هذه الجملة، وبدأت أستعيد جزءًا من ميادها من خلال المقالات التي كتبتها في جريدة "العصر" ما بين 2004 و2005 و2006 في لبنان، والتي أنقذتني وأخرجتني مثل طوق نجاة؛ لأنها جعلتني أشعر بأنني موجودة. حتى من خلال هذه المقالات، التي كانت عمودًا يوميًّا ثابتًا في مجلة "العصر"، بدأ الناس يعرفونني في زحلة بلبنان، بعدما كنت فقط سورية زوجة اللبناني، لا أكثر ولا أقل.
صرت أمر عليهم في السوق، يقولون لي: "نعم، قرأنا المقالة الفلانية، لقد نقلت الأفكار التي نريدها من خلالها، ونحن نحبها."
ففعلاً، هذا الجزء أثر فيّ كثيرًا، إضافة إلى أن والدي ينتمي إلى عائلة الكيالي المشهورة بالمفكرين والشعراء ورجال الدين. وكان وزير الثقافة حسن كيالي، وهو أيضًا ابن عم البابا عبد الرحمن كيالي، صاحب مركز دار الكيالي للطباعة والنشر، وهي أكبر دار مطبوعات.
أتذكر أن والدي كان يجلب لنا الكتب كلها ويوزعها؛ لأن هذا كان عمله. أتذكر حين كنت في الصف الرابع أو الخامس، وجدت كتاب "هكذا تكلم زرادشت"، وكنت أحاول أن أقرأه، وكان الجو بالنسبة لنا من حيث الحالة الفكرية، المكتبة، والقراءة، والكتب، جوًّا أساسيًّا في مساري.
د. ساري حنفي:
كان مسارك، في الحقيقة، مربوط بهابيتوس بالمعنى الذي يعطيه له بيير بورديو إذا حللنا الأمر. لماذا موضوع المرأة؟
د. ميادة كيالي:
أما بالنسبة إلى موضوع المرأة، فهو موضوع تاريخي، جاء بالصدفة حين درست التاريخ. في عام 2010، حاولت التقديم لماجستير في "الفنون والمتاحف" في السوربون، لكنه كان محدود القبول، رغم أنني كنت مؤهلة جدًّا للدخول؛ لأن لدي مستوى متوسطًا في اللغة الفرنسية إلى جانب الإنجليزية، وقد أستطيع الاستمرار فيهما، وكان هذا جزءًا مما أحببته، ولكنني لم أتمكن من الحصول على الفرصة؛ لأن دوام الدراسة لم يكن مناسبًا لعملي، فأنا أدير مؤسسة، وأضطر للسفر، وأتابع ولديّ أيضًا. لذا كان من المستحيل أن أتفرغ للدراسة بدوام كامل في النهار.
فالحلّ كان أن ألتحق بجامعة افتراضية تساعدني؛ إذ إنني حاصلة على بكالوريوس في الهندسة، وأحتاج إلى شيء يساعدني في دراسة التأسيس في العلوم الاجتماعية بطريقة ميسرة.
تعرفت على الدكتور خزعل الماجدي، وكان من الأشخاص الذين التقيت بهم. أخبرني أن لديه مؤسسة جامعية في هولندا، وقال لي إنه مستعد لمساعدتي في هذا المجال؛ إذ يمكنني دراسة سنة تحضيرية تعوضني عن البكالوريوس، ثم أبدأ الماجستير وأكمله.
اعتبرتها فرصة جيدة وسعيدة؛ لأنني أعمل شيئًا بالتوازي مع عملي، ولم تؤثر الدراسة على عملي. نجحت في السنة التحضيرية التي كانت سهلة بالنسبة لي، ثم التحقت بالماجستير.
في الماجستير، كان علي إعداد بحث تحضيري في السنة الأولى عن دور المرأة في الحضارة السومرية. وبالفعل، كان هذا كنزًا لي؛ فقد اكتشفت تاريخًا عريقًا، حيث كانت المرأة كاتبة ومغنية ومسؤولة عن حسابات القصر وحاكمة ومحاربة. شعرت أن التاريخ غني جدًّا في هذا المجال، فكانت تلك الومضة الأولى التي أطلقت شغفي بالتاريخ القديم، وكلما قرأت أكثر، زاد إعجابي به.
في السنة الثانية وضعت خطة البحث، وكان عنواني الأساسي "المرأة". شعرت أن هذا امتداد لتاريخ والدتي، المرأة البسيطة التي لم تكمل تعليمها، لكنها كانت تملك قوة كبيرة حافظت بها على أسرة مكونة من سبعة أفراد وربتهم وعلمتهم.
كان لي بحث عن نفسي وعن جداتي وتاريخي، وتمكنت من النجاح فيه.
ساعدني كثيرًا الدكتور خزعل بتحمله الضغوط التي كانت على كاهلي، مع مسؤولياتي الكبيرة، وشجعني عندما كنت أميل للعمل العملي في المؤسسة والإدارة وأهمل دراستي وأولادي، قال لي: "لا، يجب أن تعطي أفضل ما لديك." وفي مرة من المرات، قال لي شيئًا جعلني أبكي: "هذا ليس الشغل الذي قدمته، هذا ليس شغل مهندسة ميادة، أنت مهندسة ويجب أن تعملي بكل طاقتك". فذكرني ذلك بوالدتي رحمها الله.
د. ساري حنفي:
كان للهندسة تأثير واضح عليك، في عنوان كتابك الثاني "هندسة الهيمنة على النساء: تاريخ الزواج في حضارات العراق ومصر القديمة "...؟
د. ميادة كيالي:
بعد أن أنهيت الماجستير، أتذكر أن مدير المركز الثقافي، الأستاذ وصديقنا العزيز بسام الكردي، طلب مني إرسال الكتاب، فقال لي إنّه يتشرف بطباعته؛ لأنه يستحق ذلك.
د. ساري حنفي:
أنت تتحدثين عن المركز الثقافي العربي؟-
د. ميادة كيالي:
نعم، كان يديره بسام الكردي، وهو الآن في المغرب، وكنا نتعامل معه نحن في مؤمنون بلا حدود. في البداية طبعنا عنده أول مئة نسخة مشتركة؛ لأنه كان على رأس هذه المؤسسة.
أيضًا، جاءني تشجيع من الدكتور فهمي جدعان، الذي بعث لي رسالة إلكترونية شجعني فيها على طباعة الكتاب، وتحويله إلى كتاب ورقي. تشكل لدي رضا عن الإنجاز الذي حققته في تلك الظروف، لكنني تكاسلت قليلاً عن متابعة الدكتوراه.
ثم عاد إليّ شخص آخر، وكان عزيزًا عليّ، وهو الدكتور موسى برهومة، الذي قال لي إنه من الضروري أن أكمل، وأن أواصل في نفس الموضوع الذي بدأته، وهو تاريخ المرأة وكل ما يخص المرأة. قال لي: "هذا ملعبك، حرام أن تتركيه."
أنا أشكر د. موسى كثيرًا، فقد كان المشجع الأول لي على متابعة موضوع الدكتوراه، لإيمانه الحقيقي بإمكانياتي في الاستمرار. وفعلاً، أكملت الدكتوراه بعد أن أنهى أولادي البكالوريا عام 2017، وحصلت على الدكتوراه في أوائل 2018، وكانت أطروحتي في هذا الموضوع.
بالنسبة لي، كلمة "الهندسة" تعني أن هناك مخططًا في التاريخ، رغبة في تشكيل وسحب البساط من تحت المرأة والسيطرة عليها، بعد أن كانت تملك جميع أسباب القوة، وتشكل المجتمع الأبوي بما فيه من مؤنث ومذكر.
في علم الاجتماع، يقولون إن الصورة التي تمثل الشخص الحاكم على الأرض يقابلها في الميثولوجيا إله متناغم مع جنس المسيطر على الأرض، وهذا صحيح؛ فالمرأة كانت تملك ثروات المعابد، والنسب كان لها، وكانت المسؤولة، وهي صاحبة اكتشاف الزراعة، التي كانت ثورة في التاريخ على يد المرأة.
كما كانت المرأة الحامية للنار والصناعات الأولى، التي بدأت من بين يديها، مثل صناعة الفخار ورسوم المعابد. وتشير بعض الأبحاث إلى أن 75% من بصمات الرسومات في المعابد هي للنساء.
نشرت مجلة ناشيونال جيوغرافي، بالتعاون مع جامعة أمريكية، هذا البحث المهم، وكأن المرأة هي التي رسم وعبرت عن المشاعر الأولى للعالم القدسي والخلق، حيث تتمثل الخلقة أيضًا في جسدها.
د. ساري حنفي:
هل أثر اهتمامك بالمرأة والنسوية، وعملك على الدراسات الدينية وتجريد الفكر الديني، في تفكيرك بالنسوية الإسلامية من أمينة ودود إلى نائلة سيليني في تونس، إلى آخره... هل فكرت في هذا الموضوع، هل فكرت كيف يمكن أن تتخذي هذا المسار المهم، الفكري والمهني، في لحظةٍ، لنقل، راهنة، ومليئة بالإشكاليات المعاصرة واليومية؟
د. ميادة كيالي:
أستطيع أن أقول إنني فكرت في هذا الموضوع، خصوصًا بعد عام 2020، أي بعد أن تحوّلت "مؤمنون بلا حدود" - كما تعلم-، بعد جائحة كورونا وهذه النكسة التي تعرّض لها المشهد الثقافي كلّه.
عمليًّا، اليوم، المؤسسة – دار النشر – هي التي تحمل إرث "مؤمنون بلا حدود"، وتحوّلت إلى مؤسسة نشر وإنتاج معرفي، بطريقة متميزة. ليست دار نشر عادية، بل تعمل على الكتاب منذ استلامه، من حيث المحتوى وتحكيمه، والعمل عليه، ثم نشره بكل الوسائل الممكنة: من حوارات، وندوات، وأبحاث، وغير ذلك من الوسائل المتاحة.
اكتشفت أن هناك جانبًا أحسست فيه وكأن هناك نوعًا من العداوة المبطّنة بين الدراسات الدينية والدراسات النسوية. وكأنني، لمجرد أنني عرّفت عن نفسي بأنني نسوية، بدا وكأني ضد الدين، وكأنه توجد حالة من المواجهة! حتى إن بعض النسويات لا يقبلن بفكرة وجود شيء يُسمى "نسوية إسلامية"، وأنا أعتبر ذلك إجحافًا؛ لأن لديّ صورًا مشرّفة لنساء، سواء رحلن أو لا يزلن معنا.
حتى الآن، مثلًا، أعتبر عفراء جلبي أيضًا نسوية إسلامية تعمل في هذا المجال. لماذا لا يكون هناك نسوية إسلامية؟ ما المانع؟ وكأننا، عندما نقول إنه لا توجد نسوية إسلامية، نقرّ بوجود عداوة بين الدين والنسوية!
د. ساري حنفي:
أنا مسرور بأن "مؤمنون بلا حدود" أتاحت تسليط الضوء على عمل عفراء جلبي، التي عمليًّا ليست معروفة كثيرًا في العالم العربي، فهي تقيم في كندا. وبالمناسبة، لمن لا يعرف، هي ابنة أخت الشيخ جودت سعيد، وابنة خالص جلبي.
د. ميادة كيالي:
هي من أوائل من أمّت الناس في صلاة العيد، وكانت إمامة وخطيبة ومتحدثة. وكان خطابها مؤثرًا جدًّا، وأسعد عندما أسمعها.
أذكر لك حادثة معيّنة: أذكر أن الدكتور محمد شحرور – رحمه الله – هو من قال لي: "ميادة، هل سمعتِ عن عفراء جلبي؟ لقد خطبت في العيد وأمّت المصلّين". سمعت هذه الحادثة منه، ربما في عام 2009 تقريبًا. وكان الدكتور شحرور يحبّ الشيخ جودت سعيد كثيرًا، وقال عنه ذات مرة: "أنت نيوتن العرب"،
د. ساري حنفي:
تعلمين، أنا من جلب كتاب القرآن للشيخ جودت سعيد. كنت أزوره في "بير عجم"، كنت أنا وصديق من السلمية اسمه صفوان الموشلي، فكنا نذهب معًا لزيارته. وأتذكر أننا حملنا له كتبًا لمحمد عبد الجابري ولحسن حنفي، وهكذا. هو طبعًا كان يعرف كلاسيكيات أخرى، لكن ليس هذا النمط من الكتابة في الفكر الإسلامي، نحن حملناه له؛ لأننا كنا في العاصمة، ونعرف من هم المفكرون الجدد...أنا آسف، فقط كان هذا بين قوسين.
د. ميادة كيالي:
خاصة نحن أيضًا، كنساء سوريات، تعرّضنا لغبن في حقوقنا، بسبب الظروف التي عشناها في سوريا، وهذا التشرذم... كل واحدة منا باتت منتشرة على خارطة العالم، فلم يعد هناك تركيز فعلي على الاشتغال بالإنتاج الفكري السوري عمومًا، والنسوي خصوصًا.
لذلك، أنا الآن، وخصوصًا في هذه الفترة، وفي هذه المرحلة، أحب فعلاً أن أركّز على هذا الاجتهاد. على فكرة، دكتور الشيء بالشيء يُذكر: نحن في المجتمع السوري، استعدنا، خلال غياب الدولة وغيابنا عن الحضور في المجموعات الثقافية على "واتساب"، أصبح الأمر ظاهرة. وكأن كل مجموعة لا تجد نفسها إلا ضمن مجموعة أخرى.
أحيانًا، تجد نفسك عضوًا في عدة مجموعات على "واتساب"، وهذه كانت المتنفس الوحيد، لنقل "العالم الآمن"، لتشكّل مجموعة من الناس.
د. ساري حنفي:
يكون هذا هو الفضاء العمومي – Public Sphère – في مجتمعات يسودها الاستبداد، والتي هي غير آمنة.
د. ميادة كيالي:
صرنا نتوجّه إلى بعضنا البعض، نعرف بعضنا أكثر، ونثق ببعضنا قدر الإمكان. وكان بعضهم لا يسجّل الندوات أبدًا، مع أنها كانت بالفعل بالغة الأهمية. في إحدى هذه الندوات، تعرّفت على العزيزة رحاب شاكر، وهي مترجمة مهمة في مجال الترجمة بهولندا. خلال ذلك، دعتني للانضمام إلى مجموعتها؛ وكان لديها مكان أطلقت عليه اسم "بيت النرجس"، يضم أقسامًا، مثل: قسم القراءة النسوية، قسم القراءة العام (مثل قراءة الروايات)، وأسست أيضًا الغرفة الثالثة من هذا البيت، وهي تعنى بتجديد الفكر الديني وقضايا المرأة تحديدًا. فدعتني، وقالت لي: "أعتقد أنّ لديك أفكارًا في هذا الاتجاه، ما رأيك؟" فقلت لها، كما يُقال: "أروِ عذرك ولا تروِ بُخلك"، أخبرتها بأن وقتي مزدحم، ولكنني سأشارك، على الأقل لأتعرّف على هذا الحراك. ومن خلال "بيت النرجس"، تعرّفت على الدكتورة عفراء، ومن خلاله أيضًا، تعرّفت على العديد من الوجوه العزيزة، مثل الدكتورة عفراء، والدكتورة نعمت برزنجي، التي لديها كتابات مهمة، وتأويلات للنصوص، وتُعدّ من النسويات الإسلاميات المهمّات. وهنّ أيضًا، من خلالي، تعرفن على أفكار أخرى، وإلى مفكّرين من المجدّدين.
د. ساري حنفي:
أنتِ، ميادة كيالي، باحثة سورية، قادمة حديثًا من سوريا كما نقول. أولًا: ما هي مشاعرك في أول زيارة بعد "تحرير" سوريا؟ وثانيًا: هل هناك مشاريع لسوريا؟ نحن جميعًا اليوم يجب أن نكون ورشات عمل، نفكر في كيفية الانتقال نحو مرحلة انتقال ديمقراطي حقيقي، مدني، إلى آخره... فهل يمكنكِ أن تحدثينا عن ذلك؟
د. ميادة كيالي:
اليوم، صادف أنني كتبت على "فيسبوك" أن إحساسي وأنا في سوريا كان شبيهًا بإحساسي عندما كانت المدرسة ترسل إلينا دعوة لحضور اجتماع أولياء الأمور مع الأساتذة. كنت أذهب، والهيئة التعليمية كاملة موجودة، وكل مادة لها أستاذ، وأنا يجب أن أقدّم نفسي: "أنا أم فارس"، أو "أم كريم"، ثم يبدؤون بقول: "ينبغي أن يعمل كذا، وهو مقصّر في كذا، وكذا وكذا..."وأنت تأتي بهذا الشعور... أنت أب أو أم لهذا "الولد"، الذي تراه أغلى ما تملك، وتضعه بين أيادٍ أمينة، ولكنك رغم ذلك، تشعر بأنك مسؤول، ويجب أن تكمل معه هذا المشوار.
ذا كان شعوري عندما نزلت إلى سوريا… شعرت أن هذا البلد يرتبط بروحي. وكانوا يسألونني: هل ستعودين إلى سوريا؟ فأجيبهم: قطعًا مستحيل؛ طالما أن هذا الإنسان موجود في هذا البلد، لا يمكنني أن آتي. علمًا بأنه كان خاضعًا لحظر، لكن حتى لو رُفع هذا الحظر، فلست مستعدة لرؤية وجهه في هذا البلد. نزلتُ هذه المرة، فشعرتُ بحريةٍ لم أعهدها منذ فتحتُ عينيّ على الدنيا. ولأول مرة شعرتُ أنني قادرة على التحدث مع الجميع: أحدث صاحبَ المحل، وأتبادل الحديث مع سائق التاكسي الذي كنّا نخشى أن ننطق بكلمة واحدة أمامه، لأنه قد يكون عنصرًا في المخابرات.
الناس جميعهم ما زالوا يحملون التفاؤل، رغم كل ما مرّوا به، ورغم كل العذاب والدمار. وجيل الشباب أكثر تفاؤلًا منا؛ نحن جيل النكبة. والمُلفت أن نسبةً كبيرةً منهم، ممن تراهم في الشوارع، يحملون طاقةً خلاقة، وهم منفتحون على وسائل التواصل الاجتماعي، صاروا على درايةٍ أوسع، وصار الحلم ممكنًا بالنسبة إليهم. أمّا نحن، فقد انتظرنا خمسين أو ستين عامًا حتى رأينا هذا اليوم، بينما هم، على الأقل، باتت لديهم فسحةٌ للحلم
د. ساري حنفي:
أنا مسرور؛ لأنني شاهدت أربع ندوات نظمتها مؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، بالتعاون مع المستشار والصديق حسام الدين درويش، الفيلسوف السوري المهم، وكانت حول سوريا ومعناها.
فعلاً، نحن الآن في الجامعة الأمريكية، أُعدّ مع زميلتي ريما ماجد سلسلة عن "سوريا ما بعد الأسد". ونشعر أننا بانتظار أن يكون هناك حوار وطني، يمكننا من خلاله أن نقيم مؤتمرًا، وربما مؤتمرًا سياسيًّا، المقصود أن من واجبنا أن نستمع إلى بعضنا، وأن تستمع الاتجاهات المختلفة إلى بعضها، ريثما يحدث شيء رسمي في سوريا. سأكمل سؤالي لكِ، ميادة: هل ستواصلون العمل في هذا المجال؟
د. ميادة كيالي:
بالتأكيد، نحن الآن نظمنا ثلاث ندوات؛ كانت الأولى تضم نخبة من الأساتذة. أما الندوتان التاليتان، فقد خصّصتا قليلًا لموضوع المرأة، نتيجة الحراك الحاصل. طبعًا؛ لأن من الأساسيات في المرحلة القادمة هو حضور المرأة. لا يمكن أن نحيد المرأة بعد كل ما عانته خلال هذه المراحل، معاناة قد تكون مضاعفة أحيانًا مقارنة بالرجل. لذلك، من غير المقبول أن يتم تهميشها بأي شكل من الأشكال، أو إطلاق أي تنميط في حقها، فهذا قد فات أوانه؛ لأنها، بعد أن تحمّلت ما تحمّلت، تخطّت كل الأدوار المطلوبة منها. أصبحت هي الأب، والراعي، والحامي، والعامل، وكل شيء. ولهذا كان الأمر ضروريًّا.
بالنسبة لي، أتذكّر شيئًا سأقوله هنا: في عام 2017، عاد معرض الكتاب في مكتبة الأسد، في محاولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، ونُظّم المعرض. أذكر وقتها أنني كنت أميل إلى مقاطعته، كما قاطعته كثير من دور النشر، لكنني شعرتُ أن من واجبي أن أشارك، رغم أن في داخلي غصّة. لكنني قلت لنفسي: دخول كتب "مؤمنون بلا حدود" إلى سوريا أهم عندي من هذه الغصّة، فابتلعتها. ابتلعتها لعامين. شاركت في العام الثاني أيضًا، وتوقفت بعد ذلك، معتبرة أن المهم هو دخول الكتب. كنت حزينة جدًّا عندما كانوا يبعثون لي يسألون: كيف يمكننا الحصول على الكتب؟ حتى التهريب لم يكن ممكنًا، حتى المكتبات حاولت إيصال كتب عبر أشخاص، ولكن دون جدوى.
وأنا أعلم أن هناك اليوم تعطشًا شديدًا للكتب في كل مكان في سوريا، وأنا مستعدة لأن أقدّم هذا المخزون من الكتب الذي أملكه إلى المراكز الثقافية والجامعات بكل الأشكال. وهذا أبسط ما أستطيع.
د. ساري حنفي:
إن شاء الله يكون هناك من المعنيين من يستمعون إلينا، ويتواصلون معك.
د. ميادة كيالي:
إن شاء الله، وهم يحاولون أن يوفّروا السبل التي تمكّنني من أن أساهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، أنا أؤمن، أولًا وأخيرًا، بأن المعرفة هي أمضى سلاح. كل شيء له قوانين، وهذه القوانين قدَرية، والقضاء هو المعرفة. كلما ازدادت معرفتنا، كلما ازداد قضاؤنا في قدرنا. فلم نعد نسمح للقدر بأن يتحكم فينا، بل نحن، من خلال المعرفة، نستطيع أن نتحكم في هذا القدر، ونوجّهه نحو الخير ومصلحة بناء سوريا، إن شاء الله.
د. ساري حنفي:
بهذه الكلمة، أشكركِ كثيرًا، ميادة، على هذا اللقاء اللطيف. وأشكر حسن استماعكم، وإن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة من بودكاست ربط البحث الاجتماعي بالمجتمع.
والسلام عليكم.